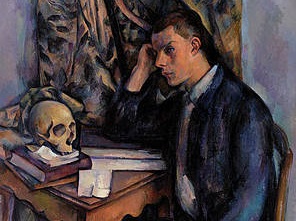تتناول هذه الورقة أبرز مشكلة من مشكلات فلسفة العلم العامة، وهي مشكلة الاستقراء! (نسخة PDF)
1. مقدمة
فلسفة العلم تأمّل نقدي في أفضل طريقة ابتدعها الإنسان لإدراك حقيقة العالم من حوله. هي ميدان واسع من ميادين البحث، ولهذه الحقيقة أسباب موضوعية، بعضها على علاقة مباشرة بموضوع البحث في هذا الميدان، ونعني به العلم نفسه. أولا، هناك سبب تاريخي، فالعلاقة بين العلم والفلسفة تعود جذورها إلى الحضارة الإغريقية ولم تزل مستمرة إلى عصرنا الحاضر، وأمام علاقة بهذا العمر الطويل لا نتوقّع من أي ميدان بحث يختصّ بأي شكل من أشكال هذه العلاقة سوى أن يكون واسعا من حيث منظوره التاريخي على أقل تقدير. ثانيا، هناك سبب فكري، فالمشكلات الفكرية التي أثارها ويثيرها العلم لا حصر لها، والتعامل مع هذا الكمّ الكبير من المشكلات يجعل من اتسّاع ميدان فلسفة العلم أمرًا متوقّعا. أخيرا، هناك سبب إجرائي، فمن المتعارف عليه تقسيم العلم الحديث إلى فروع متعددة بحسب طبيعة موضوع البحث، ومن الطبيعي أن تتّسع فلسفة العلم بما يكفي للإحاطة بفروع العلم الحديث. هذا من حيث حجم فلسفة العلم بوصفها ميدانا للبحث، لكن ماذا عن مضمونها؟
فلسفة العلم فرع من فروع الفلسفة وموضوعها هو العلم، وحين يكون الموضوع متعلّقا بالعلم على إطلاقه، نكون أمام ما يسمى “فلسفة العلم العامة”، وأمّا إذا ارتبط الموضوع بعلم محدد، فإننا نكون عندئذ أمام فلسفة هذا العلم على وجه الخصوص؛ على سبيل المثال، هناك فلسفة الفيزياء وفلسفة الأحياء وفلسفة اللسانيات وغيرها من فلسفات تختصّ كل واحدة منها بفرع من فروع العلم، وجميعها فلسفات تقع تحت مظلة فلسفة العلم العامة[1]. بطبيعة الحال، تتعلّق الأسئلة التي تطرحها فلسفة العلم العامة بالعلم من حيث هو علم، في حين تنصبّ الأسئلة في فلسفات العلم الخاصة على العلم من حيث هو فرع من ضمن فروع العلم الأخرى. على سبيل المثال، أسئلة من قبيل “ما طبيعة القانون العلمي؟”، أو “ما هي العلاقة بين التفسير العلمي والتنبؤ العلمي؟”، أو “ما الفرق بين العلم الحقيقي والعلم الزائف؟”، جميعها أسئلة تنتمي إلى فلسفة العلم العامة، في حين أنّ أسئلة من قبيل “ما الطبيعة الجوهرية للزمان والمكان؟”، و”هل بات مفهوم الغائية زائدا عن الحاجة في ظل نظرية التطور؟”، و”هل ينتمي علم اللغة إلى العلوم الطبيعية أم إلى العلوم المجرّدة؟”، هي أسئلة تنتمي – على التوالي – إلى فلسفة الفيزياء وفلسفة الأحياء وفلسفة اللسانيات.
تتناول هذه الورقة أبرز مشكلة من مشكلات فلسفة العلم العامة، وهي مشكلة الاستقراء. في القسم التالي، وعلى سبيل التمهيد، سنوضح بعض الفروقات بين أهم نوعين من أنواع الاستدلال العلمي: الاستــنباط والاستقراء، ثم ننتقل في القسم 3 إلى الحديث حول المعرفة العلمية من حيث احتوائها على تكلفة استبدال مزية بأخرى، أو بعبارة أخرى أكثر تحديدا، من حيث احتوائها على تنازل عن اليقين في مقابل اكتشاف الجديد. يتناول القسم 4 الموضوع الرئيس لهذه الورقة، وهو مشكلة الاستقراء، ثم نختم أخيرا في القسم 5 بتلمّس أثر هذه المشكلة الفلسفية على مكانة الاستقراء في المنهج العلمي.
2. الاستنباط والاستقراء
تتكون الحجة المنطقية من طرفين: مقدمات ونتيجة، والاستدلال هو استخلاص نتيجة من مقدمات. حين يكون الاستدلال خاضعا لقوانين المنطق، نكون أمام استدلال سليم منطقيا، وحين يخالف الاستدلال قوانين المنطق، نكون أمام مغالطة منطقية. هناك نوعان رئيسيان من الاستدلال: الاستنباط والاستقراء، ولكل منهما أشكاله الخاصة. أبرز فرق بين هذين الاستدلالين يكمن في درجة احتمال نتيجة كلّ منهما؛ فنتيجة الاستدلال الاستنباطي يقينية، ونتيجة الاستدلال الاستقرائي محتملة. للتعرّف بشكل أوسع على الفروقات بين هذين النوعين من الاستدلال المنطقي، سيكون من المفيد التوقف قليلا لتوضيح الفرق بين القضية التحليلية والقضية التركيبية[2].
في القضية التحليلية، مثل “أخي الأصغر أصغر مني”، الموضوع “أخي الأصغر” يتضمّن المحمول “أصغر مني”[3]، ولهذا تتصف القضية التحليلية بخاصيتين: (1) هي صادقة دائما بحيث أن نفيها يؤدي إلى تناقض، ليس استنادا إلى تطابق مضمونها مع معطيات الواقع، بل استنادا إلى مجرّد تحليل مفرداتها تحليلا دلاليا، ولهذا، (2) هي تحصيل الحاصل، أي أنها قضية لا تأتي بمعلومة جديدة تتعدّى حدود اللغة إلى حدود الواقع. أمّا القضية التركيبية، مثل “الجو ممطر”، فإنّ الموضوع “الجو” لا يتضمّن المحمول “ممطر”، ولهذا تتصف القضية التركيبية بخاصيّتين: (1) هي صادقة أو كاذبة اعتمادا على مدى تطابق مضمونها مع معطيات الواقع، ولا يؤدي نفيها إلى تناقض، ولهذا، (2) هي قضية تأتي بمعلومة جديدة تتعدّى حدود اللغة لتتصل بمعطيات الواقع. إزاء هذا الاختلاف بين القضية التحليلية والقضية التركيبية، يبدو واضحا أننا أمام تكلفة استبدال مزيّة بأخرى: إمّا يقين من دون معرفة جديدة، وإمّا معرفة جديدة من دون يقين[4].
العلاقة بين الاستنباط والاستقراء شبيهة بالعلاقة بين القضية التحليلية والقضية التركيبية. تتصف الحجة الاستنباطية بأنّ استدلالها استدلال تحليلي، ذلك أن مقدماتها تتضمّن نتيجتها، وهي بذلك حجة تحصيل الحاصل، أي أن نتيجتها لا تأتي بمعلومة لم تكن موجودة أصلا في مقدماتها، وهي لهذا السبب نتيجة صادقة بالضرورة المنطقية ومستقلّة عن معطيات الواقع. على سبيل المثال، من المقدمة “س أكبر من ص” والمقدمة “ص أكبر من ع” نصل عن طريق الاستنباط إلى نتيجة صادقة بالضرورة المنطقية: “س أكبر من ع”، وذلك بصرف النظر عمّا تشير إليه هذه الرموز، إذ يكفي أن نحلّل منطقيا العلاقة “أكبر من” كي ندرك أن محتوى المقدّمتين تضمّن محتوى النتيجة المنبثقة عنهما. في المقابل، حين نتأمّل الحجة الاستقرائية، نجد أنّ استدلالها يتّصف بأنه استدلال توسّعي، ذلك أنّ مقدماتها لا تتضمّن نتيجتها، أي أنّ نتيجتها أضافت معلومة جديدة لم تكن مُتضمَّنة في مقدماتها، وهي لهذا السبب نتيجة محتملة وتعتمد في صدقها على مدى قدرتنا على التحقق من تطابق مضمونها مع معطيات الواقع. على سبيل المثال، من المقدمة “كل كواكب مجموعتنا الشمسية التي تمّ اكتشافها حتى الآن لها مدار بيضاوي الشكل” بإمكاننا أن نستخلص عن طريق الاستقراء النتيجة التالية على شكل تعميم: “كل كوكب في مجموعتنا الشمسية له مدار بيضاوي الشكل”، وهي نتيجة محتملة وليست يقينية.
نستطيع القول – إذًا – إنّ علاقة الموضوع بالمحمول في القضية التحليلية مشابهة لعلاقة المقدمات بالنتيجة في الاستدلال الاستنباطي، في حين أنّ العلاقة بين الموضوع والمحمول في القضية التركيبية مشابهة للعلاقة بين المقدمات والنتيجة في الاستدلال الاستقرائي. كما هي الحال مع الاختلاف بين القضية التحليلية والقضية التركيبية، نجد أيضا هذا الاختلاف بين الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي، ونعني به الاختلاف المرتبط بتكلفة استبدال مزيّة بأخرى: مع الاستنباط نحصل على معرفة يقينية لكنها غير جديدة؛ ومع الاستقراء نحصل على معرفة جديدة لكنها غير يقينية.
أبرز خاصية للاستقراء هو أنه استدلال توسّعي كما ذكرنا، بمعنى أن المحتوى المعرفي لنتيجته غير مُتضمّن كُليّا في المحتوى المعرفي لمقدّماته، وهذه الخاصية التوسعية ملازمة للاستقراء بصرف النظر عن شكله. لنعطي مثالا على ذلك من خلال التوقف عند شكلين من أشكال الاستدلال الاستقرائي: الاستقراء التعدادي والاستقراء الاستبعادي.
في الاستقراء التعدادي، نصل إلى تعميم كُلّي استنادا إلى تعداد جُزئي، وقد رأينا مثالا على ذلك من خلال الانتقال من ملاحظة أن كل الكواكب التي تم اكتشافها في مجموعتنا الشمسية لها مدار بيضاوي إلى تعميم يشير إلى أنّ كل الكواكب في مجموعتنا الشمسية، المكتشف منها وغير المكتشف، لها مدار بيضاوي. هناك اعتقاد بأن المنهج العلمي قائم على الاستقراء التعدادي، بحيث تكمن مهمة العلماء في جمع المعلومات حول معطيات الواقع وتصنيفها بهدف اكتشاف تعميمات حول ظواهر الطبيعة. بصرف النظر عن مدى دقة هذا الاعتقاد، ما يهمنا هنا أن الاستقراء التعدادي استقراء لأنه استدلال توسّعي من حيث أن المحتوى المعرفي للتعميم يذهب إلى أبعد من المحتوى المعرفي للملاحظة الحسية، وهو استقراء تعدادي لأن الملاحظة الحسية قائمة على مجرّد تعداد معطيات الواقع، ولهذا السبب يُعرف الاستقراء التعدادي أيضا بالاستقراء البسيط.
إذا كان الاستقراء التعدادي بسيطا، فإن الاستقراء الاستبعادي مُركّب، ذلك أنه يبدأ باستنباط بغرض الاختبار وينتهي باستقراء بغرض الاختيار. مثلا، حين نكون أمام فرضيّتين مختلفتين تُفسّر كل منهما الظاهرة نفسها، بإمكاننا اختيار أحدهما استنادا إلى قدرة أي منهما على التنبؤ بظواهر جديدة، وهذا يحتاج إلى التسليم بصحة كل منهما على حدة كي نختبر مدى صحة ما ينتج عنهما. هذه الخطوة الاختبارية هي خطوة استنباطية. لنفترض أن التسليم بصحة الفرضية الأولى أدّى إلى تنبّؤ خاطئ، في حين أدّى التسليم بصحة الفرضية الثانية إلى تنبّؤ صحيح. بإمكاننا في هذه الحالة استبعاد الفرضية الأولى والاحتفاظ بالفرضية الثانية، وهذه هي الخطوة الاستقرائية والتي يُجسّدها الاستقراء الاستبعادي. لكن ما الذي يبرّر احتفاظنا بالفرضية الثانية؟ للوهلة الأولى، تبدو الإجابة مباشرة: فالفرضية الثانية لم تكتفِ بتفسير ظاهرة محددة فحسب، بل ذهبت أيضا إلى حدّ التنبؤ الصحيح بظاهرة جديدة. لا شك في أن هذه الإجابة لا غبار عليها، لكنها مع ذلك لا تبرّر منطقيا الاحتفاظ بالفرضية الثانية، فالاستشهاد بصحة التنبؤ للتدليل على صحة الفرضية يعني استخدام صحة النتيجة للتدليل على صحة إحدى مقدماتها، وهذه بالطبع مغالطة منطقية. هنا يكمن مظهر من مظاهر مشكلة الاستقراء التي سنتوقّف عندها بشيء من التفصيل في القسم 4، وما يهمنا هنا هو التأكيد فقط على أن كلا النوعين من الاستقراء، التعدادي والاستبعادي، يحتفظ بالخاصية التوسعية للاستقراء.
3. يقين بلا جديد أو جديد بلا يقين
إذا كان الهدف الأسمى من العلم هو اكتساب معرفة موثوقة وجديدة، وإذا كان المنطق أداة ضرورية لتحقيق هذا الهدف، فإن من الطبيعي أن نتساءل: هل من الممكن العثور على معرفة علمية تجمع بين اليقين والجِدّة؟ المعرفة العلمية الموثوقة إلى حدّ اليقين تحتاج إلى استدلال مثل الاستنباط، لكنها لن تكون في هذه الحالة معرفة جديدة، لأنها ستعتمد على استدلال ليس سوى تحصيل الحاصل، في حين أن المعرفة العلمية التي تطمح إلى الإتيان بجديد تحتاج إلى استدلال مثل الاستقراء، لكنها لن تكون في هذه الحالة معرفة موثوقة إلى حدّ اليقين، لأنها ستعتمد على استدلال غير سليم منطقيا. لقد عبّر كوهين وتلميذه ناجل عن هذه الفكرة في كتابهما القيّم والمعنون “مقدمة في المنطق والمنهج العلمي”[5]:
إذا كانت نتيجة الاستدلال غير مُتضمَّنة في المقدّمات، فلن يكون الاستدلال سليما؛ وإذا لم تكن النتيجة مختلفة عن المقدّمات، فإنها نتيجة غير مفيدة؛ لكن ليس بوسع النتيجة أن تكون مُتضمَّنة في المقدمات وتحتوي أيضا على ما هو جديد؛ وبالتالي، ليس بوسع أي استدلال أن يكون سليما ومفيدا في آن واحد.
يبدو واضحا أنّ الجمع بين اليقين والجِدّة في المعرفة العلمية أمرٌ مستحيل لأسباب منطقية صرفة، وهذا هو الرأي السائد في ميدان فلسفة العلم الحديث. كان أرسطو نفسه على دراية تامة بالفرق الإبستمولوجي بين الاستقراء والاستنباط، ومع ذلك ظلّ الجمع بين ما هو يقيني وما هو جديد يُشكّل النموذج الأمثل للمعرفة العلمية لقرون طويلة، بدءًا بفلسفة العلم عند أرسطو، مرورًا بمدرسة الإسكندرية الفلسفية والفلسفة العربية الإسلامية والفلسفة المدرسية المسيحية، وانتهاء بـ المذهب العقلاني في الفلسفة الغربية الحديثة. بالطبع، كان هناك منذ القدم أنصار المذهب التشكيكي ممن لا يؤمنون بإمكانية الوصول إلى يقين معرفي على الإطلاق، بل كان هناك أيضا من ضمن أتباع أرسطو على مرّ العصور ممن يقصرون اليقين العلمي على الحساب والهندسة وحتى علم الفلك، لكن النموذج الأرسطي للمعرفة العلمية بوصفها معرفة يقينية وجديدة ظلّ حاضرا حتى مع نضوج الثورة العلمية في القرن السابع عشر.
كان تفوّق فيزياء نيوتن على فيزياء ديكارت عاملا حاسما في تغليب الجانب التجريبي من المنهج العلمي الحديث على الجانب الحدسي، لكن تعزيز الجانب التجريبي لم يحسم على الفور الموقف من مسألة اليقين العلمي، فبعد مرور قرابة قرن كامل على ظهور فيزياء نيوتن، شهد القرن الثامن عشر موقفين متضادين إبستمولوجيّا: موقف “هيوم” السلبي والمتشكك بقدرة العقل البشري على الوصول إلى يقين علمي، وموقف “كانط” الإيجابي والطامح إلى إثبات إمكانية مثل هذا اليقين. أمّا موقف “هيوم” فسنتناوله لاحقا حين نصل إلى مشكلة الاسقراء في القسم التالي، وأما موقف “كانط” فذو جانبين، أحدهما متعلّق بفلسفة الرياضيات، والآخر متعلّق بفلسفة العلم، والرابط بينهما يكمن في إصرار كانط على أنّ هندسة إقليدس وقوانين نيوتن مثالان على معرفة قِبلية وتركيبية في آن واحد. لنشرح هذه النقطة الهامّة فيما يلي.
في فلسفة الرياضيات، هناك مشكلة تُعرف باسم “مشكلة كانط”، وهي تدور حول طبيعة المعرفة الرياضية. يلاحظ كانط صفتين للمعرفة الرياضية: هي معرفة تجمع بين ما هو يقيني وما هو جديد. لكنّ هاتين الصفتين تبدوان متناقضتين: فمن جهة، اليقين المعرفي مستقلّ عن الواقع، ومن جهة أخرى، التراكم المعرفي مرتبط بمعطيات الواقع. بعبارة أخرى، تبدو الرياضيات غنية معرفيّا رغم عدم اعتماد صحة مقولاتها على معطيات الواقع. لفهم كيف حاول كانط تجاوز هذا التناقض الإبستمولوجي، ينبغي أن نشير إلى تقسيمين للقضايا، الثاني منهما من ابتداع كانط نفسه: التقسيم الأول بين قضايا قِبليّة وقضايا لاحقة، والتقسيم الثاني بين قضايا تحليلية وقضايا تركيبية.
سبق أن تناولنا هذا التقسيم الأخير في القسم السابق، حيث أشرنا إلى أن الفرق بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية يكمن في مدى اشتمال الموضوع على المحمول؛ مثلا، في جملة “الأعزب شخص غير متزوج”، اشتمل معنى الموضوع “الأعزب” على معنى المحمول “شخص غير متزوج”، ولهذا هي جملة تعبّر عن قضية تحليلية، في حين أن جملة “اليوم يوم الأربعاء” تشير إلى قضية تركيبية، ذلك أن معنى الموضوع “اليوم” لا يشتمل على معنى المحمول “يوم الأربعاء”.
يعتمد تقسيم القضايا إلى قِبلية ولاحقة على علاقتها بمعطيات الواقع أو عالم الحس؛ حين تكون القضية مستقلة تماما عن معطيات الواقع بحيث يمكن تبرير صحتها من دون الاستعانة بعالم المحسوسات، هي قضية قِبلية، فمثلا، جملة “ضعف الخمسة يساوي نصف العشرين” تشير إلى قضية قِبلية. من جهة أخرى، حين تكون القضية مُستمدّة من معطيات الواقع بحيث لا يمكن تبرير صحتها من دون الاستعانة بعالم المحسوسات، هي قضية لاحقة، فمثلا، جملة “درجة غليان سائل في وعاء مفرّغ جزئيا من الهواء أقل من درجة غليانه تحت الضغط الجوي” تشير إلى قضية لاحقة.
لضمان ما هو يقينيّ في المعرفة الرياضية، يجادل كانط في أنّها معرفة قِبليّة، ولضمان ما هو جديد فيها، يصرّ كانط على أنها معرفة تركيبية[6]. بالطبع، لم يغب عن كانط أن وصف المعرفة الرياضية بأنها تركيبية يعني أنها معرفة تعتمد في صحتها على معطيات الواقع، لكن كيف تكون كذلك وهي أيضا معرفة قِبليّة، أي مستقلة تماما عن الواقع؟ لتبرير هذا التزاوج بين القِبلي والتركيبي، يلجأ كانط إلى قِبليّة الزمان والمكان، ولا تعنينا هنا التفاصيل بقدر ما تعنينا إحدى أهمّ نتائجه، وهي تأكيد كانط على أن الفضاء من حولنا إقليديّ بالضرورة، أي أنه فضاء ثلاثي الأبعاد بالضرورة، ذلك أن بُنية الذهن البشري لا تسمح إلّا في تصوّر الفضاء بهذه الصورة! يلجأ كانط إلى فلسفته المتعالية أيضا للتأكيد على أن قوانين الحركة في نظرية نيوتن تشير أيضا إلى معرفة قِبلية وتركيبية. هذا يعني أن قوانين نيوتن وهندسة إقليدس تشتركان في خاصية الجمع بين معرفة يقينية وجديدة في آن واحد.
أدّى اعتماد النظرية النسبية العامة على الهندسة اللاإقليدية في نسختها الرّيمانيّة إلى الإطاحة بالمنظور الكانطي، وقد أحدث هذا التطور ما يشبه الزلزال في نظرية المعرفة؛ ليس الفضاء من حولنا إقليدي بالضرورة، ولا تجسّد نظرية نيوتن الكلمة الأخيرة في ميدان الفيزياء[7]. في محاضرته الشهيرة أمام الأكاديمية البروسية للعلوم (برلين، 1921)، أعاد ألبرت آينشتاين طرح سؤال كانط الفلسفي حول علاقة الرياضيات المحضة بعالم الأشياء من حولنا: “كيف استطاعت الرياضيات، التي هي في آخر المطاف نتاج العقل الإنساني المستقل عن الواقع، أن تكون ملائمة – بشكل مثير للإعجاب – لوصف الأشياء في عالم الواقع؟”[8]. إزاء هذا السؤال الشائك، أو اللغز كما يصفه آينشتاين، يجيب هذا الفيزيائي الفذ إجابة بسيطة في شكلها وعميقة في محتواها: “بالقدر الذي تشير فيه قوانين الرياضيات إلى الواقع، فإنها ليست قوانين يقينية؛ وبالقدر الذي تكون فيه هذه القوانين يقينية، فإنها لا تشير إلى الواقع”[9].
لو تأمّلنا المشكلات التي ترتّبت على التخلّي عن اليقين العلمي، لوجدنا أنها مشكلات تدور جميعها حول مضمون إجابة آينشتاين، ذلك أنّها مشكلات تتعلق في مجملها بمشكلات الاستدلال العلمي، وأبرزها هي مشكلة الاستقراء.
4. مشكلة الاستقراء
الاستقراء – كما رأينا – استدلال توسّعي من حيث الفارق المعرفي بين مضمون مقدماته قياسا إلى مضمون نتيجته، ونظرا إلى أن هذا الفارق يشير إلى معرفة جديدة تضمّنتها النتيجة ولم تتضمّنها المقدمات، فإنّ مشكلة الاستقراء هي في جوهرها مشكلة تبرير هذه المعرفة الجديدة. فعلى سبيل المثال، قد تلاحظ أن جميع الأجانب الذين تعرّفت عليهم في حياتك أناس لطفاء، ثم تصل بواسطة قفزة استقرائية من هذه المقدمة إلى نتيجة تعميمية مفادها أن جميع الأجانب لطفاء. لو طُلب منك تبرير صحة المقدمة فلن تواجه مشكلة في القول إنّها قائمة على دليل مستمد من واقع تجربة شخصية، لكن حين يُطلب منك تبرير صحة النتيجة التعميمية، فلن يكفي أن تستنجد بالدليل نفسه، ذلك أنّ النتيجة ذهبت في تعميمها إلى أبعد من قدرة هذا الدليل على تبرير صحة التعميم. في ميدان العلم، قد لا يلجأ العلماء كثيرا إلى مثل هذا التعميم القائم على استقراء تعدادي بسيط، لكنّهم مع ذلك يحتاجون إلى تعميمات لا تختلف عن هذا النوع البسيط من حيث أنها تعميمات قائمة على استقراء توسّعي ينتقل مما هو جزئي ومحسوس ومعلوم إلى ما هو كُلي ومجرّد ومجهول، فكل قانون تجريبي، مثلا، هو تعميم بهذا المعنى حتى لو كان محدودا بشروط أولية، ولا يُمكن تخيّل قدرة العلم على جني معرفة جديدة من دون اللجوء إلى الاستقراء بوصفه استدلالا توسّعيّا، والعجز عن تبرير صحة هذه المعرفة هو ما تشير إليه مشكلة الاستقراء.
لو تأمّلنا أفكارنا وسلوكنا الروتيني، لوجدنا أننا نستخدم الاستقراء باستمرار وبكثرة في حياتنا اليومية، كما أنّ استخدام الإنسان للاستقراء أقدم من نشأة المنطق أو الفلسفة. أمّا أوّل محاولة فلسفية لتأمّل مفهوم “الاستقراء” بوصفه انتقالا من الجزئيات إلى الكليّات فنجدها عند أرسطو، وأمّا الاستقراء بوصفه مشكلة إبستمولوجية فيرجع تاريخها على أقل تقدير إلى أواخر القرن الثاني بعد الميلاد، حيث نجدها عند سيكتوس إمبريكوس، أحد الأنصار المتأخرين للمدرسة البيرونية الشكوكية التي نشأت في القرن الرابع قبل الميلاد، كما نجدها أيضا عند أحد أشهر أتباع أرسطو في القرن الثالث من الميلاد وهو الفيلسوف الشهير الإسكندر الأفروديسي، كما نجدها عند فلاسفة المسلمين كـ الإمام الغزالي، وبهذا يكون من الواضح أن مشكلة الاستقراء، وإن ارتبطت بالفيلسوف الإنكليزي ديفيد هيوم، قديمة جدا[10].
ديفيد هيوم، مع ذلك، لم يكن فقط أكثر من ساهم في تسليط الضوء على مشكلة الاستقراء، بل كان أيضا أوّل من قام بإخضاعها للتحليل العميق والمستفيض بوصفها مشكلة فلسفية. ينطلق هيوم في تحليله لمشكلة الاستقراء من تقسيم ثنائي عُرِف فيما بعد باسم “شوكة هيوم”: علاقات بين الأفكار، ومعطيات حول الواقع. من ضمن الأمثلة التي يوردها هيوم على العلاقات بين الأفكار تلك الحقائق المرتبطة بعلوم الهندسة والجبر والحساب، مثل حقيقة أن مربّع الوتر في المثلث قائم الزاوية يساوي حاصل جمع مربّع كلّ من الضلعين الآخريْن، فهي حقيقة تعقد علاقة ذهنية بين فكرتين مجرّدتين، ويمكن اكتشافها بواسطة الاستعانة بالذهن فحسب، أي أنها حقيقة قِبلية لا تحتاج لإثبات صحتها إلى الاستعانة بمعطيات الواقع أو الحس أو التجربة[11]. في المقابل، تشير الحقائق المتعلقة بمعطيات الواقع إلى العكس من ذلك تماما؛ فمثلا، القول بأنّ قطعة الحجر المقذوفة إلى أعلى تسقط على سطح الأرض يعبّر عن حقيقة مستمدة من التجربة، أي أنها حقيقة لاحقة تحتاج لإثبات صحتها إلى الاستعانة بمعطيات الواقع.
فيما يتّصل بالحقائق التي تشير إلى العلاقات بين الأفكار، بإمكاننا تقديم برهان عقلي على صحتها، كأنْ نأتي، مثلا، باستدلال استنباطي يجعل من هذه الحقائق نتائج يقينية، أي حقائق يُمكن التعبير عنها بواسطة قضايا تحليلية من حيث أنّ نفيها يؤدّي إلى الوقوع في التناقض. لكن ماذا عن تلك الحقائق التي تشير إلى معطيات الواقع؟ كيف بوسعنا تبرير الوثوق بصحتها؟ قبل محاولة التبرير هذه، يفحص هيوم الأساس الذي تقوم عليه الحقائق المرتبطة بالواقع لينتهي إلى الجزم بأنها جميعها تقوم على علاقة ثنائية بين العلّة والنتيجة؛ حين أسألك عن السبب وراء ارتداء معطف ثقيل، ثم تجيب، مثلا، أنّ المعطف يحميك من البرد، فإن مضمون إجابتك (العلة) ومضمون سؤالي (النتيجة) كلاهما يشير إلى حقيقة مرتبطة بالواقع، أي أنها حقيقة لاحقة تُعبّر عنها قضية تركيبية من حيث أنّ نفيها لا يؤدي إلى الوقوع في التناقض. هذا يعني أنّ تبرير صحة الحقائق المرتبطة بمعطيات الواقع هو في جوهره تبرير لصحة العلاقة العِلّيّة بين قضية تركيبية وأخرى.
كيف لنا – إذًا – تبرير صحة هذه العلاقة العلّيّة؟ لا يمكن لإجابة هيوم عن هذا السؤال أن تكون أشدّ وضوحا: ليس بوسعنا تبرير هذه العلاقة على الإطلاق! بمعنى آخر، لا يمكن تبرير الحقائق المرتبطة بمعطيات الواقع عن طريق العقل المحض أو عن طريق التجربة الحسية. لو سلكنا طريق العقل المحض، فهذا يعني أننا نتعامل مع حقائق قِبلية، في حين أن العلاقة العلّيّة مرتبطة كما رأينا بحقائق لاحقة، ولذلك لا يمكن اللجوء إلى الاستدلال الاستنباطي لتقديم برهان عقلي على صحة حقائق مرتبطة بالواقع، ذلك أن نفي مثل هذه الحقائق لا يتعارض مع قوانين المنطق؛ الأمر هنا مشابه لما سبق أن ذكرناه حول الفرق بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية، فنفي قضية تحليلية مثل “أخي الأصغر أصغر مني” يؤدي إلى تناقض، في حين أنّ نفي قضية تركيبية مثل “الأرض تدور حول محورها” لا يؤدي إلى تناقض بالضرورة.
إذا كان طريق العقل المحض مسدودًا أمامنا لتبرير صحة الحقائق المرتبطة بمعطيات الواقع، فماذا عن طريق التجربة الحسيّة؟ هنا يطلب منك هيوم أن تتخيّل أنّ أحدهم قدّم إليك شيئا ما لم تره من قبل على الإطلاق ولا تستطيع أن تجد له شبهًا بأي شيء آخر سبق أن شاهدته في حياتك. في هذه الحالة، يؤكد هيوم أنك لن تستطيع، مهما أمعنت النظر في هذا الشيء الجديد، أن تكتشف العلّة من وجوده أو الأثر الناتج عن وجوده. “آدم”، كما يقول هيوم، حين رأى الماء والنار لأوّل مرة، “لم يكن ليستطيع أن يستدلّ من سيولة الماء وشفافيته على أنّ من شأن الماء أن يُغرقه، ولم يكن ليستطيع أن يستدلّ من ضوء النار وحرارتها على أنّ من شأن النار أن تحرقه”[12]. العلّة والنتيجة، كما يؤكد هيوم، مختلفتان تماما، ولا يمكن في هذه الحالة الاستدلال على إحداهما من خلال التعرّف على الأخرى[13].
كيف اكتسب الإنسان أو الحيوان – إذًا – قدرات مثل الحذر من الغرق في وجود الماء أو الحذر من الاحتراق في وجود النار؟ الإجابة عن هذا السؤال بطبيعة الحال تشير إلى التجربة؛ فمع تراكم الخبرة حول العلّة والنتيجة المنبثقة عنها، تتولّد القدرة على ملاحظة الترابط فيما بينهما، وبالتالي، تتولّد القدرة على عقد علاقة استدلالية بين العلّة والنتيجة. حين أهُمُّ في إزاحة كتاب عن حافة مكتبي، فإنّي أتوقّع سقوطه على الأرض، وحين أكتشف رسومات كتابية على جدران كهف مهجور، فإنّي أستدلّ على حقيقة أنّه كان مأهولا. في الحالة الأولى، استطعت التنبؤ بالنتيجة الغائبة بفضل العلّة الحاضرة، وفي الحالة الثانية، استطعت الاستدلال على العلّة الغائبة بفضل النتيجة الحاضرة، وفي الحالتين هناك انتقال من المعلوم إلى غير المعلوم. هل بمقدوري تبرير صحة المعرفة الناتجة عن هذا الانتقال؟ إجابة هيوم تشير إلى النفي القاطع.
لنفترض أني حاولت تبرير صحة التنبؤ في الحالة الأولى على الوجه التالي: كل مشاهداتي السابقة تؤكد على أنّ الأجسام الثقيلة تسقط نحو الأرض حين لا يحول شيء بينها وسطح الأرض، وبالتالي، من الطبيعي التنبؤ بسقوط الكتاب حين أهُمُّ بإزاحته عن حافة مكتبي. إنّ الأمر أشبه بالتنبؤ بطلوع الشمس من المشرق غدا صباحا استنادا إلى عدد مشاهداتي السابقة للشمس وهي تظهر من المشرق.
هيوم، مع ذلك، له رأي مغاير، فحتى لو استطعنا ملاحظة طلوع الشمس من المشرق لعدد لامتناهٍ من المرّات، ليس بوسعنا التيقّن مُسبقًا من ظهورها من المشرق في اليوم التالي، فالتيقّن المسبق أو الحُكم القِبلي من أي قضية يقتضي منطقيا أن يؤدي نفيها إلى تناقض، ولا تناقض في إمكانية تصوّر العقل لاحتمال عدم طلوع الشمس من المشرق.
لكننا نلاحظ ترابطا مستمرا بين العلّة ونتيجتها في حياتنا اليومية، فلماذا لا يصلح هذا الترابط المستمر في تبرير صحة العلاقة بين العلّة والنتيجة؟ هذا ما يسمّى بمبدأ “انتظام الطبيعة”، أي تكرار الظواهر بطريقة تدفعنا إلى الاعتقاد بأنّ ما جرى في الماضي تحت ظروف محددة سيجري في المستقبل تحت الظروف نفسها، بحيث نتوقّع النتائج نفسها من الأسباب المرتبطة بها، كما نستدلّ على الأسباب نفسها من النتائج المرتبطة بها. يُقرّ هيوم باستنادنا إلى هذا المبدأ، فهناك نوع من “الهارمونيا” أو التوافق المُسبق بين مسار الطبيعة وتسلسل أفكارنا، وهذا التوافق المسبق نستقيه بحكم العادة منذ نعومة أظفارنا، وهو الذي يتيح لنا عقد علاقة استدلالية بين العلّة والنتيجة[14]. بل إن هيوم يذهب إلى أبعد من ذلك ليؤكد على أن أي معرفة جديدة، وبالتالي أي معرفة علمية استقرائية، غير ممكنة من دون التسليم بمبدأ “انتظام الطبيعة”[15]. غير أن هذا المبدأ نفسه، كما يؤكد هيوم، لا يمكن تبريره إلّا من خلال الاستقراء نفسه؛ فالاعتقاد بصحة مبدأ “انتظام الطبيعة” يفترض ضمنيّا أنّ المستقبل يشبه الماضي تحت الظروف نفسها، لكن ما الذي يبرّر صحة هذا الافتراض؟ ليس أمامنا سوى أن نجيب: في الماضي، لاحظنا كيف تشابهت أحداث كانت مستقبلية قبل وقوعها مع أحداث الماضي بعد وقوعها، ولهذا، من الطبيعي أننا في المستقبل سنشهد تشابها بين أحداث مستقبلية مع أحداث الماضي. هذا التبرير الأخير يقوم على انتقال مما هو معلوم إلى ما هو مجهول، وهو لهذا السبب تبرير استقرائي، وبهذا نكون قد برّرنا صحة الاستقراء بواسطة الاستقراء نفسه، وهذا تفكير دائري يشير إلى مغالطة منطقية هي مغالطة الدور، وأي تفكير دائري – كما هو معروف – يستطيع تفسير كل شيء، وهو لهذا السبب لا يصلح أن يكون تفسيرا لأي شيء.
5. مجد العلم وفضيحة الفلسفة
على ضوء ما تقدّم، نصل إلى نتيجة لا تبدو مُرضية من الناحية المعرفية: الاستقراء الذي نثق بنتيجته إلى حدّ اليقين يشير إلى مغالطة منطقية، والاستقراء الذي نثق بنتيجته إلى درجة من الاحتمال لا يمكن تبريره منطقيا. حين نتأمّل مكانة الاستقراء في الاستدلال العلمي، تبدو هذه النتيجة صادمة من حيث أنها تشير ضمنا إلى أنّ العلم، بوصفه أوثق طريقة متاحة لجني المعرفة، لا يقوم على أساس منطقي مُحكم، وهنا يبرز دور التحليل العميق الذي قام به هيوم في تناوله لمشكلة الاستقراء.
من جهة أخرى، حين نتأمّل الجانب التاريخي لمكانة الاستقراء في المنهج العلمي، فإنّ مضاعفات مشكلة الاستقراء ستبدو أكثر وضوحا، فمنذ أول فلسفة للعلم قبل أكثر من ألفيْ سنة كان للاستقراء دور في المنهج العلمي، لكن في الفترة الممتدّة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر احتلّ الاستقراء (أو كاد أن يحتلّ) الدور الأوحد في نظرية المنهج العلمي. بدأت هذه النزعة الاستقرائية بشكل غير ناضج في فلسفة فرانسيس بيكون في أوائل القرن السابع عشر، ثم بلغت ذروة نضوجها في فلسفة جون ستيوارت مِل في أواخر القرن التاسع عشر.
في كتابه “الأورغانون الجديد”، يقسّم بيكون المنهج العلمي إلى ثلاث مراحل، يحتّل الاستقراء فيها المرحلة الأخيرة، لكن رغم التفاصيل الكثيرة التي ذكرها بيكون حول المرحلتين الأولى والثانية، والمتعلقتين بجمع المعلومات وتصنيفها، لم يذهب في تناوله لمفهوم “الاستقراء” إلى أبعد من التأكيد على أهميته من جهة، ودعوته من جهة أخرى إلى الاعتماد على الاستقراء الاستبعادي بدلا من الاستقراء التعدادي[16]. كان بيكون ساخطا على فلسفة أرسطو بشكل عام وعلى القياس الأرسطي بشكل خاص، لكن تحجيمه لدور الاستدلال الاستنباطي في المنهج العلمي لم يسفر عن نجاحه في تقديم الاستقراء بوصفه البديل الأمثل للتعبير عن طبيعة الاستدلال العلمي.
في المقابل، قطع جون ستيوارت مِل في كتابه “نسق المنطق” شوطا طويلا في أدق تفاصيل الاستقراء وجعل منه السمة الجوهرية للمنهج العلمي، بل إنه ذهب إلى حدّ الزعم بأن جميع العلوم الاستنباطية هي في جوهرها علوم استقرائية، وأنّ كل مبادئها (ومن ضمنها المقدمات البدهيّة) ليست سوى تعميمات استنادا إلى الملاحظة الحسية[17]. في واقع الأمر، ذهب مِل إلى أبعد من ذلك في نقاشه الشهير مع معاصره ويليام ويويل حول مفهوم الاستقراء[18]. أبرز مثال احتلّ قسما كبيرا من ذلك النقاش كان ذلك المتعلق باستدلال كِبلر الذي يشير إلى دوران كوكب المريخ حول الشمس في مدار بيضاوي. بالنسبة إلى ويويل، كما هي الحال بالنسبة إلى الرأي السائد في فلسفة العلم، يعدّ هذا المثال مثالا واضحا على الاستدلال الاستقرائي، في حين يجادل مِل أنه ليس سوى وصف لظاهرة ولا يرقى إلى مرتبة الاستقراء. لا تعنينا هنا تفاصيل هذا النقاش الشيق بين مل وويويل بقدر ما تعنينا هذه النزعة الاستقرائية عند مِل. يرى مِل أن الاستقراء استدلال ينتقل مما هو معلوم إلى ما هو غير معلوم، وليس هذا التعريف من ابتداعه بطبيعة الحال، بل حتى الطرق الأربع (أو الخمس) الشهيرة التي ارتبطت باسمه ليست من ابتداعه، والحق أن مِل لم يدّعِ الأصالة في ذلك، وهذا ما يعترف به هو نفسه في مقدمة كتابه “نسق المنطق”، لكن إليه يرجع الفضل في وضع طرق الاستقراء المختلفة في نسق واحد يُعرف اليوم بطُرُق مِل[19].
مع أواخر الربع الأول من القرن العشرين، بدأت النزعة الاستقرائية في اتخاذ أشكال مختلفة بعد محاولات الاستفادة من نظرية الاحتمال الرياضية في معالجة الاستقراء العلمي. هذا الاستقراء في جوهره يشير إلى علاقة انتقالية من الحُكم بصحة ما هو جزئي وحسّي ومعلوم إلى الحُكم بصحة ما هو كُلّي وافتراضي ومجهول، وهذا الحُكم الأخير له درجة احتمال أكبر من 0 وأقل من 1، وحساب هذه الدرجة هو من اختصاص نظرية الاحتمال الرياضية.
أسفر هذا التزواج بين الاستقراء العلمي والاحتمال الرياضي إلى مقاربات مختلفة ساهمت جميعها وما زالت في تطوير المنطق الاستقرائي، لكن مشكلة الاستقراء الفلسفية بقيت حاضرة من دون حلّ، وحتى أولئك الذين استعاضوا عن الاستقراء بالاستنباط كأساس للمنهج العلمي لم يفلحوا في التخلّص من مشكلة الاستقراء بشكل أو بآخر[20]. لا عجب – إذًا – أن يشير الفيلسوف البريطاني شارلي بورد إلى الاستقراء بوصفه مجد العلم وفضيحة الفلسفة[21].
المراجع
محمود، زكي نجيب، (1951)، المنطق الوضعي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
Bradley, F. H. (1883). The Principles of Logic, London: Elibron Classics.
Broad, C. D. (1926). The Philosophy of Francis Bacon, Cambridge: Cambridge University Press.
Cohen, M. R. and E. Nagel (1934). An Introduction to Logic and Scientific Method, New York: Harcourt, Brace.
Einstein, A. (1954). Ideas and Opinions, Crown Publishers, New York, USA.
Forster, M. (2011). “The Debate between Whewell and Mill on the Nature of Scientific Induction,” in D Gabbay, J Woods & S Hartmann (eds), Handbook of the History and Philosophy of Logic, vol. 10, Inductive Logic, North-Holland Publishing Co (Elsevier Science & Technology), Amsterdam, pp. 93-116.
Hume, D. (1748 [2007]). An Enquiry Concerning Human Understanding, Oxford University Press.
Kant, I. (1787 [1998]). Critique of Pure Reason, translated & edited by P. Guyer and A. W. Wood, Cambridge University Press.
Losee, J. (1972). A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Oxford University Press.
Mill, J. S. (1886). System of Logic, London: Longmans, Green & Co.
Milton, J. R. (2011). “Induction before Hume,” in D Gabbay, J Woods & S Hartmann (eds), Handbook of the History and Philosophy of Logic, vol. 10, Inductive Logic, North-Holland Publishing Co (Elsevier Science & Technology), Amsterdam, pp. 1-42.
Poincaré, H. (1905 ]1958[). The Value of Science, New York: Dover.
Quine, W.V. (1951). “The Two Dogmas of Empiricism,” The Philosophical Review 60: 20-43.
Salmon, W. C. (1966). The Foundations of Scientific Inference, Pittsburgh University Press.
White, M. (1950). “The Analytic and the Synthetic: An Untenable Dualism,” John Dewey: Philosopher of Science and Freedom, ed. S. Hook. New York: Dial.
[1] لم يكن هذا التقسيم بهذا الوضوح عند بروز فلسفة العلم بوصفها ميدانا مستقلّا في النصف الأول من القرن العشرين، ومن يطّلع على الأدبيّات المبكرّة في هذا الميدان يلاحظ اقتصار فلاسفة العلم على الفيزياء في كتاباتهم إلى درجة لا يمكن عندها التمييز بين “فلسفة العلم” و”فلسفة الفيزياء”.
[2] تجدر الإشارة هنا إلى أن زكي نجيب محمود هو من أوائل (إن لم يكن أول) من قدّموا الفرق بين القضية التحليلية والقضية التركيبية إلى القارئ العربي، ومع ذلك لا يملك المرء سوى أن يندهش من طريقة عرض محمود لهذا الفرق، حيث شابها خلط كبير بين منطق برادلي المثالي والمنطق الحديث في الفلسفة التحليلية. تصوّر برادلي للقضايا وتقسيماتها مختلف تماما عن التصوّر السائد في الفلسفة التحليلية؛ عند برادلي التقسيم نسبي ومتدرّج بل ومتداخل، في حين أنه تقسيم نوعي ومطلق حسب التصور السائد في الفلسفة التحليلية. الجدير بالذكر أن برادلي نفسه يُحذّر القارئ من الخلط بين تصوّره الخاص والتصوّر الكانطي لتقسيم القضايا (انظر ما كتبه في الهامش في Bradley 1883: 49)، وهو محقّ في هذا التحذير، ذلك أنّ برادلي يرى في جملة مثل “عندي ألم في الأسنان” مثالا على قضية تحليلية، وهي قطعا ليست كذلك حسب معيار التقسيم السائد بين القضايا في الفلسفة التحليلية. رغم هذا التحذير، يخلط محمود بين فلسفة برادلي المثالية والفلسفة التحليلية في عرضه للتقسيم بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية، وهو الخلط الذي أدّى إلى وقوعه في التناقض. فعلى سبيل المثال، في الصفحة 13 من كتابه المعنون “المنطق الوضعي”، يتبنّى محمود نظرة برادلي المثالية ليؤكد “على أنّ تقسيم القضية إلى تركيبية وتحليلية أمر نسبي، وليس هو بالتقسيم المطلق، إذ قد تكون القضية الواحدة تحليلية بالنسبة لشخص وتركيبية بالنسبة لشخص آخر”، لكنه سرعان ما ينتقل بعد صفحات قليلة إلى تبنّي نظرة آير الوضعية ليؤكد على أن القضية التركيبية محتملة ولاحقة (أو بَعدية) من حيث اعتماد صدقها على العالم الخارجي، في حين أن القضية التحليلية يقينية وقِبلية من حيث أنّ صدقها “لا يتوقّف على طبيعة عقولنا”، (صفحة 21). يذهب محمود أيضا إلى تبنّي الرأي السائد في الفلسفة التحليلية حول القضايا التحليلية بوصفها “تحصيل حاصل”، وهي كذلك فعلا، لكن هذا لا يتسق مع تبنّي محمود لمنطق برادلي حين يؤكد على أن القضية الواحدة قد تكون “تحليلية بالنسبة لشخص وتركيبية بالنسبة لشخص آخر”! تجدر الإشارة هنا أيضا إلى أنّ التقسيم الكانطي السائد بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية يحظى بقبول كبير في الفلسفة التحليلية بالرغم من الحجج القوية التي ساقها بعض المفكرين ضد هذا التقسيم من أمثال كواين (Quine, 1951) أو وايت (White, 1950).
[3] تقسيم الجملة إلى موضوع ومحمول تقسيم له تاريخ طويل ومتعلّق بميادين مختلفة، مثل النحو والمنطق والفلسفة، والموضوع هو الشيء الذي تتحدث عنه الجملة، وأما المحمول فهو السمة التي تُنسب إلى الموضوع في حالة التأكيد وتُستبعد منه في حالة النفي. تجدر الإشارة إلى أنّ الموضوع والمحمول، في لغتنا العربية، مصطلحان يقابلهما ما يسميه النحويون “المبتدأ” و”الخبر”، كما يقابلهما ما يسميه البلاغيون “المسند إليه” و”المسند”.
[4] إذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أنّ القضايا التحليلية هي قوام العلوم المجردة مثل الرياضيات والمنطق، والقضايا التركيبية هي قوام العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والأحياء، نكون قد خطونا خطوة إلى الأمام على طريق إدراك ذلك السؤال-اللغز الذي انشغل به فلاسفة وعلماء من أمثال كانط وآينشتاين حول التماثل بين الرياضيات والطبيعة (انظر القسم 3).
[5] (Cohen and Nagel, 1934: 173).
[6] انظر (: 145-146 [1998] Kant 1787 ).
[7] في ميدان الرياضيات، ساهم اكتشاف الهندسة اللإقليدية في بروز مواقف متباينة في فلسفة الرياضيات حول طبيعة المعرفة الرياضية، إذْ لا يمكن فهم منطق فريجه أو حدسيّة برووير أو مشروع هيلبرت وراسل وآخرين بعيدا عن فلسفة كانط والهندسة اللاإقليدية.
[8] (233 Einstein, 1954:).
[9] المصدر السابق، في الصفحة نفسها. قارن كذلك إجابة ألبرت آينشتاين مع ما سبق أن قاله هنري بوانكاريه حول هذا الموضوع (20:[1958] Poincaré, 1905).
[10] انظر (Milton 2011: 9-10).
[11] انظر (18:[2007] Hume 1748 ).
[12] انظر المصدر السابق، الصفحتان 19 و 20.
[13] انظر (21 :[2007] Hume 1748 ).
[14] انظر المصدر السابق، الصفحات 39 و 40.
[15] انظر (27 :[2007] Hume 1748 ).
[16] انظر (Milton 2011: 25-26).
[17] (Mill 1886: 169). هذا لا يعني أنّ مِل يُنكر أي دور للاستدلال الاستنباطي في المنهج العلمي، انظر حول هذه النقطة (Losee, 1972: 152-155).
[18] لمعرفة تفاصيل هذا النقاش الشيّق، انظر (Forster 2011).
[19] “حول الطرق الأربع للبحث التجريبي”، هذا هو عنوان الفصل الثامن من المقالة الثالثة في كتاب “نسق المنطق”، حيث يعرض مِل (1) طريقة الاتفاق، و(2) طريقة الاختلاف، و(3) طريقة المتغيرات المتلازمة، و(4) طريقة المتبقّيات، غير أنّ مِل يجمع أيضا بين الطريقتين الأولى والثانية ليصل إلى طريقة خامسة تسمّى الطريقة المشتركة بين الاتفاق والاختلاف. تشترك هذه الطرق جميعها بعقد علاقة بين العلّة والمعلول بوصفها علاقة بين سابق ولاحق، ويؤكد مِل على إمكانية استخدام أيّ من هذه الطرق إما للاستدلال على العلّة وإمّا للاستدلال على المعلول. انظر (Mill 1886: 253).
[20] أشهر مثال هنا هو كارل بوبر، ولمعرفة الجانب الاستقرائي “الخفيّ” في فلسفة العلم عند بوبر، انظر نقد ويسلي سالمون للاستدلال العلمي البوبري (Salmon 1966 : 21-27).
[21] انظر (Broad 1926: 67).