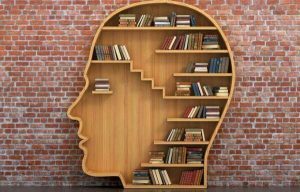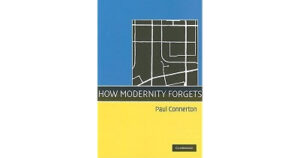| الكاتب | إيمانويل كانط |
| ترجمة وتقديم وتعليق | حميد لشهب |
مقدمة المترجم
لكل ترجمة سبب ومسببات، وظرف مادي ومعنوي، يوحي (أي يفرض) القيام بها. فيما يخص هذا النص الدسم لكانط، فإن سبب اختيار ترجمته على الرغم من لغته المعقدة، المليئة بالحشو والإضافات -وفي بعض الأحيان الاستعارات- هو الرغبة في إضافته لنصنا المترجم “ما هي الأنوار”[2]، لأن هناك بعض الخطوط العريضة التي تجمعهما. وأما المسبب المباشر، الذي عجل بترجمة هذا النص، فهو اطلاعنا على ترجمة د زهير الخويلدي، التي نشرها في منبر ما، وهي ترجمة عن الفرنسية[3]. لا نريد انتقاد ترجمة د. الخويلدي ولا تقويمها، بل من واجبنا التنبيه إلى أنها ليست دقيقة، لربما لأن الترجمة الفرنسية في حد ذاتها لم تكن دقيقة. اعتمدنا في هذه الترجمة على النص الأصلي لكانط (انظر المرجع الأول المُشار إليه هنا)، وهو نص غير سهل لغويا، حتى وإن كان على مستوى الفكر والتفكير لم يأت بجديد لا نعرفه في فلسفة كانط (أو على الأقل القدر المتواضع الذي نعرفه عنها). فالنص مكتوب بلغة ألمانية قديمة، معقدة للغاية، لا تبوح بكنهها إلا بعد قراءات متعددة لنفس الجملة أو لنفس الفقرة. وككل الترجمات المتأنية الهادفة، خصصنا وقتا كافيا (ما يقارب الأسبوعين، بمعدل ساعتين في اليوم قبيل الفجر أو بعده بقليل عندما يكون المخ قد نال قسطا من الراحة ومستعدا لسبر أغوار أفكار كانط). بعد ترجمة المضمون للعربية والتحقق من بقائه وفيا للمضمون بالألمانية، بمقارنتهما عدة مرات، اشتغلنا على أن يكون النص المترجم بلغة عربية سليمة، سلسة وخالية من التعقيد قدر المستطاع. فإذا كانت الترجمة أمانة، فإنها كذلك فيما يخص متلقي اللغة المترجم إليها، على اعتبار أن هذا المتلقي يضع ثقته كاملة في المترجم وهو يقرأ ترجمته. والأمانة في الترجمة لا تعني الترجمة الحرفية، بل تمرير مضمون ما يُترجم إلى اللغة الأخرى بوعي الخصوصيات المختلفة للغتين من حيث التعابير والأسلوب والمعاني والمجازات والأمثلة وجوهر النص عامة. اعتبارا لكل هذا، نعتقد بأننا قمنا بترجمة جادة، هادفة، مبتغاها الأول والأخير هي توفير نص متخصص للمهتمين بالفلسفة في العالم العربي، لفهم أفضل لفلسفة كانط والتفاعل معها وعدم التسليم بها جملة وتفصيلا، بل إشغال كفاءاتنا الفكرية والثقافية لكي يبقى مرجعا وليس مكبلا لإبداعنا الفكري والفلسفي.
- النظرية الاجتماعية اليوم: حوار مع هارتموت روزا

- في ظلال الغد

- مذبحة العرفاء: مآلات التصوف والعرفان في المجال الشيعي

إن العلامة التي تتكرر في نص كانط “ما هي الأنوار؟” ونصه “ماذا يعني التوجه في التفكير؟” هي علامة الإستفهام. ولهذه الإشارة دلالات فلسفية في غاية الأهمية، ومنها بالخصوص أنها محاولة كانط الإجابة عن استفهام شغله. وهذا الإستفهام هو موضوع معين يُعتبر حبل البَحَّارة الغليظ بين النصين: قيمة وأهمية حرية التفكير في عصر كانط، الذي كان عصر مخاض الفلسفة والفكر الغربيين ومحاولة بناء “تنوير” فكري مستقل عن الفكر اللاهوتي الدوغمائي.
إن “ماذا يعني التوجه في التفكير؟” هو موقف كانطي واضح المعالم من السجالات التي دارت رحاها بين جاكوبي ومندلسون حول مذهب وحدة الوجود، ومحاولة الأول إلحاق الفيلسوف ليسنغ LESSING إلى حضيرة السبينوزيين. ومحاولة الإلحاق هذه كانت بمثابة تهديد للتنوير برمته، وهذا ما حذا بمندلسون، الذي كان في العمق أحد التنويريين المرموقين، إلى مقارعة جاكوبي[4].
من المعروف أن كانط، على الرغم من أنه كان من دعاة التنوير والمقتنعين به، لم ينخرط في السجالات التي كانت رحاها دائرة بين التنويريين و”المحافظين”، إلا بعد وفاة مندلسون عام 1786. ما يميز هذا النص هو الإجابة المباشرة لكانط وندائه إلى التوجه في الاستعمال التأملي الخالص للعقل، إما عن طريق الحس المشترك أو عن طريق العقل السليم أو الفهم الإنساني المجرد، وكل هذه التسميات هي وجوها لعملة واحدة. يذكر كانط في هذا النص بين السطور، ودون الإشارة المباشرة لذلك، إلى صلب الخلاف بين جاكوبي ومندلسون. ونقطة الضعف التي استغلها الأول ضد الثاني هي ترك هذا الأخير قضية ممارسة القدرة على استعمال العقل في القضايا اللاهوتية ملتبسة وغير واضحة، بما أن العقل السليم نفسه مهدد بدوره، إذا استخدم كمبدأ للحماس والتحميس لاستعمال العقل.
ما يُلاحظ أيضا هو أن كانط حاول التموضع بين الإثنين، اعترف لجاكوبي بحجته الشخصية للدفاع عن نفسه، وهي حجة لا تصلح إلا ضد الخصم. وهنا يُعرِّف كانط العقل بطريقته الخاصة، معتبرا إياه بأنه ليس إحساسا أو حدسا متعاليا. كما بين بأن ما اشتغل عليه ماندلسون هو محاولة توضيح كون العقل المجرد يحصر أو يحدد المعنى (معنى الأشياء)، وهو بهذا مُلزم تحت شروط معينة، ومنها بالخصوص شرط تحمل هذا العقل، إذا اعتبر تأمليا خالصا، وظيفة أو دور تطهير مفهوم العقل من تناقضاته الداخلية والحد من السفسطة عن مبادئ العقل السليم.
ليس في نيتنا تحليل النص الذي بين أيدينا، لكي لا نثقل كاهل القارئ الكريم، ما نود الإشارة له هو أن تطرق كانط لإشكالية الحرية، كانت بمثابة وضع هذه الحرية تحت مظلة العقل، منبها بين السطور إلى أن هذا العقل، في جانبه النظري والعملي، لا يضمن هذه الحرية، إذا استمر المرء في استعماله السيء. فالحرية كقيمة اجتماعية -ولربما أخلاقية تنويرية- في كل تجلياتها وخصوصياتها وممارساتها مطلوبة ومرغوب فيها، شريطة أن تُقاد من طرف العقل، أي موجهة من طرفه، لكي لا تحدث تجاوزات في ممارستها. وحتى وإن كان هذا العقل مرشدا وموجها، فإنه لا يضمن الحرية، لأنه قابل بدوره إلى الإستعمال السيء والإستغلال للتحكم في رقاب العباد، وبالخصوص عند استعمال العقل العملي النفعي كمبدأ للحكم، كما حدث في التاريخ السياسي الغربي طولا وعرضا، وكما يحدث حاليا: باسم الحرية سلب الغرب أمما كاملة حريتها، وباسم العقل (المقصود هنا العقل العملي) ورفعه إلى مستوى أيقونة يحدد مصير شعوب بأكملها حاليا، فيما يخدم مصالحة.
هنا بالضبط يكمن سبب آخر لترجمتنا لهذا النص: لأسباب لا حصر لها، وبالخصوص بسبب استلابنا وانخراطنا اللاواعي في الفكر الغربي دون فحص دقيق وعميق لأبعاده الأيديولوجية اتجاهنا، ودون نجاحنا في بناء “نهضة” تستفيد من بعض ما حققه هذا الغرب دون الإنخراط الكلي والأعمى في محاولة تكرار تجربته الخاصة، من واجبنا فحص الأسس التي ينبني عليها هذا الغرب فكريا وسياسيا، بالرجوع إلى ما يُعتبر انطلاق نهضته و”تقدمه” ونجاحه في إخضاع العالم لسيطرته. تعامل جيل المثقفين العرب ما بعد الحرب العالمية الثانية مع مفاهيم كالعقل والحرية والتنوير إلخ وكأنها مفاتيح حقيقية للأبواب التي من خلالها نعبر إلى الضفة الأخرى للفكر الإنساني، عوض بدأ بناء شواطئ فكرية عربية إسلامية خاصة. وقد أدى مثل هذا السلوك الفكري إلى تحويل مثل هذه المفاهيم إلى “أوثان فكرية”، شعلت الحرب في الساحة العربية والإسلامية لمدة لا يستهان بها بين فصائل مختلفة ممن “اعتنقوا” الفكر الغربي، وكأنهم يعتنقون ديانة جديدة (الماركسيين، البنيويين، التحليليين، الوجوديين إلخ)؛ وبين هؤلاء والقوى المحافظة التي في غالب الأحيان لم تكن تفقه من الفكر الغربي إلا القشور وتحكم عليه بالإعتماد على الأحكام المسبقة الموروثة عبر التاريخ. كما يبين نص كانط هذا “ماذا يعني التوجه في التفكير؟” فإن الحرية ليست صنما واستعمال العقل لتحقيقها ليس ضمانة للحفاظ عليها إن حصل أن تحققت. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، هذا أمر يشهد عليه عصرنا هذا، وبالخصوص في زمن جائحة كورونا حيث انكشف الوجه الحقيقي للغرب، الذي لم يتهاون في قص أجنحة الحرية والعقل على حد سواء في التعامل اليومي مع شعوبه ومع النازحين الأجانب له. فباسم العقل والحرية يدوس الغرب حاليا بقدميه على “طوطيم” آخر بنى له قصورا وهمية ودافع عنه خطابيا، بل باسمه وبسببه قاد حروبا هوجاء في جميع أنحاء المعمورة: “حقوق الإنسان وحرية التنقل”. عرت الجائحة على وجه صلب، خال من كل إنسانية لغرب لا يرى إلا ظله. فما معنى، أو كيف يمكن تفسير تعامل هذا الغرب، وبالخصوص “الدول الأوروبية المتحدة” مع جحافل النازحين من إفريقيا وآسيا والدول العربية، المركونون في غابات شاسعة بين روسيا البيضاء وليتاون أو على حافة “كالي Calais” الفرنسي المطلعة على أنجلترا، في عز فصل شتاء بارد وتهديد جائحة لبشر يعيشون دون أي حد أدنى للكرامة الإنسانية في بلدان “حقوق الإنسان”.
ما لا يجب فهمه من كلامنا هذا هو أننا لا نُشيطن الغرب، ونستعمله شماعة لتعليق كل مشاكلنا وإخفاقاتنا، بل حاولنا تقديم بعض الأمثلة البسيطة على حقيقة ما يروجه ويدعو له، بل يحاول فرضه ولو بالبندقية والمدفع والصواريخ الفتاكة: العقل، الحرية، حقوق الإنسان، المساوات واللائحة طويلة. لابد أن ننتبه بأن الإستعمال اللغوي البروباغاندي لمثل هذه المفاهيم لا يتماشى البثة مع تطبيقها الفعلي على أرض الواقع. وهذا ما نلمسه أيضا في نص كانط.
النص المترجم (ماذا يعني التوجه في التفكير؟)
افترضوا بأن العقل، بعد الفحص الدقيق الأكثر قابلية للتصديق، قد يكون هعذا التصديق حقائق وقد يكون أسباب العقل، لكن لا تنفوا عنه ما يجعل منه أعظم خير على وجه الأرض، يعني ميزة كونه آخر محك للحقيقة. وإلا ستصبحون غير أهل بهذه الحرية، وتخسرونها بالتأكيد وتسحبون هذه المصيبة على عنق باقي الأبرياء، الذين كانوا، لولا ذلك، على استعداد تام لاحترام حريتهم وفقًا للقانون؛ ومن تم أيضًا استخدامها بأفضل طريقة في العالم!
حتى لو وضعنا مفاهيمنا على أعلى مستوى ممكن، وانتشلناها بذلك من الأحاسيس كثيرا، فإن تصورات حسية تبقى معلقة عليها، يكون تحديدها الحقيقي هو جعلها مناسبة قصد معرفتها، هي التي لم يتم اشتقاقها من التجربة. كيف يمكننا أيضًا إعطاء مفاهيمنا معنى ودلالة إذا لم تكن مبنية على نوع من التصور (والذي يجب أن يكون دائمًا في النهاية مثالًا من تجربة ممكنة ما)؟ إذا حذفنا بعد ذلك من هذا الفعل الفكري الملموس أولاً مزج الصورة من الإدراك العرضي من خلال الحواس، وحذف حتى الإدراك الحسي الخالص على الإطلاق أيضا، فإن ما يبقى هو ذاك المفهوم الخالص للعقل، والذي تم توسيع نطاقه، ويحتوي على قاعدة تفكير بشكل عام. وبهذه الطريقة ظهر المنطق العام نفسه، وتكمن بعض أساليب التفكير “الاستكشافية” في استعمال خبرة عقولنا، ولربما لا تزال هذه الأساليب مخفيًا عن العقل، وإذا عرفنا كيفية استخلاص هذه الأساليب بعناية من تلك التجربة، فقد تُثري الفلسفة ببعض القواعد المفيدة حتى في التفكير المجرد.
المبدأ الذي اعترف به المبارك مندلسون صراحةً، على حد علمي، في كتاباته الأخير “Morgenstunden”[5] هو من هذا النوع؛ وبالتحديد مبدأ الضرورة في الاستخدام التأملي للعقل (الذي كان يثق فيه بالنظر إلى معرفة الأشياء التي تتجاوز الحواس، لتصل حتى إلى وضوح الشرح) من خلال وسائل أداء معينة. دعى إلى اتباع هذا العقل وسماه مرة الحس المشترك، في كتابه “Morgenstunden ساعات الصباح”، ومرة العقل السليم في كتابه “لأصدقاء ليسينج”. من كان يعتقد بأن هذا الاعتراف لا يجب أن يصبح ضارًا جدًا فقط برأيه المؤيد لقوة الاستخدام التأملي للعقل في مسائل اللاهوت (وهو أمر لا مفر منه بالفعل)؛ ولكن هذا العقل المشترك الصحيح ذا المعنى المزدوج (الغامض)، من شأنه أن يترك ممارسة هذه القدرة في مواجهة المضاربة لخطر خدمة مبدأ الحماس للعقل والعزل التام له؟ ومع ذلك، حدث هذا في خصومة ماندلسون وجاكوبي في المقام الأول من خلال الاستنتاجات غير المهمة للمؤلف الماهر للنتائج. وعلى الرغم من أنني لا أريد تحميل مسؤولية بدء مثل هذه الطريقة الخبيثة في التفكير لأي منهما، بل بالأحرى إظهار بإن عمل الأخير (جاكوبي) يتمثل في “argumentum ad hominem”؛ [البرهان الشخصي]، والذي ربما يحق للمرء استخدامه للمقاومة فقط، واستخدامه ضد الخصم لإظهار نقطة ضعفه. سأبين من جهة، بأنه يمكن حقًا تطعيم العقل “فقط”، وليس إحساسًا سريًا مزعومًا للحقيقة، ولا حدسًا غزيرًا باسم الإيمان، يمكن على أساسه تطعيم التقليد أو الوحي دون موافقة العقل، بل، كما أكد مندلسون بثبات وجدية، فإن العقل البشري الخالص الصحيح، الذي أثنى عليه ورأى بأنه من الضروري اتباعه، على الرغم بالطبع من أن الميول الكبيرة للعقل التخميني تضيع في المقام الأول سمعتها الوحيدة (عن طريق الشرح)، وبما أنه تخميني، فليس عليه أكثر من العمل على تنظيف المفهوم العام للعقل من التناقضات والدفاع عنه ضد تناقضه؛ كما يجب ترك الهجمات السفسطائية على مبادئ العقل السليم. إن مفهوم “توجيه النفس” الموسع والمحدد بدقة أكبر، يمكن أن يساعدنا في تقديم مبدأ العقل السليم بوضوح في معالجته لمعرفة الأشياء الفائقة للحواس.
- مقاربة في شعرية التصوف

- كيف تقرأ كافكا (الجزء الثاني)

- قَصّ أثر الدابة بين الفراسة وفنّ التّحرّي: دراسة مقارنة في خبر أبناء نزار بن مَعَدّ بن عدنان مع أشباهه في الآداب الأخرى

يعني” التوجه” في المعنى الحقيقي للكلمة: العثور على “الطلوع/الشروق” من منطقة معينة من العالم (نقسم الأفق فيها إلى أربعة). إذا نظرت إلى السماء وعرفت أنه الظهر الآن، فإنني أعرف كيف أجد الجنوب والغرب والشمال والشرق. لهذا الغرض أكون بالتأكيد بحاجة إلى الشعور بالتميِيز في “موضوعي” الذاتي، أي اليد اليمنى واليسرى. أسمي هذا “شعورًا”، لأن هذين الجانبين لا يُظهران في التصور اختلافًا ملحوظًا. ودون القدرة على وصف دائرة ما، ودون الحاجة إلى تمييز ما للأشياء فيه، لكن الحركة من اليسار إلى اليمين لتمييز الحركة في الإتجاه المعاكس؛ ومن هنا تحديد الإختلاف في موضع الأشياء “بداهة”، سوف لن أعرف ما إذا كان يجب أن أضع الغرب على النقطة الجنوبية من الأفق على اليمين أو على اليسار، وبالتالي أكمل الدائرة عبر الشمال والشرق إلى الجنوب مرة أخرى. أتوجه إذن “جغرافيا”، على الرغم من جميع البيانات الموضوعية في السماء من خلال سبب “شخصي” فقط للتمييز، وإذا كنت في يوم من الأيام بمعجزة أبقيت كل الأبراج بنفس الشكل والموضع نفسه بالضبط ضد بعضها البعض، فقط أن اتجاه هذه الأبراج، والذي كان لولا ذلك شرقًا، كان سيصبح الآن غربًا، فإنه في الليلة الموالية المضاءة بالنجوم، لن تلاحظ عين بشرية أدنى تغيير، وحتى عالم الفلك، إذا كان ينتبه فقط إلى ما يراه وليس إلى ما يشعر به في نفس الوقت، سيصبح حتمًا “مرتبكًا”. وبهذه الطريقة، فإن القدرة الطبيعية على التمييز من خلال إحساس اليد اليمنى واليسرى، المتأصلة في الطبيعة، والتي اعتاد عليها من خلال التمرين المتكرر، تأتي لمساعدته؛ وإذا نظر إلى النجم القطبي فقط، فلن يلاحظ فقط التغيير السابق، ولكن أيضًا ودون مراعاة لهذا النجم “سيتوجه” من خلاله.
يمكنني الآن توسيع هذا المفهوم الجغرافي لإجراء توجيه النفس لفهمه: توجيه النفس في فضاء معين بشكل عام، وبالتالي “رياضيًا” فقط. أقوم بتوجيه نفسي في الظلام في غرفة أعرفها، إذا كان بإمكاني لمس شيء واحد فقط، يكون مكانه في ذاكرتي. لكن يبدو أنه لا يوجد شيء يساعدني هنا سوى القدرة على تحديد المواضع وفقًا لسبب “ذاتي” للتمييز: لأنني لا أرى الأشياء التي من المفترض أن أجد موضعهاا؛ وإذا وضع شخص ما مزاحا كل الأشياء بالترتيب نفسه، واحدة أسفل الأخرى، ولكن على اليسار ما كان موجودًا سابقًا على اليمين، فلن أتمكن من أن أجد نفسي في غرفة حيث ستكون جميع الجدران متشابهة تماما. وبهذا سرعان ما أوجه نفسي فقط من خلال الشعور بالفرق بين جانبي الأيمن والأيسر. هذا ما يحدث بالضبط عندما يُفترض أن أسير في الليل في شوارع مألوفة لي، والتي لا يمكنني الآن تمييز منزل فيها، والاستدارة بشكل صحيح.
في النهاية، يمكنني توسيع هذا المفهوم بشكل أكبر، لأنه سيتألف بعد ذلك من القدرة على التواجد ليس فقط في الفضاء، أي رياضيا، بل بشكل عام في التفكير، يعني التوجه منطقيا. يمكن للمرء أن يفترض بسهولة من القياس أن هذا سيكون عملاً للعقل الخالص، إذا أراد توجيه استخدامه، فيتوسع انطلاقًا من الأشياء المعروفة (من الخبرة) إلى ما وراء كل حدود التجربة ولا يجد على الإطلاق أي هدف للإدراك، بل مجرد فضاء له؛ نظرًا لأنه لم يعد قادرًا على إصدار أحكامه طبقا لأسس موضوعية للمعرفة، بل فقط وفقًا لسبب شخصي للتمييز في تحديد حكمه الخاص[6]. هذه الوسيلة الذاتية، التي لا تزال قائمة، ليست سوى الشعور بالحاجة إلى العقل. ويمكن للمرء بالخصوص أن يطمئن من الخطأ إذا لم يجرؤ على الحكم، حيث لا يعرف كثيرا، باستثناء ضرورة حكم ما حاسم. لذا فإن عدم المعرفة في حد ذاته هو سبب الحدود، وليس سبب الأخطاء في معرفتنا. ولكن عندما لا يكون الأمر تعسفيًا ولا يكون المرء يريد الحكم على شيء ما بشكل قاطع أم لا، حيث توجد حاجة حقيقية؛ وبالتأكيد تكون حاجة من هذه الحاجات مرتبطة بالعقل نفسه، مما يجعل الحكم ضروريًا. ومع ذلك فإن نقص المعرفة، على ضوء القِطَع الضرورية للحكم، يعيقنا. هناك حاجة لقاعدة نصدر على أساسها أحكامنا؛ لأن العقل يريد الإرتياح. إذا تم الاتفاق مسبقًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك تمثلا للموضوع، ولا حتى شيء مشابه له، حيث نقوم بتقديم مفاهيمنا الموسعة للأشياء المطابقة لها، وبالتالي يمكن تأمين إمكانيتها الفعلية/الواقعية/ الحقيقية، فلن يتبقى لنا أي شيء سوى فحص المفهوم أولاً، الذي نريد أن نجازف به بعيدًا عن كل التجارب الممكنة، لنرى ما إذا كان أيضًا خاليًا من التناقضات؛ ثم على الأقل إحضار الشيء إلى أشياء الخبرة في ظل مفاهيم فكرية بحتة، حيث لا نجعله حسيا على الإطلاق، لكن نفكر مع ذلك في شيء محسوس صالح على الأقل لاستعمال تجربة عقلنا؛ لأنه بدون هذا الحَذَرِ لن نكون قادرين على الاستفادة من مثل هذا المفهوم على الإطلاق؛ سنهتف بدلاً من التفكير، بل سنهذي بدلا من أن نفكر.
من خلال هذا وحده، أي من خلال المفهوم المجرد، لا يوجد شيء يتماشى مع وجود هذا الموضوع وارتباطه الحقيقي بالعالم (خلاصة كل الأشياء ذات الخبرة الممكنة). ولكن الآن يأتي “حق الحاجة” للعقل لافتراض وقبول شيء ما كسبب ذاتي، ما لا يمكن افتراض معرفته لأسباب موضوعية؛ وبالتالي لتوجيه الذات في التفكير طبقا لحاجياتها فقط، في الفضاء اللامحدود الفوق المحسوس، والذي يمتلئ بالنسبة لنا بالظلام.
يمكن التفكير في الكثير من الأشياء فوق الحسية (لأن أشياء الحواس لا تملأ الحقل الكامل لكل الإمكانيات)، بحيث لا يشعر العقل بالحاجة إلى توسيع نفسه إلى نفس النقطة، ناهيك عن قبول وجوده. يجد العقل انشغالا كافيًا بالأسباب في العالم، التي تكشف عن نفسها للحواس (أو على الأقل تكون من نفس النوع مثل تلك التي تكشف عن نفسها له)، بحيث لا يحتاج إلى تأثير الكائنات الروحية النقية لهذا الغرض، بل إن قبولها قد يضر باستخدامه، بما أننا لا نعرف شيئًا عن القوانين التي يمكن لمثل هذه الكائنات أن تعمل وفقًا لها، لكننا نعرف الكثير عنها، أي أشياء الحواس، ويمكننا على الأقل أن نأمل في معرفتها. على العكس من هذا، فإن مثل هذا الافتراض من شأنه أن يعطل استخدام العقل. إذن إنها ليست حاجة على الإطلاق، إنها مجرد حب استطلاع، لا يرقى إلا إلى الحلم أو البحث فيها أو اللعب بأوهام كاذبة من هذا النوع. إنه مختلف تمامًا عن مفهوم “وجود أصلي” أول باعتباره أعلى ذكاء وفي نفس الوقت مع أعلى خير. ليس فقط لأن عقلنا يشعر بالفعل بالحاجة إلى تأسيس “المفهوم”، غير المقيد، مفهوم كل شيء مقيد، وبالتالي كل الأشياء الأخرى[7]، لذا فإن هذه الحاجة تنطبق أيضًا على الإفتراض المسبق لـ “الوجود هنا”؛ وبدونه تختلف هذه الحاجة عن احتمالية وجود الأشياء في العالم، على الأقل تختلف عن النفعية والنظام، اللذان يصادفهما المرء في كل مكان بهذه الدرجة الرائعة (على نطاق ضيق وعلى نطاق واسع، لأنه قريب منا)، ولا يمكن لهذه الحاجة أن تعطي سببا مُرضيا على الإطلاق. ودون افتراض سبب معقول، ودون الوقوع في تناقضات متعددة، على الأقل لا يمكن إعطاء سبب “مفهوم”؛ وعلى الرغم من أنه لا يمكننا “البرهنة” على استحالة مثل هذه النفعية دون “سبب معقول” أول؛ (لأنه عندئذٍ ستكون لنا أسباب موضوعية كافية لهذا التأكيد ولن نحتاج إلى الرجوع إلى الذات). وعلى الرغم من هذا النقص في البصيرة، يبقى هناك سبب شخصي كافٍ لـ “افتراض” “حاجة” العقل لها: افتراض شيئ ما يمكن لهذا العقل فهمه لشرح هذا التمظهر المُعطى، لأن كل شيء يمكن أن يربط هذا العقل بمفهوم واحد فقط لا يعالج هذه الحاجة.
يمكن للمرء أن يرى بأن الحاجة إلى العقل ذات شقين: في استعماله النظري “أولاً”، وفي استعماله “العملي” ثانيا. لقد ذكرت الحاجة الأولى؛ لكن يمكن للمرء أن يرى بأنها مشروطة فقط، يعني يجب أن نفترض وجود الله إذا أردنا الحكم على الأسباب الأولى لكل شيء عرضي، وفي المقام الأول بترتيب االمقاصد الموضوعة بالفعل في العالم. والأهم من ذلك بكثير هو الحاجة إلى العقل في استخدامه العملي، لأنه ضروري، ومن ثم فنحن لسنا مجبرين فقط على الافتراض المسبق لوجود الله إذا أردنا الحكم؛ بل يجب أن نحكم. يكمن الاستخدام العملي الخالص للعقل في قواعد القوانين الأخلاقية، وتقود هذه القواعد كلها إلى فكرة أسمى قيمة ممكنة في العالم، بشرط أن يكون ذلك ممكنا من خلال الحرية وحدها والأخلاق أيضًا من جهة ما يعتمد ليس فقط على حرية الإنسان، بل أيضًا على الطبيعة، أي أكبر سعادة بشرط أن توزع بما يتناسب مع الأخلاق. يحتاج العقل إذن إلى قبول مثل هذا الخير الأسمى التابع، ولنفس الغرض افتراض الذكاء الأسمى باعتباره الخير المستقل الأعلى، ليس من أجل اشتقاق الصورة الموحدة للقوانين الأخلاقية أو المنبع الرئيس لمراقبتها (فلن يكون لهذه القوانين أي قيمة أخلاقية إذا كان سبب دافعها مؤكدًا من شيء آخر غير القانون وحده، والذي يكون في حد ذاته حكيما [منطقيًا حتما، ويمكن إثباته]؛ بل فقط لإعطاء مفهوم الخير الأعلى حقيقة موضوعية، يعني لتجنب عدم اعتبار هذا الخير الأسمى، جنبًا إلى جنب مع الأخلاق بأكملها، مجرد مثال إذا لم يكن موجودًا في أي مكان وفكرته لا تنفصل عن الأخلاق.
إنها ليست معرفة إذن، ولكنها حاجة محسوسة[8] للعقل، من خلالها يوجه مندلسون (بدون علمه) نفسه في التفكير التأملي. وبما أن وسيلة التوجيه هذه ليست مبدأ موضوعيًا للاستخدام، فإنه مسموح بها بحدودها وحدها، إنها نتيجة طبيعية للحاجة، وتشكل بمفردها العامل المحدد لحكمنا على وجود الكائن الأعلى، وهو مجرد استخدام عرضي في المحاولات التخمينية للتوجيه نحو نفس الموضوع (أعلى الكائنات: إ.م). وهنا يخطأ على كل حال، فقد اعتقد بأن لهذه المضاربة الكثير من القدرة لترتيب كل شيء بمفردها من أجل البرهنة. لا يمكن أن تحدث ضرورة الوسيلة الأولى إلا عندما يتم التسليم الكامل بعدم كفاية هذه الوسيلة. إنه اعتراف كان من الممكن أن تُوصله إليه فطنته في النهاية، إذا كان مع التقدم في العمر قادرًا على تغيير طريقة التفكير القديمة والمعتادة بسهولة بعد تغيير في حالة العلوم، والتي كانت أكثر تميزًا في شبابه. ومع ذلك، لا يزال له الفضل في الإصرار على هذا: لا يوجد المحك الأخير لقبول البحث في الحكم في أي مكان آخر باستثناء البحث في العقل وحده؛ قد يتم توجيهه في اختيار مبادئه من خلال الإدراك أو مجرد الحاجة ومبدأ كماله. في استخدامه الأخير للعقل سمَّى العقل البشري بالعقل المشترك؛ لأن هذا هو الهم الحقيقي الذي يضعه أولاً أمام عينيه في جميع الأوقات. ولكن يجب أن يكون المرء قد خرج من المسار الطبيعي لينسى ذلك ويتأمل بكسل المفاهيم بنظر موضوعي لتوسيع معرفته فقط، سواء أكان ذلك ضروريًا أم لا.
بما إن عبارة: “نطق العقل السليم”لا تزال غامضة بشأن السؤال المطروح فهي إما، كما أساء مندلسون نفسه فهمها، حكم قائم على “البصيرة في العقل”، أو، كما يبدو أن كاتب النتائج فهمها، يمكن أن تؤخذ حكمًا من “إلهام العقل”؛ لذلك سيكون من الضروري إعطاء مصدر الحكم هذا اسمًا مختلفًا، ولا يمكن الإعتماد على مصدر آخرأكثر من الإعتماد على “الإيمان بالعقل”. يجب أن يكون كل معتقد، حتى التاريخي منه، “معقولاً” (لأن المعيار الأخير للحقيقة هو العقل دائمًا)؛ والاعتقاد في العقل هو ذلك الذي لا يستند إلى أي بيانات أخرى من غير تلك الواردة في العقل “الخالص”. كل “المعتقدات كافية بشكل ذاتي، ولكن بموضوعية مع “وعي” غير كافٍ للتمسك بالحقيقة؛ بحيث إنه يتعارض مع “المعرفة”. إذا ما تم اعتبار شيء ما صحيحًا لأسباب موضوعية غير كافية في الوعي، وبالتالي يعني “يعني ” (Meinen) فقط، فإن هذا “التفكير” يمكن أن يصبح في النهاية معرفة من خلال إضافة تدريجية في نفس النوع من الأسباب. على العكس من هذا، إذا كانت أسباب الاعتقاد بصحتها طبقا لنوعها غير صالحة على الإطلاق من الناحية الموضوعية، فلا يمكن أن يصبح الإيمان معرفة من خلال أي استخدام كان للعقل. فالاعتقاد التاريخي، على سبيل المثال ذِكر بعض الرسائل لوفاة رجل عظيم، يمكن أن يصبح معرفة إذا أبلغت سلطات المكان حيث توفي هذا الشخص عن ذلك وأخبرت عن دفنه ووصيته وما إلى ذلك. ومن ثم، فإن هذا الأمر يعتبر صحيحًا تاريخيًا انطلاقا من الشهادة فقط، يعني من الإعتقاد/الضن، على سبيل المثال وجود مدينة روما في العالم. يمكن لأي شخص لم يزرروما أبدا في حياته أن يقول: “أنا أعلم” وليس فقط: “أعتقد”، بأن هناك روما، وتقف هاتين المعرفتين جنبا إلى جنب. على العكس من هذا، لا يمكن أبدًا تحويل “الإيمان بالعقل” الخالص إلى “معرفة” من خلال جميع البيانات الطبيعية للعقل والخبرة، لأن سبب الحفاظ على الإعتقاد في صحة هذا يكون هنا مجرد سبب شخصي، أي حاجة ضرورية للعقل. وطالما أننا بشر، سنبقى دائمًا “نفترض” فقط وجود كائن أسمى، وليس إثباته. هذه الحاجة إلى العقل لاستخدامه “النظري” المُرضِي لن يكون سوى “فرضية عقلية” خالصة، يعني رأي يكون كافيا ليكون صحيحا لأسباب ذاتية: لأنه لا يمكن للمرء أبدًا توقع أي سبب آخر غير هذا، نظرًا “للتأثيرات التي يجب شرحها”، يبقى العقل في حاجة إلى سبب للتفسير. على العكس من هذا، يمكن تسمية “الإيمان بالعقل”، الذي يقوم على الحاجة إلى استخدامه بِنِيَّة “عَمَلِيَة” ، بـ “افتراض” العقل، ليس كما لو كانت نظرة ثاقبة تفي بجميع المتطلبات المنطقية لليقين، ولكن لأن هذا التمسك بالصدق/الصحة (إذا كان كل شيء في الإنسان صالحًا من الناحية الأخلاقية فقط) لا يكون بأي حال من الأحوال أدنى من المعرفة[9]، على الرغم من أنها مختلفة تمامًا في طبيعتها.
إن الإيمان الخالص بالعقل هو الطريقة أو البوصلة التي يوجه بها المفكر التأملي نفسه في غاراته على العقل في مجال الأشياء فوق الحسية، إنسان العقل المشترك (الأخلاقي) السليم. ولكن يمكنه رسم مساره من الناحيتين النظرية والعملية بطريقة مناسبة تمامًا للغرض الكامل من تحديده؛ ويجب أن يكون هذا الإيمان بالعقل أساس كل معتقد آخر، بل كل وحي.
لا يمكن العثور على “مفهوم” الله ولا الاقتناع بـ “وجوده” إلا في العقل وحده، وانطلاقا منه وحده ولا يأتي أولاً إلينا من خلال الوسط أو من خلال رسالة معينة مهما كانت عظمة سلطتها. إذا حدث لي تصور مباشر من هذا النوع، لا تستطيع الطبيعة، على حد علمي، أن تعطيه إياي: يجب أن يكون مفهوم الله بمثابة دليل لما إذا كان هذا التمظهر يتوافق أيضًا مع كل ما هو ضروري لخاصية الإله. على الرغم من أنني لا أفهم كيف يمكن لتمظهر ما أن يقدم أي ظاهرة تمثل ذلك من حيث الجودة فقط، ولكن لا تسمح أبدًا بفحصها. من الواضح من أجل الحكم على ما إذا كان ما يظهر لي هو الله، وما يؤثر على شعوري داخليًا أو خارجيًا، يجب أن أحتفظ بمفهوم العقل عن الله ثم بعد ذلك يجب علي فحصه، ليس ما إذا كان يوافق هذا العقل، بل فقط ما إذا كان لا يتناقض معه. نفس الشيء: حتى لو لم يتم العثور عليه في كل ما يكشف لي عن نفسه مباشرة، والذي يتعارض مع هذا المفهوم؛ فإن هذا التمظهر أو هذا الإدراك أو هذا الوحي المباشر أو كما أراد المرء تسمية مثل هذا الأمر، لن يُثبت أبدًا وجود كائن، يتطلب مفهومه (إذا لم يتم تحديده بشكل غير مؤكد وبالتالي يجب أن يخضع لمزيج من كل أنواع الجنون الممكنة) “اللانهاية”؛ وتمييزه وفقًا لحجمه عن جميع المخلوقات، وهو مفهوم لا يكون مطابقا لأي خبرة أو حدس على الإطلاق، وبالتالي لا يمكن أبدًا إثبات وجود مثل هذا الكائن بشكل قاطع. لا يمكن لأي شخص أن يقتنع بوجود أعلى كائن بأية وجهة نظر، يجب “أولاً” أن يسبق الإيمان بالعقل، وبعد ذلك على الأكثر يمكن أن تؤدي بعض الظواهر أو الافتتاحات إلى مناسبة لدراسة ما إذا كان مخولاً لنا أن نفكر فيما يخاطبنا أو ما يقدم لنا “كإله”، ويُسمح لنا “اعتباره ألوهية”، وتأكيد هذا الاعتقاد كما نشعر به.
إذن، إذا كان العقل في الأمور التي تتعلق بالأشياء فوق الحسية، مثل وجود الله والعالم المستقبلي، محرومًا من حق “السبق” في الحديث عن هذه الأشياء، فإن الباب سيُشرّع لكل خيال وخرافة وحتى الإلحاد. ويبدو أن كل شيء في النزاع الجاكوبي والملدنسوني يشير إلى هذا التخريب. لا أعرف بالضبط ما إذا كانت مجرد “بصيرة العقل” والمعرفة (من خلال القوة المفترضة في التخمين)، أو حتى “الإيمان بالعقل”، وفي مقابل هذا إنشاء اعتقاد آخر يمكن لأي شخص أن يصنعه وفقًا لتقديره الخاص. على المرء أن يستنتج الأمر الأخير تقريبًا عندما يرى بأن المفهوم “السبينوزي” عن الله هو المفهوم الوحيد الذي يتوافق مع جميع مبادئ العقل[10] ومع ذلك فهو مستهجن. لمعرفة ما إذا كان متوافقًا تمامًا مع الإيمان بالعقل، يجب الإعتراف بأن العقل التأملي نفسه غير قادر حتى على معرفة “إمكانية” وجود كائن، بالطريقة التي يجب أن نفكر فيها في الله؛ لذلك لا يمكن أن يوجد في أي معتقد وفي أي وجود حقيقي في أي مكان، كون العقل يمكنه معرفة حتى “عدم إمكانية” شيء ما ومع ذلك يمكنه معرفة حقيقة هذا الشيء من مصادر أخرى.
يا رجال الكفاءات الفكرية والتفكير الواسع! أحترم مواهبكم وأحب مشاعركم الإنسانية. لكن هل فكرتم أيضًا في ما تفعلونه وإلى أين تتجه هجماتكم على العقل؟ لا شك أنكم تريدون الحفاظ على “حرية التفكير” دون قيد أو شرط؛ فبدون ذلك ستنتهي قريبًا همتكم العبقرية الحرة نفسها. نريد أن نرى من طبيعة الحال ما يجب أن تصبح عليه طريقة التفكير الحرة هذه، إذا سادت مثل إجرائاتكم هذه.
أولا تتعارض حرية التفكير مع “الإكراه المدني”. صحيح أن المرء يقول: يمكن حرماننا من حرية “الكلام” أو “الكتابة” من خلال سلطة عليا، لكن حرية “التفكير” لا يمكن حرماننا منها على الإطلاق. لكن إلى أي مدى وبأي صحة “نفكر”، إذا لم نكن معية آخرين، ونعتقد أنه يمكننا “مشاركتهم” أفكارنا ومشاركتهم أفكارهم! لذلك يمكن القول بأن القوة الخارجية التي تنتزع الناس بعيدًا عن حرية “إيصال” أفكارهم علنًا تُصادر أيضًا حريتهم في “التفكير”: الجوهرة الوحيدة التي تبقى لنا على الرغم من كل الأعباء المدنية، والتي من خلالها وحدها يمكن العثور على المشورة ضد كل شرور هذا الوضع.
ثانيا، تؤخذ حرية التفكير أيضًا على أنها معارضة لإكراه الضمير؛ حيث يقوم المواطنون، دون أي سلطة خارجية في الأمور الدينية، بوضع أنفسهم أوصياء على الآخرين وعوض الحجج الواضحة لما يُفرض، وبخوف مخيف من “خطر الدراسة التي يقومون بها” فإن صيغ الإيمان المصاحبة تعرف كيفية إبعاد جميع اختبارات العقل من خلال الانطباعات المبكرة في العقل.
ثالثًا، تعني “حرية التفكير أيضًا عدم خضوع العقل لقوانين أخرى غير تلك التي يُعطيها لنفسه” ونقيضه هو مبدأ “الاستخدام الخارج عن القانون” للعقل (لكي يرى، كما يتخيل ذلك العبقري، أبعد من حدود القوانين). والنتيجة الطبيعية لذلك هي أنه إذا كان العقل لا يريد أن يخضع للقانون الذي يضعه لنفسه، فإنه يكون مضطرا للإنحناء لنير القوانين التي أعطاها إياها شخص آخر؛ لأنه بدون قانون، لا شيء، ولا حتى أعظم هراء، يمكنه أن يلعب لعبته لفترة طويلة. لذا فإن النتيجة الحتمية هي الفوضى المعلنة في الفكر (تحرر من قيود العقل) هذه: قد تسقط حرية التفكير في النهاية، ليس بسبب سوء الحظ، بل بسبب الوفرة الحقيقية، والتي “تُصادر”.بالمعنى الحقيقي للكلمة.
- حوار مع الباحث فرنسوا طاديي

- كروبوتكين ليس مخبولًا (معنى الصراع في نظرية التطور)

- طرق جديده لأطاله عمر الانسان وعلاج الشيخوخة (دراسة علمية)

تم الأمر بهذه الطريقة تقريبًا. في البداية، كان “العبقري” مسرورًا جدًا بتأرجحه الجريء، لأنه تجرد من الخيط الذي كان يوجه العقل إليه. وسرعان ما سحر الآخرين أيضًا من خلال ادعاء القوة والتوقعات العظيمة، ويبدو الآن أنه جلس على العرش، وكان يزين العقل البطيئ والمُرهق؛ على الرغم من أنه يستخدم دائمًا لغة هذا العقل. ومن تم نسمي على العموم مبدأ بطلان العقل الذي يوضع على قمة تشريع القوانين؛ الخيال المشترك للناس، وذاك المفضل من الطبيعة الخَيِّرة، نسميه العقل “المنير”. وبما أن اختلاط لغوي يجب أن ينشأ بسرعة فيما بينهم، فيمكن للعقل وحده أن يحكم بشكل صحيح عليهما معا، ويتبع كل واحد الآن إلهامه. بمرور الوقت يجب في النهاية أن تُصبح المستندات “المفروضة” من الإلهام الداخلي من خلال الشهادات الخارجية ومن التقاليد التي اخترناها في البداية، حقائق مثبتة. باختصار، التسليم الكامل للعقل بالوقائع، يعني أن “الخرافة” تنشأ، لأنه يمكن على الأقل تحويلها إلى شكل “قانوني” وبالتالي إحالتها على التقاعد.
ولأن العقل البشري لا يزال يناضل من أجل الحرية، فإنه بمجرد أن يكسر القيود، يكون الاستخدام الأول لهذه الحرية التي كانت غائبة طويلا تعسفيا (سوء الإستعمال: إ.م). وتراجع الثقة في استقلال قدراتها عن جميع القيود، في الإقناع بالقاعدة الوحيدة للعقل التأملي، الذي لا يقبل إلا ما يرجع لأسباب “موضوعية” ويمكن أن يبرر اقتناعًا دوغمائيًا، لكن ينكر بجرأة كل شيء آخر. إن مبدأ استقلال العقل عن “حاجته” (التخلي عن الإيمان بالعقل) يسمى الآن “عدم الإيمان”، ليس تاريخي، لأن المرء لا يمكنه التفكير في الأمر على أنه متعمد، ولا يفكر فيه أيضًا على أنه رَشِيد (لأن كل شخص يجب أن يؤمن بحقيقة تم إثباتها بشكل كاف بالإضافة إلى البرهنة عليها رياضيا، قد يرغب في ذلك أو قد لا يرغب)، بل إن “الإيمان بالعقل” هو حالة محرجة للعقل البشري، الذي حرم أولاً القوانين الأخلاقية من كل قوة الينابيع الرئيسية في القلب، وحرمها في الوقت نفسه من كل سلطة، و يبدأ طريقة تفكير تسمى “الروح الحرة”، يعني مبدأ عدم الاعتراف بأي واجب على الإطلاق. وهنا تتدخل السلطات، لكي لا تقع الشؤون المدنية في الفوضى العارمة، وبما أن الوسيلة الأكثر رشاقة والأكثر تأكيدًا هي على وجه التحديد الأفضل بالنسبة لها، فإن هذه السلطات تلغي حرية التفكير وتخضع مثل الحِرَفِ الأخرى لمراسيم الدولة. وهكذا فإن حرية التفكير، إذا أرادت حتى المضي قدمًا بشكل مستقل عن قوانين العقل، تدمر في النهاية نفسها.
أصدقاء الجنس البشري وأقدس ما عندهم! اقبلوا ما يبدو لكم، بعد الفحص الدقيق والصادق/الصحيح، أكثر تصديقًا، قد تكون حقائق، قد تكون أسباب عقلية؛ السبب الوحيد الذي لا يجادل فيما يجعله أعظم خير على وجه الأرض، أي امتياز كونه آخر محك للحقيقة[11]. وإذا كان ذلك مخالفا لهذا، فإنكم لا تستحقون هذه الحرية وستفقدونها وستسحب هذه المحنة أيضًا على عنق بقية الجزئ البريء، الذي كان لولا ذلك على استعداد لاستخدام حريته “وفقًا للقانون”، وبالتالي استخدامها أيضًا بشكل مناسب للأفضل في العالم!
الهوامش
[1] تمت ترجمة هذا النص من نص كانط المنشور في أعماله الكاملة، المجلد 13، الذي يوافق النص الذي نشره عام 1791. وتم نشر هذا المجلد ببرلين ولايبتزغ عام 1923. Immanuel Kant, Werke, Bd. VIII, Abhandlungen nach 1781, Berlin und Leipzig 1923. نشر هذا النص في الأصل في المجلة البرلينية في أكتوبر 1786، حيث نشر أيضا نصه الآخر “ما هو الأنوار؟”.
[2] الأنوار: ما هي الأنوار؟ دعوة لاستفزاز المدافعين عنها – إيمانويل كانط • مجلة حكمة (hekmah.org)
[3] Emmanuel Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, Traduction par Joseph Tissot. Mélanges de logique, Ladrange, 1862 (p. 315-341).
[4] تم ذلك في نصه “ساعات الصباح” و “رسائل إلى أحباء ليسينغ”.
[5] Morgenstunden, Seite 164-65 und dem Brief an Lessings Freunde, Seite 33 und 67
[6] . يعني “توجيه” النفس في التفكير بشكل عام، في حالة عدم كفاية المبادئ الموضوعية للعقل، أن يحدد المرء نفسه وفقًا لمبدأ شخصي في حالة عدم ملاءمة المبادئ الموضوعية للعقل.
[7] نظرًا لأن العقل يحتاج أن يفترض مسبقًا “الواقع” كمعطى ولا يعتبر اختلاف الأشياء إلا حدودا من خلال النفي المرتبط بها: لذلك يشعر بأنه مضطر إلى وضع احتمال واحد، وهو إمكانية الجوهر غير المقيد، كأساس أصلي، ولا يعتبر الجواهر الأخرى إلا كمشتقة. بما أن الإحتمال الشامل لكل شيء يجب أن يوجد في الوجود كله، على الأقل، يجعل مبدأ التحديد المستمر التفريق بين الممكن والحقيقي لعقلنا ممكنًا بهذه الطريقة فقط، فإننا نجد سببًا شخصيًا للضرورة، أي حاجة إلى عقلنا نفسه، لوضع وجود أكثر الكائنات الحقيقية (الأعلى) في أساس كل الاحتمالات. لذا فإن الدليل “الديكارتي” على وجود الله ينشأ من حقيقة أن الأسباب الذاتية التي تدعو إلى الافتراض المسبق لشيء ما لاستخدام العقل (والتي تظل دائمًا تجربة في الأساس) تعتبر موضوعية – ومن ثم “الحاجة إلى البصيرة/العقل”. هذا هو الحال مع هذا البرهان، ومع كل أدلة المحترم ميندلسون في “ساعات الصباح”. إنها لا تقدم أي برهان. لكن هذا ليس بأي حال من الأحوال سبب عدم جدواها. ناهيك عن المناسبة الرائعة التي تعطيها هذه التطورات الذكية للغاية في الظروف الذاتية لاستخدام عقلنا لاستخدام سببنا في المعرفة الكاملة لقدراتنا، ولأي غرض تبقى أمثلة دائمة. إن الاعتقاد بالصحة من خلال الأسباب الذاتية لاستعمال العقل، عندما نفتقر إلى الأسباب الموضوعية ونكون مضطرون مع ذلك للحكم، لا يزال ذا أهمية كبيرة؛ فقط ليس علينا التسليم بكون “الشرط الأساسي” القسري كـ “عقل حر”، من أجل عدم إظهار نقاط الضعف للخصم الذي انخرطنا معه في “دوغمائية” دون حاجة لذلك، والتي يمكنه استخدامها لغير صالحنا. ربما لم يعتقد مندلسون أن “العقائد” مع العقل الخالص في مجال ما وراء الطبيعة/ما فوق الحواس، والذي يعتبر بالضبط الطريق إلى الحماس الفلسفي، وأن انتقاد ملكة العقل فقط هو الذي يمكنه أن يعالج هذا الشر تمامًا. صحيح أن نظام المنهج المدرسي (لـ “فولف” على سبيل المثال، والذي نصح به)، المتمثل في وجوب تحديد جميع المصطلحات بالتعريفات وتبرير جميع الخطوات بالمبادئ، منع هذا الهراء حقًا لفترة من الوقت، لكنه لم يستطع توقيفه كليا بأي حال من الأحوال. بأي حق إذن يمكن للمرء أن يمنع العقل، والذي نجح وفقًا لاعترافه (المقصود مندلسون: إ. م) من المضي قدمًا في هذا المجال؟ وأين هي الحدود حيث يجب أن يتوقف (العقل: إ. م)؟
[8] العقل لا يشعر. يعترف بنقصه ويعمل من خلال “دافع المعرفة” والشعور بالحاجة. ومع هذا، وكما هو الحال مع الشعور الأخلاقي الذي لا يسبب أي قانون أخلاقي، لأن هذا الشعور ينشأ بالكامل من العقل؛ ولكن من خلال القوانين الأخلاقية، ومن ثم فهو ناتج عن العقل أو يعمل عن طريق العقل، حيث تتطلب الإرادة النشطة والحرة أسبابًا معينة.
[9] يتضمن “ثبات” الإيمان إدراك”عدم قابليته للتغيير”. يمكنني أن أكون على يقين تام بأن لا أحد يستطيع دحض الجملة: “يوجد إله”، من أين يريد الحصول على هذا الفهم؟ لذلك فإن الإيمان بالعقل يختلف عن الاعتقاد التاريخي الذي لا يزال ممكنًا فيه العثور على دليل مُضاد، وحيث لا يزال يتعين على المرء الاحتفاظ بالحق في تغيير رأيه إذا كان ينبغي زيادة معرفتنا بالمسألة.
[10] من الصعب أن نفهم كيف تمكن علماء مرموقون من إيجاد دعم للسبينوزية في “نقد العقل الخالص”. يقطع هذا النقد أجنحة الدوغمائية تمامًا بالنظر إلى معرفة الأشياء فوق الحسية، والسبينوزية دوغمائية للغاية في هذا الأمر لدرجة أنها تتنافس حتى مع عالم الرياضيات بالنظر إلى صرامة البرهان. يثبت النقد:بأن جدول المفاهيم البحتة للفهم يجب أن يحتوي على جميع مواد الفكر الخالص. تتحدث السبينوزية عن الأفكار التي تفكر، وبالتالي عن حادث يوجود لنفسه ويوجد في نفس الوقت كموضوع: مفهوم لا يمكن العثور عليه في العقل البشري ولا يمكن إدخاله فيه أيضًا. يُظهر النقد بأنه لا يكفي لتأكيد إمكانية وجود كائن متصوّر ذاتيًا، التأكيد بأنه لا يوجد ما يتعارض مع مفهومه (على الرغم من أنه يبقى مسموحًا بقبول هذا الاحتمال، إذا لزم الأمر ذلك)، لكن السبينوزية تتظاهر برؤية استحالة وجود كائن، تتكون فكرته من مفاهيم فكرية خالصة، يزيح المرء عنه فقط كل شروط الحسية، وحيث لا يمكن العثور على التناقض أبدًا، ولا يمكن دعم هذه الإستطالة التي تتجاوز كل الحدود بأي شكل من الأشكال. ولهذا السبب بالضبط، تقود السبينوزية إلى الخيال. ولا توجد أي وسيلة مؤكدة للقضاء على كل هذه الخيال من الجذور، باستثناء الحد من تحديد ملكة العقل الخالصة. يجد باحث آخر “شكًا” في “نقد العقل الخالص”، على الرغم من أن النقد يهدف إلى إنشاء شيء مؤكد ومحدّد بداهة بالنظر إلى مدى معرفتنا. وفي نفس الوقت هناك “جدلية” في البحوث النقدية، التي صُممت لإذابة الديالكتيك المحتوم والقضاء عليه إلى الأبد. وبه يمسك العقل الخالص نفسه ويشتبك فيه، هذا العقل الذي يوجه دوغمائيا في كل مكان. الأفلاطونيون المُحْدَثُون، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم انتقائي لأنهم عرفوا كيفية العثور على نظاراتهم الخاصة في كل مكان في المؤلفين الأكبر سنًا، إذا كانوا جلبوا هذا النظارات مسبقًا، ساروا في نفس الطريقة تمامًا؛ لذلك لا شيء جديد يحدث تحت الشمس.
[11] إن “التفكير الشخصي” يعني البحث عن المحك النهائي للحقيقة في الذات ذاتها (أي في العقل الشخصي)، ومبدأ التفكير في الذات بالذات في أي وقت هو مبدأ “التنوير”. ولا يشمل هذا الكثير من الأمور، كما يعتقد أولئك الذين يتخيلون التنوير في “المعارف”، لأنه (التنوير) مبدأ سلبي في استخدام ملكاته المعرفية، وغالبًا ما يكون الشخص الذي له معرفة كافية في استعماله لهذه الأخيرة، الأقل استنارة. إن استخدام العقل الخاص لا يعني أكثر من تسائل المرء عن كل ما يجب أن يفترضه. سواء اعتقد المرء بأنه من المناسب تقديم سبب قبوله لشيء ما أو أيضًا القاعدة التي تتبع ما يقبله المرء كمبدأ عام لاستخدامه للعقل.
يمكن لكل شخص أن يختبر هذا على نفسه، فسرعان ما سيرى الخرافات والحماس يتلاشى في اختباره هذا، حتى لو لم يكن لديه إلى حد بعيد المعرفة لدحض كليهما لأسباب موضوعية. ولأنه يستخدم مبدأ “الحفاظ على الذات” للعقل فقط. إن ترسيخ التنوير في “الأشخاص الفرديين” من خلال التربية هو أمر سهل للغاية؛ على المرء فقط أن يبدأ مبكرًا لتعويد عقول الشباب على هذا التفكير. إن توضيح “العصر” أمر شاق للغاية؛ لأن هناك العديد من العوائق الخارجية التي تمنع جزئيًا وتعقد هذا النوع من التربية.