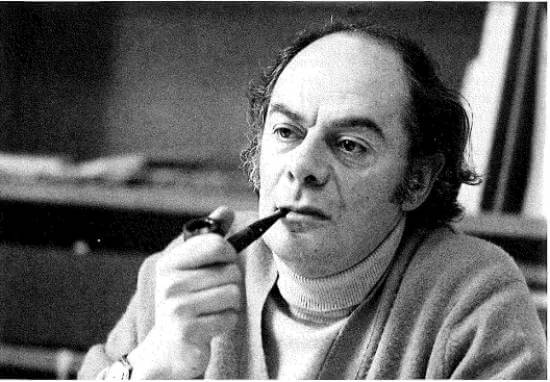| الكاتب | سيمون مانون |
| ترجمة | عبد الوهاب البراهمي |
يندهش كلود لوفور بوصفه مفكّرا في الكليانية، من اشمئزاز أصدقائه من اليسار وأقصى اليسار من اكتشافهم الحريّة في الديمقراطية، لكونها بورجوازية، والاستعباد في الكليانية، بحكم إخلاصهم للاشتراكية. لقد مرّ على هذه الملاحظة أربعون سنة، وإذا كانت الأحوال قد تغيّرت فيما يخصّ علاقة مثقفي اليسار بالرعب الكلياني، فمن غير المؤكّد اختلافها جذريّا فيما يخصّ العلاقة بالديمقراطية. فنحن مندهشون من تحفّظ منظّري الديمقراطية الراديكالية من الإقرار بالبعد المؤسّسي للديمقراطية، والاعتراف بقيمتها البارزة ومسؤولية الحفاظ على مبادئها.
من هنا كان الحماس الذي ميّز جهدهم في مطابقتها فحسب بالديناميكية النزاعية المقوّضة لكلّ نظام قانوني. فالديمقرطية قد تكون ” تمرّدية”، ” ثوريّة” بالنسبة إلى ميقال أبونسور Miguel Abensour، ” لاغنوصية” لدى شنتال موف Chantal Mouffe، ” فوضويّة” بالنسبة إلى جاك رونسيار Jacques Rancière. ويبدو أنّنا نسينا أن نشير بصرامة إلى أنّه حيثما لا توجد الديمقراطية بوصفها نظاما سياسيّا، ومؤسّسة، ويفضّل لوفور القول بوصفها شكلا خياليا للسلطة، بوصفها حيّزا فارغا، فلا يوجد، لا اعتراف بالتقسيمات الاجتماعية، ولا منافسة الأحزاب من أجل السلطة، ولا نقاشا ولا حرية سياسيّة. يبدو إذن أنّه توجد اليوم، صعوبات أكثر من الأمس في الإمساك بطبيعة السلطة السياسية وتقدير الطفرة الرمزية التي تجسّدها الحداثة السياسيّة. يعترض لوفور على هذا الزيغ. وبمعزل عن اعتبار تساؤلات الفلسفة السياسية التي دشّنها سقراط، وأفلاطون وأرسطو، ” حول المبادئ المولّدة للمجتمع أو بالأحرى، مختلف أشكال المجتمع” والتي ليست سوى كواكب قديمة تصلح فحسب للفكر المحافظ، يقترح لوفور على نفسه أن يعيد لها إلهامها وأقلّ ما يمكن أن يقال، هو أن هذه التحليلات لا تمنح مطلقا الحقّ في كراهية جاك رونسيار في هذا الباب، فهو الذي يؤكّد: ” لا يبدو أبدا، أنّ الفلسفة السياسية المعاد بناءها، تدفع التفكير إلى ماوراء مَا يمكن لمسيّري الدولة الاحتجاج به على الديمقراطية والقانون، على القانون ودولة القانون. وباختصار يبدو أنها تضمن خاصّة التواصل بين المذاهب التقليدية الكلاسيكية وأشكال الشرعية العادية للدول المسماة ديمقراطية ليبيرالية” (انظر “سوء التفاهم”، باريس قاليلي 1995 ص10). وعلى العكس، يشعّ التفكير السياسي لكلود لوفور، في مواجهته لهذا التكذيب، بأصالته الكبيرة حينما يعيد للسؤال القديم راهنيته:” ماذا بشأن اختلاف مختلف الأشكال الاجتماعية؟” لكن للاستفادة من إعادة طرح هذا السؤال، لابدّ ألا نكون سجناء النقد الماركسي للدولة بوصفها جهازَ هيمنة طبقة على أخرى. ذلك أنّه من الجيّد أن نكون مهووسون بالتصوّر الأداتي للسياسة وبالأهمية المسندة للصرامة الاقتصادية التي تمنع من النظر إلى الديمقراطية بما هي نظام غير قابل للاختزال في الرأسمالية وهي أبعد من أن تكون الهيئة المؤسِّسَة، والبنية التحتية الاجتماعية- الاقتصادية ذاتها تحيل إلى هيئة تأسيسية. وكما عبّر عن ذلك الكاتب:
“إذا ما أحسنّا التقدير (فيما يخصّ طبيعة السلطة)، فعلينا قلب الأطروحة التي تتحكّم في التأويل الماركسي والإقرار بأن الدولة المعاصرة، أبعد من أن تكون نتيجة للرأسمالية، قد خَلَقَت شروطَ تطوّرها بتأمين إمكانية علاقات الإنتاج والتبادل المستقلّة نسبيا”. (كلود لوفور” الاختراع الديمقراطي ” فايار 1994 ص92).
إنّه القول بأن ما يؤسّس الاجتماعي، هو السياسي. كل مجتمع، فوضويّ، ديمقراطي، استبداديّ أو غيره، يفترض تشكيل وتمعين، ما يمثّل السمة الجوهرية للوجود الفعلي للسلطة. وهذه السمة هي السلطة السياسية التي تأخذ المؤسّسة الاجتماعية، وفق طبيعتها، أشكالا مختلفة. ما الذي يميّز إذن شكل مجتمع ديمقراطي عن آخر فوضوي؟ يجيب لوفور:” عدم اندماج السلطة“، أي بتعبير آخر تأسيس السلطة بوصفها حيّزا فارغا. عدم تعقّد مؤسّسة السلطة، ومؤسّسة القانون ومؤسّسة المعرفة، وبعبارة أخرى الفصل بين المجتمع المدني والدولة.” ذوبان إحداثيات اليقين”، وبتعبير آخر الانفتاح اللامتحكّم فيه للمعنى، في غياب كلّ تأسيس متعال للسلطة. وتتأتّى كل الصّعوبة في هذا الإقرار من كون التجربة التي يجهد لوفور نفسه في جعلها مفهومة، بأقرب ما يميّزها وهو الاختراع، لا تتوضّح في خضمّ التحليل الخبري. ذلك أنه لا يوجد واقع اجتماعي معطى في ضرب من البراءة الموضوعية التي يكفي أن نحيط بها علما. وما نمسك به بوصفه واقعيّا ليس كذلك إلاّ على صعيد التمثّل. فلا تتكوّن المجتمعات في الواقع بل في خياليّ يحدّد الطريقة التي يرتبط بها كلّ واحد بنفسه و بالآخرين، بالكليّة الاجتماعيةّ، بالطبيعة وبالإله، الخ. أي أنها تتكوّن(أي المجتمعات) على صعيد الرمز بحيث يجب على عمل الفكر أن ينصبّ لا على ما يفترض أنّه واقع خبري بل على “الطريقة التي تختلف بها إنسانية أو، تنقسم بشدّة، كي توجد بوصفها كذلك، أي الطريقة التي بها تمتلك معالم رمزية لرسم ما ينفلت عنها: أصلها وطبيعتها والزمان بل الكائن ذاته.” ((لوفور، أشكال التاريخ. محاولات انتروبولوجيا سياسية، باريس قاليمار 1978 ص9). يتعلّق الأمر إذن بالانتباه إلى الرمزية المهيكلة structurante أو المكوّنة لكلّ شكل من المجتمع. يحلّل لوفور بالخصوص ثلاثة أشكال: المَلَكَية والديمقراطية والشمولية، وتتّضح كل واحدة منها باختلافها عن الأخرى. فالنظام الملكي القائم على الحقّ الإلهي ينشأ أو يؤسّس الاجتماعي بتأسيسه على خارجيّة جذريّة، خارجية السموّ الإلهي الضامن لمشروعية السلطة، وحكم القانون والحقّ. ولنتذكّر أن كلمة ملك roi بالمعنى المسيحي، rexمتأتية من regere، التي تعني:” التصرف باستقامة” agir droitement” بحسب المعنى الاشتقاقي الذي يقترحه الأسقف إيزيدور لسيفيل.
فالرمزية المُهَيْكلة هي من أصل لاهوتي -ـسياسي. والملك ليس إلاّ وسيطا بين الإله والبشر، خادما لخَدَمَة الإله، وعلى صورة اتحاد المسيح والكنيسة في رسائل القديس بولس، مَلِكًا لا ينفصل عن شعبه حيث يمثّل جسده الخاص الأعضاء والرأس،” الوحدة العضوية والروحية في نفس الوقت” للمملكة. يشهد بذلك قول لويس 14 في توجيهاته لإبنه، الدلفين، عام 1671:” علينا مراعاة مصلحة رعايانا أكثر من مصلحتنا… بما أنّنا رأسُ جسمٍ هُمْ أعضاءه”. ينتج عن أن المجتمع الملكي له في جسم الملك واقعا جوهريا، “يجسّده” الأفراد بنفس الطريقة التي تكون وفقها مختلف هيئات السلطة، والقانون والمعرفة، متداخلة. ” تكون السلطة في النظام الملكي، مندمجة في شخص الأمير. وهذا لا يعني أنّه يملك قوّة بلا حدود. ونظام الحكم لم يكن استبداديّا. فقد كان الأمير وسيطا بين البشر والآلهة، أو بالأحرى تحت تأثير دَنْيَوَة sécuralisation وعلمنة النشاط السياسي، وسيطا بين البشر والهيئات المتعالية التي تشكلّها العدالة الأسمى والعقل الأسمى. وبالخضوع للقانون وفوق القوانين، يختزل (الأمير) في جسمه، وبعيدا عن كونه جسما، في الآن نفسه فانِ وغير فانِ، مبدأ التكوين ومبدأ نظام المملكة. وتشير سلطته إلى قطب لا مشروط، خارج عن الدنيوي، في ذات الوقت الذي يحمل في شخصه، الضامن والممثّل لوحدة المملكة. ويرى هذا الخير نفسه في صورة جسد، كوحدة جوهرية، بحيث تبدو تراتبيّة أعضاءه، وتميّز الدرجات والمستويات، مرتكزة على أساس لا مشروط. تُجسّدُ السلطةُ المجتمعَ من حيث هي مجَسَّدَةٌ في الأمير. وبموجب هذا الأمر، توجد معرفةٌ كامنة، ولكن ناجعة، عمّا كان يمثّله أحدهما بالنسبة إلى الآخر، في كل امتداد الاجتماعي.” (محاولة في السياسي، سوي Seuil 1986 ص27-28).
- النظرية الاجتماعية اليوم: حوار مع هارتموت روزا

- في ظلال الغد

- مذبحة العرفاء: مآلات التصوف والعرفان في المجال الشيعي

ما يفتأ لوفور في عدّة نصوص يوضّح هذا المعنى، وتهذيب هذا الشكل من المجتمع الملكي كي يبرز، بالتضادّ، شكل المجتمع الديمقراطي.” يتمثّلّ مجتمع النظام القديم وحدته، وهويّته مثلما هي وحدة وهوية جسدِ- جسدا يجد تشكّله في جسد الملك، أو بالأحرى يتماهى معه، في حين أنّه يتمسك به مثلما يتمسّك برأسه. لقد بين ارنست كونتوروويسز Ernst Kantorowicz بامتياز، بأنّ مثل هذه الرمزية كانت قد وضعت في العصر الوسيط وأنّها ذات أصل لاهوتي – سياسي. فصورة جسد الملك بوصفه جسدا مزدوجا، جسدا فانٍ وخالد، فرديا وجماعيا، قد استندت أوّلا إلى جسد المسيح. فالأساسي بالنسبة إلى قولنا – ولن أعرف بالفعل كيف أحلل مختلف انزياحات التمثّل في سياق التاريخ- هو أنّه ولفترة طويلة بعد أن أمّحت سمات الملكية المقدّسة، احتفظ الملك بسلطة تقمّص جسده لجماعة المملكة، التي منذ الآن أنيطت بالمقدّس، والجماعة السياسية، والقومية، والجسد الروحاني.
لا ننكر أنّ هذا التمثّل في القرن الثامن عشر، ملغوم بشكل واسع، وأنّ نماذج جديدة لقابلية الاجتماع تفرض نفسها تحت تأثير تقدّم الفردانية، وتطوّر تساوي الظروف، التي يتحدّث عنها توكفيل، وتقدّم إدارة الدولة التي تميل إلى إظهار هذا الأخير بوصفه كيانا مستقلاّ، لاشخصيا. لكنّ التحوّلات التي حدثت تسمح باستمرار مفهوم وحدة المملكة بما هي وحدة عضوية وروحية في الآن نفسه، يشكّل الملك فيها الجسم والرأس في الآن نفسه. نلاحظ وبشكل مفارقي، أنّ نموّ الحركية الاجتماعية، وتنميط السلوكيات، والآداب العامة، والآراء والتنظيم، لها تأثير هو أنّها تفجّر الرمزية التقليدية أكثر من أن تضعفها. يتكوّن النظام القديم من عدد لانهائي من الأجسام الصغيرة التي توفّر للأفراد معالم تحديد هويّاتي. وتتشكّل هذه الأجسام داخل جسم كبير خيالي يوفّره له جسم الملك الصورة طبق الأصل ويضمن له الصدقية“.(الاختراع الديمقراطي -فيار 1981،1994ص171). ويضمن المجتمع الديمقراطي بالنسبة إلى هذا النموذج، ثورة حقيقيّة وطفرة جذرية واختراعا، يطلب منا لوفور أن نقيس مداه. نحن هنا أيضا في مستوى الرمزي، ولكن مع اختلاف مع الرمزي السابق، ذاك الذي يصبح إجرائيا، في نهاية القرن الثامن عشر، مع الإعلان الأمريكي والفرنسي، ويأخذ كامل حجمه.”
بالنظر إلى هذا النموذج، يتحدّد الطابع الثوري وغير المسبوق للديمقراطية. يصبح حيّز السلطة حيّزا فارغا. ومن غير المفيد الإلحاح على جزئية الجهاز المؤسساتي. فالمهمّ هو أنّه يُمنع على الحكومة التملّك، وتجسيد السلطة. وتخضع ممارستها لإجراء إعادة نظر دورية. تحدث في نهاية تنافس منظّم، شروطه محفوظة بصفة دائمة. يستتبع هذه الظاهرة مؤسسة للنزاع. ويتجلّى حيّز السلطة فارغا، غير قابل أن يُحتلّ – مثلما أن أي فردّ ولا جماعة لا يمكن أن يكون جوهرا ملازما له- غير ملموس. نخطأ في الحكم على أنّ السلطة تقيم في المجتمع، بموجب أنها تنبع من الاقتراع الشعبي؛ إنّها تظلّ الهيئة التي بفضلها يمسك المجتمع بوحدته، ويحيل إلى نفسه في المكان والزمان. بيد انّه الهيئة التي لا تردّ إلى قطب لا مشروط؛ وفي هذا المعنى، فهي تطبع انقساما بين داخل وخارج الاجتماعي، الذي ينشأ الوصل بينهما؛ وتعترف به ضمنيا بوصفه رمزيا خالصا.” (محاولة في السياسي. سويseuil 1986 ص 28).
- مقاربة في شعرية التصوف

- كيف تقرأ كافكا (الجزء الثاني)

- قَصّ أثر الدابة بين الفراسة وفنّ التّحرّي: دراسة مقارنة في خبر أبناء نزار بن مَعَدّ بن عدنان مع أشباهه في الآداب الأخرى

يقوم لوفور هنا بصياغة فكرة صعبة ولكنّها أساسية. يتعلّق الأمر بفهم أن فراغ السلطة لا يعني أنّها غير موجودة، بل يحتلّ على العكس مكانا متعاظما. (انظر توكفيل وخشية الاستبداد الديمقراطي)، لكنها لا تتجسّد أبدا. وليس من يمارسها سوى مستأجرين مؤقّتين مدعوون إلى مراجعة دورية لولايتهم وفق إجرائيات مضبوطة. لا أحد يملك هذه السلطة، إذ هي تعبير عن سيادة الشعب، ولكن” سيادة الشعب ” لا تعني أنّ السلطة تقيم في الشعب كما لو كانت وحدته واقعا جوهريا، محدّدا. إنّ السلطة الديمقراطية هي هيئة انطلاقا منها يمسك المجتمع بوحدته، لكن تظلّ هذه الأخيرة وحدة إشكالية ذلك أّنّ ما يجعل التنافس مرئيا بالنسبة إلى السلطة، هو التقسيم الاجتماعي، والنزاع وتعدّد الأفراد، وتنوّع الآراء والمصالح واستحالة استيعابها في شكل وحدة أو كلية عضويّة. هذا مل يريد لوفور فهمه بالحديث عن ” انقسام بين الداخل والخارج“.
إنّ عبارة الإرادة الجماعية ليست تمظهرا لإرادة واحدة ومتماثلة، بل ليست سوى إرادة أغلبية، وهذه تومئ إلى أولئك الذين لا يتعرّفون على أنفسهم فيها. من هنا كانت مفارقة سلطة تَمْحِي وحدةَ وهويةَ المجتمع في اللحظة ذاتها التي يقبض فيها المجتمع على وحدته. لأجل هذا يذكّر لوفور بأنّ الاقتراع العام قد أدانته عدّة عقول في النصف الأول من القرن التاسع عشر بوصفه مبدأ انحلال اجتماعي.” ليس خطر العدد سوى تدخّل الجماعات في الساحة السياسية؛ وفكرة العدد على هذا النحو تتعارض مع فكرة جوهر المجتمع. يفكّك العدد الوحدة، ويلغي الهويّة”. (الاختراع الديمقراطي فايار 1981-1994). ” نقطة تمثّل لمركز ومعالم المجتمع: لن تعرف الوحدة عندئذ مَحْوَ التقسيم الاجتماعي. تدشّن الديمقراطية تجربة مجتمع لا يمكن الإمساك به ولا التحكّم فيه، والتي يقال فيها عن الشعب إنّه صاحب السيادة، يقينا، ولكنها تجربة لا يكفّ فيها المجتمع عن السؤال عن هويته، التي تظل كامنة فيه.” (نفس المصدر). وليس القانون بأكثر من السلطة، شأنه في ذلك شأن الحقيقة والعدالة والشرعي قابلا للتعريف في محتوى ثابت غير قابل للنقاش. وفي غياب أساس متعال، لا يوجد لا العادل ولا الخير ولا الحقيقة المطلقة. وتكون معالم اليقين ممحاة مصحوبة بنتيجة هي أزمة الحقيقة و كلّ القيم التقليديّة.
يُفْتَح شارعٌ لما يسمّيه ماكس فيبر ” التعدّد الإلهي للقيم “« le polythéisme des valeurs، وإصلاح الآراء، وتماشيا مع النقاش الديمقراطي.” إنّ القسمة بين الشرعي واللاشرعي لا تتجسّد في الفضاء الاجتماعي، بل يستعاض عنها فحسب باليقين، مذّاك لا أحد يستطيع احتلال موقع الحَكَمِ الأعلى، منذ أن احتفظ هذا الفراغ بمقتضى المعرفة. وبعبارة أخرى، تدعونا الديمقراطية المعاصرة إلى الاستعاضة عن مقولة نظام يحكمه القانون، وعن سلطة شرعية، بنظام مؤسس على شرعية نقاش حول الشرعيّ و اللاشرعيّ- نقاش بلا ضامن وبلا حدّ“.(محاولات حول السياسي،seuil 1986 ص 55). و في منطق اضمحلال معالم اليقين، فُتحت قضية المعرفة مثلما هو شأن كل مجالات النشاط، والتي لها حريّة الانتشار وفق معاييرها الخاصّة وغاياتها المميزة. ينفصل المجتمع المدني عن الدولة ويصبح ميدان تحوّله في الزمان. وهو أمر واضح في مجال الحقّ كما في غيره. وبردّ ” منبع الحقّ البيان الإنساني للحقّ“، فإنّ الإعلانات الأمريكية والفرنسية تعني أنّ من يقول الحقّ le droit هم البشر، ولا شيء غير البشر، وليس مشرّعا متعاليا. إنّهم هم من يعلنون عنها و تدشّن في حريتهم المصرّح بها مغامرة، يمكن أن نتوقّع بطابعها الاحتمالي. وبعيدا عن تجميد الواقع الاجتماعي في لحظة من التاريخ، تقوم الإعلانات بالاعتراف، بتعبير يستعيره لوفور من حنا آرنت، “بالحقّ في امتلاك الحقوق.”
يرافق ظاهرة فكّ الاندماج أو اللاتجسّد التي تحدثنا عنها، تفكّك بين حقل السلطة و القانون، وحقل المعرفة. ومذّاك تكف السلطة عن أن تكثّف في ذاتها الخاصيات المستمدّة من عقل وعدالة متعالية، ويتأكّد الحقّ والمعرفة بالنسبة إليها، في خارجيّة، في عدم قابلية للاختزال جديدة. وبمثلما يمّحي شكل السلطة في ماديتها، وجوهريتها، وبمثلما تنكشف ممارستها مأخوذة في زمانية إنتاجها وتابعة لنزاع الإرادات الجماعية، بمثلما تكون استقلالية الحق مرتبطة باستحالة تثبيت ماهيتها؛ نرى اتساعا كاملا لبعد مصير الحقّ، ودائما في استقلالية نقاش حول أساسه وحول مشروعية ما هو قائم وما يجب أن يكون؛ وبالمثل تسير الاستقلالية المعترف بها للمعرفة جنبا إلى جنب مع تحوير متّصل لقضية المعارف وتساؤل حول أسس الحقيقة. ومع تفكك السلطة والحق والمعرفة، تنشأ علاقة جديدة مع الواقع؛ أو لنقل، تجد هذه العلاقة نفسها مضمونة في حدود شبكات المَجْمَعَة socialisation وميدان النشاطات المميّزة؛ ويميل الواقع الاقتصادي أو الواقع التقني، والعلمي والبيداغوجي والطبّي مثلا لتأكيد ذاته، ولتعريف نفسه وفق معايير تخصّه، تحت شعار المعرفة. و تُستخدم في الاجتماعي بكامل امتداده، جدلية التخريج exteriorisation لكلّ مجال نشاط، وهو ما أدركه ماركس الشابّ بوضوح، لكنّه بالغ في ردّه إلى جدلية اغتراب. أن تمارس هذه الأخيرة في متانة علاقات الطبقات، التي هي علاقات استغلال وهيمنة، فلا يمكن لهذا أن ينسينا أنها متأتية من تكوينٍ رمزيٍ للاجتماعي. وتتجلّى بوضوح العلاقة التي أقيمت بين التنافس الذي تحرّكه ممارسة السلطة والنزاع داخل المجتمع.
إنّ تهيئة ساحة سياسية، يقام عليها هذا التنافس، يُظهر التقسيمَ، بوجه عام، بوصفه مكوّنا لوحدة المجتمع ذاته. أو، بعبارات أخرى، يحتوي تشريع النزاع السياسي الخالص مبدأ مشروعيةٍ للنزاع الاجتماعي في كل أشكاله. يتلخّص معنى هذه التحوّلات، إذا ما احتفظنا في الذاكرة بالنموذج الملكي للنظام القديم، فيما يلي: يُبْنَى المجتمع الديمقراطي بوصفه مجتمعا دون جسم، بوصفه مجتمعا يُفْشِلُ تمثّل شمولية عضوية. ولا يجب أن نفهم مع ذلك أنّه مجتمع دون وحدة، وبلا هوية محدّدة، بل على العكس: في غياب التحديد الطبيعي، المتصل من قبلُ بشخصِ الأمير، وبوجود النبالة، ينشأ المجتمع بوصفه اجتماعيا خالصا، بحيث ينتصب الشعب والأمة والدولة في كيانات كونية وكلُّ فردٍ، وكلُّ مجموعة تجد نفسها أيضا مضافة إليه. لكن لا الدولة، ولا الشعب يشكلان واقعا جوهريا. وتمثلهما هو ذاته في استقلالية خطاب وفي بناء اجتماعي وتاريخي مرتبطا دائما بالنقاش الايديولوجي.” (محاولات في السياسي seuil 1986 ص 28-29-30).
خاتمة: إنّه اختراع رائع، أن ينشأ نظام رمزي للحرية السياسيّة، لكنه نظام هشّ. يحتوي التقسيم الاجتماعي على خطر الانكسار، والتردّد الهووي والحنين إلى دمج هووي وإغراء إعادة بناء خيالي لشعب – واحد. لقد نبعت الشمولية حسب لوفور من الديمقراطية كمحاولة للتصدّي لهذه التهديدات المختلفة، ولكي تدمج السلطة في حزب، أو في شخص، ملغية بذلك الفصل بين المجتمع المدني والدولة والحرية السياسية التي لا تقدّر بثمن. نلاحظ اليوم أنّ الإحالة إلى الشعب – الواحد الذي يُزعم اندماجه في مُمَثَّل، قد أصبحت صاخبة للغاية ومغرية في مجتمعات ديمقراطية. هل بإمكانها ألاّ تميل أبدا إلى التخلي عن الشكوك، عن التردّد والمسؤولية التي هي ثمن الحرية السياسية.
" لقد أُقِيمَ، مع الشمولية، جهازٌ يميل إلى تجنب هذا الخطر، الذي يميل إلى درء التصدع بين السلطة والمجتمع، ومحو كل علامات الانقسام الاجتماعي، واستبعاد التردد الذي يلاحق التجربة الديمقراطية. غير أن هذه المحاولة لم أستطع غير جعلها تُلاحظُ، بما أنّها هي ذاتها نابعة من أصل ديمقراطي، وتقود إلى التأكيد التام لفكرة شعب - واحد، وفكرة المجتمع بحدّ ذاته، حاملا لمعرفة بذاته، واضحة بذاتها، متماثلة، وفكرة رأي عام و سيادة معيارية، وفكرة دولة راعية. منذ ذلك الوقت تُعيد الديمقراطية تشكيل جسمها رغما عنها. هل علينا أن ندقّق أن ما يُعاد صنعه مختلف عمّا كان مفكّكا في السابق. فصورة الجسد الذي يشكّل المجتمع الملكي قد استندت على صورة المسيح. واشتغل عليها فكر قسمة المرئي واللامرئي، فكر ازدواج الفاني و الخالد، فكر التوسط، وفكر التولّد الذي، في آن واحد، يَمْحو ويُعيد تأسيس اختلاف المولَّد والمولِّد، وفكر وحدة الجسد وتميّز الرأس عن الأعضاء. يتكثّف في شخص الأمير مبدأ السلطة، ومبدأ القانون، ومبدأ المعرفة، لكنه يُفترض أن يطيع سلطة عليا؛ ويقول عن نفسه إنّه في نفس الوقت غير مقيّد بالقانون وخاضع له، أَبُ وابن العدالة؛ يمسك بالحكمة ولكنه خاضع للعقل. وبحسب الصيغة القروسطية، فقد كان راشدا وقاصرا se ipso، فوق وتحت نفسه. لا يبدو هذا موقع "صاحب سلطة الأنا l'Egocrate أو معوِّضيه، والقادة البيروقراطيين. إنّه (أي الأمير) يتطابق مع ذاته، مثلما يفترض أن يتطابق المجتمع مع نفسه. ترتسم استحالة ابتلاع الرأس للجسد بمثل استحالة ابتلاع الجسد للرأس. إنّ جاذبية الكل لا تنفصل عن جاذبية التجزئة. وحالما يغمى على البناء العضوي القديم، يُطْلَق العنان لغريزة الموت في الفضاء الخيالي المغلق والموحّد للشمولية." (الاختراع الديمقراطي فايار 1981- ص174.175).