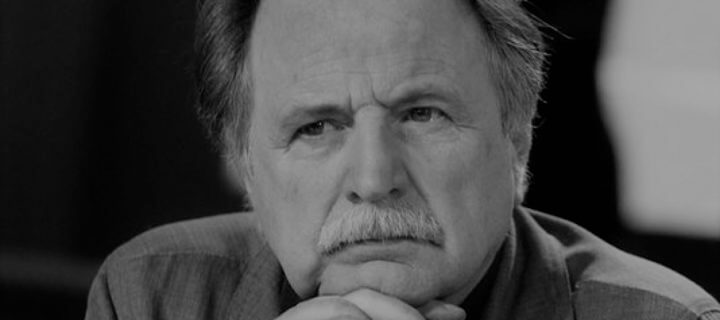أية انتظارت ؟
في الظاهر يبدو الإجماع قائما. فالرأي العام الفرنسي يتفق في أغلبه على قبول فكرة تدعيم دراسة الديني في المدرسة العمومية. ولا يفصح عن هذه الرغبة لمجرّد ضغط الأحداث الصادمة أو إتباع موضة (صرعة ) فكرية عابرة .
فقد عرضت الأسباب العميقة لهذه الرغبة منذ سنوات 1980-1990 في مناسبات عديدة ومن زوايا مختلفة وطرح تطوير مقاربة معقلنة للأديان بصفتها شأنا حضاريّا، وقد جاء تقرير رئيس الجامعة جوتار سنة 1989 معبّرا عن هذا المنحى. إنّ استدلالات المدافعين عن هذا المنحى معروفة. فهي تشير إلى الخطر المتعاظم لشغور جماعي وانقطاع في سلسلة الذاكرة الوطنية والأوروبيّة، فغياب حلقة المعلومات الدينية تسقط مفهومية العديد من الآثار، بل تسقط فائدتها من الأصل، مثل “لوحات” شارتر و”الصلب” لتنتوري و “دون جوان ” لموزار” و”البوز النائم” لـفكتور هيغو و”الأسبوع المقدس” لأراغون. وتشير إلى التسطيح والمسخ اللذين يلحقان بمحيطنا اليومي عندما يصبح ” التثليث” محطة ميترو وأيام الأعياد والعطل و الفصح والسنة السبتيّة مجرّد صدف في الروزنامة. وتشير إلى خشية الانحلال الجماعي لقيم التضامن المدنية لأن أحد أسباب هذا الانحلال هو الجهل بماضي معتقدات الغير وتضخم ما نحمله حوله من صور نمطيّة وأفكار مسبقة. وتشير إلى البحث عبر كونية المقدس وما يتضمنه من ممنوعات وإباحات عن رصيد من القيم الموحدة تكون قادرة على التهيئة القبليّة للتربية المدنيّة والتخفيف من آثار انفجار الضوابط، وذلك مثل التنوّع غير المسبوق للانتماءات الدينية في بلد متميّز بالهجرة المفتوحة من حسن الحظّ على أفق فسيح.
إنّ الكثيرين يشعرون بالتخوف من أزمة أسريّة واجتماعية و أخلاقية، ومن تصاعد الظلاميات واليأس والتعصب، ومن الشعور بالخيبة والضياع. وليس هذا مجال الحكم على شعور التخوّف بالصحة أو الخطأ، لكنه شعور موجود يضاف إليه عامل من الصنف البيداغوجي. لقد انهارت أو تآكلت الأطر القديمة لانتقال المعنى مثل الكنائس والأسر والعادات والسلوك الحضاري فأصبح التعليم، وهو جزء من الخدمات العامة، مطالبا بالاضطلاع بالمهام الأولية للتوجيه في الزمان والمكان لأن المجتمع المدني فقد القدرة على القيام بها. فهذا الانتقال في المهام وهذا التحوّل للفضاء الخاص إلى مدرسة العموم قد برزا منذ حوالي ثلاثين سنة في ظرفية شهدت تراجع الاهتمام بالدراسات الإنسانية الكلاسيكيّة والاختصاصات الأدبية، وشهدت تفوّق الإعلام البصري وتوزع ديمغرافي جديد في المؤسسات [التعليمية] وشهدت كذلك نمطا من المقاربة التقنوية الشكلانية للنصوص المدرسيّة والآثار [الثقافية] همّشت قليلا أو كثيرا اختصاصات المعنى القديمة (الأدب، الفلسفة، التاريخ، الفن). إن المؤسف أنّ تصادف هذه العوامل في نفس الفترة قد جعل الوضع عسيرا.
إنّ ” الجهل الديني ” الذي يثار باستمرار لا يمثّل قضية في ذاته ( أمام تمثال العذراء لبوتسالي يقول أحد الشبان : من هذه المرأة ؟) إنّه جزء وأثر من “جهل” عام ومن ضياع شفرات التذكّر، وهي ظاهرة تعصف بكل أنواع المعرفة وطرق العيش وأساليب الإدراك، وقد تفطنت إليها التربية القومية منذ أمد بعيد لأنها كانت تقف في الصف الأول من المواجهة وتحاول أن تسدّ الثغرات. فليست القضية أن يعامل الشأن الديني معاملة خاصة وأن يمنح امتيازات، إنّما القضية أن يمنح التلاميذ زادا معرفيّا يمكنهم من البقاء متحضّرين وقادرين على ممارسة حقهم في الحكم الحرّ بدل أن يخضعوا كليّا للثنائي “استهلاكـ/إعلام”. وليست القضيّة أن يعاد الربّ إلى المدرسة، وإنّما أن يمدّد المسار الإنساني ذي الشعب المتعدّدة، لأنّ التواصل التراكمي الذي ندعوه ثقافة هو الذي يميّز جنسنا الحيواني عن بقية الحيوانات التي كانت أقل خطأ منّا. إنّ تراث الأديان ومستقبل المجموعات الإنسانيّة يركبان نفس المركب ولن نتمكّن من دعم دراسة الديني دون دعم الدراسة عامة.
هنا يمكن لتاريخ الأديان أن يضطلع بأهميته التعليمية كاملة باعتباره وسيلة لربط المدى القصير بالمدى الطويل ولاستعادة الروابط والإحداثات الخاصة بالبشرية مما يسعى الفضاء السمعي البصري إلى فسخه تحت ضغط الآني المتكرر. ذلك أن ما ندعوه – خطأ على الأرجح – جهل الأجيال الجديدة هو في الحقيقة ثقافة أخرى يمكن أن نعرّفها بأنّها ثقافة الامتداد. فهي تمنح الأولوية للفضاء على حساب الزمان وللمباشر على حساب المتواصل، متوسلة في ذلك أفضل ما توفّره التكنولوجيات (الانتقال بين القنوات، طقوس النقل المباشر والحيّ، التوظيب الحيني والرحلات فائقة السرعة). ويترتب على هذا الأمر توسع مذهل للأفق وتراجع حادّ للتسلسل التاريخي، انه انقباض للبسيطة وانسحاق للتقويم. إننا نتخلى عن التاريخية بنفس السرعة التي ننتقل فيها من مكان إلى آخر. أليس العلاج الناجع لانخرام التوازن بين الفضاء والزمان، وهما الضابطان الأساسيان لكل وضع حضاري، هو إبراز سلاسل النسب وتعميق الأحداث الأكثر اضطراما ؟ كيف يمكن أن نفهم أحداث 11 سبتمبر 2001 دون فهم الوهابية وتيارات التفسير القرآني وتحوّلات التوحيد؟ كيف نفهم التمزقات اليوغسلافية دون فهم الانقسامات الملية القديمة في منطقة البلقان؟ كيف يمكن فهم موسيقى الجاز والقسّ لوثر كينغ دون الحديث عن البروتستانتية والكتاب المقدس؟ ليس تاريخ الأديان مدونة لذكريات الطفولة الإنسانية ولا مجموعة غرائب مقبولة أو مرذولة. تاريخ الأديان يؤكد أن الأحداث ( مثل تفجير برجي التجارة العالمية ) لا تفهم بعمق إلا بالتعمّق في زمنيّتها، ويساهم ذلك في تنسيب الانبهار بالصورة لدى التلاميذ والتخلص من أسر الدعاية واللهثان الإعلامي، فيمنح هؤلاء التلاميذ وسائل إضافية للخروج من سجن الحاضر والقيام بعودة إلى الماضي، ثم عودة عن معرفة إلى عالم اليوم. إننا ننأى بمقصدنا حينئذ أن يكون مشروع ” إعادة تسليح أخلاقي ” أو تقديم حدّ أدنى روحاني مضمون أو التعلق بحنين لطيف وأبوي للماضي.
إنّ المعنيين بالقيام بهذه الجهود هم أساتذة الآداب واللّغات لأنهم الأقدر على تفسير مختلف استراتيجيات الخطاب والطرق المختلفة للتعبير لدى الكائن البشري حسب أن يكون مقصده عرض إيمانه أو وصف أحداث أو تقديم أفكار، ولا يمكن أن تعامل كل طرق التعبير بنفس الكيفية. والمعنيون هم أيضا أساتذة الفلسفة الذين يدفعهم البرنامج الحالي وأفكارهم الخاصة إلى تفسير الفوارق بين العلاقة السحرية والعقلية والدينية بالعالم. والمعنيون هم أساتذة الفنون لأن دراسة الأشكال والرموز والتمثلات تدفعهم حتما إلى الاحتكاك بالثقافات الدينية. وهم أساتذة التاريخ والجغرافيا ( بما أنّ خريطة العالم المعاصر تفهم دون الإحالة إلى الهيكليات الدينية للفضاءات الثقافية). وهؤلاء جميعا معنيون بنفس الدرجة.
-
أية مقاومات ؟
لقد تحققت خطوات مهمة، خاصة منذ سنة 1996، عندما وضعت التوجيهات الجديدة والجيّدة لبرامج التاريخ و الفرنسية ( السنوات السادسة والخامسة والثانية والأولى ). ولم يعد ممكنا أن نزعم مثلا أنّ الإسلام غائب من برامج التدريس، فهذا الزعم يخالف الحقيقة. مع ذلك، فإن محاولة التعمق تؤدي إلى انهيار الوفاق. ذلك أنّ التوتّر يظل قويّا كلما طرح موضوع الطرق والوسائل المستعملة لإدخال القضايا الدينية في تعليم خال من كل طابع ديني. والانتقال من إعلان النوايا إلى تحديد طرق العمل يوقظ على التوّ الاتهامات القديمة. فهناك حذر متبادل كان يفترض منطقيا أن ينقض بعضه بعضا لكنه التقى ليساهم نفسيّا في تضخيم الكبت.
فمن الجهة اللائيكية ، نسمع تنديدا مستترا أو صريحا بحصان طروادة الذي يخفي عودة التعليم الديني إلى المدرسة، وبالحيلة الأخيرة التي ابتدعها التبشير المتآكل، بل إنّ البعض يتحدث عن حملة بابويّة لاسترجاع أوروبا ولمقاومة العلم وعودة السحرة. لقد تعددت الأصوات التي تحذر من كون الذئب قد أصبح داخل الزريبة. يضاف إلى ذلك معطى يتعلّق بالتخوّف المشروع من أن ينتقل الصدام بين المجموعات العرقية والدينية إلى قلب المدرسة وتطرح أسئلة تنمي الغضب بين كل الأطراف، الملحدين وغيرهم. من هنا نفهم ردّ الفعل الذي يقول: “نحن لسنا هنا لتقديم التعاليم الرسمية للأديان”.
ومن جهة رجال الدين والمؤمنين، يحدث أن يحصل التنديد بحصان طروادة من صنف آخر، أي التشويش الذهني والنسبوية ذات النزعة الاحتقارية، عندما تعرض المعطيات جامدة وتفسخ الحدود بين الأصل والنسخة وبين “الدين الحق” و “الأديان الباطلة” . كيف يمكن فصل الأحداث عن تأويلاتها التي تمنحها المعنى؟ هل يمكن أن نحوّل التزاما يعيشه المؤمن من أعماق نفسه ويتماهى بشخصه إلى مجوعة من الملاحظات الخارجية الباردة؟ كأننا بذلك نحوّل الموسيقى إلى مجموعة من النوتات المكتوبة على قطعة ورق أو نطلب من الأعمى أن يحدثنا عن الألوان.
لا تخلو هذه الاعتراضات من الوجاهة لكنها تستند جزئيا إلى مجموعة من سوء الفهم أو الخلط التي يجدر رفعها أولا قبل المرور إلى الأشغال التطبيقية.
إنّ أوّل ما يطلب التوضيح هو أنّ تدريس الشأن الديني ليس تعليما دينيّا. والمدافعون عن الفكر الحرّ والمدرسة الإدماجيّة يعرفون الفروق التي سأتحدث عنها، لكن التذكير بالمعروف يزيده معرفة وتأكّدا.
أـ لا يمكن لأحد أن يخلط بين التعليم الرسمي للديانة ( catéchisme ) والإعلام بمعطيات الديانة، ولا أن يخلط بين مقترح الإيمان ومقترح المعرفة، ولا بين الشهادات والعروض، وأخيرا لا يمكن أن يخلط بين ابستمولوجيا الوحي وابستمولوجيا العقل. فالعلاقة التقديسية بالذاكرة إنّما تهدف إلى تعزيز الإيمان، أمّا العلاقة التحليلية فهي تهدف إلى تعزيز المعرفة. والنوع الأوّل من التعليم يفترض سلطة وحي لا شبيه له يعتبر منحة متعالية تديرها المؤسسة الدينية، فلا تغيب هذه السلطة حتى لو جاء الخطاب في شكل استدلالي وتعليمي. أما النوع الثاني من التعليم فيعتمد مقاربة وصفية قائمة على الأحداث والمفاهيم المتصلة بالأديان الحاضرة في تعدّدها، من الشرق الأقصى إلى الغرب، دون رغبة في تبجيل دين على آخر. فليس من صلاحيات الجمهورية أن تقوم بالتحكيم بين المعتقدات، بل هي تعتمد مبدأ المساواة المبدئية بين أصحاب المعتقدات المختلفة والملحدين و اللاأدريين، وأولى طبعا المساواة المبدئية بين الطوائف المختلفة.
ب ـ يمثل “البحث عن المعنى” واقعا اجتماعيّا لا يمكن للتعليم الوطني أن يكون المضطلع الوحيد به، لكن لا يمكن أيضا أن نتنازل للأديان باحتكار هذه المهمّة كي نلبي الطلبات الاجتماعية معتمدين الحلّ الأكثر يسرا ( لنلاحظ أنّ كلمة دين ظهرت متأخرة وأنها متشابهة الدلالة وغير مناسبة للحقائق التي تسميها). ليس للأديان حصرية ولا تفوّقا بصفة قبلية في مجال معالجة التخوفات الميتافيزيقية للإنسان المترتبة على علاقته بالزمن والعالم والسلف. فمنذ ثلاثة آلاف سنة يعمل الحكماء والفلاسفة وأصحاب المعارف والفنون على البحث في العلاقات التي تربطنا بضوابط وجودنا دون الإنصات حتما إلى ما يأتي من “الضفة الأخرى”.
إنّ الإجابات غير الدينية على الأسئلة التي يطرحها الموت وأصل الكون ومصيره تساهم مساهمة قوية في تكوين المعنى. والتذكير بهذا الأمر البديهي لا يصرفنا عن إدراك حقيقة أنّ الناس يعيشون ويتقاتلون من أجل الرموز وباسمها، وهي حقيقة صالحة للأمس واليوم وستكون صالحة على الأرجح في المستقبل أيضا ( إذا اعتبرنا المرحل المتتالية لتاريخ العقليات مراحل متراكمة هيكليا في النفس الإنسانية الجمعية وليست مراحل متعاقبة يلغي اللاحق منها سابقه). كذلك يتصارع البشر من أجل صور وإعلانات وينزلون بالملايين للتظاهر من أجل الثقافات واللغات والأديان والهويات والمكاسب التراثية ( لقد رأينا تجسيما لذلك في باريس عند الصراع حول قانون المدارس ). والفضاء الرمزي في ذاته هو الذي يتعين على المدرسة أن توسّع التفكير فيه والنقد، خاصة عبر تعليم الفلسفة، وهو يشمل القانون والأخلاق وتاريخ الفنّ والأسطورة. كيف يمكن رسم المغامرة المتواصلة للحضارات دون إدراك الآثار العميقة التي تركتها الأديان الكبرى (1)؟ لابدّ من القيام بجهد في هذا الاتجاه، لاسيما وأن الاقتصاد والتكنولوجيات الجديدة والإحالات إلى المؤسسات الاقتصادية والتسيير الاقتصادي تفرض نفسها على التلاميذ بصفتها الأفق الوحيد المتوفّر أمامهم.
ج- إنّ إبعاد الشأن الديني عن المكان المخصّص لنقل المعارف نقلا عقلانيا وعموميّا ومراقبا يضخّم من المصاعب بدل أن يساهم في تذليلها. فسوق الخرافة والصحافة والنشر تعمل من تلقاء نفسها على تضخيم الاتجاهات العرفانية واللاعقلانية، أفلا يجدر بمدرسة الجمهورية أن تعمل على تعديل الكفّة أمام الإعلام والدجالين والنزوات الطائفية؟ تجاهل الأمر ليس حلاّ. إنّ مفكّر رودان الذي يدفع الكتاب المقدس برجله تعبرا عن عدم الاكتراث ( موضوع صورة كاريكاتورية ) ينسى أنّ الكتاب المقدس لن يضيع بسبب ذلك في الطبيعة أو أنه لن يختفي بذلك عن أنظار كل الناس. سوف تتلقفه القراءات الأصولية وتستعمله لمغالطة شبّان لم تقدّم لهم إضاءات صالحة حوله. وقد قام الدليل على أنّ المعرفة الموضوعية والسياقيّة بالنصوص المقدسة وبالتقاليد الدينية تدفع العديد من الشبّان المتطرفين إلى مراجعة من قادهم إلى التطرّف عن جهل أحيانا. إنّ الممثلين المثقفين عن المجموعات الدينية يدركون هذا الأمر بوضوح.
يجدر أن نتجه أيضا إلى المؤمنين المتحفظين لنذكرهم ببديهيات من نوع آخر كي نحقق التوازن بينهم والفريق السابق.
د– لا تناقض بين خطاب العالم وخطاب الشاهد، ولا بين خطاب يرنو إلى الموضوعية وخطاب يرنو إلى الإيمان، بشرط أن يتواجدا معا ويزدهرا في نفس الوقت (هذا ما يسمح به مبدأ حرية العقيدة وخاصة وجود كليات اللاهوت، والبعض منها تابع للدولة مثل كليتي منطقة ألزاس والموزيل). فمن الممكن إذن أن يتعايش الخطابان لدى بعض الناس (يمكن لمفسّر النصّ المقدس أن يكون نقديا ومنظّما في فكره). والإيمان والمعرفة لا ينتهيان إلى نتيجة متعادلة. فلا بدّ من التمييز بين الديني من جهة كونه موضوعا للثقافة والديني من جهة كونه موضوعا للعبادة. وما هو موضوع للثقافة يدخل ضمن المهام التي عهد بها إلى التربية والتعليم، إذ عليهما أن يبحثا أيضا في مساهمة الأديان المختلفة في التأسيس الرمزي للإنسانية. وما هو موضوع للعبادة يطلب إرادة شخصية تمارس في إطار جماعي غير إطار المدرسة. إنّ كيمياء الألوان لا تلغي تاريخ الرسم، والتركيبة الكيميائية للماء لا تنفي التقديم الذي تعرّف به محطات المياه المعدنية نفسها، ولا تنسي صدى طقوس الماء في الذاكرة. و اللائيكية لا تهتمّ إلا بما هو مشترك بين الجميع، أي الآثار الواضحة لمختلف المعتقدات الجماعية حول العالم التي يشترك فيها البشر، دون أن تتدخّل فيما هو مشترك بين البعض فقط، أي التجارب الحميمية.
هـ – تتطلب الأخلاق المهنية للمدرس أن يضع جانبا عقائده الشخصية أثناء الدرس، وتطبق هذه القاعدة سواءً أتعلق الأمر بالمعتقدات في الفلسفة أو معتقدات المنظومات الاجتماعية في التاريخ. فهناك فارق بين الحديث عن عقيدة معينة والعمل على نشرها والدعاية إليها. والمدرسون مهيأون لممارسة هذه العملية الدقيقة التي تعرض دون تسطيح وتفسّر دون حطّ بقيمة الشيء المفسّر وترغّب دون الظهور بمظهر الحريص على الشيء. إنّهم متدربون منذ عهد بعيد عبر ممارستهم للاختصاصات المدعوّة بالأدبيّة على التوفيق بين القرب للفهم والابتعاد للنقد وبين المعرفة بالشيء واتخاذ مسافة منه، سواء أكان الشيء المدروس نصوصا أو حضارات أو أفرادا. ولابدّ من إنشاء تعليمية للعلوم في الأديان وستكون قادرة بفضل الخبرة البيداغوجية على تحقيق المطلوب. صحيح أنّ عرض السياق التاريخي دون المناخ الروحاني الذي كان يحيط به يتضمن خطر رفع الروح عنه. وعلى العكس من ذلك فإن عرض الحكمة خارج السياق الاجتماعي الذي أنتجها يتضمن خطر المخادعة. التجريد الأول يحوّل علوم الأديان إلى شكل يشبه علم الحشرات أو “متحف غريفان”. والتجريد الثاني يولّد شيخ الطائفة أو فرقة “معبد الشمس”. نحن نراهن على طريق ثالثة هي الإعلام بالأحداث لتشكيل دلالتها، وهي طريقة مألوفة في نظامنا المدرسي منذ أكثر من قرن.
و– تشير العديد من المؤشرات إلى أن الجهل الديني يشمل المؤسسات الخاصة ذات الانتماء الطائفي والمؤسسات الحكومية [ اللائيكية ]. و تشير العديد من المؤشرات إلى أنّ الجهل سببه مستوى الدراسات وليس الأصل الديني للتلاميذ أو انتماؤهم الأسري. ولم تعد المدارس الكاثوليكية مجرّد ” قلاع للإيمان ” كما كان الأمر سابقا. فالدعوة إلى أن ” تهتم كل طائفة دينية بشأنها ” تبدو بعيدة عن الواقعية. والتعليم الخاص [ الديني] والعام [ اللائيكي] يواجهان نفس المشاكل والثغرات ولا يكادان يفترقان إلا في قضية الانتماء الاجتماعي للتلاميذ.
-
أية مقاومات ؟
يدفع الحذر اللائيكي وتضخم المواد المدرسية إلى اتخاذ الخيار الذي اقترحناه، أي استبعاد أن توجد مادة مستقلة لدراسة الشأن الديني تضاف إلى مراحل التعليم الثانوي. صحيح أن تاريخ الأديان هو مثل تاريخ الفنون أو تاريخ العلوم والتقنيات، فهو قابل أن يمثل اختصاصا قائما بذاته في التعليم العالي وفي البحث العلمي، وقابل أن يستقل بنفسه مثل التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم الوسائط. أمّا في المدارس الثانوية، فلا يمكن له أن يشكّل مادة مستقلّة. فينبغي أن يعهد بـ تدريس الشأن الديني إلى مدرسي الاختصاصات الموجودة حاليّا. على أن تقدم إلى هؤلاء المساعدة ويتمتعون بالإحاطة للنجاح في هذه المهمة.
لا يمكن للمدرسة أن تأخذ على عاتقها كل القضايا الاجتماعية المطروحة في فترة تمرّ فيها بأزمة نموّ: تضخم أعداد التلاميذ، كثرة النشاطات، ثقل جداول الأوقات، تراكم البرامج. فالاتجاه اليوم هو نحو التخفيف وليس زيادة مادة جديدة، والمدرسون يشتكون من ثقل البرامج الحالية وصعوبة إيصال المعلومات في أوساط مدرسية شديدة التباين. إننا سنقضي على تاريخ الأديان لو وضعناه مادة مستقلة في التعليم الثانوي لأنه لن يحظى في هذه الحالة إلا بتوقيت هامشي ولن تتجاوز قيمته درس الموسيقى الذي أصبح هامشيا كما نعلم.
ثمّ إنّه يخشى على الأمد البعيد أنّ يترتب على غياب مناظرات منتظمة (الإجازة، التبريز أو الكفاءة في التدريس) وغياب هيئات مستقلة للتقييم المعرفي (المجلس الوطني للجامعات) أن يحلّ القساوسة محلّ المدرسين اللائيكيين. إذ سيقترح حينئذ الالتجاء إلى متدخلين من خارج النظام التعليمي تعويضا عن نقص المدرسين، فينتدب هؤلاء من بين حاملي شهادات الجامعات اللاهوتية الممثلين لمختلف الطوائف الدينية، وسيقع الاحتجاج بتأهل هؤلاء لتدريس هذه المواضيع وقديم خبرتهم بها. وإذا حصل هذا فإن جيل فيري سيصبح غريبا في المدرسة الحديثة التي أنشأها.
لا يبقى من حلّ حينئذ إلا أن نوظّف المواد الموجودة بأن نقرب بين الاختصاصات الحالية ثم خاصة نوفّر الإعداد اللازم للمدرسين الذين سيضطلعون بالأمر. ينبغي أن نوفّر لهؤلاء التشجيع والسلاح الفكري والمهني ليواجهوا قضايا حساسة لأنها تتعلق بالهوية الأكثر عمقا للتلاميذ وأسرهم، فهم سيعالجون موضوعا بالغ التعقيد (وهو أكثر سخونة من الناحية الاجتماعية بالمقارنة بتاريخ العلوم أو الفنون)، فلا بدّ أن يكونوا قادرين على تخفيف التوتّر حول الموضوع وكبح النزوات، بل قد نتجرأ ونقول إنّ عليهم أن يحوّلوه إلى موضوع عادي دون أن ينزعوا عنه أهميته.
لا ينجح تكوين المكونين في هذا الموضوع إلا بالتقريب بين عالم الدراسة الثانوية وعالم الجامعة، لأنّ هناك هوّة تفرّق حاليا بينهما، كما تفرق بين التطور الذاتي للمعارف وعملية نشرها، وبين ثقافة “رفيعة” مخصوصة بنخبة اجتماعية أو معرفية و”مستوى متوسط” يواجه رياح الإعلام وضرورة التبسيط. ألا نقرأ في كتب مدرسية لائيكية عبارات جديرة بالتاريخ المقدس في القرن التاسع عشر (“إبراهيم أب الشعب اليهودي” أو “المسيح مؤسس الديانة المسيحية”) ؟ إنّها تبسيطات ربما لم يكن تستسيغها الخطابات الدينية نفسها في القرن التاسع عشر. لا مناص من رفع هذه الهوّة المتعارضة أيضا مع مبدأ ديمقراطية المعرفة، فهي مسيئة للطرفين في آن واحد. ولابدّ من ربط أطراف علوم الأديان على التراب الوطني وفتح مراكز البحث وتمكين نتائجه من البروز للعموم وكذلك فتح فرص التكوين لدى مدرسي التعليم الثانوي كي يحصلوا على تكوين مهني ممتاز، فهذه المهام الثلاث تصبح مهمة واحدة لأنها تعاضد بعضها بعضا.
-
أيـــة لائيــكية ؟
يضع مبدأ اللائيكية حريّة الضمير (الانتماء أو عدم الانتماء إلى دين معين) فوق ما يسمى في بعض البلدان “الحرية الدينية” ( القدرة على اختيار أي دين على أساس الانتماء إلى دين معيّن). فاللائكية ليست اختيارا روحيّا ضمن اختيارات أخرى بل هي الشرط الضروري ليتحقّق مبدأ الاختيار نفسه، فالمشترك بين مجموع البشر ينبغي أن يقدّم على ما يفرّق بينهم. إنّ تمتع كل شخص عاقل بملكة التعامل مع مجموع التجربة الإنسانية يفرض مقاومة الجهل الديني وفسح المجال لدراسة أنظمة المعتقدات الموجودة. فلا يمكن الفصل بين مبدأ اللائيكية ودراسة الديني (لذلك اخترنا العنوان الذي سيأتي ذكره). بل أنه يجدر أن نبدأ بدرس حول الأسس والضرورات التي تؤكد مبدأ اللائيكية فلا نعتبر الأمر من المسلمات أو نظنه متعمقا في السلوك الجمعي أو نفترض أن الاندفاع الحالي يزيده رسوخا في نفوس الناس. ينبغي أن تؤكد المدرسة اللائيكية إصرارها على مبدأ اللائيكية وأن تفصح منذ البداية عن ترتيب قيمها الذي ينبغي أن يكون متفوقا على ترتيب القيم لدى المجموعات الدينية وأن يتقدم عليها إذا اقتضى الأمر، فلا يمثل تدريس الشأن الديني استثناء أو تنازلا أمام بعض مراكز الضغط أو تراجعا بسبب تقدّم الدعوات المخالفة. إنّ التمسّك بـ اللائيكية شرط في تحقيق المشروع المعروض هنا (لكل معتقده، نحن نحترم معتقدك فعليك باحترام معتقدنا…).
إنّ المقاربة المقترحة تعمل بقدر الإمكان على فهم الدلالة الرمزية والوجودية للطقوس والعقائد لدى المؤمنين لكنها مدعوّة أيضا إلى أن تضع لنفسها حدودا منذ البداية. فهي لا تدعي الوصول إلى لبّ الإيمان المعيش أو الاستحواذ على مكان المهتمين بقضاياه. وليس من مشمولاتها طرح الانخراط الشخصي في الموضوع المدروس أو العمل على معارضة هذا الانخراط. وعلى أساس هذا التحدّد الذاتي فلا خوف على روح اللائيكية لأسباب ثلاثة.
أـ إنّها مقاربة تواصل “النضال من أجل العلم” الذي يحرّر النفوس من الخوف ومن المسلمات، فهي تعمل على توسيع خطاب العقل إلى ميدان المخيال والرمزية دون التهرب أمام المصاعب. فـ اللائيكية التي تتهرّب من الموضوع الديني تتخلى عن جزء من مسؤوليتها. ستتغلب الأنوار على الظلمات عندما نفتح عقول الشباب على كل أنماط السلوك والثقافات كي نساعدهم على فهم العالم الذي يعيشون فيه والإرث المشترك الذي وصل إليهم. وقد يتطلب الأمر مقاومة نوع من العلموية الساذجة التي تمثل المرض الطفولي للعلم المزدهر، أو مقاومة نوع من اللائيكية النفورة التي تمثل المرض الطفولي للتفكير الحرّ. إن كبت الديني وتغييبه عن التفكير ووضعه خارج مجال المتحدث عنه والمخاطرة بتشجيع النزعات الباطنية تشهد على أنّ جزءا من اللائيكية ما يزال مطبوعا بظروف نشأته والنضالات التي اضطر لخوضها في الفترة التأسيسية. لكن بعد قرنين قد مضيا منذ تلك النضالات أصبحت المواقف أقلّ تشنجا لدى الطرفين وتغيّرت الظروف التاريخية بوضوح.
ب ـ إنّ القواعد المهنية اللائيكية هي القادرة وحدها على تفادي الخلط بين السلطات المعرفية بفرض الحيادية بين المدرسين ورفض العودة إلى ما دعي سابقا بـ”حرب الفرنستين” ( عمل مبدأ اللائيكية منذ الأصول على أن يتميّز عن المعاداة المناضلة للأديان). فـ تدريس الشأن الديني يذكر بالعهد الذي شهد سنّ القوانين اللائيكية والجمهورية، ومنها إنشاء قسم مستقل بالمدرسة التطبيقيّة، منذ سنة 1886، مخصص لدراسة الظواهر الدينية بطريقة غير لاهوتية.
ج- إذا كانت العلمانية غير قابلة للانفصال عن منظور ديمقراطي للحقيقة فلابدّ أن يتمتّع الفرد بثقافة مناسبة كي يكون قادرا على المساهمة في التعالي على المسلمات وإعلاء قيمة الاكتشاف (الهند، التيبت، أمريكا) والتخفيف من طوق الهوية وهو يعيش في وضع يتسم أكثر من أي وقت مضى بتفتت الشخصيات الجمعية. هذا هو طريق التقدم الحقيقي واتجاهه. اللائيكية منحة للإسلام في فرنسا وإسلام فرنسا منحة للائيكية.
لن نتحدث حينئذ عن تحديث ديني بل عن تدفّق جديد، ولا عن لائيكية تعددية ومفتوحة بل عن لائيكية تعيد تأسيس نفسها في وضع اطمئنان على قيمها. إنّ ثبات مستنداتها الفلسفية لا يتعارض من حسن الحظ مع تطورها وتجددها.
لقد فرضت الظروف المضطربة لنشأة الجمهورية التغاضي المقصود عن الموضوع الديني وكان هذا الموقف يمثل في نظر الرواد تعبيرا عن احترام المعتقدات الحميمية وتفاديا للفرقة التي يمكن أن تحدث بين التلاميذ. وقد تأوّل البعض خطأ هذا التغاضي المنهجي على أنه احتقار للموضوع الديني نفسه. لقد حان الوقت للانتقال من لائيكية عدم تخصص (الديني ليس من مشمولاتنا) إلى لائيكية فطنة (من واجبنا فهم الديني)، فاللائيكي لا يسلّم بوجود محرمات أو مناطق ممنوعة على العقل. ألا يكون التفكير الحرّ والمنهجي حول الشأن الديني خارج كل تمذهب ساعة الحقيقة ومرتكز الرهان لهذا الموقف الفكري المتحفّظ ؟
إنّ اللائيكية متضمنة في الدستور، وهي أكثر حزما من الفصل القانوني بين الكنيسة والدولة، وأكثر طموحا من مجرد “العلمنة “( التي تنتزع القيم الدينية عن الجماعات الدينية لتوزعها بطريقة أفضل في المجتمع المدني نفسه)، وهي تعبّر عن خيارنا الوطني في شكل مبدأ كوني قد تشكو تطبيقاته بعض المشاكل لكنه في فرنسا هو الأكثر تقدما بين بلدان العالم، وهو يمثل خصوصيتنا في أوروبا. أما تركيا والمكسيك فهما حالتان لهما خصوصيتاهما أيضا، ماضيا أو حاضرا. والبعض يلومنا من أجل هذه الخصوصية ويطالب بأن نتلاءم مع الوضع الأوروبي العام وأن ننخرط في ” النموذج الجماعي – الطائفي “. هؤلاء ينسون أمرين. أولهما أنه لا يوجد في ميدان دراسة الأديان نموذج واحد بل تتعدّد النماذج بتعدّد البلدان. ففي إيرلندا حيث يمجّد الدستور التثليث المسيحي أو في اليونان حيث الكنيسة الارتدوكسية هي كنيسة دولة، يدرّس الدين بصفة إجبارية وبشكل إيماني. أمّا في اسبانيا فقد أصبح تدريسه اختياريا، لكنه يحتفظ بطابع التعاليم الرسمية الكنسية، ولئن كانت الدولة هي التي تختار المدرسين فإنّ عليها أيضا الالتزام باختيارهم ضمن قائمة تعدّها السلطات الكنسية. وفي البرتغال تتولّى الكنيسة الكاثوليكية تدريس الدين في المدارس العامة إلى حدّ الآن، رغم مبدأ حيادية الدولة الذي يعلنه هذا البلد. وفي الدانمرك حيث الكنيسة اللوثرية هي الكنيسة الوطنية لا وجود لتعليم كنسي للدين لكن كل مرحلة من مراحل “مدرسة الشعب” تتضمن درسا غير إجباري عنوانه ” التعرف على المسيحية “. وفي ألمانيا التي تختلف فيها نظم التعليم حسب المقاطعات يندرج التعليم الديني المسيحي ضمن البرامج الرسمية، غالبا تحت إشراف الكنائس، و تحتسب أعداد مادّة تدريس الدّين في الانتقال إلى مستوى دراسي أعلى. وفي بلجيكا تقدّم المؤسسات الحكوميّة الخيار بين دروس في الدّين و دروس في الأخلاق مستقلّة عن الأديان. والخلاصة أنّه لا يوجد نموذج أوروبي في هذا المجال، فكل بلد يتولّى إدارة ذاكرته بالطّريقة الّتي تتناسب مع تراثه التّاريخي وعلاقته بالقوى الرّمزيّة.
أمّا الأمر الثاني الذي ينساه هؤلاء فهو أنّ التعليم المدعوّ بــ” الأوروبي ” يمرّ في الغالب بأزمة ويخضع للانتقادات المتصاعدة لمن لا يرغبون في الانتماء إلى دين معيّن أو في حضور الدروس الدينية. ولنلاحظ أنّ منطقة الألزاس الفرنسية مازالت تحتفظ بالنظام الألماني والدروس الدينية فيها إجبارية ومنظمة على الطريقة الكنسية، لكن أربعة تلاميذ على خمسة يطالبون بالإعفاء من هذه الدروس ( الثلث فقط في الابتدائي). فمن الخطأ أن نظنّ أنّ المطالبة بــ” ثقافة دينية ” هي مطالبة بالدين. والخلط الحادّ بين الأمرين في الوضع الحالي يمثل خطرا على مشروع تدريس الشأن الديني .
يمكن أن نفترض حينئذ أنّ إقامة نموذج أكثر توازنا يضمن مسافة نقدية بين التدريس وموضوعه سيجلب اهتمام جيراننا وأصدقائنا من الأوروبيين، ويمكن أن تكون مدرستنا الجمهوريّة قاطرة للدفع بدل أن تكون العربة الخلفية. فهل نتحوّل من ” متأخرين” في الركب إلى طليعته ؟ هذه أمور واردة.
-
أية توصيات ؟
يترتب على جملة المعطيات المعروضة أن نتقدّم إلى السيد الوزير باثني عشرة توصية مختلفة الأبعاد لكنها مجتمعة يمكن أن تقدّم الدفع الجديد المنشود.
1ـ المبادرة بتكليف مصالح التفقد العامة المعنية، وأساسا مصالح التاريخ والجغرافيا والآداب، بإعداد تقرير تقييمي يتعلق بالتغييرات المدخلة على البرامج منذ 1996. وسيسمح هذا التقييم الأوّل الذي يمكن أن ينجز باعتماد مصالح التفقد الجهوية بتعريف الإدارة العامة للتعليم الابتدائي والثانوي بالتجارب الحاصلة على الميدان: المصاعب التي يواجهها التلاميذ، التحفظ أو الحرج الذي يشعر به بعض المدرسين، الاختيارات المقامة داخل البرامج. وسنكون قادرين من خلال هذه المعطيات على ملائمة التعليمات والتوجيهات للظروف الواقعية.
2ـ يكون مجديا أن نعيد التجانس في البرامج، خاصة في برامج التاريخ للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي التي تعتمد محاور ستة مترابطة بعضها البعض(2). فقد كان المدرس مدعوّا سابقا إلى التخفيف من البرنامج لذلك جعلت بعض الفصول اختيارية، مع أن المجموع ينخرط في خط ثقافي تواصلي لا شك أنّه سيختلّ إذا غاب جزء منه. وتنسحب هذه الملاحظة على العديد من الاختصاصات الأخرى. فكيف يمكن تدريس الأدب الفرنسي في القرن السادس عشر إذا كان تاريخ النهضة الأوروبية مجهولا؟ وكيف يمكن فهم حالة الطبيعة لدى روسو أو الأوديسة الهيغلية لمن لم يسمع أبدا عن آدم وحوّاء ؟
3ـ من المفترض أن تعمل التوجهات الجديدة حول المدرسة الإعداديّة، وخاصّة مسارات الاكتشاف، على تسهيل الحديث عن مسائل دينية في المرحلة المركزية (السنة الخامسة والرابعة)، على أن يحصل ذلك في شكل محسوس ومشخص وفي علاقة مع البرامج المعدلة للفرنسية والتاريخ. ويمنح مجالان من المجالات الأربعة المقترحة الفرصة لاقتحام هذه المسائل وهي: “الفنون والإنسانيات” و”اللّغات والحضارات”. فيمكن مثلا تدريس أنواع الحجّ أو طقوس التطهّر أو مختلف الالأنظمة العمرانية الدينيّة. ويمكن إعداد وثيقة بيداغوجية مصاحبة تدفع إلى هذا الانفتاح وتساعد عليه.
4ـ إلى جانب الجهود التي تبذل داخل كل اختصاص وتمثل العمود الفقري للتعليم فمن الممكن أن نقحم في المعاهد الثانوية ” دروسا مشخصة مؤطرة ” لنشجع على المقاربات المحسوسة والخارقة للاختصاصات حول ظواهر دينيّة. وسيكون مجديا أن نأخذ بالاعتبار رغبات التلاميذ وما يتوفّر من فرص (متاحف، كنائس، معابد يهودية، مساجد، أعياد دينية، الخ) كي ندرّس بطريقة مقارنة أنواع الصيام بين الأديان التوحيدية أو وضعيات المرأة أو تمثلات الألوهية بين التوحيد والوثنية، الخ. ويمكن للتعليم الفني أن يتعاضد مع التاريخ والفلسفة ويضطلع بدور محوري في طرح هذه المسائل عبر آثار هامة داخل كل تراث ديني أو عبر السينما والصورة والرقص والتربية الموسيقية ومناسبات الفرجة.
5ـ إحداث وحدة للمدرّسين المتكوّنين ضمن “المعاهد الجامعيّة لتكوين المعلّمين” وهي التي عوّضت مدارس ترشيح المعلّمين القديمة. ويمكن اقتراح محتويات عديدة بل كثيرة ومتنوّعة، لكن يبدو أنّ أولاها هي وحدة تتّخذ لها عنوانا “اللائيكية والأديان” لأنّها الأكثر التصاقا بالمبدأ المؤسس للمهنة. وإذا ما كانت هناك نيّة لمراجعة وطنية لمسالك التكوين، أو إذا ما وقع تحديد بعض الأولويات، فيمكن حينئذ اقتراح وحدة إجبارية عنوانها “فلسفة اللائيكية وتاريخ الأديان”، على أن يعهد بها إلى أساتذة الفلسفة والآداب والتاريخ في الأكاديميات، وإلى شخصيات أو أساتذة جامعيين مختصين ومكونين لهذا الغرض (انظر لاحقا).
ويمكن تنظيم مداخلات بصفة منتظمة وبشروط تضبط محليا. وتبرمج هـــذه الوحدة (حوالي 10 ساعات في السنة) في السنة الثانية، بعد اجتياز المناظرات، وتشمل المترشحين للتعليم الثانوي (العام،التقني والمهني) والتعليم الابتدائي. ويمكن أن تدرج المحاور في المذكرات المهنية تفاديا لإجراء المصادقة على الوحدات. ويوجد حوالي ثلاثين معهدا جامعيا لترشيح المعلمين يربط بين الجامعة والتعليمين الابتدائي والثانوي (بحكم الموقع وليس بحسب الوضع القانوني)، وهي مهيأة للاضطلاع بدور الوساطة بين مخابر البحث والمؤسسات الدراسيّة. ولقد أقرّت اللجنة الوطنية للتقييم سنة 2001 بأنّ “الثقافة مهمّشة في مسالك تكوين هذه المعاهد” لأنّها توجّه الاهتمام لاستعمال الوثائق أكثر من اهتمامها بالإشكاليات، فيمكن أن يمثل إدخال هذه الوحدة التكوينية فرصة لفتح المجال أمام أكثر الإشكاليات سخونة وانفتاحا على العالم (بما في ذلك ما يبدو لنا غريبا مثل البوذية والهندوسية والشينتو)، وبذلك تزداد الآفاق اتساعا.
6ـ تنظم دورة تدريبيّة بين الأكاديميات مرّة في السنة باعتبارها تكوينا مستمرّا وتجمع ابتداء من السنة القادمة وعلى مدى ثلاثة أيام مجموعة من الباحثين المشهود لهم بالكفاءة من قسم علوم الأديان بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا ومجموعة من المتفقدين البيداغوجيين من كل الأكاديميات، وبخاصة في اختصاص التاريخ والجغرافيا والفلسفة والآداب واللغات الحيّة والتعليم الفنّي، يضاف إليهم أستاذ – مكوّن في كل اختصاص يقترح نفسه في كل أكاديمية(3).
لماذا نقترح هذه الطريقة المتمثلة في التقدّم بطريقة تدريجية ؟ لأنّه يوجد من جهة حوالي 40 ألف أستاذ تاريخ وجغرافيا (مجازين ومبرزين وأساتذة تعليم ثانوي الخ) و60 الف أستاذ آداب وستة آلاف أستاذ فلسفة، دون اعتبار الآلاف من أساتذة اللّغات الحيّة والتعليم الفنّي،الخ. وهناك من جهة أخرى حوالي مائة من المكونين الافتراضيين ذوي المستوى العالي. لا تناسب حينئذ بين الفريقين، فلا بدّ أن نتقدم حسب مراحل إذا أردنا لأساتذة المعاهد الإعدادية والثانوية أن يحصلوا على مرجعيّات صلبة. فالبرنامج الموزّع على ثلاثة أيام يمكن أن يشمل الأديان الكبرى الحاضرة على التراب الفرنسي (إضافة إلى النحل الدينية)، ويمكن أن يتولّى قسم العلوم الدينية بالمدرسة التطبيقية إعداد هذا التدريب فهو القسم الذي برز فيه سيلفان وكوجياف ودومزيل وكلود ليفي ستروس وآخرون. ويمكن أن تضمّ الدورة التدريبيّة محاضرات عامة وورشات عمل. كما يمكن تسجيل المحاضرات العامة ووضعها تحت طلب المؤسسات التعليمية بواسطة المركز الوطني البيداغوجي على أن يتولّى موقع الواب للمركز عملية التحيين.
يمكن أن تنظم هذه الدورة التدريبية في دار المعلمين العليا بباريس، وبأكثر دقة في قاعة العرض السينمائي القديمة التي تحمل اسم جيل فيري. ويمكن لدار المعلمين العليا أن تساهم بتجنيد باحثيها والتكفل بالتنظيم، فتلك المهمّة التي حدّدت لها عند تأسيسها: توفير مخزون للأنوار يمكن أن يتدفق باتجاهات عديدة (4).
7ـ ضمانا لاستمرار التكوين فإنه يتعيّن أن يدرج محور اللائيكية / تاريخ الأديان ضمن برنامج التوجيه المعدّ للأكاديميات وضمن البرامج التي تتكفّل بها هذه الأكاديميات وتدفع الجامعات إلى تنفيذها. وهكذا يتسنّى أن تدرج ضمن البرنامج الأكاديمي للتكوين مبادرات يضطلع بها المشاركون في هذه الندوة الوطنية، في علاقة بالجامعات وعلى أساس تعدّد الاختصاصات. ويمكن بعد ذلك أن تنظم جامعات صيفية إذا اقتضت الحاجة.
8ـ يمكن أن نبحث من هذا المنظور في إمكانية أن يضطلع قسم علوم الأديان بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا بمهمّة قيادة الشبكة وربطها بأفضل مؤسسات البحث الفرنسية المعنيّة (مخابر البحث، المركز القومي للبحث العلمي،جامعات باريس وبقية المدن) كي يصبح ممكنا الاستجابة لطلبات التكوين الأولي والمستمرّ. وقد يكون ملائما التساؤل عن الحاجة لإنشاء” المعهد الأوروبي في علوم الأديان ” يكون له ظهور بارز في الساحة الدولية، على أن يُمثل ” القسم الخامس” ( العلوم الدينية) قلبه النابض، فهذا القسم مغمور نسبيا ومؤسساته موزعة في باريس وإمكانياته العلمية ليست مستغلة الاستغلال الكامل. أما إذا قام المعهد المقترح في إطار برنامج تجديد المدرسة التطبيقية للدراسات العليا(5) فإنه سيكون أكثر قدرة على تنفيذ المهام المنشودة في البحث العلمي وعلى تلبية حاجيات المعاهد الجامعية لتكوين المعلمين، وسيضطلع بالدور الذي تقوم به حاليا ” مدينة العلوم” بالنسبة إلى تاريخ العلوم والصناعات ( تعليم عن بعد، ندوات عن بعد، توفير البيبليوغرافيا والملفات، الخ). وتتمثل أهمية هذا الإجراء في توفير مركز معروف يتولى تنظيم النشاطات ويكون مستقلا عن كل الضغوط الدينية والأيديولوجية وضامنا للموضوعية وقابلا لفتح مجال اهتماماته على تيارات واختصاصات فكرية أخرى والحكم على قيمة المشاركات الأجنبية عند الاقتضاء. إنّ أقطاب التميّز العلمي لا تخضع بالضرورة إلى التقسيم خاص/ عمومي أو ديني/ لائيكي، ومن الخطأ حسب رأيي المتواضع أن نحرم أنفسنا من الاستفادة من بعض المراكز الهامة (المدرسة التوراتية والأركيولوجية بالقدس، المعهد الفرنسي للدراسات الدينية بديجون، كليات اللاهوت، الخ). فلا أقلّ حينئذ من تخصيص مؤسسة جامعية تتولّى الحكم والانتقاء لما يمكن أن يعرض على التكوين العام حسب المقاييس المعتمدة عند أهل الاختصاص والبحث. وسيكون هذا التغيير في المشهد والوضع الإداريين شاهدا على إرادة حقيقيّة وواضحة تنتهي بتجميع مكتبة وإدارة وقاعات محاضرات تحت عنوان واحد كي يضطلع المعهد بالمهمة في مستوى ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
أمّا الآن، وعلى سبيل التهيئة، فيمكن أن نبدأ بإحداث خلية بحث عنوانها ” التعليم / المجتمع، الدين ” تكون مرتبطة مباشرة بالإدارة العامة للتعليم ويلحق بها أساتذة باحثون من المدرسة التطبيقية.
9ـ من مهام هذا المعهد إعداد وسائل بيداغوجية مناسبة (ورقية أو رقمية) والمساهمة في تقييم أفضل للمنشورات الموجودة في السوق المدرسية. ومن المؤسف أن يضلّ تقرير دومنيك بورن حول ” الكتاب المدرسي” تقريرا منسيّا. وعلى هذا الأساس يمكن أخذ رأي الممثلين للأديان الحاضرة في فرنسا أو ممثلي عائلات فكرية أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
10ـ يمكن للوزير من جهته أن يطلب من الإدارة العامة للتفقد، مع موافقة المجلس الوطني للبرامج، تكوين مجموعة من الخبراء ينتمون إلى تخصصات مختلفة (مؤرخو الفنون، مؤرخون، آداب،لغات حية، رسم، موسيقى) كي يضعوا مجموعة من المسالك والملفات والأدوات البيداغوجية التي يمكن أن تفيد التلاميذ. ويمكن أن نشجع بذلك مقاربة مباشرة للشأن الديني من التلاميذ عبر مناسبات فنية وثقافية.
11ـ يجدر توسيع الجذع المشترك للتكوين المذكور إلى رؤساء المؤسسات ومديري المعاهد ممن يواجهون يوميّا هذه المسائل (رفض متابعة دروس البيولوجيا أو التربية المدنية، ارتداء الحجاب، الاختلاط) فهم الذين يتحاورون مع المجموعات المنتمية إلى الأقليات التي تحتج باعتبارات محسوبة على الدين للحصول على تنقيحات في القوانين الداخلية. كما يمكن أن تمثل وحدة ” لائيكية ودين” عنصرا من العناصر القابلة للإدماج في مخططات تكوين المتفقدين (6 ساعات على الأقل)، على أن يتمّ ذلك تحت إشراف إدارة الموارد البشرية الإدارية والتقنية والتأطيرية، وكذلك الفرق الأكاديمية المنظمة للحياة المدرسية التي يعهد إليها بتكوين رؤساء المؤسسات.
12ـ يمكن للوزير أن يطلب رأي لجنة التفكير والاقتراح حول اللائيكية والمدرسة (اللجنة التي أنشأها مؤخرا) عند بعث وحدة جديدة موجهة أساسا للمعاهد الجامعية لتكوين المعلمين.و يجدر أيضا ان يقع تشريك هذه اللجنة في إعداد الدورة التدريبيّة السنوية بين الأكاديميات التي ينظمها المعهد الأوروبي لعلوم الأديان.
لنلخص هذا التقرير. إنه يعرض مجموعة من التوصيات التي اختيرت لتكون عملية ومتواضعة وهي لا تلبي المطلوب إلا إذا عاضد بعضها بعضا. وإذا تأملنا الأمر بعمق وجدنا أن الانصراف عن فكرة تخصيص مادة لدراسة الشأن الديني قد يوفّر فرصا فكرية مثمرة، لأن الدين عابر لحقول الدراسة وأنواع السلوك الإنساني. لكن يمكن أن يؤدي أيضا إلى العكس، أي التهميش والاكتفاء بالحضور الظاهري. لا بدّ في الوضع الحالي أن نسلك طريقا وسطا بين الكثير جدّا والقليل جدّا. ولن يتجاوز تطبيق هذه التوصيات متضامنة حدود الطموح المعتدل: التأثير أثناء التعليم وبعده في الرأي الأوسع.
محمد الحداد أستاذ بالجامعات التونسيّة، متخصص في الإسلاميات والدراسات المقارنة للأديان، تولى سنة 2004 تأسيس ماجستير للدراسات المقارنة للأديان بكلية الآداب بمنوبة (تونس) ويشرف حاليا على كرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للأديان .
هوامش التعريب:
1) كيف يدرس الدين اليوم؟ أعمال الندوة المنعقدة بالدار البيضاء يومي 5و6/12/2003 بالاشتراك بين مؤسسة الملك عبد العزيز ومؤسسة كونراد أديناور.
2) تدريس الأديان في عصر العولمة. أعمال الندوة المنعقدة بتونس في أبريل/ أفريل 2009 بالاشتراك بين كرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للأديان و مؤسسة كونراد أديناور.
3) هذا التقرير الذي أعدّه الفيلسوف الفرنسي ريجيس دوبريه بطلب من وزير التربية والتعليم بفرنسا مكتوب بأسلوب غير مألوف في التقارير الرسميّة، وهو يعكس جزئيا الأسلوب الشخصي وطريقة كتابة صاحبه، لكننا نعتقد أيضا أنه كتب بهذه الطريقة لأنه يتناول موضوعا شديد الحساسيّة لدى النخبة الفرنسية شديدة التمسّك بـ اللائيكية ، وقد تعرّض إلى انتقادات لاذعة واتهم بالمس بمبدأ اللائيكية الذي هو مبدأ دستوري وجمهوري وتاريخي في فرنسا. فقراءة التقرير باللغة الفرنسية وفي السياق الفرنسي يجعل القارئ أكثر تفطنا للمراوغات المفهومية والأسلوبيّة التي توسّل إليها الكاتب ليقتحم قلاعا شديدة التحصين في فرنسا، وهو أمر لا يمكن أن تعكسه الترجمة. من ذلك مثلا استعمال كلمة “ديني” بدل “دين” ( مفهوم قد يحيل على اللاهوت ) أو ” ظاهرة دينية” ( مفهوم قد يتخذ بمعنى وضعاني صرف). لكن المثال الأهمّ هو كلمة fait religieux وهي كلمة رئيسية في التقرير، ولا يمكن أن تترجم ترجمة دقيقة إلى اللغة العربية، بل إنها لا تجد لها مقابلا دقيقا في بقية اللّغات الأوروبية، لذلك نرى غير الفرنسيين يتركونها بصيغتها الفرنسية في كتاباتهم.
فكلمة (fait) لا ترادف كلمة “ظاهرة”، كما هو الغالب في استقبال علماء الاجتماع، ولا ترادف كلمة “حدث” المستعملة في التاريخ، لأن دوبريه يرى، وهو على حق، أن الاقتصار على الأحداث الموضوعية لا يكفي لتفسير عمق القضايا الدينية، ولا ترادف كلمة “شأن” كما هي مستعملة مثلا في قولنا ” وزارة الشؤون الدينيّة “، لأن شأنا وشؤون تعني مجرّد ما يترتّب على الدين من تنظيمات وترتيبات إداريّة، ولا ترادف كلمة “قضية” أو قضايا لأن المقصود ليس بالضرورة التأملات الفكرية والنظرية حول الدين.
فكأن كلمةfait religieux تعبّر عن خصوصية فرنسية ناتجة عن خصوصية اللائيكية الفرنسية التي لا يوجد لها أيضا مقابل في بقية اللّغات، إلا عندما تترجم صوتيا عن الفرنسية (العلمانية مختلفة جزئيا عن اللائيكية وهي المقابل لكلمة sécularisation وليس لكلمة laïcité).
ويدفعنا هذا الوضع إلى تعريب كلمةfait إمّا بشأن أو بظاهرة أو بحدث حسب ما يبدو لنا الأقرب من سياق استعمالها.
هوامش النص المعرب:
1) تربط الرواقية مثل البوذية، أو الأفلاطونية مثل فلسفة سبينوزا، الأنا بالمجموع وبالزمان. لكن الرواقيين لم ينشئوا هياكل ولم يؤثروا في توزيعنا للسنة الشمسية. نقرّ نحن الغربيين بوجود فكر رواقي، وهذا أمر جيّد، لكن هناك كاتدرائيات و يوميات وشأن يهو-مسيحي مشترك بين المؤمنين وغير المؤمنين لا يمكن إبعاده من مجالنا العملي دون أن نبتعد عن ميدان الحقائق.
2) المواطنة الأثينية، نشأة المسيحية، المتوسط في القرن الثاني عشر، الانسوية والنهضة، الثورة التجارب السياسية في فرنسا إلى حد 1851، التحولات الأوروبية في النصف الأوّل من القرن التاسع عشر.
3) المدرسة التطبيقية للدراسات العليا هي مؤسسة مهمة من مؤسسات التعليم العالي، يشرف عليها السيد جون بوبيرو، وتتضمن ثلاثة أقسام: علوم الحياة والأرض (القسم الثالث)، العلوم التاريخية والفيلولوجية (القسم الرابع)، العلوم الدينية( القسم الخامس). ويترأس القسم الخامس السيد كلود لنغلوا، ويضمّ القسم (سنة 2001) اثنين وخمسين مدير أبحاث وثمانية أساتذة محاضرين.
4) لنذكر بمنشور لجنة التعليم المنبثقة عن الهيئة الوطنية للثورة: ” ما أن تنتهي بباريس دروس فن تعليم المعارف الإنسانية حتى ينتشر الشباب العالم والمتفلسف الذي لقّن هذه الدروس في أنحاء فرنسا لينشر هذه المعارف بدوره بين الجميع، وسيفتح هؤلاء المدراس كلما طاب منهم ذلك، وستكون هذه المدارس مصدرا للنور العذب والفياض المنبثق من الرجال الأوائل للجمهورية، وسيدفّق من مخزون إلى آخر ومن فضاء إلى فضاء حتى يشمل فرنسا كلّها دون أن يخسر شيئا من نظارته “.
5) راجع تقرير السيد سارتر، جويلية 2001، وعنوانه: المدرسة التطبيقية للدراسات العليا: مهامها وظروف عملها، وهو يوصي بإعادة تنظيم المدرسة على أسس جديدة.