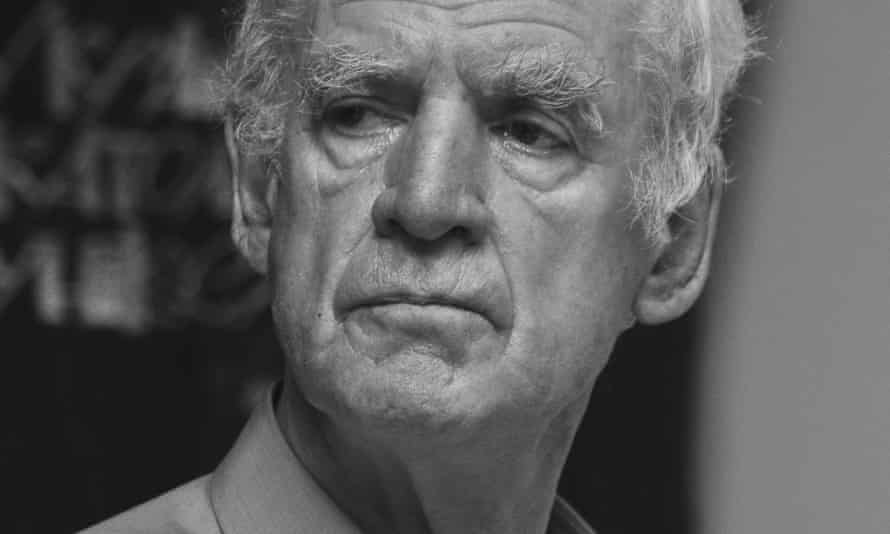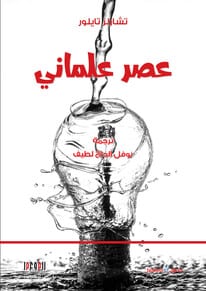
يمكنك شراء نسخة كندل من كتاب (عصر علماني) عبر هذا الرابط
لقد تطورت في أوساط النخب الأكثر أهمية في العالم المسيحي اللاتيني هوية عازلة، منيعة ضد الكوسموس المسحور، زادها انضباط الفكر والسلوك حيوية وصلابة. بيد أن هذا الانضباط، لم يكن يرمي فقط إلى إصلاح السلوك الفردي فحسب، وإنما أيضًا إلى إصلاح وإعادة تشكيل المجتمعات حتى تكون أكثر سلمية وكدحًا.
كان على المجتمع الذي أُعيد تشكيله من جديد أن يُجسِّد، على نحو لا لبس فيه، تعاليم الإنجيل في ظل نظام مستقر، وعقلاني وفقًا لفهم بدأ يتنامى بشكل متزايد. فلم يعد في هذا المجتمع مكان لتلك التكاملات المتناقضة التي عرفها العالم المسحور القديم: بين الحياة الدنيوية وبين حياة النسك الكهنوتية وبين النظام القويم وبين تعليق هذا النظام الظرفي زمن الكرنفال، وبين القدرة المعترف بها للأرواح والقوى الخارقة وبين أشكال ضبطها عن طريق القدرة الإلهية. فقد أصبح النظام الجديد متسقًا وعنيدًا في آن. وأفضى نزع السحر إلى توحّد الغاية والمبدأ.
عنى الترسيخ المتزايد لهذا النظام نهاية التوازن بعد المحوري غير المستقر. لقد ألغي التوافق بين الدين الفرداني المتَّسم بالإخلاص أو بالطاعة أو بالفضيلة المفهومة عقلانيًّا، من ناحية أولى، والشعائر الجمعية ذات الصلة غالبًا بالكوسموس للمجتمعات بأكملها، من ناحية أخرى. وكان هذا الإلغاء لفائدة الصيغة الأولى. لقد تنامى كل من نزع السحر والإصلاح والدين الشخصي جنبًا إلى جنب. وكما أن الكنيسة تكون في أحسن أحوالها كلما انخرط كل عضو من أعضائها فيها بمحض إرادته وعلى مسؤوليته الفردية الخاصة – وقد أصبح هذا النوع من الانخراط، في أماكن بعينها، مثل ولاية كونيكتيت الأبرشية شرطًا صريحًا من شروط العضوية في الكنيسة – فإن المجتمع نفسه أصبح ينظر إليه بوصفه مكوّنًا من أفراد. وعندئذ يبلغ الانعتاق العظيم – كما أقترح تسميته – المضمر في الثورة المحورية نتيجته المنطقية.
وقد استدعى ذلك تطوير وترسيخ الفهم الذاتي الجديد لوجودنا الاجتماعي الذي يُعطي الفرد أولوية غير مسبوقة. وتلك هي القصة التي أريد أن أرسم خطوطها العريضة هنا.
حينما أتحدث عن فهمنا لذواتنا، فإني أعني ما دعوته على وجه الدقة باسم “المتخيّل الاجتماعي” أي بطريقة تخيّلنا الجمعي لحياتنا الاجتماعية في العالم الغربي المعاصر، وإن على نحو سابق على النظرية. وسوف أتوسَّع في هذه الفكرة وفي الأدوار التي يمكن أن تلعبها في حياتنا لاحقًا.
بيد أني أود قبل ذلك أن أنزل الثورة التي شهدها متخيلنا هذا في القرون القليلة الماضية في سياق التطور الثقافي-الديني واسع النطاق على النحو الذي أصبح يفهم فيه هذا الأخير بوجه عام. ويتجلى هذا التحوُّل التاريخي بشكل أوضح، كلما ركَّزنا في المقام الأول على بعض سمات الحياة الدينية التي طبعت المجتمعات القديمة وصغيرة الحجم على قدر ما نستطيع تمييزها. ولا بد أن تكون هناك حقبة عاش خلالها كافة البشر في مجتمعات صغيرة الحجم من هذا القبيل على الرغم من أن جزءًا مهمًا مما نقول بشأن حياة تلك الحقبة يظل مجرد تخمين لا غير.
وإذا ما ركزنا على ما أدعوه “الديانة البدائية” (ويشمل جزئيًا ما يدعوه روبرت بيلا Robert Bellah مثلًا “الديانة القديمة”)([1]) فسنتبين بطرائق ثلاث حاسمة مدى “انغمار” الفاعل في أنماط الحياة هذه.
أولًا، على الصعيد الاجتماعي، في المجتمعات القبلية في العصر الحجري القديم، بل وأيضًا في بعض المجتمعات القبلية في العصر الحجري الجديد، تقترن الحياة الدينية بالحياة الاجتماعية اقترانًا يصعب فكه. وبطبيعة الحال، لا ينطبق هذا، بمعنى من المعاني، على الديانات القديمة فقط، وإنما يتجلّى بشكل واضح في اللغة البدائية جدًا وأصناف المقدّس، وأشكال التجربة الدينية، وأنماط الفعل الشعائري التي كانت متاحة للفاعلين في تلك المجتمعات، التي توجد في حياتهم الاجتماعية الدينية القائمة. وكأن كل مجتمع صغير من هذه المجتمعات شكَّل قدرة بشرية مشتركة وعبَّر عنها بأسلوبه الأصلي الذي يخصه، ورغم بعض التحويلات والاقتراضات اللغوية، ظلت الفوارق في المفردات وفي جملة الاحتمالات متنوعة بشكل استثنائي.
قد لا نحتاج إلى تحديد ماهية هذه القدرة الدينية المشتركة بين البشر مسبقًا، سواء أكانت تقع وجوديا في نطاق النفس البشرية بشكل مستفيض، أم كان يتعيّن النظر إلى هذه النفس البشرية باعتبارها تتفاعل بشكل مختلف مع واقع روحاني يتعالى على البشر. ولنا أيضًا ألا نجيب عن السؤال عما إذا كان هناك أمر ما من هذا القبيل يمثل بعدًا من أبعاد الحياة البشرية لا فكاك منه، وما إذا كان باستطاعة البشر في نهاية المطاف أن يلقوه خلف ظهورهم (على الرغم من أن كاتب هذه السطور، ولا شك في ذلك، لديه بعض الحدوس بشأن السؤالين). لكن ما يبرز أولًا، هو وجود شيء ما في كل مكان يشبه علاقة بالأرواح أو بالقوى أو بالقدرات التي يدركها الإنسان باعتبارها شيئًا أعلى، بمعنى من المعاني، ويختلف عن القوى العادية والحيوانات التي توجد في حياتنا اليومية. في حين أن ما يبرز ثانيًا، هو مدى الاختلاف في تصوُّر هذه القوى والقدرات وعلاقتنا بها. وهو اختلاف يتجاوز “النظرية” أو “الإيمان”، إنه اختلاف في القدرات وفي التجربة، وفي ذخيرة أساليب عيش الدين.
وهكذا نجد من بين الناس مَن يعتقدون بأن الفاعلين يقعون في حالة شبيهة بالغشية، يُنظر إليها كنوع من المسّ أو التملك، وآخرون (بل عند الأشخاص أنفسهم أحيانًا) يعتبرونها بمثابة أحلام مروّعة حادة، ومن بينهم كذلك مَن يعتقدون بأن الأطباء السحرة (الشامانات) يشعرون هم أنفسهم بأنهم انتقلوا إلى عالم أسمى، ويعتقد آخرون أيضًا أن بعض العلاجات الغريبة قد تساعد على شفاء حالات معينة، وما إلى ذلك، ومجمل هذه القدرات تخرج عن نطاق البشر في حضارتنا الحديثة، كما كانت تخرج عن نطاق بعض الناس في عهود سابقة. وإذا أتيحت لبعضهم الأحلام المروعة فإنها ليست تملكًا، أما عند غيرهم فإن التملك موجود، ولكن يتعذر شفاؤه، وما إلى ذلك.
إذن ثمة حقيقة لا سبيل لإنكارها، بمعنى ما، بالنسبة لجميع الناس. ومفادها أن اللغة والقدرات وأنماط التجربة الدينية المتاحة لكل فرد تتأتى لنا من المجتمع الذي نولد فيه. وعلى مؤسسي الديانات المبتكِرة الكبرى أن يعتمدوا هم أيضًا على المفردات الموجودة قبلًا في مجتمعاتهم. وبهذا نستنتج على نحو جليّ أن اللغة البشرية بصفة عامة نكتسبها من الجماعات اللسانية التي ننشأ فيها، ولن يتأتى لنا التعالي على ما يعطى لنا إلا بالانطلاق منها. لكن من الواضح أننا قد انتقلنا إلى عالم تغيَّرت فيه المعاجم الروحية كثيرًا، وأصبح متاحًا لكل امرئ أكثر من معجم وتبادلت المعاجم التأثير في ما بينها، حتى انتفت الاختلافات الحادة في الحياة الدينية بين الناس رغم تباعد المسافات.
ولكن المعنى الثاني يتمثل في أن الديانة البدائية من الناحية الاجتماعية على صلة حاسمة بما سميته الانعتاق العظيم. وأن الفعالية الأولية في الممارسة الدينية المهمة كالصلاة للآلهة أو الأرواح أو تقديم القرابين، أو استثارتها أو استعطافها والتقرُّب من هذه القوى توسلًا للحماية أو الشفاء أو التصرف بمشورتها، هي المجتمع ككل أو فعالية ما أكثر تخصصًا يُنظر إليها على أنها إنما تقوم بذلك من أجل الجماعة. معنى هذا أن البشر كانوا يتصلون في الديانة البدائية بالإله بوصفهم مجتمعًا في المقام الأول.
ويتجلى هذا الأمر مثلًا في طقوس القرابين لدى أفراد قبيلة دينكا (Dinka) كما وصفها غودفري لينهاردت Godfrey Lienhardt قبل نصف قرن في مستويين. فمن ناحية أولى نرى أن الفاعلين الرئيسين للقرابين أي “سادة حربة الصيد”، وهم “موظفون” بمعنى من المعاني، يعملون من أجل المجتمع ككل، ومن ناحية أخرى، فإن الجماعة كلها تصبح مشتركة في الأمر فتردد تضرعات هؤلاء السادة إلى أن يصبح انتباه أفراد الجماعة كلهم منصبًا على فعل طقسي بعينه. وفي لحظة الذروة يصبح “كل المشاركين في الطقوس أعضاء في جسم واحد لا تمايز فيه”. وغالبًا ما تتّخذ هذه المشاركة شكل الهوس بالآلهة التي يتوسلون ويتضرعون إليها([2]).
ولا تجري الأمور بهذه الطريقة فقط في مجتمع ما. فهذا الفعل الجماعي جوهري في سبيل نجاعة الطقوس وليس بمستطاع المرء بمفرده أن يستحضر الآلهة بقوة في عالم الدينكا، فهذه “الأهمية للفعل المشترك للجماعة من حيث أن الفرد عضوًا فعليًا وتقليديًا فيها، هي سبب الخوف الذي يشعر به أيّ فرد من قبيلة الدينكا عندما يتعثر حظه بعيدًا عن موطنه وأهله”([3]).
ويحضر هذا النوع من الفعل الطقسي الجمعي حيث يتصرَّف الفاعلون الرئيسون باسم المجتمع الذي يصبح مشاركًا في الفعل على طريقته، في الديانة البدائية في كل جزئياتها. ويبدو أن هذا الأمر ما زال قائمًا بشكل أو بآخر حتى زماننا هذا. ومن المؤكد أنه ظل يحتلّ مكانة مهمة طالما أن الناس يعيشون في عالم مسحور كما لاحظت ذلك سابقًا عندما ناقشت مسألة نزع السحر. فطقوس موكب “طواف أتباع الأبرشية حول حدودها حاملين عصيًّا يضربون بها على حجر يؤشر على تلك الحدود” في القرية الفلاحية في القرون الوسطى على سبيل المثال، تفترض مشاركة أبناء الأبرشية جميعًا ولا يمكن أن تكون فعَّالة إلا إذا كانت فعلًا جماعيًا يشترك فيه الكل([4]).
عادة ما يحمل هذا الاستغراق في الطقوس الاجتماعية سمة أخرى أيضًا. فبما أن الجزء الأهم من الفعل الديني جمعيّ وحيث يؤدي بعض الموظفين – الكهّان والشامانات والمتطببون والنساك والزعماء وآخرون – أدوارًا حاسمة، فإن النظام الاجتماعي الذي تتمّ فيه تلك الأدوار، يميل إلى القداسة الشديدة. وبطبيعة الحال يُعتبر هذا الوجه من أوجه الفعل الديني الأكثر بروزًا، ولكن أيضًا الأكثر رفضًا من قبل النزعة التنويرية الراديكالية. وهنا يماط اللثام عن جريمة تكريس أشكال من الهيمنة والاستغلال وانعدام المساواة من حيث تماهي هؤلاء الموظفين مع البنية المقدسة للأشياء، بنية لا ينبغي الاقتراب منها. ومن هنا جاء ذلك الشوق إلى يوم “يُخنق فيه آخر الملوك بأمعاء آخر الكهّان”. لكن هذا التماهي الضارب في القدم في حقيقة الأمر يعود إلى زمن لم تظهر فيه بعد الأشكال المتأخرة الأكثر فظاعة وفداحة من عدم المساواة أي حتى قبل ظهور الملوك والتراتبية الكنسية.
ثمة شيء أكثر عمقًا يكمن وراء مسألة عدم المساواة والعدالة، شيء ما يمكن أن نسميه اليوم “هوية”، الكائنات البشرية في تلك المجتمعات القديمة. ولأن أكثر أفعال أولئك الناس أهمية كانت أفعالًا تقوم بها الجماعة كلها، (القبيلة أو العشيرة أو مجموعة الأقارب)، لأن تلك الأفعال كانت تجري وفق طريقة معينة (كان يقودها الزعماء والشامانات وسادة حراب الصيد)، فلم يكن باستطاعة أصحابها أن يتخيلوا أن بإمكانهم الانفصال عن هذه البيئة الاجتماعية، أو بالأحرى ربما لم يفكّروا يومًا حتى في محاولة الانفصال أصلًا.
ولنتبين هذا الأمر، يمكننا أن نُفكِّر في سياقات يصعب التفكير فيها حتى بالنسبة إلينا: ما عساي أكون لو أني ولدت لأبوين مختلفين؟ إذا ما نظرنا إلى هذا السؤال باعتباره تمرينًا مجرّدًا فقد يكون باستطاعتنا معالجته (كأن نقول مثلًا: سأكون مثل مَن ولدوا لأبوين مغايرين). لكني إذا حاولت أن أدرك معنى هذا الفعل وأن أسبر إحساسي الذاتي بالهوية وذلك عبر محاكاة من قبيل: ما عساي أكون لو أني لم أحصل على تلك الوظيفة؟ أو لو أني لم أتزوج تلك المرأة؟ وهكذا دواليك، فستستبد بي الحيرة، لأني بهذه الأسئلة إنما أتعمَّق في الأفق الذي تتشكل في صلبه هويتي أكثر من القدرة على إضفاء معنى على السؤال، وقد يصحّ الأمر ذاته لدى بعض الناس في ما يخصّ جنسهم أيضًا.
هنا أود أن أُبيّن أن هذا العجز عن تصوّر الذات خارج سياق معين يمتدّ في المجتمعات القديمة إلى عضوية المجتمع ذاته في نظامه الجوهري. أما بالنسبة إلينا فالأمر مختلف لأن أسئلة كثيرة من قبيل “ما عسى يكون عليه الحال لو أني…؟” أصبحت ممكنة، أو أكثر من ذلك أصبحت بمثابة مسائل عملية ملحة (هل عليّ أن أتزوج؟ هل أتحوَّل إلى دين آخر؟ هل عليّ أن أتخلى عن أيّ دين كان؟) حتى أضحت معيارًا لانعتاقنا. ومن بين النتائج المترتبة عن هذا أيضًا أننا أصبحنا قادرين على تخيُّل إجابات عن أسئلة مجردة رغم عجزنا عن تخيّل إن كانت حقيقية أم لا.
من هنا فإن ما أسميه الانغمار الاجتماعي متصل في جزء منه بالهوية. وانطلاقًا من إحساس الفرد بذاته، فإن هذا الانغمار يعني عجز المرء عن تخيّل نفسه خارج بيئة معينة. لكن يمكن أن يفهم باعتباره واقعًا اجتماعيًا حين يُحيل الطريقة التي نتخيّل بها جميعًا وجودنا الاجتماعي مثلًا، عندما تكون أكثر أفعالنا أهمية تلك التي يقوم بها المجتمع ككل، والتي تستدعي بناء المجتمع بطريقة معينة بحيث يكون قادرًا على تنفيذها. تضع تنشئتنا في عالم يسوده هذا النوع من المتخيَّل الاجتماعي حدودًا لإحساسنا بذواتنا.
ذلك هو الانغمار في المجتمع، ويصاحبه انغمار في الكوسموس أيضًا، ذلك أن الأرواح والقوى التي نتعامل معها في الديانة البدائية تتداخل في عالمنا بطرائق شتى، والأمثلة على ذلك كثيرة في عالم أسلافنا المسحور في القرون الوسطى. فعلى الرغم من أن الإله الذي كانوا يعبدونه يتعالى على العالم، كانوا مضطرين أيضًا إلى التعامل مع أرواح تسكن الكوسموس وقوى سببية منغمسة في الأشياء: آثار مقدَّسة وأماكن مقدَّسة وأشياء من هذا القبيل. وغالبًا ما كانت الآلهة العليا ذاتها تتحدَّد في الديانة البدائية بسمات معينة موجودة في العالم. ففي الديانة “الطوطمية” مثلت بعض سمات العالم، أنواع حيوانية أو نباتية مثلًا، محور هوية الجماعة([5]). بل قد تكون لمنطقة جغرافية معينة أهمية قصوى في حياتنا الدينية. ولأجل ذلك هناك أماكن مقدَّسة، وتحيلنا هندسة الأرض على الترتيب الأصلي للأشياء في زمن مقدَّس. ويعكس هذا المنظر الطبيعي مدى ارتباطنا بأسلافنا وبالزمن الأعلى([6]).
إلى جانب هذه العلاقة بالمجتمع وبالكوسموس يوجد شكل ثالث من الانغمار في الواقع الموجود في الديانة البدائية. وهنا يكمن التضاد الصارخ مع الديانات التي نعتبرها ديانات “عليا”. فما يطلبه الناس عندما يستعطفون الآلهة هو الازدهار والصحة وطول العمر والخصوبة. وما يطلبون الحماية منه هو المرض والفاقة والعقم والموت المبكر. وهنا يتجلى تصوُّر معين للازدهار الإنساني لا يحتاج إلى أي واسطة لكي ندركه، ومهما يكن ما نريد أن نضيف إليه يظل على ما يبدو فهمًا “طبيعيًا” تمامًا. لكن ما كان غائبًا رغم أهميته المحورية في الديانات “العليا” المتأخرة، كما أشرت إلى ذلك في الفصل الأول، هو ضرورة وضع هذا الفهم المتداول موضع تساؤلات جذرية علينا تخطيها بشكل أو بآخر.
لا يعني هذا أن الازدهار الإنساني هو الغاية التي يرنو إليها الجميع. كما قد تكون للإله مقاصد أخرى قد يكون بعضها مؤذيًا لنا. ونجد في الأديان القديمة، بمعنى ما، أن الإله قد لا يكون مهتمًا بنا على الدوام. بل قد يكون أحيانًا لا مباليًا بنا ضمن بعض الوجوه. وقد يعتري الآلهة غضب أو كره أو غيرة يتعيّن علينا تجنب آثارها. ومع أن للإحسان، من حيث المبدأ، اليد الطولى، إلا أن هذه العملية تفترض استعطافًا أو أفعالًا معيَّنة تأتيها شخصيات “متحيّلة”. لكن الثابت رغم ذلك كله هو أن الغايات الخيِّرة للآلهة تتَّحد من منظور الازدهار الإنساني. هذا وأن بعض الأشخاص يتمتعون بقدرات تفوق قدرات البشر العاديين بكثير، مثل الأنبياء والشامانات. لكن هذه القدرات في آخر المطاف تخدم الرفاه في الفهم المتداول.
في المقابل نجد في المسيحية والبوذية، مثلًا، كما رأينا في الفصل الأول، فكرة عن الخير تتجاوز الازدهار الإنساني. وهو خير يمكن أن نكسبه حتى عندما نفشل تمامًا وفق مقاييس الازدهار الإنساني، بل يمكن لنا أن نكسبه من خلال هذا الفشل ذاته (كالموت على الصليب في ربيع العمر) أو من خلال الفشل الذي يتمثل في ترك ميدان الازدهار البشري بتاتًا (إنهاء دورة التكاثر)، وتكمن المفارقة التي تنطوي عليها المسيحية مقارنة بالديانة البدائية على ما يبدو في الإحسان الإلهي غير المشروط تجاه البشر، ففي هذا المضمار لا وجود لذلك التناقض الذي تنطوي عليه الآلهة الكبرى، علاوة على أن المسيحية تُعيد تحديد غاياتنا من خلال توجيهنا إلى ما يتجاوز الازدهار الإنساني.
وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن قاسم مشترك بين الديانة البدائية والنزعة الإنسانية الحديثة الحصرية. وهذا بيّن في الإحساس بتعاطف كثير من الحداثيين ما بعد التنويريين مع الوثنية. من ذلك أن جون ستيوارت ميل Jon Stuart Mill يرى أن “إثبات الذات في الوثنية” أسمى بكثير من “إنكار الذات في المسيحية”([7]) (وهذا على صلة بالإحساس بالتعاطف مع الاعتقاد في آلهة متعددة (الشرك) وإن بأقل حدَّة وسأناقشه لاحقًا). فما يجعل النزعة الإنسانية الحديثة غير مسبوقة هو بطبيعة الحال القول بأن الازدهار الإنساني لا علاقة له بأي شيء يسمو فوق حياتهم الدنيوية.
يقف الدين البدائي على طرفي نقيض مع ما دعاه كثيرون باسم الديانات “بعد المحورية”([8])، وأشير هنا إلى ما سماه كارل ياسبرز Karl Jaspers باسم “العصر المحوري”([9]) أي تلك الفترة الاستثنائية في الألفية الأخيرة قبل ميلاد المسيح عندما ظهرت أشكال “متعالية” متعددة للدين على نحو يبدو مستقلًا في حضارات مختلفة. وقد تميَّزت هذه الديانات بوجود شخصيات بارزة مؤسسة مثل كونفوشيوس Confucius وغوتاما Gautama وسقراط والأنبياء العبرانيين.
تكمن السمة المثيرة للدهشة في الديانات المحورية أو ما يجعل من إمكانية تحديدها بدقة مقارنة بسابقاتها في أنها دشنت قطيعة في ما يتصل بأبعاد الانغمار الثلاثة كلها: النظام الاجتماعي، والكوسموس، والخير الإنساني، وهذا لم يحدث بشكل منتظم ولا دفعة واحدة. ولعل البوذية، ضمن بعض الوجوه، هي الديانة التي قطعت شوطًا أكبر من غيرها لأنها تختصر البعد الثاني اختصارًا جذريًا: إن نظام العالم ذاته موضع تساؤل لأن عجلة التكاثر تعني المعاناة. ويوجد ما يشبه هذا في الديانة المسيحية: عالمنا مضطرب، ويجب بناءه من جديد. لكن بعض وجهات النظر في الحقبة بعد المحوريـة تحافظ على معنى ما لعلاقة مع الكوسموس. وهذا ما نجده بأشكال مختلفة لدى كونفوشيوس وأفلاطون لكنهما يشيران إلى تمييز بين هذا والنظام الاجتماعي الفعلي المتَّسم بقدر كبير من عدم الكمال. ولأجل ذلك تثير الصلة الوثيقة بالكوسموس عن طريق الحياة الدينية الجمعيّة إشكالًا.
وقد عبَّر فرانسيس أوكلي Francis Oakley في مناقشته حول تاريخ النظام الملكي عن هذا الانغمار ثلاثي الأبعاد في شكله القديم بصورة رائعة:
“الملكية… انبثقت عن عقلية “قديمة” ذات نزعة أحادية، على ما يبدو، لم تفصل بتاتًا بين الإنساني والإلهي. وتفترض حدسيًا أن الإلهي محايث لإيقاعات دورية العالم الطبيعي والمجتمع المدني كما لو كانت منغمسة بشكل أو بآخر في السيرورات الطبيعية، وتعتقد أن وظيفتها (الملكية) الأساسية دينية في جوهرها، إذ تتعلق بالحفاظ على النظام الكوني و”التكامل المتناغم” للبشر مع العالم الطبيعي”([10]).
إن الفاعلين من البشر منغمسين في المجتمع، والمجتمع منغمس في الكوسموس الذي يتضمن الإلهي. وما اعتبرته بمثابة التحوّلات المحورية يقطع هذا التسلسل على الأقل في نقطة واحدة إذا لم يكن أكثر. ويعتبر أوكلي أن النقطة المصيرية في تطور الغرب هي القطيعة في الجزء الأعلى، وقد أحدثتها الفكرة اليهودية (كما نسميها اليوم) الخلق من عدم، حيث عزلت الله تمامًا عن الكوسموس ونصّبته فوقه. وهذا معناه أن الله أصبح بإمكانه أن يكون مصدر التعاليم التي تقطعنا عن “سيرورة العالم” التي سمَّاها براغ “حكمة العالم” التي لم تعد تقيّدنا أبدًا([11]).
ولكن ربما التجديد الأكثر أهمية من ذلك كله هو موقف المراجعة بشأن الخير الإنساني في الديانات المحورية. فهذه الديانات جميعًا تحمل في طيَّاتها دعوة جذرية للشك في تلك المفاهيم التي يبدو أنه لا يرقى إليها الشك حول الازدهار الإنساني، وهذا بدوره من شأنه أن يُفضي، لا محالة، إلى الشك في بنى المجتمع وملامح الكون التي يُفترض أنها هي التي ساهمت في تحقيق هذا الازدهار. وقد كان هذا التحوَّل مزدوجًا، كما ذكرت أعلاه. من جهة، العالم “المتعالي” عالم الله، أو الآلهة والأرواح أو الجنة، مهما كان تعريفها، والتي تحتوي مسبقًا على العناصر التي تكون مواتية وغير مواتية على حد سواء للخير الإنساني، وهذا العالم يُصبح بشكل لا لبس فيه أصل هذا الخير. ولكن من جهة أخرى، فقد أُعيد النظر في معنيي المتعالي والخير الإنساني.
وقد لاحظنا بالفعل تغييرات في المصطلح الأول، حيث قد يتموقع المتعالي في العالم الماورائي تمامًا أو خارج الكوسموس، كما هو الحال مع الله الخالق في سفر التكوين Genesis أو في النيرفانا البوذية (السعادة القصوى) Nirvana of Buddhism. وإذا ما ظل على طابعه الكوسمولوجي، فإنه يفقد طابعه الأصلي المتناقض، ويكشف عن نظام للخير لا تشوبه شائبة، كما هو الحال بالنسبة “للجنة” الضامن للحكم العادل في الفكر الصيني([12])، أو نظام المثل عند أفلاطون حيث يكون مثال الخير بالذات هو أصل كل شيء.
ولكن على المصطلح الثاني أن يتطوَّر هو أيضًا. فالهدف الأسمى الإنساني لم يعد مجرَّد تحقيق الازدهار، كما كان عليه الأمر من قبل. فقد أصبح يتعلق إما بموقف جديد من الخلاص يسمو بنا عمَّا نعنيه عادة بالازدهار الإنساني. وإما يتعلق بالجنة، أو مثال الخير بالذات، الذي يفرض علينا أن نحاكي أو نجسِّد خيره الذي لا تشوبه شائبة، وبالتالي تغيير النظام الأرضي لأشياء الدنيا، فينتج عن ذلك، عادة، ازدهار واسع النطاق، ولكن ازدهارنا الشخصي (على صعيد الفرد والأسرة والعشيرة أو القبيلة) لم يعد هدفًا أسمى. وبطبيعة الحال، يمكن التعبير عن ذلك عن طريق إعادة تحديد معنى “ازدهار”.
ينظر إلى ذلك من زاوية أخرى، على أنه تغيُّر في الموقف من الشر بوصفه الوجه التدميري والضار في الأشياء. فلم يعد مجرَّد جزء من نظام الأشياء بحيث علينا القبول به بما هو كذلك، بل يتعيّن علينا معالجته. ويمكن تصوُّر ذلك على أنه هروب من خلال التحوُّل ذاتيًا، أو يمكن أن يُنظر إليه على أنه نضال من أجل احتواء السيئ أو القضاء عليه، ولكن في كلتا الحالتين الشر ليس مجرد شيء نقبل به مرغمين كجزء من توازن في الأشياء لا مفرّ منه. بطبيعة الحال، فإن المعنى العميق لمصطلح “الشر” قد تطوَّر هنا، فلم يعد يُحيل فقط على الجانب السلبي من الكوسموس، ولكن أصبح يُنظر إليه بوصفه نقصًا([13]).
يمكن أن أُعبِّر عن التناقض المشار إليه بالقول: تشتمل الديانة البدائية خلافًا للديانة بعد المحورية على قبول بنظام الأشياء في الأبعاد الثلاثة التي نناقشها هنا. وفي سلسلة مهمة من المقالات التي تناولت ديانة السكان الأصليين في أستراليا يتحدَّث ستانر W.E.H. Staner عن “مزاج القبول” الذي يلعب دورًا مركزيًا في روحانيتهم. ولم يُنشئ السكَّان الأصليون في أستراليا “نوعًا من الصراع مع الحياة” انطلاقًا من محاولات التلقين الدينية بعد المحورية المتنوعة([14]). ومن السهل أن نغفل عن التناقض هنا لأن ميثولوجيا السكان الأصليين، في علاقة بظهور نظام الأشياء في زمن الأحلام – الزمن الأصلي خارج الزمن، زمن كل الأزمان – تروي قصص الكارثة التي حاقت بالناس نتيجة التحايل والخداع والعنف، وهي كارثة استطاعت الحياة الإنسانية أن تتعافى منها، وأن تستأنف حياتها من جديد لكن على نحو ممزق ومُعيب، إذ حافظت على تلك العلاقة العميقة بين الحياة والمعاناة، وإذ ظلت الوحدة غير منفصلة عن الانقسام. قد يبدو لنا هذا شبيهًا بقصص أخرى عن السقوط بما في ذلك ما جاء في سفر التكوين 1، لكن خلافًا لما خلصت إليه المسيحية من هذا السقوط، فإن واجب “متابعة” الحلم لدى السكان الأصليين، أي واجب التعافي من خلال الطقوس ومن خلال التبصُّر باتصالهم مع نظام الأشياء في الزمن الأصلي، يرتبط بهذا التقدير الممزق والمعيب الذي يتداخل فيه الخير والشرّ: فلا مجال هنا للحديث عن إصلاح للخلل الأصلي، ولا عن التعويض أو على جعل تلك الخسارة الأصلية تبدو خيرًا. فالطقوس وما يُصاحبها من حكمة تحمل هؤلاء السكان الأصليين على القبول بما يتعذر تغييره “ويحتفلون بابتهاج بما لا سبيل إلى تغييره”([15]). والكارثة الأصلية لا تفصلهم ولا تغربهم عن المقدَّس أو الأعلى، كما في رواية سفر التكوين، بل هي تساهم في تشكيل النظام المقدَّس الذي نجتهد في “متابعته”.
لم تتخلص الديانة المحورية من الحياة الدينية البدائية، حيث حافظت على سمات الممارسات القديمة بشكل كبير في صيغ معدّلة لتحدّد الجزء الأكبر من الحياة الدينية على مدى قرون عديدة. ولا تنبثق التحويرات، بطبيعة الحال، من الصيغ الدينية المحورية فحسب، بل أيضًا من تنامي مجتمعات أوسع نطاقًا وأكثر اختلافًا وأكثر تمركزًا حول المدن، مع مزيد من التنظيم التراتبي ومع وجود بنى جنينية للدولة. والواقع أن ثمة من يقول بأن هذه البنى الأخيرة ساهمت هي أيضًا في عملية الانعتاق لأن وجود سلطة الدولة نفسه يتضمن محاولة من أجل التحكم في الحياة الدينية والبنى الاجتماعية التي تفترضها وتشكيلها، مما يقلل من شأن الطابع غير المادي لهذه الحياة ولهذه البنى([16]). وأعتقد أن هناك الكثير مما يمكن أن نقوله بشأن هذه الفرضية، وسأشير إلى شيء من هذا القبيل لاحقًا، ولكني أريد قبل ذلك التركيز على أهمية الحقبة المحورية.
بيد أن هذا الأمر لم يُحدث تغييرًا في الحياة الدينية للمجتمع بشكل كامل دفعة واحدة، إلا أنه أتاح إمكانيات جديدة أمام ديانة الانعتاق من خلال البحث في علاقة مع الإله أو مع الأعلى تُعيد النظر بقوة في التصوُّرات السائدة عن الازدهار الإنساني، أو حتى تذهب إلى أبعد من تلك التصوُّرات، التي يمكن للفرد أن يبنيها بمفرده و/أو ضمن أنماط جديدة من المؤانسة لا صلة لها بالنظام المقدَّس القائم. وعلى هذا النحو يمضي الرهبان المسيحيون والبوذيون والهندوس أولئك الذين نذروا حياتهم لله مخلصين، متوكلين على أنفسهم فتنشأ عن ذلك أنماط غير مسبوقة من المؤانسة: جماعات التلقين، وطوائف المخلصين، والسانغا Sangha، وتنظيمات الرهبان، وما إلى ذلك.
وفي جميع تلك الحالات ثمَّة نوع من التعطل، أو الاختلاف أو حتى القطيعة في العلاقة بالحياة الدينية للمجتمع ككل الذي قد يشهد، هو بدوره، اختلافًا بسبب اختلاف الفئات أو الطوائف أو الطبقات، وقد تستقر الرؤية الدينية الجديدة في واحدة منها. بيد أنه كثيرًا ما تخترقها جميعًا تقوى جديدة لا سيما كلما كان هناك انقطاع في البعد الثالث مع وجود فكرة “أكثر سموًا” بشأن الخير الإنساني.
وهناك نجد أنفسنا أمام توتر لا فكاك منه، ولكن غالبًا ما كانت هناك محاولة لضمان وحدة الكل أيضًا، ولاستعادة بعض من معنى التكامل بين الأشكال الدينية المختلفة، ومن هنا فإن المكرسين للأشكال “العليا”، على الرغم من انتقادهم لأولئك الذين تمسكوا بالأشكال القديمـة، ظلوا هم أنفسهم يتضرَّعون إلى القوى العليا من أجل الازدهار الإنساني، تبادلوا الخدمة مع تلك القوى، كأن يُطعم عامة الناس رجال الدين فيكتسبون فضيلة، وهي فضيلة بقدر ما تساعدهم على المضي قدمًا على طريق السمو، بقدر ما تحميهم أيضًا من مخاطر الحياة، وتُطور رخاءهم وصحتهم وخصوبتهم.
يبلغ الانشداد إلى التكامل من القوة حدّ أنه حتى في تلك الحالات حيث تسيّد الدين الأعلى على المجتمع كله كما في البوذية والمسيحية والإسلام، حيث لا شيء يتعارض معه، فإن الفارق بين الأقليات من “أولي النهي” (إذا استخدمنا مصطلح ماكس فيبر) والدين الجماهيري الخاص بالمقدَّس الاجتماعي يظل متَّجهًا إلى حدّ كبير صوب تحقيق الازدهار، ويظل حيًا أو قادرًا على إعادة تشكيل نفسه، عبر ترابط المجهودات من جهة، وعبر التكامل التراتبي من جهة أخرى.
وفي إطار وجهة نظرنا الحديثة، ومن خلال النظر إلى الوراء بكل معنى الكلمة، يبدو كما لو أن الروحانيات المحورية حُرمت من إنتاج أسباب الانعتاق بشكل كامل لأنها كانت مطوَّقة – إن جاز التعبير – بقوة الحياة الدينية لدى أكثرية الناس المترسخة في القالب القديم بشكل متصلب. لقد تمكنت هذه الروحانيات من تحقيق شكل ما من أشكال الفردانية الدينية، ولكن بالمعنى الذي عناه لويس دومون Louis Dumont من “الفرد خارج العالم”([17])، أي بوصفها طريقة حياة أقليات نخبوية وبوصفها، ضمن بعض الوجوه، على هامش “العالم” أو في علاقة متوترة معه، والعالم المعني هنا ليس الكوسموس المنظم في علاقة بالمقدس أو بالأعلى فحسب، بل أيضًا المجتمع المنظم في علاقة بكل من الكوسموس وبالمقدس معًا. وكان العالم لا يزال مجرد بيئة للانغمار وكان لا يزال يوفر الإطار الذي لا بدّ منه للحياة الاجتماعية بما في ذلك حياة الأفراد الذين أداروا الظهر له وذلك بقدر ما ظلوا في متناوله بمعنى ما([18]).
ما كان يجب أن يحدث هو أن تتحوَّل هذه البيئة نفسها، وأن يُعاد تشكيلها وفقًا لبعض مبادئ الروحانية المحورية حتى يتسنى النظر إلى “العالم” ذاته بوصفه مكوَّنًا من أفراد. وهذا من شأنه أن يكون بمثابة عهد من أجل “الفرد في العالم” وفقًا لمصطلحات دومون، أي الفاعل الذي يعتبر نفسه فردًا في الأصل في حياته الدنيوية العادية. وهذا هو الفاعل البشري للحداثة الغربية.
كنت قد تعرَّضت لمشروع التحوُّل هذا في الفصول السابقة: محاولة إعادة تشكيل المجتمع على نحو شامل وفقًا لمتطلبات النظام المسيحي مع تخليصه من كل اتصال بالكوسموس المسحور، إلغاء مظاهر التكامل القديم كلها بين الروحي والدنيوي وبين حياة حصرية لله وحياة في هذا “العالم”، وبين النظام والفوضى التي يستمد منها النظام معناه.
لقد كان هذا المشروع انعتاقيًا بالكامل في شكله وفي نمط عمله: الإعادة المنضبطة لتشكيل السلوك وأنماط المؤانسة من خلال إضفاء طابع موضوعي عليها ومن خلال اتخاذ موقف أداتي بشأنها. لكن ظلت غايات هذا المشروع مشدودة بشكل عميق بالانعتاق أيضًا. وهذا ما يتضح لنا من خلال الدفع نحو نزع السحر الذي قضى على البعد الثاني من أبعاد الانغمار. كما يتضح لنا أيضًا في سياق مسيحي، ذلك أن المسيحية لا تختلف في نمط عملها عن أيّ روحانية محورية. والواقع أنها تعمل بالتزامن مع روحانيات أخرى كالرواقية مثلًا. ولكن كانت هناك أيضًا أنماط مسيحية قائمة بذاتها ولها خصوصيتها. ويعج العهد الجديد بالدعوات إلى ترك أشكال التضامن ضمن العائلة أو العشيرة أو المجتمع أو الحد منها حتى يصبح المرء جزءًا من ملكوت الله. وقد انعكس بشكل جدّي في طريقة عمل بعض الكنائس البروتستانتية حيث لا يكون المرء عضوًا في الكنيسة بمجرد ولادته لأبوين عضوين فيها، بل يكون عليه أن ينضم إلى الكنيسة من طريق الاستجابة إلى نداء شخصي. وهذا ما أضفى بدوره صلابة على تصوُّر للمجتمع بوصفه مؤسسًا على اتفاق، وبالتالي فإنه يتكون، في نهاية المطاف، بفعل قرارات الأفراد الأحرار.
من البديهي أن يكون هذا التوافق في المواقف نسبيًا. إلا أن أطروحتي هي أن أثر المحاولة المسيحية أو المسيحية-الرواقية لإعادة تشكيل المجتمع من خلال “فرد داخل العالم” حديث، كان واسع النطاق ومتشعبًا جدًا. لقد قادت هذه المحاولة المتخيل الأخلاقي أولًا ثم الاجتماعي في اتجاه الفردانية الحديثة. وقد تجلى ذلك، بداهة، في التصوُّر الجديد للنظام الأخلاقي في نظريات القانون الطبيعي([19]) في القرن السابع عشر الذي يُدين، في الكثير منه للرواقية، ومؤسسوه هم الرواقيون الجدد في هولندا، لا سيما جوستوس ليبسيوس وهوغو غروتيوس. لكنها كانت رواقية مسيحية، حديثة أيضًا بمعنى أنها أعطت مكانة كبيرة لإعادة تشكيل المجتمع البشري على نحو إرادي.
نستطيع القول إن كلًا من الهوية العازلة ومشروع الإصلاح ساهما في الانعتاق. فالانغمار، كما ذكرت أعلاه، مسألة متعلقة بالهوية. والحدود التي يضعها السياق العام على تخيُّل الذات متعلقة بالمتخيَّل الاجتماعي أيضًا: أي بالطرائق التي تمكّن من التفكير في المجتمع كله أو من تخيّله. لكن الهوية العازلة الجديدة، مع إصرارها على الإخلاص والانضباط الفرديين، وسَّعت الفجوة وانعدام القدرة على تحديد الهوية، بل والمعاداة بين الانعتاق وبين الأشكال القديمة من الطقوس والانتماءات الجماعية. فقد انتقلت النخب المنضبطة إلى تصوُّر العالم الاجتماعي باعتباره عالمًا مؤلفًا من أفراد، سواء من حيث وعيها بذاتها أو من حيث مشروعها من أجل المجتمع.
يُثير هذا النوع من التأويل التاريخي المترامي الأطراف إشكالًا. وهو إشكال أدركته، فعلًا، عند مناقشة أطروحة ماكس فيبر حول تطوُّر الأخلاق البروتستانتية وعلاقتها بالرأسمالية. وفي الحقيقة لا أختلف كثيرًا معه في هذا الشأن، إذ يؤكد على التحديد الأوسع نطاقًا لتلك العلاقة، الذي يعنيني هنا بالدرجة الأولى. ويقينًا يُعتبر فيبر أحد أهم المرجعيات التي أعتمدها هنا.
هناك اعتراض على أطروحة فيبر يقول بعدم إمكانية التحقق منها لغياب صلات واضحة بين الانتماءات الطائفية وتطوُّر الرأسمالية. وعادة ما يكون أثر هذا النوع من العلاقة بين وجهة النظر الروحانية والأداء الاقتصادي والسياسي غير مباشر، بل شديد الضبابية. وحين نعتقد حقًا وفق أكثر صيغ الماركسية ابتذالًا أنه يمكن تفسير كل تغيُّر عن طريق عوامل غير روحية، كالحوافز الاقتصادية مثلًا، بحيث تكون التغيرات الروحية تابعة، فإن هذا يصبح غير ذي معنى. ولكن في الحقيقة، فإن العلاقة أكثر حميمية وتبادلية بكثير، من ذلك أن بعض الصيغ الأخلاقية لفهم الذات منغمسة في بعض الممارسات وهذا معناه أنها تتعزَّز وتزداد بفعل انتشار هذه الممارسات أو أنها تشكلها وتساهم في تأسيسها. وبالمثل من العبث، الاعتقاد في أولوية الممارسات دائمًا، أو تبنّي وجهة النظر المناقضة التي تقول بأن الأفكار هي ما يقود التاريخ ويحركه بشكل ما.
لكن هذا لا يمنعنا على المدى البعيد من بناء أحكام معقولة في ما يخص العلاقة بين بعض أنماط المؤانسة وبعض التقاليد الروحية. فإذا كانت الأنماط الأنغلو-سكسونية من المشاريع الرأسمالية أقل ارتباطًا بكثير بالعلاقات الأسرية بالمقارنة بالأنماط الصينية على سبيل المثال، وهذا ما لا سبيل إلى إنكاره فيما يبدو([20])، فهل يعني ذلك أن لا علاقة لها بالاختلاف بين التصوُّر البروتستانتي للعضوية الفردية في الكنيسة ومركزية الأسرة في الديانة الكونفوشيوسية؟ هذا ما لا يمكن تصديقه، على ما يبدو، حتى لو تسنى لنا تقصي كل الروابط في أدق تفاصيلها.
وبطريقة مماثلة تحاول أطروحتي ربط الأولوية التي لا شك فيها للفرد في الثقافة الغربية المعاصرة، وهي سمة مركزية في التصور الحديث للنظام الأخلاقي بالمحاولات الراديكالية السابقة لتحويل المجتمع وفق مبادئ الروحانية المحورية، أو بعبارة أخرى تقصي كيفية تنامي فهمنا المعاصر للذات.
قد يبدو من السهل اعتبار أن هذا التقصي الجنيالوجي لا طائل من ورائه بالنظر إلى هيمنة قصص الطرح. وقد اكتسبت تلك القصص قوَّتها منذ أن أصبحت الفردانية أمرًا بديهيًا. وهذا خطأ ارتكبه المحدثون نتيجة فرط استكانتهم إلى هذا الفهم للفرد كفهم مفروغ منه، وبوصفه فهمنا “الطبيعي” للذات. ومثلما يعتقد في الأبستمولوجيا الحديثة أن الوصف المحايد للأشياء يسبق “القيم” التي “نضفيها” عليها، فإننا نعي ذواتنا أولًا بوصفنا أفرادًا قبل أن نعي الآخرين من حولنا، وقبل أن نعي أشكال الاجتماع. ومن ثم يصبح من السهل علينا أن نتبيّن نشأة الفردانية الحديثة عبر نوع من قصة الطرح: فقد تآكلت الآفاق القديمة وذوت محترقة، وظهر من تحتها المعنى الكامن لذواتنا بوصفنا أفرادًا.
إن الفكرة التي أقترحها هنا، خلافًا لذلك، مفادها أن تصوُّرنا الأولي لذواتنا منغمر بشكل جذري في المجتمع. حيث هويتنا الجوهرية هي هوية الأب والابن، وما إلى ذلك، أو العضو في قبيلة. ولم يتسنَ لنا وعي ذواتنا كأفراد أحرار أولًا إلا في حقبة متأخرة. ولم تكن هذه مجرد ثورة في نظرتنا الحيادية إلى ذواتنا، بل كانت تشتمل أيضًا على تغيير عميق في عالمنا الأخلاقي مثلما يكون الأمر دائمًا عند تحوُّلات الهوية.
هذا يعني أن علينا هنا أيضًا أن نميِّز بين نمط صوري وآخر مادي من الانغمار الاجتماعي، وذلك بحسب الوجهين الأولين اللذين أتيت على ذكرهما أعلاه. ففي مستوى أول، نحن منغمسون اجتماعيًا على الدوام، حيث نتعلم هوياتنا في الحوار ومن خلال انخراطنا في لغة معينة. أما على مستوى المضمون، فما نتعلمه هو أن نكون أفرادًا وأن تكون لنا آراؤنا الخاصة بنا، وأن نقيم علاقتنا الخاصة مع الله، وأن نخوض تجربتنا الإيمانية الخاصة.
هكذا يكون الانعتاق العظيم بمثابة ثورة في تمثلنا للنظام الأخلاقي-الاجتماعي، ويمضي قدمًا مدعومًا بأفكار النظام الأخلاقي. وأن يكون المرء فردًا لا يعني أن يكون روبنسون كروزوي Robinson Crusoe، بل أن يحتل موقعًا ما بين أناس آخرين. وفي ذلك انعكاس للضرورة المتعالية للقدسية الكونية التي أشرت إليها.
لقد أعتقتنا هذه الثورة من المقدس الكوني بشكل كامل وليس جزئياً فحسب، ولا مقتصرًا على بعض الأشخاص خلافًا للتحوُّلات المحورية السابقة. كما أعتقتنا من المقدَّس الاجتماعي وأسست لعلاقة جديدة بالله بوصفه الخالق المصور. وهذه العلاقة الجديدة أصبحت، في الحقيقة، لا غنى عنها، حتى إنه يمكن اعتبار أن خطة الخلق الكامنة خلف النظام الأخلاقي وُضعت من أجل ازدهار الناس العاديين. لقد تمّ إبطال هذا الوجه المتعالي للثورة المحورية على نحو جزئي، أو أنه يمكن إبطاله تمامًا، بالنظر إلى الفصل الدقيق بين خير دنيوي وخير دنيوي آخر. لكن ذلك حدث جزئيًا فقط لأن مفاهيم الازدهار تخضع للرقابة في نظرتنا الأخلاقية الحديثة، إذ عليها أن تتلاءم مع متطلبات النظام الأخلاقي نفسه، متطلبات العدالة والمساواة وعدم الهيمنة إن كان لها أن تنجو من الإدانة. وهكذا فإن مفاهيمنا عن الازدهار قابلة دائما للمراجعة. لأنها تنتمي إلى وضعنا بعد المحوري.
بقدر ما عزَّزت المسيحية هذه المرحلة الأخيرة من الانعتاق العظيم وأعطتها زخمًا قويًا، بقدر ما “أفسدتها” أيضًا، بمعنى ما، بحسب عبارة إيفان إيليتش Ivan Illich الخالدة([21]). عززتها لأن الإنجيل هو بدوره انعتاق، وكنت قد ذكرت في ما سبق الدعوات للقطع مع أنماط التضامن القائمة. لكن هذا المتطلب كان حاضرًا بقوة أكبر في قصص مثل قصة السامري الصالح كما يوضح إيليتش. وإن كان ذلك تلميحًا، فإنه مضمر في القول، بحيث لا يمكن أن تخطئه العين. لو أن السامري التزم بالمتطلبات التي تفرضها الحدود المقدَّسة للمجتمع، ما كان أبدًا ليتوقف لإغاثة اليهودي الجريح. وهكذا فمن الواضح أن ملكوت الله يشتمل على نوع مختلف تمامًا من التضامن: نوع يقودنا إلى شبكة الحب الإلهي.
وهنا مكمن الفساد: لم يكن ما كسبناه شبكة من الحب الإلهي، بل كان مجتمعًا منضبطًا تحظى فيه العلاقات القطعية المطلقة، وبالتالي معايير وقواعد السلوك، بالأولوية. وعلى الرغم من ذلك فقد بدأ الأمر كله بمحاولة جديرة بالثناء لمواجهة متطلبات “العالم” وإلى إعادة بنائه بعد ذلك. فكلمة “العالم” (كوسموس) في العهد الجديد يمكن أن تحمل، من جهة، معنى إيجابيًا، وذلك كما في قوله “هكذا أحب الله العالم” (إنجيل يوحنا 3-16)، ومن جهة أخرى، يمكن أن تحمل معنى سلبيًا: لا تحكم مثلما يحكم العالم. يمكن فهم هذا المعنى الأخير لكلمة “العالم” على أنه نظام الأشياء المقدَّس وانغماره في الكون([22])، وبهذا المعنى تكون الكنيسة حقًا على طرفي نقيض مع العالم. وهذا ما كان واضحًا في موقف هيلدبراندHildebrand عندما دافع من أجل أن تبقى مسألة تعيين الأساقفة خارج دائرة السلطة الجامحة، حيث الاندفاع والطموح لدى الأسر الحاكمة أثناء نزاع التنصيب.
من الواضح إذن أن على المرء البناء على هذا النصر الدفاعي مع محاولة تغيير ميدان السلطة في “العالم” وتطهيره وجعله أكثر انسجامًا مع تعاليم الروحانية المسيحية. لكن، طبيعي جدًا، أن هذا لم يحصل دفعة واحدة. وإنما نتيجة تحوُّلات متراكمة، فالمشروع كان منذ البدء يتجه إلى الأمام بشكل مستمر وبأشكال أكثر جذرية عبر الإصلاحات الكثيرة والمتعاقبة وصولًا إلى عصرنا الحالي. وسواء تعلق الأمر بتحوُّل على نحو ما إلى شيء مختلف تمامًا وبمعنى آخر، مختلف نسبيًا، رغم ما يثيره ذلك من مفارقة، فقد انتصر “العالم” في نهاية المطاف. ولعلّ التناقض يكمن في صميم فكرة فرض الانضباط في ملكوت الله. لقد كان إغراء السلطة شديدًا جدًا في حقيقة الأمر، وهو ما نبَّه إليه دوستويفسكي في أسطورة المحقق العظيم، وهنا مكمن الفساد.
لننظر الآن في الكيفية التي تكشّف بها الانعتاق العظيم في متخيلنا الاجتماعي الحديث.
الهوامش:
([1]) Robert Bellah, «Religious evolution» in: Beyond belief (New York: Harper and Row, 1970), chap 2.
([2]) Godfrey Lienhardt, Divinity and Experience (Oxford: Oxford University Press, 1961), pp 233-235.
([4]) Robert Bellah, “What is Axial about the Axial Age?” in Archives européennes de Sociologie 46 (2005), no. 1, pp. 69–89.
يُقدِّم بيلا الملاحظة نفسها حول ما يسميه “الديانة القَبَلية”: “تفترض الطقوس في المجتمعات القبلية مشاركة جميع أو معظم أعضاء الجماعة” (69). ويقارن بين هذه المجتمعات القبلية و”المجتمعات القديمة”، التي عرفتها الدول الكبرى التي نشأت في العالم القديم وهيمنت على العديد من المجتمعات الصغيرة ذات العلاقات الأفقية. وقد تمركزت المجتمعات التراتبية وطقوسها الأساسية حول الشخصيات المهمة والملوك أو الكهنة. بينما واصلت طقوس المجتمعات الأفقية، الاهتمام بالقاعدة، حسب بيلا، حتى عصرنا هذا. لقد استفدت كثيرًا بالدرجة الأولى من التحليل الثري لروبرت بيلا في مقاله “التطور الديني” “Religious Evolution”، الموجود في مجموعته ما وراء الإيمان Beyond Belief. ثم مؤخرًا من المقال المذكور أعلاه. إلا أن التباين الذي أريد أن أكشف عنه في هذا الفصل هو أبسط بكثير من سلسلة المراحل المتعاقبة التي حددها بيلا. فالحقبة “القبلية” والحقبة “القديمة” تنصهران في فئتي الديانة “البدائية” أو “ما قبل المحورية”. وغايتي هي تسليط الضوء على الانعتاق العظيم في الصيغ المحورية.
([5]) انظر الفصل الثالث من Roger Caillois. L’homme et le sacré (Paris: Gallimard, 1963).
تناولت مناقشات كثيرة هذه السمة من سمات الديانة الأصلي في أستراليا، انظر،
Lucien Lévy Brühl: L’expérience mystique et les symboles chez les primitifs (Paris: Alcan ,1937), p.180; Caillois, l’homme et le sacré, pp.143-145, W.E.H Stanner, «On Abobiginal Religion» A Séries of six Articles, Oceania, vol.30-31(1959-1963).
([6])وقد لوحظت العلاقة نفسها مع الأرض لدى شعب أوكاناغان في كولومبيا البريطانية. انظر،
Jerry Mander and Edward goldsmith, The case against the global Economy (San Francisco: Sierra club Books, 1996), chap.39.
([7]) Jon Stuart Mill «On liberty», Three essays (oxford: oxford university press 1975), p.77.
S.N. Eisenstaedt, ed; The Origins and Diversity of Axial Age civilization (Albany: state university of New York press,1986).
([9]) Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (Zurich: Artemis1949).
أريد من خلال استخدام مصطلحي “محوري” و”بعد محوري” أن أجد عبارة أستطيع من خلالها التمييز بين شكلين مختلفين تمامًا من الحياة الدينية، الأول أقدم بكثير من الثاني من دون أن أكون متفقًا تمامًا مع ما يعنيه كارل ياسبرز بذلك. فلا أملك رأيًا باتًا في خصوص تحديد “عصر محوري” معيّن حدثت فيه تغيّرات مهمّة في الآن ذاته في حضارات متباعدة أكثر أو أقل. وقد مثلت مسألة طبيعة هذه التحولات الكبرى في الآونة الأخيرة محور اهتمام العلماء من جديد بالتوازي مع الانهمام المتجدد بتحديد تنوع العادات والتقاليد الحضارية بعد فترة طويلة من العقم حيث كان المفكرون الغربيون مفتونين بفكرة استثنائية تقول بأنه لا وجود إلا لمسار واحد من “التقليدي” إلى “الحديث” يتعيّن على كل المجتمعات أن تكون قد قطعته. ولكن بعضها أسبق من بعض. انظر على سيبل المثال،
Johann Arnason, S. N. Eisenstadt, and Björn Wittrock, Axial Civilizations and World History (Leiden: Brill, 2005).
ليس غرضي أن أتخذ موقفًا في صلب هذا السجالات على أهميتها القصوى كالسجال بين آيزنشتات Eisenstadt وفيتروك Wittrock حول مسألة معرفة أيّ التغيّرات كانت مصيرية من بينها جميعًا بالنسبة لما حصل من منعطفات. وقد عددت أهم الاختلافات بين العصر ما قبل المحوري وما بعد المحوري بحسب أغراض هذا الكتاب.
([10])Francis Oakley, Kingship (Oxford: Blackwell, 2006), p. 7
وأعتقد أن بيلا يطرح بأكثر عمق مشكلة مماثلة في مقاله الأخير “ما هي المحورية؟” (“? What is Axial”) حيث يقول: “كل الديانات، قَبَلية كانت أو قديمة ذات طابع كسمولوجي على اعتبار انصهار الخارق للطبيعة والطبيعة والمجتمع، في كوسموس واحد” (ص 70).
([11])Oakley, Kingship, pp. 50–57.
انظر أيضًا Rémi Brague, La Sagesse du Monde (Paris: Fayard, 1999), pp. 219–239.
([12]) Cho-Yun Hsu, “Historical Conditions of the Emergence and Crystallization of the Confucian System”, in S.N. Eisenstadt, ed., Axial Age Civilizations, pp. 306–324.
([13]) في هذا الاتجاه، أتفق مع صياغة صموئيل آيزنشتات لأحد التغييرات الرئيسة في الفترة المحورية “نشأة ومفهمة ومأسسة التوتر الأساسي بين المتعالي والأنظمة الدنيوية”. وبطبيعة الحال، يتغيَّر نظام “المتعالي” نفسه عندما ينشأ التوتر،
- N. Eisenstadt, ed., Axial Age Civilizations, p. 1.
([14]) Staner «On Aboriginal Religion» Oceania, vol. 30, no. 4 (June 1960), p. 276, and «the Dreaming» in W. Lessa and E.Z. Vogt, eds, Reader in Comparative Religion (Evanston, IL: Row Peterson, 1958), pp, 158-167.
([15]) Staner «On Aboriginal Religion» Oceania, vol 33, no. 4 (June 1963), p. 269.
([16]) انظر Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde (Paris Gallimard, 1985), chap. 2. وفي ذات السياق يؤكد بيلا على أهمية هذه “المجتمعات القديمة” في مقاله , p. 70″What is Axial?”.
([17]) Louis Dumont: «De l’individu-hors-du monde l’individu-dans-le monde», Essais (13) sur l’individualisme (paris: seuil, 1983).
([18]) أريد أن آخذ بعين الاعتبار تحفظات تمبياه ستانلي Stanley Tambiah بشأن عبارة دومون Dumont “الفرد خارج العالم” في ما يتعلق بالناسك البوذي. انظر،
- J. Tambiah, “The Reflexive and Institutional Achievements of Early Buddhism”, in S. N. Eisenstadt, ed., Axial Age Civilizations, p. 466.
إن الزاهد البوذي The bhikkhu خارج “العالم”، بحسب معنى حياة المجتمع-المنغمسة-في الكوسموس-وفي الآلهة. لكن هذا لا يمنع وربما يجعل لا مفر من (أ) نوع جديد من الاجتماعية مفتوح أمام جميع النساك (السانغما)، و(ب)علاقات تكامل بين النساك وبقية الناس داخل العالم يمكن من خلالها لهؤلاء (الناس) أن يشاركوا في ما يسعى إليه النساك مباشرة (“الجدارة”) أو (رغم أن ذلك يظهر كانزياح) يكمن من خلالها أن توجه القدرة الروحية للكهنة إلى غايات الناس غير المتدينين في الحياة العادية.
([19]) الفصل الثاني المقطع الثالث.
([20]) Fukuyama, Trust (New York: Free Press, 1995).
([21]) Ivan Illich, The Corruption of Christianity, publication of the Canadian Broadcasting Corporation in the Series “Ideas”, January 2000. See also The Rivers North of the Future: The Testament of Ivan Illich, as told to David Cayley (Toronto: Anansi, 2005).
سأعود إلى مسألة “الفساد” هذه في الفصل الأخير.
([22]) René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair (Paris : Grasset 1999).