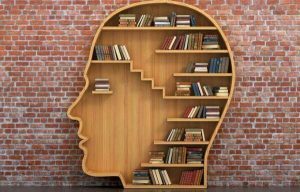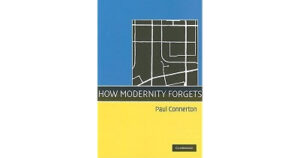| الكاتب | جواد ايت سليمان |
تجربة الخلوة: الكتابة كمعاناة.
“أن تكتب يعني أن تكون وحيدا لكن..”
مقدمة
في المساء وحيدة، ترغب في الكتابة، فتُغلق النوافذ، تدخّن وتشرب بإفراط، لكن الأحداث تتنطع عن التدفق بليونة على مكتبها الخشبي، تجلس فتنهض قائمة، تتمشى عشوائيا في فناء الغرفة كأنها تدور في فراغ، تحدّث نفسها: أريد أن اكتب شيئا ما لكن الأفكار والشخصيات التي أودُّ أن أحكي عنها تهرب مني، كما يهرب سراب الماء من عين العطشان في صحراء قاحلة، “لقد هجرتني لتعيش في حياة أخرى(..) رحلوا وانتظر الآن عودتهم.” تهيم بها مُخيلتها إلى عوالم مُفارقة من دون أن تتمكن من الوقوف على أرض صلبة. في ظل وقْع هذه المتاهة العجائبية، تنبلج فجأة أحد الأسئلة الحارقة: متى نحكي؟ هذا سؤال قديم جديد، كان ولا يزال محط كتابات عديدة ناولته حدَّ الإطناب. لربما يكمن السر في الزمان والمكان، أن نختار الجو المناسب للكتابة وأن نعرف متى نبدأ – وهذا هو الّمهم- في الوقت المناسب!
أتاحت لها مكالمة هاتفية مفاجأة من أحد صديقاتها بالسفر إلى إيطاليا والإقامة في متحف مُخصّص “للفن الحديث” يتواجد في جمارك بحر البندقية (ايطاليا) لمدة ليلة كاملة. يبدو في الغالب أن هذا الليلة البعيدة عن المنزل، ستكون حافزا مشجعا على ممارسة الحكي عبر استنطاق أفكارها المسكوت عنها التي قد تبدو للقارئ أنها تدخل ضمن الطابوهات المحظورة! أن يكون عنصر إلهام يفتح الشهية على الخوص في متاهات الذاكرة وعرضها على مسرح الحاضر، لأن الأدب مثل الفن، لا يعرف زمن الحياة اليومية المعاشة، لا يهتم بالحدود بين الماضي والحاضر، فهو يستشرف المستقبل ويعيدنا إلى الغابات الصافية للطفولة.
عندما نكتب، الماضي، لا يموت(..)[1] تشجيع المُخيّلة على كتابة شهادة خاصة سيكون لا محالة هو الهاجس الأول من وراء هذه الكتابة الحمراء، لكنها شهادة بطعم الاعتراف. عن أي شيء؟ سيرتها الذاتية مثلا. أليست الكتابة عموما هي أن نقضي حياتنا في البحث المتواصل لتملُك القدرة على قول “أنا”؟
- مقاربة في شعرية التصوف

- كيف تقرأ كافكا (الجزء الثاني)

- قَصّ أثر الدابة بين الفراسة وفنّ التّحرّي: دراسة مقارنة في خبر أبناء نزار بن مَعَدّ بن عدنان مع أشباهه في الآداب الأخرى

ليلى السليماني والكتابة
في عزلة ليلية تامة، تسرد ليلى السليماني[2] الكاتبة والصحفية الفرنكفونية، ظروف كتابة رواياتها الأولى[3] تعود إلى الوراء، لاستذكار أرشيف الأحداث والوقائع الحية والدفينة وتحريضها للخروج من سراديب النسيان ونقلها إلى طاولة الحاضر، ينتابها إحساس غريب في هذه اللحظة بأنها خارج حدود الزمن، يتساوى فيه الواقع بالخيال وينساب كل واحد منهما في الآخر، كمتصوّف يعيش تجربة الفناء كتجربة روحانية فريدة، تمليها الرغبة في الوصول إلى أسمى مقامات المعرفة لإلهية.
نفس التجربة رغم تمايز المقام، حيث تشعر الكاتبة أن وحدتها مكّنتها من نسج علاقة وجدانية وروحية مع الأشباح وظلالها وكذا طفولتها وعشقها لعزلتها وشخصيات الأعمال الفنية التي تحتل كل جدران المتحف، تشعر بهم، كأنهم كائنات حية تخاطبها ويخاطبونها من موقعهم الزمكاني، عندما نكتب تحدث لحظات خارقة للطبيعة تقريبًا، حيث يختلط الخيال بالواقع أو تتجسد الشخصيات بطريقة نفرح بها وتخيفنا كذلك كما لو كنّا نرسم الآثار التي خلّفها الموتى لإعطاء معنى للحياة[4] لكن هل هذا فعل إنسان أراد أن يبدأ صفحة جديدة من حياته بالمبيت وحيدا في متحف؟
لكي تكتب، تقول ليلى السليماني في سيرتها الذاتية قيد الدراسة والمعنونة ب (le parfum des fleurs. La nuit / رائحة الزهور ليلا)[5] : “عليك أن تنكر نفسك للآخرين، تحرمهم من حضورك، حنانك، تخيب ظن أصدقائك وأطفالك، أجد في هذا الميدان(الكتابة) سببا للرضا أو حتى للسعادة والسبب في حزني أيضا” يظهر التاريخ من جهة أخرى، أن أغلب من قاموا بعمل عظيم، كتابة كانت أو إنجازا يستحق الإشادة، قضوا حياتهم في عزلة، أدباء كانوا أو فلاسفة، من أرسطو إلى ديكارت وشوبنهاور إلى نيتشه وهايدغر(فيلسوف الغابة السوداء) فضلوا ممارسة طقس الكتابة في عزلة صامتة بعيدة عن عالم اليومي، في غابة أو جبل، كما هو الحال بالنسبة لنيتشه الذي يقول على لسان نبيه زرادشت: “إن مملكتي ليست من هذا العالم فلأذهبن مفتشًا على جبال جديدة.”
أو في منزل منزو في أحد الأصقاع البعيدة، هي شروط عامة يقتضيه فعل الكتابة كعمل مرهف الحساسية، يتطلب استبطانا ذاتيا أكثر منه رغبة في الانغماس في وجود الآخرين، أن تكتب يعني أن تكتشف حرية خلق ذاتك واكتشاف العالم، بعيدا عن الجميع وبمعزل عن وجودهم. أليست الوحدة هي مصير الأرواح العظيمة التي تبحث عن بعض الرّاحة وسط عالم يتفجر بعيونٍ من القلق والتفاهة؟
يبدو في كثير من الأحيان أن الهدية الثمينة التي قد يقدمها رفاقنا من البشر؛ أن يضمنوا لنا مسافة من الخلوة، لاكتشاف الذات والعالم من زاوية نظر مغايرة لما تتيحه لنا حياة الواقع المعاش(..) هي نفسها المسافة التي مكنت العديد من الكتاب العظام كتشيخوف و دوستويفسكي وتولستوي وكافكا من بناء قراءة جريئة وجديدة للحياة والواقع.
تقول مـتأثرة بتجارب وكتابات هؤلاء الأدباء “العدو الأكبر للكاتب هو الهاتف والضيوف” هي رغبة في العودة إلى الإنسان الأول قبل أن يفقد ذاتيته ووجوده الأصيل، أي قبل أن يغترب ويغرق كليا في عالم الآخرين، ويخضع لشروطهم وقواعدهم التي تحرم هذا الفرد من الانفراد بذاته أو أن يكون كائنا لذاته L’être-pour-soi تعد ” الدردشة- مع- الهم (الآخرين)” في هذه الوضعية كما تذهب إلى ذلك ليلى السليماني “العدو الأول للكاتب” ينبغي أن نكون صامتين، وأن نلجأ إلى صمت عنيد وعميق، إذا التزمت الصمت المطلق، فيمكنني أن ازرع الاستعارات والرحلات الشعرية مثل زراعة الزهور في البيوت البلاستيكية. ألا يمكن أن يعبر هذا العشق للوحدة علامة على الخوف من عالم الخارج؟ خوف مرضي له رواسب قديمة تعود لمرحلة الطفولة مثلا؟
لعبة الداخل والخارج:
"بالنسبة لي الخارج هو الذي يخيفني، إنهم الآخرون، عدوانيتهم، لم أكن خائفة أبدا من الشعور بالوحدة."
بين الرباط وباريس تبدأ الحكاية، بين ما هو غائب هنا ومتاح هناك، بين أمور عديدة تحسم الاختلاف، بين شمال المتوسطي وجنوبه، تحكي الكاتبة عن طفولتها في الرباط وفترة مراهقتها في باريس، في المغرب الطفولة، في ظل لعبة الداخل (الآمن/ المنزل) والخارج المفتوح على كل المخاطر، تقول:
"ليس الليل وحده هو المنطقة المحظورة، إنه الخارج عموما، الفتيات ليس لديهن ما يفعلن في الشوارع، في الأماكن العامة، في المقاهي، على الأرصفة، كنت أتذكر، أنهم لم يكونوا مشغولين إلا بالرجال، الفتاة يلزم أن تنتقل من نقطة أ إلى نقطة ب. وإلاّ فهي عاهرة، وقحة، فتاة تائهة. المخاطر متنوعة: كأن تصبح حاملة، أن تقع في الحب، ترى نتائجها الدراسية تتدهور تحت تأثير مشاعرها العاطفية(..)[6]
يتطلب اكتشاف عالم الخارج جرأة مدفوعة بتحمل كل النتائج والتبعات. النساء هنا كائنات- مكانية محكوم عليهم وفق شروط مركبة وقوانين لا-مرئية من خطر اقتحام عالم الخارج بأريحية، من اللازم في هذه الحالة اتخاذ الكثير من الحيطة والحذر حين تغادر جدران المنزل، لو كنت في حانة مثلا، يجب أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي أي مضايقات ممكنة حتى تلك التي تبدو بسيطة وتافهة، كأن تمتلك قدّاحة خاصة، لقد أخبرني نادل الحانة سرّا:
"يجب أن تكون لديك قدّاحتك الخاصة، إذا طلبت شعلة نار من رجل، سيعتقد أنك ترغبين في الدردشة معه، سيحس انه من حقه تخديرك، أنت لا تريدين أن تكوني موضع إحراج، وعليه، إذا كنت تُدخنّين، فعليك دائما أن تحضري معك قداحة."[7]
تتساءل الكاتبة مع نفسها، كفتاة يافعة، يتملكها بحكم سنها رغبة عارمة في اكتشاف العالم من حولها، تتبادل أطراف الحوار مع نفسها على نحو مايوتيكي: أنا دوما خائفة من هذه القوقعة التي تخنقني مقابل أن تضمن لي عيشا مطمئنا مُؤمّنا من المخاطر، تقنعني بالبقاء في مكاني دون تطلع إلى ما يحيط بي من عوالم مختلفة، في حضور مثل هذا الوصاية الفوقية تنتفي قدرتي على اقتحام المجهول وتكوين فكرة خاصة عنه(..) من جهة أخرى، سيكون الأمر مختلفا في باريس، حيث ستكتشف الكاتبة معنى الخروج من هذه الصدفية المتحجرة التي أقحمتها فيها مجموع تلك التصورات والرؤى النمطية التي حيكت تاريخيا وثقافيا حول وجودها كأنثى في مجتمع بطريكي-أبوي. لكن هل سيكون الوضع متشابها في الضفة الأخرى من المتوسط؟
- النظرية الاجتماعية اليوم: حوار مع هارتموت روزا

- في ظلال الغد

- مذبحة العرفاء: مآلات التصوف والعرفان في المجال الشيعي

بين جنوب المتوسط وشماله، القدر التاريخي والجغرافي، كأبناء للعالم المتوسطي، تحاصرنا أسئلة ثقافية مُحيّرة، نبحث مع الكاتبة سبب هذه الغرابة التي جعلتنا اليوم نعجب بأشياء تخصهم(الغرب) نحبها ونتطلع إليها لكننا نكره أو نتوجس من ضريبة نتائجها، أمسيا في ظل هذه الحالة نعيش بشخصيات مرضية- سكيزوفرينية، رغبتنا في الحرية تدعونا إلى التفكير جديا في مسألة التحرر وباحتراس!
هذا ما رسب في خاطرها وهي تقارن التجربتين معا، تجربة العيش هنا وهناك، ترفض الكاتبة مبدئيا نعتَ المنفى، باعتبارها مهاجرة أو نتيجة شروط ظرفية قادتها لشمال المتوسط، إلى فرنسا خصوصا، في الواقع، دوما ما يكون سؤال الانتماء l’appartenance ملازما لسؤال الهوية، يطرح علينا هذا السؤال في صيغة من أنت ومن أين أتيت! هو سؤال قَبلي (قبيلة) يركز حصرا على الخصوصية والفردانية الهَووية، على العصبية إن نحن- شئنا- استعمال المفهوم الخلدوني، الذي يُعبر به عن رابطة الدم التي تشكل أساس بناء الهوية القبلية لجماعة ما (النحن) وبالتالي نجد أنفسنا هنا أمام إشكال فلسفي جد معقد: كيف تُحدّد الهوية، هل بالمعنى التقليدي الذي يربطها بالانتماء الدموي لقبيلة أو لبلد ما-أم بما هو كوني Universel بحيث تصبح كل الهويات الثقافية كلا من جزء، العنصر الأعمق والأكثر شمولية؟
تقرأ ليلى السليماني هذا الإشكال على ضوء الأدب، وترى أن انتماءها لا يحدده وجود أصل ثابت كقطعة لحم أو كأس نبيذ معروف المصدر، وأنّ ما يُحدد جنسية هوية كائن ما هو التاريخ، والطفولة، والمشترك(..)هي التي تعتبر نفسها في كل لحظة تأمل كائنا-متعددا ينتمي للعالم ككل، تقول:
لقد وجدت في باريس كل ما كنت أطمح له، الجلوس مطولا على رصيف مقهى، لشرب نبيذ، أو للقراءة والتدخين.[8]
الهوية إذن حسب هذا الطرح هوية كوسموبوليتية[9] لا تتحدد بما خلف بل بما سيأتي هنا ومستقبلا، هي ليست قابعة في ماض سحيق أو خالص، أو ضمن خلفية سياسية أو ثيولوجية مقدسة يغذيها صراع وصدام حضاري نراه كمسوّغ مشروع نفرح بموجبه لأحزان الآخر ونحزن لأفراحه(..) في السياق ذاته، يروي أمين معلوف عن تجربته في بلاد المهجر قائلا:
منذ أن غادرت لبنان للاستقرار في فرنسا، كم من مرة سألني البعض عن طيب نية إن كنت أشعر بنفسي "فرنسياً" أم "لبنانياً". وكنت أجيب سائلي على الدوام: "هذا وذاك!"، لا حرصاً مني على التوازن والعدل بل لأنني سأكون كاذباً لو قلت غير ذلك. فما يحدد كياني وليس كيان شخص آخر هو أنني أقف على مفترق بين بلدين، ولغتين أو ثلاث لغات، ومجموعة من التقاليد الثقافية"[10]
كسائحة تتواجد في البندقية، تتأمل الكاتبة أحوال “المدينة العائمة” خصوصا الديوان الجمركي باعتباره قناة تواصل منفتح على كل العالم كمركز دبلوماسي ومركز متعدد الوظائف، للتبادل الاقتصادي والتلاقي الثقافي بين مختلف الشعوب إذ يصبح من الصعوبة في هذه الحالة تحديد هوية ثابتة للمكان أو موضعته في إطار ثابت معين.
وعليه، نحن أصبحنا اليوم نعايش عصر تصدّع الكينونات المغلقة تحت ثقل نموذج هَووي كوني ينقلنا من الذات إلى الآخر، أو كما صرّح الشاعر “ارتور رامبو”: “الأنا هي آخر” بذلك سيكون سؤال “من نحن؟” هو سؤال “من نصير”؟ الزمان كصيرورة ما تفتأ تلقي بهويتنا خارج مدى الماضي لتضعها في أفق المستقبل، سؤال أصيل لأنه يفترض أننا لم نعد ما كناه ولن نكون ما نحن عليه.[11]
في ظل طفولة مليئة بالتناقضات إذن بين عالمين يقيم كل واحد منهما على طرفي النقيض، عالم الخارج، المرعب والمرغوب في الآن ذاته، والداخل، الآمن والمُراقب، تعيش الكاتبة وقع حيرة غير مفهومة، ضريبة كل واحدة منهما مختلفة ومتمايزة عن الأخرى، حيرة اختيار المكان المناسب والأفضل، هل نختار الأمان أم المخاطرة! تتساءل ليلى السليماني مع نفسها ببرودة قاتمة: لماذا تريد أن تفتح بابا لن يأتيك منه غير الوجع وصداع الرأس!
“المنزل هو الجحيم، أمّا الشارع (الخارج) فهو مرادف للحرية والتحرر، التحرر يستلزم الهروب إذن(..)” تتذكر ليلى السليماني سياق هذا القول، في لحظات دراساتها الثانوية التأهيلية، عندما كان يدرّسها أستاذ فلسفة، يبدو لها دوما على أنه يشكل شخصية فريدة، نموذج خاص ومتميز عن الآخرين، شكلا ومضمونا، يدّخن أثناء الفصل، يلقن دروسه في حديقة المؤسسة، تستطرد ليلى السليماني في استحضار ما علق في ذهنها من دروسه الهاربة من عقال التقنين.
كان يشرح لنا أن وجودنا يقتضي لزاما “الخروج من الذات” لضمان التفرد/ الفردانية d’individualité ينبغي الهروب من كل الإطارات التي تحتجزنا، والتي تعمل على أن تجعلنا نعيش وهم “دائرة الامان” يجب توخي الحذر من ” رقة القلب” وأن تختار في مقابل ذلك، أن تكون متجولا، مشاءً هائما، مسافرا شاملا.
وقع هذه الكلمات شكلّت شرارة حارقة أيقظت مخيلة الكاتبة على طرح أسئلة عن وجودها وعن وضعيتها كامرأة تحت الوصاية، مثلتها وعلى الدوام كتلة من التنبيهات والتحذيرات العائلية والتي تأخد في الغالب طابعا عاطفيا وثقافيا، لقد تربيت على يد أم قلقة تنصحني دوما “احذري!” أمّ ترى الخطر في كل شيء.
من زواية أخرى مختلفة، ينبع إحساس داخل نفسية الكاتبة تظهر لها هذه الأوامر الفوقية بمثابة تعبير صارخ عن قيم مَرضية وخطيرة منافية للحياة تعزّز فعل الشفقة pitié كفعل دنيء يلغي الحياة لصالح قيم ارتكاسية تشجع على الاستسلام والعودة إلى الوراء، يخسر الإنسان، كما يرى الفيلسوف نيتشه عندما يشعر بالشفقة كمّا من الطاقة، وتتضاءل لديه طاقات الأحاسيس الحياتية، تصرّح بجسارة: كم أحب الناس الذين يقولون: “أنا لست خائفا من أي شيء” أنا متأثرة بمن يملكون شجاعة جسدية ونفسية، الذين لا يخشون الصراع، الذين لا يركضون في منتصف الشارع في قبضة ذعر غير مفهوم.[12]
تقتبس متأثرة بكتابات عن فاطمة المرنيسي النسوية قولها:
“إذا لم يمكن بإمكانك مغادرة مكان تواجدك فأنت واحد من الضعفاء إذن“[13]
دعوة مباشرة وصريحة إلى ثورة جريئة يحدوها أمل عارم في الخروج من دائرة الصمت والخفوت والكمون إلى دائرة القول أو التعبير الأصيل. فالثبات يقتل أو هو على الأقل يعمّق من حدة قسوتنا الوجوديةّ. يسندها في ذلك عشقها للأدب والشعر، كملاذ روحي، وممكن من ممكنات السعادة، يجعلها تتسامى عن حياة اليومي المبتذلة إلى عوالم برزخية متعالية، إنه بمثابة وساطة مقدسة تربط السماء بالأرض، في الوقت الذي فشلت الخطابات الدينية في عصرنا الحديث على أن تكون منقذنا من التيه والضياع، بحكم أنه -أي الشعر- مأوى للوجود، يأوي الإنسان، ويحميه من غربة الوجود، تعّلق على الأمر بشكل طريف: لا أعرف إن كانت الكتابة ستحفظ حياتي، أريد أن أعيش دون أن أكون كاتبة، لكني لست متيقنة أنّ هذا سيشعرني بالسعادة.[14]
يتيح لنا الشعر والأدب، وفقا لهذا المنظور، طريقا ملكيا للخلاص (الأرضي) فإذا لم نعد قادرين على الإيمان بأي شيء، كما تزعم الكاتبة على لسان أحد أصدقائها الشعراء، يبقى الشعر على الدوام- لأنه لا يموت أبدا- فما يبقى- كما سيصرح هايدغر في قراءته لشعر هولدرين، إنما يؤسسه الشعراء“.
الحواشي
[1] – ليلى السليماني” le parfum des fleurs. La nuit“ (رائحة الزهور ليلا) ص 148.
[2]– ليلى السليماني Leïla Slimani) ) ولدت في 3 أكتوبر 1981 بالرباط من أم فرنسية وأب مغربي وهي صحفية وكاتبة مغربية – فرنسية، حصلت على جائزة جونكور (Goncourt) في عام 2016 عن روايتها “الأغنية الناعمة “chanson douce” تم تعيينها في عام 2018 رئيسة جائزة Inter Book وهي عضو في لجنة تحكيم مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي 2018. تقلدت منصب الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية منذ 6 نوفمبر 2017.
[3] – صدر للكاتبة مجموعة من الروايات في السابق: Dans le jardin de l’ogre – Chanson douce–Paroles d’honneur
[4] – نفس المرجع ص 107.
[5] – ” le parfum des fleurs. La nuit“ (رائحة الزهور ليلا) وتحته عنوان فرعي : “ليلتي في متحف” تحت طلب صديقة قبلت الكاتبة بقضاء ليلة داخل متحف للفن الحديث، يتواجد في جمارك بحر البندقية( ايطاليا)، في شهر ابريل من 2019، هنا ستعيش الكاتبة عالما سرياليا خاصا مليئا بالكثير من الأحداث والأفكار سواء التي تهم سيرتها الذاتية أو رؤيتها للحياة ومجموع إشكالاته المصيرية كالوجود والفن والموت والقلق ووضعها كأنثى الخ.
[6] – نفس المرجع ص 76.
[7] – نـــــفس المرجع ص 73.
[8] – نفس المرجع ص 85.
[9] – كوسمبوليتيةCosmopolite: : فكرة ذات أصول فلسفية تعني مواطَنة كونية أو عالمية، تنطلق من فكرة أن البشر ينتمون جميعا إلى مجتمع واحد رغم اختلافاتهم العرقية والثقافية والسياسية.
[10] – أمين معلوف، الهويات القاتلة، ص07.
[11] – محمد مزيان، الفلسفة وواقعة نحن ص 37.
[12] نفس المرجع ص 49.
[13] – في عام 1994، نشرت المرنيسي (كاتية وأديبة ومفكرة مغربية) كتاب “أحلام الخطيئة: حكايات طفولة الحريم”، وهي رواية شبه خيالية، وشبه سيرة ذاتية عن طفولتها. فـــــي هذا الكتاب تصف المرنيسي الحياة في الحريم في فاس في أربعينيات القرن الماضي، من وجهة نظر طفلة صغيرة. في ظل تلك الحواجز المفروضة على تنقل أو خروج النساء، إذ ترى في الأمر تعبيرا عن الضعف والجمود، في الإطار ذاته، عملت المرنيسي على تقسيم العالم إلى أقوياء وضعفاء. هنا تتحدث عن مكانة النساء ضمن هذا التقسيم الثقافي.)
[14] – نفس المرجع ص 126.