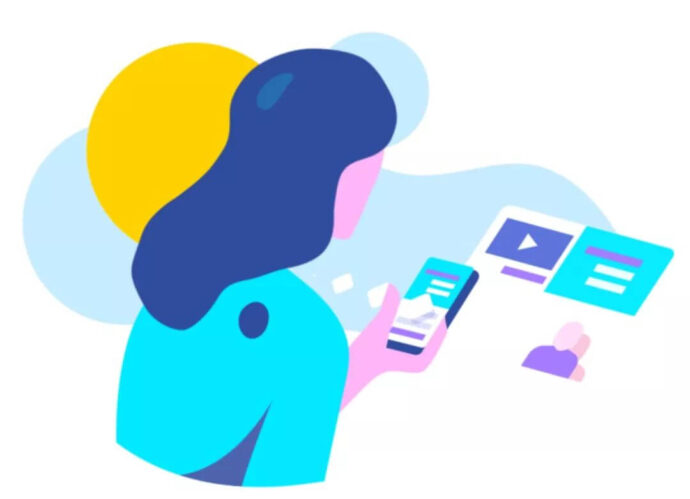كان وضع الدراسات الأدبية، منذ السبعينات، موضع سؤال نظري فعلي من زاوية الترجمة، أحد الظواهر ذات الأهمية القصوى [بالنسبة لهذه الدراسات ].
إن أغلب المختصرات الحديثة للأدب المقارن، على وجه التحديد، تخصص حيزا للترجمة وإن كان ذلك على سبيل التعريج فقط. والأمر نفسه ينسحب على المؤتمرات واللقاءات الدورية الأكثر تمثيلية. إلا أن مد الجسور بين هذه الحقول من الدراسة يتميز بنوع من عدم الانسجام. فتارة يكون المترجم هو الذي يتناول الكلمة، وتارة يكون اللساني هو الذي يرسم الحدود لما هو قابل للترجمة، وتارة أخرى يكون أستاذ الترجمة أو أستاذ الأدب المقارن هو الذي يرى نفسه معنيا باستخدام الترجمات لغايات بيداغوجية. مجمل القول، إذن، هو أن الدراسة النسقية للترجمات الأدبية وما تعلمنا إياه بخصوص الظواهر الأدبية لا يزال أمرا يجب القيام به [ لاحقا].
كيف تفسر هذه الأشكال من التردد والاختلال من لدن مبحث يزعم أن بمقدوره أن يمد جسورا بين الآداب؟ إذا صح أن ذلك يؤشر على اضطراب جوهري فسيصبح من المحتمل أن يكون لمقاربة جيدة أثر درامي يتمثل في حمل الدراسات الأدبية على إعادة النظر في مواقفها النظرية تجاه عدد لا يستهان به من المواضيع-المفاتيح.
على أن دراسة الترجمات أخذت، منذ بضع سنوات، تحتل مكانا ضمن التوجهات الجديدة في الأدب المقارن (كوشنر 1984)؛ إذ لم يرتفع عدد الأعمال، بصورة ملحوظة، فحسب، بل ظهر أيضا، وبخاصة، مجهود واضح من أجل تأسيسها بناء على خطاطات منهجية واضحة المعالم.
دراسات نظرية و/أو دراسات تاريخية:
إن أحد الأسباب الرئيسية التي هجر من أجلها مقارنو الأدب، لزمن طويل، دراسة الترجمات التي يقوم بها اللسانيون والمرتجمون، هو، من دون شك، خشيتهم من النظريات باعتبارها كذلك، وبخاصة النظريات غير الأدبية. فكون غياب النظرية يظل نظرية، أمر لم يبد لهم إلا تدريجيا.
منذ أن دشنت اللسانيات العامة انطلاقها والعديد من النظريات اللسانية تطبق على الترجمة، لتحل بذلك محل النظريات السالفة، أي نظريات المترجمين أنفسهم الذين يعتبرون أن “الترجمة فن وليست علما”؛ على أن بعض الباحثين ما انفكوا يعتقدون أن دراسة الترجمات -والآداب عموما- هي نفسها أقرب إلى الفن منها إلى “العلم”، وهو ما انبثق عنه سيل من المناظرات فيما بين 1960 و 1970 حيث كان يتقابل فيها المترجمون وأساتذة الترجمة واللسانيون، إنها الوضعية الحرجة لأي نظرية إزاء الترجمات الموجودة فعليا، بوصفها ظواهر “تاريخية”. إن المنظرين وهم يضعون نصب أعينهم نصوصا عليهم أن ينتجوها، وبالتالي نصوصا ذات نمط مثالي، كانوا يقيمون جدارا بينهم وبين الظواهر الواجب وصفها؛ ذلك أن تعريفاتهم المعيارية لا تتناسب مع التاريخ (توري 1978، لامبر 1978). فإذا كان من الصعب أن نفلت من الطابع القسري للنظريات، فإنه يبقى علينا أن نحدد ما هي النظريات التي يمكن أن تكون مناسبة، وما هي الشروط التي تكون فيها كذلك. يرى توري أن الباحثين يجانبون الصواب حين يجهدون أنفسهم في تعريف الظواهر (بصورة منغلقة) قبل أن يقوموا بدراستها. فالافتراضات وحدها الجديرة بأن توجه الأبحاث توجيها جديدا وتصل في النهاية إلى معرفة أكثر نسقية بالترجمات.
إن الخاصية شبه المتفردة لترجمات الأعمال الأدبية، عرض أن تطرح و/أو تحل آنفا، تصبح بذلك، مرة أخرى موضوع دراسة؛ إن التمييزات بين الترجمة والاقتباس والمحاكاة أو بين الترجمات الجيدة والترجمات الرديئة هي بدورها معطيات تاريخية وفحص هذه الظواهر يجب أن يصبح أكثر فاعلية بفضل نظريات من نمط جديد، نظريات، هي في الواقع، نماذج وصفية، الغرض منها هو تسيير تحليل موضوع تاريخي.
الترجمة المترجمة موضع سؤال:
يبدو، في الواقع، أن تساؤلاتنا حول مختلف مظاهر الترجمة، تكون عرضة لكثير من سوء التفاهم. فالباحثون وهم يواجهون موضوعا لا منزلة أكاديمية له ولا تقليد علميا، ظلوا إلى يومنا هذا يطرحون أسئلة ساذجة مثل ما السر في أن يكون المترجم فلان عبقريا في الترجمة؟ هل بإمكاننا أن نترجم “الأوليسا” لجويس؟ كيف يتسنى لنا ترجمة أمهات الأعمال اليابانية إلى الإنجليزية؟ هل ظل المترجم وفيا لنموذجه؟ من هم كبار المترجمين؟ كيف نفسر شيخوخة الترجمات؟
هذه هي الأسئلة التي يطرحها المترجم أو الناقد أو الإنسان المثقف؛ فمن دون أن نذهب إلى حد القول إنها أسئلة خاطئة بإمكاننا أن ننظر في تركيبتها وفي سوء التفاهم المحتمل فيها، بل في حدودها، مقارنة مع أسئلة أخرى أكثر جوهرية، وبخاصة الأسئلة التالية: ما الذي نعنيه -عبر الثقافات- بفعل “ترجم”؟ كيف نترجم؟ ما هي الوظيفة التي تلعبها الترجمات في الآداب وفي تطورها أساسا؟ كيف نفسر الأزمات والثورات في مجال الترجمة؟
وبالموازاة مع ذلك، فإن الدراسات الأدبية هي أيضا متحررة من الأسئلة التي يطرحها الإنسان الجاد على الآداب الجميلة. فمنذ عقود والباحث يعمل جاهدا إلى جانب الكاتب والناقد وجامع الكتب، كي يلج عالمهم دون أن يتماهى معه تماهيا لا قيد فيه ولا شرط، فأحل، بتركه جانبا المواقف المعيارية، الخطاب “العالم” محل الخطاب الفني وأصبح البحث يتناول أسئلة تم تلافيها من لدن النقاد، لكن وفق أهدافه الشخصية.
حسب المنظور النظري، الذي هو هنا منظورنا الشخصي، ينبغي في المقام الأول أن نحدد التصورات التي تحكم الترجمات في فترة تاريخية محددة بحيث تصبح الترجمة موضوعا للدراسة فنعمل على معرفة من ينتج الترجمات؟ ولأي جمهور؟ وبواسطة أي نصوص؟ وفي إطار أي جنس منها؟ وبأي لسان؟ وبأية لغة؟ حسب أي سجل؟ وأي خطاطة أدبية؟ وتبعا لأي نمط أدبي وأخلاقي وسياسي؟ والأكثر من ذلك، وفق أي تصور للترجمة؟
النموذج النسقي:
إننا سنصف الترجمات من زاوية العلاقات القائمة بين أنساق التواصل، التي تستخدم لغات مختلفة (سنن (ج.سنن) مختلفة)؛ إننا نقبل بأن الطبيعة الحقة لهذه العلاقات قد لا يمكن أن تحدد سلفا؛ وأنها تتوقف بالأساس على الوضعية التي يحتلها المترجم داخل نسق الاستقبال (يمكنه أن يتظاهر بـ الترجمة) ومدى تساهل وسطه معه؛ وأنها تكون دائما، حصيلة توليف مواضعات أجنبية ومواضعات محلية إلى الحد الذي تبدو فيه مصطنعة في أعين القراء-المتلقين.
يتعلق الأمر، حسب ما يظهر للعيان، بسيرورة تواصل شخصي وجماعي في آن معا، فالتكافؤ، أي طبيعة العلاقات بين أنساق التواصل، يتفاوت، على ما يبدو، حسب الفترات والأوضاع. إن الآداب والثقافات الأكثر استقرارا تنحو نحو إدماج النصوص المستورة من خلال فرض مواضعاتها الشخصية عليها: فالمترجمون يتلافون الأعمال الشديدة الغرابة ويتحاشون التوليد، والاقتراض والخلق الأسلوبي والسردي، والأجناس الطلائعية، الخ. إن الآداب والثقافات التي تتخبط في الأزمة أو التي توجد في طور التكوين هي على العكس من ذلك تنشد الخلق مع الحفاظ، ما وسعها ذلك، على خصائص الأعمال المستوردة؛ ففي مثل هذه الوضعيات تولد، عموما، الترجمات المجهولة الاسم (توري 1980، إيفن زوهر 1978) بل إن هذه الافتراضات بخصوص موضوع الاختيارات الممكنة من لدن المترجمين والترجمات وقرائها، تتيح صياغة خطاطات استشرافية، حسب توافق الأنساق الحاضرة أو عدم توافقها. إن التوافقات وعدم التوافقات ليست مطلقة البتة. إنها [توافقات ] تاريخية وبالتالي نسبية، حتى على المستوى اللساني. وهكذا تصبح مسألة إمكانية الترجمات مسألة تاريخية ونسبية يحلها كل مترجم حسب وسائله وتمثلاته الشخصية، أو حسب الوسائل والتمثلات المتاحة داخل وسطه.
إن ميزة التأويل النسقي للترجمة، هي في المقام الأول، خاصيته الشمولية وخاصيته المفتوحة. إنه يتناسب مع خطاطات الأسئلة وليس مع الأطروحات. إنه يؤول إلى المعجم المستعمل من لدن المترجم، ولكن أيضا إلى أسماء الأعلام والوزن العروضي والوجوه البلاغية والتقنيات السردية أو الفوارق الأجناسية، بل إلى اختيار النصوص داخل الأنساق الأجنبية وضمنها؛ إن غياب الترجمات، في جنس فرعي، خلال حقب معينة أو آداب معينة يغدو بدوره عرضا مثلما تغدو الطريقة التي أنجزت بها الترجمة كذلك. فكل ثقافة وكل أدب (يعيد) صياغة الترجمة ومتغيراتها حسب طريقته. وكل تعريف لا تاريخي، ولنقل كل تعريف كوني، هو من الآن فصاعدا، تعريف عبثي؛ إن التعريف الذي يتيح لنا التأكد من أن المعايير والنماذج التي تميز الظواهر الترجمية معايير ونماذج فضفاضة هو التعريف الوظيفي والمنفتح.
إن النظريات اللسانية وأغلب نظريات الترجمة الأخرى هي في الواقع، شروح مغلقة للظاهرة الترجمية: إنها تقترح تأويلا فريدا من نوعه وجامدا للعلاقات (التكافؤية) الموجودة بين نص الانطلاق ونص الوصول داخل لغة أخرى. فهي تدعي أنها تعزل الأعمال “المتكافئة” عن الأعمال غير المتكافئة والحال أنها، في الواقع، تسقط معايير الباحث على الموضوع الواجب دراسته عوض أن تحلل المعايير التي يقوم عليها، إنها تقوم عموما، على أساس مقابلة نص الانطلاق بنص الوصول الذي يرتسم فيه النص الأول بوصفه معيارا بديهيا ويقينيا، في حين يحيل النص المترجم، غالبا، على كثير من النماذج الأخرى داخل الثقافة والحياة الأدبية. إن نص الانطلاق قد يصبح مجهولا، إن لم نقل مطمورا، من لدن المترجم و/أو قرائه؛ أما وجوده في حال الترجمة المجهولة الاسم فلا يعدو أن يكون وجودا خياليا.
إن توسيع العلاقات الواجب ملاحظتها يقود الباحث إلى ربط أسئلته بخطاطات. فالمفروض في النموذج النسقي أن يكون واضح المعالم مثل برنامج الأبحاث. ونقدم هنا خطاطة سيميائية للتكافؤ الذي يتيح تنظيم الأبحاث حول مجموع الظواهر الترجمية:
م1 ن1 ق1 @ م2 ن2 ق2
م1’ ن1’ ق1’ م2’ ن2 ’ ق2’
نســــــق 1 نســــــق 2
شروح:
@ يشير إلى التكافؤ في شكل سؤال (أية علاقة)؟
م، ن، ق = مؤلف، نص، قارئ
م’، ن’، ق’ = مؤلفون، نصوص، قراء
– – – – = العلاقات (إيجابية، سلبية)
إن لخطاطتنا منزلة نظرية وافتراضية: إذ تطلعنا على العلاقات التي يمكن لدور ما أن يلعبها في إنتاج ترجمات أو بلورتها، ونتيجة لذلك، تطلعنا على الترجمة التي تستحق، من بين هذه الترجمات أن تؤخذ بعين الاعتبار في دراسة الترجمات. إنها أداة للكشف قبل أن تكون مجموعة أطروحات. إنها تدعي أنها من الانفتاح والاتساع بحيث تستطيع أن تضع كل المظاهر المتعلقة بـ الترجمة داخل وضعية ثقافية معينة بدءا بالسيرورة ووصولا إلى التلقي ومرورا بالمقولات النصية (اللسانية، الأسلوبية، السوسيوثقافية، الأجناسية) وبالتوزيع التجاري أو بالميتانصوص المتعلقة بالأنشطة الترجمية.
كل ترجمة تبدو تجسيدا للخطاطة [وذلك ] حسب أولويات جد محددة، الباحث هو الذي من شأنه أن يحصرها. إلا أن المسألة المركزية تبقى هي طبيعة التكافؤ هل الترجمة أو المعيار المهيمن في مجال الترجمة في نمط ملائم (موجه نحو نسق الانطلاق) أم من نمط مقبول (موجه نحو نسق الوصول)؟ إن ثنائية ملائم/ مقبول تصحح السؤال التقليدي حول “أمانة” المترجم وذلك بوضعه في علاقة مع الأطراف القصوى، وذلك من خلال المعايير المهيمنة؛ إن لدينا، بالفعل، أسبابا وجيهة للاعتقاد بأنه لا وجود لترجمة منسجمة انسجاما حقيقيا بالنظر إلى هذه الثنائية: ففي ترجمة فرنسية يمكن لبعض أسماء الأعلام أن تفرنس، بينما لا يمكن ذلك بالنسبة لأخرى، فالمفردات يمكن أن يكون مصدرها هو “الفرنزية”(1) Franglais، بينما يمكن أن تناسب عملية تصفيف الأوراق والتقنيات السردية العادات الفرنسية. ينبغي، بالتحديد، أن ندرس الاختيارات من جميع وجوهها البنيوية الصغرى منها والكبرى؛ إن الاتجاهات اللسانية والأخلاقية والفنية التي تهيمن على نسق الانطلاق ترغم المترجمين على اتخاذ موقف، شعوريا كان أولا شعوريا، في أي لحظة من لحظات السيرورة. وبما أن الهدف ليس هو دراسة النصوص والمترجمين بل هو دراسة المعايير والنماذج التي توجههم فإن كل الميتانصوص، بما فيها نظريات المترجمين، يجب أن تعرض على نفس التحليل، إنها تشكل اتخاذا لموقف إزاء الثنائيات المتعلقة بـ الترجمة. أما بخصوص الترجمات الأدبية فإنها في نفس الآن اتخاذ لمواقف إزاء الثنائيات التي يخضع لها الأدب.
إن النموذج النسقي يتيح إمكانية إعادة تأويل الأعمال السالفة المقترحة بنظريات أخرى وتصحيحها. فهي تنحث مظاهر جد محدودة، وبخاصة العلاقات بين نص1 ونص2 أو بين المؤلف والمترجم وتستعمل غالبا نص (نسق) الانطلاق كما لو كان معيارا لتحليل (تقييم) نص الوصول. فمن دون إقصاء مثل هذه الخطوات الإجرائية، التي توشك أن تكون، ضمنيا، معيارية نتممها بواسطة تحليل مختلف العلاقات الأخرى. وعلة أية حال فمن الواضح أن “ما هو أصيل” ليس أبدا النموذج الوحيد للترجمة.
على أن النموذج النسقي يقودنا بعيدا عن الفحص المنعزل عن النصوص أو عن المترجمين الذين تم اختيارهم بالصدفة. فبقدر ما تحيل المسألة المطروحة للحل على المعايير والنماذج، ثم على المعايير والنماذج المهيمنة، يصبح الموضوع الحقيقي هو مجموع الترجمات (الأدبية)؛ إذ سوف تصبح الخطوة الإجرائية للباحث، التي كانت تراكمية في المقاربة التقليدية، نسقية.
اقترح إيفن زوهر أن نتصور الأدب موضوع الترجمة مثل نسق مركب له، هو أيضا، معاييره ونماذجه (إيفن زوهر 1978) ويعتبر أن لديه حجتين لصالح هذا الافتراض وهما: 1) أن أدبا محددا يطبق معاييره الشخصية في الاختيار، حتى إزاء آداب وأعمال أجنبية ضاربة في الاختلاف (أوروبا القرن 18 كلها ربطت مصير أوسيان بمصير هومير)؛ 2) أن أدب الوصول يلاحظ استراتيجية معينة في منهجية ترجمته، حتى إزاء أعمال ضاربة في الاختلاف. لا يكفي، بالطبع، أن نفترض أن الترجمات تشتغل مثل منظمة؛ بل ينبغي، أكثر من ذلك، أن نموضعها داخل النسق الأدبي نفسه وندخلها في علاقة معه: هل هي ترجمات تقليدية أم تجديدية، وفيم هي كذلك؟ هل تحتل حيزا مركزيا أم حيزا هامشيا في الحياة الأدبية؟ خلافا لما يؤكده عدد كبير من المنظرين تقبل ايفن زوهر في أغلب الأوضاع أن تصنف الآداب المترجمة إلى جانب الأعمال التقليدية. إن مهمة المنظرين والمؤرخين هي بالتحديد التعرف على العوامل التي ترجح كفة التصورات التقليدية/التجديدية، أو التي تخول للترجمات وضعية مركزية. وبذلك فإنها تولي عناية كبرى لدرجة استقرار الأدب المستقبل.
ما من أحد يجادل في أن هم هذه النظرية ينحصر في إبراز دور أدب الوصول والوظائف الأدبية المخولة للترجمات داخل الأدب وبواسطته.
إن الصعوبة تكمن في موضعة الأدب المترجم داخل نسق الوصول (الأدبي). فنسق الأدب المترجم مثله في ذلك مثل الآداب الأصلية ليست له طبيعة قارة ومنسجمة. ولقد أصبح أمرا أساسيا أن نحدد المبادئ التي توجه الترجمات. والواقع أن النظريات النسقية وحدها هي التي تفسر المفارقات ذات الصلة بـ الترجمة: فكون كلاسيكيات تاريخ الأدب في ترجمتها، وبعض الترجمات الأخرى، تتموضع خارج الأدب الفعلي، وكون ترجمات الأعمال غير “الأدبية” (عدد من النصوص الدينية: الإنجيل، الخ) تحتل أحيانا حيزا مركزيا في الحياة الأدبية. إذا صح أن نسق الوصول ينظم اختيار الترجمات وإنجازها، فيصبح من المناسب أن نضيف أننا لا نقصد، بالضرورة، بـ”نسق الوصول” أدب الوصول؛ فمعايير الآداب المستوردة ليس بالضرورة هي معايير الآداب المستوردة. بإمكانها أن تتغير وأن تعاني من أزمات ونزاعات. وهكذا فإن الآداب اليونانية-اللاتينية القديمة ساهمت في صوغ شعرية القرن 17 الفرنسي، ولم يكن للترجمة من دور سوى تقوية مثل هذا الاستثمار للموروث الأدبي، منذ القرن 19 إذ كانت تحتل حيزا في تدريس الآداب أكبر من الحيز الذي تشغله الآداب المعاصرة فيه، فمصير شكسبير [مثلا] أخذ يسير في الاتجاه المعاكس: فقد عرف مسرحي إيليزابث في البدء من خلال قراءة كتبه، بعيدا عن ذخيرته المسرحية ولم يتكيف مع وضعه كمسرحي إلا بعد حين.
إن الفرضية القائلة بأن الآداب المترجمة تنتظم مثل نسق، تقود، حتما، ومنذ الوهلة الأولى، نحو اختلالات هذا النسق ونحو وضعيته الوسيطة: أين نموضع الترجمات داخل الأعمال الأدبية وضمنها، داخل الآداب وفيما بينها؟ من هنا تستمد الأبحاث حول الترجمات كل معناها في علاقة بالأبحاث الأدبية عموما.
الآداب المترجمة بوصفها نسقا وسيطا:
بما أن الترجمات تشغل وظائف محددة داخل الآداب وفيما بينها، يصبح من اللازم أن يقود تحليل هذه الوظائف أو تحليل الترجمات نفسها، إلى قلب الآداب وقلب وظافتها. إن التفسيرات المقدمة أعلاه تجعلنا نفترض أن الترجمات لا تشكل سوى أحد قطاعات العلاقات الأدبية العالمية (لامبر 1986) أو في أحسن الأحوال نوعا من الاستيراد الأدبي. إن ما يزود الباحثين بمفتاح الترجمة هو التحليل المنسق للآداب والترجمات نفسها. والحال أن هذه الأخيرة تبقى غالبا تحتل حيزا هامشيا في الحياة الأدبية. ومع ذلك فإن الباحث قد يخطئ حين يغيب ذلك عن باله. يعتقد لوتمان أن المناطق اللانسقية جديرة بلعب دور رئيسي في نمو الأنساق (لوتمان 1973). إن ملاحظة مثل هاته تنطبق بامتياز على وضعية الترجمات. إن الفكرة التي يتم استقبالها، والتي سوف يرتبط بموجبها الإنتاج الأدبي ارتباطا وثيقا بعملية خلق أعمال جديدة، تسمى بالأصيلة. تحتفظ خلسة بالأعمال المستوردة سواء كانت مترجمة أم لا وبارتباطها الوثيق بالأعمال الأصيلة، إن الخطاب المترجم له حضور مطلق في المفردات وفي الأبيات وفي الوجوه السردية وفي الأنواع الأجناسية لكل الآداب، إلا أنه نادرا ما يتم التعرف عليه كخطاب أجنبي؛ إن صفته الأجنبية غالبا ما تتلاشى خاصة عند تكيفه التدريجي. وهكذا فإن الجوهر اللاتيني، إن لم نقل الجوهر اليوناني، تتم ملاحظة بالكاد في اللغات الغربية. إنه بالأساس الافتراض الجديد للوجوه [الأسلوبية] الأكثر غرابة التي تخلف أثر الصدمة والتي تستدعي التعرف على (شذرات) النص المستورد. فسواء تعلق الأمر بأسماء أو وجوه بلاغية أو تعلق الأمر بمقتضيات أو بنصوص أو أجناس بكاملها، فإن الترجمات تحمل دائما سمات النسق الوسيط: إذ تحقق تحديدا للمقادير المناسبة لكل من الخطاطات المحلية والخطاطات الأجنبية. إن مبادئ تحديد المقادير المناسبة-اختيار النصوص ومنهجية الترجمة-يكشف الغطاء عن الخاصية المنغلقة أو المغلقة للأدب المستقبل (لامبر 1986) فتسامح هذا الأخير إزاء أنساق القيم هو ما يفجأ. وعلى المستوى السلبي، فإن غياب الترجمة أو الخطاب المترجم يبرز من التوجهات الأدبية المحددة مالا يبرزه سيل من النصوص الأجنبية. إن الآداب الفنية تتطور غالبا بمساعدة النصوص والشعريات المستوردة (وتلك حال الآداب الأجنبية الإفريقية المكتوبة،(…) والآداب الهولاندية بفلاندر في القرن 19) فتحديد الأجناس يسلك سبلا مماثلة. وليس باستطاعة الدراما الرومانسية والرواية التاريخية الأوروبية التعبير عن ذاتهما بدون هجرة النماذج الألمانية والإنجليزية، أما الرواية البوليسية ورواية الخيال العلمي فقد أصبحتا أجناسا عالمية انطلاقا من الآداب الأنجلو-ساكسونية، وذلك بعد عملية طويلة ومعقدة من الاندماج في الآداب الأخرى.
وتطرح العديد من الترجمات مسألة الأجناس بصورة رئيسية، ذلك أن التوافق ما بين المبادئ النصية والأجناسية للأنساق المتصلة فيما بينها محدود أصلا. فحين تكون العلامات الأجناسية معروفة ومعرفا بها بشكل متواز، فمن النادر أن تتناسب مع الأوضاع التراتبية الموازية (لامبر، 1985). وفي حالة نشوب نزاع جلي، فإن المترجمين يفضلون الاندماج في الخطاطات المتعارف عليها أو، يعكسون الآية حين يميلون إلى تجديد المعايير.وبطبيعة الحال ترتبط هذه الابتداعات بمسألة التلقي. ومهما يكن من أمر، سيكون من السذاجة بمكان أن تتغافل عن المناطق الكامنة واللاشعورية للآداب حيث يشكل تراكم النصوص احتياطيا يغرق منه خيال الكتاب والنقاد والقراء. لقد كان القراء الفلامان، في بلجيكا القرن 19، ينتمون كلية وبدون استثناء لأدبين اثنين: فبما أن كل التربية كانت فرانكوفونية، فإنهم لم يتوانوا في الاستفادة من زادهم “المستورد” حين يقرأون أعمالا هولاندية أو حين ينتجونها. إن الوضعية الأكثر تطرفا، والتي علينا أن نتأملها، هي إذن وضعية الأنساق الأدبية المستوردة ككل، إن استثمار الأنساق الوسيطة يستجيب غالبا لاستراتيجيات نصف واعية فيكتور هوغو، فيني ومعاصروها يحلمون بمسرح تجريبي حيث كل شيء مباح، وحيث لا سيطرة فيه للقواعد. وإزاء عبثية حلم مثل هذا، يرفضون في المقام الأول التشخيص، بينما يوافقون على طرد مسرح “المقعد” من معبد الآداب الجميلة. والحال أن كل جديد ينشأ من تجارب مهيأة خلال فترة زمنية معينة على هامش حركة المسرح، ومن المثير أن نسجل كون ترجمات شكسبير وشيلر قد أنجزت وفق نفس المبادئ وخلال نفس السنوات على يد نفس المتأدبين. وتمثل الترجمات داخل التجارب المسرحية النسق الوسيط بامتياز.
وقد أكدنا على أنه من العبث أن نستمر في وضع الترجمات و”أصولها” بإزاء بعضها. ويصبح ذلك أمرا مثيرا في حال الترجمات غير المباشرة. وتظهر هذه الأخيرة، في جميع الآداب، في كل لحظة من لحظات التاريخ. إنها بمثابة أعراض لتنضيد مركب داخل تطور الآداب تعمل على تقويض الصورة الميكانيكية للآداب القومية التي تحتك على امتداد الحدود السياسية و/أو اللسانية تقويضا لا رجعة فيه. فليست الآداب المكتوبة بلغات مختلفة هي وحدها التي تتداخل فيما بينها، بل إنها تتداخل بشكل كبير جدا إلى حد أن بعضا منها يصلح كنموذج للآخر أو لمجموعة من الآداب. تلك هي وضعية الموروث اللاتيني للعصور الوسطى للآداب الفرنسية خلال القرن 18 (وكذلك بالنسبة لألمانيا وهولندا وإيطاليا). إن دراسة الترجمات الوسيطة التي وجهت تطور الآداب المكتوبة بالعبرية مثلا تبين بوضوح تلك التراتبات الأدبية والثقافية بأوروبا منذ القرن 18 إلى يومنا هذا (توري، 1986.أ). وتتبنى بلجيكا الفرنكوفونية والهولندية، منذ الحرب العالمية الثانية، موقفا سلبيا إزاء الترجمات: فهي تستوردها عبر هولندا (في حال النصوص الهولندية) وعبر فرنسا (في حال النصوص الفرنسية)، الشيء الذي يستتبع اندماجا شبه تام على مستوى المعايير المتصل باللغة والمبادئ. وإن فحص هذه الإبدالات العالمية، وهذه القيم التي تمررها، تسمح عموما بالكشف عن الترف الثقافي لبعض الجماعات أو الدول. وأغلب الدول والآداب تستوعب الأعمال الأكثر “غرابة”، (هذه هي وضعية الشرق الأقصى بالنسبة للدول الغربية) وذلك بواسطة لغات عالمية مهيمنة. وأمام هذا الاستيراد الأجنبي المزدوج، فإن الآداب المستقبلة تصرف النظر عن المبادئ المطلوبة في مواجهة الترجمات الأخرى.
إن الملاحظة الشاملة للتبادلات ذات الصلة بـ الترجمة وبالأنساق الوسيطة وتقلباتها، من شأنها أن تجعل ذات يوم من وصف “الأحوال” الأدبية شيئا مماثلا لوصف أحوال الاقتصاد العالمي، ومن شأنها، أكثر من ذلك، أن تعطي فكرة بنيوية عن الاستراتيجيات الأدبية على المستوى العالمي، وذلك بواسطة تحليل التفاعلات بين الوحدات العالمية والقومية وغيرها: ففكرة أدب عالمي من هذا النوع، لا يمكنها أن تترك كل من يزعم دراسة الظواهر الأدبية في وضعية اللامبالاة.
أعمال ومشاريع:
ليس من العدل أن ننسى ما سبق وقدمته العديد من أجيال الباحثين فيما مضى. توجد بيبليوغرافيات ممتازة وتم نشر عدة مونوغرافيات وأعمال جماعية. وبرغم العيوب التي كشفنا عنها أعلاه، فهي تقدم غالبا معلومات قيمية حول أسس الترجمة نفسها، وحول مكانتها في الآداب. ويمكن، في العديد من الحالات، أن توصف بكونها “نسقية” قبل الاكتمال. وتوجد المراجع في أغلب الجذاذات الموضوعة رهن إشارة الباحثين ولا داعي لجردها هنا.
ومع ذلك، فإن ما ينقصها هي القواعد الواضحة والمنسجمة أو، وهو ما يعني تقريبا نفس الشيء، الحد الأدنى من التنسيق. إن جزءا من الأعمال التي ينبغي القيام بها تقوم، إذن، على اقتفاء أثر هذه الأعمال السابقة، وإعادة تأويلها، ووضعها في سياقها المناسب.
وحتى الأبحاث القديمة تحتفظ أحيانا براهنيتها، مثل كتاب ماري ديلكور عن الترجمات الفرنسية للمسرح اليوناني. ومع ذلك، فإن الجهود الضخمة والمنظمة بصورة جيدة ثم القيام، بها في دول المشرق (ليفي 1969، دوريشن، 1972، 1985). وما يفسر هذا الأمر، هي التقاليد الغنية في فن الترجمة، ولكن أيضا مكتسبات الشكلانية والبنيوية والسيميائيات. ومنذ عشرين سنة عمل ازدهار النظريات حول الترجمة، وكذا التعاون بين مراكز جديدة مختلفة ( (…) بلجيكا وهولندا وكندا وغوتنغن ومراكز أخرى ألمانية)، وبخاصة الاتصالات بين المختصين الغربيين والمشرقيين على خلق إمكانيات جديدة. ومن داخل الجميعة العالمية للأدب المقارن، تأسست هيأة للترجمة (كان يسيرها أنطون بوبوفيك تلميذ ليفي)؛ وأخذت فرق البحث تستكشف تاريخ الترجمات في ثقافات مختلفة، فلم يعد من الطوباوية في شيء أن يحلم المرء بتاريخ للترجمة ولوظائفها الأدبية (هيرمان، 1985 أ وب)
مجلة الجابري – العدد العاشر
(*) هذا النص مأخوذ من الكتاب الجماعي:
Théorie littéraire, Marc Angenot et autres, P.U.F, 1989, pp.51-159.