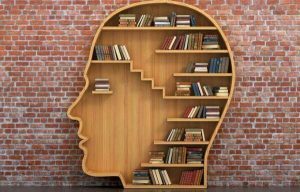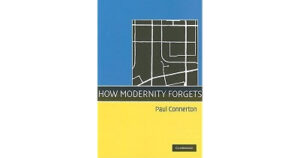| الكاتب | فورطوناطو إسرائيل |
| ترجمة | مصطفى النحال |
يخصص جيرار جنيت، في كتابه طروس، الصادر ضمن منشورات سوي سنة 1982، صفحات مخيبة للأمل عن الترجمة الأدبية حيث يقول:
“من الأحكم للمترجم، دون شك، أن يتقبل كونه لا يقوم سوى بفعل ضار، وأن يحاول، مع ذلك، القيام به على أحسن وجه ممكن، مما يعني غالبا القيام بشيء آخر“.(1)
هكذا ينطلق المنظر الكبير للأدب، في سعيه إلى لفت انتباه المترجم الممارس، من المبدأ القائل إن السمة التحريفية للنص المترجم راجعة، في نظره، إلى عدم إمكانية تحويل الكلام الشعري. يبقى أن يدقق المرء في المعنى المقصود من هذا القول. وبالفعل، فقد اعتبر العمل الأدبي، في غالب الأحيان، غير قابل للترجمة بحجة استحالة إيجاد نسخة مطابقة له، واستحالة إعادة إنتاجه مع الحفاظ على كل تشعبات اختياراته الأصلية، أن يقول المرء بمثل هذا الاستدلال لا يعني فقط أنه يحكم على نفسه بالعجز، وبإلغاء أية إمكانية للتعرف على الآداب الأجنبية، بل يعني كذلك نسيان كون العملية الترجمية تقوم، أصلا، على جدلية التطابق والاختلاف.
- مقاربة في شعرية التصوف

- كيف تقرأ كافكا (الجزء الثاني)

- قَصّ أثر الدابة بين الفراسة وفنّ التّحرّي: دراسة مقارنة في خبر أبناء نزار بن مَعَدّ بن عدنان مع أشباهه في الآداب الأخرى

فلا يمكن إذن، أن تكون بين النص الأصلي والنص المترجم علاقة تطابق، بل بالأحرى علاقة تكافؤ في الوظيفة والإرسالية. وهذا ما يفترض وجود ثوابت ومتغيرات في الوقت ذاته. فجنيت محق في قوله شريطة وضع هذا القول ضمن هذا المنظور: إن مترجم الأدب يقوم دائما بـ”شيء آخر” ما دام هناك خرق للحرفية، وما دام هناك تحويل وانزياح، أي بعبارة أخرى تملك.
فحتى في مناظرة علمية حول مفهوم الحرية، يمكن أن يبدو مصطلح “تملك”، للوهلة الأولى، مفرطا ومخالفا لأخلاقية المهنة. ومع ذلك، فهو من أكثر المصطلحات قدرة على التعبير عن العملية الترجمية، نظرا لتنوع معانيه الممكنة التي تميز كلها، بشكل أو بآخر، استراتيجية المترجم وحدود عمله. وبالفعل، فكلمة Appropriation، حسب قاموس Robert مشتقة من فعل s ‘approprier الذي لا يعني فقط “تملك” بل أيضا “تطاول على ملك الغير”، أو مشتقة من فعل Approprier الذي يعني “جعل الشيء صالحا لاستعمال أو لهدف معين، خص، كيف، لاءم”.
هناك إذن، كما نرى، مادة للتفكير بالنسبة لمنظر الترجمة، وبالتالي لا داعي للاستغراب من أن اللفظ نفسه قد يصلح للإشارة إلى مختلف جوانب العملية الترجمية. إن وجهة النظر التي سأدافع عنها، هنا، هي: كل ترجمة تملك سواء كان جيدا أو رديئا. وهذا التملك بقدر ما هو نتيجة لإكراه ما، بقدر ما هو تأكيد لحرية. فالمترجم الأدبي مجبر، بمعنى من المعاني، على أن يكون حرا، ربما أكثر حرية من زملائه. لكنه يبقى خاضعا لبعض القواعد حتى يظل التلاقي بين النصوص أمرا مضمونا.
I
ليس التملك، في غالب الأحيان، اختيارا، بل تفرضه طبيعة الكتابة الأدبية. ذلك أن الكلمات التي تنتمي في البدء حسب ما يبدو، إلى لغة التخاطب اليومي، تلعب، بحكم القيم الثقافية والعاطفية التي تحملها، وظيفة رمزية ومجازية بشكل طبيعي، فتتصادى وتتجاوب وتنتظم في شبكات. ثم تتآلف وفق منطق خاص مقصود من طرف الكاتب وخاضع، جزئيا على الأقل، لقوانين الجنس الأدبي. كل هذا تنتج عنه لغة جد حيوية وجد مكثفة وتمتلئ، في حالة قطع صلاتها بالعادات اليومية، باستعارات حية وبمؤثرات صوتية وبإيقاعات جديدة. وإذا كان الأدب فنا، فالسبب الرئيسي يعود إلى هذا الاشتغال على الكلمة التي تتساوى قوتها الإيحائية مع قوتها الموسيقية.
إن التوليف الداخلي، شأنه في ذلك شأن أي بناء جمالي، يبقى ضروريا وثابتا. وإذا كان الاستبدال والتكافؤ وممارسات مألوفة في الخطاب اليومي، فإن اي تغيير يطرأ على أحد محوري اللغة يعد هنا مسألة مرفوضة وإلا أخل بالانسجام الكلي. فيكفي أن يحول المرء كلمة أو فاصلة من مكانهما داخل بيت شعري لبودلير أو لـمالارمي ليتبين له أنه مس بالجوهر.
لا يبقى الشكل، في ظل هذه الشروط، مجرد حامل للفكرة أو للمحتوى المفهومي، بل يغدو، بعد تدثره بالقيم والدلالات، عنصرا أساسيا في تشييد الإرسالية إلى درجة أن القول غالبا ما تكون له الأهمية ذاتها التي تكون للمقول بل أكثر. فلولا جاذبية العبارة لغرقت مسرحية من مسرحيات شكسبير في التجريد الفلسفي. أو لغرقت إحدى قصائد فيرلين في التفاهة. فالشكل والمضمون المترابطان كوجهي العلامة اللغوية، يتكاملان وينصهران لإعطاء ما يسميه فاليري “تركيب غير قابل للانفصام بين الصوت والمعنى”(2).
وعن هذا الاتحاد يولد أيضا ما اصطلح على تسميته بالأسلوب والنبرة والكتابة، أي هذا القول الفريد الذي يميز، مثلا داخل نفس التيار ونفس العصر، أديبا مثل كورناي عن راسين. وأخيرا، إذا كان تسنين الأجناس وقواعد التأليف، في أنماط الخطاب الأخرى، والنمط القانوني بالخصوص، يسهمان إلى حد كبير في تحجر التعبير، فمن شأن هذا الإكراه نفسه أن يؤدي إلى الخاصية الإبداعية. وينتج عن ذلك عمل أدبي هو موضوع لفظي فني ذو كثافة متناهية تعتبر، بدورها استعارة لحقيقة عليا، كونية ولا زمانية.
أمام نص من هذا النوع مطبوع بكاتبه، توجد، كما يشير إلى ذلك GEDEON TOURY، استراتيجيتان ممكنتان للترجمة(3): الأولى محض لسانية وحرفية تعطي الأولوية للكلمة وللسياق الضيق، كما تؤدي إلى إنجاز نسخ تعلن تبعيتها للنص-المصدر(4). غير أن الانشغال الفيلولوجي، هنا، ليس كافيا، إذ أن المقابلات المعجمية والتركيبية تعتبر، حتى بين لغات متجاورة، مسألة صدفوية. وتزداج هذه الصدفوية حدة عند بلوغ درجة معينة من تشييد اللغة. وتلك دائما هي وضعية الأدب الذي يعد فيه المعنى المباشر أقل من الوظيفة المجازية حيث “الوردة” ليست “زهرة” فقط، بل هي أيضا رمز للشباب وللجمال وللهشاشة وللزمن الذي يمضي…(5). ومن جهة أخرى، فإن وجود ألفاظ أو بنيات مماثلة ظاهريا في اللغة-الهدف، لا تعني بالضرورة أنها متكافئة المعنى أو الاستعمال.
لنأخذ، مثلا، استعمال ضمير الخطاب في اللغتين الفرنسية والإنجليزية. من الناحية الشكلية، توجد نفس البنية في اللغتين معا، لكن من الواضح أن قيمتها، بالمعنى السوسوري، وبعبارة أخرى موقعها داخل النسق وبالتالي دلالتها ودرجة استعمالها، تختلف كثيرا من لغة لأخرى. فالاقتصار على استبدال الأشكال فقط سيكون عاجزا، إذن عن التعبير في اللغة الإنجليزية عن اضطراب فيدر، بطلة راسين، وهي تبوح دون شعور وتحت وطأة غرامها لهيبوليت بكونه هو موضوع معاناتها، وذلك بواسطة انزلاق مفاجئ من الضمير vous إلى الضمير أنت tu. وبالمثل، فدلالة اللحن اللغوي الموجود في جملة الأمير الصغير لسانت إيكزوبيري: (s ‘il vous plaît, dessine-moi un mouton) لا يمكن استنساخه. ففي كلتا الحالين سيتم إبعاد أو إزاحة الطابع الأسلوبي واثره على المستوى الأدبي بالاحترام الصارم للتطابق الحرفي.
ومن جهة أخرى، تعطي المقاربة الحرفية الأولوية عادة للمعنى المفهومي على حساب الشكل -الجرس اللفظي- تجانس الحروف- الإيقاعات – هذا الشكل الذي يتأبى على التحويل بسبب ماديته فنسها. والحال، فإن كلية الإرسالية هي التي تجد نفسها مختلة عندما يتم التضحية بها. فمثلا تزخر رواية جيرزي موزنسكي (The Hernit 69th Street)، من أولها إلى آخرها، بتوالى كلمتين، أو سلسلة من الكلمات، تشترك في خاصية كونها تبتدئ بالحرف S. الشيء الذي يؤدي أحيانا إلى اشياء غريبة جدا (…).
وبدلا من اعتباره مجرد نزوة لكاتب ما بعد حداثي، فإن هذا التكرار يرتبط بأحد الموضوعات المركزية للرواية، ويتعلق الأمر بسيطرة فكرة الحرب على البطل، الذي هو بدوره روائي، وخصوصا البوليس النازي الذي طارده طيلة طفولته عبر القرى البولونية. من الواضح أن الحضور الكثيف للتكرار الصامتي [ S S] يعد، إذن، أساسيا، وأن الإصرار عليه له الأولوية على بناء المضمون. وهذه حالة متواترة في الترجمة الأدبية حيث تعتبر “الأمانة الضيقة للمعنى شكلا من أشكال الخيانة”(6) حسب تعبير فاليري. ورغم ما يبدو، فالحرفية إذن بدورها صورة من صور التملك لكونها تعطل النص بتجريده من رئته التي يتنفس بها والتنكر لكل مجهود جمالي -ألم يذهب أورطيكا دوغراسي إلى حد المطالبة بأن تكون الترجمة ذميمة(7)– ولا تعطي، في نهاية المطاف، سوى وسيلة للولوج إلى النص الأصلي، سوى وسيلة للمساعدة على فهمه.
وبالمقابل، فـ الترجمة الأدبية، حسب الاستراتيجية الثانية التي ذكرها توري، لا يمكن أن تكون إلا إنتاجا لعمل آخر، أي نلص مستقل له نفس الوضع الاعتباري. ليس الأساسي، في هذه الحالة، هو استنساخ الأصل، بل هو إنتاج أصل جديد يحل محله. فأوكتافيو باث، الذي ترجم عدة شعراء، وانطلاقا من لغات لا يعرفها فضلا عن ذلك، يعلن، أن هدفه لا يكمن في الاقتفاء الدقيق لتعرجات القصيدة الأصلية، بقدر ما يكمن في خلق قصيدة مماثلة، وأنه يكفيه، لتحقيق ذلك، أن يتوفر في الصينية أو اليابانية مثلا، على مجرد نقل لموضوع القصيدة وفكرتها(8). وتفترض مثل هذه الاستقلالية ترتيبا للأولويات، وهي: اللغة-الهدف تتقدم على اللغة-المصدر، والأدبي يتقدم على المفهومي، والملامح العامة تتقدم على جزئية التعبير. فوحدة الترجمة لم تعد هي الكلمة أو المركب أو الجملة، بل النص برمته. وضمن هذا المنظور، فإن دقة المعلومة أقل أهمية من خلق مفعول كفيل بإثارة رد فعل عاطفي وانفعال جمالي قريبين من المفعول والانفعال اللذين يولدهما الاتصال بالأصل.
- النظرية الاجتماعية اليوم: حوار مع هارتموت روزا

- في ظلال الغد

- مذبحة العرفاء: مآلات التصوف والعرفان في المجال الشيعي

فتبعية المفهومي للشعري هذه، هي، على الأرجح، التي نميز أكثر الترجمة الأدبية عن باقي أنواع النقول التي عليها أن تتمسك بموضوعية أكبر. وهكذا يحكي أندري جيد كيف اضطر، في ترجمته لمسرحية شكسبير “أنطونيو وكليوباطرا“، إلى اختيار كلمة Albatros كمقابل لكلمة Mallar التي تنسجم حمولتها الإيحائية أكثر مع السياق(9). ولم يختر المقابلات الدقيقة في اللغة مثل: “Canard mâle” أو “malart” الخاليتين من كل قيمة شعرية. وهناك مثال آخر، خيالي هذه المرة: لنتخيل أن رواية “عنزة السيد سوغان” قد ترجمت إلى لغة وثقافة تحتقر فيهما العنزة أو تعتبر شريرة.
منطقيا، ليس من المستحيل تصور إمكانية تعويضها بالأيلة أو بالحمل قصد الحفاظ على جوهر دلالة الحكاية، وعلى العلاقة: فريسة-مفترس، براءة-قسوة، لا مبالاة-جزاء… وبعبارة أخرى، الحفاظ على الحمولة العاطفية، وعلى ما وراء الكلمات الذي يعتبر شيئا مجردا. وبالتالي، لن تتأتى حرية التصرف هذه لمن يريد ترجمة تقرير عن تربية “الماعز” في أفغانستان، وذلك نظرا لوجود مرجع ملموس خارج اللغة يحول دونه وتعديل معنى التلميح وذلك بمنحه قيمة مجازية.
وبالمثل، فإن الشكل الأصلي، رغم أنه أساسي، لا يبقى مطلقا بعيد المنال ينبغي تركيز كل الاهتمام عليه، ليس الأساسي، في المثالين السالفين، فيدر والأمير الصغير، هو إعادة تعاقب الضميرين vous/tu مهما كلف الأمر، وهو أمر مستحيل على أية حال في بعض اللغات، بل الأساسي هو الإيحاء بفقدان ضبط النفس أو براءة الطفل عن طريق وسائل فعالة خاصة باللغة-الهدف. وبالفعل، كلما هيمن اللفظ، اغتنت إبداعية المترجم. ومن هنا تلك الحرية الكبيرة التي يفرضها اللعب باللغة المتمثل في القصيدة الشعرية أو الجناس اللفظي. وهكذا، تبقى المبادرة بارزة جدا في ميدان الكتابة الأدبية رغم تشعبها.
فالرهان، فعلا، شعري أكثر منه لغويا لأنه لا يستهدف، هذه المرة، إنتاج نص بغية مواجهته المباشرة بالنص الأصلي، بل هو جعل المتلقي يتذوق كلاما آتيا من بعيد بإعطائه قيمة تواصلية(10). وعموما خارج النسخ الموجهة للمتخصصين، هذا هو الخيار الذي تعتمده الطبعة التي تسعى إلى إنتاج أعمال مستقلة موجهة إلى قراء لا تهمهم الدقة الحرفية أكثر مما تهمهم نشوة القراءة.
II
يكمن السبب الثاني للتملك في ضرورة إدراج العمل الأدبي الأجنبي في سياق اللغة-الهدف، وبالطبع، لا يتعلق الأمر بالسقوط في نزعة أحادية الذات مدعين أنه لا يمكن أن يوجد، بالنسبة لشعب ما، واقع آخره سواه. فانتشار الأفكار عبر العالم ما انفك أمرا حقيقيا. ولا مناص من ملاحظة كون الثقافات، شأنها في ذلك شأن اللغات، لا يمكنها، إلى حد كبير، أن تختزل إلى بعضها البعض، وكون نشرها أصعب من نشر المعارف العلمية والتقنية المتصلة بواقع قابل لأن يكون موضوعيا أكثر وغير مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور العقليات.
ولقد ذكرت نظرية إيفين زوهار EVEN-Zohar المتعددة الأنساق، والتي تهيمن على ميدان البحث في الترجمة الأدبية ما يربو على خمس عشرة سنة، بنوع من الإسهاب بأن الفن والأدب لا يقومان على المطلقات، بل يظلان معطيين من معطيات الحضارة مصدرهما إثني وتاريخي في آن(11). ومن تم لا يمكن اعتبار نص، مهما كانت طبيعته، مجرد تجميع لكلمات، ولو كان تجميعا خلاقا، بل يبقى حصيلة لإرث طويل ولنسيج ثقافي طويل يحمل بصماته. وهكذا، فكل تحويل يفترض عملية نزع النص من السياق، كما يولد، لا محالة، سيرورة مثاقفة كي تضمن مقروئية الكتاب داخل شبكة من العلائق مخالفة لسياق الإنتاج.
ويمكن أن تكون البرهنة على ذلك سهلة من خلال لغتين وثقافتين متباعدتين كالفرنسية والصينية. لكنني أفضل، مرة أخرى، أن أقتصر على فضاء قريب منا نسبيا، وهو الفضاء الأنجلوساكسوني، لإبراز كيف أنه، حتى في مثال ملائم، بشكل قبلي، فإن المشكلة تطرح بحدة. فلكي تتم مثلا أقلمة شكسبير مع تربتنا المحلية، تطلب الأمر نحو قرنين من الإخفاقات الكبرى، ومن النجاحات النسبية. ولم تكن أسباب الإبعاد واللفظ منعدمة بطبيعة الحال، لكن بالإمكان اختزالها في سبب واحد، وهو: غياب بنيات الاستقبال سواء على المستويين اللغوي والأدبي، أو على صعيد العقليات والأفئدة.
ويمكن التحقق من هذا القانون في الاتجاه المعاكس، وذلك من خلال المثال الحاسم المتجسد في ترجمة راسين إلى الإنجليزية. إن بريطانيا، بالفعل، لم تعرف مرحلة كلاسيكية ذات اتساع مثل مرحلتنا. وإذا كانت قد عرفت، خلال القرن 18، بداية وإرهاصات لتقليد مماثل، وتحت تأثير فرنسا فضلا عن ذلك، فإن هذا التقليد لم يترك بصماته لمدة طويلة على اللغة وعلى الحساسية، بحيث إن المترجم البريطاني الذي يتناول أعمال “راسين” بالدرس، لا يعثر، في ثقافته، على نموذج مرجعي حقيقي. لهذا السبب قام الشاعر الأمريكي روبير لوويل Robert Lowell، في ترجمته لفيدر، بمحاولة الاقتراب من درايدن Dryden ومن بوب Pope، وبالتخفيف من الطابع التجريدي للغة، وبحذف القافية وتعويض وزن طويل بآخر أقصر: كل هذا ليعطي لنص راسين إمكانية سريانه في النسق الأدبي الإنجليزي(12).
يضاف إلى كل هذه التغييرات، بطبيعة الحال، المفعول الناتج عن مجرد تغيير اللغة ككل. وإذا كان جليا أن خصوصية أي ترجمة تكمن في عملية نزع النص من مداره وإخضاعه لتبعية اللغة الأجنبية، فإن هذا التغيير يغدو، هنا، مركزيا بحكم أن المادة اللفظية تساهم في بناء الإرسالية، وهي تفرض جرسها وإيقاعاتها ونبرها، تقوم بتكسير الوحدة الأصلية: صوت-معنى، وذلك قصد إعادة خلق إن لم نقل خلق مزيج آخر حامل لشحنة، إيحائية ودلالية، جديدة بالضرورة، وأحيانا، يكون تأثير الشكل كبيرا جدا بحيث إن مجرد الانتقال إلى شكل تعبيري مختلف، يكفي لحجب ذكرى العلاقة بين الملفوظات. تحكي الشاعرة الكندية سيسيل كلوتيي Cécile Cloutier أنها وجدت العنوان الذي عنون به أحد المترجمين كتابا لها، وهو: Springtime of spoken words جميلا جدا، لكنها أمضت عدة أيام قبل أن تكتشف بأن الأمر يتعلق ببيت شعري مأخوذ من إحدى قصائدها(13)
III
وأخيرا، فإن العامل الثالث من عوامل التملك يتجلى في حضور المترجم الذي يعتبر فعله حاسما لعدة اعتبارات. ذلك أن النص الأدبي يعتبر، إن من حيث المضمون أو شكل التعبير، كائنا حيا، ديناميا، حيويا ومتطورا ومعناه غير قابل للنفاذ. كما أن النص الأدبي ملتبس بطبيعته، خلافا للتواصل غير قابل للنفاذ. كما أن النص الأدبي ملتبس بطبيعته، خلافا للتواصل اليومي الذي يعتبر في غالب الأحيان أحاديا. وهذا لأنه يتكون من شبكات دلالية معقدة تجعل من تعدد القراءات، دون هدم البنيات، أمرا ممكنا.
وعلاوة على ذلك، فما دام النص يصدر عن وعي فردي، وعن رؤية شخصية للعالم، فلا وجود لمرجع خارج اللغة، بالضبط، يمكنه أن يساعد على بناء المعنى وعلى التحقق منه. ومن ثم، لا يمكن أن يفهم المترجم إلا إذا استند، مثله مثل أي قارئ على كل حال، إلى تجربة الحياة والقراءة، إلى معرفة متبادلة وإلى فك ترميز الإجراءات الخطابية الخاصة بالجنس الأدبي. يظل الفهم، إذن، فعلا تأويليا ذاتيا إلى حد بعيد، كما يشرط بدوره، إلى حد كبير وعلى نطاق واسع، فهم العمل الأدبي فيما بعد من طرف الجمهور.
يلي ذلك مرحلة إعادة الصياغة، والتي ينبغي على المترجم، أثناءها، بعد حصر المضمون والشكل، أن يعيد خلق الموضوع في شموليته: وهي عملية عاطفية أكثر منها عقلية، أدبية أكثر منها لسانية، تتطلب منه حضورا كليا كما تتطلب منه، في الوقت ذاته، ذكاءه وحساسيته وموهبته بصفته كاتبا. كما على المترجم أن يسعى جادا، من خلال نهج حدسي أكثر منه تحليليا، إلى ترجمة لا الكلمات التي تحمل المعاني، بل كلاما خلاقا، لا بل أنشودة. وعليه أن يسعى كذلك إلى إيجاد انسجام يقدم نفس سمة الضرورة.
ولا يسمح لنفسه، في هذه المهمة، بلعب دور الحيطة والحذر، ولا باختيار الاعتدال وإلا خفف من حدة الكتابة. وفي الوقت ذاته عليه أن يستغل النص ويترك أثرا لأناه الداخلية عليه. وخلال هذه المرحلة الثانية، التي يتحقق فيها بعث النص، تعتبر سيادته لا حد لها. فالمترجم وحده يحدد وضعية تلقي النص من طرف جمهوره، كما يحدد الاستعمال الذي ينبغي أن يقوم به لموارد اللغة-الهدف، ووحده يعثر على تكافؤات سياقية غير مسبوقة، والتي لا تجعل منه مؤولا ووسيطا فحسب، بل تجعله كذلك مساعدا حقيقيا للكاتب. تظل الترجمة الأدبية، إذن، أكثر من أي نوع من أنواع التحويل والنقول، اقتراحا ذاتيا إلى حد بعيد.
يغر أن تحفظات الكاتب كبيرة حيال الاعتراف بكون المترجم يحتاج إلى الحرية كي ينجح في مهمته. إن “أندري جيد Gide” واحد من الذين تحملوا على أحسن وجه مبدأ التغيير الذي طال عمله، ربما لكونه عكف بدوره على ترجمة مؤلفين متعبين مثل شكسبير وكونراد، وهكذا يتناول ببصيرة نادرة مشكل العلاقة ما بين الكاتب والمترجم في رسالة وجهها إلى أندري تريق André Thérive بتاريخ 14 ماي 1928. يقول جيد: “في الأيام الأولى، كنت أطلب أن تخضع ترجمات أعمالي لمشيئتي، والنسخة التي كانت تخضع لي، كانت تبدو أحسن نسخة تقترب من النص الفرنسي، لكن سرعان ما انتبهت إلى خطئي، واليوم، أوصي الذين يترجمون لي ألا يعتبروا أنفسهم أبدا عبيدا لكلماتي ولجملتي، وألا يبقوا عاكفين لمدة طويلة على عملهم. غير أن هذه النصيحة، مرة أخرى، ليست صالحة إلا إذا كان المترجم يعرف جيدا موارد لغته الأم، وكان قادرا على النفاذ إلى روح الكاتب وحساسيته، هذا الكاتب الذي يعتزم ترجمته إلى درجة التماهي معه”(14).
وتوجد، كذلك، بخصوص منظور الكاتب لثنائية النص المترجم بعض الشهادات، من بينها هذه الشهادة الجميلة جدا للشاعرة “سيسيل كلوتي” حول الإحساس الذي ولده لديها تملك عملها الأدبي من طرف المترجم ومن طرف لغة أخرى.
"أن تترجم معناه أن نتكلم بكلمات مخالفة لا طفولة لها فينا، هو أن نشعر بكوننا مكانا لاختلاف. (…) هو أن نواصل شيئا ما، وأن نمسي بشكل آخر، هو أن نحب قراء إضافيين، أن نتطابق مع كلمات أخرى، وأن نضاعف الكلام. أن نترجم معناه كذلك أن نفقد التحكم في دلالاتنا ونقول أشياء لم نقلها، هو أن نعدد الاتجاهات ولا نكون الكاتب الوحيد للنص، بل نكتبه صحبة آخر سيختار الكلمات وفق وجوده الخاص، ووفق حياته وتجربته في العالم. معناه أن نعبر بكلماته وبعالمه هو (…). هو أن نكون في وضعية تواطؤ. وأيضا ألا نتعرف على أنفسنا. (…) أن نترجم معناه، إذن، اكتشاف المجهول فينا"(15).
إذا كان المترجم يلفي نفسه مجبرا، لكل الأسباب لتي ذكرت سابقا، على تملك النص وامتلاكه، فمن الخطورة بمكان، مع ذلك، أن نستخلص من ذلك أن كل شيء مباح له، وأن حريته لا حدود لها. وذلك لأن الفكرة الأولى للعمل الأدبي، في الواقع، ليست له. وإذا كان عليه أن يكون مبدعا وجريئا، ينبغي عليه كذلك أن يتوفر على ما يكفي من التواضع لكي لا يتصرف باعتباره صانعا ويحجب بصوته الخاص كلام الغير. وهنا يتجلى، على الأرجح، أحد المظاهر الصعبة جدا لمهمته، كما يتجلى سبب كون القلة القليلة من كبار الكتاب هم تراجمة جيدون: كلما كان الميل إلى الإبداع قويا، صعب الخضوع له.
إن الحفاظ على سلامة العمل الأدبي، يمر بواسطة احترام عدد معين من الثوابت تعتبر في مجملها غير لسانية. لنذكر مرة أخرى أنه من الضروري أن يحتفظ النص بوضعه الاعتباري الأدبي، وبطابعه الجمالي، وأن يكون الأثر الناتج عن وحدة الشكل والمعنى، قبل أي اعتبار آخر، هو الهدف النهائي للتحويل، وينبغي كذلك ألا يتم المساس بالقضايا الكبرى كالحبكة والفكرة والموضوعة أو البنية، وذلك حتى لا يضر غياب الشكل كثيرا بتكافؤ المعنى.
وإذا لم يكن من إدماج النص في السياق-الهدف بد، كما رأينا سابقا، فذلك لا يعني أن العمل الأدبي ينبغي أن يخضع لإجراءات أكثر تضييقا كالاقتباس والتمثيل اللذين ينتميان إلى مقاصد أخرى، من المستحب، عندما يتعلق الأمر بترجمة بالمعنى المألوف، أن يتم الحفاظ، قدر المستطاع، على التربة الأصلية للنص، على أصله الغريب حتى يتمكن من توسيع الأفق الثقافي للبلد المضيف، هذا الأفق الذي يشكل سبب وعلة تحويله. وأخيرا ستكون الترجمة المقترحة ترجمة مفتوحة تاركة للنص أكبر عدد ممكن من احتمالات معانيه. ينبغي على المترجم، خلافا للناقد أو للمؤول اللذين بإمكانهما اختيار هذه الوجهة في القراءة أو تلك، أن يحترس من الانحياز، ومن إعطاء نظرة اختزالية من شأنها أن تحد، فيما بعد، حقل الأبحاث الممكنة.
إن تملك النص، عندما تفرضه قوانين الجنس الأدبي، يبقى إذن في ملك الترجمة الأدبية، ذلك لأن المترجم ينهمك، خوفا من تعطيل النص المصدر، إلى ضرب من إعادة الكتابة، ضرب من إعادة إبداع شكلية يمكن الدفع بهما أبعد؛ دون شك، منه في كل أنواع التحويل الأخرى. لكن، إذا كان صحيحا كون النص المنتج ليس هو الأصل، فإن هذا الأخير يبقى دائما حاضرا، ويستمر، بشكل أو بآخر، في تحديد الأهداف وإملاء الاختيارات. وهكذا تظل الترجمة الأدبية، وخلافا للكتابة العضوية، خطابا إكراهيا وفنا للتراضي بالأساس.
مجلة الجابري – العدد العاشر
الهوامش:
(*) FORTUNATO ISRAEL, “Traduction littéeraire: l’apporpriation du texte” in: La liberté en traduction, Didier Erudition, 1991, pp. 17-29.
1 – P.241.
2 – Variations sur les Bucoliques, Préface à la traduction en vers des Bucoliques de Virgile (1944). Repris in Oeuvres complètes, Gallimard, La Péïdade, t, II, p.211.
3 – Translation, Literary and Pseudotranslation in comparatine Criticism, 6 (1984), pp. 73-85, p.77.
4 – وهذه هي وضعية الطبعات المزدوجة اللغة بالخصوص.
5 – Voir C.Aziza, C.Olivieri, R.strick, Dictionnaire des symboles et des thèmes littéraires, F.Nathan, Paris, 1978.
6 – مرجع مذكور، ص 240.
7 – Miseria y esplendor de la traduccion (1937).
8 – Versiones y diversiones, Joaquin Mortiz, Mexico, 1973, p.8
9 – In: Avant-propos, Oeuvres complètes de Shakespear, Gallimard, Bibliothèque de la pléïade, t. I, p.X.
10 – لا يمكن استبعاد هذه الغاية بصفة نهائية، إذ بإمكان الترجمة أن تستعمل من طرف بعض القراء لفهم البنية اللغوية للأصل بطريقة أفضل.
11 – Voir: Literature and Translation, New Perspectives in Literary Studies. J.S. Holmes, J.Lambert et R.Van der Broeck eds Acco, Leuven, 1978.
12 – On translating Phèdre, in Phaedra and Figaro, FARRAR Strauss, Nex York, 1960.
13 – Jongleries sur la tranduction, in la tranduction, l’université et le praticien, A.Thomas, et J.Flammand eds, Edtions et l’Université d ‘Ottawa, 1984, p.202.
14 – Divers, Les Essais 3, Gallimard, Paris, 1931, p. 196.
15 – مرجع مذكور، ص 202. (الترجمة الأدبية)
الترجمة الأدبية