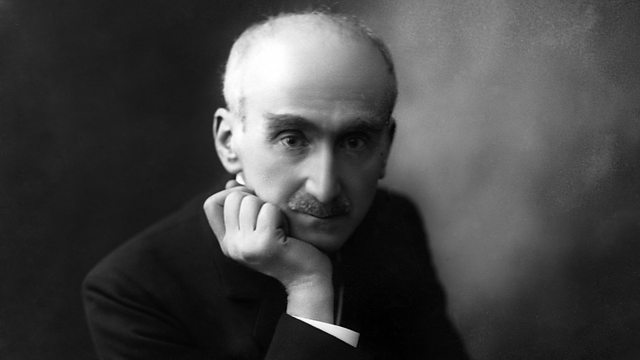| الكاتب | زهير ساكو |
كيف يتولد العقل من حيث صورته ومادته؟ هل يمكن لعلم النفس أن يظهر بصورة علمية دقيقة كيف يتولد العقل؟
لا يعتقد “برجسون” أن علم النفس يقدر على توضيح كيف يتولد العقل، وذلك لأنه يفتقر للأدوات الضرورية التي تمكن من متابعة كيف ينمو العقل تدريجيا خلال السلسلة الحيوانية. إن أكثر ما يمكن أن يقدمه علم النفس عامة والمقارِن منه خاصة، هو أن يعلمنا كيف أن الحيوان بقدر ما يستطيع أن يظهر دراجات من الذكاء، بقدر ما يستطيع أن يميل إلى إدراك أفعاله وتصرفاته التي تدفعه إلى استخدام الأشياء استخداما نفعيا. الأمر الذي يفيد أن هناك إمكانية لكي يقترب من ذكاء الإنسان. فلما كان “برجسون” يتزعم بذلك، وجدنا كيف أن الحيوان عموما، يقدرعلى التمييز تناظرا مع ما يميز الإنسان في العالم المادي.
“حيث يمكن القول إن العقل الحيواني يجول في جو تصوري وإن كان لا يستطيع تركيب التصورات العقلية الخالصة[1]“.
إذا كان الأمر هكذا، وكان هذا العقل لا يتجاوز حدود دائرة أفعاله التي تدفع به نحو الخارج، فإننا نتبين مع “برجسون”، أن الحيوان رهين بما هو عملي. أي أن تصوراته، بصورة أو بأخرى، تُترجم على شكل تمثلات عملية لا غير؛ بمعنى من غير القدرة على التفكير فيها. وعليه، يزعم “برجسون” أن هذا التمثيل، لا محالة، يعد رسما مجملا لمخطط العقل الإنساني[2].
والواقع، إن ما يفهم من خلال هذا الطرح، هو أن هناك إمكانية فعّالة لتفسير وتفكيك كيفية توالد العقل الإنساني، والتي تتراءى للباحث بالاستناد إلى ضرورة ربط المسألة بتفسير وتفكيك عقل الحيوان. بمعنى من المعاني، تفسير الحالة الإنسانية الكاملة من حيث الوعي بحالة أخرى غير كاملة الوعي.
إن المتأمل بصدد هذه النقطة يتذكر مسألة “ديكارت” فيما يخص التفاوت الحاصل بين الناس من جهة التفكير. فإن كان الرجل يرجع ذلك إلى طريقة استعمال العقل من قبل كل فرد، فإننا، مع “برجسون”، نجد الأمر يعود إلى الحالة الإنسانية/ الحيوانية التي يكونوا عليها الأفراد من جهة، وتحديد الاتجاه من جهة أخرى؛ بمعنى تحديد إحدى الاتجاهات من قبل الفرد يصاحبه مباشرة العقل بصورة من صوره وأشكاله. لهذا، لا وجود لعقل دون وجود مادة معينة قابلة للامتداد. وذلك يجعلنا ننفي إمكانية الفصل أو التفريق بين الجسد والفكر كما فعل “ديكارت” في القرن السابع عشر من عمر الفكر الفلسفي، محدثا بذلك أزمة وثورة غيرت من مجرى هذا الأخير.
من هنا يتضح لنا أن وجود العقل يعني، ضرورة، وجود المادة. والحق، إن “برجسون” يستند في ذلك إلى نظرية “سبنسر[3]“. فإذا كانت هذه الأخيرة تثبت بأن المادة خاضعة لقوانين فيزيائية، وأن الموضوعات مرتبطة بالموضوعات، والظواهر بالظواهر تبعا لعلاقات ثابتة؛ فذلك لكي يستنبط “برجسون” منها كيف أن
“أثار هذه العلاقات وتلك القوانين تنطبع في الشعور فتجعله يتخذ الشكل العام للطبيعة وينقلب إلى عقل[4]“.
إن ثنايا هذا القول البرجسوني تدفع قريحتنا، لا محالة، إلى الاستفسار عن طبيعة ووضعية الحدس. ما طبيعته؟ إذا سلمنا بأن العقل، مع “برجسون”، يوجد حينما توجد المادة، فهل الحدس صوري أم مادي، أم أنه لا هذا ولا ذاك؟ لما كانت غاية العقل، عموما، هي التأثير في المادة والتحكم فيها، ولو عند أقل جبروتيته وقوته، كان ذلك غير محصل له إلا بالنظر إلى المادة كأجزاء منقسمة ومتفرقة. والحال، إن ذلك لا يتم للعقل إلا بحدس هذه، المادة ومن ثمة نستخلص صورة وطبيعة هذا الحدس. إذ بذلك يغدو نوعا من أنواع الإدراك الذي يلتحم بالأشياء التحامًا تاما، حيث لا ينطلق من ظواهرها ليبلغ بواطنها، وإنما يغوص هذه الأخيرة بشكل مباشر، يبحث عمّا يمكن أن يكون فيها من وحدة فعلية ومتصلة، ليركب بين الأشياء على تنافرها داخل الديمومة المتجددة. غير أنّ الحدس حين يركب لا ينطلق من الوحدة بل ينتهي إليها.
لذلك فإنّ هذه الوحدة ليست افتراضية بل فعلية ومتصّلة لأنّها تنتج عن تعاطف باطني يضطرّ في كلّ مرّة، بل دومًا، إلى مغادرة الزمان الحاضر بجعله حاضرا ينسجم مع الزمان الماضي وينفتح على الزمان الاتي. لهذا، فالحدس إن تعهّد بهذا الأمر، صار عملاً مضنيًا لكنّه طريف، مربك في مباشريته، مدهش في بساطته، بليغ في صمته، مذهل في قدرته الفائقة على الاكتشاف الخلاّق، إنّه يعيد “بعث” الماضي، متنبّئًا بما سيحدث، جامعًا بين البداهة والغموض، بين الوعي واللاوعي، بين المادّة والرّوح.
وفقا لذلك، يظهر أن للحدس طبيعة زمانية خاصة، أي أن طبيعته لا هي بمادية ولا هي بصورية. ولعل ما يثبت ذلك يتضمن فيما أورده الفيلسوف الفرنسي “جيل دولوز” في كتابه (le bergsonisme) يقول:
"يعتبر الحدس منهج الفلسفة البيرجسونية، وهو ليس عاطفة ولا إلهاما، كما ليس بانجذاب مشوش، بل إنه منهج مهيأ، إضافة إلى أنه إحدى مناهج الفلسفة الأكثر إعدادا. مبني على قواعد صارمة، والتي تشكل في مجموعها ما يسميه "برجسون" ب الزمان في الفلسفة. والحق إن الرجل كان يلح على الاتي: الحدس، كما يفهمه منهجيا، يفترض الزمان. " كانت هذه الاعتبارات حول الزمان تبدو لنا حاسمة. ورويدا رويدا، جعلت لنا الحدس يعلو إلى مستوى اعتباره منهجا فلسفيا. من ناحية أخرى، الحدس ككلمة في ذاتها ترددت كثيرا في قبولها. وكتب لهوفدينغ: "نظرية الحدس التي تلح عليها بقوة كبيرة مما على نظرية الزمان لم تظهر لي إلا بعد هذه الأخيرة بزمن طويل[5]".
وعلى الرغم من ذلك، فالعقل، بالصورة التي طرحناها انفا، لا يدرك المادة إلا من داخل صورة مكانية تجعل هذه المادة بين مواد أخرى في العالم. حيث إن هذه الحركة إن كانت تجعل التفكير أو الذهن يتحول إلى عقل عاقل للموضوعات وللظواهر، إذ استيعابها على شكل تصورات متميزة، فإنها الحركة نفسها التي تجعل المادة تنقسم إلى أعيان خارجية متميزة بعضها عن بعض. لذا، “فكلما ازداد اتصاف الشعور بصفات العقل ازداد اتصاف المادة بصفات المكان[6]“. وبالتالي يمكن الزعم بوحدة الوجود، أي بوحدة الحياة. ولعل الضامن لهذه الوحدة، يمكن القول، إنه الحدس الذي يجعل الفيلسوف يبذل مجهودا كبيرا إذ يجعل العقل متعاطفا مع موضوعه. وذلك من خلال إرجاع هذا العقل إلى جوهره وكنهه بغاية إبقاءه على مبدأ بسيط، كي يصير في نهاية هذا المجهود عقلا فارغا من جهة تخيلنا لذلك. وهكذا يكون بإمكان الفيلسوف أن يستخرج منه ما وضعه. إضافة إلى إمكانية إجلاء تماسكه بنفسه أي العقل.
فإن كان من البداهة أن العقل الإنساني قادر على دراسة وتناول كل ما تخفيه الأشياء من نظام هندسي، زيادة على ذلك التماثل والاتصال الحاصل بين الهندسة ومعظم الأشياء حيث التمام والكمال؛ إذا كان الأمر بهذه الصورة، استطعنا مع “برجسون” القول إن كل شيء في الوجود معقولا وعاقلا بدرجة واحدة. والحق، إن هذا التفسير البرجسوني المتأثر بفلسفة كل من “فيخته[7]” و”سبنسر”، يجعل الباحث أمام استنتاج موسوم بسمة “تحصيل حاصل” يقضي بأن الطبيعة واحدة من جهة، وأن وظيفة العقل هي الإحاطة بالطبيعة إحاطة تامة وكاملة من جهة ثانية. وفي سياق هذا الحديث نتبين مرة أخرى، أساسية وأهمية الحدس الذي يوفر للعقل إمكانية تحقيق هذه الإحاطة؛ والتي لا يمكن تحصيلها إلا بإقامة تعاطف ومحبة للأشياء. لذا، لا مجال للتفرقة والفصل ما بين ما هو صوري وبين ما هو مادي لأن الحياة والوجود عموما وحدة كلية متساوقة. يقول برجسون:
" ولما كنا قد فرضنا أن بين ملكة المعرفة والتجربة الكاملة مساوقة في الوجود لم يكن هناك مجال للكلام على توليد إحداهما من الأخرى، لأننا نسلم بوجود ملكة المعرفة ونستخدمها كما نستخدم بصرنا للإحاطة بالأفق[8]".
فهل هذا يعني أن العقل قادر على إدراك الوجود في صيغته الكونية؟ هل من سبيل لكي يحقق حوله حقيقة مطلقة؟
مبدئيا، يظهر أن ذلك هو ما يرمي إليه العقل، فإذا كنا نسلم أن روح الفلسفة هو العقل، فإنها تعد مجهودا تهدف إلى الانصهار والتلاحم في الوجود الكلي دائما وأبدا. من ثمة أدركنا لماذا “برجسون” يلح على ضرورة الإدراك الجماعي التدريجي لا الفردي. لأن البحث من منظور هذا الأخير لا يعطينا إمكانية التصحيح المتبادل للأفكار والانطباعات، وبالتالي فالإنسانية التي تسم الوجود الإنساني مآلها التضييق لا التوسيع. وهكذا، فلما كان هذا، مع “برجسون”، يعد تعاطفا مع الموضوع المدروس، وجدنا كيف أن كماله رهين بالتفكير الجماعي التدريجي. وعليه يتبين لماذا يحصر العقل، بشكل أو بأخر، داخل دائرة العمل طالما يجد ضالته في مجرى المادة الجامدة. يقول برجسون:
" العقل لا يشعر بالغربة في ميدان المادة الجامدة، لأنها هي المجال الطبيعي لممارسة العمل الإنساني، والعمل.. لا يتحرك إلا في ميدان الوجود الواقعي[9]".
الحدس والشعور: أية علاقة؟
لأريد لنا أن نسلم أن الشعور بالوجود عموما يعد مجهودا عقليا من ناحية، وتعالقا بالمادة من ناحية أخرى، أمكننا الزعم بوجود علاقة ترابطية بينه وبين الحدس. فما طبيعة هذه العلاقة؟ هل شعور الذات بذاتها، إلى أقصى مدى، يتم بالحدس مما يجعلنا نقول ب ديمومة حدسية الشعور؟ ثم كيف يتولد هذا الحدس الشعوري بالأنا والعالم؟ يمكن القول إن الإنسان ليُدرك ذاته والعالم يبذل مجهودا فكريا عميقا يتسم بديمومة غير منقطعة التتابع أو الاتصال. ذلك لا يتم له إلا بحدسية العقل وتعاطفية الوجدان اللتين يجعلان الأنا متعالقة مع العالم المادي، سواء في بعده الحي أو في بعده الجامد. من هنا، فالعودة إلى الذات إن كانت تتم بالحدس التعاطفي، فذلك لكي يتولد لديها شعورا بذاتها وبالعالم؛ حيث يكون شعورا خيوطه تجعل الماضي يصب في الحاضر، وذلك بزمانية متصلة لا مجال فيها للانقطاع. فلما كانت الذات تبحث ذاتها بهذه الصورة التي حاولنا توضيحها أدركنا كيف أنه بحث:
"يجعلنا نغوص في الديمومة المحضة- أعني الديمومة التي يتضخم فيها ماضينا الدائم الجريان تضخما مستمرا بانضمام حاضرنا الجديد إليه- وهو يشعرنا في الوقت نفسه بأن لولب إرادتنا يتوتر إلى حدوده القصوى، وأنه ينبغي لنا إذ ذاك أن نقلص شخصيتنا تقليصا عنيفا، حتى تتجمع، وأن نلم شعت ماضينا المتواري عنا حتى نجعله كثيفا وغير منقسم ممتدا إلى حاضر يخلقه في اندماجه فيه[10]".
من خلال هذا القول إذن، ينجلي لنا مدى تعاطفية الذات لذاتها ولموضوعها حيث ما بينها وبين ذاتها وما بينها وبين موضوعها جهد جهيد يحاول عن طريقه الشعور أن يبلغ مداه. من هنا، فكلما كان الشعور أعمق ومطابقة الذات لذاتها أتم، كلما كان الحدس بالعالم تعاطفا أكثر خصبة وأشد حيوية. على غرار ذلك، إذا أمكننا استنباط أن العقل البرجسوني هو عقل حادس، استطعنا القول إنه بذلك يجد يسرا وسهولة في إدراك التتابع الزمني الحقيقي للديمومة كجوهر وماهية للحياة عموما. هكذا، فحدسية العقل هاته، هي التي تجعل الذات قادرة على تركيب حالات ووضعيات، هي بطبيعة الحال جديدة بالنسبة للوعي، يلتقطها من خارج ذاته. ومعنى ذلك،
"إن هذه الحالة تتضمن إذا صح القول عنصرا عقليا بالقوة، ولكنها مع ذلك تطغى على العقل، وليس بينها وبينه مقياس مشترك لأنها جديدة وغير منقسمة[11]".
بمعنى من المعاني، أنه بقدر ما يبذل الأنا مجهودا حدسيا كبيرا بغية جعل الماضي يصب إلى حاضرنا، بقدر ما يستطيع هذا الأنا تذكر معاني وأفهام العالم من جهة، وشعوره بذاته من جهة ثانية. إضافة إلى أن هذا الجهد، يجعل الإرادة، أيضا، موقظة وروحها مجندة. والحق، إن النتيجة التي يرمي إليها الأنا من خلال هذا المجهود تقتضي أن هناك قدرة وإمكانية كي يستشف وجودا مركبا من حاضر يتجدد دون انقطاع. وبالتالي تحقيق وحدة وجود الأنا أو الذات. ولما كانت قوة الشعور تزداد تقدما في مجال الديمومة الخالصة بقوة الحدس كانت إحساساتنا، بتداخل أقسام وجودنا المختلفة، كبيرة. وأيضا بتركيز شخصيتنا كلها في نقطة واحدة أو أقل إذا شئت في حدّ يندمج في المستقبل ويفرضه دون انقطاع[12]. بهذا التصور إذن، يؤسس “برجسون” لأرضية خصبة يمكن أن تجعل الحياة حرة بشكل عام، والفعل حرا بشكل خاص.
ما يستنتج من خلال هذه المقاربة البرجسونية لمشكلة العلاقة بين الشعور والحدس. يتمثل في أنه إن كانت علاقة شدة، فهي بقدر ما ترتفع قوتها بقدر ما تتقوى شخصية الإنسان وينجلي قوامها. وبالتالي استحالة انقطاع الحيوية والنشاطية التي تميز ذكريات وأفكار الأنا. والحال إن العكس صحيح كلما خرّت قوى هذه العلاقة بين الحدس والشعور، زد على تراخي ديمومة هذا الأخير، كلما غدت شخصيتنا مكانية منحطة غير زمانية ملقاة في أحضان حدسية الشعور، إلا أنها مع ذلك تواكب هذه المكانية دون انقطاع على مستوى الإحساس[13].
الحدس والتجربة
ما يثير فهمنا عند تأملنا في القضية هاته هو هل يمكن أن نخلق تصورات بشكل حدسي دون ارتباط الذات بشيء مادي؟ وإن كان “برجسون” يلح على أن ملكة الفهم تابعة لملكة العمل، حيث أن العقل مهيأ للتفكير في المادة، كان لزاما علينا التفكير في مشكلة طبيعة العلاقة بين الحدس والتجربة؟ بداية، ولضرورة منهجية، يلزم الوقوف على القصد الدلالي لمفهوم التجربة في فلسفة “برجسون”. يمكن الزعم بأن لمفهوم التجربة معاني ودلالات بسيطة جدا، إذ نرجعها إلى الوقائع والأحداث التي نستشعرها وندركها عبر حواسنا. ومن ثمة فالتجربة تؤطر وتوجه عقلنا في تحديد وضبط المادة، على اعتبار أن العملية هاته تحدث بصورة كلية محورها خط متصل الحلقات دون انقطاعات وذلك بشكل ثابت. يقول “برجسون”:
"انقسام المادة إلى أجسام غير معطاة أمر نسبي تابع لحواسنا وعقلنا، وأن المادة من جهة ما هي كلٌ غير منقسم أشبه بتيار جار منها بشيء ثابت[14]".
هكذا إذا، لا يمكن أن نتصور، مع “برجسون”، حدس خالص كما هو الحال مع “هوسرل”، إذ كل حدس ممكن، هو في الحقيقة، يرتبط بشكل وثيق بالمادة الحية التي تباشرها الذات انطلاقا من الحواس التي تجعلنا نقر بأن الحياة هي مجموع التجارب الواقعية التي يعيشها الإنسان أو الكائن الحي عموما بزمانية مستمرة لا انقطاع فيها. والواقع، إن الأمر هذا هو ما جعلنا نقول، مع “برجسون”، إن الحدس يتسم بخاصية التعاطف. من هنا، فلما كان العقل حسب الرجل يجد نفسه في مجاله الطبيعي عند النظر إلى المادة غير العضوية، انجلى لنا كيف أنه بقدر ما يفكر في المادة تفكيرا ميكانيكيا، بقدر ما يجد نفسه ميسور الإبداع. ووفقا لذلك، يجد المتأمل أن العقل حاملا في ثناياه بذور تفكير هندسي كامن فيه، وهذا التفكير الهندسي يزداد وضوحا بازدياد توغل العقل في صميم المادة الجامدة[15].
خاتمة
يتضح من خلال ما سبق، أن الإنسان إن كان يعيش في ارتباط بهذا العالم، فإنه أمام مكونين وجوديين كبيرين أساسيين: الحي وغير الحي. ولكي نتغيا الدقة، ولو بشكل نسبي، وجب، حسب “برجسون”، التمييز بين هاذين المكونين، أي بين الجامد والحي. والحال، إن ذلك غير متيسر لنا إلا بالتفكير في بناء وتحديد منهج فلسفي دقيق قادر على أن يتولى هذه المهمة. فإذا كان بإمكاننا أن نسلم أن المادة الجامدة تتلاءم مع الإطار الذي يمكن أن نعده وفق تفكير مسبق، حيث يمكن وضع معايير ومقولات محددة، فإن ذلك يجعلنا نتبين أن “الحي” التفكير فيه لا يستقيم بمثل ما نقارب به المادة الجامدة، يقول “برجسون”إلا بعد تجريده من كل ما هو ذاتي له[16].
هكذا إذا، لكي نحقق هذا التمييز وبلوغ هذه الغاية سيقول “برجسون” بالحدس باعتباره منهجا معد. والواقع، إن المتتبع للقواعد الصارمة التي وضعها “برجسون” لتنظيم هذا الحدس المنهجي، يتلمس في عمقها تلك العلاقة الترابطية/التداخلية بين الحدس والتجربة. فإدراك الذات الحادسة للأشياء لا يتم إلا حينما تكون هذه الأشياء موجود فعليا، حيث يضعها هذا الإدراك بشكل فوري ومباشر داخل المادة. لكن هذا الإدراك لا يكون شخصيا، إضافة إلى أنه يتطابق مع الموضوع المدرك.
والحق، إن هذا المعنى هو المؤطر للأطروحة البرجسونية بشكل عام[17]. والأساس في أطروحة “برجسون” هاته هو أن الحياة بشكل عام ترسانة من الثنائيات المتناقضة والمتقابلة والتي يصعب التميز بينها، إن لم نقل مستحيل في بعض الأحيان. ولعل من بين هذه الثنائيات نجد أعمقها: “الزمان والمدى” أو “الزمان” الحيز[18]“، حيث يتم من قبل الذات خلط بين هذه الثنائيات، وذلك وفقا لتمفصلاته الطبيعية، أي إلى عناصر تختلف من حيث الطبيعة[19]. من هنا أهمية الحدس كمنهج يساعدنا على تقسيم وتجزيئ هذه المشكلات /الثنائيات التي لازال الفكر الفلسفي يخوضها؛ وإن كان قد أعلن في مرحلته المعاصرة تجاوزها. يمكن الزعم مع “جيل دولوز” أن هذا الحدس يمتاز بروح أفلاطونية[20].
[1] Henri Bergson, L’évolution Créatrice, 1903, édition électronique (ePuB, PDF), Les Echos du Maquis, avril 2013, p 131.
[2] للتوسع في هذه الفكرة نحيل القارئ إلى كتاب المادة والذاكرة.
[3] هربرت سبنسرHerbert Spencer هو فيلسوف بريطاني ( 1820 – 1903).مؤلف كتاب ” الرجل ضد الدولة” الذي قدم فيه رؤية فلسفية متطرفة في ليبراليتها. كان سبنسر، وليس داروين، هو الذي اوجد مصطلح “البقاء للأصلح “. رغم أن القول ينسب عادة لداروين. وقد ساهم سبنسر في ترسيخ مفهوم الارتقاء، واعطى له ابعادا اجتماعيا، فيما عرف لاحقا ب الدارونية الاجتماعية. وهكذا يعد سبنسر واحدا من مؤسسي علم الاجتماع الحديث.
[4] Henri Bergson, L’évolution Créatrice, 1903, édition électronique (ePuB, PDF), Les Echos du Maquis, avril 2013, p 131.
[5] Gille Deleuze ; le bergsonisme ; P.U.F ,9édition ; «Quadrige» 2008, paris presses universitaires de France,1966 ; le philosophe6, avenuereille ; 75014 paris, pp 1.2.
[6] Henri Bergson, L’évolution Créatrice, 1903, édition électronique (ePuB, PDF), Les Echos du Maquis, avril 2013, p 132.
[7] Johann Gottlieb Fichte (1762- 1814) هو فيلسوف ألماني واحد من أبرز مؤسسي الحركة الفلسفية المعروفة بالمثالية الألمانية. بدأ الفلاسفة والدراسون حديثا تقديره كفيلسوف مهم في حد ذاته لأجل رؤاه المختلفة في طبيعة الوعي الذاتي والإدراك الذاتي.
[8] Henri Bergson, L’évolution Créatrice, 1903, édition électronique (ePuB, PDF), Les Echos du Maquis, avril 2013, p 133.
[9] Ibid, p 137.
[10] Henri Bergson, L’évolution Créatrice, 1903, édition électronique (ePuB, PDF), Les Echos du Maquis, avril 2013, p 138.
[11] Ibid, p 139.
[12] Henri Bergson, L’évolution Créatrice, 1903, édition électronique (ePuB, PDF), Les Echos du Maquis, avril 2013, p 139.
[13] Ibid, p 139.
[14] Henri Bergson, L’évolution Créatrice, 1903, édition électronique (ePuB, PDF), Les Echos du Maquis, avril 2013, p 130.
[15] Ibid, p 136.
[16] Ibid, p 137.
[17] للتوسع في هذه الفكرة يمكن العودة إلى كتاب Le bergsonisme للفيلسوف الفرنسي “جيل دولوز”.
[18] بمعنى المدى أو الفسحة أو المسافة.
[19] Gille Deleuze ; le bergsonisme ; P.U.F ,9édition ; «Quadrige» 2008, paris presses universitaires de France,1966 ; le philosophe6, avenuereille ; 75014 paris, p11.
[20] نستطيع توضيح ذلك من خلال الشعار السقراطي المعروف “أيها الإنسان اعرف نفسك بنفسك”. والواقع إن هذا الشعار ليس مطلبا سيكولوجا نسيا، بل هو مطلب عقلي ومعرفي، وبالتالي هو أعمق من الحالات السيكولوجية كالإدمان مثلا وغيرها كثير. ففي العمق هو مطلب مضاد للتوجه الطبيعي وللتوجه السفسطائي الديمقراطي وللتوجه الأرستقراطي، إنه يتجاوزها ليؤسس المعرفة الميتافيزيقة على الإنسان. فإذا كان أول طريق لسقراط هو (الوعي بالذات)، لإدراك النفس حقيقة نفسها، فإنه شرط ليس ببعيد عن المضمون البرجسوني فيما يخص مسألة ضرورة التعاطف مع الموضوع حتى يتسنى لنا وضعه وضعا صحيحا وليس وضعا زائفا.