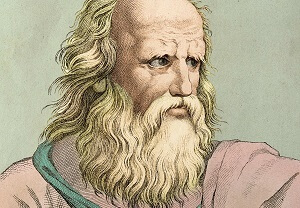-
تقديم
يبدو أن الحديث عن كتاب “الجمهورية” للفيلسوف اليوناني “أفلاطون Platon” (حوالي 427-347 ق.م) يدفعنا إلى أن ننطلق من الأسئلة التالية:
-
ـ ما هي طبيعة هذا العمل الفلسفي الأصيل الذي ظل مرجعا أساسيا في تاريخ الفلسفة والتربية معا؟
-
ـ ما هي المكانة التي يحتلها التعليم والتربية داخل الكتاب؟
-
ـ هل يمكن أن نتحدث عن نظرية تربوية/ تعليمية أفلاطونية؟
من المعلوم أن التراث الفلسفي لأفلاطون يصنف عادة ضمن “المحاورات”، حيث تحمل المحاورة عنوانا دالا في الغالب على موضوعها، وهكذا نجد على سبيل المثال:
محاورة السياسي والقوانين -< المسألة السياسية.
محاورة إقراتيلس -< أصول اللغة
محاورة المأدبة -< الجمال والحب
محاورة فيدون -< خلود النفس وموت سقراط
محاورة مينون -< الفضيلة وطبيعة الظن الصادق.
محاورة دفاع سقراط-اقريطون -< محاكمة سقراط وسجنه..
محاورة جورجياس -< نقد الخطابة التي لا تتوخى العدل.
تنطلق هذه المحاورات الأفلاطونية الأساسية من قضية محددة محاولة الإحاطة بها عبر محادثة غالبا ما يكون سقراط هو بطلها، ورغم أن موضوعات هذه المحاورة أو تلك قد تتشعب وتتداخل عناصرها تبعا لعفوية الحوار، إلا أن الأساس يظل هو القضية المحورية التي يحدد في منطلق المحاورة.
إذا كان هذا هو ما يميز، عادة، الكتابة الفلسفية الأفلاطونية، فإن محاورة “الجمهورية” تكسر -نسبيا- هذه القاعدة، ذلك أن كتاب الجمهورية -رغم النبرة السياسية التي يوحي بها العنوان- يمثل صورة عامة للنسق الفلسفي الأفلاطوني، فالباحث في الأنطولوجيا (مبحث الوجود) لا يجد بدا من الاعتماد على “الجمهورية”، كذلك الشأن بالنسبة للباحث في نظرية المعرفة، أو السياسة أو الأخلاق… بتعبير آخر، فكتاب الجمهورية يظل أكثر مؤلفات أفلاطون إبرازا وتعبيرا عن فلسفته في كليتها. ومن المؤكد أن ما كان يشغل أفلاطون في محاورة الجمهورية هو بالذات البحث في الكيفية التي يكون بها حكم المدينة عادلا وفاضلا، لكن هذا الهدف لا يتأتى ويتحقق داخل الكتاب إلا من خلال فهم الرؤية الأنطولوجية والأخلاقية التي هي الممهد لتحقيق العدالة، كما أن هذه العدالة لا تتحقق إلا بأسلوب معين في التربية والتعليم والمعرفة… هذا التداخل هو الذي يجعل رجوع الباحث في الشؤون التربوية إلى كتاب الجمهورية أمرا مشروعا ومبررا.
إذا كان الرجوع إلى محاورة الجمهورية بحثا عن تصور أفلاطوني للتربية والتعليم أمرا مبررا كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن السؤال التالي يفرض نفسه: ما هي طبيعة الأفكار التي يطرحها أفلاطون في هذا الكتاب حول التربية والتعليم؟ هل الأمر يتعلق بنظرية تربوية متكاملة لها مقدماتها وطرقها وغاياتها، أم بـ “أفكار” عابرة اقتضاها السياق الفلسفي العام للمحاورة؟ ما هي الحدود الفاصلة -إن وجدت- بين أفلاطون الفيلسوف وأفلاطون المربي/المعلم؟
إن كتاب “الجمهورية” ليس كتابا متخصصا في الشأن التربوي بالدرجة الأولى، ذلك أن الهاجس المحرك الذي حفز على إنجاز المحاورة يتعلق بشؤون أعم وأشمل، شؤون الوجود، المعرفة، والسياسية… وبالتالي فإن المسألة التربوية رغم حضورها واختراقها للكتاب ككل تظل “وسيلة” لا غاية، نهجا لا نظرية. هذا المنحى يبرره أمر آخر يتعلق بمن يعنيهم أفلاطون وهو يضع أفكاره التربوية، فهو لا يتحدث عن تربية وتعليم للمجتمع، وإنما عن نهج تربوي/تعليمي يهم فئة محددة مختارة ومنتقاة، وهكذا إذا كانت “النظرية” هي ما يكون قابلا للانطباق على “العام”، فإن الأفكار أو “النهج” ينطبق على الخاص، يقول الأستاذ “فؤاد زكريا” في دراسة أنجزها عن محاورة للجمهورية: “فمن الواجب أن ننبه منذ البداية إلى أن أفلاطون لا يقدم إلينا في هذه المحاورة نظرية شاملة في التربية، بل يقدم إلينا منهاجا لتربية فئة مختارة من المواطنين فحسب، والفارق بين الحالتين كبير: إذ أن المثل التربوية العليا التي تهدف إلى تنوير المواطن بوجه عام لا بد أن تختلف عن تلك التي تهدف إلى تثقيف صفوة مختارة منهم: فالأولى ديمقراطية شاملة، والثانية أرستقراطية انتقائية. ولا شك أن كتابات أفلاطون تفتقر إلى نظرية متعلقة بالنوع الأول من التربية، ولكنها تبدي اهتماما بالغا بالنوع الثاني.”(1)
لا يسعى أفلاطون، إذن، إلى وضع تصور متكامل وشامل للتربية يمكن أن يجد كل فرد نفسه داخله، بقدر ما يخاطب فئة معينة [سنعود لطبيعة هذه الفئة في الفقرات اللاحقة]، وبالتالي فمن يوجد خارج هذه الفئة لا تهمه الأفكار التربوية الأفلاطونية لأنها متعارضة مع “طبيعته” ومع ما هو مؤهل له. إن الطابع الانتقائي في الأفكار التربوية الأفلاطونية واضح، طابع يفسره رفض أفلاطون لـ”ديمقراطية” أثينا، وللتعليم السوفسطائي الذي يدعي -في نظر أفلاطون- أن كل فرد يمكنه أن يحصل التعليم. إن طبائع الناس حسب أفلاطون متفاوتة، وميولهم متباينة، وقدراتهم متراتبة، وعليه، لا يمكن أن يكون التعليم الحقيقي عاما بقدر ما ينبغي أن ينحصر في فئة لها مواصفات معينة ومؤهلات محددة، يقول أفلاطون على لسان سقراط وغلوكون:
” س – فمن الواجب إذن أن نختار طبائع من هذا النوع، وأن نفضل أكثرها ثباتا وشجاعة، وأجملها إن أمكن. ولكن علينا بالإضافة إلى ذلك ألا نقتصر في بحثنا على صفات الكرم والرجولة، بل ينبغي أن نبحث عن المواهب الطبيعية الملائمة لهذا النوع من التعليم.
ـ وما هي هذه المواهب؟
س ـ لا بد أن يتصفوا بالذكاء وسهولة التعليم، إذ أن التعب يصيب الأذهان من الدراسات الشاقة أكثر مما يصيبها من تمرينات البدن لأن العبء يقع في هذه الحالة عليها وحدها، دون أن يشاركها فيه البدن.
فقال: هذا صحيح
س ـ ولا بد لهم أيضا من قوة الذاكرة، والجلد على المشقة، وحب العمل في كل صوره، وإلا كيف ننتظر من شخص كهذا أن يتحمل أعباء التدريب البدني، وأن يمضي بعد هذا في الدراسات العقلية التي حددناها إلى نهايتها”(2).
ما هو “هذا النوع من التعليم” الذي يراه أفلاطون ملائما لهذه الفئة المختارة؟ ما هي طبيعة البرنامج التعليمي والتربوي الذي يوجه لهذه الفئة التي سينبثق منها “حراس المدينة”؟
-
I – المرحلة الأولى: تدريب البدن وتعليم الموسيقى:
في الدراسة التي قام بها الدكتور فؤاد زكريا لكتاب “الجمهورية”، والتي سبقت الإشارة إليها آنفا، يعتبر أنه بالإمكان تقسيم مراحل التربية والتعليم عند أفلاطون انطلاقا من مراحل، وهكذا سيصبح بالإمكان أن ننظر إليه على ضوء ثلاث مراحل: أولى أو ابتدائية، ثانية أو ثانوية، ثم ثالثة أو عليا.
يبدأ التعليم في نظر أفلاطون بمرحلة أولى لها مميزات خاصة ورهانات محددة، يقول ذ.فؤاد زكريا: “عالج أفلاطون، في محاورة الجمهورية، نظم التعليم على مراحل ثلاث، تناظر الأولى منها مرحلة التعليم الابتدائي في العصر الحديث، وقوام هذه المرحلة هو تدريب البدن والموسيقى، أي تنمية الجسم والروح في الوقت الذي يكونان فيه قابلين للتشكل”(3).
يحتل التعليم الموسيقي والتربية البدنية المكانة الأساسية في هذا التعليم الأولي، غير أن إنجاز هذه المهمة يتطلب في نظر أفلاطون تنقية عقول الأطفال مما ترسخه الحكايات الأسطورية، هذه الحكايات التي لها مفعول سحري يصادف فراغ ذهن الطفل مما يسهل رسوخه، فالاتجاه نحو الموسيقى وتربية الجسم يقتضيان أن يمهد لهما بتعويد الطفل على سماع ما يؤهله لما هو جميل وسام، يقول أفلاطون على لسان سقراط:
“ذلك لأن الطفل لا يستطيع أن يميز الأسطوري من الواقعي، ولا شك أن كل ما يتلقاه ذهنه في هذه السن ينطبع فيه بعمق لا تمحوه الأيام ولذا كان من أخطر الأمور أهمية أن تكون أولى القصص التي تطرق أسماع الأطفال أمثلة سامية للأفكار الفاضلة”[ص67].
عندما يتحدث أفلاطون عن القصص الأسطورية، فإنه يشير، صراحة، إلى الشعراء وخاصة أشعار “الإلياذة والأوديسة”، التي يعتبرها تروج لأساطير غير حقيقية عن الآلهة والحياة، ومن تم فهي تساهم في إفساد عقل الطفل وتدخل الرعب إلى ذاته. ومن تم يحذر أفلاطون من أن تصبح هذه الأشعار هي جوهر ما تحكيه الأمهات للأطفال: “… ولنحذر أن ندع الأمهات يدخلن الرعب في قلوب أطفالهن بمثل هذه الأساطير التي ابتدعها الشعراء، فيقلن لهم إن الآلهة تهيم في الليل متنكرة في زي غرباء في صور متعددة أخرى. ففي هذا تجديف في حق الآلهة، وتخويف للأطفال في نفس الآن” [ص 72].
يبدو أن الموقف السلبي لأفلاطون اتجاه الشعر يأتي من هذه المسألة التربوية بالدرجة الأولى، فالشعر في نظر مؤلف “الجمهورية” يستقي مادته من أساطير غريبة وغير معقولة يصنع منها صورا لا تتلاءم مع مقتضيات العقل أولا وما يجب من احترام اتجاه الآلهة ثانيا، ولهذا لا يمكن جعل الشعراء نماذج يقتدي بها الطفل، بل يتعين البحث عن نموذج آخر، ولهذا أيضا أصبح من الضروري:
“… أن نسعى إلى الفنانين الذين تهديهم غريزتهم إلى الإقتداء بكل ما هو جميل متناسق، كيما يجني الناشئون الذين يقيمون في بيئة صالحة، الخير من كل ما يحيط بهم، ويتأثرون بكل الأعمال الطيبة التي تبتدى لأعينهم وآذانهم وكأنها نسيم يجلب معه العافية من مناطق صحية ويوجههم منذ نعومة أظفارهم دون وعي منهم نحو حب الجمال ومحاكاته والسعي إلى الانسجام الكامل معه”[ص 97].
إن من يستحق أن يقود الطفل ويكون قدوة له ليس من يعلمه الأساطير وإنما من هو قادر على زرع حب الجمال فيه والانسجام معه والنسج على منواله. إن فكرة الانسجام هذه تحتل مكانة خاصة في كتاب الجمهورية، بل إنها مدار الفلسفة الأفلاطونية ككل، فالانسجام بين الطبقات هو تحقيق العدالة على مستوى الدولة، والانسجام بين أجزاء الجسم هو سعادة الفرد… وما دام الفرد هو المقصود بالتعليم فأن إحلال الانسجام في ذاته يتوقف على آليات معينة يشكل التعليم الموسيقي والبدني منطلقها وأساسها، وهكذا فالموسيقى من حيث هي انسجام للأنغام والنبرات تتوجه إلى الروح لتعودها على الانسجام مع ما هو جميل ونبذ ما هو قبيح:
“… ومن هنا كانت الأهمية القصوى للموسيقى في التعليم، ذلك لأن الإيقاع والانسجام قادران على التغلغل في النفس والتأثير فيها بعمق، وهما يزينان النفس بما فيهما من جمال، وذلك إذا ما تم تعليمهما كما ينبغي، على أنهما يقبحانها إذا أسيء تعليمها، وفضلا عن ذلك فالتعليم الموسيقي إذا ما أحسن أداؤه يتيح للنفس أن تكشف مظاهر النقص والقبح فيما يبتدعه الفن وتخلقه الطبيعة – فيتأثر بهذا الكشف بحيث يشيد ما يراه من مظاهر الجمال، ويتقبلها في نفسه مسرورا فيجعل منها غذاءه ويغدو رجلا خيرا، ويحمل من جهة أخرى على الرذائل ويمقتها منذ نشأته قبل أن يستطيع التفكير فيها بعقله…”[ص 97].
ليس التعليم الموسيقي مطلوبا لذاته، ليس غاية، بل إنه وسيلة لغاية أرفع منه، غاية أخلاقية تتوخى تهذيب النفس وتقريبها من الجمال وإبعادها عن القبح. لكن إذا كان التعليم الموسيقي ضروريا للنفس. فإنه غير كاف، بل إن المبالغة فيه، والاكتفاء به يؤدي إلى أن تصبح هذه النفس رقيقة، ضعيفة، سهلة التأثر، لهذا وجب في نظر أفلاطون جلب القوة والمنحة لها، وذلك لا يتأتى إلا بتدريب البدن وتعويده على المشقة وتحملها، أي لا يتأتى إلا بتربية بدنية تتوخى تقوية عود الجسم وزرع قيم الشجاعة فيه. وللإشارة، فما يصدق على التعليم الموسيقي وحده من حيث هو يؤدي إلى الرقة والضعف، يصدق أيضا على الرياضة البدنية وحدها، قد تؤدي إلى الخشونة والميول العنيفة، ومن ثم فالموسيقى ضرورية للرياضة بنفس القدر الذي تكون به الرياضة ضرورية للموسيقى، إن المسألة هنا -مرة أخرى- مسألة انسجام، مسألة قيادة للطفل لا تغفل أي عنصر فيه، يقول أفلاطون:
“… ففي وسعي إذن أن أقول إن الله إنما وهب الإنسان فني الموسيقى والرياضة البدنية من أجل هذين الهدفين: الشجاعة والفلسفة، فهو لم يهبنا إياهما من أجل النفس والجسم، ما لم يكن ذلك بطريقة عارضة، وإنما كان هدفه الأساسي هو هاتين الصفتين: الشجاعة والفلسفة، كيما يتم انسجامهما بقدر ما نشدهما أو نرخيهما على النحو الملائم (…) وعلى ذلك، ففي وسعنا أن نقول عمن يمزج الرياضة والموسيقى على أجمل نسبة ممكنة، ويطبقها في نفسه بأدق قدر من الاتفاق، إنه أمهر الموسيقيين وأبرعهم في الانسجام، وأنه أبرع كثيرا من ذلك الذي يلائم بين أوتار الآلات الموسيقية…”[ص 111].
إن من يجب أن يكون أهلا لحراسة المدينة وقيادتها ليس مسموحا له ألا يقود ويحرس نفسه أولا، وحراسة النفس وقيادتها تبدأ بالنسبة لأفلاطون بتشذيبها وتنقيتها من الأساطير والبحث فيها عن الوئام والانسجام، وتلك بامتياز هي مهمة الرياضة والموسيقى في المرحلة الأولى، فليس ممكنا أن يحقق العدالة والانسجام في المدينة/الدولة من عجز عن تحقيق ذلك في نفسه.
-
II – المرحلة الثانية: الرياضيات وتهييء النفس لتأمل المثل
إذا كان تعليم الرياضة البدنية والموسيقى يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجسم والنفس، بين الشجاعة والذوق السليم، وإذا كان هذا التكامل ضرورة فردية بنفس قدر حاجة المدينة/الدولة إليه، فإن هذا التعليم لا يمثل إلا الخطوة الضرورية الأولى تتلوها مراحل أخرى، وفي هذا الصدد يتحدث الأستاذ فؤاد زكريا عن المرحلة الثانية في التعليم والتربية الأفلاطونيين قائلا:
“يمكن القول بوجه عام إن المرحلة الثانية في برنامج أفلاطون التعليمي تناظر المرحلة الثانوية في النظام التعليمي الحديث، وإن كانت السن التي حددها أفلاطون لهذه المرحلة، وهي ما بين العشرين والثلاثين، تتجاوز بكثير نطاق المرحلة المناظرة لها في عالمنا الحديث”(4).
في مرحلة معينة يتوقف التعليم البدني والموسيقي لأنه يكون قد استنفذ مهامه، ولا يبقى كافيا لتطوير الفرد وإنضاج ملكاته وتهييئه للمهام المنتظرة منه، فما الذي تقتضيه هذه المرحلة الجديدة؟ ما هو نوع التعليم الذي يبدو ملائما، في نظر أفلاطون، لتهييء الفرد؟ لننصت إلى أفلاطون، على لسان سقراط وغلوكون، وهو يحدد المجال التعليمي لهذه المرحلة:
” ـ أجل، بالتأكيد، ولكن أي علم يتبقى بعد استبعاد الموسيقى والرياضة البدنية والصناعات؟
ـ فقلت:إذا لم نجد أي شيء عدا هذه،فنجرب ذلك العلم الذي يتصل بكل الفروع السابقة معا
ـ وما هو: أعني مثلا ذلك العلم العام الذي يستخدم في جميع الصناعات والعمليات العقلية، وفي كل أنواع المعرفة، وهو العلم الذي ينبغي أن يتعلمه كل إنسان قبل غيره من العلوم.
ـ وما هو؟
ـ ذلك العلم المألوف الذي يعلمنا التمييز بين الأرقام، واحد، واثنين، وثلاثة، أي علم العدد والحساب. أليس صحيحا أن هذا علم لإغناء عنه في كل صناعة وكل علم آخر؟
ـ بلى، بالتأكيد”[ص 257].
لا يحدد هذا المقطع من كتاب الجمهورية نوع التعليم في المرحلة الثانية فقط، بل يقدم لنا أيضا بعض خصائص هذا النوع التعليمي:
ـ فإذا كانت الرياضيات هي ما ينبغي أن يتعلمه المتلقي الأفلاطوني، فلأن ذلك مرتبط بأمور حيوية، ذلك أن ممارسة شؤون الحياة مهما كانت بساطتها. وإتقان جميع أنواع المعارف… كل ذلك يتوقف، بمعنى ما، على الرياضيات، على العلم الذي يهيء لنا شروط التمييز في أولى صوره، ولذلك يلح أفلاطون على أن هذا العلم يجب “أن يتعلمه كل إنسان قبل غيره من العلوم”.
ليست الرياضيات تخصصا وإنما هي فرع معرفي مشترك يهيء لمراحل عليا.
ـ بالنظر إلى كونها تمثل أساسا لكل تعلم، فإن الرياضيات، في هذه المرحلة، تحتل درجة الضرورة، ضرورة ما دام باقي أنماط التعلم تتوقف عليها، وضرورة لأن من يريد حسن التمييز، وضبط استعمال عقله لا يتأتى له ذلك إلا بهذا العلم، وليس غريبا، تبعا لما سبق، أن نجد أفلاطون يضع إتقان الرياضيات كشرط للانخراط في الأكاديمية، وبالتالي للتفلسف.
يمكن أن نتساءل مع أفلاطون حول الحاجة الحقيقة وراء الإلحاح عن ضرورة تعليم الرياضيات، فهل الأمر يتعلق فقط بكون هذا العلم هو شرط ضروري لباقي المعارف. أم يتجاوز ذلك؟ يجيبنا أفلاطون بوضوح قائلا:
” ـ فقال: من الواضح أن الهندسة تنفعنا بقدر ما تتصل بالعمليات الحربية، إذ أن قدرة القائد على إقامة المعسكرات، والتحصن في المواقع المنيعة، ونشر جيشه أو تركيزه، وأداء التشكيلات الأخرى خلال المعركة وأثناء السير، كل هذا يتوقف على مدى علمه بالهندسة.
ـ فاستطردت قائلا: إن قدرا ضئيلا من الهندسة والحساب يكفي لتحقيق هذه الأغراض، ولكنا نود أن نبحث فيما إذا كانت الدراسة الأكثر تعمقا والأعظم تقدما لهذا العلم، تساعدنا على بلوغ هدفنا، ألا وهو تأمل مثال الخير. ولقد ذكرنا من قبل أن أية دراسة تدفع النفس إلى التوجه إلى أجل الموجودات وأسماها، والانصراف إلى تأمله، هي دراسة من هذا النوع” [ص 264].
نحن أمام تحديد أكثر دقة لمجال وأهداف تعليم الرياضيات في محاورة الجمهورية، أهداف يمكن تقسيمها إلى مستوى عملي، وآخر نظري:
ـ على المستوى الأول، يفيد تعليم الرياضيات، بشقيه الحسابي والهندسي، في تهييء الفرد/المسؤول لإنجاز مهام الحرب بشكل منظم ومضبوط بعيد عن العفوية، فقيادة الجيش، والتخطيط للحرب، وحسن التصرف أثناء المعركة… كل ذلك يتوقف على معرفة الخصائص الهندسية للمكان، والإطار الكمي للخصوم… إن الرياضيات بهذا المعنى جزء من أدوات المدينة، ومتعلمها يفعل ذلك لغرض حراسة المدينة والدفاع عنهما. غير أن هذه المهام ليست كل ما ينتظر من تعليم الرياضيات في نظر أفلاطون، بل أكثر من ذلك، فهذه المهام “العملية” لا تحتاج في الحقيقة إلا إلى الجزء البسيط من الرياضيات، في حين هناك وظيفة عليا يقصدها هذا النوع من التعليم.
ـ على المستوى الثاني، تتجاوز الرياضيات حيز العمليات اليومية العملية لتتحول إلى “رياضة عقلية” تهدف تعويد العقل والنفس على السمو،فليست وظيفة الرياضيات هي تسهيل عمليات “البيع والشراء”، بل هي دفع الفرد إلى الارتفاع عن المعطيات الحسية ومعانقة عالم المثال/الخير الأسمى، [واضح هنا ارتباط هذه الفكرة بالتصور الأنطولوجي الأفلاطوني المؤسس على ثنائية الحس/الزائل والمثال/الخالد…]. ليست الرياضيات هدفا في ذاته، بل هي في أبسط صورها وسيلة للعمل، وفي أعلى صورها وسيلة للنظر العقلي.
يبدو من خلال الفقرات السابقة، أنه في كل مرحلة تربوية/تعليمية يكون هناك ما هو ضروري ومرغوب فيه، وهكذا كانت الرياضة والموسيقى مطلوبتين في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية أصبحت الرياضيات هي المطلوبة، وإذا كان التصوير الأسطوري مرفوضا في المرحلة الأولى، فإن ما هو غير مرغوب فيه في هذه المرحلة الثانية هو ما يسميه أفلاطون بـ: “الديالكتيك“، ذلك أن “الجدل” في المنظور الأفلاطوني يمكن أن يكون ذا قيمة عليا معرفيا، بل وهو غاية كل تعليم عال، ولكنه يمكن أن يتحول إلى معرفة دنيئة لا تهدف إلا إلى المغالطة. إن “الديالكتيك” يكون أساسيا عندما يعلم بطرق ملائمة وفي المرحلة الملائمة، أما عندما يلقن بطرق غير مناسبة وفي مرحلة ليست هي مرحلته فإنه يؤدي مفعولا عكسيا، يقول أفلاطون في هذا الصدد: “ومن أهم الاحتياطات أن نمنعهم من ممارسة الديالكتيك وهم لا يزالون في حداثتهم، ولعلك لاحظت من قبل أن المراهقين الذين تذوقوا الديالكتيك لأول مرة يسيئون استعماله، ويتخذونه ملهاة ولا يستخدمونه إلا للمغالطة، فإذا ما قام أحد بتنفيذ حججهم فإنهم يحاكونه ويفندون حجج الآخرين على نفس النحو، شأنهم في ذلك شأن الجرو الذي يجد لذة في جذب كل من يقترب منه وتمزيق ملابسه” [ص 281].
عندما يتم تعليم “الديالكتيك” [فن القول المبني على الحجة العقلية..] إذن في مرحلة غير مؤهلة له فإنه لا يؤدي إلا إلى المماحكة الكلامية، والجدل العقيم، والواقع أن أفلاطون لا ينتقد متعلم الجدل هنا، بل من كان مسؤولا عن ذلك، أي “السوفسطائية”. التي عملت -كمدرسة فلسفية وتعليمية- على إشاعة الجدل وتعميمه دون رقابة، حسب أفلاطون.
إن مزاج المراهق ميال إلى العناء والخوض في ما لا يعلم، وعندما نعلمه الديالكتيك فنحن بذلك نزوده بالوسيلة الأساسية لترسيخ هذا المزاج بل دفعه إلى استعمال عقله والتريت في الأحكام والاستدلال بالحجة على كل دعوى يدافع عنها، وهذه الخصائص لا تتاح -في نظر أفلاطون- إلا لمن اجتاز المرحلتين السابقتين وأظهر قدرة على التأمل.
-
III – المرحلة الثالثة: التأمل العقلي الخالص
يحدد الدكتور فؤاد زكريا في دراسته لمحاورة الجمهورية المشار إليها المرحلة النهائية من التعليم الأفلاطوني قائلا:
“أما هذه المرحلة الأخيرة فتوازي، في نظامنا التعليمي الحديث، مرحلة التعليم الجامعي، وإن كانت تبدأ في سن الثلاثين. ومن الواضح أن هذه هي مرحلة الانتقاء النهائي، وأن أولئك الذين ينالون هذا النوع من التعليم هم خلاصة عملية الاختيار التي تتم طوال المراحل السابقة”(5).
إذا نظرنا إلى هذه المرحلة الأخيرة من التربية والتعليم في سياق المحاورة ككل أمكننا القول إنها [أي المرحلة] هي الغاية، أما بقية المراحل فليست إلا استعدادا وتهييئا لها، وهكذا، ففي هذه المرحلة لا يصل إلا من ظهرت مؤهلاته واستوعب مظاهر المرحلتين السابقتين. ترى ما الذي ينتظر هذه “النخبة المنتقاة” من تعليم في هذه المرحلة الأخيرة؟
اتضح في نهاية المرحلة الثانية أن تعليم الرياضيات يسعى إلى ما هو أرقى من الوظيفة العملية، إلى تهييئ الفرد للتأمل والتفكير المجرد، هذه النهاية هي بداية المرحلة الثالثة،ففيها لم يعد مطلوبا من الفرد أن يسجن نفسه في عالمه المباشر، عالم التجربة اليومية، الحسية، المتغيرة والزائلة، لأنها -في نظر أفلاطون- مجرد ظل يتعين معرفة أصله، يقول أفلاطون محددا الشروط الأولى للتعليم العقلي:
“… أما الشرح الذي قدمناه فيعني (…) أن لكل نفس القدرة على التعلم، ولديها عضو خاص لهذا الغرض. وكما أن العين لا تستطيع أن تتجه من الظلام إلى النور إلا إذا اتجه معها الجسم بأسره، فكذلك ينبغي أن تنصرف النفس بأسرها عن هذا العالم المتغير، حتى تصبح قادرة على تأمل الوجود، وأبهر ما في الوجود، وهو الذي أسميناه بالخير…” [ص 251].
تبدأ هذه المرحلة التعليمية، إذن، بإبراز الفرد لمؤهلات وقدرات خاصة تجعله متبينا للفروق بين العادة والحق، المنظور والمعقول، الظلام والنور، الظل والأصل… أي مستعدا لمغادرة “الكهف” وفهم حقائق وأصول ما يقع فيه. إن الأمر يتعلق هنا بعتبة التفلسف، أي بالتخلص من قيود المحسوس وما يشوبه من ظنون وأوهام وأشباه الحقائق، وبتخليص النفس من الشوائب التي تعلق بها بحكم اعتيادها على هذا العالم المتغير، وتحريرها من قيود اللذة والشهوة الحسيتين.
إن بداية التفلسف هي امتلاك القدرة على مغادرة الكهف ورؤية الحقيقة بأكبر قدر من الوضوح، وهو ما يتأتى إلا بإعادة تركيب قوى النفس [الحيوانية – الغضبية – العاقلة] وإخضاع ما ليس عقلانيا لما هو عقلاني، إن التربية بهذا المنظور الأفلاطوني، وكما تقول “سارة كوفمان“:
“تسعى إلى وضع العدالة وإلى إعادة وضع كل جزء إلى مكانه المخصص له وذلك بإحلال الرغبات في مكان دون [النوس ]وتنمية النفس الغضبية التي لا بد من معاونتها من أجل القضاء على التسلط الذي تمارسه الرغبات تلقائيا…”(6).
إن مهمة المربي هي أن يساعد المتعلم، في هذه المرحلة، على تعويض المشاهدة العادية، والإنصات لنداء الحواس المباشرة… بتأمل حقائق الأشياء، وهي مهمة لا تخلو من مشقة وعناء بالنظر إلى ما اعتاد عليه الفرد، لكن طريق الحقيقة بطبيعته شاق، والخروج من الظلمة إلى النور مؤلم دوما للعين، ومن تم لا بد من الاستعداد للسير فيه خصوصا بالنسبة لمن يطمح في السعادة الحقيقية، السعادة المتحصلة بحصول المعرفة، معرفة الخير الأسمى، فالفضيلة والسعادة لا تتأتيان إلا بمثل هذا الجهد المضني المؤدي إلى السلوك الحكيم سواء في الحياة الخاصة أو في شؤون المدينة/الدولة.
إن اتباع هذا الطريق الوعر لا يحقق سعادة وفضيلة الفرد فقط، بل إنها هي الضمان الوحيد لسعادة المدينة، وهكذا فمن يعرف مثل وحقائق الأشياء هو المؤهل أكثر من غير لقيادة الدولة/المدينة، هذه الأخيرة لا يمكنها أن تتخلص من الشر والتطاحن والسقوط في الرذائل إلا عندما يتولى شؤونها العامة حاكم/حكيم أو حكيم/حاكم. يقول أفلاطون في محاورة الجمهورية، موضحا هذا الارتباط الدال بين الحكم والحكمة/الحكمة والحكم:
“… إن وسيلة تكوين دولة حكمهما صالح هي أن تجد لمن ينبغي أن يتولوا الحكم فيها سبيلا في الحياة أفضل من الحكم، وعندئذ فقط تكون مقاليد السلطة في أيدي الأغنياء بحق لا أغنياء الذهب، وإنما أغنياء الفضيلة والحكمة، وهو الغنى الذي لا بد منه لتحقيق السعادة. أما حين يقتحم ميدان الشؤون العامة أناس شرهون مهمون إلى إثراء حياتهم الخاصة، آملين أن يختطفوا منها السعادة التي يتوقون إليها، فعندئذ يستحيل أن تقوم حكومة صالحة، إذ أنهم سيتصارعون في سيبل الحكم حتى تقضي هذه الحرب الداخلية عليهم وعلى الدولة بأسرها” [ص 254].
-
IV – خلاصات ونتائج: المنظور الأفلاطوني للتعليم والتربية
إن تتبعنا للمراحل التي رأى أفلاطون أنها كفيلة بتكوين فئة صالحة لنفسها وللمدينة لا يمكن إلا أن يجعلنا ننتبه إلى ما يبدو أساسيا فيها، ويمكن الاقتصار في هذا الشأن على ما يلي:
-
التعليم والمدينة/الدولة: تنعت الفلسفة الأفلاطونية عادة بإغراقها في “المثالية” ويقرن النعت هنا بالطوباوية الحالمة، والواقع أنه -بالإضافة إلى كون الطوبى والحلم جزءا من الواقع- ليس لدى أفلاطون هذا النزوع السحري والأعمى نحو الحلم الفارغ ذلك لأن الفكرة الأفلاطونية في التعليم والتربية مرتبطة عضويا بالمجتمع، بالمدينة/الدولة، ففي كل مرحلة تعليمية يذكرنا أفلاطون أن ما يتعلمه الفرد ليس لذاته بل لغرض حراسة الدولة عسكريا، تحقيق الانسجام والتكامل، وأخيرا تحقيق السعادة والفضيلة. لا شيء إذن يقفز عن المعطى الحي، عن هموم الفرد والدولة، والتعليم لا معنى له بدون هذا الارتباط العضوي بالشؤون الخاصة وبالشأن العام.
-
التدرج في التعليم: ما يلاحظ بوضوح في التصور الأفلاطوني هو أن لكل شيء أوانا خاصا به، يوجد “تخطيط” محكم تتدرج فيه اللحظات وتتكامل وتتراتب، فلا معنى لتكليف الذات بتأمل مثال الخير دون أن تكون لها مناعة جسمية وحاسة ذوقية سليمة وقدرة رياضية تمييزية، كما أنه لا معنى لأن نطلب ممن استطاع معرفة حقائق الأشياء أن يعود إلى “ظلمة الكهف”، أو تعلم الحساب من جديد. إننا أمام تدرج تفرضه طبيعة الأشياء ورغبة توجيه النفس من الأسفل إلى الأعلى، إن التربية بهذا المعنى هي: “أن تجعل بصر النفس يمر من ظلمة الكهف إلى نور العالم المعقول: وإذا أردنا أن نتجنب إصابة العين ينبغي أن نعود عين النفس، النوس، تدريجيا على أن تسير في الاتجاه الصحيح وأن تقوم بتغيير وجهة نظرها..”(7). إن التدرج في التعليم لا تفرضه فقط طبيعة الأشياء والرغبة في السمو بالنفس، بل يفرضه أيضا حس بيداغوجي يتوخى جعل التعليم لذة يشعر معها المتعلم أنه يتجاوز ذاته في كل لحظة، وفي كل لحظة يتولد لديه طموح أكبر للمعرفة، وبذلك يتحول التعليم إلى فضاء تفرز فيه الميولات والملكات بشكل تلقائي بعيد عن كل عنف أو فرض، وهذا ما يعلنه أفلاطون صراحة بقوله: “… وإذن فليس لك، أيها الصديق الكريم، أن تستخدم القوة مع الأطفال، وإنما عليك أن تجعل التعليم يبدو لهوا بالنسبة إليهم، وبهذه الطريقة يمكنك أن تكشف بسهولة ميولهم الطبيعية” [ص 278].
-
أفلاطون ومسألة الراهنية: هل ينتمي أفلاطون فعلا إلى زمن ولى وانتهى؟ هل ما تضمنه كتاب “الجمهورية” على المستوى التربية-التعليمي ينتمي إلى ذاكرة تفصلنا عنها قرون طويلة؟! لا شك أن مثل هذه الأسئلة تبدو مستفزة لكل ذهن لا يستطيع النظر خارج الرؤية الخطية للأفكار، الرؤية التي تبدو فيها الأفكار وهي تتلو بعضها البعض. وفعلا، إذا نظرنا إلى المضامين الفكرية الأفلاطونية على ضوء نزعة تأريخية صرفة اتضح لنا أن الأمر يتعلق بفيلسوف وفلسفة ينتميان إلى زمن ولى لكن- ألا يوجد إلى جانب هذا البعد التأريخي حيث الانتماء إلى الماضي، بعد آخر حاضر حيث مازال أفلاطون يسائلنا ويوجهنا ويمدنا بإمكانيات لا حصر لها لتلمس طريق الحقيقة سواء على المستوى التربوي-التعليمي أو غيره من المستويات؟ هل يمكننا اعتبار “الحوار” كخاصية أساسية للفلسفة الأفلاطونية، وكأسلوب جوهري في التعليم والتعلم متجاوزا؟ ألا يبدو تحليل أفلاطون للبعد الفني -الموسيقي في التربية متقدما مقارنة مع بعض تصورات العصر الحديث وبعض المجتمعات المعاصرة؟
لا تبتغي هذه الأسئلة الانتفاعية غير التأكيد على أن الرؤية الخطية -التأريخية للأفكار ليست سليمة عندما تنبني على مبدأ التجاوز المطلق والانفصال التام بين ماضي -ما انفك يحضر- وحاضر-ما انفك يمضي-، ذلك أن قضايا التربية والتعليم -شأنها شأن القضايا الكبرى- لا تخضع لمنطق القطيعة بين الماضي والحاضر، ومن هنا يكون: “استرجاع ما قاله الإغريق معناه أن نجد أنفسنا في وحدة القدر الذي هو قدرنا والذي صدر عنه كلام ما انفك يعود نحونا في الوضوح-الغامض للتراث، وحينئذ فليس العالم اليوناني “وراءنا” إلا ظاهريا، من حيث هو ماض تأريخي يمكن لعلم التاريخ أن يعرضه علينا، إنه ليس وراءنا بقدر ما يعنينا ويهم حاضرنا فيما ينطوي عليه من غموض، وفيما يقوى عليه من طاقة مستقبلية”(8).
مجلة الجابري – العدد التاسع عشر
الهوامش (المنظور الأفلاطوني):
- 1 ـ فؤاد زكريا: تصدير جمهورية أفلاطون – الهيئة المصرية العامة للكتاب 1985، ص 126.
- 2 ـ جمهورية أفلاطون، ترجمة: د.فؤاد زكريا، راجعها على الأصل اليوناني د. محمد سليم سالم، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة 1968، ص ص 275-276 [سنكتفي لاحقا بالإشارة إلى الصفحة فقط].
- 3 ـ فؤاد زكريا، نفس المرجع، ص 130.
- 4 ـ نفس المرجع، ص 131-132.
- 5 ـ نفس المرجع، ص 137
- 6 – Sarah Kofman, Philosophie terminée, Philosophie interminale, in Qui a peur de la philisophie? Flammarion chapms – Paris 1977, p. 26.
- 7 – Sarah Kofman – Ibid, p.26.
- 8 – Jean Beaufret, Préface du principe de raison, Gallimard, pp. 31-32.