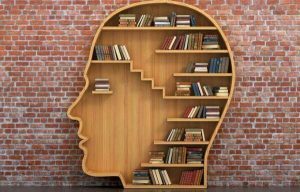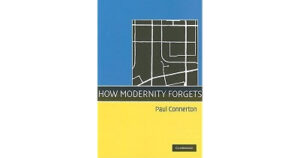| الكاتب | تشارلز تايلر |
| ترجمة | وحيد الهنودي |
أسس الزمن الحديث لميلاد شكل سياسي مستجد لم تعهده الإنسانية في تاريخها وبقدر ما أسهم هذا النظام في إنعتاق البشر من ربقة الاستبداد وأغلال الاضطهاد بانبثاق الذاتية التي ستتجذّر كذاتية حرة ومساوية في إنسانيتها للجميع قاطعة مع التراتب الاجتماعي المبني على الحظوة والامتيازات، فإن ذلك لم يكن مفصولا عن فصل جديد من فصول تحرر “الشر المطلق” الذي سينْهِك الإنسانية ويساهم في ولادة تيّار مُتَظَنِّنٍ على الحداثة مرتاب من نتائجها يحفر عميقا في تربة منابتها ليصل الفرع بالأصل ويستكمل صورة ظلت غائمة ومشوّشة فهل أذنت الحداثة كحدث بإنعتاق البشر فعلا كما وعدت؟
اليهودي المنبوذ
أرهق هذا السؤال حنة آرندت بالقدر الذي أرهق جيلها وما زال يرهقنا نحن قاطنة هذا الزمن الحديث غير أنه أرهقها لا فقط من جهة كونها فيلسوفة وهو اللقب الذي رفضته وتعففت عنه ولم تقبل أن تنعت به بل أساسا أرهقها كـ”إمرأة يهودية” فهي تقول: “أنا واحدة منهم هذا كل شيء، وهذا ينبع من البداهة ولا يمكن أن يوضع موضع نقاش.”[1] لقد رأت في الزمن الحديث منبتا لتشكّل ملامح “المنبوذ” .Le paria يوجد هنا انتقال جذري للمفهوم من سجلين أخلاقي قيمي وطبي إلى سجل سياسي.
لقد شهدت المجتمعات القديمة والوسيطة دوما منبوذين، غير أن هذا الوصم كان ينتمي لسياق أخلاقي فالمنبوذ هو الشخص أو مجموعة الأفراد الذين تم طردهم خارج الانتظام الاجتماعي وأجبروا على العيش في الهامش بسبب خروجهم عن الأعراف وعن الموروث الجليل وإجمالا عن السياق الأخلاقي الذي تفرضه الجماعة لتجعل منهم صعاليك وعاهرات.
لكن لم تعمد تلك المجتمعات إلى إفراغهم من إنسانيتهم بالكامل، فقد سُمِح لهم دوما بهامش من التحرّك والانوجاد باعتبارهم حاملين لقيم تختلف عن قيم المجموعة التي ينتمون إليها مثل الصعاليك الشعراء عند العرب وروبن هوود عند الغرب، وباعتبار سلوكهم غير قويم لا ينسجم مع الأخلاقية وهن العاهرات اللاتي كنا موصومات في العلن مفيدات للنظام الاجتماعي في الخفاء، فالمواخير نتاج اجتماعي يخضع لمراقبة سياسية ودينية إذ سيُسْمَح بإفراغ فائض اللذة الذي يمكن أن يؤدي إلى الفوضى.[2]
إشتغل مفهوم المنبوذ أيضا في سجل طبي كان قد أحسن الاعتناء بهم يشال فوكو في كتبه[3] ذلك أن المرضى والمعتوهين والمجاذيب خضعوا لمراقبة اجتماعية لم تتوان عن استعمال كل أدوات وأشكال العنف عبر الإبعاد والحرق والعزل لتنقية الفضاء الاجتماعي منهم خوفا من الشياطين التي كانت تلبسهم واتقاء للعدوى ولعل العبارة التي أكدها الشاعر العربي “أفردوني إفراد البعير المعبد” تغنينا عناء التعمّق في تحليل هذا الجانب.
إن ما يميّز الزمن الحديث هو ميلاد شكل جديد من النبذ لم تعهده الإنسانية في تاريخها فهو نبذ سياسي بالمعنى الآرندتي أو نبذ من الفضاء السياسي تزامن مع ولادة الدولة الأمة كشكل سياسي حديث حيث أدركت فيه الأمة بوصفها مجموعة سياسية متجانسة حاجتها للتعبير عن ذاتها وعن إرادتها سياسيا. تقوم الدولة الأمة على حدود جغرافية ثابتة تفصلها عن غيرها من المجموعات المجاورة لها والمختلفة عنها وتتجسّد سيادة تلك الدولة بقدرتها على مراقبة تلك الحدود والتحكم فيها. ويرتبط الجسم السياسي الحديث بحسب آرندت بثلاثة مستويات أوّلهاانهيار التراتبية الاجتماعية القديمة القائمة على الحظوة والمجد، إذ وفي تلك المجتمعات اعْتُبِرَتْ التراتبية مقبولة ومبررة وتستمد كل طبقة مكانتها ودورها الاجتماعيين من التاريخ الشخصي للأفراد، وقد أذن انهيار هذه التراتبية بولادة انتظام اجتماعي جديد يستند هذه المرة لما هو اقتصادي فـ
“في نظام طبقي كان قد وصل إلى هذه المرحلة من النضج، فإن هيئة الفرد قد تحدّدت بانتمائه لطبقة خاصة وفي علاقة بطبقة أخرى وليس بوضعه الشخصي في الدولة أو في جهاز الدولة.”[4]
إن هذا التقسيم الجديد للمجتمع قد قام على تناقض عميق في المصالح لذلك كان على كل طبقة أن تتشكّل سياسيا لتحمي مصالحها وتدافع عنها بأدوات قانونية، وهو ما سمح للدولة بأن تتحوّل إلى جسم سياسي يعلو على مصالح الطبقات المتصارعة لتتحوّل إلى إطار لـ “مصلحة الأمة” فقد “أتمّت تطوّرها وأُعْلِنَت فوق كل الطبقات مستقلّة كليا عن المجتمع وعن مصالحه الخاصة.”[5]
- النظرية الاجتماعية اليوم: حوار مع هارتموت روزا

- في ظلال الغد

- مذبحة العرفاء: مآلات التصوف والعرفان في المجال الشيعي

في هذا الفضاء تحوّلت فكرة “مصلحة الأمة” إلى فكرة هلامية وستواصل تحوّلها ذاك لتكون منطلقا “للشر المطلق”، إذ ستجمع شتات أفراد متذرّين وتعلو على مصالح من فقدوا المصالح. في هذا المناخ تحوّل دور الدولة الأمة إلى محاولة للتوفيق بين مصالح متعارضة لطبقات متناقضة اقتصاديا. إن مهمة منع أي طبقة من الاستئثار بالسلطة كان ضروريا وبسبب هذا الحياد السياسي الذي أُرْغِمَت عليه الدولة ستكون موضوع احترام وهدف مستباح للأحزاب في آن.
لقد شكّلت الدولة بموجب هشاشتها ذاتها ثنائي مع الأمة وكان عليها أن تبقى فوق الصراعات والتجاذبات لكنها من جهة قانونية استمرت في إقامة المساواة القانونية بين الأفراد قاطعة نهائيا مع الحظوة والامتياز فـ “من ناحية توجّهت الدولة فعلا إلى جعل كل المواطنين متساويين ومن ناحية أخرى وضع المجتمع كل فرد في طبقة.”[6] لقد خلقت المساواة القانونية أفرادا خارج الطبقات الاجتماعية وبالتالي خارج الفعل السياسي برمّته ذلك أن الأقليات العرقية والثقافية والدينية كان عليهم التخلّص من خصوصياتهم ليتم قبولهم كأفراد بلا ملامح وبالتالي كمواطنين، ففي فضاء عمومي يسوده الانسجام لم يُسْمَح لهم بالتعبير عن خصوصيتهم وهو ما سيؤدي إلى وضع مفارقي إذ سَيُجْبَر هؤلاء ومنهم بل أهمهم اليهود أن يكونوا أنفسهم في الفضاء الخصوصي وأن يمارسوا خصوصياتهم لينزعوها عنهم في الفضاء العام. هنا تحديدا بدأت تتشكّل ملامح المنبوذين.
ثانيا احتاج الجسم السياسي الوليد إلى أداة لمراقبة المجتمع وتنظيمه كمقدمة للسيطرة عليه وتطويعه في إطار تأويج النجاعة وقد كانت أداته المثلى البيروقراطية التي مثّلت بحسب ماكس فييبر المتغيّر التاريخي الذي احتاجته الرأسمالية. فالتبدّل الاجتماعي الذي حصل لا يتمثّل في كسر البنية الاجتماعية القائمة لارتقاء طبقة المالكين لوسائل الإنتاج الصناعي وتحكمها في العمّال كما اعتقد ماركس بل في البيروقراطية التي سمحت للرأسمالية بالسيطرة على المجتمع وإخضاعه. وفي ذروة تطوّرها تحوّلت البيروقراطية من أداة للتنظيم إلى غاية،[7] وترى آرندت أنها مكّنت الدولة الأمة من إقامة إدارة مستقلّة سياسيا عن الحكومات المتتالية واجتماعيا كانت متعالية عن المصالح الاقتصادية المتناقضة للطبقات وهو ما جعلها تشعر بالفخر ونبل المهمة في آن لكون أفرادها من الموظفين السامين يسهرون على “مصلحة الأمة”.
فداخليا استطاعت طبقة الموظفين أن تحفظ تسيير المجتمع وتضمن سيرورة العمل الإداري في ظل تداول متواصل على السلطة وتعاملوا بحيادية مع الجميع إذ جسّدوا فعلا المساواة القانونية للمواطنين وهو ما دفعهم إلى إلغاء الخصوصية الثقافية والعرقية والدينية واللغوية للمتعاملين معهم، ولكونهم أمناء على المصلحة القومية اعتقدوا دوما أنهم خدم الأمة الأوفياء والأكثر طاعة. أما خارجيا فقد جسدوا مفهوم “الموظفين الساميين” الذين أَوْكَلَتْ لهم الأمة مهمة تنظيم الفضاءات المستَعْمَرة وتعاملوا مع المستعمرات كامتداد جغرافي لبلدانهم، هذا ما جعلهم يعتقدون في نبل “رسالة الرجل الأبيض” وفي تميّزهم “العرقي” فجعلوا من بقية الأعراق دُونًا وهمّجا وبرابرة وهذه مقدّمة العنصرية التي ستجد في علم الحيوان منبعا وفي علم البيولوجيا متكأ وفي السياسة فضاء لتنمو وتلك غاية تخرج عن مبحثنا.
إن المركزة المتواصلة للقرار والانضباط المثالي للموظفين هو الميراث الذي ستسلّمه الدولة الأمة للأنظمة الكليانية فقد كانت الطاعة العمياء ميسم الجميع لا ينتظرون الأوامر بل عليهم استنتاجه وهو ما سيعفي المسؤولين في النظام النازي من المسؤولية الأخلاقية والقانونية حين تتوفر إمكانية متابعتهم من قبل المحاكم عن الجرائم التي تم ارتكابها أو الأسوأ من ذلك أن تتم مقاضاتهم في غياب الأدلة وخارج المسار القانوني للعدالة وهو ما جعل آردنت ترفض حضور ومباركة محاكمة أيخمان Eichmann. لم يكن على القائد إذا أن يحدّد ما يتوجّب فعله بل يكفي أن يشير إلى أن اليهود خونة وخطر على مصلحة الأمة ومتآمرون لتقوم الحشود الهائجة والتي تم تطويعها عبر الدعاية بقتلهم أو إلقائهم في المعتقلات وإبادتهم. لقد خلقت البيروقراطية ميكانيزمات التحكم في الحشود وضبطها وجعل سلوكها إستشراطي وتم توجيه سخطها نحو هؤلاء المنبوذين.
ثالثا استطاعت الدولة الأمة في مسار تشكّلها أن تقييم مؤسسات شرعية تنضبط للقانون وتنظّم حياة المجتمع. فقد أكد الجيش فعاليته وحياده عن الطبقات الاجتماعية المتصارعة ليتجه لحماية الأمة من القلاقل الداخلية والعدوان الخارجي إذ “بصرامته الاستثنائية والمتميّز بروح الطبقة قد شكّل طبقة مضادة للطبقات الاجتماعية المتقلّبة.”[8] استمر هذا الوضع الاستثنائي طويلا قبل أن يتم الزّج بالمؤسسة العسكرية في أتون الصراعات السياسية وتوريطه في معاداة السامية التي كان منطلقا لقضية درايفوس Dreyfus [9] ليترك مكانه للبوليس، حيث ستتضخّم المؤسسة البوليسية وتتجاوز دورها نحو مراقبة المواطنين بوصفهم “مجرمين محتملين” وستتكفل بمراقبة الحدود ضد الغرباء داخليا وبسط هيمنة الأمة و”حفظ مصالحها” في المستعمرات.
إن ذروة ما وصلت إليه الدولة الأمة خلخلة المؤسسات القائمة والانحراف عن القانون وذلك بتوظيف أدوات العنف الشرعي في الدفاع عن الجريمة وحماية المجرمين، إذ أن الأمة سلبت بعض الأشخاص مواطنيّتهم لكونهم ليسوا جزء منها بل غرباء وأقليات وكان ذلك مقدّمة لسلبهم “الحق” لأن الحق يُلْحَقُ بالمواطن ويكون له وهؤلاء منبوذين لكونهم لا ينتمون للأغلبية فإما أن يندمجوا في جسم الأمة ويتنكّرون لخصوصياتهم أو تُسْلَب مواطنيّتهم، في هذا الإطار بدأت تتشكّل ملامح المنبوذ بوصفه شخصا بلا حق ليكون عرضة للجريمة والقتل والإبعاد.
- مقاربة في شعرية التصوف

- كيف تقرأ كافكا (الجزء الثاني)

- قَصّ أثر الدابة بين الفراسة وفنّ التّحرّي: دراسة مقارنة في خبر أبناء نزار بن مَعَدّ بن عدنان مع أشباهه في الآداب الأخرى

إن ما يمكن اعتباره جذرا غائرا للمنبوذ قد تشكّل حسب آرندت في مسار تشكّل الدولة الأمة ذاتها، ولكون اليهود مجموعة بشرية لم تكن لها أرضها ولا انتمت لوطن ولا شكّلت في مسارها التاريخي دولتها فقد توفّرت فيها وفي أفرادها كل العناصر الضرورية لتجعلهم منبوذين بامتياز، لكون بقية الأقليات تجد سندا في الأمم التي تنتمي إليها وتشعر بفخر الانتماء على الأقل وهو ما يمكن أن يهوّن عليهم ما يتعرّضون له. في حين أن اليهود لم تتوفّر لهم هذه الفرصة لكونهم شعب بلا أرض[10] ومع صعود الكليانية سيجدون في المعتقلات والمعسكرات وفي النفي والإبعاد والقتل طرقا للتعامل معهم. لقد شهدت الدولة الأمة في ذروة تشكّلها انهيارات ستسمح بتحرير “الشر المطلق” وانطلاقة العنف الأقصى بما سمح لآرندت من طرح إشكال مركزي سيظل يقلق روحها الفلسفي المتعب بطبعه أصلا ويتعلّق السؤال بمنزلة الشر من البشر هل هو طبع فينا وحقيقة جبلّتنا أم تشويه لطبيعتنا وعلامة انحراف فيها؟
من أجل الإجابة عن هذا السؤال كان على آرندت أن تفهم ما وقع؟ وكيف وقع؟ ولما كان ذلك ممكنا؟ ولا تنتحي الفيلسوفة منهجا ماركسيا في التحليل لإيمانها أن “الاعتقاد في السببية هي الطريقة التي يملكها المؤرّخ حرية الكائن الإنساني”[11] حتى وإن كانت تدرك أن الدولة الأمة قد قامت منذ البداية على هشاشة ستظل تلازمها وتؤدّي إلى انهيارها سامحة بتشكّل الأنظمة الكليانية، ذلك أن الاقتصادي يتناقض مع السياسي ضرورة وسيؤدي تطوّر الإنتاجية المتنامي في الأخير إلى تدمير السياسي وفساد الاجتماع الإنساني وهذا ما كان نتاجا للزيجة الغريبة بين الدولة والأمة. إن البورجوازية لم ترغب في بداية تشكّلها كطبقة اقتصادية بلعب أي دور سياسي واكتفت بتشكيل أحزاب ودعمها للدفاع عن مصالحها لكنها ستدرك في مسار من التغيرات المعقّدة حاجتها للإستحواذ على السلطة من أجل كسر بنية النظام السياسي الذي ضاق ويزداد ضيقا مع تطوّر الإنتاجية لتنخرط في عملية توسعيّة تطرح رهانات غير معهودة مستجيبة فقط للتطوّر الاقتصادي.
ليس التوسّع بمفهوم سياسي بل هو مفهوم اقتصادي بامتياز فـ”هذا المفهوم، كما تقول آرندت، ليس مفهوما سياسيا بل يأخذ جذوره من ميدان المضاربة التجارية أين يدل على التوسع الدائم للإنتاج الصناعي والأسواق الاقتصادية.”[12] إن استحواذ الاقتصادي على السياسي سيسمح بميلاد عصر الإمبريالية التي سَتُحْدِثُ شرخا في البناء السياسي للدولة الأمة وتجبرها على الانخراط في مسار استعماري مما يوقعها في مفارقة فهي من ناحية تقوم على الاعتقاد بأن قوانينها ثمرة خصوصيّاتها وتاج تميّزها وفرادتها لكن من ناحية أخرى قادها الاقتصادوي لإقحام عناصر بشرية جديدة لهيمنتها لا يمكن إذابتها وأيضا لن تسمح هي بذلك لبقاء نقاء الأمة.
إن انهيار الاقتصادي الذي بدأ مع الحرب الفرنسية البروسية وتواصل إبان الحرب الكوكبية الأولى سيصل مداه في الثلاثينات لتشهد اقتصاديات أوروبا زلزالا مدوّيا سيخلق في آن عددا من العاطلين عن العمل والمطرودين من وظائفهم والمهمّشين ومن فنانين ومثقفين لم يجدوا الحظوة، ويزداد هذا العدد مع تطوّر الأزمة لينضاف إليهم جحافل من البورجوزيين وعائلاتهم من المفلسين ليتحوّلوا جميعا إلى حشود غاضبة توجّه عداءها لأعداء وهميين من المنبوذين والموصومين. لقد شكلت الحشود طبقة خارج الطبقات، طبقة من اللامنتمين الذين فقدوا الثقة في الأحزاب والتمثيل السياسي، فانقادت بنفس حيواني إجرامي لفقدانها القدرة على التفكير والتحكّم.
بغياب رافعة سياسية يتم إفراغ الكائن الإنساني من الداخل ويتم تحويل الأفراد من مواطنين إلى حشود تجمعهم فكرة “مصلحة الأمة” كفكرة هلامية وتوجهت جرائمهم نحو الأقليات العرقية والثقافية والدينية لكونهم ليسوا من الأمة ولكون هؤلاء ليسوا مواطنين فإن الجرائم ضدّهم لا يطالها القانون. إننا نشهد هنا وبعد ميلاد المنبوذ ميلاد موجة من العداء غير المبرّر ضدّه، باعتباره فقط “غير طبيعي”. إننا أمام وضع غير مسبوق في تاريخ البشر فمن ناحية أجبرت الدولة الأمة الأقليات على التنازل عن خصوصياتهم ليكونوا مواطنين، مما أجبر اليهود مثلا على أن يكونوا يهودا أي أن يكونوا أنفسهم ويمارسوا خصوصياتهم الدينية واللغوية والثقافية في الفضاء الخاص، وأن يتخلوا عن أنفسهم في الفضاء العمومي كما أشرنا إلى ذلك سابقا.
ومن ناحية أخرى ظلت تنظر إليهم كغرباء وأعداء وخونة محتملين وسبب في البلاء والخراب. هنا يظهر التقابل بين المنبوذ وابن البلد وهو تقابل المعنى واللامعنى فالأول فاقد للقيمة وللحق وللحماية والثاني صاحب الحق ومحمي بترسانة من القوانين وكثيف الدلالة.
سيأذن انهيار السياسي حيث ستزدري الحشود الأحزاب وترى في التمثيل السياسي تمثيلية سيئة الصياغة والإخراج ومملّة بانتصار الكليانية التي سيؤول إليها ميراثا ثقيلا هيّئ الأرضية الخصبة للتعامل مع المنبوذين، إذ لا خلاف في أن الدولة الأمة قد استطاعت في مسار تشكّلها أن تفرّق بين الأغلبية التي تشكّل الأمة والأقليات التي أصبحت عبئا ثقيلا. ولئن حمت الاتفاقيات أقليات الدول الأخرى في إطار سياسة كوكبية فإن اليهود وجدوا أنفسهم في الفراغ على اعتبار أنهم المجموعة التي لم يكن لها في تاريخها وطن كما ذكرنا وكما تلح آرندت على تذكيرنا بذلك، ولأن الحق يٌعْطَى للمواطن فقد تم التعامل معهم لا كمواطنين بل كسوائم أُجْبِر عدد منهم على الاندماج والذي لن يجعلهم مواطنين بل سيزيد من تمزيق كينونتهم إذ وكما أكدنا كان عليهم نزع خصوصيتهم في الفضاء العمومي وارتداءها فقط في الأماكن الخاصة.
وقد كان للميثاق العالمي لحقوق الإنسان دوره في تعميق أزمة المنبوذين حين منح الحقوق للإنسان بوصفه مواطنا دون التنصيص على هويته الثقافية أو العرقية أو الدينية، وأرجع مبدأ التشريع للإنسان بصفته مواطنا. إن الطابع التجريدي لتلك الحقوق كما ترى آرندت كان له أسوأ النتائج على الإنسان حين يجتثّه من انتمائه وكينونته بما حوّله إلى عيّنة من نوع، إذ أن الذين تحميهم القوانين ويتمتعون بالحقوق هم المواطنين بوصفهم مصدر كل شرعية، ولأن المواطنة مشروطة بالانتماء وجد هؤلاء الذين لا وطن لهم ولا انتماء أنفسهم في “العراء” بحسب عبارة ليبوفيتشي،[13] ولم يكن على الأنظمة الكليانية القائمة على حشود هائجة تطيع القائد الملهم إلا أن تسلّط عليهم جام غضبها وحقدها.
لقد تحوّلت المعسكرات التي أوجدتها الدولة الأمة للمبعدين والفارين والمهجّرين إلى “مخابر لتجربة الهيمنة المطلقة”،[14] لم تكن الغاية من تلك المعتقلات اقتصادية ذلك أن النظم الكليانية لم تععمد إلى استغلال المعتقلين في أعمل شاقة ولا في أعمال لها منتج اقتصادي بل كانت الغاية التحكم والسيطرة. إن نظاما يرى في الاختلاف جريمة قد جعل من الجريمة خاصية تميّزه غير أن جرائمه كانت بلا أثر لذلك يستحيل تتبع الجناة الحقيقيين وكلما أوغلنا في الملاحقة لن نمسك إلا بأدوات التنفيذ.
في هذا الفضاء الذي أطلق عنان الشر المطلق فَقَدَ المنبوذين ملامحهم وتحوّلوا إلى مجرّد حيوانات وسوائم تتم إبادة العدد الزائد عن القطيع حينا وعن الإمكانات المتوفرة من الغذاء للمعسكر أو عن سعة هذا المعسكر. لقد توفّرت كل الشروط ليكون اللامتوقّع واللاممكن حقيقة، ففي “البداية تقول آرندت، لم نكن نعلم أنا وزوجي أن هؤلاء المجرمين باستطاعتهم القيام بكل شيء ولكن هذا ما لم نتصوّره (…) فزوجي الذي كان مؤرخا عسكريا أعلمني قائلا: لا تستسلمي لهذه الحكايات، لا يستطيعون الذهاب إلى هذا الحد.”[15] الحد الذي يتحوّل فيه الإنسان إلى عينة من نوع، لكن ذلك ما وقع للمنبوذين في مسار تشكّل النظم الشمولية.
الهوامش
- [1] Judith Butler : à propos de H. Arendt the Jewish writing. www.Irb.co.uk
- 2 أنظر: تشارلز تايلور “المتخيلات الاجتماعية الحديثة” ترجمة الحارث النبهان. المركز العربي للدراسات ودراسة السياسات ط1 مارس 2015 الصفحات 45-65
- 3 أنظر ميشال فوكو: تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي. ترجمة سعيد بنكراد. المركز الثقافي العربي 2016، وانظر أيضا المراقبة والمعاقبة ولادة ا لسجن. ترجمة علي مقلد مركز الانماء العربي 1990.
- 4 H. Arendt : Les origines du totalitarisme. Ed sous dir Pierre Bouretz. Quatro, Gallimard 2002. P 231.
- 5 نفس المصدر ص 236
- 6 نفس المصدر ص 232
- 7 Guillaume Attencourt : La démocratie ou la dérive oligarchieque et burautique.
- 8 H. Arendt : Les origines. Op cit p 341
- 9 نفس المصدر صص 327-366 حول قضية درايفوس.
- 10 ستتحوّل هذه الفكرة وبتحالف الميثيولوجي والتيولوجي إلى منطلق للفكر الصهيوني وقد تبنت آرندت هذه الفكرة وطوّرتها لتؤكد أن الحق يجد أساسه في الفعل، فاليهود الذين حوّلوا الأرض بفضل جهدها إلى وطن تصبح أحق بهما وهو تجاوز صارخ لمنطق الحق ولمنطق التاريخ في آن.
- 11 H. Arendt : La nature du totalitarisme. Trad par Michelle Iréne B. D. Launay. Ed Payot 1990. P 74
- 12 H. Arendt : Les origines. Op cit p 372.
- 13 M. Liebovici : Le paria chez H. Arendt. (Actes du colloque) p 210.
- 14 H. Arendt : Auschwitz à Jérusalem. Deux temps Tierce. 1990. P 212.
- 15 A. Mérjen : p 3-4.