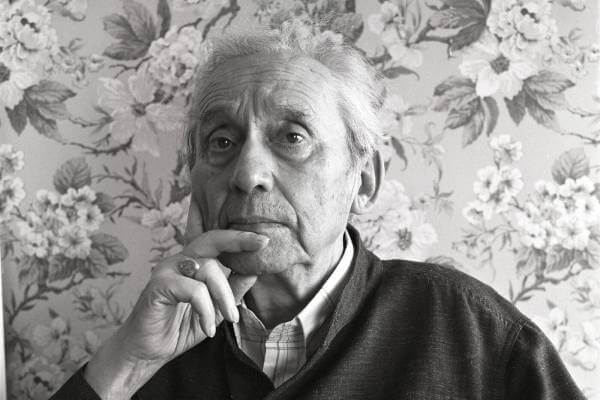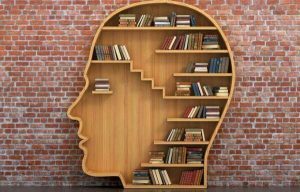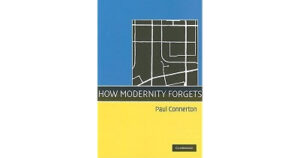| الكاتب | بول ريكور |
| ترجمة | عبد الوهاب البراهمي |
لا يعتبر التفكير الفلسفي غير مؤهّل حينما يدرج أحاسيس مثيرة، إذا ما كان مُتحكّما، يساءل الإحساس، ويكشف عن القصد الضمنيّ ويرفعه بهذا الاختبار الحاسم إلى مستوى الحقيقة.
سنحاول أن نتقصّى معا قلق هذا العصر؛ ولن يكون لمهمتّنا أي معنى إذا ما اقترحنا أن نرتعد معا خوفا، وأن نُخيف بعضنا بعضا؛ ولن يفيدنا القلق إلاّ إذا سعينا إلى فهمه وإذا ما استعدنا، بفهمه، ربط الصلة مع أصل الحقيقة والحياة التي تغذّي ردود فعلنا إزاء القلق. نعيش لنفهم، ونفهم لنتجاوز- أو، لفشلنا في التجاوز، نفهم لنواجه-، كذا يبدو لي الشعار الذي يجب أن يقود تأمّلنا.
أطرح أولا كتعريف عامّ جدّا، بمقدوره أن يرسم حدودا لحقل بحثنا، أنّ للخوف موضوعا محدّدا أو على كلّ حال قابل للتحديد وأنّه يترقّب تهديدا جزئيا، محدودا بجزء من ذواتنا؛ وعلى العكس، للقلق موضوع غير محدّد، ولاسيما غير محدّد، بحيث يحاول التفكير صياغة هدفه في خشية، في معالم دقيقة؛ ولكن في المقابل يعني هذا الموضوع غير المحدّد للقلق تهديدا لكلّيتي، من وراء قسمة جسدي إلى أجزاء ضعيفة، وقسمة نظامي النفسي إلى وظائف. قلق الزمن الحاضر وواجبات الفكر غير المتّسقة، لشخصيتي الاجتماعية في أدوار متعارضة، من وراء تشتّت حريّتي حتّى إلى أفعال غير متّصلة. (سنرى أننا بهذه المناسبة ندرك كليتنا فجأة مجمّعة بحكم التهديد). هنا إذن، حيث لا يَلْتِبس الخوف، إن جاز القول، من جهة ما يستهدف وتدفّقه من جهة أخرى، نحوي ليعلمني بخطر جامع، يفضي الخوف إلى القلق.
كيف نستعيد، على وجه الحقيقة، وفق القاعدة التي وضعناها الآن، إحساسا هو في ذات الوقت غير محدّد ومكثّّف؟ أقترح على نفسي محاولة تحليل على مستويات، أي تعيين مجالات تهديد قائمة على أصعدة تزداد عمقا؛ بقدرما سيتجذّر القلق، وسيتعمّق التفكير أيضا و سيخرِجُ ما قد سأسمّيه باستمرار طيلة هذا التأمل” الإثبات الأصلي” « l’affirmation originaire »، الذي سنتناوله هو أيضا على مستويات متتالية. هذه كلمة لـ م. نابار M,Nabert في كتابه عناصر من أجل إيتيقا، تبدو لي صالحة جدّا للإشارة إلى هذه السّوْرَة للوجود التي يضعها القلق موضع السؤال ويلاحقها من مستوى إلى مستوى في صراع غير مؤكّد. أعتقد أن التأمل في القلق هو، استخدام التعليم المدرسي الصارم لاستكشاف واستعادة الإثبات الأصلي (هكذا أفهم ” واجب الفكر” الذي يدعونا عنوان هذه اللقاءات إلى توسيع صلته بمبحث القلق).
أضيف كلمة إلى المقدمة: نحن مدعوون إلى التفكير في قلق العصر الحاضر. علينا واجب فهم عصرنا. حتى وإن كان من أجل التحدّث بلغة انشغاله. لا أعتقد، مع ذلك، أنّه علينا أن ننقاد للسمات الأكثر إثارة لعصرنا، بل بالأحرى للديناميكية الداخلية لديالكتيك القلق ولما أسمّيه الإثبات الأصلي. أن نصل إلى قلق عصرنا الراهن وواجبات الفكر في عصرنا بدل الانطلاق منه، سنكون ربّما أكثر تسلّحا لمعرفته، أي لتنزيل قلقه وردّ انفعالات إلى موقعها، انفعالات بقدر ما هي ضخمة هي أقلّ أصالة. ذلك أنّه من الممكن أن لا يكون القلق موسوما بالراهنية إلا في منطقة وسطى في سلّم ضروب القلق، بين حدّين لهذا السلّم، أحدهما سيكون تحت المستوى التاريخي- القلق الحيوي- والأخر فوق المستوى التاريخي – القلق الميتافيزيقي. من الممكن جدّا أن ّ عصرنا، لأنّه كثير التأثر بخاصية ما للقلق، سنتعرّف عليها في الأثناء، يخفي نفسه عن أشكال أخرى للقلق أكثر جذريّة في شفقة مفرطة وسطحية.
هذا ما جعلني أفضّل منهج مقاربة يُخضع معنى الرّاهنية لتفكير أكثر استقلالية عن التاريخ: وفضلا عن ذلك، لم ينفذ القلق إلى الوعي إلاّ بفضل أعمال مفكّرين وفنانين لم يكونوا في الغالب على اتفاق مع مناخ عصرهم، لا بل يتحدّثون عنه على مضض: فقد أعاد أسخيلوس Eschyle إحياء رعب الأساطير القديمة في اللحظة التي كانت فيها بصدد الموت في الوعي الجمعي و حيث تتوطّد المدينة حول آلهة أقلّ شحنا بالألغاز والقلق. وعلى العكس، كان عاموس و هوشع و أشعياء Amos، Osée، Esaie سباقين للتهديدات المخيفة التي يبلّغون بها شعبهم، – ويصرخ كيرجارد في رباطة جأش سعادة سكوندينافية. ويكتب هيدجر” الكينونة والزمان” دون الإحالة إلى الأزمة الأوروبية وفي أفق أنطولوجيا أقرب إلى بارمينيدس منها إلى الوعي العمومي المعاصر.
أضيف إذن إلى المبدأ العام: نعيش لنفهم، ونفهم لنتجاوز، هذا: نفهم قلق الزمان الحاضر وواجبات فكر الزمان، لا أبدا بالانطلاق منه، بل بالإقبال على حداثة قلقنا من عمق كلاسيكية القلق. هذان المبدآن يبرّران الإحالة منذ عنوان مداخلتي إلى الحقيقة: قلق حقيقي وقلق زائف.
- النظرية الاجتماعية اليوم: حوار مع هارتموت روزا

- في ظلال الغد

- مذبحة العرفاء: مآلات التصوف والعرفان في المجال الشيعي

1
يتعلّق القلق، في أسفل درجة، وفي مستوى حيوي، بالحياة والموت؛ وبشكل أدق، يكشف عن مجاورة الموت بالنسبة إلى الحياة. هذه المجاورة هي علاقة تتأرجح بين الخارج والداخل (ستكون لنا عودة أكثر من مرّة إلى التباس التهديد الشامل الذي يتقدّم باتجاهنا وينبثق بوصفه مركزا لذواتنا).
إنّه تهديد خارجي في معنى أنّ الحياة لا تؤدّي إليه؛ وفي مطلق الكلام، يمكن للحياة أن تكون خالدة. أتعرّف على ضرورة موتي خبريّا، بواسطة مشهد موت الأحياء الواحد تلو الآخر. لأجل ذلك، فإنّ كلّ موت، حتى الأكثر توقّعا، يتدخّل في الحياة بوصفها انقطاعا. يطفو موتي الخاص خارجا، هناك، لا أدري أين، شديد علّي، بفعل ما لا أعرف، أو مَنْ لا أعرف.
ومع ذلك يقرّب القلق منّي، هذه المعرفة المجرّدة جدّا – كون البشر جميعا يموتون، وبالتالي أنا أيضا- إلى حدّ يبدو فيه موتي يتغذّى من حياتي، بحسب التجربة الخارقة (للشاعر) لرالكيه Rilke في كرّاساته.
كيف يمكن أن يبدو الموت، هذا الدّخيل، منقوشا في حميميّتي بوصفه إمكانيتها الأكثر خصوصية؟ إنّ موت الآخر في جانب منه هو الذي يطرد نوعا ما تهديد الخارج إلى الداخل؛ بواسطة رعب صمت الغائبين الذين لا يجيبون، يَلِجُ موتُ الآخر فيّ بوصفه آفة كياننا المشترك؛ ” يلمسني ” الموت، و من حيث أنّي آخر أيضا بالنسبة إلى الآخرين، وبالنسبة إليّ في النهاية، أتوقع موتي مستقبلا بوصفه لا جوابnon-réponse ممكن لذاتي عن كلّ كلمات جميع البشر. إنّه الاحترام إذن، الذي به لا يمكن استبدال من نحبّ، والذي يستدمج القلق؛ حينما أحسّ أنني أنا منخرط في مجال هذه التقوى المتبادلة، يبلغُ قلق موتي نوعا من الكثافة روحانية أكثر منها بيولوجية والتي هي حقيقة هذا الانفعال.
وليس هذا مع ذلك سوى مرحلة: لا يوجد موت للآخر إلاّ بالنسبة إليّ، أنا الذي يبقى، وبقائي أنا لصديقي يضع أيضا الجانب الحيوي لذاتي في مأمن من القلق.
غير أن للقلق حليفه في هذا الموضع، يعني ضربا من التجربة الضبابية للعرضية التي تكتنف حدث الوجود في براءته، والذي سأصله من جهتي بالأحرى بتأمل في الولادة بدل تأمل في الموت. ويشهد الألم لي بعدُ بأنّي غير قابل للقسمة في المكان، مركّب عناصر و غبارمستقبلي؛ وتكشف لي الشيخوخة بأنّ الزمن ليس خلقا مستمرّا فحسب، واستحداثا غير متوقّع، بل يتماسف ويتفكّك.
غير أنّ ما يكشف لي لا ضرورة أن نكون هنا، هو خاصّة ضرورة أنّني قد وُلدت؛ دُوار إمكانية أن نكون آخر، إمكانية أن لا نكون. . .؛ دوار سرعان ما يمّحي بفعل حضوري الجسدي الذي لا يمكن إنكاره، دوار يرتجف، مع ذلك أمام هذا الحضور؛ فالمجيء إلى العالم ليس فعلا مؤسّسا لنفسي بنفسي. أعترف بأنّ هذا العدم العرضي ليس مقلقا بذاته، لأنّ القلق متيقّظ للإمكانات و ينتظر ضربة المستقبل؛ لكنّ القلق الخارجي للموت يلاحق بعدُ اقترابه من مركز وجودي، في اللحظة التي يلتحق فيها بهذه التجربة الحميميّة جدّا للعرضية؛ إنّه يتلقّى منها علامة الحميميّة بينما يضفي على العرضيّة عنصر الشفقة الذي هو عيبه.
يتبقّى أنّ هذا القلق لا يمكنه إتمام هذا التقارب؛ لكي تلتحق إمكانية الموت باللاضرورةٌ التي نملكها منذ الولادة، لابد لها من حدث عارض يجعلني أموت فعلا، حادث لا يمكن أن استنتجه من وجودي العرضي بما هو كذلك. وحده موتي سيتمّم يوما عرضية ولادتي والكشف عن عدم هذه اللاضرورة لولادتي يوما ما؛ إضافة إلى أن القلق من الموت، القلق الأولي الذي يصل كياني بالعالم، ليس محايثا تماما لوجودي. فالحياة هي ما لم تمسّه الحياة بعدُ. لأجل ذلك يمكنني أن أمزح بشأن الموت دون وجل: تقول اللافتة الإشهارية:” الكحول تقتل ببطء”؛ لكنّنا لسنا على عجل” يردّ السكران. يحفظ المزاح الحادّ للسكران حكمة أبيقور: عندما تحضر الحكمة، تكون أنت غير موجود؛ وحينما توجد، تغيب هي أيضا.
ومع ذلك ليس هذا القلق الناقص – ناقص في المعنى الذي نتحدث فيه عن جريمة ناقصة- عقيما: إنّه يتطلّب ردّ حميّة الوجود، إلى مستواها الأوّلي، والتي تتناسب درجات عمقها مع درجات القلق. ينكشف الإثبات الأصلي في هذا المستوى بوصفه إرادة الحياة؛ إنّها تندمج في إرادة الحياة.
بيد أنّه من البيّن أن إرادة الحياة لا تنعكس ولا تمثّل حتّى في وحدتها إلاّ تحت تهديد الموت، وبالتالي فِي وبواسطة القلق. إنّ كلمة إرادة الحياة لا تغطّي بالفعل أيّ “رغبة” بسيطة ولا أوّليّة؛ فأنا أسعى بوصفي حيّا خلف أهداف متباينة، غير متجانسة وأخيرا غير متناسقة: فالحياة هي، على الأقلّ في المرحلة البشرية، مجموع ميولات، أهدافها لا واضحة ولا متناسقة؛ لابدّ من وضعية – كارثة حتّى تتحدّد حياتي، فجأة، وتحت تهديد مطلق غير محدّد- موتي- بوصفها كلّ ما هو مُهَدَّد. إنّها المرّة الأولى التي أبدو فيها كشمولية، شمولية مهدَّدَة. يتقبّل موت العيش le vivre كل البساطة التي يقدر عليها.
لكن ما هذا الذي يتعهّد به القلق كليّة إذن؟ هنا بالتحديد يضطلع التفكير بمهمته الحقيقيّة: بالفهم، يتجاوز الوضع الحقيقيّ. وفهم هذا الكلّ المهدّد، هو تقييمه وتسليحه بالقيم. فلا وجود لإرادة الحياة دون مبرر للحياة. نحن نعرف جيّدا حينما نحاول دون جدوى أن نمسك إنسانا على حافة الانتحار؛ فيه جاذب إثبات قد انكسر، أدنى من كلّ حجاج عقلي، لأجل ذلك يكون النقاش معه غير مجد. إنّ حياتي، وحياتي الإنسانية بوصفها إثباتا مندمجا هو ما يسمّيه برجسون معنى السعادة والشرف.
أكتشف إذن أن إرادة حياتي لا تنفلت عن قلق الموت إلاّ في لحظة وضع مبرّرات حياتي فوق حياتي ذاتها، في اللحظة التي تتعالى فيها القيم الفعلية التي تضفي معنى على سعادتي وشرفي، على التقابل ذاته بين حياتي وموتي. من البداهة أن هذا الفعل للتعالي لا يستوفى إلاّ في سلوك التضحية؛ حينئذ تكون حياتي هي في الآن نفسه مهدّدة ومتعال عليها، مهدّدة بالموت في وضعية الكارثة ومتعال عليها بمبرّراتها الخاصّة للعيش التي أضحت مبررات للموت. ولكن، من هنا يكون الكلام أيسر من أن نحيا ويتطلّب التفكير عون الأمثلة البارزة التي يحفل بها عصر الخطر الداهم مثل عصرنا.
تهتزّ جدليتنا حالما نحاول تعميق مبرّرات الحياة لإرادة الحياة
هل سيجد الوعي المنعزل فيها منابع الصحّة والطاقة التي ستحفظ توازنه وفعاليته؟ ليس من غير المفيد أن نتوقّف لحظة في مرحلة النفسي الخالص، والذي يتنزل ضمنه، من بين أمور أخرى، علم النفس التحليلي. ولن أتوقف عند ذلك إلاّ بقدر ما يتطلبه نظام هذه الجدلية، بما أنه، بالأمس ومع السيد سوسير، أخذنا مشكل القلق من هذا الجانب.
علينا أن نقول، على الأقلّ وباختصار، أنّ الوعي النرجسي هو بذاته مصدر للقلق. لقد علّمنا علم النفس التحليلي بأنّ ما يغذّي الميل العصابي، الكامن في كلّ بناء نفسي، حتى الأكثر توازنا، هو الخوف من القوى الغامضة التي يرفضها الأنا الأعلى الاجتماعي لدينا. لست طاقة نفسية بسيطة، أحمل في نفسي قسمة، وربّما الانهيار العصبي، والاعتداء على ذاتي. لا يعتقد أفلوطين أنّه قد أحسن القول حينما سمّى النفس الواحد والمتعدّد، في مقابل لـ نوس Noûs والعقلl’intelligence الذي هو الواحد- المتعدد. . . يولد القلق إذن من عمق نِزاعاتي وممّا يمكن أن نسمّيه هشاشة البناء النفسي للإنسان الذي يضاعف عرضية الحياة. لكن لم تكن عرضية الحياة مقلقة إلاّ بتوسّط الموت؛ إنّ هشاشة البناء النفسي مثيرة للقلق مباشرة، إذ ما يخيفني هو وجه غريب و مدفون في نفسي، وإمكانية أن لا أتعرّف على نفسي، ومن أن أكون آخر، بالمعنى الحرفي، ومغترب.
سألحّ فحسب على هذه النقطة: على الصبغة المعاصرة لهذا القلق؛ يتنوّع القلق الحيوي فحسب في كثافته عبر العصور، بحسب الثمن الذي نمنحه للحياة الفردية؛ ويتّسم القلق النفسي أكثر بالتاريخ في تكوّنه بالذات؛ و بالفعل، من اللافت للنظر أنّه سواء أكان في المجتمعات المتحضّرة، المتسلّحة أكثر ضدّ كل المخاطر وأثناء فترات السلم التي تنبثق عن هذا الانعدام للأمن الداخلي المُنشأ للبناء النفسي، كما لو كان أكثر البناءات النفسية هشاشة هو الذي للإنسان المتحضّر. وبالإضافة إلى تركيب النظام النفسي، أثيرُ عمدا دور ما يمكن أن نسمّيه ملل الحضارة.
غالبا ما وصفنا جيدا هذا الملل الذي تفرزه المجتمعات الأفضل تجهيزا بخيرات الحضارة (أفكر في ملاحظات إ. مونييه حول سكندينافيا، وملاحظات كارل ستارن، في العلّيقة المشتعلة، حول العالم الجديد حيث حلّ اللاجئ الأوروبي، الذي هو بالإضافة، اللاجئ اليهودي الألماني، وقد فاجأه وجود عالم، على آلاف الكيلومترات من الجحيم النازي، أكثر هشاشة نفسيا من العالم الذي فارقه). إنّ ما ينشر الملل في المجتمعات الصناعية ليس الرفاه فحسب، بل العمل في شكله المقسّم، كما لو كان ألما نفسيا أكثر رهافة بصدد مناوبة المعاناة النفسية. لا أقول بأنّ الملل هو القلق، ولكنه يفضي إلى القلق؛ وبخلق مجالات الحرية، أو على الأقلّ مجالات حياة متمدّنة في ظلّ نظام عام وأمن سياسي واجتماعي، فإنّ تطوّر الحضارة يمنحها، وبواسطة الملل، كائنات أقلّ فأقلّ تسلّحا ضدّ المخاطر التي تفرزها المنظومة النفسية
إن خلق وقت فراغ، هو في الأغلب أن نترك كلاّ منا للشعور بتفاهة الرفاهية، لضرب من الكسل الحضاري و أخيرا، لخوائه الخاص، لغياب هدف لديه. إنّ خطأ النرجسية ليس ببعيد.
ليس لبعض هذه الملاحظات – المقتضبة عن قصد- من هدف سوى: كشف فشل بحث عن الصحّة والتوازن يرتكز على مجرّد انشغال بالصحّة العقلية. صحّة عقلية دون اقتراح مهامّ، وبحث عن التوازن دون إرغام بالواجبات هو أمر خال من المحتوى. لا يمكن للإنسان أن يتصدّى للقلق النرجسي، إذا لم يتجسّد في عمل هو في الآن نفسه جماعي وشخصيّ، كوني وذاتي؛ يؤكّد تراجع الأمراض العصابية زمن الحرب أنّ علم الأمراض الناشئ عن كلّ وعي ينطوي على ذاته، ينظر إلى نفسه ويهرب منها، لا يجد شفاءه إلاّ في الوعي بالانتماء إلى. . . ، في الإخلاص ” لقضية “، لو شئنا ا نعبّر مثل جوزياه رويس Josiah Royce. يسمّي هيجل تحديدا ” فكر أو روح” هذا التأليف بين الكوني والفردي، بين النحن والأنا، بين ما هو في ذاته لعالم البشر وبين ما هو لذاته لهذا الوعي الذي هو، بحسب هيجل، تحديدا وعي بائس.
2
يمكن أن نسمّي تاريخيّا المستوى الجديد الذي بلغناه، لأنّ الإنسان يشكّل فيه البطل الرئيسي- الصانع والمريض- لتاريخ البشر منظورا إليه من جهة جماعية. نمرّ بفضل قفزة حقيقيّة – يمكننا أن نعترف بذلك لهيجل والمذهب الاجتماعي الفرنسي – من همومٍ تتصل بالصحّة العقلية إلى مصير الجماعات، والشعوب والطبقات.
لكن، هل أنّ هذا ” الفكر أو الروح الحقيقيّ”، هذا ” الجوهر الإيتيقي”- حتى نتكلّم مثل هيجل- للمجموعات الكبرى التاريخيّة، بمنأى عن القلق، قلق بمستوى هذا ” الروح” (الذي نطابق بينه وإنسانيتنا)؟ لعصرنا حساسيّة خاصّة تجاه قلق مخصوص يمكن أن نسمّيه تاريخيا، بوصفه المستوى الذي يتنزّل فيه. لكن هنا يكون من المهمّ أن نكون أوفياء للمبدأ العام الذي انطلقنا منه: أن نَلقى قلق العصر الحاضر أولى من الانطلاق منه.
ألقاه انطلاقا من انتظار منفتح في الوعي بفضل الفلسفة الهيجيلية: فلا أفضل منها حاول إدماج التراجيدي في المنطق؛ وفي المقابل لا أحد غيرها زعم تجاوز التناقض بالتوفيق أو التأليف، وردّ كل نفي عقيم إلى وسائط مثمرة. فلقد اعتقد هيجل إذن أنّه أنشأ مثالية أكثر صدقا من مثالية فيخته، مثلا؛ إنّ كلّ مثالية تَعِدُ بماهية الفكر والكائن؛ ويعتقد هيجل أنّه لم يَعِدْ بذلك فحسب، بل أنشأه، لأنّ المعرفة المطلقة حيث يقع التأليف بين ما هو في ذاته وما هو لذاته، بين الكائن والذاتية، هي في نهاية مسار حيث يندمج فعليا ألم التاريخ.
ولكي يفِي هيجل بوعد المثالية، يجب أن يكون فكر عصره بالذات أقرب من غيره من المعرفة المطلقة، وأن يمنح فكر عصره إن لم يكن تحقّقاً فعليا فَشَكْلًا، علامةً، ولكي نقول كل شيء” ظاهرة ” هذا الفكر الذي يرفع إليه الأنا الفردي ألم هذا العصر. يستشهد جان هيبوليت منذ وقت غير بعيد بنصوص لهيجل مثيرة للدهشة عن هذه الألفة المزعومة بين الفكر وعصره والتأليف الجدلي بين الفكر والكائن الذي تطرحه المثالية.\
لقد خيّب التاريخ الفعلي أمل هيجل؛ فلقد تبخّرت في نظرنا مثاليته ومعرفته المطلقة في الهواء مثلما هو حال مثالية فيخته، لأنّنا لا نتعرّف على شكل الألفة بين المتناقضات في وعينا الخاص بعصرنا؛ فليس فكر عصرنا علامة حتى على أنّ السّالب يتوسّط تخفيفا فعليا لتمزّق الوعي.
ويبدو لي أن قلق العصر الراهن يتعّرّف على نفسه ويفهمها بالنسبة إلى المقتضى الراديكالي الذي صاغته المثالية، وبالأخصّ المثالية الهيجيلية: ننتظر أن يكون التاريخ المرعب حيلة للعقل في اتجاه تأليف أرفع. وها نحن ذا: ينبثق القلق في هذه النقطة المحدّدة لانتظارنا؛ ويرتبط بالتاريخ انعدام أمن مخصوص لأنّنا لسنا متأكدين من إحداث هذا التاريخ تطابقا بين العقل والوجود، بين المنطق والتراجيدي. يكتشف القلق إمكانية مخيفة: لو لم يكن للتاريخ من معنى؟ لو لم يكن التأليف الهيجلي سوى اختراعا فلسفيا؟ إنّ العدم، وقد ظهر الخطر الذي يهدّده، هو عدم للمعنى، في مستوى “الفكر” ذاته، عدم للمعنى في قلب هذا المعنى المفترض الذي يجب أن يعطي هدفا ومهَمَّةً للصحّة العقلية ويشفي نرسيس.
يبدو لي أنّه بملاقاتنا هكذا لقلق عصرنا انطلاقا من المقتضى المثالي، نكون أكثر تسلّحا كي نميّز فيه بين الأصيل والهجين أو غير الأصيل.
يحتوي المَرَضِي المعاصر دون تحديد وتمييز الأفضل والأسوأ؛ و ليس القلق تجاه التاريخ في جانب كبير منه، سوى الخوف الصغير للقرن العشرين. أجد في الكتاب الصغير لإيمانويل مونيي والذي يحمل هذا العنوان، أحد المؤهّلين أكثر لإرجاع التأثير العاطفي لأدب الكارثة إلى مقداره الصحيح، ومن دون شكّ فليست حيرة ما قبالة التقنيات الإدارية الكبرى التي تتطلّبها سياسة التخطيط الاقتصادي، والعمالة الكاملة، والجمعنة socialisation الصحة العمومية والتأمين الاجتماعي، أكثر دلالة من حيرة مراهق متعلّق بوسط أسري يرعاه قد قذف به في إيقاع حياة أوسع وأسرع. قد لا يكون ذوبان التقاليد القديمة الحرفية والريفيّة، وصعوبة التحكّم في ابتكاراتنا الخاصّة، سوى تقلّبات تكيّفٍ تُنبِأ بتوازن جديد بين الإنسان ووسطه. وعلى أيّ حال، فإنّ اكتساب التقنيات الصناعية والإدارية لا يمكن الارتداد عنه، ولا تكمن المهمّة في النواح ولا الندم، بل في الإصلاح والتعويض.
لكن لا يكفي التقليل من الخوف الصغير للقرن العشرين، بل يجب أن ندمج في التأمل الجانب الأصيل للقلق الذي يحمله. إنّ جيلنا أكثر حساسية بلا شكّ من الأجيال السابقة تجاه غموض معيّن للتطوّر التاريخي. فليست حقيقة القلق التاريخي الانحطاط، بل تناقض المكسب الإنساني، كما لو كانت حيلة التاريخ هي صناعة الإيجابي والسلبي بشكل غير مقسّم وإذن إلغاء الواحد تلو الآخر لبُنى التقدّم والانحطاط لدينا.
إنّ نفس التقنيات إذن التي تخفّف من معاناة البشر تولّد هذا الشرّ الحادّ للملل في الرفاه وحتّى في العمل، هذا الملل الذي، كما رأينا، يقود الإنسان إلى قلق نفسي. بيد أن الغموض هو خاصّة مُقلق على مستوى سياسي بالتحديد؛ ومنذ مائة وخمسون عاما يتطوّر وعي سياسي دافعه الإيمان بأنّ المؤسسة السياسية مخوّل لها التعديل إراديا وعقلانيا لصُدَفِ الحياة الاقتصادية المسماة سابقا بغرور، قوانين طبيعيّة، واستبعاد العنف والظلم الذي يدير توزيع الثروات.
لكنّ هذا الوعي السياسي الذي تستيقظ عليه القارة الآسيوية اليوم والذي ستستيقظ عليه إفريقيا غدا، هو في نشأته وعي مريض. . وفي هذا الصدد، فإنّ أعمال البسيكولوجيا الاجتماعية للعمل هي أكثر فائدة ألف مرّة من أدب الكارثة من أجل تصحيح الآثار السلبية لتقسيم العمل المفتّت. وهذه الأعمال نافعة لأنّها تمنح الفضل للتوجّه العام الذي يتّخذه العمل الإنساني وتصلحه من داخل بدل نقده من خارج. عنف جديد. وفي هذا الصدد ليس النظام المعسكراتي concentrationnaire من دون شكّ سوى الشكل الأكثر فظاعة لشرٍّ كلّياني يقطع مع الديمقراطيات القديمة مثل القوميات الشابة لما وراء البحار والاشتراكية السوفياتية.
إنّ غموض الدولة الحديثة كبير؛ ووعينا السياسي كما لو هو في مأزق: هل يمكن للدولة نفسها أن تكون متدخّلة في الشأن الاقتصادي والسياسي وتحمي المثول أمام القضاء، وحرية التفكير والحق في الخطأ بوصفها مكاسب الليبيرالية من قبل؟ علينا الاعتراف بأنّ الاقتصاد السياسي هو علم أكثر تقدّما من حال تفكيرنا في السياسة من حيث هي كذلك، في بنيتها الخاصّة، وفي الأهواء المميّزة التي تتصل بالسلطة.
على هذا النحو كان السياسي حيّزا بامتياز لغموض التاريخ المعاصر الباعث على القلق والذي يضلّلنا عنه تماما أولئك الذين يتوقفون عند ضرر الآلات والتقنيات؛ ويتمسّكون بالأشياء، وبالأدوات ويضلّون عن الدّاء المميّز للتاريخ المعاصر الذي يمسّ عمليات الإنسانية المكوّنة للسلطة وسيادة الدولة. (1) ذلك هو القلق الذي يطوّره التاريخ المعاصر عن طريق وعينا السياسي الخاص. فنحن بالذات بوصفنا إنسانا سياسيا homo politicus، من يخلق غموض تاريخنا.
هكذا يصبح تفاؤلنا على صعيد التقنيات، والذي كان ضربا من ردّ فعل لحيوية، وبحسب عبارة إ. مونيي بالذات،” تفاؤلا مأساويا”. لقد اتسع مسار القلق: ينضاف إلى عرضية الكائن الحيّ، وهشاشة النظام النفسي، غموض التاريخ؛ وتنضاف إمكانية الموت وإمكانية الاغتراب، إلى إمكانية اللامعنى؛ وينعكس هذا الخطر من درجة ثالثة بدوره في خطر ثاني وأولّ: فالسلم وملل الحضارة محفّز للقلق النفسي؛ وتضاعف الحرب والدمار الشامل بلا نهاية قلق الأولي للموت. . .
ما هي قدرة التفكير تجاه هذا القلق من درجة ثالثة؟ إنّ فصل الأصيل عن الهجين، والوعي بغموض التاريخ في مساره، هو أيضا الحفاظ على سلوك المتفرّج اللامبالي وربّما المزدري الذي يعتبر أنّه على “مسار العالم “؛ ومشهد غموض التاريخ، أن يصبحا أسلوبا لإرادتنا الأكثر خصوصية. أعتقد أنّه علينا أن نبحث هنا عن المعنى الحقيقيّ العلاجي للوجودية الفرنسية؛ فليست بالمرة فريسة شيء من المجاملة للعبث، بل مسكونة بضرب من الشجاعة تجاه لايقينية اتجاه التاريخ- بشجاعة تاريخية- قادرة على درء القلق بفعل الإمساك به في ذاته وإدماجه تماما في الحرية.
(1) نحن نعلم جيّدا بالخصوص، أن مشكل الطاقة الذريّة هو مشكل سياسي وليس تقنيا: فالمسألة هي في معرفة ما إذا استمرّت القوى العظمى في إخضاع إنتاج الطاقة الذريّة للسريّة، وبالتالي إهانة وتوظيف العمل العلمي لغاياتها الإستراتيجية أو إذا ما نقلت في الوقت المناسب هذه القوّة إلى مؤسسة عالمية ذات طابع عمومي وسلمي. إنّ خوفنا على عتبة العصر الذرّي ليس بالأساس خوفا فيزيائيا، ولا حتّى تقنيا، بل في النهاية سياسيّ. وخلف رعب تدمير مادّي لكلّ الأجساد وكل الأعمال، وحتى خلف دوار القوّة الطاقية المتضاعفة، يختفي الخوف أمام قوّة الدولة التي تمسك بالسرّ، بالإرادة والسلطة المتصلة بهذه الطاقة. يشعر كلّ إنسان منزوع ملكية أداة إنتاج جماعي، بمؤسسّة تحوّل الاتجاه والاستخدام ويبدو لنا أنّها تخفي سرّ موتنا حتّى. لقد أصبح الخطر الذرّي إذن هو الشكل الفيزيائي للدولة، من حيث أنّنا لا نتعرّف فيها على تفويض وجودنا السياسي الخاص، والخطر الذري هو وعينا السياسي الخاص، مغترب في قوّة حاقدة وقاتلة لتاريخنا الخاص.
إذن، برفع إرادة الحياة إلى إرادة جماعية واجتماعية، إلى ” الروح” بالمعنى الهيجلي، وقع تجاوز القلق في مستوياته الأولى؛ والآن وبالتخلي عن المعرفة المطلقة والترحيب بصُدَفِ مصير تاريخي في ذاته، يمكن الانتصار على القلق في مرحلته التاريخية. إنّها مهمّة فلسفة الحرية أن تقوم بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه.
كيف لي أن أخشى” سلبي” التاريخ- إذا فهمت بأنّ ” السلبي” الأوّل، هو أن أكونه- إذا قبلت أن أكون ” سلبي” العالم، سلبيَ ما اكتسبته بالخصوص، وسلبيَ أعمالي الخاصّة، التي، بتأثير العادة، تعيد تشكيل ما هو في حدّ ذاتهl’en-soi في صلب الذاتي؟ لقد تعرفنا على مبحث عدم الحرية، بما هو استبدال وجودي لمبحث هيجلي لألم ” السلبي”؛ لكن بينما نذهب عند هيجل من الوعي بالذات البائس إلى الفكر بوصفه تأليفا بين الكوني والفردي، ننثني من فلسفة التاريخ إلى فلسفة الحرية. وفي نفس الوقت، لم يقع تجاوز القلق، ولم نتخطّى السلبي، بل كما تقول هذه الفلسفة، هو “مضْطُلع” به، أي أنّ الحرية هي سَوِيّة قلق وانكشاف، قلق الانهيار، وانسحاب الذات من ذاتها، دون ضمان و انبجاس لمشروع، انفتاح على المستقبل وموقف للتاريخ.
- مقاربة في شعرية التصوف

- كيف تقرأ كافكا (الجزء الثاني)

- قَصّ أثر الدابة بين الفراسة وفنّ التّحرّي: دراسة مقارنة في خبر أبناء نزار بن مَعَدّ بن عدنان مع أشباهه في الآداب الأخرى

3
ليست المناسبة مواتية للتساؤل عما إذا كانت الحرية متعرّف عليها في ماهيتها الحقيقيّة حينما نثير سلبيتها؛ أليست فوق- كائن بدلا من نقيصة كائن؟ أتخلّى تماما عن هذا النقاش. وأتساءل فحسب إذا ما كان القلق الكامن في الاختيار هو فعلا أساس القلق وإذا ما لم يخفي قلق الوضعية التاريخية لكلّ اختيار، قلقا أكثر جذريّة أيضا: في اللحظة التي انطق فيها الكلمات المجيدة ” افعل وفي الفعل تصنع نفسك”، أخاف من أن لا أقدر، وأخاف أن أكون فريسة لقلق عجز، فريسة للعنة، لفتنة، أكون فيها في الآن نفسه صاحبها وضحيتها. يتعمّق هنا التفكير في مناطق يميل الحاضر إلى التستّر عنها؛ يعود القلق بالأحرى إلى أساطير قديمة، إلى التراجيديا الإغريقية والتوراة العبرية.
هذا القلق الذي نسمّيه قلق الذنب، ليس خوفا محدّدا بمحرّم، بمنع محدود. يصبح قلقا في اللحظة المحدّدة التي أتجاوز فيها النطاق الأخلاقي خاصّة للتقيّد بالوصايا التي جمّدها التقليد وحيث أَمُرُّ من الاستقامة الأخلاقية إلى الكمال أو القداسة اللامحدودة. الشيفرات متعالية، ولكن أيضا الواجبات العائلية والإلزام المتوسط. وأدخل ضمن مجال الخطر المطلق عن طريق الجوقة التراجيدية وبواسطة نبيّ إسرائيل(1): أنا حريّة ” في التيه”، حريّة ” ضائعة”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إنه أشعياء Esaïe صائحا في هيكل الرؤيا:” ويل لي ! لقد ضعت، لأّني ملطّخ الشفاه وأقيم بين شعب ملطّخ الشفاه هو الآخر وأعيننا قد شاهدت الملك رب الجيوش!“
وبشكل أدق، لا يعني مشكل القلق سوى أحد مكوّنا الحرية التائهة والضائعة. تنظر الأولى إلى الماضي: أنا ” دائما بعدُ” immer schon- حرية خائرة القوى déchue، حتى أتكلم مثل هيدجر في الصفحات الغريبة “للكينونة والزمان” عن فارفاللن verfallen؛ وبالسمة الثانية، التي تنظر إلى المستقبل، يكون الذنب مقلقا: أنا من أكون دوما مرتبطا بعدُ، أبدأ وأعيد الشرّ في العالم بقصد حرّ ومع ذلك مستعبد. هذا هو المكوّن الذي وضّحه هيدجر في مفهومه الشهير للقلق. وليس هذا القلق من شدّة الذنب، الوعي بارتكاب الخطيئة، الذي هو ألم أخلاقي وليس قلقا، بل الوعي بالوجود قدرة على الخطيئة؛ و ما يقلق في الذنب هو دوار الإغراء.
يسلّط جان وال Jean Wahl الضوء في أبحاثه الهيدجرية، على هذا القلق بعبارة لشيلينغ:” لم يوجد الشرّ أبدا بل يجهد نفسه كي يكون”. يدور هذا القلق إذن مثل أيّ قلق حول مُمْكِن: لكنه ممكنٌ يؤثّر بدرجة ثانية في هذه الإمكانية التي أكون، من حيث هي حريّة. (إنّها إمكانية لتقهقري من حيث أني إمكانية وجود حرّ). نجد في هذه الإمكانية، وبدرجة متفاوتة، غموض التاريخ؛ يرى كيركجارد بالفعل في قلق الذنب مزيجا من الجذب والدفع، تعاطف كريه، كما يقول، أو كره جذّاب؛ هذا الغموض الذي أصبح تناقضا، هو بالتحديد غموض الدُّوار، وغموض الإغراء.
يكتشف هذا القلق أيضا العدم – أو عدما. ولكن أي عدم؟ أعتقد أنّه، يجب هاهنا، تجزئة السلبية الهيجيلية الُمُغرية جدّا- ” السيد جاك للفسلفة الهيجيلية” كما يقول كيركجارد- وتفكيكها، حتّى وفق تمفصلات القلق: هذا العدم ليس لا الموت، ولا الجنون، ولا اللامعنى le non-sens، ولا حتّى هذا النفي الفاعل للكائن- هكذا l’être-là الذي يمثّل الحريّة، إنّه غرور الحرية ذاتها، اللاشيء لحرية مستعبدة.
من أي مصدر يكون التفكير إذن، قبالة هذا القلق الجديد؟ لابدّ أوّلا أن نؤكّد بقوّة أن هذا القلق لا يخرج عن حقل التفكير الممكن؛ فالتجربة المتفردة لـ كيركجارد يمكن أن تصبح كونية بالفلسفة الأكثر كلاسيكية. يستدعي أفلاطون في الكراتيل هذه الأرواح فريسة الدوار الذي ابتكرته، بلغة المتحرّك، وهم المتحرّك بالذات؛ وبشكل أقوى، في الفيدون، يكتشف أن النفس” سجينة” الجسد لأنّها تجعل من نفسها ” جلاّد نفسها”، هو الأسر الأوّلي للنفس الذي يجعل من الرغبة سجنا:” المدهش في هذا السياج، قد أدركته الفلسفة، بكونه صنيع الرغبة وأنّ ما يساعد أكثر على تحميل المقيّد قيوده، قد يكون هو ذاته”. نجد لدى أفلوطين صفحات مدهشة عن افتتان النفس وانصباغها، أو بالتبادل تبدو هذه الأخيرة أي النفس منشدّة إلى الخارج المطلق ومبدعة لهذا الدافع نحو الخارج ونحو الأسفل.
إنّ التفكير إذن، بجعله التجارب الأكثر فردية، تجارب كونية، يلجأ إلى نقد الأصالةauthenticité التي ما تزال تشغلنا؛ ويُدرج في هذا النقد العلومَ الأكثر تنوّعا؛ أفكر هنا بالخصوص في محاكمة فكرة الذنب للدكتور هزنار Dr Hesnard في العالم المرضي للخطأ؛ من الممتاز أن تكون تجربة الخطأ قد هذّبها علم النفس التحليلي؛ ذلك أن الذنب الحقيقي ينبثق من وراء الخوف من الذات، من العقاب الذاتي، من وراء دافع الهروب إلى العُصاب؛ إنّه يظهر في هذه النقطة من ذواتنا والتي يسمّيها كانط Willkür وليس Freiheit، في صلب هذه الحريّة الذاتية المحدّدة بميلاد المقاصد، و” المبادئ العامة” للإرادة، ما نعبّر عنه اليوم بالمشروع.
يساعد النقد التحليلنفسي للذنب إذن على التفكير في تمييز القلق السليم عن القلق العصابي بكل بساطة، الذي يؤدّي بنا إلى مستويات مُتَجاوَزَة لجدلية القلق. ويجب أن يلتحق بهذا النقد العلمي، نقد هو بالتحديد وجودي، سيميّز القلقَ الأصيلَ لهذا الرضا عن العبودية الذي يسمّيه القدامى دونيّة والذي استعاد سارتر محاكمته في ّالذبابّ وفي مواضع أخرى.
يصل القلق بهذا النقد للأصالة إلى حقيقته؛ المُفَكّر فيها بقدر ما هو ممكن؛ وأجد نموذجَ مثل هذا التفكير في محاولة كانط حول الشرّ الأصلي الذي يتفق كارك بارط وكارل جاسبرس بشكل خارق على الإعجاب به. وقد أقول إنّ كانط في هذه المحاولة، قد فكّر فيما عاشه كيركجارد وأحسّه؛ فكانط يرفع إلى مستوى المفهوم قلق كيركجارد ويسمح لي بالحديث في الحقيقة عن مفهوم القلق.
التفكير في الشرّ الأصلي بالنسبة إلى كانط، هو التفكير في مبدأ معين للاختيار الحرّ الذي يصلح كأساس لكلّ المبادئ السيّئة في التجربة والتاريخ؛ وهذا الأساس، هذا Grund (الأرض)، يسمح لي بالتعرّف هنا وهناك على الأشكال المتناثرة للشرّ الخبري. (حتّى أنّ كانط يقول بأنّ هذا Grund يجعل الأفعال السيئة قابلة للتعقّل)؛ بيد أن هذا Grund بدوره مُسْتَغْلَق ((unerforschbar من جهة منبعه، إذ، كما يقول، لا يوجد أيّ سبب مفهوم((kein begreiflicher Grund) لمعرفة من أين أمكن للشر أن ينشأ أوّلا؛ هذا هو القلق مُفكّرا فيه: أساس أعمال سيئة لا أساس لها، بل قد نقول( الأرض) Grund هو Abgrund( هوّة). ويقرّب كانط ذاته هذا المستغلق والمبهم من رواية الكتاب المقدس لسقوط الإنسان في الخطيئة؛ ليسبق كيركجارد الذي يؤكّد على طابع الحدث للشرّ الذي يبدأ ويُعاد؛ ويكشف هذا الطابع لحدث الخطأ إذن عن قرابة مع بنية الرواية الأسطورية التي تلبّس بها السقوط في الخطيئة في الإنجيل ولدى أفلاطون.
لكن التفكير- كما قلنا بعدُ في شأن الدرجات السابقة للقلق- لا ينحصر في نقد وفي التفكير في القلق؛ فالمحاولة الكانطية تحديدا، هي نموذجٌ لتفكير يمكن أن نسمّيه استرداديا récupératrice. إنّ التفكير في الشرّ الأصلي أو الجذري، هو الحفر في ما بعد المقاصد المتعاقبة، في ما بعد اختيارات متقطّعة يبعثرها الزّمن إلى حدّ هذه الشمولية للأنا؛ وفي نفس الوقت أكتشف هذا المنبع للفعل الذي منه يمكن أن ينبجس البعث أو الإحياء. يجعل القلق الأنا دون حدود، يعمّقها إلى حدّ هذا الأصل للأفعال الذي أسميناه الإثبات الأصلي l’affirmation originaire. (1)
ـــــــــــــــــــــــــ
1-. أعبّر مرّة أخرى عن امتناني للسيد جان نابير Jean Nabert. وكتابه عناصر من أجل إيتيقا الذي يبدأ تحديدا بتفكير في الخطأ.
كيف يكون ذلك ممكنا؟ يقرّ كانط في محاولته الرائعة بأنّ نفس الاختيار الحرّ، ونفس Willkür،( التحكّم) هو الذي يكون في نفس الوقت ميلا إلى الشرّ – Hang zum Bösen – ومقصدَ الخير – Bestimmung zum Guten-؛ أنا ” مائل إلى الشر” و” وعازم على الخير”، يقول لوثر:” معا صيادون وعادلون” simul peccator et justus. هنا فيما أعتقد تكون تجربة التوبة أو كما يقول كانط، تجربة التجدّد؛ يستعيد فيها القلق الزخم. ومن غير شكّ، فإنّ كانط بوصفه فيلسوفا لا يعرف شيئا عن الإنقاذ، عن الرحمة، التي ستكون كخلق جديد و هو ما يسمّيه المسيحيّ “الغفران عن الخطايا” « rémission des péchés »، لكن الفيلسوف التأملي يعرف على الأقلّ أنّ النقطة الدقيقة هي حيثُ تتراكبُ الهِبَةُ على الحرية، وهذا هو بالذات ما كشف عنه القلق. .
4
هل نحن على المرفأ؟ حتّى أنهي كلامي أودّ، أن أنقل باختصار هذه الجدلية للقلق إلى أفق قلق أقصى؛ من وراء القلق الحيوي للموت، القلق النفسي للاغتراب، القلق التاريخي لللامعنى، وحتى من وراء القلق الوجودي تحديدا للاختيار والذنب، وهاهو القلق الميتافيزيقي قد حَلَّ، ذاك الذي يعبّر عن نفسه أسطوريا في مبحث غضب الربّ. غضب الربّ: هل من قبيل الصدفة أن الإله ليس شرّيرا؟ هذه الإمكانية المرعبة أبعد من أن تكون عقيمة: إنّ لطف الله هو آخر فكرة غزوناها وربما لا تكون إلاّ مأمولا، مثل آخر حدّ، مثل έσχατον النهاية أو ما يتبقّى من كلّ المحن. كثير من ” المؤمنين” يصلون بيسر وبالإلف إلى لطف ” الرب الرحيم”.
إنّ التجربة الحاسمة التي تدخل في هذا القلق هي فيما أعتقد، تجربة العادل المتألّم. لقد أدرك الوعي العبراني هذا بعد مرحلة النّفْي؛ وكتاب (النبيّ) أيّوب أفضل تعبير. إنّ أيوب هو فشل تفسير للألم الناتج عن العقاب: هاهو فعلا البريء (بريء مفترض: أيوب هو فرضية درامية)، البريء الذي تُرك للشقاء أو البلاء. ويريد أصدقاء أيوب، والذين هم صورة للتبرير الإلهي، أن يعترفوا له بأنّ الشقاء أو المحنة ليست سوى نتيجة لخطيئته؛ لكن أيوب لا يدرك ذلك واعتراضه يكشف عن لغز الشقاء الذي قد لا يكون مقترنا بالخطيئة.
إنّ قلق الذنب ليس إذن آخر قلق: لقد حاولت أن أحمل على عاتقي الشرّ، وأن أنظر إلى نفسي بوصفي من يبدأ الشرّ في العالم، ولكن هاهو أيوب، هاهو العادل المتألّم؛ هاهو الشرّ يُدْرِك الإنسانَ، الشرّ بما هو شقاء. ، وبالتأكيد أكثر ما يؤثّر فينا نحن المعاصرون، هي صورة الطفل المتألّم أو الذي يعاني؛ الطفل المتألّم تلخّص كل مصير الإنسان الضحيّة، مصيرا متشابكا مع الإنسان المذنب، دون أيّ تطابق، ودون أيّ تناسب يبدو أنّه يصل الشقاء بالخطيئة. هل يصبح الوجود في واقعيته طاعونا؟
يرتدّ هذا القلق فجأة من أعلى قمّة السلّم نحو قاعدته، ليبدو مختصرا كل الدرجات.
يستولي (القلق) أولا على قلق الذنب الذي لا يخرج منه لكن يستأنفه من أعلى: الغضب le φόбος في التراجيديا اليونانية متأتّ من هذا الشعور المرعب بأنّ ذنب الإنسان، غضبه، هو في الآن نفسه مكر آلهة يضلّل عن التصميم. ينشأ التراجيدي الإغريقي، مأساة آخيل على الأقلّ، من التحام هذه النمطين من القلق: قلق أساسه شرّير وقلق إنسان مذنب. يبدو التفكير العبراني أوّلا بعيدا جدّا عن هذا التصوّر التراجيدي: ومع ذلك، فإنّ إمكانية الكارثة واللعنة الأصلية، ستنبثق من عدّة سبل: إله الأنبياء يكشف عن مطلبه المطلق في رعد الدّمار، في سخط التاريخ؛ إنّ قداسته قداسة رهيبة. فالاسم الأعلى للرب Jahvé هو أيضا الإله الذي يقسو؛ وفي رواية السقوط في الخطيئة تلعب الحيّة دورا ملغزا يشهد بأنّ الإنسان ليس الشرّير المطلق؛ فليس هو على المطلق سوى الشرير بالغواية، إذن، يوجد خارجه إغراء على الخطيئة ينبثق من عاطفته الهشّة ومن مشهد الفوضى الذي يهبه الخلق؛ ثمّ، كيف يكون ” الشيطان” ممكنا، إذا ما “سبق “الشيطان””آدم”؟
يلتحق قلق الأساس الشرّير أيضا، شيئا فشيئا بضروب القلق الأخرى: أليس لا معنى التاريخ الصورة الأضخم للفوضى؟ تَرَى فلسفات التاريخ في ” السلبي” توسّطا نحو تآليف جديدة؛ ولكنها تُسكِت كلّ ما لا يقبل الاسترداد في معنى أوسع وأرفع؛ تسكت كلّ ما لم يصلح لشيء،كلّ ما هو مخلّفات خالصة في نظر معقولية التاريخ: تألّم الصغار، متواضعون منفّذون يمكن استردادهم، تفاهة حياة بلا أفق ولا هدف؛ هذا ” السلبي” الذي يبدو أنّه لا يوسّط شيئا، يدمجه القلق الميتافيزيقي في عاطفته.
وفي النهاية يُسْتَعاد القلق الأوّلي للموت في قلق الصفّ الأخير؛ و الإنسان الذي يعلّم معنى الأشياء، والذي يعزم على مهامّ غير محدّدة، أنّ هذا الإنسان يجب أن يموت، فهذا هو فعلا العلامة الأكثر صراحة على ظاهر لامعنى الأساس. لأجل هذا تتحدث نهاية العالم عن الموت مثل آخر عدوّ سيتُغَلَبُ عليه. يوجد إذن من بين كلّ أشكال القلق ضرب من الدائريّة أو تبادليّة تجعل من القلق الأولي هو أيضا القلق الأخير.
بأيّ ثمن يمكن أن يكون التفكير تفكيرا استرداديا: هل له ما يتغلب به على استيهام ” “الإله الشرّير”؟ لن أحاول تقنيع القفزة التي يمثّلها التوصّل إلى فعل الرجاء الذي يبدو لي قادرا لوحده على مجابهة القلق الأخير؛ لا يمكن لأيّ أبولوجيا apologétique ولا لأيّ ربوبية تفسيرية أن تحل محلّ الرجاء. لقد وقعت مواساة أيّوب في النهاية، لا بتفسيرٍ، بل بتوسّط الألم الذي أفضى إلى نوع من اللقاء بالإله الحي.
يبدو إذن، أن التفكير اكتمل بالحدس؛ إذ، حتّى الوعي الذي اضطلع تماما بألمه الخاص وتعرّف فيه على الطريق الممكن لاكتماله الخاص، سيكون فحسب قد لَمَحَ أنّ غضب الربّ هو ظاهر حب الله بالنسبة إلينا. سيلمح ذلك فحسب، ذلك أن ألم الآخرين يظل أيضا بالنسبة إليه ” لغز الإثم”. وحده الرجاء الأُخروي، لا الحدس، ولا المعرفة، تخلّصُ أبعد ما يكون نهاية استيهام غضب الربّ.
لكن، لنأخذ حذرنا، لا يمكننا الاستفادة من هذا الفعل والذهاب مطمئنّين مثل مابعد نهاية سعيدة لفيلم حزين. يقينا، يستشعر فعل الرجاء شمولية خيّرة للكائن في البداية وفي نهاية ” حسرة الخلق” soupir de la création؛ لكن هذا الإحساس ليس سوى الفكرة الناظمة لحسّي الميتافيزيقي؛ ويبقى بشكل لا ينفصم مختلطا بالقلق الذي يتوقع شمولية لا معنى لها بالتحديد. ” ليكن هذا حسنا” – wie auch es sei das Leben, es ist gut – فإنّي لا أراه: آمله ليلا. ثمّ، هل أنا في الرجاء؟ لأجل هذا، وبالرغم من أن الرجاء هو النقيض الحقيقيّ للقلق، فأنا لا أختلف أبدا عن صديقي اليائس؛ أنا حبيس الصمت، مثله، أمام لغز الإثم. لاشيء أقرب من قلق اللامعنى من الرجاء الخجول.
ومع ذلك فهذا الفعل الصغير يحدث في الصمت وفي نفس الوقت يختفي ويظهر بدوره في قدرته على استخلاص مستويات الإثبات الأصلي. فبهذه القدرة التلخيصية، يكشف عن التفكير، مثلما يكون في مرآة محطّمة؛ إنّه هو الذي ينشّط سرّا هذه الإعادة لتدفّق الأنا العميق الذي ذاق سياط قلق الإثم، والتفاؤل التراجيدي في مواجهة غموض التاريخ وفي النهاية الطاقة النفسية ذاتها ومجرّد إرادة الحياة للوجود اليومي والقاتل.
يدخل الرجاء إذن في مجال التفكير، مثل التفكير في التفكير، وبفكرة ناظمة لكلّ الكائن الخيّر، ولكن، باختلاف مع معرفة مطلقة، لا يحدث الإثبات الأصليّ المسلّح سرّا بالرجاء، أيَّ إسقاط Afhebung مُطَمئن؛ فهو لا”يتخطّى “، بل “يواجه”؛ ولا” يُصالح” بل ” يُوَاسي”؛ لأجل ذلك سيرافقه القلق إلى آخر يوم.