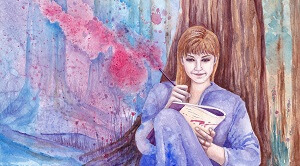أ – منطلقات واحتياطات:
يظهر أن البداية الإيجابية لتأمل إيجابي لقضية الحداثة الشعرية عامة، وقضية الإيقاع خاصة تقتضي نقاد الشعر حاليا الانتقال من ثنائية التبشير والنبوات، من جهة، والتكذيب والتكفير من جهة ثانية، إلى تأمل المعجم المستعمل في خطاب الحداثة، والآخر المستعمل في ردها، من موقع ثالث.
لماذا؟
لأن المعجم صار عائقا في حد ذاته. فهناك مجموعة مصطلحات ومفاهيم رائجة متداولة، بل هي سند إنجازات تنتمي إلى حركة الحداثة، وهي قابلة للنقاش، بل إنها لتستدعي مراجعة جدية على أسس نظرية وتأسيس تاريخي. إذ تكاد في كثير من الأحيان تبرر العنف الذي تقابل به هذه الدعوى حتى من مبدعين كبار يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان منفيين ضائعين وسط لغط لا ضوابط للغته: الانقلاب والقطيعة والتجاوز المستمر.. الخ.
لذلك سأنطلق من مبادئ من الممكن أن تعتبر مسلمات (خاصة حين تذكر) ولكنها قد تكون مثار سوء تفاهم (حين لا تذكر)، حين يعتمد على بداهتها.
-
مكونات الإيقاع:
1 – تنحصر معالجتي للموضوع في الإطار التاريخي؛ أي بالنظر إلى الأثر الشعري المنجز والمتلقي الواقعي، وتأبى الخوض في المطلق، أو الرحلة نحو سدرة المنتهى، فلذلك فرسانه.
1.2- وعلى ذلك أرى أن الإيقاع هو الملمح النوعي للشعر العربي منذ القديم، أو على الأقل هو الملمح الحاضر في كل النصوص التي لم ينازع في شعريتها(1). وحين أقول المميز لا أعني الكافي. بل أعني الشرط الضروري لدخول نص ما منطقه الشعر، ثم تبدأ التركيبات الكيميائية حوله. ويبدو، لحد الآن، أنه عنصر غير قابل للتعويض إلا من طينته ومادته.
وربما أمكن تعميم هذا على حضارات إنسانية أخرى. فبعد نظر في البعد التاريخي والحضاري لتشكل الإيقاع وصل بول زمطور في كتابه مدخل إلى الشعر الشفوي إلى النتيجة العامة التالية: “يبقى أن الإيقاع، في جميع أنحاء العالم، حسب الكلمة المشهورة لما ياكوفسكي، هو القوة المغناطيسية للشعر (للقصيد)”(2).
2.2- المكون المركزي في الإيقاع مكون موسيقي صوتي(3)، وأقول المركزي ولا أقول الوحيد. وهذا مبرر نعت البنية الإيقاعية بموسيقى الشعر(4) حينا وبالمستوى الصوتي(5) حينا آخر.. الخ.
من هنا فلا أرى من المناسب جعل العروض والقافية مساويين للإيقاع، كما يفهم من العبارات الاختزالية لبعض الباحثين حين يقولون: الإيقاع أو الوزن أو القافية أو العروض عامة. بل إن الوزن نفسه لا يعني، في تعريف المدققين من القدماء، الوزن العروضي المجرد وحده. فقدامة ابن جعفر الذي طالما حمل وزر تعريف الشعر باعتبار الوزن، يقول: “ومن نعوت الوزن الترصيع”(6). والترصيع مكون شعري حر وشبه حر.
3.2-المكون الصوتي في الشعر لا يشتغل تراكما بل تفاعلا داخليا وخارجيا حضورا وغيابا. فالإيقاع في القصيدة العربية ذو أربعة أركان:
1.3.2-البنية المجردة، وهي بنية سابقة على التحقق اللغوي. وهذا التجريد هو مبرر الحديث عن موسيقى الشعر وهي ذات مستويين: مسطح وتعبيري:
ـ فالمستوى الكمي المسطح، سابق عن الأجراس وألوانها، تستوي فيه صيغة “شاعر” (فاعل) وصيغة “متقن” (مفعل)، فمقابلهما العروضي واحد: 0//0
شَاعِرُنْ مُتْقِنُنْ
/ 0 / / 0 = / 0 / / 0
فلا فرق عروضيا بين مد الشين وسكون التاء. ولذلك عبر عنهما عروضيا بصيغة واحدة: فاعلن. وهذا إجراء ينطوي على اختزال ضروري لقيام علم شكلي بحت. ولذلك فهذا المستوى أميل إلى الانتظام والسكون وهو مصدر تهمة الرتابة.
ـ أما المستوى النوعي التعبيري: فتعبر عنه الأنساق التي تكونها الحركات والسكنات: التفاعيل. فعلى أساس هذه الأنساق -لا على أساس الكم أو المقاطع- مُيِّز بين البحور. وأعطيت أسماؤها التعبيرية: البسيط والمتقارب، والخفيف.. الخ. وقد بذلت جهود كبيرة قديما وحديثا لاستكشاف الجوانب التعبيرية لهذا المستوى خاصة بالنظر إلى الأغراض والمعاني الشعرية. وهذا مسعى غير سليم في نظرنا، لأنه بحث عن المعنى قبل الخوض في اللغة. ولذلك لاحظ الدارسون انتقال هذا المستوى بين الحضارات دونما حاجة إلى معرفة اللغة المأخوذ منها(7).
2.3.2-البنية المجسدة بالصوائت والصوامت؛ بنية لغوية تتخذ من البنية الأولى أو النسق الأول فضاء لتوزيعها، وهي مصدر الحركة لأنها تقوم على تفاعلات خارجية مع المكونات الأخرى الدلالية والنظمية. وهي تخالف النسق التجريدي من حيث منطقها ومنطلقها بكونها حرة وشبه حرة.. وإلا تحولت هي الأخرى إلى نسق منتظم، وفقدت حيويتها. إذ تصبح نظاما بديلا أي سجعا أو موشحات. وبالتفاعل بين المستويين تبدأ عملية إنتاج المعنى الشعري.
والقافية جزء من البنية التوازنية فمن الأجدى أن ننظر إليها نظرة شمولية باعتبارها ترددا صوتيا في آخر الوحدات المتوازنة، منها مستوى منتظم ومستوى حر وشبه حر.
لقد وصلت القافية في الشعر القديم إلى حدود الانتظام التام، أي الإصرار على إبراز جميع الوحدات المتناظرة بنفس التردد الصوتي.
وإلى جانب هذا الإطار المنتظم الذي بلغ حدود التشبع مع لزوم ما لا يلزم، وحد العبث الهزلي مع الجناس المركب، هناك أنساق من القوافي الحرة غير المطردة أو التسجيع.
فهل السؤال مطروح في مستوى الأنساق أم في مستوى المبدأ الإيقاعي نفسه؟ إن قصيدة التفعيلة تطرح السؤال في المستوى الأول، أي مستوى النسق، في حين تحاول النثيرة نسف المبدأ نفسه(8)، ولكن لا يبدو أنها تقدر حجم الأنقاض التي ستنهال عليها.
وبعبارة أخرى: فهل يستطيع المستوى الحر وشبه الحر من الموازنات أن يكون بديلا للمستوى المنتظم دون أن يقع المنجز في إسار النثر؟
ومن الملاحظ أن الحديث النقدي حول النثيرة لا يعير اهتماما كبيرا للبنية المجسدة بالصوائت والصوامت، وإلى أي حد يمكن استثمارها في إيجاد بديل نوعي للأنساق المنتظمة، المتهمة بالرتابة، دون الوقوع في السجع.
3.3.2-المستوى الثالث هو المستوى التأويلي مستوى الأداء. وقد كان هذا المستوى مهما قديما في القراءات القرآنية لأنه يتحكم في توليد الدلالات، وصار اليوم أشد أهمية في الشعر الحديث لأنه يدخل في تأويل التداخل بين التمفصل الدلالي والتقطيع النظمي والتوزيع الفضائي لتوليد مستويات متعددة من الدلالة. فالراوي اليوم هو الورق والشاشة التي ستسمح بتشكيلات جديدة غير متوقعة.
4.3.2-وبناء عليه فإن العنصر الرابع المعتبر في بناء الإيقاع هو العنصر الدلالي والتركيبي النحوي. وذلك باعتبارهما فضاء وعنصر مخالفة مبرزة.
تحولات الإيقاع:
1 – تطور الإيقاع كوني ثم إقليمي، وبهذا الاعتبار ننظر إلى ما يجري في حوض البحر الأبيض المتوسط من اليونان إلى العرب إلى الغرب حاليا باعتباره أخذا وعطاء. إن المرء ليدهش اليوم حين يقارن المفاهيم البلاغية بين ما استقر في التراث العربي القديم وما تراكم في البلاغة الغربية القديمة، فهناك لوائح عجيبة لا يفرق بينها غير التقطيع الإجرائي. فالاختلاف يقف عند المظاهر والتجليات.
2.1-ليس النزوع النثري وليد اليوم بل يدخل في منطق الصراع بين البنية ونقيضها على العموم، وبين البنية المتألية والبدائل النشيطة أو المنشطة. وبهذا المنطق فسر يوري تنيانوف والشكلانيون عامة فعالية الإيقاع وما يصيبه من تجديد. فلا خوف من الكونية ولا جدوى كبيرة من إسقاط الوصفات الجاهزة. وسنعود إلى هذه القضية بالتفصيل(9).
3.1-اعتبار الانتقال من الشفوية إلى الكتابة مسألة جذرية غير سطحية ورصد أثارها، والسير معها خطوة خطوة.. ويمكن القول بصفة عامة داخل هذه المقولة بأن إيقاع الشعر العربي قد تطور (مثل الشعر الغربي) من هيمنة الوظيفة التطريبية التنظيمية التي تتطلب أعلى درجات التناسب، إلى هيمنة وظيفة توليد المعاني مع وجود هامش منافرة مشاكس وصادم منذ أقدم عصوره. وهذا جلي في شعر أبي تمام.
ومع ذلك فليس التنافر وحده ما يفسد استراتيجية الإيقاع الكلاسيكي، بل تفسدها أيضا المبالغة في التوازن مبالغة تلغي العروض وتضعف القافية (وجود قواف داخلية كثيرة). ومن ذلك نثرية الرجز والموشحات برغم قوة كثافتها الصوتية. لقد نشأت داخل العروض نفسه أنساق شبه منتظمة مثل التسميط.. انتهت إلى الموشحات وهي أنساق نازعت القصيد سلطته وقللت من هيبته.
فمن الطريف أن النزوع إلى التنافر المشاكس قد رافقه نزوع نحو التجانس الملغز، ورمز الظاهرتين هو أبو العلاء المعري نفسه الذي أوصل الأمور كلها إلى حدود الانفجار.
للذي تقدم، يمكن القول بأن التحولات التي عرفتها القصيدة في العصر الحديث وما تزال تعرفها هي امتداد لتطور محلي وكوني، فيه الكثير من الإقدام والكثير من الترددات والإحجام.
لقد امتدت فوق رمال شاطئ المجهول الشعري أمواج ظن بعضها أنه عفى على كل آثار البعض الآخر. وما زال الباب مفتوحا.
المتلقي الحديث:
حين نتحدث عن التحديث والحداثة والتجاوز وإفلاس النسق العروضي القديم وعجزه عن الاستجابة للحساسية الحديثة، فلا نستدرك ولا نقيد، نقع ونوقع غيرنا وهم حداثة لا زمنية مطلقة.
والواقع أن نظرة بسيطة في الكتاب المدرسي في البلاد العربية من المحيط إلى الخليج تظهر بجلاء أننا نعيش مع النص الشعري المنتظم طفولتنا ومراهقتنا ثم نقضي معه على مضض في بعض الأحوال -زهرة أيام شبابنا في الجامعة ولا نكاد نلتقي مع النص الجديد إلا لماما وعلى منابر أخرى. فلا شك إذن أن أي مثقف عربي قد شحن- مهما كانت رداءة الشحن – ببرنامج عروضي حتى وإن لم يدرس العروض دراسة استيعاب، وهو برنامج سيظل شغالا مساهما في تحديد أفق توقعه. دعك ممن دون مستوى المثقفين.
صحيح أنه برنامج لا يشتغل بشكل طبيعي لأنه سيصطدم بحالة سيكولوجية غير مواتية، إذ يكتشف في مرحلة متأخرة ومن منابر أخرى (مهرجانات قراءات شعرية) أنه قد خدع في مفهوم الشعر، فما درسه ليس أكثر من تحف قديمة ينبغي التخلي عنها كما يتخلى عن كثير من المتاع الجامعي المتجاوز. وكثير من الجامعيين يرفضون الحديث عن الأحياء لأن الماهية لا تكتمل في اعتقادهم إلا بموت صاحبها(10).
وهكذا فنحن نختزن الإيقاع القديم، وهذا أمر طبيعي، ونمقته وهذا أمر يبدو غير طبيعي.
فما هو الطريق المتوقع لتعامل يخلو من الجحود ومن الانصياع معا؟
سيظل الإيقاع القديم إلى أمد لا ندري حدوده محاورا، لا يعطي وحسب بل يسلب أيضا. وحين سلب في المرحلة الراهنة يحيل على المعاش.
إن ظهوره يفسد اللعبة كما يفسدها غيابه غيابا مطلقا. وبين هذين القطبين تنتج القصيدة الجديدة التي تستجيب للحساسية الحديثة، كما سيأتي.
ب – الآفاق: الحداثة والسائد
أ – نظر: الكوني والمحلي
بقطع النظر عن تشنجات العدمية الصادرة عن ضغوط سيكولوجية وسياسية واجتماعية(11) يمكن القول بأن الحداثة: انزياح مستمر عن المستولي وارتباط حيوي بالواقعي في قراءة السابق واستشفاف آفاق المتوقع أو اللاحق(12). إن الحداثة حين تتحدد بمعارضة الرؤية المستولية لا غير تصبح برنامجا وجوديا قد تمتد تخومه إلى مشارف العبثية. وجودي لأنه يرهن الماهية بما سيكون، ليس بناء على حسابات مضبوطة ومقدمات، تطلب نتائج حتمية، بل على المخالفة وليكن ما يكون.. إنها بعذا المعنى اندفاع نحو النور المنبعث من فانوس أو من الشمس نفسها، فكل حداثي يعد بقبس أو جذوة من نار، وهذا أمر مشروع خاصة في أحوال التيه.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فليس من الغريب، كما وقع دائما عبر التاريخ، وجود دعوات مستقبلية يصوغها بعض نوابغ الشعراء الأكثر حساسية في صور تنبؤية تحريضية عنيفة، وإنما يكمن المشكل في أخذ هذه الدعوات على ظاهر لفظها من طرف أتباع يُشَكُّ أو يُشَكَّكُ دائما في موهبتهم. وقد التبس الشعر منذ أقدم العصور بالقوة الخارقة المخترقة للغيوب فتعامل الشعراء مع ملك الشعر (أو ملكته) كما تعاملوا مع شيطانه حسب البيئات.
أما إذا أخذنا بمفهوم تاريخي فإنها تذكرنا بدورة العصبية عند ابن خلدون، دون التعويل على الاستحمام بماء النهر مرتين. فالحداثي اليوم قد يكون مستوليا غدا. غير أن هذا ليس ممكنا ملاحظته على المستوى الحضاري العام أو الدورات الكبرى إلا بالابتعاد عن المشهد أقصى ما يمكن، أي بالنظر في الأحقاب البعيدة من التاريخ. أما في مستوى الدورات الصغرى فهو ملاحظ مشهود كما هو الحال داخل حركة الحداثة الشعرية. فمن الشطر إلى التفعيلة إلى قصيدة النثر(13). وهلمجرا.
إن الدورة الكبرى كونية هي أشبه بحركة المد ينبسط على امتداد الشاطيء، في حين أن الدورات الصغرى أو الداخلية شبيهة بالأمواج المتلاحقة التي يمتد بها البحر إلى رمال الشاطيء، خطوة خطوة، ليبلل مزيدا من الرمل ويوسع دائرة المد العام، ومنها ما لا يمتد حسب شروط مختلفة. ومن الملاحظ أن تآزر أو تلاحق الأمواج يؤدي إلى غزو أوسع مساحة من الشاطيء، خاصة إذا هبت رياح عابرة للقارات. في الدورة الكبرى تنتج الكليات أو القوانين العامة للشعر كما عبر الفارابي وابن سينا وابن رشد، وفي الدورات الصغرى تنتج التنويعات القومية والمحلية. وإهمال أحد البعدين يؤدي إلى السقوط إما في وهم الأصالة والخصوصية وإما في وهم الكونية والتقليل من شأن الخصوصية والطوابع المحلية ويخلق إحساسا بالاستعلاء. ثم يأتي رد الفعل المحلي عنيفا(14).
من هنا لا أجدني مرتاحا للفصل بين الموردين: المورد الكوني (ولا أقول الخارجي أو الغربي) والمورد المحلي، أو القومي إذا غُلِّبَتْ اللغة. لأن الكوني هو الصياغة الأخيرة للتفاعلات المحلية العالمية، صياغة أخيرة تجري في منطقة مؤهلة اقتصاديا واجتماعيا لاستيعاب التراث العالمي أو أكثره، وقد كانت الصياغة الرشدية في يوم ما كونية. ولم نستوعبها فاستوعبها غيرنا.
لا بد من استيعاب المحليات الفاعلة قبل الطمع في تقديم مقترح حداثي كوني، وهذه الشروط صارت اليوم مرهونة بالتكنولوجيا الإعلامية التي يمتلكها الآخر ونتجادل جراها ونختصم. إن صياغة نموذج كوني رهين بمدى استيعاب التنويعات الإقليمية.
فلنخرج إذن من ثنائية المحلي والكوني أو من اصطناع تعارض بينهما، خاصة بالنسبة للغة العربية وربما بالنسبة لحوض البحر الأبيض المتوسط على العموم فإنه بوتقة واحدة. وسيكون من مهام المرحلة الراهنة في النقد الأدبي تنقية المعجم من رواسب مرحلة هيمن فيها التنافي بين المكونين.
ب – تطبيق:
ستأمل في المحلي:
فإذا اعتبرنا الحداثة، كما تقدم، انزياحا عن السائد في دورة حضارية، انزياحا يتم عبر موجات، واعتبرنا تاريخ الشعر العربي من عهد امرئ القيس إلى الآن دورة لم تكتمل بعد: بالنظر إلى أننا لم نخرج بعد من دائرة ما كنا فيه، ونحن مختصون، لنخطو خطوة إقدام إلى الأمام أو حتى خطوة تربص إلى الخلف، فإن الانزياج عن المستولي، في الشعر، ابتدأت مع اكتمال النموذج القديم أي مع استواء القصيد. والناس لا يذكرون شيئا من مراحل تكون الدورة السابقة، فمؤرخو الشعر العربي يتحدثون عن: مقصد القصيد كما يتحدث النحاة عن المتكلم الأول باللغة. فالقصيدة وجدت حسب الذاكرة العربية كما وجدت اللغة. والذي قصد القصيدة صار (مثل الذي تحدث باللغة) صاحب نسق نهائي مطلق يقتضي الكشف علميا (بالعروض) كما كشف نسق اللغة بالنحو.
إن القصيدة في وعي الثقافة العربية مثل اللغة نسق نهائي. ولهذا المنطق استنبط الخليل نسقين أو برنامجين نهائيين مطلقين للكائن والممكن، للمستعمل والمهمل، هما دوائر العروض وتقليبات جذور المعجم. إن دوائر العروض ليست في نظري شيئا آخر غير المجرات والأفلاك، فكل مجموعة من البحور تدور حول قطب في إيقاع كوني. يؤدي المس به إلى الاختلاف وفساد العالم الشعري إنه نسق نهايته في بدايته. فالمطلق لا يمكن أن يكون إلا دائريا مثل الكون.
إن هذا الترابط القوي في الرؤية العربية عند اكتمال النموذج جعل سؤال الواضع الأول واردا أيضا بالنسبة للشعر كما كان واردا بالنسبة للغة. وهذا ليس محصورا في البناء الإيقاعي بل امتد أيضا إلى معمارية القصيدة كما تصورها ابن قتيبة أو تصورها من أحال عليهم من العارفين في الشعر والشعراء.
بعد هذا نقول: إن أي نموذج يكتمل يتألى وينتج نقيضه منه، غير أن الحسم ليس رهينا بحالات جزئية (منها حالة الشعر) بل مرتبط بالدورة الحضارية كلها. من هنا أصل إلى استنتاج أننا لسنا إلا حلقة من حلقات المخالفة، وأن الدائرة ممتدة في القدم، وما تزال مفتوحة في كل الواجهات. وإذا كنا نعمل في نطاق أطروحة واحدة وهي مناهضة التلاؤم القصيدي المطلق: قصيدة البيت وبيت الشطرين، مناهضته بزرع نقيضه أي اللاتلاؤم، الذي سميناه نثرية، فإن هذه العملية قديمة جدا يمكن تتبعها كما فعلنا في كتاب اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي من زهير الذي يبدو مشاكسا للنموذج المثالي القديم نموذج امرئ القيس، وصولا إلى بروز الأراجيز وشيوع الرجز في العصر الأموي واقتحامه موضوعات كانت لا تقبل غير مهابة القصيد، وصولا إلى تحويل البيت كله إلى شطر واحد أو دمج الشطرين كما فعل أبو العلاء بالبحر الخفيف الذي يبدو، لولا القافية، قصيدة تفعيلية، خاصة حين تستعمل معه أدوات الربط من عطف واستفهام. وأجدني ذاتيا أقرأ البيتين التاليين على الشكل التالي:
غير مجد، في ملتي
واعتقادي
نوح باك، ولا ترنم
شادي.
وشبيه صوت النعي،
إذا قيس
بصوت البشير
في كل ناد.
أبكت تلكم الحمامة
أم غنت
على فرع غصنها
المياد.
بل إن التقسيمات النحوية التوازنية (التوازي) داخل الأبيات (مما سمي ترصيعا وتطريزا وتسميطا) نازعت العروض سلطته ولم تترك له أكثر من تمييز الفضاء الخاجي للنص، وهو الفضاء نفسه الذي يوفره اتساق التفعيلات في القصيدة الحديثة، فأصبحنا، كما قال العسكري، أمام وزن (توازني) في وزن (عروضي)، أي أمام وزن نثري يقوم على الأسجاع والمعادلات المقولية والنحوية والتوازنات الترصيعيية الصوتية داخل الأوزان العروضية.
وقد جاءت الموشحات كمرحلة وسط بين هذا النزوع النثري في القصيد من جهة والإيقاع اللهجي عن طريق الأزجال من جهة أخرى.
ج – تفسير: الأذن والعين
زمن امرئ القيس وزمن أبي تمام:
لنترك التنويعات الصغيرة التي ظهرت في طريق الحوار بين النموذج المكتمل والصور المخالفة، ولنقفز إلى لحظة كاشفة انجلت فيها صور المخالفة، لحظة قابلة لأن توصف بمعاناة سؤال الحداثة باعتبار وجود مشروع مخالف أو يخالف. ولنجعل أبا تمام علامة ذلك الزمن، لاستبعاد ما يعايشه من بقايا الزمن الآخر (يقال مثلا إن البحتري من تلك البقايا).
ما الذي تغير في كفاءة الملتقى بين زمن امرئ القيس وزمن أبي تمام؟
نقول: تغيرت الحساسية، تغيرت طريقة إدراك الأشياء، كان الشاعر القديم يحيا العربية كجسد لا ضرورة للتفكير فيه ما دام حاضرا، بل قد يتعذر حتى التفكير فيه لأنه هو الفكر نفسه. الشعر هو العلم وهو الشعور: (ليت شعري ليت علمي)، كانت اللغة محسوسة ككتلة متراصة، كان الإحساس بالأصوات والحركات كالإحساس بالألوان، وما أكثر التعابير التي دلت على ذلك: كان الصوت هو الوحدة الأساسية، أما العصر العباسي عصر أبي تمام فكان عصر الكلمة عصر إشكالية اللفظ والمعنى. صارت اللغة موضوعا للتأمل بعد أن كانت ملتبسة بالوجود. ولقد أدى ظهور البلاغة في هذا المجال الرؤيوي الجديد إلى صعوبة إدراك جانب من أسرار جمالية النص القديم مثل التسجيع أو توازن الأصوات خارج الكلمات. فالتجنيس عرف باعتبار الكلمة والترصيع عرف باعتبار الصيغة الصرفية. كان أبو تمام يشابك الكلمات: فتكون الكلمة الواحدة طرفا في جناس وطرفا في طباق وطرفا في استعارة في الوقت نفسه، في حين كان امرؤ القيس، يلذ بتنضيد الصوائت الخفية: الكسرة والفتحة والضمة(15). ووقع عكس القضية في المجال الدلالي: كان امرؤ القيس يرى الشيء في الآخر منفصلا عنه (التشبيه)، أما أبو تمام فكان يرى الشيء في الشيء حالا فيه (الاستعارة).
ثم مع الكلمة ظهرت حساسية الخط (جناس الخط) أو مظهر الخط على الصحيفة (التصحيف). وبدأت عملية مشاكسة التوازن على أوسع نطاق، وهذا أمر مارسه أكابر الشعراء ولم يستسغه الاتجاه البلاغي الكلاسيكي أو المحافظ كما نجد عند ابن سنان الخفاجي، وقد عرضنا لهذه القضية في كتابنا تحليل الخطاب الشعري البينية الصوتية(16). في حين وجد الجرجاني في تجربة الشعر الجديد أحسن الأمثلة لتوجهه الدلالي الذهني على حساب الأجراس والأصوات فنشأت بلاغتان متمايزتان. وعموما فقد نشأت على هامش النموذج المنسجم بلاغة منافرة متعددة الآليات، من آلياتها:
ـ النثرية والتنافر
ـ الفضاء البصري.
يضعنا هذا الحديث على عتبة القصيدة الحديثة مع روادها في المنجز لا في الشعار. حيث تسعى عناصر المخالفة المذكورة إلى التحول إلى عناصر بناء داخلة في الجوهر، أي عناصر منسقة، لا مجرد عناصر مشاكسة للوظيفة الأساسية لشعر الأذن. فبدل الإطراب عن طريق التناسب يسعى إيقاع القصيدة الحديثة إلى إنتاج المعنى، بل المعاني الممكنة للنص بمستوياته المختلفة من الجملة إلى القصيدة ككل. وينبغي ألا تنسينا الصورة الماثلة أمامنا لأشكال ومظاهر من الإيقاع، ربما فقدت بفعل الزمن وظيفتها، أن وظيفة الإيقاع في الأصل هي توليد المعاني في مناطق لا تصل إليها اللغة.وفي هذا المعنى يقول بول زمطور: “الإيقاع هو المعنى الذي لا تترجمه اللغة مترجما بوسائل أخرى”(17).
ولذلك فهو يستعمل لبلوغ هذه الغاية عدة عناصر تتجانس وتتنافر ليس التقسيم الزمني (العروض التفعيلي) غير مكون من مكوناتها. فبالإضافة إليه وبالإضافة إلى أنساق الأجراس وتفاعلاتها المختلفة:
-
هناك البياض، لا باعتباره فضاء بصريا وحسب، بل باعتباره متاهة أي فخاخا: قف، لا تقف!
-
ثم هناك الترقيم أو التنقيط الذي نلاحظ عند البعض الإصرار على إحضاره ونلاحظ عند البعض الآخر إصرارا على تغييبه. وكثيرا ما يدخل في نزاع مع البياض.
-
وقد يكون من مؤشرات الشعرية ركوب الضرورة التي قد تكون أحيانا مجرد إعلان عن هوية.
وسنحاول تلمس هذه القضايا من خلال أمثلة تطبيقية في سياقات هذا الحديث.
ج – القصيدة الحديثة: الخوف من النسقية أو عدم إدراكها:
هل يمكن أن تظل القصيدة الحديثة والنثيرة على وجه الخصوص تعرف بالسلب، أي أنها ما ليس اجترارا، وما ليس تقليدا، وما ليس انتظاما، وما ليس عشرات الصفات التي يوصف بها الخصم؟ هل ستظل هي الخرق والتمرد وانعدام الشكل والمعنى(18).. إلى آخر “النشيد الحداثي” كما أسماه نجيب العوفي(19).
من البديهي أن تجريد اسم “قصيدة نثر” أو “النثيرة” نفسه من ممارسات لغوية أدبية مختلفة لأشخاص مختلفين يدل، في حد ذاته، على وجود نسق مستخرج من مجموع هذه التحققات. فهناك إذن شكل عام لكل قصائد النثر، أو وجود مسعى ولو شكلي ملحوظ نحو هذا الشكل. وهذا لا يتنافى مع وجود حيوية إيقاعية تميز هذه النثيرة عن تلك كما تميز قصيدة عن قصيدة وشاعرا عن شاعر، فهذا أمر مسلم به حتى في القصيد القديم، إذ هذا التمييز لا علاقة له بالوزن والقافية أو باطراد التفعيلات أو عدمه، بل مرجعه إلى العلاقات الداخلية الممكنة داخل هذا الإطار المنتظم.
إن المبحوث عنه ضمنيا من طرف بعض تجارب الشعر الحديث (أي الهوية والاعتراف) هو نفسه الشيء المرفوض تصريحا أو شعاريا: هناك بحث عن شكل منتظم عن قالب أو عن فضاء، وهناك خوف من هذا الشكل المنتظم لأنه يعني الوقوع في موقع المسؤولية والمحاسبة. أخشى أن يكون الخطاب (الإبداعي) النقدي الحالي حول النثيرة، خطاب البيانات الرافضة، قد صار يتغذى في بعض البيئات العربية من لغة الحياة البرلمانية المريرة بعد أن تغذى خطاب التفعيلة الحرة النسق من لغة الثورة على الرجعية زمنا طويلا.
أخشى أن يكون الرصيد الشعري العربي (من القصيد إلى الرجز إلى الموشح إلى الزجل إلى التفعيلي الشطري إلى التفعيلي غير المقيد بشطر) يتلقى اليوم المعجم الهجائي المرير الذي تستحقه الأغلبيات البرلمانية العربية المصنوعة قصد تجميد الأوضاع. وأشخى أن يكون الشاعر المبدع قد استحلى وضع المعارضة المزمنة التي تتوهم أن لديها بديلا، إن تكن عاجزة عن وصفه، فهي مقتنعة بأنه نقيض كل الفساد المستشري في الأغلبية المستولية.
كما تلقت القصيدة العربية القديمة من يد الحداثة الأولى معجما شبيها نترك تحديد حيثياته ووصفه لشاهد عيان اقتبس من نوره ثم اكتوى بناره. يقول أحمد المعداوي، فيما يشبه نقدا ذاتيا، (مشيرا إلى التيارات الفكرية والايديولوجية التي كانت تمثلها مجلات الآداب (القومية) والشعر (الليبرالية) والثقافة الوطنية (الاشتراكية)):
“وبالرغم من اختلاف هذه التيارات في الايديولوجيا وفي الرؤية الفنية فقد وقفت صفا واحدا للدفاع عن حركة الشعر الحديث ضد خصومها من أنصار الشعر العمودي. ما يهمنا في هذه المعركة هو أنها لم تستخدم أسلحة النقد للدفاع عن شعرية الشعر بل استخدمت أسلحة من خارج الميدان كالايديولوجيا (القومية والوحدة) والصراع الطبقي والعقلانية ضد التخلف والجمود والغيبية وعبادة الماضي. وإذن فإن النصر الذي خرجت به هذه الحركة من تلك المعركة لم يكن نصرا شعريا محضا، ولكننا معشر أنصار هذه الحركة والمنبهرين بها إلى حدود التماهي والاستلاب قد اعتبرنا ذلك النصر نصرا شعريا خالصا، إلى درجة أن علاقتنا بها قد ألغت كل علاقة بما عداها من الحركات الشعرية السابقة عليها”(20).
النثيرة(21): تجربة أم بديل؟
هل النثيرة تجربة أم بديل حضاري؟
لا يشك روادها في أنها بديل حضاري لكل صور الجمود والتقليد.. الخ. غير أن هذا الرأي صار يثير كثيرا من ردود الفعل العنيفة المفعمة بالسخرية أحيانا، كما يشم من عبارة الناقد نجيب العوفي حين قال إنه لا يعترض على تجربة قصيدة النثر، ولا وجه لتجاهلها فهي موجودة منذ العصر الجاهلي والإسلامي على شرط ألا تأخذها العزة بنفسها (ثم رجع وصرح): بالإثم) فتدعي أنها بديل لقصيدة الشعر(22). وهذا الرأي يصادي رأي الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي المعبر عنه حديثا؛ فجوابا عن سؤال في الموضوع قال: “أنا أقبلها عندما تكون تجربة، وأرفضها تماما إذا تصور البعض أنها أفضل الأشكال أو أكثرها حداثة، لأنها في هذه الحالة تصبح وباء كاسحا، إنها شكل يعتمد على لغة فقيرة من ناحية المعجم بسيطة ساذجة من ناحية التركيب، نثرية من ناحية الإيقاع”(23).
يمكن اعتبار المرحلة التي يمر بها إيقاع القصيدة العربية، بعد تحول الحس الشعري عن البيت المنتظم، بأنها مرحلة انتقالية بمعنى الكلمة. فلا أحد يستطيع، أم يملك مشروعية، وضع نقطة نهاية للتحولات الممكنة.
هل نوجد الآن عند المطلوب أو دونه أو تجاوزناه إلى تجريب غير مجد ينبغي التراجع عنه؟
غامرت نازك الملائكة مع جماعة من الرواد ثم توقفت نظريا تحذر من مغبة التمادي في تكسير أنساق الإيقاع العربي، مطالبة بالمحافظة، في حد أدنى، على الشطر(24). ثم جاء من يقول إن الحد الأدنى الممكن ليس الشطر بل التفعيلة والجو العلم للوزن(25). ثم جاءت قصيدة النثر تتخلى عن التفعيلة نفسها باعتبارها امتدادا للعروض القديم.
ليس من حق أحد أن يرسم حدودا، ولكن من حق كل واحد أن يبدي مخاوفه وأن يتخيل السيناريوهات الممكنة. حتى التراجعات والمحاسبات العنيفة مطلوبة. فحين يقول نزار قباني:
“الشعر الحديث واقع في أزمة ثقة مع الناس فقد رمى نفسه من الطابق التاسع والتسعين للقصيدة القديمة ولا يزال عالقا بين السماء السابعة والأرض. إننا نطلب من الشاعر الحديث أن يكون طبيعيا لأن النتاج الذي نقرأه اليوم هو ضد الطبيعة وضد نفسه وضد النظام الشعري”(26). فإننا نحتاج إلى قامة مثل قامته لتقول العكس، وتكون حداثية أي قادرة على الحضور في اللحظة التاريخية وإلا بقيت تجريبا، للمستقبل أن يقول فيه كلمته. وحين يطلب شاعر ومبدع بحجم جبرا إبراهيم جبرا من الشعر أن يبقى في ساحة القارئ ليبقى القارئ في ساحته(27)، وحين لا يجد ناقد مثل إحسان عباس في القصيدة الحديثة شحنة تشده إليها(28)، وحين وحين.. لا يحرك الشعر أحدا فإن الأمر يتطلب إعادة النظر. إن هذا الوضع هو الذي سمح لأحمد المعداوي بأن يستخلص بأن القصيدة الحديثة قد فشلت فشلا ذريعا وذلك بعد أن تخلى عنها أكابر روادها مثل الماغوط الذي توجه إلى المسرح، وجبرا إبراهيم جبرا الذي توجه إلى الرواية. كما يستخلص أن العودة إلى قصيدة النثر ما هي إلا أحد خيارين لإنقاذها. والخيار الآخر هو المراهنة على الفضاء البصري: “إن الاختيارين معا لم يتبلورا بعد بالقدر الكافي، ومن ثم فإن اعتبارهما مرحلة ثابتة من مراحل تطور البنية الإيقاعية الجديدة سابق لأوانه”(29).
“والثابت (في نظره) الذي لا جدال فيه، هو أن البنية الإيقاعية الجديدة لم تعد تحمل أي جديد. وأن حركة الشعر الحديث التي اعتمدت في ثورتها الشاملة على الثورة في مجال الإيقاع قد وصلت إلى الأفق المسدود”.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه ليس من باب الوهم البحث عن الشعر في الإيقاع عبر أجيال، ولكن العلة تكمن في النظر إلى الإيقاع نظرة تبسيطية(30)، تفصل مركزه الصوتي عن محيطه الدلالي والتركيبي، بل والتداولي.
الخريطة المتوقعة للقصيدة الحديثة:
تمتد القصيدة الحديثة اليوم بين قطبين متباعدين:
1 – قطب الإدماج أو الاندماج بين النسق العروضي والنسق الحر بحيث يختفي النسق العروضي في النسق الحر. دون أن يتكلف الشاعر أي إجراءات اصطناعية لاقتناصه. وقد لا يهتدي إليه القارئ إلا بالإجراءات التقطيعية. ونحن نستبعد هنا القصائد الخطابية التي تسير حسب النسق التفعيلي للوافر (يمثل المائل: / نهاية الشطر في توزيع الشاعر لأشطر القصيدة):
وهذا الديك / من ذهب وشـــذر/
يطير / على البناية / وهو يمضي
إلى برج الكنيسة،/ أي نجـــــم /
أتى بالديك؟/ أي ندى مصفــــى/
ترقرق في بهاء الريش؟/ طلقــــــا/
يطير الديك/ أبعد من ســـــواري/
بنايتنا وأبعـــــــــد مـــــــــــــن
نحـــــــــــــــــــــــــــــــاس /
علـــــــــى بــــــــــــــــــــــرج
الكنيســـــــة.. أي ديــــــــــــك
2 – تغييب العروض (باعتباره بيتا وشطرا وتفعيلة) تغيبا مطلقا أو شبه مطلق. إن عبارات بعض الطلائعيين المتحدثة عن نفس العروض والمعنى.. الخ والداعية إلى المجانية (كذا)! تجعلنا نستحضر التجارب التي تجري لصالح الطب وغيره خارج مجال الجاذبية الأرضية. ولكن هيهات!
وتصوري أن ما ينجز في هذا القطب لا يعدو أحد أمرين. إما أن يكون الخروج من إسار العروض دخولا في إسار السجع والازدواج المخزن من تلاوة القرآن والنثر العربي، فيعوض الوزن بالموازنات الصوتية التجنيسية والترصيعية، وإما أن يسقط في نثرية شعرية أي في نثر شعري تصويري جميل ولكنه ليس شعرا، بسبب الحدس وأفق توقع المتلقي الحديث، أما في غير هذا فأجدني حائرا وحسب. أرقب بحسن نية ردود فعل القراء وبعدها أبدأ في عملية الوصف.
فلنعد الآن إلى ما بين القطبين وهو المجال الخصب للتجربة الشعرية الحديثة. بين هذين القطبين الوهميين الداخلين في نظري في مجال التجريب أو التخوم الافتراضية توجد القصيدة الحديثة أو الكلاسيكية المستقبلة، فالأول وإن كان محبذا في نظري وحسب ذوقي الخاص وتكويني فيكاد يكون بعيد المنال صعبا وهو أدخل في ما سماه القدماء الانسجام، والثاني يبدو متجاهلا لحساسية العصر من حيث يعتقد أنه استجابة لها.
في موقع أقرب من القطب الأول أي استحضار الأنساق الوزنية ومحاورتها بالقرب والبعد ينتج شعر طائفة كبيرة من الشعراء الكبار الذين لهم صيت في الساحة الشعرية العربية. وبالقرب من القطب الآخر تومض أنوار جذابة ساحرة من حين لآخر تؤكد وجود شيء ممكن، ولكن الانكسارات والغوغائية تبعث الشكوك.
وينبغي الانتباه هنا إلى أننا لا نجحد حق البيت الشعري الخليلي في الوجود، فوجوده واقعي ومستمر إلى أمد لا نعلمه من خلال صيغتين:
1 – استمرار للجمالية القديمة نفسها إبداعا أو نظما، فمن الأكيد أن هناك أسماء قليلة ما زالت قادرة على إعادة المستمع إلى أجواء قصيدة المتنبي وأبي نواس وبشار. قادرة على انتزاع التصفيقات لاعتبارات نصية ومقامية حضارية تتعلق بشروط التلقي ومن الأكيد أن هناك أناسا ما يزالون يتشبثون بأصالة وهمية أو يتحركون في أجواء تكسبية تفرض العودة إلى النظم المعتاد في مجالات التكسب والمناسبات.
2 – الاندماج في الجمالية الجديدة حيث يصبح النسق الوزني القديم عنصرا توظفه القصيدة الحديثة في مجالات وجدانية أو فكرية (سخرية) مسعفة كما نجد عند مريد البرغوثي ومنصف المزغني بوجه خاص.
نموذجان لاشتغال الإيقاع في القصيدة الحديثة:
1 – التجانس والتعارض:
(مقطع من قصيدة صحراء للشاعر أولاد أحمد):
درس الباحث عبد العزيز بن عرفة قصيد صحراء تحت العنوان التالي: قراءة متعددة المداخل..الخ(32).
وقد لاحظت أن الدراسة لم تلمس بتاتا بناء القصيدة (ولا يمكن أن يكون إلا بلاغيا)، وضمنه الإيقاع بمعناه الواسع. ومع ذلك تنتهي إلى مطالبة الشاعر بالتزام الهوية الشعرية.
ونظرا لطول القصيدة نسبيا فقد ارتأيت أن أحلل المقطع الأول منها من جانب الإيقاع وتفاعلاته عل ذلك ينبه إلى أن القصيدة ليست بسيطة كما قد يتبادر إلى ذهن من يقرأ هذا التحليل من غير ذوي الاختصاص.
(أ -) وطن ككيس التمر
تفتحه
فيفجؤك التراب
وتحبه،
(ب -) وتغض طرفك عن يد بترت..
وعن طلب يجاب.. ولا يجاب!
وتسير وحدك تقرأ الصحراء: عاشقة
وقلب الماء من حجر. وزاهدة
كزاوية تزار جبالها تجري وأنجمها
السراب
(ج -) زبد
رماد
وحشة
كفن
غياب
عرب.. وفضلنا الكتاب!
يتكون هذا المقطع كما بينا بالحروف (أ ب ج) من ثلاث وحدات إيقاعية. وقبل التطرق إلى كل وحدة على حدة نذكر: 1) بأن القصيدة تسير على تفعيلة المتقارب: متفاعلن، وما يلحقها من تغييرات، 2) وأن التدوير يلعب دورا أساسيا في إيقاعها.
أ – تنطلق الوحدة الأولى من التجانس الصوتي والتعارض الدلالي بين التمر والتراب. والتمر هنا انزياح عن المبتذل (أي التبر) دون إقصائه. ولذلك فإن كلمة تراب تتجاوب مع حاضر عيانا ومستحضر ذهنا. ولعل البيت يناص بالمخالفة قول الشاعر:
والتبر كالترب ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الخشب
وإذا لم ينتبه المرء إلى هذه اللعبة الانزياحية فأحرى به أن يفترض أن هناك خطأ في النسخ أو الطباعة. ولو كان النص لشاعر قديم لما ترددت في افتراض هذا العطب.
ويقوي تجانس الكلمتين وقوعهما في موقع واحد قوي هو موقع القافية لشطرين متوازنين:
وطن ككيس التمر
فيفجؤك التراب
وتعانقعهما القرينتان:
تفحته
وتحبه
ومن الملموس بالقراءة قبل التقطيع أن هذه القرائن (الأسطر) المتوازنة تعانقا تشاكس الموقف العروضي حينا (بتوزيعها التفعيلة بين السطر الأول والثاني) وتصالحه حينا (بالوقوف عندها في السطر الثالث). وبذلك تقف بين النزوعين، وتسمح للقارئ المتشبع بالتراث بأن يقرأها كدورة من موشح:
وطن ككيـ/ـس التمر تفــ/
\\\0\\0 \0\0\\0
ــــتحه فيفـ/ـجؤك التراب
\\\0\\0 \\\0\\0
وتحـبـــه
\\\0\\0
إلا أن هذه الكتابة تضيع الكثير من المعاني التي يتوسل إليها الشاعر بالبياض والفاصلة. فالوصل مثلا في “وتحبه” موهم، إذ يتبادر إلى الذهن أن هناك إضافة قياسا على السابق. مثلا:
تفتحه
فيفجؤك التراب
وتحبه
فيخدعك السراب
ومع الوصول إلى الفاصلة تكتشف أن هناك محذوفا تقديره (أو أحد تقديراته): “ومع ذلك” أو “ومع ذلك تحبه”.
ولو استفتينا البديعيين القدماء في البيت المفترض كما قدمناه لقالوا إنه من حسن الانسجام، أي أن لفظه على معناه كأنه نثر.
وستتجاوب الأسطر الطويلة من هذه الوحدة كميا مع أسطر الوحدة الثانية(ب)، في حين تتجاوب الأسطر القصيرة منها مع أسطر الوحدة الثالثة (ج).
ب – أول ما ينبغي تسجيله هنا أن كلمة “بترت” في قافية السطر الأول من الوحدة الثانية هي صدى للوحدة السابقة، فهي تعيد أجراس “التمر” و”التراب”، بل هي قاسم مشترك بينهما.
بخلاف الوحدة الأولى، تقوم الوحدة الثانية على تدوير معقد، فهي مكونة من جملتين تنتهيان بجملة قوية: يجاب والسراب. وداخل الجملة الثانية ينتهي سطران بترصيع مسجع: عاشقة وزاهدة (على وزن فاعلة معا).
والحذف هو التقنية الأساسية في الجملة الثانية حيث تلعب أدوات الترقيم دورا محفزا، إن لم نقل تضليليا. فماذا لو كتبت الجملة الثانية هكذا:
وتسر وحدك تقرأ الصحراء
عاشقة
وقلب الماء من حجر
وزاهدة
كزاوية تزار
جبالها تجري
وأنجمها السراب
إن هذه الكتابة التي تبدو مبرزة للجانب التوازني في النص تؤدي إلى خللين: يتجلى الخلل الأول في حسم الدلالة، وتأويلها في اتجاه واحد. وفي ذلك إفقار لها، ويعود الخلل الثاني إلى تبديد الطاقة الوجدانية والفيزيولوجية التي تراكمها الوحدة الثانية استعدادا للحظة الانطلاق والتفتت في الوحدة الثالثة التي تندفع فيها الألفاظ منفصلة متعاقبة كزخة من الرصاص لا تتوقف إلا بإصابة الهدف: العرب.
وبعد “العرب” يأتي الفراغ والتعجب(!) من القول: فضلنا الكتاب.
إن كلمة “عرب” هي إحدى الكلمات التي تتوارد مع الوهم والخراب والموت: “سراب، زبد، رماد، وحشة، كفن، غياب، عرب”. معجم واحد وإيقاع واحد.
ثلاث قواف متوالية: غياب، عرب، كتاب، هي مكونات المحطة الإنشادية للوحدات الثلاث المكون للمقطع الأول الذي يكون في حد ذاته قصيدة قائمة الذات.
أ – توازن خادع بين الوهم والحقيقة. والحب رغم الخيبة.
ب – تعقد وانحباس
ج – انفراط العقد.
وستسير القصيدة في دورات على هذا المنوال مع بعض التنويعات في الأخير.
والحقيقة أني أجد القصيدة كلها في هذا المقطع، ولا أرغب بعده في مزيد، وهذا أمر لا يشغل الشاعر بالطبع.
2 – الترقيم والفضاء في توليد الدلالة:
(جملة من قصيدة احتفاء بهم لأدونيس(33) ):
اعتمد أدونيس في قصيدة احتفاء بهم على تقنية التنسيق والخلخلة في تركيبات وأنساق مختلفة يكون بعضها انزياحا عن بعض. مستغلا إمكانيات الترقيم.
من المريح للدارس استعمال الشاعر لأدوات الترقيم: خاصة الفواصل الدالة على تمفصل الجمل، والنقط الدال على نهايتها فضلا عن نقطتي التفسير والعارضة. إنها مؤشرات بريئة ومضللة. وما على الدارس إلا أن يتآمر معها كيدا بكيد. بناء عليه نقسم القصيدة إلى جمل بحسب ما تحويه من نقط. وننظر في الجملة الرابعة:
أتقدم نحوهم
بينهم امرأة أحببتها، ماتت
بينهم طفل يشبهني.
إن اعتماد الشاعر على النقط يعني أنه حيث لا يوجد نقط يوجد استرسال. حتى البياض لا ينوب عن التنقيط ولا يعوضه. هل نحوهم لصيقة بما قبلها أم بما بعدها؟ هل المعنى هو: “أتقدم نحوهم” فحسب، آتيا من بعيد، أم “أتقدم بينهم” أي مندمجا فيهم. هل “امرأة أحببتها” مبتدأ لشبه الجملة المقدم: توجد بينهم امرأة أحببتها، أي أحببت امرأة توجد بينهم. إذا عدنا إلى هذا المستوى لا يبقى هناك شعر. إن “ماتت” تنسلخ مما قبلها بالفاصلة لا لتجميع النفس وإتاحة هزة إنشادية قوية وحسب ولكنها ستندفع بفعل الإنشاد نفسه وبفعل سطوة الحداثة على البياض نحو ما بعدها: “ماتت بينهم”.
د – التعويض الدلالي:
1 – نظر:
يلتقي بعض الدارسين صراحة أو ضمنا حول القول بالتعويض الدلالي لما ضاع من المقوم الإيقاعي. والذي يبدو لحد الآن هو أن التعويض الكمي واقعة لا غبار عليها، فمن الشعراء من وصف بسعة الخيال والقدرة على اصطياد الشواردوالجمع بين أعناق المتنافرات، ومنهم من وصف شعره بالحلاوة والطلاوة والسلاسة والعذوبة إلى غير ذلك من الأوصاف التي تنصرف في الغالب إلى البنية الإيقاعية ومنهم من قرى الأمرين وجمع بين الحسنيين. كبعض شعر المتنبي وأبي تمام. فإن كان هذا هو المقصود فلا جديد ولا منازعة، أما إذا قصد التعويض النوعي فإن لم يكن نثرا شعريا كنثر جبران والريحاني ومن على شاكلتهم فسيتعلق الأمر بمولود نسميه حين يستصرخ.
أما الواقع الحالي فيتضمن ارتياب بعض الشعراء الحدثيين أنفسهم في إمكانية قيام بديل دلالي للإيقاع. وقد استوقفتني هنا عبارة للمرحوم عبد الله راجع في تقديمه لديوان الشاعر محمد بوجبيري جاء فيها:
“كما هو الشأن عند أسماء أخرى لها حضورها في الساحة الشعرية منذ بداية الثمانينات في المغرب، هو هذا الخيال وقد نضج، أصبح قادرا على أن يخلق المغايرة.. (بقطع النظر عما يعتره أحيانا من قصور النظر) “هل سيصبح الخيال الشعري مكونا أساسيا في تحديد هوية الشعر بعد أن تم إقصاء العروض لدى قسم كبير من هؤلاء الشبان؟”(34).
من الأكيد أن عبد الله راجع يعرف أن الخيال مكون أساسي في بناء الشعر، وقد خصه ببحث خاص في كتابه القصيدة المغربية المعاصرة، ولذلك فسؤاله ينصرف إلى المكون النوعي الذي يعطي الهوية لأول وهلة وفي جميع النصوص التي تنتمي إلى الجنس الأدبي المعني. وهذا لن يكون غير الإيقاع في اي تجل كان.
ومحاولة الاحتجاج لإمكانية استغناء الشعر عن الإيقاع بالتحول الذي عرفه تعريف الشعر في الثقافة العربية من الوزن والقافية إلى التخييل(35) لا تستقيم من عدة جهات، منها:
-
اختزال الإيقاع في الوزن والقافية، وتجاهل تجلياته الأخرى الكائنة والممكنة. وهذا مخالف لمفهومنا للإيقاع. وقد عرفت اللغة العربية أشكالا من الإيقاع شاكست الوزن والقافية.
-
2لاستشهاد بعبد القاهر الجرجاني مجازفة لأن الرجل حاول استثمار نظرية المحاكاة لصالح المفهوم الأشعري الذي يعتبر الكلام معاني نفسية ويقصي العناصر الصوتية. ومن المعروف زيادة على ذلك أن الأشاعرة يعتبرون جميع صور التوازن الصوتي خارج الإعجاز لإمكان تعلمها في نظرهم. ثم إن عبد القاهر تراجع عن شعرية الغرابة لصالح بلاغة تداولية مقامية نحوية في كتابه دلائل الإعجاز. أي أنه قيد العنصر الخيالي بالعنصر النحوي في حين يقيده الشعر بالإطار الإيقاعي الموسيقي.
2 – أمثلة تطبيقية:
كأني ببعض الباحثين سلم بمقولة البديل على الإطلاق، أي حولها من نسبيتها وجدليتها القائمة على المد والجزر فانتقل إلى مستوى التطبيق للبرهنة عليها. انظر مثلا كيف قرأ الناقد فخري صالح في مقال منشور حديثا(36) تحت عنوان: “القصيدة العربية الجديدة: الإطار النظري والنماذج”: كلام كمال أبو ديب وصلاح فضل: “إن تركيز كل من كمال أبو ديب وصلاح فضل على قدرة الصور الشعرية على تعويض غياب الإيقاع الوزني والقافية كذلك يجعل من الصورة المكون الرئيسي في شعرية قصيدة النثر”(37)، وعندما لاحظ حضور الصورة في فنون أدبية لا تعتبر شعرا فتح المجال لعنصر الفضاء البصري ليكون علامة مميزة. وقد أتاح لي هذا المقال فرصة مراجعة فرضية التعويض(38).
يقول الباحث مقدما تحليله: “وسوف نتبين في قراءتنا لبعض النماذج التي أنتجها بعض شعراء السبعينات والعقدين اللاحقين كيف تؤسس قصيدة النثر شعريتها”.
نموذج أول: (مقطع من قصيدة لـعباس بيضون)
الضوء الذي تكرر آلاف المرات
كغرزة في ثوب
والذي ينير داخل الأحذية والممرات
كما ينير عيون النساء
الضوء الذي ينكسر مع حركة اليد، ويلف
مع النول، ويعوم
على المجلى
والذي يدور في الصيوان، ويرتفع
على عمود الملابس، وينتقل
على درجات الرفوف
كأنه يرفو زوايا البيت
باذلا للأواني جلستها المطبخية
للإطار الفضي سهوه المعدني
للمسوح المعلقة عظام قصة
إنه يدخل من ثقوب القبعة القديمة
بدون أن يزيح الظل الرمادي
ويدخل إلى المخدع
في هيئة النوم
يقول الباحث:
“إن الصورة كما لاحظنا هي المكون الرئيسي لشعرية القصيدة”(39)، وكل ما يضيفه الشاعر بعد الصورة فلا يعدو “توزيع الأسطر على بياض الصفحة كتقنية إضافية تعمق دلالة القصيدة، تجعل الشاعر يتواصل مع القصيدة..(كذا)”.
والواقع أن مثل هذا الوصف التصويري يمكن أن نجده في كثير من المشاهد القصصية، وأول ما حضرني من ذلك بشكل عفوي المشهد الأول من رواية مالرو: الشرط الإنساني.
أعتقد أن جنسية هذا النص:
“الضوء الذي تكرر آلاف المراتكغرزة في ثوبو… الذي ينير داخل الأحذية والممراتكما … ينير عيون النساءالضوء الذي ينكسر مع حركة اليـــــــــد،ويلفو…… [يلف] مع النول……،ويعومو…… [يعوم] على المجلىو…… الذي يدور في الصيوان……،ويرتفعو…… [يرتفع] على عمود الملابس، وينتقلو…… [ينتقل] على درجات الرفوفكأنــــــــــــــــــــــــــه يرفــــــــــــــــــوزوايا البيتباذلا للآنــــــــــيــــــــــة جلستها المطبخية… للإطار الفضي سهوه المعدني… للمسوح المعلقة عظام قصةإنه … يدخل من ثقوب القبعة القديمةبدون أن يزيح الظل الرماديو…… يدخل إلى المخدعفي هيئة النوم” |
تنتمي إلى نظمه بالمفهومين: الإيقاعي والنحوي. فهناك تواز نحوي ذو مردودية توازنية يستطيع المنشد أن يبرز منها القدر الذي يريد، ويخفي مع المؤلف القدر الذي يريد إخفاءه. وهذه الجنسية لا تعني كمال المواطنة، أي لا تعفي من وجود العناصر الأخرى، فلا بد معها من العمل الصالح. ومنه الصور التي استخرجها الباحث. وربما وجد فيما سنبرزه فضائيا من أنساق إيقاعية ما يدعم الصورة ويبرزها. أما نسبة هذا النسق النظمي فتلتقي مع الرغبة في الانتماء إلى النثر، فهو نسق معلوم في النثر وإن بذل الشاعر قصارى جهده لطمس معالمه نثرية. وذلك ما تبرزه الكتابة الفضائية للمقطع حيث تسجل الفراغات والتكرار:
يقوم إيقاع هذا النص على نزاع بين مبدأ الرجوع الذي هو مبدأ نظمي (أي أنه في هذا السياق عنصر جوهري أو منسق)، ومبدأ الاستمرار الذي يعلنه الشاعر بالفاصلة ويقويه بالوصل ثم إن أحد الفروق بين الشعر والنثر هو: إن الشعر يخرج عن النسق استجابة لامتداد المعنى أو التجربة، أو لمجرد الرغبة في كسر الرتابة، ثم يدخل الجزء الخارج عن النسق الأول في توازن مع عناصر جديدة فينشئ من ذلك نسقا جديدا. في حين أن من أشهر ميكانيزمات السجع الانطلاق من ممهد دلالي لوضع المعنى على السكة ثم إطلاق مجموعة من القرائن المتوازنة التي تتوقف بعد حين للشروع في فكرة أخرى من خلال ممهد جديد. لا أحد من الشعراء سيقبل وصمة السجع، ولكن خطر الوقوع فيه ماثل.
يكبحه بالبياض، وهو عنصر مخالفة وظيفته التنشيط والتحفيز، ومقارعة الرتابة.
لقد احتفظنا للنص بتوزيعه الفضائي الذي اعتمده الشاعر مكتفين بإبراز العناصر المتوازية بوضع بعضها بإزاء بعض. وكان بإمكاننا التصرف لإبراز التوازي بشكل أجلى ولكنا تلافينا ذلك درءا لكل منازعة.
تعليق: محاذير الوقوع في السجع
إن الكثير من الشعراء الشباب غير الواعين بخصوصيات المدخرات التراثية لا يدركون في الغالب الحبل المشدود (بين العروض والسجع)، الذي يسير عليه الفحول بمهارة تجعلهم لا يزيلون نقطة التوتر، فيقعون أي المبتدؤون بسهولة -انقيادا مع بحثهم عن شكل من التوازن- في إسار السجع.
فالدارس الواعي بتقنيات بناء الأسجاع يصطدم عندهم من حين لآخر بالأنساق الأساسية المعروفة في السجع حيث يتم التنويع انطلاقا من ممهد يتقدم القرائن في الغالب، وقد يتأخر عنها، ويعتمد في تنسيق الأجزاء وتوازنها على الحذف والتعويض بالمكافئ الدلالي، (الحذف في المواقع الثلاثة):
الحذف 1) في الأول أو 2) في الأخير أو 3) في الوسط.
نموذج ثان. (من شعر سركون بولص)
أنا في النهار رجل عادي
يؤدي واجباته العادية دون أن يشتكي
كأي خروف في القطيع لكنني في الليل
نسر يعتلي الهضبة
وفريستي ترتاح تحت مخالبي
يقول الباحث:
“يصنع سركون بولص من الكلام التقريري، من الوصف البارد لحياة رجل يشبه نفسه بأنه خروف في القطيع، قصيدة. لكن القصيدة لا تكتمل إلا في المفارقة، إن الوصف هنا يوظف لغايات شعرية حيث يولد التناقض بين الحالتين الموصوفتين العادي عنصر المفارقة الذي تقوم عليه شعرية النص ونحن نلاحظ في كثير من نماذج قصيدة النثر أن شعريتها تستند بصورة أساسية إلى المفارقة إلى إدراكنا ما يجهله المتكلم، في قصيدة سركون بولص “تحولات الرجل العادي”(40).
ونحن نرى، خلافا لذلك، أن الهوية الشعرية للنص مضمونة بالعناصر التالية:
1 ) هيمنة تفعلة المتقارب (فعولن/فعول)، مع تنويع حسب السياق الدلالي بتفعلة المتدارك (فاعلن/فعل). انظر السطر الأول مثلا:
أنا فيــ النهار رجل عادي
//0/0 //0/ ///0 /0//0
فعولن فعول فعلن فاعلن
قد يتعثر المنشد في البداية. ولكنه ينتبه في الحين إلى غرض التنويع الإيقاعي بين المسند والمسند إليه.
2 ) هيمنة الكسرة قصيرة وممدودة في مواقع قوية بالبياض أو الدلالة تعطي المقطع كل ما تعطيه القافية مع تنويع وحرية: عادي، يؤدي، يشتكي، كأي، لكنني، الليل، يعتلي، فريستي، مخالبي.
لن نعمد إلى التبسيط، فنقول إن المقطع يصور الانكسار، ولكننا نكتفي بالقول بأنه يقوي الشعور الذي يخلقه المقطع في اتجاه واحد.
3 ) لعب الرجوع أو التضمين دورا دلاليا فزيادة على ارتهان الألفاظ بين المتقدم والمتأخر… (رجل عادي/رجل يودي دون أن يشتكي/ دون أن يشتكي كأي خروف…) فإن بعض التضمينات يمكن مع تعمد وقف قوي أن يخلق معنى مجازيا كالتوقف عند: لكنني في الليل (أي واقع في الظلام).
قبل الانتقال إلى: “نسر”
4 ) خلق تجانسات قوية بين طرفين أو أكثر مثل عادي + يؤدي + العادية
مع ملاحظة التجاوز بين عادي ويؤدي. والقرب الصوتي بين الهمزة والعين.
فيمكن اعتبار كلمة عادي هي الكلمة المولدة للإيقاع في القصيدة باعتبار امتدادها فيما بعدها تجنيسا وقافية كما تقدم.
وهناك تجانس بين النسر والفريسة وهو تجانس يسعفه السياق في أن يأخذ بعدا رمزيا يستوي النسر الذي كان في النهار خروفا والفريسة التي يفترسها.
والخاء لندرتها في النص تحس بقوة في الخروف والمخالب، فالمخالب هي الأخرى مخالب خروف. وهنا ينفتح باب السخرية على مصراعيه. فالنص إذن مفارقة ساخرة جسدها إيقاع النص بشكل فاضح.
هذا النص في نظري كثيف صوتيا، بل يقتله تجاهل بنائه الإيقاعي.
هـ – البحث عن حركة النفس في القصيدة
إن البحث عن حركة النفس في سلاسل تركيبية ودلالية تقوم على تشابك الألفاظ والدلالات في سلاسل يلعب فيها التضمين الداخلي والخارجي دورا أساسيا ينطوي على تصور ميكانيكي تبسيطي لا يخلو من سذاجة. وقد أدى فعلا إلى جر كثير من الشعراء إلى تجريب قصيدة السلسلة الغثة في كثير من الأحيان.
من الأكيد أن التضمين صار قيمة إيقاعية، ولكن ذلك ليس قيمة ذاتية له، في انفصال عن غيره، بل هو صادر عن كونه ثورة على تألي القصيدة بسبب إفراط التوازن والاتساق بين المستويات. ومن الأكيد أن هيمنة التنافر بين هذه المستويات سيؤدي إلى نكوص وعودة إلى الأنساق. بل إن التقنيتين قد تستغلان في نص واحد.
يمكن ملاحظة التصور الميكانيكي عند عبد الله راجع حيث يقول: “وفي وسعنا أن نشير إلى هذه السكونية التي تفرضها الوقفة الثلاثية على البيت الشعري بالتركيز على بدايات الأبيات التي تنتهي بهذه الوقفة”(41).
ويعلق على نص لمحمد بنيس:
“إن قارئ نموذج محمد بنيس لن يجد صعوبة كبيرة في الإحساس بطابع التدفقية في هذا النموذج، هناك استرسال نظمي ودلالي وإيقاعي يتقدم مبتلعا كل الوقفات التي يمكن أن يلجأ إليها الصوت مضطرا”(42).
لا شك أنه كلما اتسعت الاختيارات أمام الشاعر كلما سهل عليه التعبير عن انفعاله بيسر وطبيعية أي بعيدا عن الضرورات، ولكن اعتماد الشعر طريقة للتعبير هو ركوب للضرورة. والإحساس أو المعنى الشعري لا يمكن أنيعبر عنه بغير الشعر، وسيكون البحث عن شكل أهون من الشعر خروجا منه. والشاعر هو من يحس بأن الطريق الوحيد لمعناه هو ذلك الطريق الصعب. وقديما شبه ابن جني الشاعر بمجري الفرس بلا سرج ولا لجام، ومقتحم ساحة الوغى حاسرا، وهو يعرف ما ينتظره من مخاطر، ويعلم أن طريق النجاة متاح للجميع. ولكنه يعلم أيضا أن “حب السلامة يثني صاحبه عن المعالي”.
وربما وقع في وهم البعض، متأثرا بالتنظير الدائر حول العفوية والاعتباطية والاستبطان والإفراغ والشحن حسب الأحوال النفسية، وثقة في الموهبة الشعرية أيضا، أن يرفع الرقابة عن كلامه حال ثقته بحضور ربة الشعر أو شيطانه فيقرن اللفظ باللفظ لغير مناسبة ظاهرة أو قابلة للظهور. وقد كنت لسنوات أتهم نفسي وأتقي الخوض في هذا حتى ارتفعت أصوات أكابر الشعراء بالنكير.
وبهذا فإني أخشى ألا تكون “القوالب” الموسيقية وحدها ما يعرقل تدفقية التجربة الوجدانية بل يعرقلها أيضا المعنى. وفي هذه الحالة فلن يتعلق الأمر بفن القول بل سيتعلق بالسيكولوجيا(43)، وستتعذر المتابعة النقدية للموضوع.
إن المعنى الشعري ليس هو الإحساس أو التجربة أو الانفعال بل هو الصياغة اللغوية النهائية التي تروض الانفعال للمعنى والمعنى للإيقاع فينتج عن هذه العملية معنى، هو المعنى الشعري. سيكون كثير الثقوب لما يواجه من الإكراهات وهذا قدره. من البديهي أن الحالة الوجدانية أو التجربة قبل أن تتحول إلى شعر تندفع مثل الصوت داخل كيان الشاعر ومن الطبيعي أن الأصداء التي ترددها ستكون بحجم المجال الذي ستسري فيه. وهذا المجال جغرافيا وتاريخ…: فيه كل المحصلات الثقافية وفيه كل تضاريس المكان وتجاعيد الزمن.
سيكون من المفيد هنا إيراد نص يعالج المسألة نفسها في لغة أخرى كانت نموذجا يحتذى عندنا. يقول جان: “ولا شك أن الشاعر الناثر، عندما تحرر من قيود النظم صار نتيجة ذلك في وضع مريح يسمح له بالتصرف في مقومات المستوى الثاني (أي المستوى الدلالي)، وليس من السهل خاصة في الفرنسية، أن نعامل اللغة حسب ما نريد، مع الإخلاص لمقتضيات الوزن والقافية،… ويظهر لنا مع ذلك أن أكابر شعرائنا قد عرفوا، في أغلب الأحيان كيف يحفظون تناغم قوة الشعر المزدوجة. ولن نخسر شيئا ذا بال في دراستنا للمستوى الدلالي عند أولئك الذين تقبلوا قسوة عبودية النظم، حتى لا يضحوا بشيء من إمكانيات الأداة المتاحة لهم”(44).
إن في قوله: “تقبلوا قسوة عبودية النظم…” تعريضا، بل سخرية معنتة، لأنها تنطوي على قياس مضمر. وبناء الحجة في ذلك:
-
تقولون: إن النظم عبودية
-
والواقع يقول: ما أنتج في ظل عبودية النظم أحسن مما أنتج خارجها
-
النتيجة: عبودية النظم أحسن من حرية النثر
فإذا كان ما يدعي من عبودية النظم يؤدي إلى مثل أزهار الشر، فأنعم بها من عبودية وأكرم●
مجلة الجابري – العدد الثامن عشر
الهوامش:
1 – للمقارنة: انظر مدخل بنية اللغة الشعرية. لجان كوهن، ص10-12. في محاولة لتحديد مجال المفهوم الحالي للشعر كظاهرة وصفة، انتهى جان كوهن إلى أن الشعر باعتباره عملا لغويا قابلا للتحليل في مستويين: صوتي ودلالي. ومن ثم فإن الشعر قابل للإنتاج نظريا على أي من المستويين أو باجتماعهما. أما من حيث الواقع والممارسة فقد ظهرت أعمال “ذات اعتبار جمالي” في إطار ما عرف بقصيدة النثر. أما المقابل النظري الذي يمكن أن ندعوه قصيدة صوتية فلم ينتج عملا جيدا يمكن أن يعتد به. ومع ذلك فكيفما كانت قيمة ما ينتجه هذان المكونان منفردين “فالثابت أنهما استعملا معا على الدوام، في التقليد الشعري الفرنسي، وأنهما عندما يوحدان إمكانياتهما ينتجان هذه الأعمال التي يلتصق بها في أذهاننا اسم الشعر التصاقا مباشرا مثل أسطورة القرون أو أزهار الشر. فهذه الأشعار التي تكون الفئة الثالثة هي التي تستحق أن نعطيها اسم “الشعر الصوتي-الدلالي” أو الشعر الكامل” (بنية اللغة الشعرية، ص12).
2 – Introduction à la poésie orale, p.156-157.
3 – قارن بما ورد عند بول زمطور Paul Zumthor في المرجع السابق، ص159-176. ومما جاء فيه على وجه التعميم: “إن الشوق إلى الصوت الحي يسكن كل شعر يوجد في منفى الكتابة” (ص160). وبعد فحص تاريخي يعود إلى صياغة الفكرة من زاوية أخرى: “يطمح كل شعر إلى التحول إلى صوت، يطمح إلى أن يسمع يوما ما: أن يمسك بالذاتي غير القابل للتوصيل، عن طريق ملاءمة بين الرسالة والمقام الذي يولدها، بشكل يجعلها تلعب فيه دورا محفزا، شبيها بالدعوة إلى الفعل”(نفسه).
4 – ألفت كتب وأنشئت مقالات كثيرة بهذا العنوان، منها: موسيقى الشعر. ت.س. إليوت ترجمة محمد النويهي. ضمن كتاب قضية الشعر الجديد. دار الفكر، وموسيقى الشعر لإبراهيم أنيس. مكتبة الأنجلو المصرية 1978. وموسيقى الشعر العربي لشكري عياد (مشروع دراسة علمية), دار المعرفة 1978.
5 – اعتمد التحليل بالنظر إلى المستويين الصوتي والدلالي من طرف البنيوية اللسانية كما نجدها عند جان كوهن في كتابه بنية اللغة الشعرية. وإذا رجعنا إلى البلاغة العربية القديمة وجدنا أكبر مشروعين بلاغتين فيها ينحيان أحد المنحيين: بلاغة متعددة المعاني ولا تعطي الأصوات إلا ما له بعد دلالي مثل التجنيس المستوفي، وبلاغة تنطلق من الأصوات قبل أن تضطر للتفتح على المعاني وهي التي حاولها ابن سنان الخفاجي في كتابه سر الفصاحة (انظر كتابنا الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية. وانظر الأسس المذهبية للاتجاهين في كتابنا: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها (تحت الطبع)).
6 – نقد الشعر 40.
7 – Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, p.
8 – إن أصحاب التفعيلة حين يتصرفون في المستوى المجرد التعبيري يتصرفون في مستوى أنساق يحكمها التاريخ داخل اللغة العربية نفسها، في حين يحتفظون للغة الفصحى بنسقها الصوتي. أما ثورة النثيرة على التفعيلة نفسها ورفضها المستوى المسطح نفسه فهو تمرد على اللغة، على إمكانياتها الموسيقية الخصوصية التي تميزها عن اللغات الأخرى أو عن الدوارج، وفي هذه الحالة سيكون من المجدي تكسير الإعراب وتشغيل السكون على أوسع نطاق أو اللجوء إلى النبر والتكميل الشفوي كما هو الحال في الزجل. وفي غير ذلك ينبغي الامتناع نهائيا عن إنشاءالشعر.
9 – انظر: Le vers lui-même
10 – في آخر جلسة من جلسات مادة البلاغة والأسلوبية لطلبة الدراسات العليا بكلية الأدب بفاس يوم 2/7/1997، وكانت امتدادا وتكميلا للجلسة السابقة حول أفق القصيدة الحديثة، استمعنا إلى بعض التسجيلات الشعرية. فكان من جملة الملاحظات التي أثارها الطلبة عند التعليق أنهم لاحظوا أن أكثر المنسحبين من جلسة استماع إلى محمود درويش بفاس سنة 1995 هم أساتذة مادة النقد والأدب القديمين. وانظر أيضا أزمة الحداثة لأحمد المعداوي.
11 – تحدث نجيب العوفي عن كثير من المسكوت عنه أو الضمر في خطاب الحداثة في كتابه: مساءلة الحداثة. فلينظر. ومن المؤسف أننا نرى الأمر يتحول أحيانا إلى احتراف لدى أناس لم يقتربوا يوما من مجال العمل الساخن الملموس، بل استهانوا به.
12 – اطلعت، بعد تحرير هذا البحث، على تعريف محيي الدين صبحي للحداثة في دراسته له بعنوان: حداثة التراث وتراث الحداثة في شعر أحمد المجاطي، فوجدته يعبر بكل دقة عما كان يدور في ذهني. نص كلامه: “الحداثة تعريفا، هي: التعبير عن الوجدان الجمعي للأمة وفق أكثر الأشكال الأدبية تواصلا مع التراث ومعاصرة للإبداع. أي إذا كان التراث بكل تحولاته أبا الحداثة فإن أمها عصر الشاعر بكل إبداعاته العالمية. فالانقطاع عن العصر لا يشكل حداثة بل وقوعا في السلفية الناسخة. والانقطاع عن التراث لا يحقق التواصل بين النص والمخزون الإبداعي في لا وعي الجمهور على صورة استجابة جمالية قابلة للتعديل بحسب مقاييس المعاصرة(الفروسية 133).
13 – ومن الطريف في هذا الصدد أن الشعراء النقاد يؤرخون التحولات الشعرية بالعقود، فيقولون: جيل الستينات وجيل السبعينات وجيل الثمانينات وهلمجرا. ولكل جيل شعريته الناسخة لما قبلها. إنه، في العمق إحساس، بضخامة المنجز: “وحملها الإنسان..”.
14 – تمتد ردود الفعل من المقارعة العلمية النقدية الحارة، كما نجد في كتاب أزمة الحداثة لأحمد المعداوي، إلى التحريض على الاغتيال الثقافي كالدعوة إلى الطرد من الجمعيات، كاتحاد الأدباء العرب، عبر الإقذاع الهجائي التحريضي كما نجد في كتاب أزمة الفكر العربي لإبراهيم سعفان، حيث يقول في وصاياه الضامنة لـ”الأمن العربي الفكري”(ص11):
“1 – المحافظة على الشخصية العربية بالاهتمام بتراثنا الإسلامي..”
“2 – وجود تواصل ثقافي بين البلاد العربية”
“3 – تنظيف الساحة.. الثقافية”(ص12).
فالرجل يخلط بين الحرية والمشروع الواحد، ويرى الداء في “سيطرة الفكر المستورد”(13) و”ظهور أفكار مخربة وشعارات مزيفة..”(11). وليس بوسع المرء إلا أن يرثي لحال أمة يبحث عن أمنها بقمع الفكر!!
15 – انظر كتابنا اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي القديم، ص:
وتأمل وصف محمد نجيب البهشي للعصرين الشعريين: العصر الفني (العصر الجاهلي) والعصر العقلي (العباسي). وحديثه عن التباس الطبع بالصنعة في العصر الجاهلي وهو التباس بالنسبة لحساسيتنا. (مقدمة تاريخ الشعر العربي).
16 – نشأت على مفارقة النموذج المنسجم بلاغة.
17 – تصرفنا في صياغة الجملة تلافيا للبس، والأصل:
“Le rythme est sens, intraduisible en langue par d’autre moyens, Introduction à la poésie orale
18 – يعود أكثر هذه الأدبيات إلى آراء سوزان بيرنار التي “ترى… أن قصيدة النثر تولدت عن “التمرد على قوانين العروض، وأحيانا على القواعد المعتادة للغة”. (قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا ترجمة زهير مجيد. دار المامون. بغداد 1993).
يطرح تعامل الشعراء العرب مع هذا القول مجموعة أسئلة: هل التمرد يعني التخلص؟ وهل التخلص ممكن؟
والبدائل عند سوزان بيرنار هي: الوحدة والمجانية والإيجاز (ص23-24).
أو بعبارة أخرى: “كلية التأثير والمجانية والكثافة” (ص151).
19 – انظر ثلاث عينات من هذا النشيد في كتاب: مساءلة الحداثة (ص17) لنجيب العوفي. وهي لمحمد مصمولي من تونس، ومحمد بنيس وعبد اللطيف اللعبي من المغرب. وهو يرى أن هؤلاء امتداد لدعوة أدونيس “فهم من بيضته خرجوا، وفي عشه درجوا”.
20 – أزمة الحداثة 5-6. إن الجحود الذي لقيه الشاعر أحمد المعداوي، رحمه الله من منظري الحداثة في المغرب ممن كانوا طلبته في مدرجات كلية الآداب بفاس، وهو شاعر شديد الحساسية، كان شعره يلهب الحماس في الأوساط الطلابية في أواخر الستينات وأوائل السبعينات قد جعله يتصرف معهم بمنطق: علي وعلى أعدائي. ولكن ذلك كان بشكل متحضر، وضمن قواعد وشواهد قابلة للنقاش، وهذا هو المهم. يقرأ المرء عمله ويتمنى أن تطول الصفحات.
21 – يبدو لي أن من الأجدى للشكل الشعري المدعو اليوم: “قصيدة النثر” أن يثبت نثيرة الذي اقترحه بعض الباحثين. نثيرة مناسبة لأنها تذكر بالقصيدة بالاشتراك في الوزن الصرفي وتنتمي إلى الخصوصية النثرية التي اختارتها عن طواعية.
فنقول: نثيرة ونثائر كقصيدة وقصائد، ونثير كقصيد والنسبة إليه نثيري. والإيقاع النثيري في مقابل الإيقاع النثري والقصيدي معا.
22 – ورد هذا التصريح شفويا في إطار برنامج تلفزي (رياض الفكر) بالتلفزة المغربية على الساتل يوم 5/7/97. فأوردناه غير محصورا احتياطا من تغيير اللفظ.
23 – حوار مع الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي. مجلة نزوى. العدد 997101، ص155.
24 – فبين ديوانها شظايا من رماد 1949 وديوانها شجرة القمر تغيرت الحالة السيكولوجية من التراث وتغيرت استراتيجية التعامل معه. ففي الحالة الأولى نجد الصدأ يجلل الأسلوب القديم الذي صار عاجزا عن مسايرة الأحاسيس المتجددة:
“ألم تصدأ لطول ما لامستها الأقلام والشفاه منذ سنين وسنين؟ ألم تألفها أسماعنا وترددها شفاهنا، وتعلكها أقلامنا حتى مجتها… منذ قرون ونحن نصف انفعالاتنا بهذا الأسلوب حتى لم يعد له طعم ولا لون، لقد سارت الحياة وتقلبت عليها الصور والالوان والأحاسيس ومع ذلك ما زال شعرنا صورة لقفا نبك، وبانت سعاد، والأوزان هي هي، والقوافي هي هي.. وتكاد المعاني تكون هي هي”(24).
وفي الحالة الثانية نلاحظ الإحساس بانغلاق الأفق:
“سيتوقف في يوم غير بعيد، وسيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية بعد أن خاضوا في الخروج عليها والاستهانة بها”(24).
25 – يقول الخال: “إنما الفرق بين المفهوم الحديث لشكل القصيدة والمفهوم القديم، هو أن الوزن التقليدي في القصيدة الحديثة ليس شرطا (سابقا) بل إمكانية بين غيرها من الإمكانيات، فهناك الموسيقى التي ترتكز إلى الأوزان الكلاسيكية، ولكن الشاعر يتجرد فيها من رقابة الوزن بتشطيره على الشكل الذي يروق له مع الاحتفاظ بالجرس الموسيقي الأساسي للوزن”. (نقله السعيد الورقي في لغة الشعر العربي الحديث 188 عن مجلة الحوادث اللبنانية، 29 أيلول 1961) مقدما بقوله: “وقد أباح الخال للشاعر أن يستخدم التفاعيل القديمة لكن بشرط أن يتخلص من الرقابة الخارجية للوزن”.
26 – نقله في أزمة الحداثة، ص17.
27 – يقول: “كان الجواهري إذا كتب قصيدة، العراق كله يهتز، اليوم ألف واحد يكتب ألف قصيدة، لا أحد يهتز، الشعر الحديث فقد الوقع الذي كان له وانسحب القارئ من ساحته لأنه هو انسحب من ساحة القارئ”. (نقله المعداوي في أزمة الحداثة، 19).
28 – يقول إحسان عباس: “أنا عادة في القراءة أتلقى شحنة من القصيدة، وعندئذ تثيرني لقراءتها خمس مرات أو ست مرات أو عشر مرات. أصبحت الآن أفتقد هذه الشحنة، أصبحت القصيدة لا تستطيع أن تبعث في نفسي الشرارة الأولى التي توجه انتباهي للاهتمام بها”. (نقله المعداوي في أزمة الحداثة 19).
29 – أزمة الحداثة 76.
30 – يقول يوسف الخال: “يمكننا تسمية الإيقاع بالنغم أو الموسيقى أو حتى بالوزن على أن ذلك ليس من الضروري أن يكون تقليديا أو موروثا أو مفروضا مسبقا على الشاعر، فللشاعر ملء الحرية في إيجاد إيقاعه الخاص وهذا ما يميز المفهوم الحديث في الشعر عن المفهوم القديم الذي كان يصر على نوع معين من قواعد الوزن”. (يوسف الخال نقله السعيد الورقي في لغة الشعر 188 عن مجلة الحوادث اللبنانية 1961).
ورأيي أن الشاعر لا يوجد إيقاع القصيدة أو النثيرة بل يوجد إيقاع قصيدته أو نثيرته هو، أما إيقاع القصيد أو النثير فمن مجموع ما تشترك فيه قصيدته أو نثيرته مع غيرها، إنه عمل التاريخ.
31 – منشور بمجلة آفاق سنة 1991. ص146.
32 – في كتابه الإبداع الشعري وتجربة التخوم، ص73-85.
33 – احتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة، ص5.
34 – تقديم ديوان عاريا… أحضنك أيها الطين5.
35 – يقول فخري صالح: “ويستند أدونيس، على عكس أنسي الحاج إلى النظرية الشعرية العربية لمجابهة جبهة معارضة قصيدة النثر. ومن ثم يمكن عده أول من حاولوا التأسيس لمشروعية قصيدة النثر”. (“القصيدة العربية الجديدة” 40 والإحالة على أدونيس في سياسة الشعر، ص76).
36 – مجلة نزوى، العدد 10، سنة 1997.
37 – القصيدة العربية الجديدة 41.
38 – وأقدم قراءتي هنا لا باعتبارها بديلا لقراءته بل باعتبارها إغناء، تحذوها نفس الروح إلى التعريف بمكامن جمالية النصوص التي اختارها ويبقى للشعراء، في نهاية المطاف، أن يقبلوا قراءتي أو يرفضوها.
39 – فخري صالح. القصيدة العربية الجديدة: الإطار النظري والنماذج. مجلة نزوى، العدد 10 أبريل 1997، ص42. وهو يعتمد هنا على رأي كمال أبو ديب في كتابه في الشعرية 219.
40 – نفسه 42.
41 – القصيدة المغربية المعاصرة، 111.
42 – ص132 من النصوص التي يمكن أن يصدق عليها هذا الوصف والتي تقطع الأنفاس قول الشاعر محمد بنيس:
“لن ينتشي الموج بهتك صخور دافئة سأرافق للجوف خليجي من حمأ مسنون تسقط فاكهتي أسلم للأرض جموعي يغويني سم يتنضح في أحشائي بين يدي مواقيت تتأهب ناسية من يجذبها نحو سرير الماء هي الألفاظ معتقة في الصلب مجازات تنحفر الساعة في ألواحهن طين فاسي يا أيتها المسكوبة من أنفاق دمي سيكون الوشم جميلا أومنجذبا لكن الرض بأنفاس الصفصاف سأجعلها تستعذب طعم سمومي”. (ورقة البهاء 5).
43 – يذكرني طرح المسألة بهذا الشكل بالخلاف الذي دار بين المعتزلة وأهل السنة حول طبيعة الكلام هل هو أصوات (المعتزلة) أم معاني نفسية (أهل السنة) حيث رد المعتزلة بأنه إذا كان معاني نفسية فهو مجرد أفكار سابقة على اللغة ولا تستحق صفة الكلام. ونقول نحن أن الذي يهمنا ليس إحساس الشاعر بل صراعه مع اللغة والموسيقى والفضاء إلخ…
44 – بنية اللغة الشعرية، 13.
مراجع مباشرة:
1 – أدونيس: احتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة. دار الآداب، بيروت 1988.
2 – بيرنار سوزان: “بودلير والغنائية الحديثة، تموجات أحلام اليقظة وخفقة الجناح الأخيرة”. (وهو الفصل الأول من كتابها: قصيدة النثر من بودلير حتى الآن) ترجمة رواية صادق، ومراجعة رفعت سلام. مجلة نزوى. العدد 11. 1997، ص17-52.
3 – بزون أحمد: قصيدة النثر العربية (الإطار النظري)، دار الفكر 1996.
4 – بك كمال خير: حركة الحداثة في العر العربي المعاصر، دراسة حول الإطار الاجتماعي الثقافي للاتجاهات والبنى الأدبية. المشرق للطباعة والنشر 1982.
5 – البهبيتي محمد نجيب: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري. مكتبة الخانجي ودار الكتاب العربي 1967.
6 – ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب، بيروت 1987.
7 – بنيس محمد: ورقة البهاء (شعر)، توبقال، الدار البيضاء 1987.
8 – راجع عبد الله: القصيدة المغربية المعاصرة، بنية الشهادة والاستشهاد، الجزء الأول، عيون المقالات، الدار البيضاء، 1987.
9 – سعفان إبراهيم: أزمة الفكر العربي: شهادات الأدباء والكتاب من العالم العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية-سوريا 1994.
10 – السمطي عبد الله: “بين بلاغة الصورة وسردها، قصيدة النثر الراهنة وصنع الرؤية الجمالية”، مجلة نزوى، العدد 11، 1997، ص43-65.
11 – صبحي محيي الدين: “حداثة التراث وتراث الحداثة في شعر أحمد المعداوي”. ضمن ديوان الفروسية لأحمد المعداوي، منشورات المجلس القومي للثقافة العربي، الدار البيضاء 1987.
12 – الصالحي محمد: “قصيدة النثر.. تأملات في المصطلح”. مجلة نزوى، العدد 10، 1997، ص80-94.
13 – العمري محمد:
أ – تحليل الخطاب الشعري: البنية الصوتية، الدار العالمية، الدار البيضاء 1990.
ب – اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي، دراسات سال، الدار البيضاء 1990.
ج – الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية، نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة العربية، سال، الدار البيضاء 1991.
14 – العوفي نجيب: مساءلة الحداثة، سلسلة شراع، طنجة، يوليوز 1996.
15 – فخري صالح: “القصيدة العربية الجديدة: الإطار النظري والنماذج”، مجلة نزوى، العدد 10، 1997، ص37-45.
16 – قدامة بن جعفر: نقد الشعر.. تحقيق كمال مصطفى، القاهرة 1978.
17 – القط عبد القادر: “رؤية الشعر المصري المعاصر”، مجلة إبداع، ع3، ص8-19، مارس 1996.
18 – كوهن جان: بنية اللغة الشعرية.. ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، توبقال، الدار البيضاء 1986.
19 – المعداوي أحمد: أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، دار الآفاق الجديدة، الدار البيضاء 1996.
20 – الورقي السعيد: لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، دار النهضة العربية 1984.
21 – Gauthier Michel: Système euphonique et Rythmique du vers français. Klincksieck. Paris, 1974.
22 – Tatilon Claude: Sonoritébs et textes poétique. Stadia phonética 10. Didier 1976.
23 – Tynianov Iouri: Le vers lui-même. Les problèmes du vers. Traduit du russe par Jean Duvin et autres.ed 10/18.
24 – Varga Kibédi: Les constantes du poème. Picard 1977.
25 – Zumthor Paul: Introduction à la poésie orale. Collection poétique. Ed. du Seuil. Paris 1983.