| الكاتب | ستيفان زفايغ |
| مراجعة | عبدالله عبدالمحسن الصَّدِي |
الروح بين أديبٍ وطبيب “سيرة غيرية”
المقدمة
ما زلت أتذكَّر اللحظة الأولى التي رأيت فيها الكتاب على رف تلك المكتبة في معرض الكتاب الدولي بالرياض السَّنة السَّابقة، وقد شدَّ انتباهي اسمين على غِلاف أحد الكتب؛ “ستيفان زفايغ” و “سيغموند فرويد” بعنوان شيِّق يطرح بالنفس التَّساؤل “العلاج بالروح”. وانبهاري باشتراك هذين الاسمين يكمن في إدراك أن مؤلَّفات زفايغ تحتوي دائمًا على تحليلاتٍ نفسية يصيغها بالرواية بطريقة أدبيَّة خلَّابة. فأصبحت بين اسمين لديهما باعٌ طويل في “النفس” فالأول بقلمه أدبيًا والآخر بمشرطِه طبيبًا.
مراجعة كتاب “العلاج بالروح”
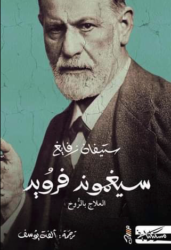
في كتاب “العلاج بالروح”، كسر الروائي النمساوي ستيفان زفايغ الطريقة الكلاسيكية في كتابة السيرة الغيرية، فهو لم يتطرق فقط لحياة العالم والمفكر النمساوي سيغموند فرويد، إنِّما أيضًا تطرق للمجتمع ككل، والأفكار التي تم تكوينها عن علم النفس. وهذه النظرة التاريخية المرتبطة بقراءة المجتمع مرورًا للحالة النفسية للفرد تشير لمدى إلمام المؤلف الدقيق لهذا العلم، وهذا أمرٌ ليس بحديث؛ فبمؤلَّفاته السَّابقة لطالمَا أظهر هذا الجانب بربطهِ بين حالات المرض النفسي بالطرح الأدبي.
وقد أظهر لنا زفايغ شخصيَّة العالم والمفكر النمساوي سيغموند فرويد بطريقةٍ مُغايرة، تجعلنا نتعرَّف عليه لمدى أقرب من المُعتاد، فهو لم يتكلم عن سيرته فحسب؛ بل أيضًا جرأته الفريدة وصدقه، وعدم انثنائه عن الحق. وهذا لم يناقض شكله الخارجي أيضًا؛ فقد حلل زفايغ ملامحه الخارجية ليُعطي القارئ مجهرًا دقيقًا ليرى بحق من هو فرويد، وما مدى حزم هذا العالِم ذي الإرادة الجامحة والذكاء الفريد مع قدرته على التحليل والربط.
للوهلةِ الأولى نظن أن الكتاب هو ترجمة كلاسيكية لفرويد، أو مُقدِّمة للتحليل النفسي التي أنشأها فرويد، إنما هو أبعد من ذلك، فزفايغ قدم لنا نظرة تاريخية لكيفية رؤية الإنسان للمرض؛ ابتداءً في كون المرض مرتبطًا بالشعور الديني، وأن الآلهة هي التي ترسل الأمراض وتزيلها، فكان الدواء الوحيد هو الدعاء والصلاة حتى ترضى الآلهة ويتلاشى المرض؛ فحتى هذه اللحظة كان المرض متصلا بالروح.
ولكن الإنسان احتاج إلى وسيلةٍ أكثر نفعًا وقُربًا، احتاج إلى إنسانٍ آخر يفُوقه حكمةً وعلمًا. من هنا بدأ التركيز على الممارسات الطبية كـ فن عملي، ومن حيثُ هو سر ديني. حتى وصل لمرحلةٍ فصل فيها المرض عن الدين، وهذا الانفصال أدَّى إلى فصل المرض عن شخصية الفرد الروحية والنفسية، وبذلك أصبح المريض مجرد ( جسد ) يسلم نفسه بشكل كامل إلى الطبيب؛ متناسيًا الطبيب خلف هذا الجسد من كيان، فجل التركيز كان على العضو الذي يشتكي منهُ الإنسان ألمًا فقط، فأصبح المرض مشكلةً تُحل ( بالعقل ). وذلك ما أظهر تساؤلًا مُهمًّا: “هل غدا الدكتور طبيبًا أكثر من اللازم؟” مُتزامنةً مع ظهور بما يسمَّى “أزمة الطِّب الأخلاقية”.
وهي ليست أزمة مهنيَّة بسيطة متَّصلة فقط بالممارسة، بل هي جزءٌ من أزمةٍ فكريَّة؛ أزمة الانتشاء بالعقلانية. في عصرٍ غرق بشدِّة بالإيمان بالعقلِ وحده، بسبب التَّطوُّر الكبير في العلوم والاكتشافات السريعة التي حدثت في تلك الفترة، فبالاعتماد على العقل ارتقى الانسان منزلةً لم يتصور أنه سيرتقيها يومًا، فكل شيءٍ خضع لسلطة العقل، الزمان والمكان والفضاء. لقد استطاع العقل أن ينظم كل ما هو عشوائي، ونقل الإنسان من أكل لحوم البشر إلى الإنسانية بمعناها الاجتماعي، وقد نظم تلك الغريزة الحيوانية التي تسكنه، ولم يتبقَّى إلا ومضات برق شاحبة من هذه الغريزة الحيوانية للإنسان القديم، غريزةٌ شغلت العقل قديمًا وحديثًا، فلطالما رأى الإنسان أنه يجب السيطرة على تلك الغريزة الخَبيثة؛ خبيثة الجنس، ويجب وضع كل ما يتعلقُ بها خلف قضبان الأخلاق.
لهذا أُنتج جيشٌ من المتنكرين في زيِّ المعلمين والمربين، ليُبيدوا هذه الخبيثة الجنسية التي من شأنها أن تُشعِل دماء الإنسان الحديث وتذكِّرُه بحيوانيَّته القديمة، بكُلِّ الأساليب المصطنعة وغير الطبيعية، وذلك بعدَمِ الالتفاتِ إليها وجعلها في طيِّ النسيان. فنجد أن بيداغوجيا القرن التاسع عشر لم تطرح أي مسائل فعليًا، إنما تعاملت مع كل المسائل تحت مبدأ “الكتمان”، فأصبحت التربية مبنيَّةً على الحذر والنفاق الشديدين.
وكلُّ هذه الأفعال متنكرة بزيِّ الأخلاق، فيجب على الفرد أن يلتزم بتلك “الأخلاق التي فرضها العقل” وعليه أن يظهرَ متخلِّقًا؛ أن يظهر بمظهر أخلاقي، تجاه من يُراقبونه، أما كون هذه الأخلاق تنبعُ من تصرُّفٍ داخلي فهذا غير مهم.
فلم يجد الفرد سبيلًا إلا بكتمان غريزته الجنسية، وعند التحدث بها يجب أن يكون ذلك بسرية، خوفًا ورهبةً من مجتمع جعلها ضربًا من ضروب المحرمات، وهذا الأمر كله بسبب الغوص في ضلال الجهل. وكيف لعصرٍ أن يغوص في ضلال الجهل وهو مؤمنٌ بالعقلانية؟ والجواب بسيط: بسبب اغترارهُ بعقليته، فـ “الجهل يولِّد الشدة دائما”.
رغم أن هذا التحليل المجتمعي النفسي في غاية الروعة والصِّحة إلا أنه لا يخلو من دفاعٍ عن أفكار غير سليمة، فقد قال زفايغ مدافعًا عن الشواذ جنسيًا مبررًا أفعالهم، وليس فقط مشاعرهم: “أما الأشخاص غير العاديين ( الشواذ ) فكانوا ضحايا للحمق البشري بشكلٍ أكبر من غيرهم. ذلك أنه لما حكم عليهم العلم بأنهم كائناتٍ من منزلةٍ أخلاقيةٍ دنيا، وحكم عليهم القانون بأنهم مجرمون، فإنه هؤلاء المساكين، وهم ضحايا إرثٍ رهيب، يمضون حياتهم كاملةً في خوفٍ من السجن الذي أمامهم” وهذا إنِّما كان تأكيدًا على رواية كتبها سابقًا وهي “فوضى الأحاسيس” متناولًا هذه الفكرة روائيًا، في محاولةٍ منه لتمرير هذه الأفكار عنهم بأنهم مظلومين، فهو لم يبرر أفكارهم، إنما أفعالهم أيضًا بكونها أمرًا طبيعيًا بسبب ظروفٍ نفسية.
“الكتمان” إذن هو السبيل لحماية الفرد من غضب المجتمع. ولم يعلم الفرد الأضرار المترتبة عليه، فبسببه ظهر الكثير من الأمراض العُصابية. وهنا يظهر لنا زفايغ كِفاح فرويد نحو معرِفة ما خلفَ هذه الأمراض من روح، مع مجتمَعٍ علميٍّ جُل تركيزه بكيفية علاج الأمراض بالمشرط والمجهرِ والآلات. فهو قد اتَّجهَ بطريقةٍ عكسيَّةٍ ومُخالِفَة لأفكار المجتمع العلمي وتوَجُّهاتهم ابتداءً من تركيزه على “اللاوعي”، فهو لم يجهل أن العقل الواعي للإنسان لم يكن مدركًا تمامًا لما يجول في خبايا النَّفس، فقرر البحث في منطقة أبعد من الوعي، وتحديدًا العقل “اللاوعي”. فلم يكون اللاوعي بالنسبة لفرويد هو رواسب النفس فقط؛ إنما كان لبَّهُ وأساسه، فإن أساس “حياتنا لا تدور في حرية ضمن الفلك العقلاني، بل ترضخ للضغط الجامح للاوعي”. ومن هنا حاول فرويد أن يُظهر اللاوعي للسطح، فلا بُد من فهم أساس الإنسان النفسي بالرجوع إلى تاريخه، لفهم سطحه وأفعالهُ وتصرُّفاته.
وسرعان ما أدرك فرويد أن “أنواع العُصاب وأغلب الاضطرابات الجنسية تولد من رغبة غير مشبعة.. ومكبوته في اللاوعي” بما في ذلك الرغبة الجنسية التي لا يمكن حتى أن يتحدث عنها ويفهمها في ظل الظروف السابقة، ومن ثم يلجأُ المريض إلى الكتمان، رغم التفكير الملح في هذه الرغبة حتى يتأثر فيها اللاوعي بشكل تدريجيْ ومن ثم تظهر هذه الاضطرابات. ولكن كيف لفرويد أن يبيِّن هذا الأمر لمجتمعٍ مقتنعٍ أن لا شيء يهدد ثقافته مثل تحرير الغرائز الجنسية؟
فحتى في الإطار العلمي كان الحديث عن الجنس أمرًا يكاد أن يكون محرمًا، وبسبب جرأة هذا العالِم وحزمه فقد كسر هذا الأمر، بتصريحٍ في إحدى محاضراته مؤكِّدًا أن الكثير من أنواع العصاب بل لعلها كلها ناتجة عن كبت الرغبة الجنسية. فكان هنا انطلاقة التغيير لأفكارٍ كثيرة من المجتمع، فقد أجمع العلماء أن علم النفس قبل فرويد وبعده انطلق انطلاقًا مهوولًا، كيف لا وهو مؤسس التحليل النفسي.
الخاتمة
لقد قارن زفايغ في الكتاب علم النفس ما قبل فرويد وما بعده، وكيف أصبح ذو أهمية، حيث أن كل العلاجات للظواهر العصابية قبل عام ١٨٨٥م عاجزة تمامًا عن إيجاد أي حل، ومع فرويد تغير الأمر تماماً. لقد قام زفايغ عند تأليف هذه السيرة الغيرية بمثلِ ما عمل فرويد مع النَّفس؛ بالبحثِ دومًا عن الماضي وربطهِ بالحاضر.
ومن هنا يتبيَّن مدى أهميَّة التحليل النَّفسي ومدى أثره على المجتمع بشكلٍ عام والفرد بشكلٍ خاص، فالفرد يجابه تحدِّيًا شديدًا بين نفسهِ الدَّاخلية وقوانين وأنظمة المجتمع التي تعيق تحرُّر النفس منذ الولادة وحتَّى الموت. ومن جهة عالم النفس يدرك مدى التَّركيز الذي يعيشه لمعرفة علَّةِ مريضه، تركيز وتحليل شديديْ الدِّقة، ومنها أيضًا يعرف نبل هذه المهنة.
فعلاج الرُّوح ليس كأي علاج.


