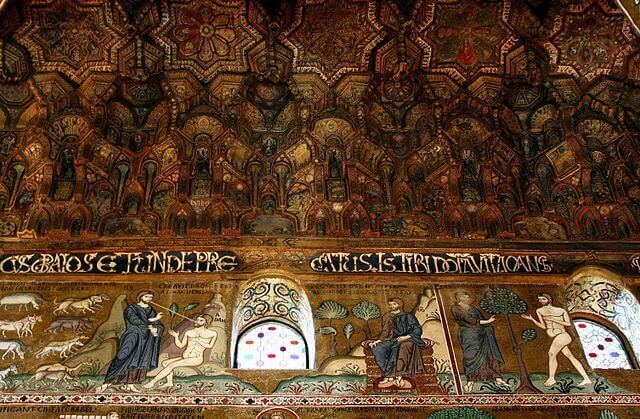لم يحصل في تاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط أن شهدت المنطقة توسعا لإمبراطورية ما بالسرعة والمدى اللذان ميزا الفتح الإسلامي. هذا ما يثبته المؤرخون والسياسيون وخبراء الاستراتيجيا. انتشر الإسلام في ثلاث قارات في أقل من قرن. وفرض نفسه على الثقافات والمرجعيات السائدة في هذه الفضاءات بكل الطرق الممكنة، وغدا تحديا جديا أمام أكثر من إرادة للقوة، سيما تلك التي كانت لها الغلبة على صعيد الشرق الأدنى والبحر المتوسط، وعلى رأسها الامبراطورية البيزنطية والرومانية. وهل من قبيل المصادفة أن “يقبل الفتح الجارف للإسلام بسهولة من طرف الشرق الأدنى والمجال المزدوج لإفريقيا الشمالية وجزء من أسبانيا في نفس الآن؟… لقد كان العالم القرطاجي أكثر استعدادا، في العمق، لاستقبال حضارة الإسلام من هضم القانون الروماني، لأن حضارة الإسلام ليست إضافة فحسب ولكنها تمثل استمرارية أيضا. فهي لم تستوعب اليهودية والتراث الإبراهيمي فقط، ولكنها جسدت ثقافة وعادات وتقاليد راسخة في المكان. والحضارة، في حقيقة الأمر ، ليست دينا فحسب، وإن كان الدين يوجد في قلب كل نسق ثقافي، وإنما هي فن للحياة وآلاف المواقف التي تتكرر”(1).
ومع ذلك كثفت الواقعة الإسلامية، في الصيرورة التاريخية لحوض الأبيض المتوسط، لحظة مزدوجة، تداخل فيها فعل القطيعة ورموز الاستمرار. والقول بأحدهما، بشكل استثنائي، سيسقط صاحبه في زلة هائلة، تجعله في حالة لن يتمكن فيها من إدراك المدى الفعلي الذي جسدته هذه الظاهرة. وفي هذا المجال، هناك اجتهادات لا حصر لها، سواء من موقع الدفاع أو من منطلق الطعن. وفي كل الأحوال فإن الواقعة الإسلامية أحدثت مشكلة حقيقية للآخر، ولا سيما في تعبيراته النصرانية، والبيزنطية، والرومانية، والغربية. سواء اعتبرناها “غربا مضادا”(2)، أو تجسيدا “لجواب الشرق على ادعاءات الإسكندر”(3) أو تحيل على عالم “الغرابة الجذرية”(4)، فإن الشغف الإسلامي المندفع بنى، في سيرورة تكوينه وتأسيسه، حضارة حقيقية يجمع الكل، مسلمين ومسيحيين ويهود وغيرهم، على اعتبارها حضارة في منتهى التنوع والثراء والقوة.
لقد عملت الاندفاعة الإسلامية على بلورة وعي إسلامي بالذات، و صاغت صورا عن الآخر، سواء في أبعاده المساكنة أو الصراعية، أو في مظهره الداخلي وفي تجلياته الخارجية. وقد تم ذلك، في أكثر الأحوال، داخل ظرفيات منحت للمد الإسلامي القوة والغلبة وجعلت الواقعة الإسلامية تتعامل مع الآخر من موقع التفوق والاقتدار، كدين وثقافة وحضارة. ولأن الحضارات، في نظر فرنان بروديل، تتميز بخاصيتين أساسيتين، تتمثل الأولى في كون الحضارات تجسد وقائع ضمن حقب طويلة، وطويلة جدا؛ والثانية في أنها تتجذر، بقوة، في فضائها الجغرافي(5)، فإن أي حضارة كبيرة، برهنت عن حضور في الزمان والمكان، لا تخضع للحضارة الأقوى إلا من حيث المظهر، بل في الغالب الأعم ما “تكتسب وعيا أكبر بذاتها، تستنفر قواتها وتنفي قومية ثقافية متصلبة”(6) ولذلك فإن الحرب والحقد يلعبان دورا كبيرا في صنع الحضارات، في تغذيتها وفي تزويدها بعناصر الحياة، بل إن الحضارات، في الغالب، ليست إلا ” تجاهل وإنكار، احتقار وكراهية للآخر. ولكنها ليست هذا فحسب، لأنها، أيضا، تضحية وإشعاع ، وتراكم للثروات الثقافية وميراث للذكاء”(7). إن الحضارات ” أكثر الشخوص تعقدا وتناقضا في البحر المتوسط. بمجرد ما نعترف لها بصفة ما حتى تنتصب صفتها المناقضة… تستقبل زيارات الآخرين كما تقوم هي بزيارتهم، مسالمة ومحاربة في نفس الآن . وبقدر ما تتميز بثبات مدهش، هي، في نفس الوقت، متحركة، جوالة، ومتسكعة…”(8)
أطروحة فرنان بروديل، حول المتوسط والحضارات التي تعاقبت أو تصارعت عليه، من أكثر الأطروحات عمقا وشمولية وطرافة. لا يعطي الأولوية الحاسمة لأي عامل في تكون وتطور الحضارات. كل المستويات تفعل في المكان والزمان والإنسان، للاقتصاد المادي دور مهم كما هو الشأن بالنسبة للاقتصاد الرمزي. ومن منطلق فهمه لمعنى الحضارة اعتبر بروديل أن الإسلام يمثل “غربا مضادا، بكل الإلتباسات التي تتضمنها كل معارضة عميقة، حين تكون هناك منافسة وعداوة واقتباس”(9)
الاختراق الإسلامي للقارات المحيطة بالبحر المتوسط، بقدر ما كان جارفا ومثيرا للدهشة، اعترضته مقاومات هائلة، مثلت البؤر المسيحية أهم التحديات التي واجهته، وبشهادة كل الباحثين، فإن إخفاق الجيوش الإسلامية في الاستيلاء على القسطنطينية سنة 718 وهزيمة بواتيي عام 732 لم يسمحا للمسلمين من أن “يجعلوا من المتوسط تلك البحيرة الإسلامية التي لربما كانوا يحلمون بها”(10). فالمقاومة التي واجهت به القسطنطينية التمدد الإسلامي ، ومعركة “بواتيي” اعتبرتا من الوجهة الغربية، بمثابة حدثين تاريخيين حاسمين “أنقذا أوروبا”(11) من الإسلام وأعطيا فرصة استثنائية للمسيحية للاحتفاظ بشمال المتوسط لاتخاذه قاعدة استراتيجية للرد ولتنظيم هجوم مضاد سيترك آثارا عميقة على مختلف العلاقات التي ستشهدها المنطقة بين الإسلام والمسيحية، بين العرب والغرب.
إذا كانت الحضارات، في نظر بروديل، تحمل في داخلها عناصر الاستبعاد والتبرم واحتقار الآخر، هل ذلك يرجع إلى اعتبارات المصلحة والسيطرة والتبادل الثقافي، بمختلف مستوياته، أم أن العامل الديني، بوصفه حقلا لإنتاج وإعادة إنتاج “الدوغما” هو الذي يؤجج مشاعر الكراهية والحقد(12)؟ وهل يمكن القول، مع هذا الباحث الموسوعي الجسور، إن “المستقبل لا يعود إلا لمن يعرف كيف يحقد”؟(13).
لا تهمنا الإجابة عن هذا السؤال المحير أو ادعاء القدرة على ممارسة “تحليل نفسي” للحضارة، ولكننا سنستحضر بعض أبعاد هذا السؤال كلما تبينت لنا ضرورة استدعائه في سياق المواجهة الحضارية المعقدة التي ميزت الإسلام والمسيحية في المجال العام الذي يحتله المتوسط. فالمواجهة لم تكن تقتصر على التحكم في الأمكنة وفي الناس، لأن المرحلة كانت تولي أهمية قصوى للرموز في حضورها المكاني. وهكذا، وإذا كانت الحضارات تتحرك ضمن إيقاع الحقب الطويلة، وتتجذر في المكان مهما تعرضت للعواصف ولضروب الهزيمة، فإن المسيحية ستنظم أكبر هجوم مضاد على الإسلام في القرون الوسطى من خلال الظاهرة الصليبية. ستستنفر المسيحية كل الطاقات والإمكانيات وستعبئ كل الوسائل، المادية والرمزية، وستؤجج المشاعر وتحرك المخيلات لتنظيم أكثر الحملات المضادة قوة وعنفا لاستعادة ما نعت “بالأماكن المقدسة”، ولضرب الإسلام في أكثر مناطقه اقترابا وحيوية.
مشروعان متناقضان اتخذا من البحر الأبيض المتوسط مجال مواجهتهما ومن الرموز رهان التعبئة ووسيلة لاستنفار المتخيل الجمعي. وإذا كان الإسلام قد جعل من مبدأ الجهاد قاعدة حاسمة للفتح والانتشار ومحاربة الكفر والشرك، فإن المسيحية ابتكرت المشروع الصليبي لإعادة الاعتبار للرسالة المسيحية بطرق جديدة لم يكن المسيحي، باختلاف كنائسه، متعودا عليها أو مستئنسا بها. ويهمنا، هنا، أن نتوقف عند مكونات النظرة المسيحية للإسلام، للعمل على استجلاء بعض آليات التنميط التي نسجتها كل من المخيلة الإسلامية والمسيحية للآخر، في سياق المواجهة الحضارية حول السيادة على الأمكنة والرموز.
يندهش جل الباحثين في تاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية من التفجر الكبير لعناصر المتخيل فيما يخص إدراك الآخر, ولا سيما من المنظور المسيحي. ويرى “مونتغومري واط” أن أوروبا الوسيطية أفرزت ظاهرتين لا يمكن لأي باحث جاد أن يتعامل معهما بلا مبالاة. تتمثل الأولى في الصورة الشائهة تماما التي ولدتها أوروبا عن الاسلام ، وتبرز الثانية في التجذر الهائل الذي تمكنت “الايديولوجيا الصليبية من ترسيخه في قلوب وعقول الأوروبيين عن الذات وعن الآخر(14).
وإذا كان الهدف المعلن للصليبيين تجلى في الدعوة إلى استعادة الأماكن المقدسة بالطرق العسكرية، فإنهم ، من أجل ذلك، استثمروا كل الوسائل الكفيلة بتكوين متخيل جمعي يعلي من شأن الذات ويقدم الآخر في أشكال انتقاصية، شيطانية، تمنح لكل المنخرطين في الحركة العامة حوافز التعبئة والإيمان بعدوانيته وشراسته، لدرجة يصل فيها المحارب إلى خلق شعور لديه بأنه حين ” يحارب ضد المسلمين، فإنه يحارب الظلام قصد إشاعة الأنوار”(15). وسواء سمينا هذه العملية التعبوية الكبيرة “ايديولوجيا” أو “دعاية”، أو “حملة إعلامية”…الخ فإن ما يثير الانتباه، عند كل الذين تناولوا الموضوع، هو استعمالهم الكبير لقاموس المتخيل، مثل صورة، مخيلة، إدراك، تخيل، صورة نمطية…الخ الأمر الذي يضعنا ، مباشرة، في قلب الإشكالية التي تحركنا منذ البداية. وهي أن للمتخيل دور حاسم في تشكيل النظرة المتبادلة للآخر، بكل ما يمكن لهذه الملكة الإنسانية الخاصة من إنتاجه من صور وأحكام وخلقه من مشاعر وأحاسيس في سياق الاحتفال بشؤون الذات والانتقاص من صور الغير. فالحضارة لا تقاس بإنتاجها المادي وبإنجازاتها العمرانية والفنية، وإنما تتميز بقدرتها، أيضا، على نحت صور للآخرين التي تربطها معهم علاقات اللاتكافؤ والمنافسة. وليس من قبيل الصدفة أن يؤكد بروديل على دور المشاعر في صنع الحضارات، ومن ضمنها المشاعر المستنكرة، نظريا، والمستهجنة، عقليا، ولكنها تفعل فعلها في السلوك والعلاقات والتاريخ.
وإذا كانت الواقعة الإسلامي قد انبثقت من أحشاء الآخرين وقدمت نفسها باعتبارها امتدادا رمزيا ودينيا للفكرة التوحيدية، فإنها، مع ذلك، تكونت وتأسست ضد الآخرين، قياسا إلى حجم التبرم الذي أعلنه هذا الطرف أو ذاك إزاء مشروعها. وعبر الإسلام عن إرادة للقوة ناذرة في التاريخ. امتد، بشكل مدهش، على أكثر من قارة في فترة لا تتجاوز القرن. وانتزع من المسيحية مناطق واسعة. وكون، بموازاة ذلك، متخيلا جمعيا خاصا، للآخر فيه صورة محددة ودور خاص. للذمي أحكامه، وللمشرك أو الكافر إجراءاته وللحضارات الأخرى مكانتها. وعلى الرغم من التقسيم المبدئي بين دار الإسلام ودار الحرب، أو دار الصلح، فإن الواقعة الإسلامية، في سياق انتشارها، برهنت عن حالات كثيرة من “البراغماتية” والميل إلى التوافق والتساكن والتعايش. كان للقوة الداعمة للشغف الإسلامي دور بارز. ومن موقع التفوق كانت تنسج العلاقات مع الآخر، لا سيما في القرون الأولى من الفتح الإسلامي. ومعنى ذلك أن “الغرب قابل الإسلام في ساحة المعركة”(16)، كما صاغ عناصره المتخيلة كصور لنموذج ديني وثقافي وحضاري يختزن كل مكونات الضدية ومظاهر المنافسة.
إذا كانت الحضارات تنتصر، كما يؤكد على ذلك بروديل، لأنها تعرف كيف تمارس كراهيتها للآخرين، هل يمكن أن نقول، من ناحية أخرى، أن التشويه الذي تعرض له الإسلام من طرف “الأوروبيين” عبر عن حاجة ضرورية “للتعويض عن شعورهم بالنقص”(17)؟ أي أن التعبئة المسيحية حين قرنت الإسلام بالظلام والمسيحية بالنور زرعت في وجدان المسيحي الشعور بضرورة الانتصار على النقص لهزم الظلام الإسلامي. إذ مهما كانت قوة المسلمين، في هذه الحالة فإن “المسيحيين، من جهتهم، ترسخت لديهم القناعة بتفوقهم بفضل دينهم”(18)، ومن ثم فإن الصورة المشوهة للإسلام يتعين النظر إليها بأنها ” إسقاط للجانب المظلم في الشخصية الأوروبية”(19).
ومهما يكن فإن الصور النمطية المسيحية عن الاسلام تشكلت بالتدريج وعبرت، بكيفيات مختلفة، عن الاهتمام المسيحي الأوروبي بالواقعة الإسلامية. انطلق هذا الاهتمام في البدء، من خلال المسيحية الشرقية، والنصارى الأصليين، ثم اتخذ أبعادا أكثر جدية مع احتدام المواجهة في سياق الصراع التاريخي والحضاري على المواقع والأمكنة والرموز. وفي كل الأحوال يمكن القول بأن “الصورة” المسيحية عن الاسلام ، أي التعبير المسيحي عن الوعي الضدي بالآخر، جاءت نتاج “الأدبيات التي وضعها رجال الكنيسة، وعلماء الكلام، والمؤرخين والدعاة، بالدرجة الأولى، لسبب بسيط هو أنه من العصر الوسيط إلى النهضة كان رجال الكنيسة والرهبان والكهان وموظفو الكنيسة الكبار هم الذين يمتلكون مفاتيح المعرفة ويتكفلون بتربية المؤمنين بكتاباتهم ودعواتهم “(20).
غير أن أعمال يوحنا الدمشقي تمثل إطارا مرجعيا لكثير من الأقوال والكتابات التي اتخذت من الإسلام موضوعا لها. فهو، وإن ترعرع في بيئة عربية بيزنطية وإسلامية، قد ساهم، بقسط وافر، في إثراء الجدل الكلامي بين الإسلام والمسيحية، وإضفاء نوع من “العقلنة” على نمط المناظرة الذي دار حول قضايا لاهوتية بين علماء الكلام المسلمين وعلماء اللاهوت المسيحيين. ولأن هذا الجانب لا يهمنا إلا من زاوية اعتباره مثل لحظة بارزة في سياق تطور آليات الحكم على الآخر، فإننا سنكتفي بالإشارة إلى أن يوحنا الدمشقي ساهم، بشكل تأسيسي، في رسم بعض ملامح المسلم، وذلك أنه حاول “التشكيك بكون الإسلام دين إبراهيم الحنيف من خلال وصفه المسلمين، على نحو لا يخلو من الخبث، بالسرازانيين (Saracens). ويبدو أن يوحنا الدمشقي هو أول كاتب بيزنطي استخدم هذا التشويه الايتمولوجي لأغراض الجدل العنيف وتحفيز الذاكرة. كذلك يصف المسلمين بـ”المفسدين”. وصور، من جهة ثانية، الرسول على أنه واحد من “أتباع بدعة أريان” وبأنه “استقى من الآريانية العقيدة التي تفيد بأن “الكلمة” و”الروح” لا يعدوان كونهما مخلوقين لله، واقتبس من النسطورية ما يتعلق بعدم تأليه الابن المتجسد”(21)، كما أنه يعتبر بأن القرآن نتاج “لأحلام اليقظة، ويصور الرسول كشخص مضلل”، و ينتقد، بقوة، “ما يعتبره معاملة لا تليق بالنساء من قبل المسلمين”(22)، ثم ينتهي “معددا أهم الممارسات والمحظورات في الإسلام على الشكل التالي: الختان، عدم اتخاذ يوم السبت للراحة والعبادة، وإلغاء المعمودية، وإحداث تغيير في محرمات الطعام، ومنع شرب الخمر”(23).
وبغض النظر عن التأثير الذي كان ليوحنا الدمشقي على المناخ الجدلي الكلامي الإسلامي، أو عن انتمائه السامي و”ثقافته السورية”، أو حتى الاحترام الذي تمتع به من قبل المسلمين والمسيحيين، فإن هذا الرجل، في نظر بعض الباحثين” ناقش الإسلام كبدعة”(24)، بل إن “التصورات المتكونة عن الاسلام كبدعة مسيحية، مرتدة ومنشقة وعن محمد كنبي مزيف انتقلت من مسيحي سوريا إلى البيزنطيين، ومنهم إلى الأوروبيين”(25). إلا أن تعرف أوروبا على الكتابات الدينية والجدلية، المناهضة للإسلام ثم من خلال “نموذجها البيزنطي بالدرجة الأولى”(26)، وبمعنى آخر أنه مهما كان دور المسيحيين الشرقيين في التمهيد لعناصر الصورة المسيحية عن الاسلام ، فإن الوساطة البيزنطية أعطت لكثير من الصور بعدا “فانتازيا” ينشط المخيلة، ويحرك الوهم اكثر مما يستدعي النظر العقلي الهادئ. وهكذا اعتبر الرسول أنه غير قادر على أن يكون “نبيا حقيقيا” أو أن يأتي بعقيدة صحيحة، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون إلا شخصا “مرتدا أو نبيا مزيفا، لا يملك سوى الادعاءات والأضاليل”(27)، بل إن الخيال المسيحي جعل منه ساحرا ومعاديا للمسيح ويجسد صورة الشيطان كذلك. وخلاصة القول أن الوعي، أو بالأحرى المتخيل، المسيحي في الزمن الوسيط، بلور الصورة التالية عن الاسلام:”إنه عقيدة ابتدعها محمد، وهي تتسم بالكذب والتشويه المتعمد للحقائق، إنها دين الجبر، والانحلال الخلقي، والتساهل مع الملذات والشهوات الحسية، إنها ديانة العنف والقسوة”(28).
قد يرجع عنف الأحكام المتخيلة على الإسلام إلى طبيعة الشغف الإسلامي وما تولد عنه من إرادة للقوة تمكنت من انتزاع مناطق شاسعة من سيطرة المسيحية. وعلى الرغم من احتكاك المسيحيين الشرقيين بتحولات الواقعة الإسلامية وبنصوصها التأسيسية، فإن الوساطة البيزنطية بما افترضته من تنشيط لمتخيل عدائي للإسلام، أفضت إلى تكوين الصور النمطية المؤسسة للوعي واللاوعي المسيحي عن الاسلام طيلة الزمن الوسيط(29). خضعت هذه الصور لتطور خاص تبعا لسيرورة المد الإسلامي ولطبيعة النزاع الذي شهدته المنطقة المتوسطية وما جاورها بين الإسلام والمسيحية. ويجمع الباحثون على أن الإدراكات والصور الأولى التي كونتها المخيلة المسيحية عن الاسلام كانت باهتة، وغامضة، ولا تستند – باستثناء حالات قليلة محددة، مثل حالة يوحنا الدمشقي – إلى اطلاع ومعرفة بأصول الإسلام ونصوصه التأسيسية. وفي كل الأحوال فإن المسلمين شكلوا، ولمدة طويلة، بالنسبة للغرب المسيحي “خطرا قبل أن يصبحوا مشكلة”(30)، وضمن جدلية المد والجزر، والاحتكاك العنيف والمتساكن أحيانا، بدأت الصور المسيحية عن الاسلام تتحدد أكثر، دون أن يعني ذلك اقترابها أو مطابقتها للوقائع. وكلما توغل الإنسان عميقا، للبحث عن الأصول المباشرة لهذه الصور، كلما صعب عليه التمييز بين ما هو واقعي وما هو متخيل، بل إن البعد الأسطوري لهذه الصور يغدو حاسما في إعادة إنتاجها وتكريس معانيها في أعماق اللاوعي الجمعي، سيما وأنها تتعلق بمنظومة دينية وثقافية تحمل كل عناصر الضدية بالنسبة للمسيحية، وأن ارتباط نمط الإدراك بالخلفية الدينية ينشط آليات المتخيل، يجعل البعد الأسطوري يعيش حياة خاصة يغدو فيها الواقع بعدا يصعب القبض عليه. بل تصبح للأسطورة وظيفة تفسيرية لا يهم فيها إن كانت صائبة أو خاطئة، تعكس الواقع أو تشوهه، مادامت قدرتها على “التمثل تفرض ذاتها على الذاكرة الجمعية وتجثم بكل ثقلها الواقعي على المستقبل. هكذا، تساهم في تأسيس سلوكات في العمق، وبهذه الصفة تغدو مشاركة في الواقع”(31)
تحل الصورة محل الواقع، سيما إذا اقترنت بمشاعر ضدية واندرجت ضمن سياق الصراع على المواقع والمصالح والرموز، صراع يحركه رجال دين وينفده جنود، وتنظم حوله حملات “دعائية” تعطي للآخر صورا “شيطانية” وتجعل منه خطرا محدقا على العقيدة والوجود، يوظف، من أجل ذلك، “الحكايات الشعبية، وقصص الأبطال والحجاج والقديسين، والمؤلفات الجدالية – اللاهوتية الدفاعية للمسيحيين الشرقيين، وشهادات بعض المسلمين، وترجمات مفكريهم وعلمائهم، ولكن كانت المعلومة المقدمة تنتزع في معظم الحالات من سياقها الأصلي، … وبهذا الشكل شوهت الوقائع بصورة متعمدة – واعية أحيانا، أو بشكل غير واع في أحيان أخرى”(32)
هل التعبئة الهائلة التي نظمتها الكنيسة في الزمن الوسيط لخلق أكثر ما يلزم من الصور الشائعة والتأويلات الزائفة والأخبار المغرضة ضد الواقعة الإسلامية، تعكس، بكيفية ما، ذلك الشعور العميق بما يسميه بروديل، “الكراهية”؟ هل العنف المتخيل والقسوة في الحكم على المسلم والإسلام استدعته شروط تنظيم الهجوم المضاد على المد الجارف للفتح الإسلامي؟
يرى أكثر الباحثين الغربيين أن الانتشار الإسلامي الكاسح شكل أكبر تهديد للوجود المسيحي في البحر المتوسط، بل إنه أحدث قطيعة حاسمة بين المرحلة الرومانية التي كانت ترى في المتوسط مركز العالم والفضاء الاستثنائي للمسيحية، وبين عهد جديد أعطى للعلاقات بين الشرق والغرب، جراء التنافس الإسلامي المسيحي، أبعادا عميقة في العقل والوجدان جعلت المؤسسة المسيحية تشعر بحسرة لا متناهية على فقدان وحدتها الجغرافية والروحية. وتندرج الحرب الرمزية والنفسية، من خلال الانتقاص من كل مظاهر الواقعة الإسلامية، رسولا ونصوصا وحضارة وإنسانا، لإعادة بناء الوعي المسيحي بالذات في سياق خلق صور قدحية للآخر، قصد التعويض عن الفقدان الكبير الذي أحدثه الإسلام. لذلك عملت الظاهرة الصليبية، بمراحلها المختلفة، على تكثيف “الصور الأولى، والصور المؤسسة التي كونتها المسيحية الأوروبية عن الدين المنافس”(33)
كثيرة هي الدراسات التي اتخذت من التصور المسيحي الوسيطي للإسلام موضوعا لها، ويهمنا، هنا، أن نتوقف عند الصور النمطية الكبرى التي نسجتها المخيلة المسيحية عن الاسلام ، والنظر في أسباب القوة الهائلة والقدرة التعبوية التي مارستها على النظرة الغربية منذ الزمن الوسيط إلى الآن. ثلاث صور تتكرر، باستمرار، في كل الكتابات الغربية عن الاسلام ، وهي صور بقدر ما تم إبرازها في نصوص بعض رجال الكنيسة، عملت المخيلة الشعبية، من جهتها، على التغني بها والاحتفال بمضامينها “الحربية”.
أولى الصور تتمثل في اعتبار الإسلام دينا وثنيا، وبأن نبوة محمد مشكوك في صحتها وصدقيتها. فالقول بأن محمدا أرسل إلى الناس لتصحيح التحريف الذي طرأ على اليهودية والمسيحية، وبأن كل ما هو جيد في الإنجيل يوجد في القرآن، قول “باطل”، لأن ذلك ينم عن “ادعاء” بل وعن “جنون” أكيد(34). وقد اعتبر رجال الكنيسة أنه يستحيل البرهنة على حقيقة القرآن أو على نبوة محمد، لأن سورا كثيرة في القرآن تتعارض مع نصوص الثوراة والإنجيل التي يدعي استكمالها وتصحيحها. والقصد من التشكيك في نبوة النبي، ونعت الديانة الإسلامية،وكل من يعتنقها، بالشرك ” والوثنية”، يتمثل في الانتقاص من صورة النبي، واعتقدوا أنهم بذلك يطعنون ويحطمون كل البناء الإسلامي(35). ولم يقتصر الأمر على الجدل الكلامي أو على صياغة أحكام القيمة، حتى ولو ادعت “الإطلاع” على النصوص من قبل اللاهوتيين المسيحيين، وإنما تحركت المخيلة الشعبية وغدت تهتم بالآخر، من خلال الإشاعة والنكتة والأغنية. وبرزت، في هذا المجال، ما سمي بـ “أناشيد البطولة”، التي كانت تحكي سير الأبطال والفرسان الملاحم واتخذت من “السارازان” Sarrasin(36) أو المسلم موضوعا لتهييج العامة أو الترويح عليها بتقديم العربي والمسلم بكل الأشكال الانتقاصية.
نسج الغرب المسيحي في الزمن الوسيط خطابا حول الإسلام تداخلت فيه المعلومة المنتزعة من سياقها وواقعها، والخيال المتدفق، بالميل المقصود إلى تشويه الإسلام وتقديمه بكل الأشكال المتناقضة مع ماهيته وأصوله. ففي الوقت الذي نجد الإسلام يتأسس على التوحيد والوحدة كقاعدة دينية وأنطولوجية، يعمل الخطاب المسيحي على الترويج لما هو متناقض لهذه القاعدة، مدعيا كون الإسلام ديانة وثنية، تدعو إلى التعدد، ومؤسسها دجال وساحر، ومنشق، وفي كل الأحوال لا يمكن أن تنطبق عليه صفات النبوة.
“أناشيد البطولة”، ومنها “أنشودة رولان” -وهي الأكثر شهرة- و”غورمون وإيزومبار”، و”تتويج لويس”…الخ، ستقدم الآخر -المسلم- باعتباره تجسيدا لما هو أجنبي، غريب، سلبي ويستحق الإدانة. ستختزل صورة المسلم في كونه ساحرا، له قدرة خاصة على استدعاء قوى الشر. ولما كان الوعي الجمعي، في ذلك الوقت، ينظر إلى أن كل ما هو خارج المجال المسيحي ينتمي إلى عالم الشر، فإنه جعل من المسلم الآخر النقيض بامتياز. قد يكون لهذه الأناشيد طابعا “ترفيهيا”(37) تمكنت بفعل التواثر من الاستمرار أكثر من أربعة قرون، تتميز ببعد شاعري إيقاعي بارز، لكنها، مع ذلك، عبرت، بشكل واضح، عن إرادة مقصودة على تشويه الإسلام وذلك “بجعله غير مقبول، منفر وممقوت”(38). فالجمع بين الإسلام والوثنية يحرك في اللاوعي المسيحي الجمعي الخوف من انتعاش جديد للوثنية التي هددت المسيحية أكثر من مرة، كما ينشط صور “شهداء الإيمان” الذين سقطوا ضحية الفتح الإسلامي للمناطق المسيحية، ويعمق الشعور بضرورة إنقاذ المسيحية من خطر ديانة “ماكرة” وتحرير الأماكن المقدسة من براثينها.
من هنا تكرست الصورة النمطية الثانية عن الاسلام من حيث كونه دينا عنيفا شعاره السيف والحرب والقتال. وهذه الصفات هي ما يمثل النقيض المباشر للمسيحية. فالمسلم يتقدم إلى مساحة الإدراك المسيحي الأوروبي باعتباره رجلا محاربا، شرسا، متوحشا، يقوم بكل أنواع النهب والتنكيل، خالقا بذلك وراءه تعاسة وشقاء لا يوصفان. يمثل الرجل المسلم كل تعبيرات العدوانية. يحركه ميل قوي للقتل. لقد “اعتبرت القوة، على نطاق عام تقريبا، عنصرا مؤسسا للديانة الإسلامية وعلامة بديهية على الضلال”(39). وعلى الرغم من كون المسيحيين الأوربيين كانوا ينظرون إلى هذا الموضوع بهذه الطريقة فإنهم لم يترددوا في تهييئ وتخطيط الحملات الصليبية.
التضخيم من صفة العنف لدى المسلم، ومن خاصية الحرب في الإسلام، عبرا عن إرادة لتبرير العدوان، من خلال التحضير للهجوم المضاد ضد الإسلام. فالمجهود التعبوي العام للإساءة لهذه الديانة يدخل ضمن عملية إنتاج متخيل جمعي حاقد على الإسلام ينشط لدى المسيحي الشعور بضرورة الاستجابة لمحاصرته والانخراط الطوعي لإعادة الاعتبار للمسيحية. وهكذا فإن “الصورة النمطية لا تستمد جذورها من الواقع الذي من الجائز أن يكون قد تعرض لتشويه من طرف الآخر، إنه ينبعث من فكر الآخر، في سياق نية الإساءة، والدفع بالعمل الحربي إلى الغزو”(40).
وفي معرض تساؤله عن الأسباب الحقيقية التي دفعت المسيحيين إلى تحديد الإسلام بوصفه ديانة عنيفة، يلاحظ “جان فلوري” أن ذلك تم في وقت بدأت تظهر به المسيحية بوجه جديد للعدوان والغزو من خلال الظاهرة الصليبية. إذ في فترة كانت فيه، على أرض الإسلام، ولا سيما في إسبانيا وفي “الأراضي المقدسة”، نسبة عالية من التسامح “النموذجي في زمنه”(41) بين الديانات الثلاث، عملت المؤسسة الكنسية على اختيار نهج العنف بتقديم صور شيطانية عن الاسلام قصد تحطيمه والحد من انتشاره، لدرجة أنه مع الزمن، “نمت نوع من البرانويا من الخطر الذي يمثله المسلمون”(42) غير أن الأمر الجذير بتسجيله، في هذا السياق، يتمثل في المنعطف الكبير الذي عاشته المؤسسة الكنسية في القرنين العاشر والحادي عشر، حيث انتهت، بعد صراع ومناقشة طويلين، إلى اختيار العنف كعنصر مذهبي، “ذلك أن الحرب – والمحاربين بالنتيجة- اعتبرت منذ مدة طويلة، بوصفها مسألة مستنكرة في ذاتها، والعنف مستبعد لأنه خطيئة… وبتقديم الخصم في صور شيطانية تمكنت الكنيسة، وخصوصا المؤسسة البابوية، من تبرير الحروب حين تم إعلانها من طرف السلطات العمومية الشرعية وتبنتها للدفاع عن المؤسسات “الإلهية” المهددة… والنتيجة أن “الحروب العادلة” الحقيقية، ثم “الحروب المقدسة” كانت البابوية هي التي دعت إليها لضمان حمايتها الخاصة للمسيحية والتي توسعت شيئا فشيئا. هذا هو أصل سلام الرب والحركة الصليبية”(43)
أصبحت الحرب شرعية في المذهب المسيحي الجديد، “بعد نقاش طويل ومؤلم”(44) تخلل ذلك احتجاجات ومعارضات ضد استعمال العنف الذي دعت إليه وزكته الكنيسة، بل وقادته ضد الإسلام. في نفس الوقت، بالمقابل، وكيفما كان سلوك المسلمين في عمليات الفتح التي قاموا بها، لم يكن موضوع اللجوء إلى الحرب يطرح أي مشكلة لديهم، لأن الجهاد قاعدة مؤسسة للواقعة الإسلامية وقتال المشركين والكفار مطلب ديني. ولهذا فإن دعوة “أوربان الثاني” إلى الحرب لاسترجاع “الأراضي المقدسة” تمثل نوعا من الاهتداء بالتجربة الإسلامية فيما يخص العلاقة بين العنف والإيمان(45)، حتى ولو تعارض الأمر مع التقليد المسيحي الذي كان يرى في المسيح نموذجا للسلم وللرفض القاطع لاستعمال العنف، فمملكته ليست من هذا العالم، وحتى لو اضطر المسيحيون للعيش داخل وسط معاد لا يجب الاعتراض عليه بالعنف، لأن الخلط بين الدين والسياسة مسألة تضر بالدين.
كانت الكنيسة في حاجة إلى تضخيم العلاقة بين الإسلام والعنف للتغطية على التحول المذهبي الكبير الذي طرأ على الموقف المسيحي من الحرب. بل إن “جان فلوري” يتساءل ما إذا كان “تأثير الإسلام قد لعب دورا تشجيعيا على هذا التطور المدهش الذي حصل للمسيحية”(46) لذلك تمت صياغة مبدإ الوعد بالجنة لكل الذين يموتون في المواجهة ضد أعداء الإيمان، أي ضد المسلمين.
وبقدر ما كان الجهاد مبدأ مقررا في الإسلام، فإن الآلة الدعائية المسيحية أعطت لهذه المسألة بعدا دراميا لتقديم المسلم في اكثر الصور شيطانية وشراسة ووحشية من جهة، ولتسويغ قاعدة الحرب كوسيلة ضرورية لتنظيم هجوم مضاد على ما نعتته الأدبيات الكنسية بـ”الأراضي المقدسة” ضد الإسلام من خلال الظاهرة الصليبية من جهة ثانية. حاجة المؤسسة الكنسية إلى ذريعة، أو إلى تخيل نافع”(47) جعلتها تقدم الإسلام كديانة للعنف، والمسلم ككافر ومتوحش وصنو الشيطان.
وأما الصورة النمطية الثالثة التي صاغتها المخيلة المسيحية الغربية عن الإسلام، فتتعلق بحياة النبي وبعلاقاته بالمرأة وبموقفه من المسألة الجنسية. وقد جعلت الآلة الدعائية من هذا الموضوع “الحجة الجوهرية على عدم مقبولية الإسلام بأن يكون نتيجة وحي رباني، وقد تم التعامل معها بوصفها الدليل الأكثر أهمية للرفض المسيحي للإسلام”(48) وفضلا عن الطبيعة الوثنية وعن التكوين العنيف للعقيدة الإسلامية، انخرط الكتاب المسيحيون ورجال الكنيسة في معمعة التجريح والانتقاص، بكل الطرق والوسائل، من النبي باعتباره رسولا وإنسانا. لقد ادعوا أن هذا الرجل “الوثني”، المرتبط بأكثر مصادر الإغراء واللذة، لجأ إلى “حيل ساقطة” للوصول إلى السلطة، مدعيا الاتصال بمنابع الوحي، وحاملا لرسالة دينية جديدة، تدعو إلى تصحيح الديانات السابقة، وإلى الجهاد والعنف. وما انتصار هذه “البدعة” الإسلامية إلا دليل على “مكر” هذا الرجل وعلى جهل كل من اتبع رسالته. فالمجتمع الجاهلي الذي انبثق منه كان مجتمعا “متوحشا يسكنه ناسا عاديين وأميين، بدون نظام ولا حكومة، في المدينة على الأقل، معرض للتأثيرات الخارجية للامبراطورية الرومانية بالشرق، ولكنه مخترق من طرف لاجئين ضحايا الصراعات الكنسية اكثر مما تأثروا بالمبشرين الأورتودوكس… ويمثل محمد النتاج الطبيعي لهذا العالم، مخادع وسط المخادعين أحيانا، ولكنه متلاعب كبير على العموم”(49)
لقد عمل رجال الكنيسة المسيحيين على بناء سيرة ذاتية للنبي خاصة بهم. لعبت فيها المخيلة دورا حاسما في إنتاج الصور واختلاق الأكاذيب. يدمجون بعض التفاصيل القريبة من الصحة في قالب متخيل يجعل من التهويل والتضخيم قاعدته وتوليد النفور والاستمرار غايته. فالنبي عندهم رجل “شبقي”، ينغمس في عوالم اللذة بشكل عبثي. يقول بتعدد النساء وبالتمتع بالحياة معهن. وفي عرف المسيحي الداعي إلى الورع والتقشف والتعالي عن اللذة والامتناع عن الزواج، يمثل هذا السلوك قمة التفسخ والانحلال الخلقي، وما هو ما استغلوه، في كتاباتهم للتشكيك في نبوة الرسول، مدركين أن الهجوم عليه، وعلى المسلمين الذي اتبعوه، يمثل أحسن وسيلة لتقديم صورة شائهة عنه، ولتدمير صدقية رسالته.
لبناء هذه الصورة النمطية التجأت المخيلة المسيحية الغربية إلى استثمار كل أشكال التجريح والدعاية. وفي هذه الصورة، كما في الصورتين السابقتين، ينشط المتخيل بشكل لا حدود له قياسا إلى واقعية الأمور. لقد نعت المسلمون بكونهم يمارسون الشذوذ الجنسي، ولا يتورعون في جعل الجنس مسألة حيوية في علاقاتهم ووجودهم. وهذا ما يعبر عن ضعفهم وعجزهم عن التحكم في غرائزهم وأهوائهم. فكيف لنبي، ولمن اتبعه، أن يدعي الإتيان بمشروع إلهي وهو غير قادر على الترفع عن غرائزه البسيطة والتحرر من إغراءات اللذة والحياة العابرة؟
هل السلوك الواقعي للمسلمين هو الذي مثل المرجع الأولي لهذه الصورة؟
للجواب عن هذا السؤال يعتبر أحد الباحثين أن اتهام العرب والمسلمين بالشذوذ الجنسي اتهام وارد في كتابات مسيحية، في الشرق والغرب، بل ويوجد حتى في بعض النصوص العربية. ولكن هل هذه الممارسة خاصية إسلامية أم أن المجتمع المسيحي في الفترة الوسيطة شهد سلوكات من الجنسية المثلية أيضا، بل أن الأسياد والأمراء لم يكونوا يترددون في تمتيع أنفسهم بما لذ وطاب من النساء والرجال، “فالتجاوزات الجنسية لم تكن منعدمة لا في الغرب ولا في الشرق، حتى ولو كانت متسترة”(50) غير أن المذهب المسيحي الرسمي في الجنس يدعو إلى الترفع عن الملذات الدنيا و الإعلاء من شأن العذرية بالنسبة للنساء (الراهبات) والعزوبة عند الرجال (الرهبان..)، ذلك “أن الفوبيا الحقيقية لدى الرهبان إزاء الجنس، مثلت المصدر الأولى للخطيئة، وانتشرت شيئا فشيئا داخل الكنيسة وأثرت حتى على بعض العلمانيين”(51)
لتعزيز الصورة القدحية عن الاسلام التجأت الكتابات المسيحية إلى استدعاء نماذج متعارضة. وهكذا “فالنبي محمد محارب عنيف، في حين أن المسيح لطيف ومسالم، ثم إن المسيح ورع وأعزب وأما محمدا فهو طالب لذة ومتعدد النساء”(52)
قد يعتبر المسيحي الغربي المطلع على السيرة الذاتية للرسول، أن القول بالعنف واللذة وتعدد النساء مسائل لها أساس من الصحة، لأن الإسلام يدعو إلى الجهاد، ويشجع الرجال على التمتع بالنساء…الخ وهذه مسائل قد لا تتعارض مع الفهم الإسلامي المشترك، إلا أن الوصف المطلع يخفي إرادة مقصودة على الاستخفاف وتقديم الأمور بطريقة كاريكاتورية مضخمة. فالمخيلة المسيحية كانت تبرز ما يمثل الجوانب “الفضائحية” في الإسلام قياسا إلى الأخلاقيات الكنسية المسيحية في ذلك الوقت. وهكذا نجد أنفسنا أمام صور نمطية “تخلق انطلاقا من وقائع حقيقية، مشوهة بشكل ما، تقدم للآخر صورة لا تقل كاريكاتورية لأنها تركز على بعض جوانب العقلية الإسلامية التي تصدم داخل جماعة في الوقت الذي تقبل من طرف الجماعة الأخرى بدون صعوبة”(53)
لقد ظهر الإسلام للغرب المسيحي وكأنه ديانة تدعو إلى الشبقية والشهوانية. وضخم الرهبان ورجال الكنيسة في ذلك، بشكل مثير. ويرى “جان فلوري” أنه حتى ولو اطلعوا، بالفعل، على السلوك الحقيقي للنبي، لأصدروا في حقه نفس الأحكام ولانتقصوا من صورته وحياته ورسالته، لأن المسألة تدخل في الأول والأخير ضمن صراع شامل كان يتعلق بالوجود المسيحي نفسه في حوض البحر المتوسط وجنوب أوروبا. فالصور النمطية الانتقاصية، والقدحية التي اتخذت من الإسلام موضوعا لها حركتها الرغبة العارمة في خلق “رأي عام” مسيحي ينفر من الإسلام ويشمئز من المسلمين وهي صور “دعائية سلبية، استخفافية تتغيا جمع المسيحيين حول القيم الذي تظهر لهم مشتركة. وللرفع من شأن هذه القيم وتبرير الكفاح من أجلها ركزت هذه الصور على القيم المضادة الموازية التي مثلها الإسلام”(54).
للاستجابة لهذه الحاجة ركزت الدعاية المسيحية على “حياة محمد دون الاهتمام بمدى دقة ما يقولون عنه، تاركين المجال حرا لما أسماه “سودرن” بـ”جهل المخيلة المنتصرة”. فمحمد كان ساحرا عمل على تدمير الكنيسة في إفريقيا والشرق بواسطة السحر والخداع وأثبت انتصاره بالسماح للتعدد والاختلاط الجنسي”(55)، كل الوسائل جائزة بالنسبة للآلة الخيالية الهائلة لإنتاج الصور والحقائق المشوهة عن الاسلام والمسلمين. وعلى الرغم من الإمكانيات الكثيرة للقاء والتبادل، وحتى الإطلاع، فإن الإدراك الأوروبي للآخر تم بشكل تدريجي وبطيء، ولكنه استمد عناصره من مخيلة ترفض النظر إلى الواقع كما هو، وإلى الحقائق كما تتشكل على الأرض، منتجا بذلك صورا نمطية تصر على تقديم الآخر في جوانبه المنفرة، حتى صار الإسلام علامة على كل ما هو فضائحي.
لم يكن الأمر يتعلق بفضول معرفي أو بإرادة للمعرفة، وإنما بخضوع الآخر-الإسلام إلى أكثر معايير المتخيل قدرة على قلب الأمور وتشويه الوقائع والتشويش على العقل. وهكذا “بقي الإسلام موضوعا لتمثل متخيل أكثر منه موضوعا للمعرفة الموضوعية”(56) والسبب في ذلك يرجع إلى الموقف الكنسي المعادي للآخر، الذي تميز بكل مظاهر “البارانويا” اتجاه الإسلام، بل أن المسيحية الغربية نسجت هذه “الأسطورة” وهي تعيش داخل “عالم مغلق، تنقصه المعلومات، منكفئ على ذاته كما على معرفته الخاصة. عالم حيث تتسرب المعلومات الخارجية، بشكل مشوه، حتى وإن كانت مختزلة وفقيرة”(57). ففي الوقت الذي كانت الواقعة الإسلامية تقدم كل صور الانفتاح والتبادل، العنيف أو المتساكن، كان العالم المسيحي يعطي انطباعا بأنه عبارة عن قلعة محروسة من كل جانب. “وخارج اختلاف الأشكال والفترات والأمكنة، كان الإسلام حاضرا باستمرار، وهو ما جعله يمثل ظاهرة كبرى. وأما الحوار الطويل الذي كان على الغرب أن يقيمه مع خصمه فقد تم تدشينه من خلال تبادل حربي، وجه المناقشة، بسرعة، في اتجاه جديد مؤثرا، بشكل مستديم، على العقليات الوسيطة…لقد تم الانتقال من الجهل المتبادل إلى مرحلة العنف والحرب”(58)
ومع ذلك تمكن الغرب المسيحي من صياغة صور خاصة به عن الاسلام ، فبالإضافة إلى صفات الوثنية والعنف والشذوذ الجنسي، منحت الاجتهادات المسيحية إلى تخيلها العام خصائص أخرى تتعلق باللون وبالسلوك. فالمسلم -أو السارازان- ليس محاربا فظا، ومتوحشا فحسب، بل يتميز، أيضا، بلون جلده. “زنجي، ورجل أسود. إنه الشيطان، أو بالأحرى تعبير شيطاني”(59) ذو نزعة تدميرية، لا يترك وراءه إلا الشقاء والخراب. لم تكتف المخيلة المسيحية بتضخيم وتشويه عقيدته وسلوكه ونمط حياته، بل أضافت اعتبارات “سميولوجية” تتعلق بلونه وهيئته، لدرجة كثف فيها المسلم، في العصر الوسيط، مخاوف وهلوسات اللاوعي الجمعي المسيحي ومثل أكبر مصدر للخوف شهدته الأوساط المسيحية في ذلك الوقت.
تعزيز الوعي المسيحي بالذات كان في حاجة إلى تقديم الآخر في أكثر أشكاله عدوانية وتشوها.و التأكيد على خصوصية الهوية المسيحية الأوروبية افترضت، في سياق الإدراك الوسيطي، التبرم من العربي المسلم. وعلى الرغم من الفروق الممكن تسجيلها بين النخبة الكنسية المشدودة إلى استراتيجية المؤسسة البابوية وبين “الرأي العام” فإن المتخيل المسيحي تمكن من بناء صور نمطية خاصة بالإسلام سواء من خلال الكتابات والتقارير أو بواسطة وسائل التعبير الشفوية المختلفة، وعلى رأسها الغناء.(60) وفي كل الأحوال فإن النظرة العامة التي تمت صياغتها يطغى عليها الجانب “الافتراضي” التهويلي، لسبب أساسي هو أنها اعتمدت، في نسج مكوناتها وتفاعلها، على “فهم خارجي” للآخر(61)
ثلاث صور نمطية كبرى صاغها الوعي والمخيلة المسيحية الغربية في الزمن الوسيط عن الاسلام ، الوثنية والعنف والشبقية، بكل ما يفترض ذلك من كفر وتوحش وانحلال. بهذه الصور تمت عملية بناء خطاب مسيحي عن الاسلام ، يحتل فيه الخيال والجوانب الفانتازية “مكانة بارزة. ولذلك لا تخلو الكتابات الغربية المعاصرة عن هذا الموضوع من تأكيد على أن الخطاب المؤسس للنظرة المسيحية الوسيطة للإسلام ارتهن بقاموس لفظي ورمزي للوهم والمتخيل فيه دور حاسم. فالوعي الضدي بالآخر، والإدراك القوي للمنافسة” وما يفترضه ذلك من الاحتفاظ بالوجود، ولدا لدى المؤسسة الكنسية الشعور بضرورة القيام برد الفعل، والتجأت من أجل تحقيق ذلك إلى كل الوسائل لشحن المتخيل الجمعي بالصور المضادة للحقيقة المسيحية، سواء تقدمت هذه الصور في شكل صور متخيلة” تشوه الإسلام باعتباره عقيدة، أو “صور-كاريكاتورية” تضخم بعض الجوانب الواقعية وتصوغها في قالب منفر ولا أخلاقي، أو في “صور انتقائية”(62) تجعل من بعض المواقف الإسلامية، ولا سيما في موضوع الجنس، فرصة للتهويل، وذلك كله قصد إنتاج ردود أفعال رافضة للإسلام في كليته، وخلق شروط تعبئة نفسية ومعنوية لمحاربته. فالدعاية التهويلية، المكرورة حين تركز على الاختلافات والتناقضات، تولد مشاعر النفور والاستبعاد والرغبة في اللجوء إلى العنف. وذلك ما جسدته الظاهرة الصليبية في أبعادها الدينية والعسكرية والتخييلية ·
مجلة الجابري – العدد الخامس
هوامـش
1 – Fernand Braudel, La méditerranée, l’espace et l’histoire, Ed. Flammarion, Paris 1985, pp. 163-164.
2 – F. Braudel, op.cit, p. 160.
3 – Christopher DAWSON, Les origines de l’Europe et de la civilisation européenne, les Editions Rieder, Sans date ni lieu d’edition, p. 145.
4 – Alain Ducellier, Les imaginaires de l’Islam dans l’Orient chrétien au Moyen Age, Horizans maghrébins, N° 14/15, 1989.
5 – F. Braudel, op.cit, p. 167.
6 – Ibid, p. 168
7 – Ibid, p. 173.
8 – F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, T.2, Ed. Armand Colin, 6ème Edition, 1985, Paris, p. 95.
9 – F. Braudel, La méditerranée, L’espace et l’histoire, op.cit, p. 160.
10 – Christopher DAWSON, op.cit, p. 409.
11 – Contre-Amiral.R. De Belot ( R), La méditerranée et le destin de l’Europe, ed. Payot, Paris 1961, p.50.
ويعتبر صاحب هذا الكتاب أن احتفاظ المسيحية بأوروبا بفضل معركة “بواتيي” حقيقة استراتيجية، وحين سقطت بيزنطية في القرن الخامس عشر في يد الأتراك، حينذاك كانت أوروبا قوة صاعدة، تمكنت من صد الاختراق التركي بدون خوف على مستقبل الكيان الأوروبي الناشئ.
12 – يرى بروديل أن الطوباويين وحدهم يمكنهم أن “يحلموا بصهر الديانات فيها بينها: فالديانات، هي بالضبط اكثر الأمور شخصية، وأكثر العناصر مقاومة داخل مركب الثروات والقوى والأنظمة التي تمثلها الحضارة. يجوز الجمع، جزئيا فيما بينها، ونقل هذه الفكرة ومن هذه الديانة إلى تلك، أو هذه الدوغما أو تلك، أو هذا الطقس أو ذاك، ولكن أن يتم المزج بينها، فذلك ما يشكل طريقا في منتهى الشساعة”.
13 – F. Braudel, op.cit, p. 173.
14 – W. Montgomery Watt, L’influence de l’Islam sur l’Europe médiévale, Ed. Librairie orientaliste Paul Genthner, 1974, Paris, p. 67.
15 – Ibid, p. 97.
16 – Jean-Jacques Weardenberg, L’Islam dans le miroir de l’Occident, comment quelques orientalistes occidentaux se sont penchés sur l’Islam et se sont formés une image de cette religion, Ed. Monto, La Haye, Paris, 1962, p.5.
17 – W. Montgomry watt, op.cit, p. 97.
18 – Ibid, p. 97.
19 – Ibid, p. 97.
20 – Simon Jargy, Islam et chrétienté, Ed. Labor et Fides, Genève, 1981, p.9.
21 – دانييل ساهاس، الشخصية العربية في الجدال المسيحي مع الإسلام، الاجتهاد، العدد 28، 1995، ص 126-127.
22 – نفس المرجع، ص 128
23 – نفس المرجع، ص 129
24 – ألكسي جورافسكي، الإسلام والمسيحية، ترجمة خلف محمد الجراد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1996، ص 71.
25 – نفس المرجع السابق، ص 73
26 – نفس المرجع، ص 73
27 – نفس المرجع، ص 70
28 – نفس المرجع، ص 75.
29 – لم تكن الكنيسة المسيحية منسجمة ولا موحدة، وكانت هناك فوارق عقائدية ومؤسسية كبرى بين الكنيسة الشرقية والمسيحية الأوروبية، لدرجة أن زوج “شرق-غرب” كان يعبر المسيحية نفسها قبل أن تنهض شروط التعارض بين الإسلام والمسيحية. ولأن تأويلات مختلفة كانت تعتمل داخل العقيدة المسيحية، فإن ما يهمنا، نحن هنا، هو الصور المشتركة التي أنتجتها المخيلة المسيحية حول الإسلام.
30 – Maxime Rodinson, La fascination de l’Islam, Ed. La découverte, Paris, 1989, p. 35.
31 – Theirry Hentsch, L’Orient imaginaire , la vision politique occidentale de l’est méditerranéen, Ed de Minuit, Paris, 1988, p.18.
32 – أليكسي جوارفسكي، الإسلام والمسيحية، نفس المعطيات السابقة، ص 69. ويقول باحث آخر أيضا: “أن الأقاويل عن آلام المسيحيين الشرقيين في ظل حكم السلجوقيين وعن العقبات التي أقاموها في وجه الحجاج هي بقدر كبير، اختلافات باطلة تفتق عنها خيال كتاب كنسيين… فأحيانا كثيرة كانوا قصدا وعمدا ينشرون الإشاعات عن مآثم السلجوقيين من كل شاكلة وطراز ضد المسيحية… لكي تسهم الإشاعة عن الخطر الذي يشكله “الكفار” على الأماكن المقدسة في تدفق قوات مسلحة جديدة من الغرب..”، ميخائيل زابوروف، الصليبيون في الشرق، ترجمة إلياس شاهين ، دار التقدم، موسكو، 1986، ص 35.
33 – Theirry Hentsch, op.cit, p.45.
34 – Norman Daniel, Islam et Occident, traduit par Alain spiess, Ed. Du Cerf, Paris, 1993, p. 49.
35 – Ibid, p. 100.
36 – يعتبر “نورمان دانيال” أن “سارازان” تعني الإنسان الذي ينتمي لنفس ديانة محمد، أي مسلم”، نفس المرجع، ص 34.
في حين أن البعض الآخر يرى أن “سارازان” ترجع إلى لفظة “شرقي”،
أنظر: Philipe Sénac, Musulmans et Sarrasins, dans le Sud de la Gaule du VIII au XI. Ed. Le Sycomore Paris 1980, p. 63.
37- Norman Daniel, Sarrasins, chevaliers et moines dans les chansons de geste, Mélanges, MIDEO, n° 17, 1986, p. 115.
38 – Jean Flori, Radiopraphie d’un steréotype: la caricature de l’Islam dans l’Occident chrétien: sens et contreseus, in Maroc-Europe, n° 3, 1992, p.94.
ويرى هذا الباحث أن تأجيج مشاعر الاشمئزاز من “الوثنية السارازانية” ثم في وقت بدأت تنمو فيه داخل المسيحية الغربية أشكال من الوثنية مثل تقديس الأولياء والأنصاب…الخ. فإبراز “عيوب” الديانة الإسلامية في أناشيد البطولة “كان يخدم صراعا داخليا، أيضا ضد بعض مظاهر الشعودة.
39 – Norman Daniel, Islam et Occident, op.cit, p. 151.
40 – Jean Flori, op.cit, p. 97.
41 – Norman Daniel, op.cit, p. 152.
42 – Jean flori, op.cit, p.98.
43 – Jean Flori, op.cit, p.99
44 – Ibid, p. 99
45 – Ibid, p. 102.
46 – ويلاحظ “جان فلوري” أن مجموعة كبيرة من الكتاب واللاهوتيين المسيحيين عبرت عن استغرابها أمام هذا “المذهب العجيب” -الإسلام- الذي كان يبشر الشهيد بالجنة لأنه يقوم بواجب ديني ضد المشركين والكفار، في حين أن النموذج الرهباني، متجرد عن العالم ويستبعد العنف المسلح، قد فرض نفسه على الغرب، قبل أن تتسرب الدعوة إلى العنف، شيئا فشيئا، إلى دواليب المؤسسة الكنسية.
47 – Philip Senac, musulmans et Sarrasins…op.cit, p. 63
48 – Norman Daniel, Islam et Occident ,op.cit, p. 115.
49 – Norman Daniel, op.cit, p. 123.
50 – Jean Flori, op.cit, p. 103
51 – Ibid, p. 103.
وقد ترتب على ذلك انتقاصا حقيقيا من الحب الجسدي لدرجة اعتباره نتيجة غواية شيطانية وربما لهذا السبب ظهر “الحب العذري” في المجتمع الوسيطي كرد فعل إزاء هذه القناعة.
52 – Jean Flori, p. 104.
53 – Jean Flori, op.cit,, p. 107
54 – Ibid, p. 107.
55 – Maxime Rodinson, La fascination de l’Islam, op.cit, p. 41.
56 – Philipe Senac, L’image de l’Autre, histoire de l’Occident médiéval face à l’islam, Ed. Flammarion, Paris, 1983, p.98.
57 – Philipe Senac, op.cit, p.17.
58 – Ibid, p. 22
59 – Philipe Senac, Musulmans et Sarrasins dans le Sud de la Gaule du VIII au XI siècle, op.cit, p. 63.
60 – بخصوص الفرق في النظر إلى المسلم بين النخبة الكنسية و “الرأي العام” المسيحي، انظر التحليل الذي قام به “نورمان دانيال” في:
Norman Daniel, Sarrasins, chevaliers et moines dans les chansons de gestes et aussi, la persistance des perceptions médiévales du Monde Arabe in, d’un Orient l’Autre, Ed. C.N.R.S. Paris, 1991, pp. 75-76.
61 – Norman Daniel, Sarrasins, chevaliers, op.cit, p.112.
62 – Jean Flori, op.cit, pp. 108-109.