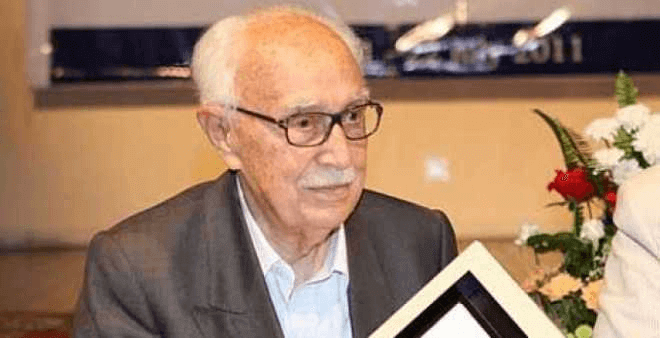تكتسي الجمل الأولى في المحكي الروائي أهمية مزدوجة: فهي، من جهة أولى، تمثل جسرا نصيا يتم فيه شروع القارئ في الانتقال ذهنيا من عالم الأشياء، إلى عالم الكلمات، أي من عالم الحقيقة إلى عالم التخييل. وغالبا ما يرافق هذا الانتقال -الذي يمنح الذات القارئة وجودها الفعلي بعد أن كانت موجودة بالقوة فقط- إحساس غامض لديها بالعسر والارتباك قد يثنيها قبل الأوان عن مواصلة القراءة. ويرجع ذلك إلى أن القارئ، لحظة بداية اقتحامه للنص، يكون بعد مشدودا إلى عالم حياته اليومية، وأن مبارحته له، باعتبارها تخطيا لهوية وجودية حقيقية، لن تكون إجراء عاديا ولا بسيطا.
ثم هي، من جهة ثانية، تمثل عتبة استراتيجية يتم فيها شروع النص نفسه في التخلق والوجود كخطاب متصل، أي في المرور من مجال الواقع إلى مجال الخيال، من الماقبل إلى المابعد، وذلك بوساطة محفل سردي سيمكن هذا النص من الانبساط التدريجي كديمومة خطابية في فضاءي الكتابة والقراءة.
ونظرا إلى ذلك، فقد بدأ النقد في الأعوام الأخيرة يولي الجمل الأولى في النص الروائي منتهى الاهتمام، حيث حدد أشكالها المختلفة باختلاف البنية التلفظية الشاملة التي تندرج فيها، وعين وظائفها المتنوعة بحسب الجمالية الروائية التي يستند إليها هذا النص. لا جمله الأولى فحسب، بل كذلك جمله الأخيرة بما هي فضاء ختامي يستأذن فيه المحكي القارئ في الانصراف عنه، فينغلق على صدى أو ذكرى نص سيظل عنوانه رمزا كنائيا يشهد عليه.
وإسهاما في توضيح هذه الأهمية المزدوجة، سأفحص في روايات عبد الكريم غلاب(1) جملها الأولى فقط التي استهلت بها ملفوظها الحكائي، والتي سأدعوها “مطالع” (كترجمة لـ “incipits“)، حيث سأسعى إلى تنميط أشكالها وتحديد وظائفها ودلالاتها وتحليل رهاناتها، دون اهتمام الآن بجملها النهائية التي أدعوها “مقاطع” (كترجمة لـ “clausules” أو “explicits” أو “exipits“).
ومن باب الاستطراد الذي لا يفتقر إلى الملاءمة، يجمل الإلماح إلى أن الخطاب النقدي والبلاغي العربي القديم قد عني بـ”مطالع” النص الشعري، (أو “ابتداءاته” و”استهلالاته” و”افتتاحاته”)، من حيث انتهاجها لآثار أسولبية، ذلك أن “حسن المطالع والمبادئ دليل على جودة البيان، وبلوغ المعاني إلى الأذهان، فإنه أول شيء يدخل إلى الأذن، وأول معنى يصل إلى القلب، وأول ميدان يجول فيه تدبر العقل”(2). ووعيا من النقاد بأهمية الترابط العضوي بين المطالع والمقاطع -حيث تصوروا “أول الشعر مفتاحا له وآخره قفلا له”(3)– فقد اشترطوا في كل “من نظم شعرا أو ألف خطبة أو كتابا أن يفتتحه بما يدل على مقصوده منه، ويختمه بما يشعر بانقضائه، وأن يقصد ما يروق من الألفاظ والمعاني لاستمالة سامعيه”(4).
* * *
بين الماقبل والمابعد:
تكتنف مطلع “سبعة أبواب”، مثل كل استهلال روائي، مشكلة الحد الذي ينتهي عنده. وهي المشكلة التي تنحل من تلقاء ذاتها بالاستناد إلى نص المطلع نفسه. بالفعل، تعلن نهاية المطلع عن نفسها بالتحول من صيغة الخطاب التي تميز عتبة الرواية (“لم تكن المرة الأولى التي عرفت فيها السجن، ولذلك لم أكن لأتهيب السجن كما يتهيب الأطفال باب المدرسة لأول مرة، ولم أباغت بالسجن يصدر حكما من فم القاضي أو رئيس الشرطة، كما يباغت الخارجون عن القانون حينما لا يتوقعون نتيجة ما يرتبكون، بل إني كنت أسعى إليه عن عمد وسبق إصرار كما يقول رجال القانون” (ص 9) إلى صيغة سردية خالصة تنفتح بقول السارد-المؤلف/ “واقتربت محنة عشرين غشت، وابتدأت تتجمع نذر الكارثة في الآفاق”(ص11). فكأن هذا الاقتراب إيذان بالابتعاد عن روح التعليق التي تطغى على الخطاب، وهذا الابتداء مؤشر على انتهاء نبرة التقرير التي تطبعه.
ولعل الانطباع الفوري الذي يرتسم في ذهن المتلقي، لدى مباشرته اقتحام مطلع الرواية، هو أن هذه، باعتبارها جوهرا نصيا في طور الوجود، أي في بداية تخلقها، تحيل على جوهر آخر غير نصي يتمتع بوجود قبلي، وذلك بدليل أن ابتداءها بهذا الملفوظ: “لم تكن المرة الأولى التي عرفت فيها السجن” يفيد ضمنيا بأن السارد قد عرف السجن من قبل مرات عديدة. وهذا يعني من جهة أن السارد -ومعه القارئ المفترض- ما يزالان متعلقين على نحو وثيق بعالم سابق على السرد والكتابة هو عالم الواقع، ويعني من جهة أخرى أن ملفوظ المطلع هو ذلك المجاز النصي الذي يعبر فيه كل من السارد والمسرود له من عالم الواقع ذاك إلى عالم التوقع، أي عالم التخييل الروائي، مما يجعله في موقع التخم.
وكما هو شأن سائر المطالع، فإن هذا العبور قد تم بنوع من العسف والعنف. فالنص لا يدشن محكيه مثلا بإعداد القارئ لاقتحام عالمه بتعابير مثل “يحكى أن …”، بل يحتال في اقتلاعه من واقعه وقذفه بقسوة إلى واقعه الخاص. وسيكون هذا القارئ في آن واحد ذات التجربة التي سيعيشها -بحكم رجحان تماهيه مع الأنا المتلفظة- وذاكرة لما عاشه، بحيث إن الكلمات التي سيشرع في قراءتها، من دون أن تكون له بعد مرجعية أخرى غير مرجعية العالم الذي يكتنفه والذي سيبارحه بعد حين، تفترض أن بينه وبين النص تجربة مشتركة تتعلق بعالم الممكن والمحسوس.
فلئن كان هذا المطلع يحتل، مثل كل مطلع، موقع التخم كما تقدم، أي “الحد بين الصمت والكلام، بين الماقبل والمابعد، بين الغياب والحضور”، فإن هذا “لا يعني الحد بين العدم والوجود، [ لأن ] أي عمل أدبي لا ينبني على العدم. فلا يمكن للشروط التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والإيديولوجية والفكرية والنفسية واللغوية التي تسبقه أن تكون فراغا”(5). بالفعل، تعلن “سبعة أبواب” عن انخراطها في التخييل بواسطة متوالية خطابية استهلالية ذات نبرة مزدوجة تختص بها عادة لغة التأملات والخواطر: نبرة استطرادية (“كنت إذن أعرف المصير وأسير في طريق السجن راضيا مطمئنا. وقد دهشت حقا إذ مرت مناسبات مهمة لتصفية الاستقلاليين والمثقفين والعاملين، ولعزلهم خلف الأسوار العتيدة أو وراء الأسلاك الشائكة والمراكز المنعزلة. ولكنني رغم الدهشة كنت أو من بأن دوري آت لا ريب فيه” (ص 10)، ونبرة تقريرية (“وكانت الشهور المشحونة بالتيارات تتجمع في الأفق لتنذر بالكارثة، تؤكد أن المصير هو باب السجن” (ص 9). وتبرز هذه المتوالية الخطابية على خلفية ضمنية من الإشارات المادية المشتركة بين القارئ والنص، والتي تدل على مناخ تاريخي واجتماعي ما، وتحدد بالتالي عتبة إدراك معين. فإضافة إلى كونها فضاء يتحقق فيه “أثر الواقع” بامتياز-مما يعني أن النص يوحي منذ مطلعه بأنه ما يزال مشدودا إلى ما قبل النص-فهي (أي تلك المتوالية) فضاء يعكس سياقا سياسيا محددا في لحظة تاريخية محددة كذلك، ألا وهما “ثورة الملك والشعب” في غشت 1953، ومساهمة المؤلف- السارد في إشعال فتيل تلك الثورة، وهو ما قاده إلى السجن، إيمانا منه بضرورة الالتزام بقضية الوطن واتخاذ موقف ضد قوى النكوص والخيانة.
ولا ريب في أن ما يقوي أثر الواقع في المطلع هو أن السارد لا يباشر فقط وظيفة الحكي، بل يتجاوز ذلك إلى التورط في الأحداث المحكية، مستعملا ضمير المتكلم. فهو إذن سارد “داخل-حكائي” (intradiégétique) حسب اصطلاح Gérard Genette(6) أي مشخص في المحكي. وقد خولته هذه الصفة تبئير السرد على ذاته دون سواه من الشخصيات أو الأماكن أو الأزمنة. فزيادة على إهماله تحديد مكان الحدث المحكي في المطلع وزمانه -مما يعني تأجل سيرورة الانتقال من الواقع إلى المتوقع- فهو يستأثر بامتياز البروز على حساب باقي الشخصيات، متخذا من نفسه بؤرة لخطابه. ألا يتعلق الأمر في “سبعة أبواب” بـ”ذكريات تصور تجربة حية عاشها الكاتب فعلا، وهي تجربة السجن ستة أشهر رهن التحقيق أيام الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي لتحرير الوطن المغربي من سيطرته” كما ورد في غلاف الكتاب؟ لذلك، فهو الأنا الساردة والأنا المسرودة في آن واحد، مما أعطى لخطابه نسبة عالية من قابلية التصديق. فكأن مهمته تتعدى السرد الموضوعي لتجربته إلى الإدلاء بشهادة منزهة عن الافتراء والمغالاة. فهو بمثابة “شاهد أو مؤتمن على أسرار أو ملاحظ يحول حضوره النص إلى محاكاة للواقع غير مشكوك في أمانتها”(7).
يتضح إذن أن ما يميز هذا المطلع، بسبب إحالته على عالم جاهز موجود قبل فعل الكتابة، وبحكم طبيعة محفله السردي ونوعية سجله التلفظي، هو كونه فضاء ينبض بآثار الواقع الذي يبدو أن المحكي يتردد في مبارحته من أجل ارتياد آفاق السرد التخييلي. لذلك، ليس غريبا أن يستنفر في المتلقي كفاية قرائية إحالية، تجعله منجذبا بقوة نحو الأنا المتلفظة إلى حد التذاوت معها، وأن يضطلع بالتالي بوظيفة تحقيق التواصل بين النص وهذا المتلقي، التي تزدوج بوظيفة مناورته من أجل إغرائه باقتحامه، خاصة وأن توسل المطلع، وكذا المحكي كله، بضمير المتكلم، كفيل بتحويل القارئ من ذات مستهلكة للنص إلى ذات منتجة له ومتورطة فيه.
تنصص الواقع:
لعل ما يؤشر على نهاية المطلع في “دفنا الماضي” هو ذلك التحول الواضح من سجل الوصف إلى سجل السرد(8). فالرواية تفتتح متخيلها بمطلع وصفي طويل يبتدئ بمستهل الفصل الأول: “كان حي المخفية بمدينة فاس مقر عائلة (التهامي)، وهي عائلة بورجوازية موسرة من هذه العائلات التي كان لها حظ من مال وحظ من جاه وحظ كبير في التشبث بالتقاليد والمحافظة على الوقار في المجتمع الضيق الذي تعيش فيه. وهو مجتمع لا يخرج عن الحي الذي تسكنه العائلة” (ص 7)، وينتهي بمستهل الفصل الثاني: “كان الحاج محمد يخرج من منزله في الصباح الباكر إذا لم ترهقه شدة البرد وغزارة الأمطار، فقد ألف منذ كان شابا أن يشهد الحي وهو يفيق من نومه وهدوئه، تنبعث الحياة هادئة ناعمة في أوصاله كما تنبعث اليقظة في أوصال الرجل وهو يتمطى فيه فراشه ويتسلل من نومه” (ص 13). ويسعفنا فحص هذين الحدين النصيين على تلمس الانتقال من سجل إلى آخر. فهما، رغم ائتلافهما في الابتداء بفعل مشترك، يختلفان بسبب المضمون الدلالي والوظيفي لهذا الفعل في كل من الحالتين: فإذا كان الملفوظ الأول يبتدئ بـ “كان” بما هو فعل كينونة خالص يصف فضاء الحي بالمقر الذي يحتضن شخصيات الرواية، فإن الملفوظ الثاني يبتدئ بـ “كان” بما هو فعل ديمومة محض يسرد حدثا تعودت على فعله شخصية الحاج محمد، وهو خروجه مبكرا كل صباح للتمون، مما يجعله، بتعبير Genette، ملوفظا “إعاديا” (itératif)، أي “يقص مرة واحدة حدثا وقع مرات عديدة”(9).
ويعتبر هذا التحول اعتياديا في رواية واقعية مثل “دفنا الماضي”. فهي، قبل شروعها في السرد، و “لأسباب تتعلق بالتثبيت الإحالي وببروتكول القراءة”(10)، تنصب على عتبتها الإطار المرجعي الذي سيتحقق فيه ما يدعوه Claude Duchet “تنصص الواقع”، أي تحوله إلى نص حكائي بوساطة خطاب وصفي يحدد صورة المكان والزمان والشخصية، وذلك بحسب “إجراءات مشفرنة تنظم طقوس المرور من واقع (العالم) إلى واقع آخر (النص)، على نحو يتم به تجهيز الفضاء (قبل الحكائي) بما يكفي من الكثافة والعمق ليكون للقصة ماض ونقط تثبيت وإحالات تضمنها. هذا في الوقت ذاته الذي يوحي فيه هذا الفضاء بأنه موجود من تلقاء نفسه كامتداد لواقع جاهز وانقطاع عنه في آن واحد”(11).
وتؤلف هذه الإجراءات بلاغة استهلالية تتكفل مباشرة بالجواب عن أسئلة النص المحورية: من يفعل الحدث أو ينفعل به؟ أين يقع؟ ومتى وقع؟
-ففي الوقت الذي يشرع فيه صوت السارد في التلفظ (يناظره شروع مسرود له في التلقي)، تبدأ في التخلق صورة الشخصية التي ستشكل سناد الحدث الأولي. ففي المطلع تصوير مسهب لعميد عائلة التهامي الحاج محمد يهم هيئته البدنية ومظهره الخارجي بحسب الفصول وسلوكه “المستوفي لشروط الوقار والاحترام” (ص 11).
-كما تتحدد في المطلع صورة المكان الذي ستظهر على خلفيته الشخصية هذه، سواء كان هذا المكان حيزا جغرافيا رحبا هو حي المخفية بفاس الذي تستوطنه عائلات “اكتسبت حظا من الثراء وحظا من الجاه” (ص 7)، أو كان قصرا بهذا الحي “توارثته عائلة التهامي(…) تحالف عليه القدم والبلى (…) وتعاقبت على سكناه أجيال” (ص 8)، أو كان فضاء رمزيا يعكس قيم “التشبث بالتقاليد والمحاكمة والمحافظة على الوقار” (ص 7).
-أما الزمن، فيطابق زمن القصة الذي يمكن لملمة عناصره انطلاقا من قرائن نصية غير مباشرة منبثة في النسيج الوصفي للمطلع.
ويقوم بتحبيك هذا الإطار، الذي “يصور نموذجا متناهيا لعالم غير متناه”(12)، سارد “خارج-حكائي” (extradiégétique) بلغة Genette(13) أي غير مشخص في المحكي. وهذه الوضعية تسمح له بمعرفة كل شيء عن كل شيء، مما يبرر تقصيه في تصوير الحي وسكانه وعاداتهم وقيمهم وكذا القصر ومعماره وسكناه ونمط حياتهم اليومية على نحو يشبه الوصف الإثنوغرافي للمجتمع، وذلك في أسلوب تسجيلي ينبئ بطبيعة الجمالية الروائية التي ستستوحيها لغة السرد.
ومن ثم، فإن هذا المطلع يضطلع بوظيفة تخصيصية بما هو فضاء تتحدد فيه السمات الأسلوبية الخاصة التي ستطبع الرواية ككل، ومن ثم ستبني بلاغته الكتابية الخاصة، القائمة على الشفافية والمباشرية والنزوع إلى التصوير والتشخيص، تنضاف إليها وظيفة تأطير الحدث (الذي سيتبلور في الفصول اللاحقة) من حيث مكان وقوعه وزمانه وكذا فاعله أو المنفعل به، لكن أبلغ وظائفه أثرا في تحديد إنتاجيته ومقروئيته هي بدون شك وظيفة التجنيس. ففي عتبتها أعلنت الرواية عن انتسابها المطلق إلى الجمالية الواقعية، ذلك لأن “المطلع، بما هو فضاء استهلالي، يدرج النص ضمن نمط جنسي جمعي. ففي بدايته، يتخذ النص، بطريقة خفية أو معلنة، موقفا من نموذج يصدر عنه نموذج الرواية الواقعية أو الرواية السيكولوجية أو الرواية الجديدة…، نموذج يلعب دورا إحاليا بالنسبة للروائي وللقارئ معا. لذلك ليس المطلع بريئا ولا يمكنه أن يكون بريئا بحكم إحالته على هذه النموذج”(14).
تجذر مزدوج:
تباشر رواية “المعلم علي” سيرورة تخلقها بحوار طويل بين شخصية علي وأمه فاطمة، سيمتد إلى حد مستهل الفصل الثاني الذي يتراكب فيه السرد والوصف: “على باب المطحنة، كان يقف تحت سقيفة من صفيح دقت على خشبة مهترئة، يحاول أن يتقي بها المطر المتهاطل كأنما ينصب من أفواه القرب. عيناه زائغتان تتلفتان ذات اليمين وذات الشمال كأنهما تبحثان عن مستقر. فكره منفعل مشتت لا تنعكس عليه أضواء الصباح ولا يتسم بهدوئه…” (ص 15).
وأن تبدأ الرواية متخيلها بمطلع حواري، فهذا يعني أنها لا تدشن كينونتها على أساس خطاب وصفي يعين الخلفية الزمكانية لوقوع أحداثها وتحرك شخصياتها، أو خطاب سردي يصوغ بنيتها الحدثية، وإنما تدشنها على أساس خطاب خارجي جاهز تسعى إلى مزايلته، وهو الواقع:
“- أفق يا بني، أفق. فقد اضاءت الشمس مشارف السطوح.
– خو…خو…
– أفق يا علي، مالك أصبحت ككيس رمل لا تطيق حراكا…
– أوه…
ندت من علي وهو -يشير بيده متأففا- غارق في نومه العميق، وكأنه في أول ليله…”(ص – ص 5-6).
ولا غرابة في أن يتسم سعيها هذا بنوع من التمحل والتكلف هما من سمات جميع المطالع الروائية. فهذا المطلع يوحي بأن الرواية بادرت إلى مفارقة “ما قبلها” بافتعال حوار بين شخصيتين دون سابق إشعار يبرره ويضفي عليه شرعيته. لذلك، فهو “يجسد صعوبة كل بداية، أي التوتر الناجم عن هذا الرهان: أن يكون الواقع، في ذات اللحظة التي ينزاح فيها عن هذا الواقع لينخرط في الخيال”(15).
والرواية، بمطلعها الحواري هذا، تقذف القارئ رأسا وبمنتهى السرعة إلى غمرة الحدث في طور وقوعه، أو لنقل، بتعبير استعاري، إن القارئ، في هذه الحالة، يركب الرواية وهي في معمعة انطلاقها. فلم يتم إعداده لاقتحام الرواية بخطاب تمهيدي ينقله تدريجيا إلى عالمها الخاص، ولا تم تجهيز النص قبلا بمشهد موصوف أو بصورة للشخصية أو بإطار للحبكة. ولا شك في أن السارد، بسكوته عن ذلك، أراد الإيهام بحكاية مشروع فيها ترسم صورة عالم ما يزال يشد الرواية إليه مثلما يشد النعاس شخصية علي إليه . فكأن ترجح علي بين اليقظة والنوم ترميز إلى تردد الرواية بين الخروج من عالم الواقع والدخول إلى عالم المتخيل:
“… ويهمهم غاضبا وما يزال النعاس يشده إليه:
-… ما يزال الليل يسدل ستاره على الدنيا وهي توقظني كما لو كنت مذنبا أساق إلى مصيري…”(ص 6).
وهو كذلك مصير الرواية (بل مصير كل الروايات) الذي يتقرر في مطلعها، أي قدرها كجوهر ذي تجذر مزدوج: تجذر في الواقع وتجذر في الخيال!
تكمن أهمية هذا المطلع “المباشر”(16) إذن في كونه “يقطع حدثا بدأ من قبل، مما يثير سؤالا أساسيا يتصل بـ”ما قبل القصة الذي لم يكشف عنه، ولكن النص يفترضه. وهذا النمط المطلعي يجر القارئ مباشرة (أي دون توسط أو تدخل ما) إلى الخوض في الحدث”(17)، وفي كونه يباشر وظيفته خاصة. فبخلاف الروايتين السابقتين، اللتين تقومان على سنن حكائي نسقي يتألف من عناصر ومتواليات سردية تتسم، صراحة أو ضمنا، بإحكام الرصف والتركيب -وهو ما يدعوه Roland Barthes بـ”السنن التأويلي”، أي “مختلف العناصر الشكلية التي بواسطتها تتمحور الحبكة وتتوكد وتتوضح ثم تتأجل لتنكشف أخيرا”(18)– فإن رواية “المعلم علي” تكسر أحد عناصر هذا السنن بابتدائها بمطلع يوحي بانفتاحاها على حبكة تكاد أن تكون جاهزة، مما يجعله يزاول وظيفة تسريع إيقاع تشكل الحبكة الروائية.
من عالم الأشياء إلى عالم الكلمات:
ينحصر مطلع “صباح ويزحف الليل” بين ملفوظ سردي ووصفي في آن مستهل بـرن الجرس” (ص 5) وبنية حوارية مستهلة بـ “-أرأيت؟ لقد كان من الغموض بحيث لم أفهم شيئا مما يقول.- ومع ذلك حاولت، ولعلني أدركت…” (ص 5). ويتمثل بلحظة ارتفاع الستار في العرض المسرحي إيذانا بنهاية الصمت والسواد وبداية انتقال الممثلين (وكذا المتلقين) من عالم الحقيقة إلى عالم الخيال. فكأن رنين الجرس هو تلك الضربات الثلاث على أرضية الخشبة التي تعلن عن افتتاح اللعبة المسرحية. بالفعل، يضطلع الملفوظ المطلعي بوظيفة الوصل (embrayage). فبوساطته، تتحقق سيرورتان متزامنتان: دخول القارئ عالم التخييل الروائي وخروج الشخصيات الروائية (التلميذات) إلى عالم الاستراحة: “ولفظت الأبواب الصغيرة إلى الساحة الكبيرة مجموعات من رايحين الجنة تعبق من أردافهن حيوية ونشاط ونزق، يتدافعن في حماس كما لو كن ينطلقن لأول مرة من أقفاص يدخلنها فرحات، ويخرجن منها مستبشرات” (ص 5). وإذا كانت السيرورة الثانية تتم بنوع من التلقائية والاعتيادية، بحكم تكرر رنين الجرس “ثماني مرات في اليوم” من غير أن “يفقد أبدا حدته” (ص 5)، فإن السيرورة الأولى تتم بنوع من العنف والفجائية، بحكم عدم التمهيد لها بما يضمن تلقائيتها، من غير أن تفقد أبدا خاصتها غير البريئة. فقد دشن القارئ دخوله عالم التخييل ذاك باصطدامه العنيف بعتبة نصية مشفرنة هي ملفوظ العنوان. فبخلاف عناوين روايات عبد الكريم غلاب السابقة، وهي “سبعة أبواب” و”دفنا الماضي” و”المعلم علي” ذات الشفافية والمباشرية الواضحتين، فإن العنوان “صباح ويزحف الليل” يكتسي كثافة قوية تتطلب من القارئ كفاية تفكيكية وتأويلية خاصة. لكن دخوله الفعلي والكامل لن يتم إلا بعبوره لعتبة نصية أخرى تنقله من عالم الأشياء إلى عالم الكلمات، من عالم الواقع إلى عالم النص، ألا وهي المطلع، بما هو متوالية قصيرة من الجمل (صفحة واحدة) ذات اكتفاء دلالي ذاتي.
وكسائر العتبات، فهذا المطلع ذو وجهين: أحدهما ناظر شطر متخيل النص، والآخر ناظر شطر عالم الواقع. إنه مزدوج الاتجاه: فهو في آن واحد يفتح عالما ويغلق عالما آخر، يميز داخلا هو النص عن خارج هو ما قبل النص أو اللانص. فكأنه “بوابة المدرسة الفاصل (ة) بين عالمين (ص 7).
فهو، باعتباره مغلقا، يمثل ذلك الحيز الذي تنقطع فيه الرواية عن عالم الأشياء المحسوسة الذي استمدت منه لوازمها التكوينية، أي فضاء المدرسة والأشخاص الذين يتحركون فيه وكذا الكلمات التي تتكفل بتحقيق عمليتي الوصل والتواصل، وهو العالم الذي يحدد الإطار المرجعي الذي سيضمن محكيها ويوجهه.
أما باعتباره فاتحا، فهو (أي المطلع) يمثل ذلك الحيز الذي تشرع فيه الرواية نفسها على مغامرة التخييل والتخريف، فتولي ظهرها لعالم الأشياء المحسوسة ذاك، بحيث تصبح المدرسة فضاء نصيا، أي وهميا، ويتحول الأشخاص إلى شخصيات ورقية، وتفقد الكلمات تصديقيتها.
بهذا المعنى، فقد تحقق في المطلع نوع من التبادل الرمزي الضروري بين مقول العالم ومقول النص. فبمجرد ما شرعت الرواية في الحكي، توارى الواقع. فكأن المطلع جملة صغرى مقتطعة من جملة كبرى جاهزة كتبها العالم، منها يمتح شروط وجوده.
ولا شك في أن عبد الكريم غلاب، كغيره من الروائيين، قد واجه على عتبة روايته هذا المشكل: “من أين أبدأ؟”، أي معضلة ضمان الانتقال من الماقبل إلى الما بعد. ذلك أن “صباح ويزحف الليل”، باعتبار ترجحها بين العالم الواقعي، المفترض فيها تصويرها له، والعالم النصي الذي تشرع في بنائه واقتراحه للقراءة، قد نظمت في مطلعها سيرورة اقتحامها لذلك الفضاء النوعي الذي سيكون فضاءها الخاص، وفق بروتكول قرائي ينهض على بلاغة الاستهلال. فمن هو يا ترى ذلك الصوت الباطني المجهول الذي سيتردد صداه من مطلع الرواية (“رن الجرس” ص 5) إلى مقطعها (“حملت حقيبتها القديمة. أمسكت بيده. خطت خطواتها ثابتة جريئة صارمة إلى الشارع” ص 240)؟ إنه حتما وبداهة صوت السارد، سارد ذي رؤية خلفية صريحة. فهو، بحكم اختلاقه للمحكي، موجود في كل مكان، عارف بكل شيء، وقادر على كل شيء. إنه يشارك -ويشرك القارئ- شخصياته أحوالها وتقلباتها ويستبطن سرائرها. ورغم أنه سارد خارج-حكائي، أي غير مندمج في القصة، فهو يضفي على سرده حميمية استثنائية توحي بتماهيه، أي السارد، مع المؤلف، ومن ثم توحي بانشداد المطلع إلى عالم الحقيقة. فلنلاحظ كيف أنه، رغم كونه ذا رؤية خلفية، يتخلى عن حياده المفترض، فينساق عنوة وراء نوع من التأويل الوجداني الواقعي لدلالة رنين الجرس وما يعبر عنه من “شوق” و”أمل” و”جاذبية” و”سحر” الخ. والكلمات جميعها مقتطفة من نص المطلع. وهذا الإجراء خوله حرية رصد الأشياء والأحوال بكل تلقائية، وكأن به حنينا خفيا إلى الاندماج في نسيج القصة وتاثيره في ما جرياتها وتأثره بها. فهو لا يكتفي بعرض مكونات الديكور من أماكن وشخصيات وأشياء كما تبدو لحواسه، بل يصهرها بوجدانه ويتولاها بخياله، بحيث يصبح السرد فيضا لذاتية السارد على تلك المكونات، ويصبح الوصف إسقاطا لنفسيته واستيهاماته عليها. مما يعني أنه، أي السارد، بعد مشدود إلى ما قبل النص، الطافح بمشاعر الألفة والأنس الممكنة، بما هو “عالم فسيح عريض حافل مثير ينتهي عند باب آخر” (ص 7) هو أيضا باب ذو صلة بالواقع، أي باب البيت.
فضاء البين بين:
ففي “شروخ في المرايا”، ينتهي المطلع حيث يبتدئ الفصل الثاني بتحول واضح في “التبئير” (Focalisation)، أي في طريقة انتظام المحكي حول “وجهة نظر” محددة، إشارة إلى نوعية إدراك المحفل السردي للعالم المسرود. فالرواية تفتتح ملفوظها الحكائي بقول السارد: “كانت الأقدار معي مجازفة مرتين: حينما بشرت القابلة والدي بأن طفلا جديدا أبصر الحياة، وحينما رأيت اسمي من بين أسماء الناجحين في إجازة الحقوق. ميلادان كانا عثرة من عثرات الحياة، رغم أن الحياة لا تعترف بذلك. ما زلت أتحداها” (ص 5). ولأنه يستعمل ضمير المتكلم، محققا بذلك تطابقا تاما مع إحدى شخصيات الرواية، فإن خطابه ذو “تبيئير داخلي”، بحكم كون معرفته بالأحداث محددة بمعرفة هذه الشخصية لها ومتكافئة معها. لكنه تبئير داخلي “ثابت”، ما دام السارد يجعل من ذهنه بؤرة لتصور الأشياء، ومن وعيه مركزا لاتخاذ القرارات. غير أن هذا السارد سرعان ما سيخضع، ابتداءً من الفصل الثاني، لتقلبات عدة ستجعله في الأخير لا يتعرف على وجهه في المرآة الصافية، فيشرخها، مما يعني تحول خطابه إلى تبئير داخلي “متبدل”(19).
وفي بداية هذا المطلع، يعود السارد، بالاستذكار، إلى اثنتين من لحظات حياته الماضية: ولادته ونجاحه في الامتحان، هما أيضا لحظتان أساسيتان من حياة الرواية ذاتها: مجيئها إلى العالم، عالم الكتابة (وكذا القراءة)، ونجاحها في استهواء قارئها المفترض. فمن هو هذا السارد -الشخصية الملغز الذي يسعى إلى فرض نفسه على مخيلة القارئ بهذا النزق، أي بتعمد السكوت عن توسيم نفسه باسم يحدد هويته، وبعدم التضايق من افتعال خطاب أنا- مركزي متوتر يتذرع منذ البدء بلغة البوح التلقائي والتأمل الفلسفي والتحدي الوجودي؟ لا ريب في أن الرواية، باستهلالها المفخخ ذلك، تسعى إلى وضع قارئها في حالة ترقب قصوى لما سيحدث من بعد، مما يفيد اضطلاع مطلعها بوظيفة التشويق: “ففي حافتها، انكشف انتظار المحكي والتشوق إليه، وفيها كذلك، انجلى الأثر المنتج في المتلقي وتقدير إنجاز سردي”(20).
ولئن كانت اللحظتان الأوليان موصوفتين بكونهما مجازفتين (“جازفت الأقدار معي، أو أخطأت لا أدري. ولكن الذي أدريه أني أصبحت هكذا نتاج مجازفة” ص 6)، فإن اللحظتين الأخريين لا يمكنهما أن تكونا ثمرة الخطأ أو المجازفة. ذلك أن نجاح هذا المطلع في استمالة القارئ إليه مرهون باستراتيجية مهيأة تحرص على عدم تكرار البدايات الروائية المقولية، تلك التي تعوزها الصفات الفردية المميزة. ومن جهة أخرى، فرغم أن المطلع عتبة تنبض بآثار مرور السارد (وكذا المسرود له) بتعسف وتمحل من صورة الغياب إلى صورة الحضور -وهو ما قد يوحي بالمجازفة- فإن هذا المرور لا يعني أبدا الانقطاع عن الواقع. فالإفادات القليلة التي يقدمها السارد عن نفسه وعن المكان والزمان تنبئ بالوجهة الإحالية-التخييلية التي سيتخذها المحكي، تلك التي “ستجعل القارئ يرى، مع السارد، الواقع وهو ينجلي شيئا فشيئا أمام ناظره”(21)، واقع الرواية الخاص. وبهذا الإجراء، الذي ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـ “بلاغة الانجلاء”(22)، يستطيع القارئ، في آن واحد، أن يشاهد العبور السري للرواية من نصيتها المرجعية إلى مرجعيتها النصية، وأن يعاين حركة السارد ذاتها التي سيشرع المحكي بواسطتها في التخلق والانبساط في فضاء القراءة والتأويل.
تبدو عتبة “شروخ في المرايا” وكأنها إذن نتاج ذلك “البين بين” حيث ينتهي نص ويبتدئ نص آخر. وهو ما يؤشر على توزعها بين كونها نصا “متعديا”، أي مجاوزا ذاته إلى مرجع محتمل، وكونها نصا “لازما” أي محايثا لذاته. إنها ثمرة مراوحة خفية بين الكتابة عن واقع جاهز (فهي رواية أطروحة بامتياز تتجاوز فيها الأفكار وتتناحر القيم) وكتابة هذا الواقع، أي أسلبته.
* * *
ما هو الحد الذي ينتهي عنده المطلع الروائي؟ ما هي وظيفة (وظائف) الجمل الأولى في النص؟ بأية إجراءات يتوسل الروائي لينقل ملفوظه الحكائي من خارج النص إلى النص؟ هل هناك أساليب جاهزة وملائمة لتوصيل المتخيل؟ كيف يتم تنصص الواقع؟ هذه بعض الأسئلة التي شكلت مدار قرائتي المتقاطعة لمطالع روايات عبد الكريم غلاب.
ويمكن القول إن هذه المطالع اتسمت بسمات مشتركة تكفلت متضافرة بصياغة استهلالية خاصة.
-فهي، ككل المطالع الروائية، تحمل في ذاتها آثار كونها امتدادا لعالم موجود قبلا وكونها انزياحا عنه. ففيها تحقق نوع من التناص بين جوهرين مختلفين، لكن متكاملين، تجسد في تفاعل النص الروائي مع نص الواقع، هذا التفاعل الذي سرعان ما سيخبو بمجرد ما يتجاوز السارد الوجه الأول لعتبة محكيه ليمر إلى وجهها الثاني، لا السارد وحده، بل كذلك المسرود له، حيث سيتم عبوره من النص الأول إلى النص الثاني بالسيرورة ذاتها.
-انتقالها بعنف وتعسف بين النصين. فالجمل الأولى تمثل تلك العتبة التي يشعر فيها الروائي بالتردد والارتباك. فهو، لدى مواجهته الصفحة البيضاء، يكون بعد مشدودا بأكثر من وثاق إلى عالم الحقيقة. لكن نداء هذه الصفحة ملحاح وإغراءها لا يقاوم! فهل من حيلة أخرى إذن سوى افتعال مرور عنيف ومباغت من اللانص إلى النص؟
-احتواؤها على مبادئ إنتاجيتها النصية. ففي متوالياتها الاستهلالية تقرر مصير الروايات. فهي جميعا شفافة في مستوى شفافية الواقع الذي تسعى جاهدة إلى تصويره، لا أثر فيها لأي أسلبة متكلفة ولا لأي تكلف أسلوبي، مما ينبئ بطبيعة السجل الجمالي (هنا: الواقعية) الذي ستستمد منه هذه الروايات عناصر صوغ متخيلها.
-تضمنها، بالتلازم مع هذه الخاصية، لاشتراطات مقروئيتها. فالروايات، باستيحائها الجمالية الواقعية، قد جهزت في مطالعها قارئها المفترض، فحددت أفق انتظاره والميثاق الذي سيبرمه معها.
مجلة الجابري – العدد الحادي عشر
الهوامش
1 – “سبعة أبواب”، القاهرة، دار المعارف، 1965.
–“دفنا الماضي“، الدار البيضاء، دار الثقافة، الطبعة الثانية، 1973.
–“المعلم علي“، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الرابعة، 1984.
–“صباح ويزحف الليل“، بيروت، دار الآداب، 1984.
-“وعاد الزورق إلى النبع“، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 1989 (ملحوظة: لم أدرس مطلع هذه الرواية لتشابهه مع مطلع رواية “المعلم علي” وقد درسته في كونه مباشرا وحواريا).
-“شروخ في المرايا“، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 1993.
2 – ابن قيم الجوزية، نقلا عن أحمد مطلوب، “معجم المصطلحات البلاغية وتطورها“، بغداد، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، 1986، الجزء الأول، ص 33.
3 – ابن رشيق، عن المرجع السابق، ص 390.
4 – محمد بن محمد التنوخي، عن المرجع السابق، ص 263.
5 – Raymond Jean, “Ouvertures, phrases, seuils“, in “critique“, n° 288, 1971, p.421.
6 – Gérard Genette, “Figure III“, Seuil, 1972, p. 238.
7 – Charles Grivel, “Production de l’intérêt romanesque LaHaye-Paris, Monton, 1973, p. 157.
8 – ليس سهلا دائما الفصل بين الوصف والسرد في الرواية، وذلك لقوة التعالق بينهما: “من الممكن تصور الوصف مستقلا عن السرد. لكن الحقيقة هي أنه لا يمكنه أبدا أن يكون في حالة خالصة. أما السرد، فلا وجود له بدون وصف، وهذه التبعية لا تمنعه من تأدية الدور الأول”، G. Genette، في “Figure II“، منشورات Seuils، 1969، ص 57.
9 – G.Genette, “Figures III“, op.cit., p.p.147-148.
10 – Guy Larroux, “Mise en cadre et clausularité“, in “Poétique“,n° 98, 1994, p. 247.
11 – Claude Duchet, “Idéologie de la mise en texte, in “La pensée“, n°215, 1980, p.95.
12 – Iouri Lotman, “La structure du texte antistique, Gallimard, 1973, p. 300.
13 – G. Genette, “Figures III“, op.cit., p. 238.
14 – D’après Andrea Del Lungo, “Pour une poétique de l’incipit“, in “Poétique“, n° 94, 1993, p.131.
15 – Jean-Louis Cornille, “Blanc, semblant et vraisemblance (sur l’incipit de “l ‘Etranger“)”, in “Littérature “, n° 23, 1976, p. 49.
16 – تعرف Andrea Del Lungo المطلع “المباشر (in medias res) بكونه “مطلعا سرديا يحقق دخولا فوريا إلى القصة بدون أي عنصر إخباري أو تمهيدي صريح، ويحدث أثرا دراميا [ أي يحرك سير الأحداث ]، خاصة حين ينفتح على لحظة أساسية وحاسمة في سير الأحداث [ هذا]”ن مرجع سابق، ص 144.
17 – Andrea Del Lungo, op.cit, p. 141.
18 – Roland Barthes, “Les cinq codes“, in “S/Z“, Seuil, 1970, p. 26.
19 – انظر ما يتعلق بـ “التبئير” وأشكاله وتنويعاته عند G. Genette في “Figures III“، مرجع سابق، ص ص 206-223.
20 – Guy Larroux, op.cit., p. 248/
21 – S. Jansen, ” Texte et fiction“, in. “Degrés” (Bruxelles) n° 46-47, 1986, p.14.
22 – M. Crouzet, “Stendhal et les problèmes de l’autobiographie“, Presses universitaires de Grenoble, 1976, p. 123.