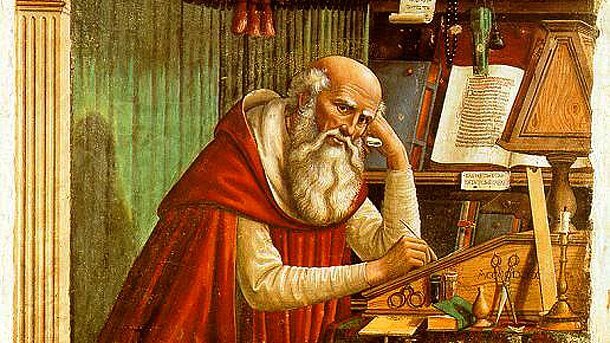تعتبر الترجمة نشاطا إنسانيا أصيلا ساهم على الدوام في تفاعل الثقافات واللغات وتلاقحها. ولما كانت كذلك فقد أفرزت خطابات حولها، تراوح موضوعها بين التساؤل عن كيفيات فعل الترجمة وبين الشروط المفروض توفرها في الترجمان، كما فعل الجاحظ(1).
فالعودة إلى الكتابات التي تهتم بنظرية الترجمة تجعل الباحث يلتقي بمواقف وآراء مختلفة، من حيث التصور ومن حيث الانتماء التاريخي والثقافي لمنتجي تلك الآراء ولمتخذي تلك المواقف(2).
أما مع البحث المعاصر، والذي تحت الإرغامات القصوى لحاجة كل مجموعة لغوية وثقافية، إلى التعرف على تطور معرفة الآخر، فقد حولها إلى موضوع للتفكير النظري. وقد نتج عن ذلك ظهور محاولات تصنيفية وتقعيدية وتقييمية أخلاقية، حولت التفكير فيها إلى إشكال منفتح. ومن ثم وجود دراسات تربطها بأشكال الموضوع المترجم (نص علمي / نص أدبي…) ودراسات تحاول ضبط السنن العام المتحكم في إنجازها بغض النظر عن القيود الخطابية والأجناسية للموضوعات المترجمة، ثم هناك الدراسات التقييمية الأخلاقية التي تسعى إلى تصنيفها بناء على علاقة النص -المصدر بالنص- الهدف، انطلاقا من مبدأي الأمانة والخيانة… الاستحالة والإمكان. وقد أدى هذا الاتساع إلى تداخلها مع نظريات عامة مثل الشعرية وفلسفة اللغة والمنطق واللسانيات والسيميولوجيا، فأصبحت نقطة تقاطع أشكال المعرفة الإنسانية نفسها. لكن هذا الشكل الإمبريالي الذي تظهره النظرية باتساعها، ليس في الحقيقة إلا مظهرا خداعا لإمبريالية مضادة. ففي الوقت الذي تبدو غازية لأراضي النظريات الأخرى ومهيمنة عليها، لا تكون فعليا إلا مكانا لمناورات تلك النظريات من أجل تطوير ذاتها: فهي بفضل إشكالية موضوعها، الذي هو موضوع مضاعف للتمثل والتدلال (représentation et sémiosis) أغرت كل الحقول المعرفية بتناولها، غير أن ما حدث هو أنها تحولت في ذاتها إلى نماذج توضيحية للمقولات النظرية لحقل معرفي معين. ونتيجة لذلك صارت قراءتنا لنظريات الترجمة، تجعلنا، عوض أن نلتقي بالآليات العلمية المرشدة لها، لا نلتقي إلا مع الموضوعات المعرفية الموسطة للبت فيها أو الحكم عليها. إن ما يقع في الغالب هو أن الحقول المعرفية التي تأتي لكي تحل مشاكل الترجمة سرعان ما تتناساها لتحيلها إلى أداة لحل مشاكل نفسها، فتغدو بذلك بمثابة وسيلة ناجعة لإجراء التجربة التفنيدية (بمعناها عند بوبر)(3) من أجل التأكد من فرضياتها الخاصة. وليست هذه الفكرة إجحافا أو تقولا، ولكنها ناتجة في آن عن تأمل الدراسات النظرية التي تتظاهر بجعل الترجمة موضوعا لها، وعن تأمل نتائجها الواضحة في مجال اهتمام الدارس الأصلية، ولتأكيد ذلك فلنتأمل انعكاس التفكير فيها لدى ثلاثة من رموز الفكر، في مجالات الشعرية واللسانيات والفلسفة التأويلية: فأما بالنسبة للتفكير فيها من وجهة نظر الشعرية، فقد قادت رائدها هنري ميشونيك إلى اكتشاف أهميتها القصوى في تجديد وتطوير الوعي بنظرية الأدب خاصة، وبنظرية الكتابة بوصفها نشاطا اجتماعيا عامة(4). أما ياكوبسون فلم يفكر فيها إلا بوصفها معيارا للبرهنة على اختلافية الأنساق اللغوية من حيث تقطيعها للعالم ومن حيث إسنادها لقيم التذكير والتأنيث.. ومن حيث ارتباط الدلالة بشكل التركيب، ونظرا لنجاعتها في تجلية تلك الاختلافات فقد استعارها لتجلية صعوبة أو استحالة بعض الأشكال العبر تسنينية المنجزة داخل نفس اللغة. ومن ثم كان اقتراحه لثلاثة أنواع من الترجمة: الترجمة الداخل لغوية (intralinguale) الترجمة بين اللغات (interlinguale) الترجمة بين السميائية (intersémiotique) والتي تتغيا تأويل الأدلة اللغوية إلى أدلة غير لغوية(5). وبذلك فقد حولها إلى أداة للبت في قضايا لسانية، ونفس الشيء تقريبا نلاحظه عند ريكور، الذي ماثل بينها وبين التأويل، بل جعله ترجمة، الشيء الذي أعطاها معنى استعاريا.
إن هذه الحقائق لتدعو إلى التساؤل عن علة هذا الوضع الذي تعيشه نظرية الترجمة: هل هو راجع لطبيعتها الخاصة بوصفها سننا مركبا يقوم على مواءمة بين سننين مختلفين ومعقدين، حيث كل سنن هو في ذاته تركيبة لترسانة من السنن (فليس السنن اللغوي إلا تركيبا لسنن مختلفة: ثقافية ومعرفية وتعرفية.. وينضاف إلى ذلك الذهن القائم بفعل الترجمة، والذي هو أيضا تركيبة معقدة) أو راجع فقط إلى افتقاد الترجمة لخلفية محايدة وعامة تجعلها موضوعا فعليا للمعرفة وليس أداة وحسب.
إن الوضع السابق هو ما يجعل المرء لا يندهش إذا خرج، وهو يطالع الدراسات المخصصة للترجمة، بفائدة ثمينة حول الموضوع المعرفي الموسط للبحث فيها، وبنتائج متواضعة لا تفيد، لا الترجمة وال الترجمان عمليا،كمثل القول إن الترجمة تكون أقل وفاء للشعر وأكثر وفاء للنص العلمي.. أو إن كل ترجمة خيانة.. ولعل هذه النتائج الضحلة لمجهودات جبارة، هي التي دفعت بعض المفكرين إلى التلميح إلى عدم جدواها، وإلى السخرية الإيجابية من نتائجها، واقتراح بديل فلسفي يختزل كل إمكاناتها. ويمكن إذا شئنا الاكتفاء بنسقنا الفكري الوطني الإشارة إلى مقالتي الأستاذ بنعبد العالي الذي ربط مفعول الترجمة (نص الوصول) بالسيمولاكر(6).
تأسيسا على ذلك يريد هذا المقال أن يجعل الترجمة موضوعا فعليا لخطابه، وأن يجعل الآليات التي سينطلق منها، هي نفسها الآليات التي تنطلق منها بقية الموضوعات المعرفية الأخرى-التي غالبا ما تأتى لمعالجتها ثم تهيمن عليها- ومن أجل ذلك فقد تم تفضيل معالجتها انطلاقا من التمثل والتدلال، لأنها ليست في الواقع إلا تحيينا مخصوصا لهما. ولما كان هذا الإنجاز مسبوقا إليه، في حقلنا الثقافي الراهن، فقد فضلنا الانطلاق منه. ومن ثم ستكون هذه المساهمة محاولة لكشف آليات إنتاج الترجمة، إطلاقا من تفاعلها مع مقترح نظري مغربي مستند إلى نفس التصور، وهو مقترح الأستاذ محمد مفتاح في دراسته “درجات الأيقون وترجمة الشعر”(7). ولتحقيق ذلك سيتم نهج الخطة التالية:
1 – المحمول الأساسي للمقترح النظري
2 – الخلفية الإبستيمولوجية العامة
3 – خلفية تدريج الآبقون وأنواع الترجمة.
1 – المحمول الأساسي للمقترح:
لا بد في البداية من الإشارة إلى عاملين فرضا علينا الإقرار بأن ما قدمه محمد مفتاح هو بمثابة نظرية وصفية للترجمة في ذاتها. ويتعلق الأول بكون مقدماته النظرية الخاصة بالأيقونة تستقطب بدقة كل أنواع الترجمات الممكنة من الحرفية إلى الحرة، من نقل الدليل كما هو في لغته المصدر (si 1 + 2 >–< إذا كان 1 + 2) إلى نقله مؤولا تأويلا بعيدا، كما تسعف على تحديد درجات الأمانة والإبداع؛ بينما يتعلق العامل الثاني بتأكيد الباحث نفسه على ذلك: “حاولنا تصنيف الأيقون إلى درجات، كل درجة منه تناظرها ترجمة معينة. وقد أصبحت درجات هذا التصنيف بمثابة قواعد لتقويم الترجمة وتقنينها”(8).
وإذا كان هذا المقترح النظري يستحق تمحيصا إبستيمولوجيا مدققا، يستند على تركيب مقترحي: كون وسنيد Kuhn et Sneed على شاكلة ما قام به غوتنر(9) فإن هذا المقال لن يقوم بذلك، إلا في حدود، نظرا لخصوصية المجال المعرفي الراهن، ولكون الباحث لم يدعم مقترحه النظري بتطبيقات. ولهذا يحسن الاكتفاء باستنباط المحمول النظري الأساسي، والذي يبدو ماثلا في افتراض أن الترجمة هي نقل لصور المعنى من دليل -مصدر إلى دليل- هدف، ويبدو ذلك واضحا من خلال عدم اهتمامه بكل عناصر التدلال الثلاثة (الممثل والموضوع والمؤول)(10) حيث اكتفى بالموضوع وحده وعالجه بوصفه موضوعا للتدلال، كما فعل بورس نفسه وهو يفصل أقسام الأدلة، إذ تصبح أبعاد الموضوع الثلاثة (الأيقونة والمؤشر والرمز) أدلة متكاملة، هي نفسها ممثلة لممثل وموضوع ومؤول. ويبدو أن مفتاح قد ركز على الموضوع وحده نتيجة لطبيعة الموضوع نفسه (الترجمة) لأن الممثل لا يحضر بل يغيب، لأنه يحول بناءا على موضوعه. فنحن حين نترجم نعم بـ(Oui) لا نترجم الممثل (ن،ع،م) بل موضوعه؛ ولأن المؤول هو الفعل ذاته المتحكم في الترجمة والذي تم وصفه سابقا بالسنن المركب. فحين نقرأ ترجمة (نعم بـ Oui) لا نقرأ ما الذي جرى بذهن المترجم لاعتبار Oui مؤولا لموضوع نعم في اللغة الفرنسية.. فضلا عن كون الموضوع بوصفه المعطى المادي في الترجمة هو الذي يستطيع أن يجعلنا نستنبط المؤول.
وقد تحقق هذا الاستبدال في مقدمتين نظريتين هما:
أ – إن الترجمة (ولا يقصد بها -كما يفعل الجميع- الفعل، أي المؤول، بل المفعول، أي النص-الهدف) هي أيقونة.
ب – إن للترجمة درجات للوفاء. وقد التقيتا في اعتبار الأيقونة متدرجة، وتدرج الأيقونة هو نفسه تدرج الأمانة. بيد أن سمات مقترحه النظري لا تكتمل إلا باستنباط المقدمات غير النظرية، والتي يمكن اختزالها في إغفال “ذرائعية الترجمة”، وأقصد بها التساؤل حول قيمة النص المصدر وحول دواعي ترجمته إلى ثقافة اللغة الهدف، وحول تكوين الترجمان الترجمي.. ولهذا السبب تم ربطها بالنظريات الوصفية رغم عدم خلوها من جوانب معيارية ماثلة في معيارية الأمانة والإبداع.
2 – الخلفية الإبستيمولوجية العامة:
لا يمكن فهم مقترح د.مفتاح الترجمي دون ربط تصوره عن الأدب بوصفه أيقونة بتصور بورس حولها:
1.2-الأيقونة بوصفها انحلالا لرمز:
يرى بورس، وهو يحدد الأيقونة بوصفها دليلا، أنها ممثل، حيث الصفة أو الخاصية الممثلة هي أولانية الممثل لما هو أولاني، بمعنى أن خاصية (أو صفة) الشيء بوصفه شيئا هي التي تؤهله لأن يكون ممثلا. لذلك فإن كل شيء يمكنه أن يصبح بديلا [أي مؤولا] لشيء آخر مشابه له، فليس للممثل في مستوى الأولانية إلا موضوعا مشابها. وهكذا، فالدليل في مستوى الأولانية (عالم الممكنات والإحساسات..) هو صورة لموضوعه، الذي لا يمكن إلا أن يكون فكرة، ذلك لأنه ملزم بإنتاج فكرة(11). غير أن بورس وهو يربط موضوعها بالفكرة، ينبه إلى أن ذلك ليس سوى مفعول ضروري لنظام الإدراك الذهني، الذي لكي يفهم ما هو ممكن في علاقته الإمكانية بموضوعه الوجودي، يستند على قانون ضروري (الفطرة). أما الفكرة في ذاتها، أي بوصفها دليلا، فهي من نظام الثالثانية (رموز). ولذلك فقد أنهى الفقرة (2.276) التي يحدد فيها الأيقونة بالإشارة إلى “إن الموضوع الخارجي للأيقونة يحفز الفكرة من خلال تأثيره على الذهن وأن الفكرة ذاتها -خارج الممكن أو الأولانية- لا يمكن أن تكون أيقونة”(12).
واضح إذا أن بورس بفضل استمرارية وواقعية فلسفته الذرائعية ومحايثتها لسيرورة التدلال المتحكمة دوما في تحديداته لأقسام الأدلة، يربط الثالثاني بوصفه ضروريا ولا زمنيا ومجردا (لأنه رموز وأفكار) بالأولاني الممكن الماثل فقط في صفات ما للدليل أو الممثل الحاضر وجوديا، باعتبار ذلك الربط وسيلة الذهن الوحيدة لتجسير العلاقة بين ما يتمثله الذهن بوصفه ممكنا وبين موضوعه الوجودي الممكن وحسب (فليست الشجاعة في استعارة “زيد أسد” إلا نتاج إدراك الذهن لصفات يفرزها الممثل نتيجة تفاعلها مع سنن معرفية سابقة، إذ ليست إلا إمكانية مجردة محينة وحسب، فلا وجود لمانع يحول دون التحيين المرحلي لأفكار أخرى مثل الحيوانية والافتراس والسلطوية…)
إن ما يقع فعلا مع الدليل المدرك بوصف موضوعه أيقونة (أي ممكنا وموصوفا من قبل ممثل الدليل وحسب) هو تنمية الممكن ليحتمي بالضروري، وحيث تلك التنمية هي الحل الوحيد المتاح للذهن لكي ينتج سيرورة التدلال الهادفة إلى تمثل الثانياني الوجودي: أي المؤشر. غير أن ذلك يتم دون أن يفقد الثالثاني بعده الضروري، لأنه لا يأتي إلا مرحليا وتحت إرغامات الذهن لكي يرسم الطريق للمكن، حتى يصير جزء منه وجودا(وهذا معنى الانحلال عند بورس)، ثم ينسحب بعدما يكون قد قام بدور المؤول. ولكنه لا يقوم بذلك الدور إلا بشكل ذهني خفي، يناظر فعل التدلال الخفي الذي يحقق فعل الترجمة المظهر، ذلك أننا نظهر في الترجمة إلى الفرنسية (Oui ) ولا نظهر قبلها أو بعدها، ما هي العمليات الذهنية المجردة والمعقدة التي قادتنا من (نعم إلى Oui). إن مجيء الفكرة إلى الدليل الأيقوني هو مجيء متسام ومشروط بمسبقات الذهن (الشجاعة دون غيرها في المثال السابق) ومرحلي لا يجسد الفكرة بل يوسط بها علاقة الممكن بالوجود، فالشجاعة التي يستحضرها الذهن مرحليا حالما تسعف الممكن تنسحب ليرتسم الوجودي في شكل نسخة مخصوصة لها: “زيد شجاع” تلك النسخة التي تؤشر وجوديا على الدليل الايقوني الممكن وعلى الفكرة-الرمز، دون أن تكون تجسيدا لكل إمكانات صفات الدليل الأيقوني أو لموضوع الفكرة أو الرمز (أي الشجاعة)، لأن النسخة التي تولدت وصارت مؤشرا لا يمكن أن تكون هي نفسها إذا كانت مسبقات الذهن مختلفة (إذ لا مانع في ثقافة أخرى من استعانة الذهن بفكرة الافتراس أو التواكل..) كما لا يمكن أن تكون هي الفكرة المجردة نفسها، لأن (زيد شجاع) هو مقدار مخصوص من الشجاعة يكافئ جزءا منها يناظر شجاعة زيد وتصور المتكلم أو المتلقي؛ فضلا عن كون اسم الفاعل (شجاع) وهو ينطبع كنهاية للتدلال، لا يكون إلا مؤشرا يستدعي لكي يفهم هو نفسه، تحيينا جديدا للرمز (الشجاعة) الذي يتضاءل أبدا إلى تجسيداته. وذلك ما سيتوضح في عكس السيرورة التدلالية التي تمضي من الرمز إلى المؤشر. وهكذا تتضح جوانب من خلفية اعتبار مفتاح للأدب وللترجمة أيقونة، مثلما تتضح الخلفية الفلسفية لنسبية التأويل والفهم بوصفهما متحكمين في فعل الترجمة التي تقوم بمضاعفتهما.
2.2-الرمز بوصفه انحلالا إلى أيقونة:
لقد رأينا أن ضرورات الذهن تطور الأيقونة إلى رمز ينحل لكي يرسم الطريق نحو المؤشر (مضمون الفهم)، وسنرى الآن كيف تنعكس الآية حين يكون المنطلق من الرمز: إن الرمز كما سبق توضيح ذلك لا يتحين إلا بشكل مجرد وذهني وبتوافق مع محفزات استدعائه. ولذلك، فإنه في مستوى التحقيق الفعلي، لا يحظر إلا ممثلا بإحدى نسخه (لكي نوضح أكثر، لنقل بلغة سوسير، إن اللغة لا تحين إلا بوصفها كلاما). غير أن التجسد المباشر للرمز عبر نسخته يجعل الممثل دالا بموضوعه الداخلي وليس بصفاته. ولذلك يكون مؤشرا (حرفيا أو جادا إذا شئنا اعتماد لغة عادية) وفي هذه الحالة أيضا كيف يمكن للذهن أن يفهم هذا الدليل المفرد المؤشر (Sinsigne indicaire)؟ فتبعا لبورس لا يمكن للفهم أن يتم إلا بجعل نسخة الرمز تنحل إلى أيقونة: “كل منهج غير مباشر للتواصل مع فكرة ما، يجب أن يقوم لكي يتأسس ، على استعمال أيقونة ما” (278،2)(13) وإذن، فكل تجميع للرموز والمؤشرات هو تجميع أيقوني: “الرمز هو دليل، قمين طبيعيا، بأن يخبرنا أن مجموعة من الأشياء التي هي معينة بمجموعة من المؤشرات التي يمكن أن تكون مرتبطة بها، بطرق ما، هي ممثلة بواسطة أيقونة” (295،2) والمثال الذي يحلله بورس لتجلية فكرته هاته، يوضح الجانب الثاني من الخلفية التي بناء عليها ربط مفتاح الترجمة بالأيقونة، والمثال هو (إيزيشييل يحب هولدة)(*). إن تركيب المؤشرين الوجوديين بفضل نسخة الرمز (فكرة الحب) يجعل الدليل الكلي قضويا (dicisigne). لكن هذا الدليل لا يفهم في علاقته بالموضوع الذي يمثله إلا بجعله ينحل إلى أيقونة لأن: “اثر هذه الكلمة (يحب) يقول بورس، كامن في كون الموضوعين المعينين بالمؤشرين (إيزيشييل وهولدة) ممثلين بالايقونة أو الصورة التي نملكها في أذهاننا عن محب ومحبوبته” (295،2). و إذن فإننا لا نستطيع، حتى في حالة كون الأدلة مؤشرية: أي دالة بفضل تحديدها لموضوعاتها) إلا أن نحولها إلى صورة أو أيقونة، وذلك باستدعاء الفكرة. ولكن ليس وفق نفس الطريقة السابقة، من جهة لأننا مع نسخة الرمز، نستدعي الرمز مباشرة لكي نفهم معنى المؤشر (نستدعي فكرة الحب لكي نفهم المؤشر الماثل في الجملة السابقة) على خلاف الأيقونة التي معها نستدعي الرمز لكي يمنحها قبل انسحابه نسخته التي تطور إلى مؤشر. ومن جهة ثانية لأن الرمز حين يستدعي ذهنيا من قبل نسخته، يحضر مباشرة في الوعي ويكون الوحيد المستدعى، بينما مع الأيقونة لا يكون استدعاؤه إلا بعد عمل ذهني سابق يحدد أولا الصفة الممثلة، ثم بناءا على تلك التصفية أو ذلك الانتفاء الذي لا يكون إلا ممكنا وحسب، (لقد سبقت ملاحظة إمكانية استدعاء أيقونة” زيد أسد” للشجاعة أو للافتراس..) يتم استدعاء الفكرة. ولكن الشكلين يلتقيان مع ذلك، في نهاية الفهم عند حقيقة متشاركة وهي أنهما لا يقبضان إلا على نسخة للرمز، لا تشكل إلا جزءا منه، وهو جزء خاضع دوما لتصور الذهن حول ذلك الرمز، لأن النسخة خاضعة على الدوام لإرغامات وشروط متعددة أولها الكفاءة اللغوية والتجربة الحضارية والذاتية… ففهمي للحب لن يكون أبدا هو فهم الفرنسي له(**)،لأنني لو أردت فهم تلك الجملة، لتحولت في ذهني إلى أيقونة الحب، وهي صورة عاطفة يتملك فيها القلب العقل وقد ينهكه. وهي حالة دائمة لأن التواصل الجسدي يبطلها، ويعيدها إلى رمز آخر في لغتي وثقافتي مثل الهوى، العشق، الغرام.. إن أول صورة تولدها تلك الجملة في ذهني هي أيقونة (قيس وليلى) وقد تنضاف إلى هاته الصورة تجربتي الخاصة عما أربطه بذلك الرمز (الحب) إذا كنت فعلا أعيشه. ولا يمكن أن تفجر تلك الجملة نفس الصورة في ذهن الفرنسي مثلا، نظرا لفقر لغته بخصوص الأفكار المتصلة بالعاطفة، فاشتقاقات الحب في لغته وهي اشتقاقات مترابطة بثقافته، تسمح دون شك بتشكيل صورة مزدوجة بين الاتصال والعاطفة. وإذن فترجمتي للجملة السابقة نفسها ليست أمينة، لأنها ترجمة بناء على أيقونة وحسب، وقد يوجد من يرفض الصورة التي فهمت بها نسخة الرمز (حب)، وسيكون ذلك مثالا لتفسير قصد بورس)، فإنني أجيبه بأن عليه أن يقنعني بالصورة المثلى، ولكي يقنعني عليه أن يحول دون شك مالا يوجد في الوجود إلا بوصفه وصفا لما لا يوصف إلا بالصورة، أي عليه أن يريني الحب مجسدا في شكل هندسي أو رياضي من نوع (1+1 = 2) ولكن من حقه أن يخالفني في فهمه، ثم في ترجمته لنفس الجملة، ما دام مرتطبا بتحيين مخصوص لصورة ما تحضر في ذهنه لنفس الفكرة(*). ونفس الشيء يكون مضاعفا في حالة كون الدليل-المصدر أيقونة. وهكذا يتضح أن الفهم الذي تعتبر الترجمة نتاجا له قبل أن تضاعفه بتحيين فعلها، هو مجرد تواطؤ ومحاولة للاقتراب، ولذلك لا يمكن أن تكون الأمانة إلا إخلاصا لهذا التواطؤ وهذا الاقتراب.
إننا حين نأتي بالرمز سواء بشكل مباشر (انطلاقا من نسخة مؤشرية) أو غير مباشر (انطلاقا من أيقونة) لا نأتي به إلا لكي نغدر به (أو لكي نلطف الأمر) لا نأتي به إلا لكي نخلصه دون أن ندري من غموضه وكثافته، ولكي نقتطع منه ما هو موجود مما يناسبه في لغتنا وثقافتنا وتجاربنا الخاصة، ذلك التلطيف الذي يفرضه كل تحيين بوصفه ملاقاة للوجود. وبتركيب شكلي التدلال فإن الممكن يستنجد بالضروري والضروري يستنجد بالممكن من أجل التعبير عن الوجود، الشيء الذي يجعل ذلك التعبير نسخة أي أيقونة، وهكذا نكون قد رسمنا الخلفية الفلسفية التي استند إليها محمد مفتاح في ربطه للعمل الأدبي ثم للترجمة بالأيقونة، وفي ربطه نظريا للأيقونة بالرمز.
3 – خلفية تدريج الأيقونة وأنواع الترجمة:
قبل التعرض إلى التدريج المقترح من قبله، نشير إلى أننا سوف نعمل على تقديم نماذج للدرجات التي تلائم الأدلة الأدبية ببعض العناوين المترجمة من الفرنسية إلى العربية، ويستلزم ذلك افتراض أنها ليست عناوين، لعدة اعتبارات:
-لأن العنوان ينتج وفق قانون سيميائي مضاعف قياسا إلى الأدلة النصية أو الأدلة بصفة عامة، لأنه بخلافها لا ينتج بوصفه دليلا لغويا انطلاقا من الإدراك المباشر لفكرة حاضرة في الذهن، وآتية من العالم الخارجي، أو من انعكاسه ثم تفاعله مع العالم الداخلي للذات المنتجة، ولكن انطلاقا من تضاعف ذلك باندماج النص المنتج والمدرك وفق صفة ما بوصفه جزءا مضافا إلى ذلك العالم. ولعلها الحقيقة التي تجعل الكتاب أنفسهم يحتارون إزاء إنتاج عناوينهم، ولا يمانعون، في الاستماع إلى آراء زملائهم، أو في تغيير عناوينهم. ومن ثم فإن عملية ترجمة العناوين تعتبر أكثر تعقيدا، وقد لا تكون بالضرورة ترجمة للعنوان نفسه، وإنما استخلاصا لعنوان جديد انطلاقا من النص نفسه.
-إن النظام السيميائي المتحكم في إنتاج العناوين يفرض إلى جانب ذلك، الاختزال والكثافة والأناقة. وذلك ما يقيد العنوان المترجم أيضا، إذ يجري تفادي ترجمة الدليل المركب من دليلين مثلا بدليل مركب من أكثر من ذلك العدد، لأن إجراء من ذلك النوع يحيل العنوان إلى ما يشبه النص. ومن ثم قد تكون التضحية بما يسمى “أمانة أو مطابقة”، أمرا يفرضه القانون السيميائي لإنتاج العنوان نفسه.
-إن تحليل تمثل المترجم وشكل التدلال الذهني الذي قاده إلى إنتاج العنوان في اللغة الهدف، يفرض بفعل التضاعفات المذكورة، إدماج بعد المؤول ضرورة، وذلك ما لا يمكن الوفاء به في مقال من هذا الحجم.
وهكذا نكون قد وضحنا شكل استعمالنا للعناوين على اعتبار أنها أدلة وحسب، أي نماذج مصغرة -من أجل الاقتصاد- للأدلة عامة، جملا كانت أو نصوصا. ولذلك فإن تحليلاتنا لا تتصل إطلاقا بإصدار أحكام غير موضوعية على مترجمي هذه العناوين، بل تتصل باستعمالها بوصفها نماذج تمثيلية فقط. ويرجع اختيارنا للعناوين عوض النصوص إلى الرغبة في التواصل البسيط مع القارئ. وانطلاقا من نفس الاستراتيجية لقد ارتأينا الاكتفاء بثلاثة عناوين لكاتب معروف هو د.عبد الفتاح كيليطو. أما العناوين التي سنجعلها وسيلة لتجريب قوة صمود المقدمات النظرية فهي على التوالي: (العين والإبرة، لسان آدم، الكتابة والتناسخ L ‘oei et l’aiguille, la langue d’ADAM, l’auteur et ses doubles).
انطلق مفتاح في تدريجه للأيقونة من مبدأ التفريع البورسي لأقسام الأدلة عامة، ولقسم الدليل -الأيقونة خاصة، فقد فرع بورس الأيقونة إلى ثلاثة أقسام صغرى: وهي الصور والرسوم البيانية والاستعارات. وذلك تبعا للجهة الأولانية التي تنتمي إليها، فالصور هي التي تشكل جزءا من الخصائص البسسيطة أو أولانية الأولانية، وتعتبر الأيقونات الفرعية التي تمثل العلاقات- وخصوصا الثنائية أو التي تعتبر كذلك -التي تربط أجزاء الشيء بعلاقات مماثلة في أجزائها الخاصة، رسوما بيانية. وتسمى الأيقونات الفرعية التي تمثل الطابع التمثيلي لممثل ما، بواسطة تمثيل مواز داخل شيء آخر، استعارات(277،2).
وإذا كان بورس قد أضاء ما يقصده بالصورة والرسوم البيانية، حيث ربط الأولى بالصورة الفوتوغرافية للطبيعة، وربط الثانية بالشكلنات الرياضية والصور الصوتية للغات الطبيعية وقواعدها التركيبية وعلة الخطاطات الدالة على التدرج… فإنه صمت بخصوص الاستعارات، الشيء الذي جعل شراحه يسندون لها موضوعات مختلفة ترتبط بإنجازات لغوية مجازية مثل كونها استعارات كما يذهب إلى ذلك (دولودال) أو كونها أليغورة ومثل أو حكمة، كما نجد عند (فإن زوست) لكن الواضح أنها تشكل ثالثية الأولانية. ولذلك فهي مرتبطة باللغات الطبيعية ومن ثم يمكن بناء على ثالثانياتها تفريعها وفق نفس المبدأ. فإذا كان تفريع قسم الأيقونة من قبل بورس نفسه، قد بني على حساب (33)[27] فلا مانع من تفريع الفروع وهكذا إلى ما لا نهاية. وفعلا فذلك ما قام به مفتاح بخصوص فرع الاستعارات التي فرعها بناء على الجهات الثلاث، إلى استعارة أيقونية واستعارة مؤشرية ثم استعارة رمزية.
إذا تأملنا بعمق في هذا التفريع نجده يقوم على حساب (34) [81]. والملاحظ أن تحديده للأيقونات غير المفرعة (الصور والرسوم البيانية) قد شاكل تماما تحديدات بورس لها، بينما حدد الأيقونات المولدة وفق الحساب السابق، بناء على القانون الاستنباطي البورسي:
1.3-الايقونة(*) المثالية: إذا كان بورس يربط الصور بالصور الفوتوغرافية، والتي يتضاءل السنن المنتج لها إلى آلة، وليس إلى ذات، فإن مفتاح يربطها بالمستنسخات المطابقة لأصل وحيد، وقد جعلها مستحيلة في مجال الترجمة باستثناء الحالات النادرة التي تتقارب فيها تعابير اللغة -المصدر مع اللغة- الهدف. ويستنتج من تعريف مفتاح استبعاده لظاهرة التعريب المسيطرة على ترجمتنا (مثل إيديولوجيا، سيميولوجيا..) ولظاهرة نقل الأدلة كما هي في لغتها-المصدر. والواقع أنه حق من وجهة نظر السنن الترجمي، أولا، لأن الدليل الهدف لا يكون إلا نسخة مباشرة للدليل المصدر. وإذن لا يمر من السنن الترجمي العام، بل ينجز خارج السنن، ثم لأن الذات-مكان سيرورة الدلال الترجمي تتضاءل إلى مستوى آلة التصوير: لا تبدل أي رد فعل.
2.3-الأيقونة المتماثلة ويربطها في الترجمة بالحفاظ على الشكل والمضمون، وخاصة بترجمة الشعر الفضائي والكتابات الرياضية والمنطقية… وهذا التحديد مناظر لتحديد بورس لثانوية الأولانية (الرسوم البيانية) والتي ربطها بأشكال الكتابة القديمة، مثل الهيروغليفية. لكن هذه التحديدين السابقين ليسا إلا فرعا من التحديد العميق للرسوم البيانية أو الأيقونية المتماثلة، فإذا كان بروس، في تعريفها المترجم أعلاه، يربط موضوعها بعلاقات أجزائها بأجزاء الشيء الممكن الذي تدل عليه مثل علاقة تدرج العناوين بتدرج الموضوعات المرتبطة بها، الشيء الذي جعلها ذات بعد أيقونة فضائية(*) تتصل بدلالة الفضاء وتدرج الأدلة المعنوي أيضا، والحفاظ على الرتبة، وذلك ما نجده في تطبيق مفتاح على النصوص التي مثل بها في دراسته، حيث لاحظ التفاوت بين الشكلين، والاختلاف في التقديم والتأخير، والاختلاف في توزيع الأبيات سطريا وفضائيا.
ويمكن إضافة أدلة أخرى تقبل أن نبت فيها بفضل هذا الشكل الترجمي مثل أرقام الفصوص والفضاءات المحسوسة المشكلة للفوارق بين الفقرات والفصول، ومثل الصور الخارجية للأغلفة… وأيضا ما يتصل بالرتبة الدلالية، خاصة إذا كانت الرتبة الفضائية أيقونة لرتبة ثقافية ما، مثل شروع الأب أولا في الأكل -كما هو الحال في رواية الثلاثية لمحفوظ- وبعده الأبناء، ثم انسحابه قبلهم…الخ، وحيث أي تعديل في هذه الرتبة الدلالية يعد إخلالا بالشكل والمضمون أيضا..
3.3-الأيقونة المتشابهة: ويحددها بكونها “ما تكون علاقتها بأصلها علاقة المشابهة التي تجمع بين الأصل والفرع” وهي بذلك تطابق وفق منطق التفريع المضاعف (34) بناء على قاعدة النظرية التفريعية البورسية، جهة أولانية الاستعارة. ومن ثم تفرض ارتباط الترجمة -التي تنتج وفقها- بالسنن البسيط للترجمة، أي أن يحرص المترجم ما أمكنه، على الحفاظ في ترجمته، على المؤولات المباشرة المعادلة لأدلة النص-المصدر بهدف المحافظة النسبية على الخصائـص التمثيلية لأيقونات المصدر، في الأيقونات الهدف. (ولا يعني هذا الترجمة الحرفية). وهكذا لكي يتحقق هذا النمط لا بد من أن تكون أدلة النص الهدف أيقونة أيقونية: فإذا كان الوصف الأول (أيقونة) كامنا في مسلمات نظريته الترجمية ومبرهنا عليه انطلاقا من النظرية العامة الموجهة (بورس)، حيث كل فهم أيقونة وكل ترجمة أيقونة، سواء كان المنطلق أيقونة مباشرة (الاستعارة بمعناها الشائع) أو كان المنطلق مؤشرات ورموزا (س يحب ص أو س يؤمن ب ص…)، فإن الوصف الثاني (أيقونية) هو الذي يحكم قانون هذا النوع والذي يشير إلى ضرورة كون الخصائص الممثلة في الدليل المصدر، هي نفسها الممثلة في الدليل الهدف، بغض النظر عن طبيعة التمثيل-المصدر: أيقونة، أو رمز منحل إلى أيقونة. فترجمتنا لـ. AMR est un lion بـ عمرو أسد، مماثل لترجمتنا لجملة بورس السابقة “س يحب ص” رغم أن الأولى أيقونة والثانية مؤشر، لأن الترجمة حافظت على الخاصيات الممثلة.
1.3.3-مطابقة القاعدة: إن ما يطابق قانون الأيقونة التشابهية لإنتاج الدليل الترجمي من بين العناوين السابقة هو العنوان الأول (العين والإبرة / l ‘oeil et l’aiguille) وهو من إنجاز “مصطفى النحال”. ولنتصور في البداية ما الذي يمكن أن يكون قد راج بذهن المترجم قبل تجسيد قراره كتابة. لقد كان أمام دليل-مصدر ممثل لموضوعه بفضل خاصيات ممثله وحسب، أي كان أمام أيقونة لا يدرك موضوعها الممكن إلا بإدراك خاصياتها الممكنة، مع أن إدراكها مشروط بالمسبقات المعرفية الذهنية للمترجم والمركبة من عالم اللغة الفرنسية وثقافتها المضاعف بالسنن الخاص بمنتجها الأول (كيليطو). فلا بد أن ذهنه قد قلب كل الإمكانيات، التي بناء عليها -بوصفها خاصيات تمثيلية ممكنة- يمكن استحضار الفكرة الموسطة المنسجمة مع الإدراك، ثم العبور عبرها نحو الموضوع الممكن (المؤشر)، ولكي نحصر الإمكانات الغنية لهذه الأيقونة فلنكتف بإمكانيتين، كان بإمكان المترجم أن يحنينهما: تتمثل الأولى في إدراكه للدليل باعتبار عنصريه مختلفين (oeil / aiguille) من حيث البعد الأنطلوجي للتمثيل ، مثل اعتباره الأيقونية ماثلة فقط في أحدهما، كأن يدرك الإبرة مؤشرا منحلا عن رمزها مثلا. وإذن لا داعي من أجل الأمانة لتأويلها، بينما يعتبر (oeil) أيقونة وبؤرة لأيقونة الدليل المركب، وأن خصائصها الممثلة لا تلائم خصائص مؤولها المباشر العربي المعطى في الذهن، إلا إذا حددت وقيدت بسياق مثل السياق الفيزيولوجي (الرؤية…) أو السياسي (الجاسوس..) أو الطبيعي (المنبع).. ولذلك، من أجل الحفاظ على الخصائص الممثلة للأيقونية الكلية للدليل، قد يجعلها تطور إلى إحدى خاصياتها في مؤولها المباشر العربي مثل الربيئة أو المنبع… وبذلك سيجعل أيقونيتها الترجمية تجسيدا لنهاية تمثله وتدلاله الذهني، فإذا فهم أن خاصياتها الممثلة تنسجم مع السياق الفيزيولوجي فسينتج الدليل الترجمي التالي (الرؤية “أو البصر..”) والإبرة). ومثل هذا الإجراء لن يجعل ترجمته خاضعة لقانون الأيقونة التشابهية (أو الأيقونة الأيقونية) بل مجسدة للأيقونية المتوازية (أو المؤشرية) والتي تجعلا لترجمة، بفعل رد فعل الذات الواضح، أقل أمانة وإبداعية.
وتتمثل الثانية في اعتباره للدليلين معا (كل على حدة) أيقونة، وأن الدليل الكلي أيضا أيقونة. وبناء على ذلك، سيدركهما بفضل الفكرة الثالثانية الرمزية التي تلائم شكل فهمه للدليل (أي خصائصه الممثلة) وحالما تستقر في ذهنه تلك الفكرة، يتمثل نسختها بوصفها الموضوع الممكن للدليل، فتصبح تلك النسخة مؤشرا وجوديا على ما كان وصفيا وممكنا فقط: كأن يكون الرمز القادم إلى ذهنه مع (oeil) مجسدا في صورة الرؤية أو الإنسان.. ومع (aiguille) مجسدا في صورة الخياطة أو الوخز..(*) وبوصف تلك الصور مؤشرات وجودية على نسخها وعلى أيقونيتها الممثلة (الدليل-المصدر) وعلى مكان سيرورة التدلال (أي المترجم) فإنها تشكل أيضا ابتعادا عن الحد الممكن للأمانة وتقليصا للإبداعية. وذلك واضح من خلال نسخ الرموز التي يمكن أن تنتجها: (الرؤية والوخز، الإنسان والنسيج..) لكن هذه الإمكانات وغيرها مما يمكن أن ينتجه التمثل والتدلال بخصوص أي “فانيرون” حاضر في الذهن، قد توارت في ترجمة النحال لأنه اختار في النهاية الحد الأقصى للأمانة، وذلك بالاحتفاظ للدليل المصدر، وهو يترجم، بنفس خصائصه التمثيلية فكان: “العين والإبرة” حيث ظلت الخصائص التمثيلية للدليل الأيقوني المصدر ماثلة في الدليل الهدف. وبذلك حققت هذه الترجمة، وهي تخضع بدقة لقانون الأيقونية التشابهية الحد الأقصى للأمانة والإبداعية: إن ذلك واضح من خلال تمليها قياسا إلى الشكلين اللذين افترضناهما أعلاه، والمنسجمين مع الشكلين الترجميين المتبقيين.
2.3.3-استثناء القاعدة: لا يعتبر التعريف السابق للأيقونة المتشابهة تاما إلا بإضافة الجزء المتصل بوصف استثناءاته، والتي لا تنفي ما ينتج عن إكراهاتها من الإنتماء إلى هذه الترجمة المتصفة بالأمانة والإبداع في آن: “تكون الترجمة أيقونية متشابهة، حين يسعى المترجم إلى المحافظة على الشكل والمضمون محافظة لا تصل إلى درجة المحافظة المثالية، بأن يرد السبب إلى إهمال المترجم أو إعواز الوسائل التقنية أو إلى اختلاف اللغتين في كثير من مكوناتهما مثل العربية واللغات الهندو أوروبية”. حيث يتضح أنها مستحيلة التحقق طوال ترجمة النص، ولذلك فإنها تشكل سننا يقبل داخله بقية السنن المحددة من قبل (من المثالية إلى التناظرية)، شرط وجود معوقات مثل العوز التقني، ويتصل كما هو واضح بصعوبات ترجمة المصطلحات وبعض الأشكال الخطاطية. ثم اختلاف اللغات، ذلك الاختلاف الذي يؤثر بالضرورة على ضياع الأيقونات الفضائية للتركيب (الرتبة)، وعلى القيم الخاصة بالأدلة بوصفها تقطيعا مخصوصا للعالم، إذ غالبا ما يكون هذا التقطيع مختلفا أغلب الأحيان (مثل تمفصل القرابة في العربية وتمفصلها في الفرنسية، أو تمفصل عمر الإنسان، أو الاختلاف في تذكير وتأنيث نفس المؤشرات الدالة على نفس الشيء الطبيعي: “الشمس / le soleil”..) ويمكن أن نمثل لهذا الإكراه بجملة مترجمة ضمن هذا العدد (كل عانس عازبة Tout vieux garçon est célibataire )(14) واضح أن الترجمة الأيقونية التشابهية مستحيلة هنا لاستحالة توافق تقطيع اللغتين للعالم ولتصوراتهما حول الرموز المرتبطة بهما، لذلك لم يجد المترجم بدا من تحويل الدليل إلى مؤشر منعكس عن الدليل السياقي الماثل في الفكرة التقنية التي يريد الكاتب التدليل عليها. ومثل الاختلاف الجزئي لبعض التركيبات الدلالية، التي قد لا يكون لها معنى محدد في لغة الهدف، أو أن مقابلها الحرفي يبدو نشازا، ومثال ذلك العنوان الثالث، لأن الثقافة العربية وقواعد بلاغتها لن تقبل ذلك الإنجاز. الشي الذي دفع بنعبد العالي إلى تحويل الأيقونة إلى رمز، ثم تهديمه إلى أيقونة جديدة جعلها موضوعا في اللغة-الهدف للدليل في اللغة المصدر، كما سنرى لاحقا. وهكذا فإن الابتعاد الاضطراري عن التشابهية هو أيضا تشابهية، بل إنه عنصر محقق للأمانة والإبداعية (فهي لا تعني الحرفية، فإذا حدث وسمحت اللغة الهدف بترجمة بعض المسكوكات حرفيا نتيجة جعل المترجم باللغة المصدر، فلا يعتبر ذلك ناتجا عن هذا النوع، بل مرتبطا إما بالمتوازية أو المتناظرة، وإذا حدث مرة واحدة طوال نص، فإنه يقبل بفضل قاعدة إهمال المترجم وحسب) بناء على القاعدة والاستثناء فقد ربط مفتاح هذه الترجمة إضافة إلى التماثلية بالأمانة والإبداع ليلتقي وهو يجمع بينهما مع فكرة الأيقونة الحقة، التي هي أيضا (سيمولاكر) من وجهة نظر الفلسفة المعاصرة، والتي توفر الأمانة والإبداع في آن(15).
4.3-الأيقونة المتوازية: ويحددها كالتالي “ونعني بها ما تطابقت بنيتها ولكن العناصر التي تتكون منها مختلفة، كليا أو جزئيا أو توازي مضمونها مع اختلاف في البنيات”.
واضح أن التعريف ينطوي على فرعين: على ما هو متطابق من حيث البنية ومع ما هو متواز من حيث المضمون. إن القول بالتطابق بنيويا مع اختلاف العناصر، يشي بكونها مؤشرا منحلا عن أصلها التركيبي، ويعني ذلك أنها تجتهد في مستوى التركيب وحده لتجعله في اللغة الهدف مؤشرا على أصله في اللغة المصدر، مع وجود اختلاف في المضمون. أي أنها تكتفي بجعل الأيقونة ماثلة في عناصر تجد تمثيلها في تركيب النص، ونستطيع أن نعبر بشكل ملموس وتقريبي عن ذلك، بالحفاظ في الترجمة، على النحو السطحي للنصوص، كما هو محدد من قبل غريماس(16) أو بمحاولة الحفاظ على تدرج عناصر الجملة في النصين رغم ما ينشأ عن ذلك من اختلاف في المعنى. أما الجزء الثاني من التعريف المتصل بتوازي المضمون واختلاف البنيات، فيدل على معنى المؤشر المعنوي. وبتركيب التعريفين الفرعيين نحصل على قسم الدليل الموجه وهو ثانوية الأولانية، أي الأيقونية المؤشرية. فسواء أهمل المعنى أو أهمل التركيب فإن النتيجة واحدة: إنها ضياع الخصائص التمثيلية للدليل المصدر، لأنها لا توجد في التركيب وحده أو المعنى وحده لكنها مؤسسة عليهما معا، وناتجة عنهما معا. وبغض النظر عن طبيعة الممثل في اللغة المصدر (أيقونة أو مؤشرات أصيلة أو منحلة عن رموز) فإن اللقاء به يحيله إلى أيقونة، والأيقونة كما وضحنا مرارا، لا تدرك إلا عند تفجيرها لرمز ما في الذهن، يأتي ليوسط التدلال بوصفه مؤولا مجردا يعين في الذهن موضوعها الوجودي، ويسمح هذا القانون للمترجم بتجسيد ناتجه، الذي هو نسخة ذهنية لفهم الدليل، أما حين يتجسد في نص الوصول، فيصبح في ذاته مؤشرا مركبا على الدليل المصدر. وعلى فهم المترجم المخصوص الذي يكون قد انتقل من السكونية المكتفية بالسنن الترجمي المحايد إلى رد الفعل المضاعف للسنن الترجمي بإدماج سنن فهمه الخاص، لكن هذا لا يصدق إلا على الأدلة التي لا ينطبق عليها الاستثناء الموجود في القانون السابق (التشابهية) بل على الأدلة التي تقبل النقل المحافظ على أيقونتها التمثيلية (أي يصدق على ما هو قصدي وليس اضطراريا).
ويمكن اعتبار ترجمة الشرقاوي لعنوان (la langue d’ADAM بـ لسان آدم) ضمن هذا القانون، لقد تطابقا في البنية واختلفا في العنصر الأول. إن ما قام به المترجم هو تنقيص للخصائص التمثيلية للأيقونة من خلال تحويل الدليل الثاني إلى مؤشر، وبذلك جرد (la langue) خصائصها الأيقونية التي تجعلها في نفس الوقت ممثلا مؤشريا للعضو الفيزيولوجي (لسان) و(للغة بوصفها قواعد). ولقد ترك المترجم اللغة ووجه اللسان، وهو بذلك قد حول الأيقونة إلى مؤشر ممكن لها، لأن اللسان في العربية لا يحدد اللغة بوصفها جهازا رمزيا من القواعد، ولكنه يحدد -تبعا للسان العرب ص 385 ج. 11/15- الكلمة الجارحة وكنائيا الكلمة. ويجب أن لا يغيب عن الأذهان أن ابن منظور نفسه لم يستعمل كلمة اللغة بل استعمل اللسان، إلا بناءا على ذلك، لأنه يقدم للعربي إلا الكلمات أو المفردات التي تداولها أسلافه وتكلموها، وهي مفردات معزولة، أما اللغة فهي التركيب المجرد… وهكذا وهو يحد من الخصائص الممثلة للدليل المصدر ويجعله مؤشرا على جزء منها فقط، مثلما يجعله مؤشرا على رد فعله الخاص، قد تطابقت ترجمته مع قانون الترجمة المتوازية، لأن الترجمة التشابهية كانت ممكنة بفضل توزيع الخاصيتين الممثلتين للدليل المصدر على دليلين مماثلين في تمثيل تلك الخصائص، إذ لا مانع من ترجمة الدليل ترجمة تشابهية وفق الشكل التالي (لسان ولغة آدم) مثلما فعل النحال مع الدليل (لقد أخلص لوعده وتكلم / Il a tenu parole)(17). واضح إذن أن تبني هذا النوع الترجمي لا يكون إلا بقرار من المترجم، بموجبه يحول -قبل فعل الترجمة- الأيقونة إلى مؤشر. ولذلك فإن درجة الأمانة تقل مثلما تقل درجة الإبداعية عن طريق قمع إمكانية الأيقونية..
5.3-الأيقونة المتناظرة: وهي “بمعنى ما يشترك في العناصر أو في الصفات مع ما يناظره” وأقل ما يعنيه التناظر أو التكافؤ “الإشتراك في شيء ما” أو “تكافؤ الوقع” غير أن تعريفه لهذا النوع لا يكتمل إلا بإضافة ملاحظته المستنبطة من تحليله للنماذج الشعرية: “إنها تترجم روح الكلمات ووظائفها بعد تقويم النص وانتقاء المعلومات الوجيهة” وينسجم هذا التعريف مع ثالثانية الأولانية الاستعارية، حيث لا يعمل المترجم وهو يدرك الأيقونة على استحضار الفكرة (الرمز) -وفق الشكل الموصوف سابقا- لكي يدرك موضوعها الممكن وحسب، أو لكي يوسطها لانتقاء إحدى إمكاناتها الممكنة، لكي يحولها إلى وجود (المؤشرية أو المتوازية)، ولكن يجعل الفكرة تحل محل موضوعها. ثم بناء عليها يجسد الترجمة بوصفها نسخة لها: أي مؤشرا وهو مؤشر ثلاثي الأبعاد: يؤشر على الأيقونة-المصدر، وعلى فعل الذات المترجمة، ثم أساسا على (الفكرة) أو الرمز الذي صار موضوعه. وتعتبر ترجمة جمال الدين بن الشيخ الممثل بها من قبله نموذجا لهذا النوع. أما بالنسبة للأدلة التي اتخذناها نماذج لتفنيد أو تأكيد النظرية، فيلائمها العنوان المترجم من قبل بنعبد العالي -لكن يجب التذكير أنه ينتمي إلى التشابهية الأكثر أمانة وإبداعا، لأنه متولد عن إكراه يوجد في استثناءاتها- إن الدليل المترجم (l ‘auteur et ses doubles) إذا ترجم وفق مبدأ التشابهية فلن يقدم إلا ترجمة حرفية تفرز تركيبا تمجه اللغة العربية فضلا عن كونه لن يستطيع إعادة تمثيل نفس الخصائص في أيقونيته-المصدر، لذلك فقد استنجد المترجم بالرمز الذي حوله إلى مؤول حال محلها، ثم جسد نسخته، ويمكن تأكيد ذلك بالتدريج: فالدليل الأول والذي هو في شكل تمثيله الأصلي مؤشر (مثله مثل اسم علم ما، أي أنه بدون رمز) قد حوله إلى مؤشر على رمز صفات فعله ووظائفه: (الكتابة) أما الدليل الثاني والذي لا نعرف العدد الذي يقصد به اثنان أو أكثر، نظرا لاختلاف قيمة الجمع بين اللغتين، والذي لا نستطيع علاوة على ذلك الجزم في تقديم معادلة في العربية، ولو استندنا على فهمه بوصفه مؤشرا: (بدائل، إبدالات، نسخ، تكرارات، تضاعفات..) فقد ربطه بالرمز العام المجرد، الذي يستقطب كل تلك الإمكانيات التي لا تفهم في الواقع إلا بفضله. وهكذا يبدو أنه لم يجد بدا من تعويض الممكن بالضروري الذي صار تحت إرغام التحيين الذي تفرضه الترجمة وجودا بفضل نسخة الرمز، ليتحول في النهاية إلى أيقونة جديدة مخالفة للمصدر في العناصر والتركيب أيضا. إذ لم يعد الدليل الثاني مرتبطا ومتعلقا بالأول عن طريق الضمير، بل أصبحت العلاقة بفضل واو العطف فقط. وبغض النظر عن استثنائية هذا النموذج (من جهة، لأنه ناتج عن إكراهات لغوية وثقافية بالأساس (مبدأ الوحدانية) ولذلك فهو استثناء ضروري ومبدع لأيقونية التشابهية، ومن جهة ثانية لأنه ترجمة لعنوان، والعنوان من نظام سيميائي مخالف للأدلة النصية). فإنه يبقى نموذجا جيدا لهذا النمط الترجمي، -حيث يوضح أن النص -الهدف يتماسف وينأى عن النص-المصدر، إذ لا تكون العلاقة إلا تناظرا يشبه التناظر الذي يوجد بين النصوص المتقاربة من حيث الموضوعات. إن العلاقة تنحو ما يمكن أن نسميه بالتناص الكنائي(18)، أو ما يشبه ما أسماه القدماء بالسرقة الأدبية. ولكي نؤكد هذا الابتعاد، فلنتصور أننا ممتلكون للسنين اللغويين (العربي والفرنسي) وأن كتابين موجودان أمامنا، وقد كتب على الأول عنوان (l ‘auteur) وعلى الثاني (الكتابة والتناسخ) مع عدم وجود إشارة إلى المؤلف والمترجم، فهل نستطيع اعتبار أحدهما ترجمة للثاني -وإن استطعنا اكتشاف علاقة التناص المعنوي-؟ وهل يمكننا أن نترجم من جديد النص الهدف إلى لغة النص المصدر وأن يقع -وفق نفس الفرضية- على النص نفسه؟ طبعا لا.
إن الترجمات التي تقوم على هذا المبدأ رغم توفر إمكانية إنجازها وفق مبدأ التشابهية (كما هو حال العنوان “جماليات المكان” الذي طرح ترجمة لعنوان “la poètique de l’espace”)، هي ترجمات واعية ومقصودة، إنها لا تترجم في الواقع، ولكنها تريد لأصحابها أن يفكروا بأفكار الآخرين وحسب، ولذلك فإنها بالاستناد إلى الأيقونية الفضائية (diagramme) توجد في آخر صف الترجمات وعلى “اليسار”، وذلك دلالة على ابتعادها عن الأمانة، أما مسألة الإبداعية -إذا ما توفرت- فتعود ليس بالضرورة إلى النص الأصلي، بل إلى شكل إنجازها الحر، لأن الإبداعية تشكل غاية داخلية لها.
لقد اتضح أن كل النماذج الترجمية تجد مكانها الطبيعي بسهولة ضمن إحدى الأيقونات، مثلها اتضح أن كل أيقونة تقبل استقبال أدلة جزئية انطلاقا من قواعد تمثل أيقونة أخرى إذا كانت الإكراهات هي المانعة من إنجازها وفق الأيقونة المشكلة للسنن العام للترجمة، كما اتضح بشكل يكاد يكون طبيعيا أن الأمانة نسبية، وأنها تكون إبداعية أكثر كلما كانت أيقونية أولانية. ولا تتحقق تلك الدرجة من الأمانة والإبداعية إلا مع التماثلية على مستوى الأشكال، ومع التشابهية على مستوى الأدلة بمعناها العام، وذلك واضح حتى من النماذج المدروسة هنا: فالعنوان (العين والإبرة) المنجز وفق التماثلية في مستوى الرتبة الفضائية والتركيبية، ووفق التشابهية في مستوى تمثيل الخصائص الأيقونية الممثلة، وحده يقبل إذا ما أعيدت ترجنته إلى الفنرسية، الوقوع على (L oeil et l aiguille) (درجة قصوى من الأمانة) ثم إنه مع ذلك وهو يحتفظ بالخصائص الممثلة للأيقونة في لغتها المصدر يضيف إليها في اللغة الهدف خصائص تمثيلية تمنحها هذه اللغة تلقائيا، فتغنيها، إذ تصبح في العربية مضاعفة، فإلى جانب العين الفيزيولوجي هناك المنبع والجاسوس والربيئة… وكل ما يتصل بها. ونفس الشيء يقع مع الإبرة، التي لا تنحصر في الشيء المتوسل به للخياطة أو النسيج. بل تنضاف إلى أيقونتها خاصيات ممثلة ذات بعد ثقافي وعقائدي مثل دقة المبحوث عنه…
هكذا، ونحن نلمس دقة مقترح الأستاذ مفتاح النظري، الذي وهو يتجاوز حدسية الثنائيات، سواء كانت أخلاقية (أمانة / خيانة) أو تقنية (حرفية / حرة) أو إيديولوجية (تواصلية/دلالية) استطاع تقديم وصف يستطيع في آن أن يصف التجارب الترجمية المنجزة، وأن يرسم الطريق للتجارب الممكنة. ولذلك نرى أنه مقترح يستحق العودة إليه والانطلاق منه…
مجلة الجابري – العدد العاشر
الهوامش:
1 – الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، 1948، ج.1، ص ص 75-76.
2 – Myriam SALAMA-CARR, la traduction à l’époque Abbasside Coll “Traductologie” n°6 Didier 1990
-Amparo Hurtado Albir, la notion de fidélité en traduction, Coll “Traductologie” n°5 Didier 1990.
3 – K.Popper, la logique de la découverte scientifique, ed. Payot, Paris, 1973, pp (36-37à.
4 – H.Meschonnic, Pour la poétique II, Gallimard, 1973, pp (305-436à.
5 – R.Jakobson, Essais de linguistique générale, ed, de Minuit, 1963n p. 79.
6 – عبد السلام بنعبد العالي، الخيانة المضاعفة، مجلة فكر ونقد، س.1، ع.2.
-الترجمة والاختلاف، الحياة الثقافية، وزارة الثقافة تونس، ع.64-65. 1992.
7 – محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، المركز الثقافي العربي، 1996.
8 – نفسه، ص 210.
9 – H.Gottner, Methodologie des théories de littérature in A.K.Varga, et A.Théorie de littérature, ed. Picard, Paris, 1981, pp. 15-16.
10 – محمد مفتاح، مفهوم الحقيقة عند بورست، “الحقيقة المجتمعية” مجلة فكر ونقد، ع.2، 56.
11 – C.S.Peirce, Ecrits sur le signe, Traduits.. par G.Deledalle, ed.Seuil, p.149.
12 – نفس المرجع والصفحة.
13 – نفس المرجع، ص 150.
14 – انظر مقال ياكوبسون المترجم من قبل عبد المجيد جحفة ضمن هذا العدد.
15 – عبد السلام بنعبد العالي، أسس الفكر الفلسفي المعاصر (مجاوزة الميتافيزيقا) توبقال، 1991. (فصل النموذج والنسخة)
16 – A.J.Geimas, Du Sens, Essais sémiotiques, Seuil, 1970, pp. (157-183)
17 – عبد الفتاح كيليطو، العين والإبرة، ترجمة مصطفة النحال، الفنك، 1996، ص 68.
18 – عبد اللطيف محفوظ، البناء والدلالة في الرواية.. رسالة جامعية، (د.د.ع)، كلية الآداب الرباط. 86/87، ص 206.
(*) لا بد من افتراض أن التحليل يقوم انطلاقا من وعي ذات تدرك أن “ازيشييل وهولدة” اسمان علامان لمذكر وأنثى، وأنهما بفعل ذلك ليسا انحلالا لرمزين، (لأن اسم العلم وهو مؤشر أصيل)، بل نسختان لؤشرين. ويجب أيضا افتراض أنهما ليس دالين على واقعة تاريخية مترسبة في الذهن الجماعي مثل علاقة قيس وليلى في ثقافتنا، لأن ذلك سيجعل التحليل معقدا جدا.
(**) المثال يعطيه بورست.
(*) هناك فكرة مشوشة على صورة الحب في العربية ناتجة عن تحريف استعاري سببه الاستعمال، يقول المرء بموجبها (أحب زوجي) إن كلمة أحب هنا استعارة لأسكن وأرتاح لزوجتي، فلا معنى لها إلا بوصفها أيقونة لمؤشر دقيق مستعمل في الدارجة المغربية (أبغي) الذي له معنى التفوق والظلم والامتلاك القسري (الأبيسية) المشوبة بالرغبة. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم استعمل السكن للتعبير عن العلاقة الزوجية السوية، بينما استعمل الحب لعلاقة الخالق بعباده الصالحين ولعلاقة هؤلاء به وبرسوله(ص)…
(*) يستعمل مفتاح كلمة أيقون، لكننا نفضل استعماله السابق لها (أيقونة) لكي يستقيم الإسناد إلى الترجمة، وأيضا لتحقيق توافق أيقوني مع دلالتها بوصفها رحما لتوليد المعاني المتعددة والمختلفة لنفس الدليل، فهي رحم للمعاني، ثم إنها لكي تولدها تستدعي الرمز الذي يخصبها، لكي يتولد مع كل إخصاب ابن ما وجودي هو المؤشر…
(*) لقد ترجمت إلى الفرنسية من قبل البعض بـ Topologie عوض Diagramme وبناء على قانونها درجنا العناوين الثلاثة التي سنستعملها: العين والإبرهة فلسان آدم فالكتابة والتناسخ، لكي تكون في علاقة مع الأيقونات الترجمية التي تنضبط، في إنتاجها، لقوانينها
(*) إن هذا التعدد عن تحويل الأيقونة إلى رمز، تم تحويل ذلك الرمز إلى أيقونة جديدة هي نسخة، ولأن عملية التحويل خاضعة دائما لمعرفية الذات (بمعناها الواسع) فإنها شاسعة الإمكانيات، كما وضحنا في تفسير الخلفية الإبستيمولوجية لاعتبار الأدب أيقونة.