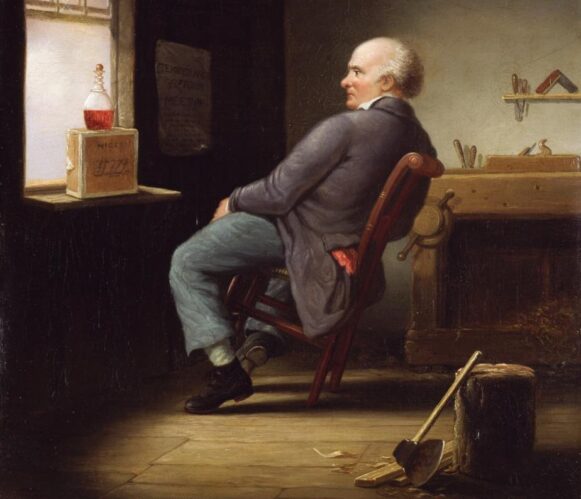قبل بضع سنواتٍ في واحدةٍ من زياراتي لمدينة نيويورك، وجدت نفسي في محادثةٍ مثيرةٍ مع سائق سيارة أجرة، أجد الآن صعوبةً في تذكّر اسمه، لكنه كان باكستانياً كما أخبرني، سألني حينها من أين أنا، فأجبته بأني من إيطاليا، وكان متفاجئاً لأن تعداد سكان إيطاليا قليل وأننا لا نتحدث الانجليزية، بعدها باغتني بالسؤال التالي: من هو عدوكم؟ ونظراً لرد فعلي فقد بدأ يشرح سؤاله بصبرٍ بأنه يود معرفة العدو الذي نقف ضده ونقاتله على مر العصور سواءً للمطالبة بأراضٍ تاريخية، أم لصراع عرقي أم ترسيم الحدود أو أي أسبابٍ أخرى، أخبرته أننا لسنا في حالة حرب مع أحد، لم يرق له جوابي فبدأ يستفسر من جديد بأنه يود معرفة أعداءنا التاريخيين، أولئك الذين يريدون قتلنا ونريد قتلهم، أعدت عليه بأننا لا نملك أعداءً وأن آخر حربٍ شاركنا فيها كانت الحرب العالمية الثانية، إذ بدأنا الحرب في جانبٍ وانتهينا في الجانب الآخر، لم يكن راضياً عن إجابتي، فكيف لبلدٍ ما ألا يملك عدواً، حينما خرجت من السيارة تركت له دولارين بقشيشاً كتعويضٍ عن البلادة الإيطالية المحبة للسلام، بعدها بقليلٍ فقط تنبهت كيف كان يجب أن أجيب، فنحن لا نملك أعداء خارجيين أو بالأصح لسنا قادرين على تحديد من هم هؤلاء الأعداء؛ وذلك لأننا وبشكلٍ متواصل في حالة حرب داخلية، مثلاً بيزا (Pisa) ضد لوكا (Lucca)، وغلفس (Guelphs) ضد غيبلينس (Ghibellines)، والشمال ضد الجنوب، والفاشيون ضد اليسار، والمافيا ضد الدولة، وحكومة بيرلسكوني ضد السلطة القضائية، من المؤسف أن الحكومتين اللتين تزعمهما رومانو برودي لم تسقطا بعد، وإلا كان بإمكاني أن أشرح للسائق معنى أن تخسر الحرب بنيران صديقة.
كلما أمعنت النظر في محادثتنا تلك أصل إلى ذات النتيجة، بأن من سوء حظ إيطاليا طوال السنوات الستين الماضية غياب عدوٍ حقيقي، فتوحيد إيطاليا كان مرده مع الشكر وجود الامبراطور النمساوية، أو على حد وصف جيوفاني بيرشي: نتيجة الإزعاج الجيرماني، لقد كان موسوليني قادراً على الاستمتاع بدعم الجماهير له حينما وصف الانتصار القاسي في الحبشة بانتقام إيطاليا على الهزيمة المذلة في معركتي جوندت وعدوة، وأن اليهود أقلية ثرية تسيطر على الدولة وتسعى كما يدّعي لظلمنا، لننظر إلى ما حدث في الولايات المتحدة حينما اختفت امبراطورية الشر، وبدأ الاتحاد السوفييتي العظيم بالتفكك، كانت أميركا تواجه خطر فقدان هويتها حتى جاء ابن لادن – مع العرفان لخدماته المقدمة في قتاله ضد السوفيات- ومد يده الرحيمة مما أعطى لبوش فرصة ابتكار أعداء جدد؛ وهذا ما قوّى الشعور بالهوية الوطنية وكذلك سلطة إدارته.
إن وجود عدوٍ ليس مهماً من أجل تعريف هويتنا فقط، بل لوضع عوائق يتم من خلالها تحليل منظومة قيمنا والتغلب عليها، وكذلك استعراض هذه القيم، لذا ففي حال غياب العدو يجب علينا أن نوجده، وجديرٌ بالذكر أن عملية ابتكار العدو هذه مرنةٌ بشكلٍ لا يضاهى، ففي حالة فوضويي فيرونا يكفي أي شخصٍ أن يقول بأنه لا ينتمي لهم حتى يكون عدوهم، غير أننا لا نهتم كثيراً بالظاهرة التي تكاد تكون طبيعيةً في تعريف العدو، إنما في العملية التي يتم من خلال ابتكار هذا العدو وشيطنته.
في خطاباته ضد لوشيوس كاتالين لم يكتفِ قنصل روما شيشرون بإقناع مجلس الشيوخ بوجود عدوٍ تمثّل بكاتالين طالما هو يمتلك أدلة إدانته بالتآمر، بل قام بتوسيع دائرة الأعداء لتشمل أصدقاء الأخير، حيث اتهمهم بالانحلال الأخلاقي إضافةً إلى التآمر، وقاصداً تفريقهم عن بقية الرومانيين وصفهم بأنهم ” متخمون وسكارى يقضون أوقاتهم في أحضان نساء منحلات أخلاقياً، يتوجون رؤوسهم بأكاليل الغار، ويتجشأون بكلماتهم، ويرون أن جميع المواطنين الطيبين يجب قتلهم، وأن المدينة يجب أن تأكلها النار، كل واحدٍ منا يراهم بشكلٍ دائمٍ وواضح، أشكالهم وملامحهم جميلة، ولحالهم مشذبةٌ بشكل جيد، ويرتدون ألبسةً تسترهم حتى أقدامهم، إنهم يحاولون من خلال مظهرهم هذا ستر حقيقتهم، فهؤلاء الشباب بارعون جداً، غير أنهم لم يتعلموا كيف يحبون ويُحبون، ولا كيف يغنون ويرقصون فقط، بل تعلموا أيضاً كيف يزرعون خناجرهم ببراعة، وكيف يستخدمون السم للقتل”، إن الحكم الأخلاقي لشيشرون يقترب من الحكم الأخلاقي للقديس أوغسطين الذي فرّق بين المسيحي والوثني، حيث الأخير يحضر عروض السيرك والمسارح والمدارج، ويحتفل بطقوس العربدة، فالأعداء مختلفون عنا ويمتلكون تقاليد تختلف عن تقاليدنا.
إن الصورة المصغرة للاختلاف تتمثل بالغريب الأجنبي ففي العرف الروماني كانت صورة البربري رجلٌ ملتحي وأفطس الأنف، وكما هو معلوم فإن كلمة بربري في اللاتينية تشير إلى خللٍ في لغة المتكلم، وبذا فإن معنى كلمة البربري بأنه الذي لا يجيد الكلام، وبذا فهو بالضرورة لا يجيد التفكير، يصبح من البدهي هنا أن الأشخاص الذين نراهم أعداءنا ليسوا الذين يشكلون تهديداً مباشراً لنا، وهذا الأمر كان ينطبق على البرابرة فيما مضى، بل الأشخاص الذين نرى فيهم تهديداً حسب المصلحة، وبدلاً من أن يقوم هذا التهديد بإيضاح طبيعة الاختلافات بيننا وبين من نراهم أعداءنا، فإن الاختلاف ذاته يغدو رمزاً نراه تهديداً، كان السيناتور تاكيتوس (Tacitus) يصف اليهود بالتالي: “كل الأشياء التي نعتقدها مقدسةً هي مدنسةٌ بالنسبة لهم، وما هو منحلٌ وفاسق عندنا هو أخلاقيٌ عندهم”، يتبادر إلى الذهن كيف كان الانجليز يصفون الفرنسيين بأنهم آكلو ضفادع، وكيف اتهم الألمان الإيطاليين بالمبالغة بأكل الثوم، “اليهود غريبون عنا لأنهم يحرمون أكل الخنزير، ولا يضعون الخميرة في الخبز، ولا يعملون شيئاً في السبت، يتزوجون من بعضهم فقط، ويمارسون الختان ليس لأسباب صحية أو دينية؛ إنما ليظهروا اختلافهم عن الآخرين، يدفنون موتاهم، ولا يبجلون القيصر”، بعد استعراض طبيعة اختلاف التقاليد “الختان، السبت” يذهب تاكيتوس بعيداً بالتأكيد على فكرته بإضافة عناصر أسطورية، “يصنعون صوراً مقدسةً لحمار، يحتقرون ذويهم، يخونون بلدانهم والآلهة”، لم يجد الكاتب والقاضي الروماني بليني الأصغر تهماً تسيء للمسيحيين فأفعالهم كما يصفها فاضلة، غير أنهم كانوا يرفضون تقديم القرابين للامبراطور لذا أرسلهم للموت، وهذا العناد في أمرٍ بدهي وطبيعي هو ما أوحى باختلافهم.
تطورت مفاهيم الاختلاف بعد أن صارت العلاقات السياسية والاجتماعية أكثر تعقيداً عما مضى، ومعها تطور مفهوم العدو أيضاً فلم يعد الشخص القابع خارج مجالنا ويظهر اختلافه من بعيد، بل الشخص الذي يعيش بيننا، والذي نسميه هذه الأيام بالمهاجر، والذي يتصرف بغرابةٍ بالنسبة لنا، ويتكلم لغتنا بشكلٍ غير جيد، فهو الشخص الذي نستخدم فيه هجاء الشاعر الروماني جوفينال (Juvenal): الشخص الماكر، والمخادع، والوقح، واليوناني الفاسق، والقادر حتى على إغواء جدة صديقه.
إن الزنجي وبسبب لونه يظل غريباً أينما ذهب، ففي الموسوعة الأميركية الأولى المطبوعة من قبل توماس دوبسون (Thomas Dobson) سنة 1798 تم تعريف مفردة الزنجي بالتالي:”بالنسبة لبشرة الزنوج الذين نلتقيهم فإنها تتكون من عدة أطياف لونية، وفوق هذا فإنهم مختلفون تماماً من ناحية ملامح وجوههم عن بقية البشر، فهم بخدود مستديرة، وذقون بارزة، وجباه كبيرة بشكلٍ غريب، وأنوف فطس وكبيرة، وشفاه غليظة، وآذان صغيرة، وبالنسبة للنساء الزنجيات فإن أحواضهن مضغوطة إلى الخلف، وأردافهن كبيرة مما يعطي المؤخرة شكل السرج، عدم التناسق في الأشكال هذا يوحي بالبشاعة، وأن الرذائل جزءٌ من حياة هذا العرق التعيس: الخمول والخيانة والانتقام والوحشية والوقاحة والسرقة والكذب والإغواء والبذاءة، هذه الصفات أدت إلى وضع حدٍ لجوهر القانون الطبيعي، وأخرست تأنيب الضمير، إنهم غرباء عن أي شعورٍ بالشفقة تجاه الآخرين، ومثالٌ سيءٌ وواضحٌ لفساد الإنسان إذا تُرك بدون رادع”.
الزنجي بشعٌ، وكذلك العدو يجب أن يكون بشعاً لأن الجمال صفةٌ ملازمةٌ للطيبين والأصدقاء، في العصور الوسطى كان الكمال واحدٌ من الصفات الجذرية للجمال، أوفي عبارةٍ أخرى امتلاك الكائن صفاتٍ معينة يصير معها معياراً للنوع الذي يمثله، فالإنسان الذي فقد عضواً أو يمتلك عيباً في قامته مثل القصر الواضح كان يوصف بالبشاعة، لهذا السبب كان العملاق بوليفيموس (Polyphemus)ذو العين الواحدة أو القزم مايم يشكلان العدو بدهياً، كان المؤرخ والدبلوماسي الروماني بريسكوس البانيوني في القرن الخامس (Priscus) يصف أتيلا (Attila) الهوني بأنه “شرير المظهر فهو قصير القامة وواسع الصدر وكبير الرأس، له عينان صغيرتان ولحية رمادية صغيرة وأفطس الأنف وداكن البشرة”، غير أن المثير في الأمر أن ملامح أتيلا تشبه ملامح الشيطان كما يصفه رودلوفوس غلابر (Rodolfus Glaber)، فقد وصفه بعد موته بخمسة قرون بأنه “نحيل الوجه، له عينان سوداوان عميقتان وجبهة عريضة تملؤها التجاعيد، أفطس الأنف وفمه بارز وشفاهه متورمة وله ذقنٌ حاد وبارز، وشعره مجعدٌ يشبه صوف الماعز، آذانه بارزة ويغطيها الشعر، وأسنانه تشبه أنياب الكلب، ورأسه كبيرة وقامته متوسطة، وصدره بارزٌ وله حدبةٌ في ظهره”[1].
حينما أرسل الامبراطور أوتو(Otto) الأول ليتوبراند الكريموني (Liutprand of Cremona) مبعوثاً إلى بيزنطة سنة 968 وواجه حضارةً غير معروفةٍ حتى اليوم، رأى الامبراطور البيزنطي يفتقد لصفات الكمال فوصفه بالتالي: “لقد وقفت أمام نقفور، إنه مخلوقٌ متوحش، قزمٌ له رأسٌ كبيرة، عيناه الصغيرتان تشبهان عيني الخلد، ولحية رمادية وصغيرة وبشعة، عنقهٌ قصيرةٌ جداً، داكن اللون كما لو كان حبشياً – إنه الشخص الذي لا ترغب أن تلقاه صدفةً في الظلام – كبير البطن، صغير الحوض وفخذاه كبيران، له ساقان قصيران، وأقدامه مفلطحة، يرتدي ملابس كريهة الرائحة وقد عفا عليها الزمن”[2]، كريه الرائحة، الأعداء وبشكلٍ ثابت كريهو الرائحة، كتب عالم النفس الفرنسي إدغار بيريلون (Edgar Berillon) في بداية الحرب العالمية الأولى واصفاً الألمان بأنهم يتبرزون أكثر من الفرنسيين لذا فإن روائحهم كريهةً وبشكلٍ مبالغ[3]، إذا كان البيزنطي كريه الرائحة، فإن المسلم أيضاً كريه الرائحة كما يقول الراهب فليكس فابري (Felix Fabri) من القرن الخامس عشر: “للمسلمين روائح تسبب الغثيان، لذا فهم يتوضأون بشكلٍ مستمرٍ، وبما أن روائحنا طيبة فإنهم لا يمانعون استحمامنا معهم، لكنهم في هذا الأمر غير متساهلين مع اليهود، والذين تصدر منهم روائح لا تطاق أبداً وبشكلٍ أسوأ من المسلمين… يظهر المسلمون السرور برفقتنا نحن الذين لا روائح كريهة لنا”[4].
بالنسبة لجوسيبي جيستي (Giuseppe Giusti) فإن النمساويين كريهو الرائحة، فعندما وصل إلى كاتدرائية القديس أمبروجو في ميلان كتب هذه الانطباعات:
“دخلت الكاتدرائية المليئة بالجنود
الجنود الذين أتوا من الشمال
بوهيميون وكروات
مصطفون كالأعمدة في الكروم
لقد انسحبت سريعاً، فالوقوف هناك
بين الرعاع والأنفاس القذرة
يثير فيّ شعور التقزز، ويصيبني بالغثيان
ويحرمني حتى الشعور بلهيب الشموع
المعلقة على مذبح بيت الرب المقدس
المذبح الملطخ بالشحوم”[5]
الغجري أيضاً وبالضرورة كريه الرائحة بما أنه يتغذى على الجيف كما يخبرنا تشيزاري لومبروزو (Cesare Lombroso)[6]، ذات الأمر ينطبق على روزا كليب عدوة جيمس بوند في رواية إيان فيلمنج “من روسيا مع الحب 1957” فهي ليست روسيةً سوفييتيةً فقط بل وسحاقية: “واقفةٌ في الرواق قبالة الباب الأصفر، استنشقت تاتانيا رائحة الغرفة النفاذة حينما سمعت صوتاً يناديها بأن تدخل، فتحت الباب فغمرتها رائحة الغرفة، حينها كانت تقف قبالة طاولةٍ مستديرةٍ يعلوها مصباحٌ مضاء، كانت الرائحة تشبه رائحة المترو في مساءٍ حار، ورائحة الزنخ الذي تتسبب به الحيوانات، فالناس في روسيا على كل حالٍ تفوح منهم الروائح الكريهة سواءً استحموا أم لا، وتكون الحال متناهيةً في السوء إذا لم يستحموا، كانت تاتانيا تتفحص المكان بغبطةٍ حين فتح باب غرفة النوم وظهرت روزا، كانت ترتدي ثياب نومٍ برتقالية اللون شبه شفافة، أظهرت من طية اللباس إحدى ركبتيها وكانت تشبه جوزة هندٍ مصفرّة، وقفت كما لو كانت عارضة أزياء، بعد ثوانٍ نزعت روزا كليب نظارتها وتبين لتاتانيا وجهها العاري إذ كانت تضع الماسكارا وأحمر شفاه، ثم وقفت بجوار الأريكة ومسحت عليها بيدها وقالت: أشعلي الضوء فالمفتاح هناك جوار الباب، وتعالي واقعدي بجواري، علينا أن نتعرف على بعضنا بشكلٍ أفضل”.
منذ فجر المسيحية واليهودي يوصف بأنه وحش ذو رائحة كريهة، فهو ليس عدو المسيح فقط، ولا العدو الأول للمسيحية، ولا حتى عدو الإنسان بل عدو الله؛ “فهو برأسٍ تلتهب كشعلة، عينه اليمنى محتقنةٌ بالدم، واليسرى كعين القط خضراء ولها بؤبؤين، وأجفانه بيضاء، وشفته السفلى كبيرة، وعظام فخذه اليمنى ضعيفة، وأقدامه ضخمة، وإبهامه مفلطح وطويل”[7]، “عدو المسيح سيولد من بين اليهود، من تزاوج رجلٍ وامرأةٍ تماماً كبقية البشر، لكن ليس كما يقول البعض من عذراء، ففي بداية تخلقه سيدخل الشيطان إلى رحم أمه ويغذيه بقوته، وستظل قوة الشيطان دائماً معه”[8]، “ستكون له عينان تشعان لهيباً، وآذانٌ كآذان الحمار، سيكون له أنف وفم الأسد، لذا سيرسل بين النيران الرجال لارتكاب أبشع الجرائم، وفي وسط الصراخ المليء بالخزي سيجعلهم ينكرون الله، وسيثيرون بكافة قدراتهم النتن لتشويه أسس الكنيسة؛ مستخدمين أبشع الطرق، وسيكشرون بسخريةٍ عن بشاعة ناب الأسد”[9] إذا كان عدو المسيح يولد بين اليهود فإن صورته بالضرورة تعكس صورة اليهود ككل، سواءً كان على المستوى الشعبي في عداء السامية أم الديني أم البرجوازي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لذا فلنبدأ مع وجه اليهودي: “وجوه اليهود زرقاء، وأنوفهم معقوفة، وعيونهم عميقة، وذقونهم بارزة، تتحرك عضلات الفم بشكلٍ واضحٍ إذا تكلموا… اليهود أيضاً عرضةٌ للأمراض مما يوحي بفسادٍ بالدم، كالجذام في أزمان ماضية والاسقريوط والأمراض المشابهة له كالسل والرعاف الآن، يقال أن روائح أفواه اليهود دائماً كريهة؛ ويرد البعض هذا الأمر لاستخدامهم المفرط للثوم والبصل، بينما يرى آخرون أن السبب ولعهم بلحم الأوز، وهذا ما يجعلهم سوداويون ومتشائمون”[10].
في زمنٍ لاحق كتب الموسيقار ريتشارد فاغنر يصف اليهود ولكن بطريقةٍ معقدة لها علاقةٌ بالصوت والسلوك يقول: “هناك شيءٌ غريبٌ يتعلق بالشكل الخارجي لليهود، مما يجعل هذا العرق بغيضٌ جداً، فبشكلٍ غريزيٍ نتمنى ألا يكون هناك ما هو مشتركٌ معهم، فمن المستحيل أن نتصور يهودياً يلعب على المسرح دور بطلٍ أو عاشق، دون الشعور بشكلٍ غريزي أن هناك ما هو غير لائق، لكن السبب الأهم الذي يمنعنا من تقبل الأمر هو النبرة التي يتحدث بها اليهودي… إزعاجٌ شديدٌ وصفيرٌ حادٌ يصم الآذان في حال تكلموا، اليهودي يستخدم كلماتٍ وجملاً غريبةً عن لغتنا الوطنية… حينما نسمع يهودياً يتحدث فإن انتباهنا يتركز على طريقته في الكلام لا كلماته التي ينطقها، إن هذا يشير إلى الأهمية الكبرى في شرح التعابير الموسيقية التي تتضمنها أعمال اليهود، إن الاستماع إلى اليهودي يتحدث يشكّل إهانةً لنا؛ لأن حواره يخلو من أي تعابير إنسانية… من الطبيعي أن نجد اليهودي يرث موت الجانب العاطفي في شخصيته، وهذا يتجلى في أبهى تعبيرات الإنسان عن عواطفه وهو الأغاني، ولعلنا نجد أن اليهود يتميزون في كثيرٍ من الفنون باستثناء الغناء، كما لو أن الطبيعة قد حرمتهم هذه الموهبة”[11]، كان هتلر يبدو أكثر رقةً وهو يضع الحدود بين اليهود والألمان حتى وإن كان كلامه لا يخلو من نبرة حسد: “بالنسبة لجيل الشباب فإن موضوع اللباس يجب أن يكون من اختصاص التعليم… فإذا كان معيار الجمال هذه الأيام لا يتعلق بشكلٍ مباشرٍ بطريقتنا الخرقاء باللباس، فإنه من غير الممكن لنا أن يتم تضليل آلاف الفتيات الألمانيات من قبل اليهود اللقطاء المتعجرفين”[12].
من ملامح الوجه مروراً باللباس يقودنا هذا إلى صورة العدو اليهودي المتمثلة في قتل الأطفال وشرب دمائهم، وقد ظهرت هذه الصورة النمطية عنهم في أوقاتٍ مبكرةٍ، مثلاً في واحدةٍ من قصص الانجليزي تشوسر(Chaucer) المعنونة بـ”قصص كانتربري”، حيث تتشابه أحداث هذه القصة مع واحدة من قصص القديس سيمونينو الإيطالي (Simonino of Trento) إذ تروي قصة صبيٍ مرّ في حيٍ يهودي وهو يغني: “يا أم سيدنا المخلص” حيث تم قطع عنقه ورمي جثته في حفرة، نموذج اليهودي الذي يقتل الأطفال ويشرب دماءهم ينحدر من موروثٍ معقد، فقد ظهرت بعض هذه النماذج في بداية ظهور المسيحية مع تشكل مفهوم الهراطقة، يظهر هذا المثال ما نود الإشارة إليه: “في المساء وحين أشعلنا المصابيح وبدأنا إحياء ذكرى آلام المسيح، أخذوا فتياتٍ اختاروهن بعنايةٍ من أجل إقامة طقوسهم السرية في أحد المنازل، هناك أطفأوا المصابيح حتى لا ينتبه لوجودهم وارتكابهم الفواحش أحد، لقد أفرغوا المكان كي يستطيع الجميع حتى الأخوات والبنات الاشتراك بالطقس الفاجر، كانوا يظنون أنهم يقدسون الشيطان بانتهاكهم حرمة الزنا والوهق، وحين تنتهي الطقوس يعودون إلى بيوتهم منتظرين تسعة أشهر بانتظار ولادة الأطفال، حينها يجتمعون مرةً أخرى في ذات المكان، وفي اليوم الثالث للولادة يقومون بأخذ الأطفال ثم يقطعون أطرافهم الغضة ويفرغون دماءهم في أواني معدة مسبقاً، بعدها يقومون بإحراق الأطفال الذين ما زالوا يصارعون الموت، ويخلطون الدم بالرماد لصنع توابل يضيفونها إلى الطعام والشراب، وكمن يقوم بدس السم في الخمرة بسريةٍ تامةٍ تكتمل طقوس هذه الطائفة”[13].
يبدو العدو مختلفاً وبشعاً لأنه أحياناً من طبقةٍ اجتماعيةٍ أقل، تظهر الإلياذة ثيرسيتيس على أنه مهلهل الثياب وأعرج القدم، كتفاه محدودبان جداً، ويبدو كما لو أنه رأسه خرج من صدره، ولأنه من طبقةٍ أقل من أغاممنون وأخيل فهو يحسدهم، غير أن هناك فارقٌ بسيطٌ بين ثيرسيتيس وفرانتي بطل رواية “قلب” للإيطالي إدموند دي أميسي (Edmondo de Amicis)، فبينما قام أوديسيوس بمهاجمة ثيرسيتيس وإدمائه فإن المجتمع عاقب فرانتي بالسجن:” 25 أكتوبر: وبجواره كان يجلس فتىً قويٌ ذو نظراتٍ جريئة اسمه فرانتي، وقد تم طرده من مدرسةٍ أخرى منذ مدةٍ قصيرة.
21 يناير: هناك فتىً واحدٌ كان قادراً على الضحك حينما كان ديروسي يتكلم عن جنازة الملك، إنه فرانتي وأنا أكرهه جداً؛ إنه شرير، فحينما كان يأتي أحد الآباء إلى المدرسة لتأديب ولده كان فرانتي يرى هذا الحدث مضحكاً، وحينما يبكي أحد الأولاد يضحك، لكنه كان يخاف كاروني، لقد ضرب ابن البناء بسبب أنه كان صغير الجسم، وكان يسخر من كروسي لأن أحد أطرافه معاقة، وكان يتهكم على بريكوسي الذي يحبه الجميع، وكان يطلق النكات على روبيتتي، لكن المفاجئ أنه في السنة الثاني كان يمشي بواسطة عكازين بعد أن أنقذ طفلاً، إنه يتهكم بكل الذين يبدون أضعف منه، وحينما تكون هناك مصيبة فإنه يصبح متوحشاً ويؤذي كل من حوله، هناك شيءٌ مغرورٌ توحي به تلك الجبهة الصغيرة والعينان الداكنتان، واللتان يحاول إخفاءهما دائماً بقبعته، إنه لا يخاف شيئاً، فهو يضحك في وجه المعلم، ويسرق وقتما استطاع، ويكذب ببجاحة، ويتشاجر بشكلٍ دائم، يُحضر إلى المدرسة دبابيس كبيرة ليخز بها زملاءه بالفصل، ينزع أزرار معطفه ومعاطف الآخرين ليلعب بها، يحمل في حقيبته الممزقة، كتبه ودفاتره المتسخة، ومسطرته المعوجة، يعلك قلمه ويقضم أظافره، ملابسه ممزقةٌ بسبب مشاجراته التي لا تنتهي… كان المعلم يتظاهر بأنه لا يهتم بسلوكه السيء وهذا ما كان يجعله يتمادى، وحينما كان يعامله المعلم بلطف فإنه يهينه، وإذا قرر معاقبته وضع يديه على وجهه كأنه يبكي وهو في الحقيقة يضحك.
المجرم والعاهرة وبشكلٍ بدهي أبرز أمثلة البشاعة، وذلك بسبب وضعهم الاجتماعي، لكن بالنسبة للعاهرة فإن الأمر يتعلق بعالمٍ تبرز فيه العداوة الجنسية، والتي من الممكن أن نسميها العنصرية الجنسية، فبالنسبة للرجل الذي يكتب ويسيطر، أو يسيطر من خلال الكتابة فقد صور المرأة منذ زمنٍ قديم بشكلٍ عدائي، لذا فيجب ألا ننخدع بتلك الصورة الملائكية للمرأة، خاصةً إذا ما علمنا أنها نتاج الأدب العظيم الذي كتبه بالغالب أناسٌ نبلاء وطيبون، فعالم الأدب الهجائي وبتأثيرٍ من المخيلة الشعبية كان يمارس شيطنة المرأة منذ العصور القديمة مروراً بالوسطى حتى الأزمنة الحديثة، بالنسبة للعصور القديمة سنكتفي بمثالٍ واحد من ماركوس مارشالييس (Martial): “بالنسبة لكِ يا فيتسويلا التي صمدت أمام ثلاث مائة قنصل، لا تملكين سوى ثلاث شعرات في رأسك، وأربعة أسنان، صدرك يشبه صدر الجراد، ساقاكِ يشبهان ساقي نملة، تمشين وجبينكِ مجعدٌ أكثر من تجاعيد ثوبك، ثدياكِ يشبهان ثديي بقرة، نظراتكِ تشبه نظرات البوم في الصباح، رائحتك تشبه رائحة الماعز، أردافكِ ذابلةٌ كمؤخرة بطة… وحده مشعل الجنازة يستطيع اختراق فرجك”[14].
من يستطيع كتابة هذا المقطع؟ “المرأة حيوانٌ غير مكتمل، تحكمها عواطف من غير الممكن القبول بها لعفنها، دعونا ننظر في هذا الأمر، لا يوجد حيوانٌ أقذر من المرأة، حتى الخنزير الذي يتمرغ بالوحل لا يجاريها بشاعة، وإذا كان هناك من يرغب بإنكار هذه الحقيقة، عليه أن يتفحص أعضاءها الحساسة، فالمرأة تخفيها وهي تشعر بالعار”[15]، إذا كان جيوفاني بوكاتشيو الرجل الفاجر وغير المؤمن يفكر بهذه الطريقة فنستطيع أن نتخيل كيف كان يفكر أخلاقيو العصور المظلمة، وماذا كتبوا للتأكيد على وصية باول الرسول، حيث يؤكد على أنه إذا كان من الممكن مقاومة الإغواء فإنه من الجيد عدم تجربة اللذة الجسدية، في القرن العاشر استحضر الراهب أودو الكلوني هذه الفكرة بقوله: “جمال الجسد ظاهري فقط، فإذا استطاع الرجال النفاذ بأنظارهم إلى ما وراء الجلد فإنهم سيصابون بالقرف جراء النظر إلى المرأة فقط، فخلف هذا الحسن يوجد الدم والبلغم والمخاط والمرارة، تأمل ما هو موجودٌ في الأنف والبلعوم والمعدة وفي كل مكانٍ من جسدها ستجد القذارة، ونحن ممنوعون من لمس القيء والقذارة، حتى بأطراف أصابعنا فكيف بنا نقوم باحتضانها”[16].
انطلاقاً مما يمكن لنا تسميته هنا بكراهية النساء الطبيعية نصل إلى أحد نتاجات الحضارات الحديثة المميزة، وهو تكوين الساحرة، ورغم أن الساحرة كانت معروفةً في العصور القديمة وهنا نود ذكر مثالٍ واحدٍ ورد في الحمار الذهبي لأيوبليسيوس وكذلك هوراس: “لقد رأيت كانديا بأم عيني، ترتدي ثياباً سوداء حافية القدمين وشعثاء الشعر، تعوي مع ساغانا، كان شحوبهما مما لا يطاق النظر إليه”[17]، كان السحرة والساحرات في العصور القديمة والوسطى جزءاً من الاعتقاد الشعبي، وكان يُعتقد أنهم يمثلون إلى حدٍ ما حالاتٍ نادرة من سيطرة الأرواح الشريرة عليهن.
في عصر هوراس لم تكن روما تشعر بأن الساحرات يشكلن تهديداً، وكان السحر في العصور الوسطى يعتبر ظاهرة إيحاء ذاتي، أو في كلماتٍ أخرى كانت الساحرة شخصاً يُعقتد أنها مجرد ساحرة فقط، كما تشير إلى ذلك شريعة الأساقفة في القرن التاسع: “لقد أغوى الشيطان بعض النساء المنحلات مما جعلهن يتوهمن أنهن يمتطين ظهور الوحوش في الليل صحبة جمعٍ من النساء، ظناً أنهن قد امتلكن قدرة الآلهة ديانا… على الرهبان وعظ رعايا الإله بأن هذه الأشياء التي يتخيلها المؤمنون ليست من فعل الروح القدس، بل من فعل الشيطان، إن الشيطان ذاته قد تقمص دور ملاك وامتلك عقول هؤلاء النسوة المسكينات وتحكم بهن، بسبب شكوكهن وفساد عقيدتهن”.
مع بزوغ فجر الأزمنة الحديثة كان يُظن أن الساحرات يلتقين بشكلٍ ما للاحتفال بالسبت الخاص بهن، حيث يطرن ويتحولن إلى أشكال حيوانية، وبذا فقد صرن أعداء للمجتمع، ولهذا السبب فقد تم تعقبهن ومحاكمتهن وعقابهن بالموت حرقاً، وحتى لا يضيع جهدنا فالمجال هنا لا يسمح لنا بدراسة متلازمة السحر، تلك المشكلة المعقدة سواءً كانت الساحرة كبش فداء في أزمنةٍ واجهت هزاتٍ اجتماعية عميقة أو أثر الشامانية السيبيرية أو حتى ظاهرة دراسة المجتمعات البدائية، ما يهمنا هو تواتر الطريقة التي يتم بها صناعة العدو، فبالشكل المشابه لحالة الهراطقة واليهود، كان كافياً لرجل علمٍ في القرن السادس عشر وهو جيرالموا كاردمونو أن يحاجج بـ:”أنهن نساء مسكينات يعشن أوضاعاً صعبة، يفتشن في الأودية عن الكستناء والأعشاب من أجل الغذاء… لذا فإنهن يبدين هزيلات ومكسورات وشاحبات اللون بأعين جاحظة، ونظرات تكشف عن التشاؤم والمزاج السيء، إنهن نساء قليلات الكلام وتائهات، ومن الصعب عزلهن عن أولئك الذين استولى عليهم الشيطان، آراؤهن حادة وصارمة وأي شخصٍ يستمع إلى قصصهن سيكون متأكداً من أن القصص التي يروينها باقتناعٍ تامٍ قد حصلت، قصص لم تحدث ولا يمكن لها الحدوث”[18].
ظهرت موجةٌ جديدةٌ من الاضطهاد بعد انتشار الجذام حسب ما يقول كارلو غينزبيرغ (Carlo Ginzburg) في كتابه “ابتهاجات: معرفة سر سبت الساحرات”: حيث سجّل أن المجذومين تم حرقهم في فرنسا سنة 1321 بتهمة محاولة قتل الفرنسيين من خلال تسميم مصادر مياه الشرب كالآبار والحنفيات العمومية: “النساء المجذومات اللواتي اعترفن بالجريمة سواءً تحت التعذيب أم بدوافع ذاتية كان يحكم عليهن بالإعدام حرقاً، باستثناء الحوامل واللواتي كان يتم احتجازهن حتى الولادة ثم يتم إعدامهمن”، من الصعب التعرف على جذور الاضطهادات التي كانت تطال المتهمين بنشر الطاعون أو الجذام، لكن غينزبيرغ يشرح جانباً آخر من هذه الظاهرة، وهي الربط التلقائي بين المجذومين واليهود والمسلمين، فعددٌ من المؤرخين يربطون اتهام اليهود بأنهم كانوا يحرضون المجذومين ويقدمون لهم المساعدة؛ لهذا السبب كان العديد منهم يرسلون إلى المحرقة، يقول غينزبيرغ: “كان السكان قد أخذوا على عاتقهم تحقيق ما كانوا يرونه العدالة، فبمساعدة المسؤولين المحليين أو الرهبان كانوا يحبسون أولئك الناس في بيوتهم مع كافة مصادر حياتهم ويحرقونهم”، أحد قادة هذه المجموعات اعترف أن يهودياً قدم له المال مقابل وضع السم في حنفيةٍ عمومية، كان السم مصنوعاً من “دمٍ بشري مع بول وثلاثة أنواعٍ من الأعشاب” ومغلفاً بقطعة قماش مربوطةً بحجر حتى تغرق إلى قاع الحنفية، لكنه أخبر أيضاً أن ملك غرناطة المسلم هو من أرسل اليهود، وفي روايةٍ أخرى كان سلطان بابل أحد أطراف هذه المؤامرة، هناك ثلاثة أعداء تاريخيون وهم المجذومين واليهود والمسلمين، لذا فإنهم يجتمعون دوماً في أي مؤامرة، بعض المصادر تشير إلى عدوٍ رابع وهو الهراطقة، حيث يقومون بتجميع المجذومين من أجل البصاق على الهيكل والوطء على الصليب.
هذه الطقوس كانت تمارس في زمنٍ لاحق من قبل الساحرات ففي القرن الرابع عشر ظهر أول كتيّب لمحاكمة الهراطقة حيث نشرته محاكم التفتيش وهو “دليل المحقق لمعرفة شرور الهرطقة” من تأليف بيرنارد غوي (Bernardo Gui)، وكذلك كتاب “دليل التحقيق” لنيكولو إيميرك (Niccolao Emeric)، وفي القرن الخامس عشر في الوقت الذي كان فيه مارسيليو فيسينو (Marsilio Ficino) يترجم أفلاطون في البندقية بتوجيهٍ من كوزيمو ميديتشي، كان طلاب المدارس يغنون: “أخيراً، أخيراً، لقد انتهت العصور المظلمة” كان جون نيدر(John Nider) يؤلف كتابه فورميكاريوس (Formicarius) بين سنتي 1435 و 1437 وطبعه سنة 1473 والذي يتحدث لأول مرةٍ وبعلانية عن ممارسات السحر، كتب البابا جيوفاني باتيست سيبو “البريء الثامن” (Giovanni Battista Cybo) عن هذه الممارسات في البيان البابوي سنة 1484: “لقد تناهى إلى أسماعنا مؤخراً ما تسبب بقلقنا، أنه في بعض مناطق ألمانيا… أناسٌ من الجنسين ضحايا غفلتهم عن الدين، تم تضليلهم من قبل الشيطان، وأخرجهم من الإيمان الكاثوليكي، لا يتورعون عن الارتماء في الأحضان الشيطانية، يتركون الأطفال والحيوانات والمحصولات تموت وتهلك… يستخدمون التعاويذ والطلاسم وممارسات سحرية أخرى، لذا فقد وجهنا إلى استخدام كل الوسائل المناسبة لمنع انتشار ممارسات الهراطقة في تلك المناطق، والتي تسعى لتسميم أرواح رعايا الكنيسة الطيبين وذلك من خلال المحققين سبيرنغر وكرامر (Sprenger and Kramer)”، بعد هذا البيان بسنتين نشر الاثنان متأثرين بـكتاب جون نيدر كتابهما سيء الصيت والمعنون بمطرقة الساحرات.
تعطي سجلات محكمة التفتيش المتعلقة بمحاكمة الساحرة أنطونيا من أبرشية القديس جوريوز التابعة لأسقفية جنيف واحداً من آلاف الأمثلة حول تكوين الساحرة: “قامت المتهمة بهجر زوجها والمضي مع ماسي لمكانٍ يُعرف بلاز بيروي قرب النهر، حيث أقيم هناك كنيسٌ للهراطقة يتواجد فيه عددٌ كبيرٌ من الرجال والنساء، ليرقصوا ويعربدوا، بعدها أراها ماسي شيطاناً يدعى روبين، والذي كان له مظهر الزنجي وقال لها: هذا هو سيدنا والذي يجب عليك أن تظهري له كل فروض الولاء إذا ما أردت الحصول على كل رغباتك، سألت المدعى عليها ماسي ماذا عليها أن تفعل فرد قائلاً: عليكِ أن تنكري الإله خالقك والإيمان الكاثوليكي وتلك الزانية المسماة مريم العذراء، وتقبلي هذا الشيطان روبين كسيدك وإلهك وتفعلي كل ما يطلبه منك، للوهلة الأولى ترددت أنطونيا بعد سماعها هذه الكلمات لكنها سرعان ما قالت: أنكر إلهي والإيمان والكاثوليكي والصليب المقدس، وأؤمن بالشيطان روبين سيداً وإلها، ثم قدمت فروض الولاء بتقبيل قدمه بعدها أخرجت صليباً خشبياً وألقته على الأرض وداسته بقدمها اليسرى حتى تكسر، ثم مشت على عصاً بطول قدمٍ ونصف لتدخل الكنيس، بعدها قامت بدهن ما بين فخذيها بمرهمٍ موضوعٍ في إناء القربان وقالت: اذهب، اذهب إلى الشيطان، حينها دخلت في طقوس الكنيس، لقد اعترفت المدعى عليها بأنهم أكلوا في ذلك المكان خبزاً ولحماً وشربوا نبيذاً ثم رقصوا، بعدها تحول الشيطان روبين إلى كلبٍ أسود، وقاموا بتقديسه وعبادته وتقبيل مؤخرته، وأخيراً قام الشيطان بإطفاء النار المشتعلة في الموقد، وأشعل ناراً بلهيبٍ أخضر أنارت الكنيس كله وصرخ (ميكليت Meclet ( يطالبهم بالممارسة الجنسية وفي وسط الصراخ اضطجع الرجال والنساء بشكلٍ وحشي بينما هي اضطجعت مع المدعو ماسي غارين”.
هذه الشهادة مع التفاصيل المذكورة حول البصاق على الصليب وتقبيل المؤخرة تتشابه إلى حدٍ كبيرٍ مع ما تم تسجيله في محاكمة فرسان المعبد قبل ما يقارب قرناً ونصف، وما يثير الدهشة ليس استخدام المحققين في محاكمات القرن الخامس عشر قواعد الاستجواب المسجلة عن محاكمات سابقة، بل أن الضحية في نهاية التحقيق تقتنع بصحة الادعاءات الموجهة ضدها، ففي محاكمات السحرة لا يتم بناء صورةٍ للعدو فقط، ولا كون الضحية تعترف بارتكاب أشياء لم تفعلها بل اقتناع الضحية بحقيقة ما يقوله خلال عملية الاعتراف وهذا ما يثير الانتباه، من الجيد تذكر إجراءات مشابهةٍ تم شرحها في رواية “ظلام عند الظهيرة لآرثر كوستلر” وكيف تم صناعة العدو خلال المحاكمة تحت حكم ستالين، حيث يتم صناعة صورةٍ لعدوٍ ما ويتم إقناع المتهمين بأنهم على تلك الصورة فيصدقون، حتى أولئك الذين يأملون بأن يكونوا في مواقع حسنةٍ يتم إغراؤهم كي يصيروا أعداء، فالمسرح والأدب يقدمان لنا أمثلةً مشابهةً لفرخ البط البشع، والذي يتم ازدراؤه من قبل المحيطين به بناءً على الصورة التي كونوها عنه بشكلٍ مسبق، هنا أقتبس شكسبير من مسرحية ريتشارد الثالث:
لكنني لم أُوجد لممارسة الألاعيب المسلية
ولا حتى متعة النظر في مرآة حبيبة
أنا المحروم بسوء أقداري
الذي شوهت الطبيعة خلقته
المشوه الناقص الذي أُرسل قبل زمانه
إلى هذا العالم الذي يمضي بشق الأنفس
هذا العالم الكسيح
أنا الذي تنبح الكلاب عليه كلما وقف بالقرب منها
لماذا لا أجد متعةً أمضي بها وقتي
سوى اختلاس النظر إلى ظلي
والتغني بخلقتي المشوهة
وما دمت غير صالحٍ للحب
والتمتع بهذه الأيام الجميلة
فلأكن وغداً
يبدو أننا لا نستطيع الحياة دون وجود عدو، فصورة العدو لا يمكن بالمطلق محوها من عملية تشكل الحضارات، إنها الحاجة الطبيعية حتى بالنسبة لإنسانٍ محبٍ للسلام، ففي حالة ريتشارد تبدو صورة العدو تنتقل من كونها تكويناً بشرياً إلى قوةٍ طبيعية أو اجتماعية تقوم بتهديدنا بشكلٍ أو بآخر، وعلينا أن نهزمها، سواءً كانت استغلالاً رأسمالياً أم تلوثاً بيئياً أو حتى مجاعة في العالم الثالث، وبالرغم من كون هذه الأشياء قضايا عادلة كقضية مقاومة الظلم والطغيان، فإنها كما يذكرنا بريشت: “تجعل ملامحنا صارمة”.
هل حسنا الأخلاقي واهٍ حينما نواجه الحاجة الحتمية لوجود عدو؟ نستطيع المناقشة بأن الأخلاق تتدخل لا في حالة تظاهرنا بعدم وجود عدوٍ فقط، بل حينما نحاول أن نفهم هذا العدو، أو نضع أنفسنا مكانه، أسخيلوس لم يكن حاقداً على الفرس حينما كتب مسرحيته التراجيدية “الفرس” من وجهة نظرهم أنفسهم وبناءً على خبرته معهم، وكان قيصر يعامل الغاليين باحترامٍ كبيرٍ وفي أسوأ الأحوال كان يكتفي بمظهرهم الضعيف وهم يستسلمون له، كان تاكيتوس يحترم الألمان ومظهرهم العام وكانت شكواه من روائحهم الكريهة وتخاذلهم في الأعمال الشاقة كونهم لا يستطيعون مقاومة الحر والعطش، إن محاولة فهم الآخرين تعني تدمير الشائعات المرتبطة بهم، بدون إنكار أو تجاهل الآخرية، لكن فلنكن واقعيين فهذه المحاولات لفهم العدو تعتبر من امتيازات الشعراء والقديسين وحتى الخونة، بينما دوافعنا الداخلية من نوعٍ آخر، في سنة 1967 نشر في أميركا كتاب: “تقرير من الجبل الحديدي: في إمكانية ورغبة تحقيق السلام”، من قبل كاتبٍ مجهول، كان من الواضح أنه كتيبٌ ضد الحرب أو مرثيةً تشاؤميةً حول حتميتها، لكن وبما أن إعلان الحرب يتطلب وجود عدو، فإن حتمية الحرب مرتبطةٌ بحتمية تعريف العدو وابتكاره، لهذا فإن الكتيب كان يلمح وبشكلٍ جدي أن أي محاولةٍ لدفع المجتمع الأميركي كي يشكّل دولة سلام سيكون كارثياً، فالحرب وحدها من تقدم أسس اندماج المجتمعات الإنسانية وتطورها، فالخسارة المنظمة تشبه الصمام الذي يقوم بضبط حركة المجتمع الحثيثة، إنها أي الخسارة المنظمة هي ما تحل مشكلة التموين فهي قوةٌ فعالة ومؤثرة، إن الحرب تساعد المجتمع كي ينظم ذاته كأمة، فالحكومة لا تستطيع أن تؤسس لشرعيتها دون الحضور الدائم للحرب، فالحرب وحدها من يحافظ على حالة التوازن بين الطبقات الاجتماعية وتساعد على إبعاد العناصر المعادية للمجتمع.
بينما يتسبب السلام بحالةٍ من الفوضى والانحراف في جيل الشباب، تسهم الحرب في استغلال هذه القوى المدمرة بشكلٍ أفضل، حتى على المستوى الاجتماعي فإنها تعطيهم مسمّىً وقيمة اجتماعية، فالجيش في هذه الحالة هو الأمل الأخير بالنسبة للمنبوذين، فنظام الحرب وقدرتها على وهب الحياة والموت يحث الناس على دفع الدم ثمناً في سبيل إعادة التنظيم الاجتماعي بدلاً عن عوامل أخرى كحوادث السيارات مثلاً، فمن وجهة نظر بيئية فإن فاتورة الحرب يدفعها عددٌ هائل من القتلى، وهذا الأمر قد تغير مع نهاية القرن التاسع عشر فبينما كان المنبوذون يبقون أحياء داخل المدن أو على هوامشها، كان أعضاء المجتمع الشجعان “الجنود” يقتلون في المعارك والحروب، غيّر التطور التقني هذا الأمر إذ صار قصف المدن عاملاً بارزاً في منع زيادة السكان أكثر من طقوس قتل المواليد قديماً أو الرهبنة أو حالات بتر الأعضاء التناسلية، وكذلك الاستخدام المبالغ فيه لعقوبة الإعدام، الحرب وحدها تجعل هذا الأمر ممكناً، إذ تقدم مفهوماً ووسيلةً إنسانوية للسيطرة على الأوضاع المختلة.
إذا كان هذا الأمر صحيحاً فإن عملية صناعة العدو يجب أن تكون مكثفة ومستمرة، وهنا يقدم لنا جورج أورويل في روايته 1984 مثالاً جيداً عن هذه الحالة: “في اللحظة التالية تم بث خطابٍ مرعبٍ ومخيفٍ من التلفاز المركون في آخر القاعة، وكصوت آلة جف زيتها، كان الصوت وحشياً بحيث يجعل الأسنان تصطك رعباً، ويقف له شعر الرأس… لقد بدأت حفلة الكراهية، ظهر على الشاشة وجه عدو الشعب إيمانويل غولدشتاين، وبدأت صرخات الاستهجان تعلو في القاعة، صرخت الفتاة ذات الشعر الذهبي بصوتٍ ممزوجٍ بالخوف والقرف، فغولدشتاين أحد القياديين السابقين للحزب صار المرتد والمنحرف والخائن الأول للحزب، وكذلك الملوث لطهارته، كانت تعاليمه مصدر كل الخيانات والانحرافات التي عصفت بالحزب مؤخراً، والآن هو قابعٌ في مكانٍ ما يحيك المؤامرات.
بسبب الزحام حوله لم يستطع ونستون رؤية وجه غولدشتاين جيداً على الشاشة، غير أنه كلما لمحه كساه خليطٌ من المشاعر المفعمة بالألم، كان وجهه اليهودي نحيلاً، تكسوه هالةٌ من التجاعيد، بشعرٍ أبيض ولحيةٍ صغيرة، كان وجهه ذكياً غير أن منظر أنفه الطويل النحيل بمنخريه يوحي بالسذاجة، فهو يذكّر بوجه التيس، كما أنه صوته يشبه ثغاء الماعز، كان غولدشتاين يهاجم عقيدة الحزب ويطالب بالسلام الفوري مع أوراسيا، كان يدافع عن حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، وحرية التفكير، لقد كان يصرخ بشكلٍ هيستيريٍ بأن الثورة قد تمت خيانتها… في الدقيقة الثانية ارتفعت نوبة الكراهية، وبدأ الحضور يتقافزون في أماكنهم صارخين بأن يتم إخراس هذا الثغاء المجنون الصادر من الشاشة، امتقع وجه الفتاة ذات الشعر الذهبي، وبدأت بالصراخ كانت تفتح فمها وتغلقه كما لو كانت سمكةً أُخرجت من الماء… الفتاة ذات الشعر الداكن الواقفة خلف ونستون صرخت “خنزير، خنزير، خنزير” ثم أمسكت معجم اللغة الجديدة وقذفته على الشاشة حيث أصاب أنف غولدشتاين ثم ارتد على الأرض، تعالى الصراخ، وانتبه ونستون إلى نفسه وهو يصرخ مع الجموع ويضرب قائمة الكرسي بقدمه بشكلٍ عنيف، المرعب في دقيقتي الكراهية هاتين ليس أن الفرد كان ملزماً بالانضمام للجموع في صراخها، بل استحالة عدم الانضمام إليها… سرت نشوةٌ عارمةٌ كما لو كانت تياراً كهربائياً في الجموع يكسوها الخوف ورغبة الانتقام، رغبةٌ بالقتل والتعذيب، رغبةٌ بتحطيم الوجوه بمطرقة، جعلت الجميع يقطبون ويصرخون بشكلٍ جنوني دون رغبتهم”.
ليس علينا أن نتعمق أكثر في رواية 1984 لنجد أننا لا نستطيع الحياة دون عدو، فنحن نشهد الخوف الذي يتسبب به تدفق المهاجرين، ففي إيطاليا اليوم يتم تصوير الرومانيين على أنهم أعداء من خلال سلوك بعضهم باعتبار أن هذا السلوك يشكّل ثقافةً إثنية، هذه الحال تقوم بتقديم كبش فداء لكل مجتمعٍ لا يستطيع تعريف نفسه كونه في طور التغير، بما فيه التغير الإثني، سارتر يقدم لنا النظرة الأكثر تشاؤماً في هذا المجال في مسرحيته “أبواب مغلقة”، حيث لا نستطيع معرفة أنفسنا إلا بوجود الآخرين، وهذا ما تبنى عليه بالأساس مسألتي التعايش والخضوع، وعلى الرغم من هذه الإشكالية فإننا نقع في إشكاليةٍ أخرى وهي عدم القدرة على التسامح مع الآخر؛ لأنه وببساطةٍ ليس نحن، وبهذه الطريقة فإننا حين ننزل الآخر منزلة العدو فإننا نخلق جحيمنا على الأرض، يغلق سارتر الغرفة على ثلاثة رجال لا يعرفون بعضهم حتى الموت، أحدهم أدرك هذه الحقيقة الرهيبة وقال: “انتظر، سترى كم الأمر سهلٌ جداً، فمن الواضح أنه لن يكون هناك أي تعذيبٍ جسدي، ألا تتفق معي؟ ومع ذلك فنحن في الجحيم، ولن يأتي أحدٌ آخر إلى هذا المكان، سنبقى نحن الثلاثة في هذه الغرفة إلى الأبد… بعد برهة: هناك شخصٌ مفقود! إنه الجلاد! يبدو واضحاً أن ما يسعون إليه هو تقليص عدد العاملين هنا، لذا فإن كل واحدٍ منا سيكون الجلاد بالنسبة للاثنين الآخرين. انتهى
-
محاضرة في جامعة بولونيا الإيطالية، في تاريخ 15 مايو أيار 2008، كجزء من سلسلة لقاءات حول الكلاسيكيات، كتاب في مديح السياسة، تحرير إيفانو ديونيغي 2009
[1][1] مجلدات التاريخ، المجلد الخامس، الجزء الثالث
[2][2][2] سفارة إلى القسطنطينية وكتابات أخرى
[3] سيكولوجية العرق الألماني، 1917
[4][4] رحلة إلى الأرض المقدسة ومصر والأراضي العربية
[5] سانت أمبروجو، 1845
[6] الرجل المجرم، 1876، المجلد الأول، الفصل الثاني
[7] العهد السرياني لسيدنا يسوع المسيح
[8] رسالة في أصل وزمن عدو المسيح، الراهب أدوس من كاثدرائية مونتي اون دير
[9] هايلدغارد بينغن، رؤى روحانية، القرن الثاني عشر، المجلد الثالث الجزء الأول، القسم الرابع عشر
[10] بابتيست هنري غريغور، مقالة في التطور الجسدي والأخلاقي والسياسي عند اليهود، 1788
[11] اليهودية في الموسيقا، 1850
[12] أدولف هتلر، كفاحي، 1925
[13] مايكل بسيلوس، في ممارسات الشيطان، القرن الحادي عشر
[14] ماركوس مارشالييس، شاعر روماني اشتهر بهجائياته الساخرة، القصائد، الكتاب الثالث، القصيدة 93
[15] بوكاشيو، الغراب
[16] أودو الكلوني، الممارسات الرهبانية، الكتاب الثالث، الفصل 133
[17] هوراس، السخريات، الكتاب الأول
[18] في الظواهر الطبيعية، الكتاب الخامس عشر