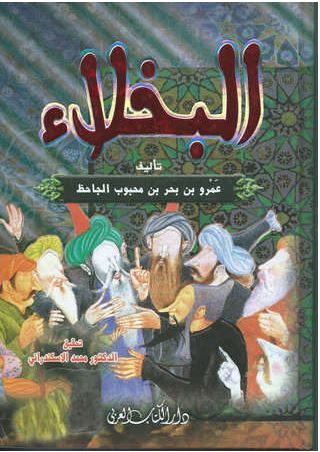
“البخلاء لا يؤمنون بالبعث؛ إن الحاضر كل شيء بالنسبة لهم”
بلزاك، أوجيني غرنداي
في مقدمة كتاب البخلاء(1)، يحيل الجاحظ إلى كتاب آخر له، لم يصلنا، في تصنيف حيل لصوص النهار وفي تفصيل حيل سراق الليل. هذه الإحالة ليست اعتباطية: إنها تدعونا إلى قراءة كتاب البخلاء كجرد لمناورات أنصار البخل ، وهم قوم دوما يقظون محترسون، إلى درجة أنهم يعتبرون الآخرين لصوصا فعليين أو محتملين. ففي رسالة كتبها أحدهم (ابن التوأم)، نقرأ تحذيرا من “حيل لصوص النهار، وحيل سراق الليل، وحيل طراق البلدان، وحيل أصحاب الكيمياء، وحيل التجار في الأسواق والصناع في جميع الصناعات، وحيل أصحاب الحروب”؛ ثم يضيف صاحب الرسالة أن هذه الحيل لا تبلغ مبلغ” حيل المستأكلين والمتكسبين” (ص 177).
إن ما يتبادر إلى الذهن أن الجاحظ ألف كتابه “ضد البخلاء”؛ يبدو هذا طبيعيا، وهو بالضبط ما يعتقده جل من كتبوا عنه. فمن هو يا ترى القارئ الذي لا يصنف نفسه ضمن فئة الكرماء؟ من هو القارئ الذي لا يحتفظ في ذاكرته بنوادر ومسرحيات وأشعار تذم البخل وتصوره رذيلة مذمومة وعاهة منفرة وشائنة؟ أن يكتب الجاحظ عن البخلاء معناه أن يكتب ضدهم. ألا يروي عدة حكايات تسخر منهم وتحط من شأنهم؟ ألا يشعر بلذة قصوى أثناء عرضه لحساباتهم القذرة ووصفه لخستهم ودناءتهم؟
لو اقتصر مؤلف الجاحظ على هذا الجانب، لكانت فائدته ثانوية. صحيح أنه في المقدمة يهاجمهم ويهجو سلوكهم، فيقول مثلا إن البخيل “لا يفطن لظاهر قبحه وشناعة اسمه وخمول ذكره وسوء أثره على أهله”. إلا أنه لا يلبث أن يضيف أن البخيل يحتج ” لذلك بالمعاني الشداد وبالألفاظ الحسان وجودة الاختصار وبتقريب المعنى وبسهولة المخرج وإصابة الموضع” (ص 2). إن بداية الكتاب، والحالة هذه، يكتنفها الإبهام والازدواجية: الاشمئزاز من البخلاء يصاحبه إعجاب بهم، وهجاء شحهم يرافقه مدح لفصاحتهم وبيانهم، حتى ليخيل إلينا أن الجاحظ يعتبر البخل والبلاغة مترابطين لا انفصام لهما.
لكن من يتكلم في المقدمة؟ المؤلف طبعا. بيد أن قراءة متأنية لها تبين أنه ليس وحده صاحب الكلام؛ فالعديد من المقاطع منسوبة للقارئ، وأحيانا يكون من العسير الفصل بين الصوتين، أي التحقق من مصدر القول، الجاحظ أو قارئه، كما في المقطع التالي الذي نجد فيه حكما متناقضا على البخلاء: “وقلت: فبين لي ما الشيء الذي خبل عقولهم وأفسد أذهانهم وأغشى تلك الأبصار ونقض ذلك الاعتدال؛ وما الشيء الذي له عاندوا الحق وخالفوا الأمم، وما هذا التركيب المتضاد والمزاج المتنافي، و ما هذا الغباء الشديد الذي إلى جنبه فطنة عجيبة؛ وما هذا السبب الذي خفي به الجليل الواضح وأدرك به الجليل الغامض” (ص 2).
هناك عند القارئ رغبة في العلم، شهية أو قابلية للمعرفة يغذيها إلمام سابق من جانبه بـ “التركيب المتضاد” الذي يميز البخلاء. ربما يعرف هذا القارئ أكثر مما يصرح به ويعلن عنه، وربما يستر معرفته بغطاء محتشم حيي. ما هو مؤكد أن البخل ليس شيئا غريبا عنه، وليس قضية طريفة لا غير. إن شكا يخامره فيما يخص موقفه من البخل: “وذكرت أنك إلى معرفة هذا الباب أحوج، وأن ذا المروءة إلى هذا العلم أفقر. وإني إن حصنت من الذم عرضك بعد أن حصنت من اللصوص مالك، فقد بلغت لك ما لم يبلغه أب بار ولا أم رؤوم” (ص 4). إن سمعة القارئ معرضة للخطر، والإطلاع على كتاب الجاحظ وحده كفيل بصيانتها والحفاظ عليها، كما أن الإطلاع على كتاب حيل اللصوص مكن القارئ من تحصين ماله والذوذ عنه. بعبارة أخرى، ليس القارئ في منجى من البخل، وإن ما حذا بالجاحظ إلى تجشم مشقة تأليف الكتاب، هو مساعدته على محاربة هذا العيب والتغلب عليه. فلعل القارئ بخيل دون أن يعي ذلك تماما، ولن يرتقي إلى الوعي الكامل بما يجول في نفسه إلا بعد أن يعمق معارفه ويقوم بدراسة مفصلة للبخل: “فإن نبهك التصفح (…) على عيب قد أغفلته، عرفت مكانه فاجتنبته، فإن كان عتيدا ظاهرا معروفا عندك نظرت، فإن كان احتمالك فاضلا على بخلك دمت على إطعامهم وعلى اكتساب المحبة بمؤاكلتهم. وإن كان اكتراثك غامر الاجتهاد، سترت نفسك وانفردت بطيب زادك، ودخلت مع الغمار وعشت عيش المستورين “(ص 3-4). ها هو القارئ مشدود بقوة إلى مادة الكتاب ومدعو إلى استبطان و استكناه ما يجول في ذهنه من أجل كشف “العيب” المستور واستئصاله، أو – إن كان عاجزا عن ذلك – من أجل الاضطلاع به والإقرار به صراحة وبصفة نهائية. سيستخرج إذن من قراءة الكتاب منهاجا وبرنامجا للحياة وسيكون شاكرا للجاحظ الذي أزاح الستار عن نزعاته العميقة وأتاح له التعرف على نفسه وسبر أغوارها، وبالتالي اكتشاف حقيقته الدفينة.
قد يقال: أين هو المشكل؟ وما الذي يزعج القارئ ويوجب كل هذه المناقشة؟
نكتشف تدريجيا أن ما يقض مضجع القارئ هو إغراء الكرم وفي الوقت نفسه الارتباك أمام ما يقتضيه ذلك من نفقات وتبعات. القارئ، ضمنيا، شخص ميسور؛ بإمكانه أن يدعو الناس للغذاء، أن يهيئ ولائم (الطعام يحتل الصدارة في الكتاب، وسنرى ارتباطه الوثيق بمسألة البخل)؛ إلا أنه حائر مشتت الذهن، تتجاذبه نزعتان : الانكماش أو البروز، الانزواء أو الظهور، العيش في الظل أو في النور. لا أحد يلزمه أن يكون سخيا ندي الكف، لا أحد يلزمه أن يطعم الآخرين بغية “اكتساب المحبة بمؤاكلتهم”. إن دعاهم فإن أي تقصير وأية علامة للبخل تصدر من جانبه سيعرضانه لانتقاداتهم وسخريتهم اللاذعة. وإن لم يدعهم فإنه سيحكم على نفسه بالعيش محجوبا مجهولا خاملا. وطالما لم يحسم الأمر، سيبقى متحيرا شقيا، أو كما يقول الجاحظ: “وإن كانت الحروب بينك و بين طباعك سجالا وكانت أسبابكما أمثالا وأشكالا، أجبت الحزم إلى ترك التعرض وأجبت الاحتياط إلى رفض التكلف، ورأيت أن من حصل السلامة من الذم فقد غنم وأن من آثر الثقة على التغرير فقد حزم”(ص4).
لكي ندرك جيدا المعضلة المشار إليها، لنتفحص حكاية، أو على الأصح منظرا أدهش الجاحظ كثيرا (ضمن الفصل المخصص للخرسانيين، المشهورين بالبخل): “ورأيت أنا حمارة منهم، زهاء خمسين رجلا، يتغذون (…) فلم أر من جميع الخمسين رجلين يأكلان معا، وهم في ذلك متقاربون، يحدث بعضهم بعضا. وهذا الذي رأيته منهم من غريب ما يتفق للناس” (ص 18). ما هو وجه الغرابة في هذا المشهد؟ ومن يشعر بالغرابة؟ الجاحظ أكيدا، وكذلك القارئ الذي يتوجه إليه بالقول، وإلا لما اكتفى بإعلان اندهاشه ولحرص على توضيحه وتعليله. لماذا لا يأكل الخرسانيون معا؟ كيف يمكن للمرء أن يأكل وحده؟ هذا ما يزعج الجاحظ. الحمارة الخمسون كلهم من أصل خرساني، ويشتركون في المهنة واللغة والمرجعية الثقافية، بل هم أثناء غدائهم” متقاربون”، ومع ذلك فهم منفصلون ومنعزلون بصفة نهائية لأنهم لا يتطاعمون، لا يشتركون في الأكل. ذهول الجاحظ يعطينا الانطباع بأنه يعتبر أنهم يفتقدون إلى الحس الجماعي الحق، وأنهم لم يتحرروا تماما من البهيمية؛ إنهم نصف رجال ونصف حيوانات. صحيح أنهم يتكلمون، ” يحدث بعضهم بعضا”، لكن إنسانيتهم لن تكتمل إلا إذا جعلوا طعامهم مشتركا فيما بينهم.
أما بالنسبة للحمارة (الذين يراقبهم الجاحظ من الخارج، ومن بعيد)، فإن عدم المشاركة في الطعام يبدو شيئا طبيعيا ولا يحتاج بالتالي إلى أي تبرير. فهم لا يعيرون أدنى اهتمام لنظر الجاحظ، ولعلهم لم ينتبهوا إلى وجوده. وهو بدوره لم يعن له أن يسألهم عن علة سلوكهم؛ على كل حال هم سائقو حمير ولا يخفى ما كان يكنه أدباء الماضي من احتقار للعامة.
لماذا يعتبر عدم التطاعم شيئا مذموما يستوجب اللوم؟ وما علاقة هذا التصرف بالبخل (إذ من الواضح أن الجاحظ يشير إلى هذا عند وصفه لهذا المشهد)؟ هل يخشى كل واحد من الحمارة أن تتم المؤاكلة على حسابه؟ مباشرة قبل هذه الحكاية، يروي الجاحظ أن جماعة من الخرسانيين “ترافقوا في منزل، وصبروا على الإرتفاق بالمصباح ما أمكن الصبر. ثم إنهم تناهدوا وتخارجوا، وأبى واحد منهم أن يعينهم، وأن يدخل في الغرم معهم. فكانوا إذا جاء المصباح شدوا عينه بمنديل، ولا يزال ولا يزالون كذلك إلى أن يناموا ويطفئوا المصباح، فإذا أطفؤوه أطلقوا عينيه” (ص 18). وفي الفصل نفسه، نجد حكاية أخرى، بطلها هذه المرة أديب من الأدباء يقوم بالدفاع عن الأكل على انفراد. راوي الحكاية هو الشاعر أبو نواس: “كان معنا في السفينة-ونحن نريد بغداد-رجل من أهل خراسان، وكان من عقلائهم وفقهائهم. فكان يأكل وحده. فقلت له: لم تأكل وحدك؟ قال: ليس علي في هذا الموضع مسألة: إنما المسألة على من أكل مع الجماعة، لأن ذلك هو التكلف. وأكلي وحدي هو الأصل وأكلي مع غيري زيادة في الأصل” (ص 24). أبو نواس لا يفهم لماذا يأكل الفقيه الخرساني وحده، وهذا الأخير لا يفهم لماذا يصر أبو نواس على الأكل مع الجماعة. تعجبان يتقابلان، وقياسان يتقاطعان. الخرساني، بعد أن يلاحظ أن السؤال المطروح عليه ليس في محله، يضيف أن سلوكه ملائم لطبيعة الأشياء، بينما السلوك الذي يدعو له أبو نواس مناف للفطرة ويشكل بدعة وضلالة. لماذا يطلب منه التخلي عن الجبلة والسليقة، واعتماد تعاقد و مواضعة لا يرى أي سند لهما؟ اللافت للنظر أن أبا نواس لم يرد على نصير الطبيعة بخطاب عن الثقافة (أو الأدب): هل فاجأه الخرساني بكلامه وأفحمه بحجته، أم هل يتكل على المستمع لحكايته لاستخراج القاعدة التي خرقها الخرساني؟ كيفما كان الحال، فإن الأكل مع الجماعة، بالنسبة لأبي نواس والجاحظ، يعني الاشتراك و التضامن والإيثار ويعين درجة عالية في سلم الإنسانية(2).
قد يتيح لنا الفصل المتعلق بالحارثي أن نفهم جيدا ما يقلق القارئ الذي يخاطبه الجاحظ: “قيل للحارثي بالأمس: والله إنك لتصنع الطعام فتجيده، وتعظم عليك النفقة وتكثر منه. وإنك لتغالي بالخباز والطباخ والشواء والخباص ثم أنت-مع هذا كله-لا تشهده عدوا لتغمه، ولا وليا فتسره، ولا جاهلا لتعرفه، ولا زائرا لتعظمه، ولا شاكرا لتثبته” (ص 67). بتناوله الطعام وحيدا، يحرم الحارثي نفسه من حظوة وتأثير لا يستهان بهما، سواء لدى أصدقائه أو أعدائه؛ فاستضافة الناس تكسب اعتبارا ونفوذا لا جدال فيهما، إذ يفيض الضيوف في الشكر والمدح. إن إطعام الناس ينتج عنه خطاب تقريظي يستفيد منه المضيف لا محالة؛ هذا على الأقل ما يحاول مخاطب الحارثي تبليغه له، لكن الحارثي يتصامم، ولتبرير سلوكه يتذرع بعادات الضيوف السيئة. فخلال عرض طويل (عوض الطعام يقدم خطابا!)، يقوم بإحصاء هذه العادات التي تجعل من الأكل مع الجماعة، الذي يقصد منه مبدئيا إظهار المجاملة والأدب، تجعل منه مشهدا حيوانيا مثيرا للتقزز. وهذا نموذج لضيف كريه: “كان إذا أكل ذهب عقله، وجحظت عينه، وسكر وسدر وانبهر، وتربد وجهه، وعصب ولم يسمع، ولم يبصر (…) ثم ما رأيته قط إلا وكأنه طالب ثأر، وشحشحان صاحب طائلة، وكأنه عاشق مغتلم، أو جائع مقرور” (ص 79-80). لقد قيل إن الحارثي يهدف من خلال هذا الخطاب إلى إخفاء بخله؛ ربما، ولكن لا ينبغي أن ننس أن هذا الشخص يسرف في الإنفاق ولا يحرم نفسه من الطيبات. ثم إن الجاحظ ينقل خطابه دون تعليق ولا يسمه بالبخل في الفصل المخصص له (وإن كان في مكان آخر يصنفه ضمن البخلاء). الخلاصة أن الحارثي قام باختيار وحرر نفسه من الحيرة التي تعذب “القارئ”.
يمكن اعتبار كتاب البخلاء وليمة أو مأدبة كبرى تلتقي خلالها شخصيات من عدة طبقات ومشارب: مبذرون، بخلاء، أطباء، عمال، لغويون، طفيليون، متكلمون… وخلالها تقدم أنواع عديدة من الطعام. أغلب مشاهد الكتاب تمت بصلة، كما أشرت إلى ذلك من قبل، إلى الطبخ والتغذية، إلى الأكل الذي قد يتم في إطار حميمي خاص أو في سياق من الأبهة والبذخ(3). هذا التنوع في الأطعمة المقدمة لضيوف يقابله تنوع في المواضيع التي يطرقها الجاحظ. كل شيء مهيئ لإرضاء شهية القارئ: “ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء: تبين حجة طريفة، أو تعرف حيلة لطيفة، أو استفادة نادرة عجيبة. وأنت في ضحك منه إذا شئت وفي لهو إذا مللت الجد” (ص 5). القارئ مدعو إذن إلى وليمة ممتعة والجاحظ يعده بأنه لن يشعر بالملل، فهو على ميعاد مع البشاشة والبهجة لأن الكتاب يمزج الجد بالهزل.
مباشرة بعد أن يعلن في المقدمة التنوع الذي يميز الكتاب، يأخذ الجاحظ في عرض مطول يقوم خلاله بمدح الدموع وذمها، ثم بمدح الضحك وذمه. وذريعته أن الكتاب يجمع بين اللهو والجد، وفي هذا الصدد يمكن سرد العديد من المقاطع في مؤلفاته تظهر فيها خشيته العنيفة من أن يمل القارئ. إن تنوع المواد واختلاف وجهات النظر والاستطراد ومخاطبة القارئ والسعي إلى إشراكه بل إلى استفزازه وتوريطه، كلها وسائل لدفع وإبعاد عدو القراءة، الملل(4). إلا أن الخاصية الكبرى للجاحظ هي ما لاحظه معاصره ابن قتيبة (لائما إياه عليها)، أقصد نزعته إلى قول الشيء وضده. إن مدح الدموع وهجوها، وكذلك الضحك، كمثال على ذلك(5). ينبغي أن لا ننسى هذه الخاصية عندما نتناول بالدرس كتاب البخلاء الذي يجمع بين مدح البخل وذمه في آن.
دائما في المقدمة، يحيل الجاحظ إلى مؤلف آخر له، كتاب المسائل، الذي تفحص فيه حجج من يدعو إلى “نفي الغيرة”، وعلة آخر “في إلحاق الكذب بمرتبة الصدق، وفي حط الصدق إلى موضع الكذب”، ومذهب ثالث “في تفضيل النسيان على كثير من الذكر” (ص 4)، وكلها آراء تتعارض مع الآراء الشائعة المسلم بها. ليس من الهين معرفة السبب الذي من أجله ذكر الجاحظ هذه الآراء، ومن العبث أن نفسرها بنزعته إلى الاستطراد. إلا أن إمعان النظر في المقدمة يظهر لنا أن هذه المفارقات ترد في سياق يعلن فيه أن البخلاء يحتجون “لما أجمعت الأمة على تقبيحه(…) وتهجينه” (ص 2)، إضافة إلى كونهم “زهدوا في الحمد وقل احتفالهم بالذم” (ص 1). نلمح بالتالي الصلة بين المفارقات المعروضة في كتاب المسائل والمفارقة التي بني عليها كتاب البخلاء: نظرة غير عادية إلى الأشياء، إلى العلاقات الإنسانية، إلى العالم.
إذا كانت المقدمة ملتبسة، بصوتين (الخطاب موزع بالتساوي بين المؤلف والقارئ)، فما هو الحال بالنسبة لباقي الكتاب؟ نجد فيه حكايات، قصيرة عموما، كما نجد فيه خطابات، وجيزة أو مسهبة، منسوبة إلى عدد من البخلاء. أما كلام الجاحظ المباشر، فحصته محدودة، إذ في أغلب الأحيان يعطي الكلام للبخلاء، يضعه على لسانهم، كما يضعه على لسان القارئ. إنه لا يحتكر الكلام ولا يستأثر به، فهو ليس جشعا شرها كما هو حال بعض الأكلة الذين يصفهم. مرة أخرى يتأكد لنا أن الكتاب مأدبة القصد منها توزيع الطعام والكلام بالتساوي بين المدعوين(6).
كرم الجاحظ يظهر إذن بصفة خفية؛ فهو صاحب الكلام الذي ينسبه للبخلاء، يمنحه لهم ويضعه على ألسنتهم بسخاء. هذا يعني أنه يتماثل معهم، يتكلم لغتهم ويتبنى، على الأقل بصفة مؤقتة، أسلوبهم و طريقتهم ووجهة نظرهم. وهذا ما حدا ببعض القراء إلى اتهامه بالبخل فقالوا إن براعته في وصف الشح والتقتير لدليل على أنه كان شحيحا مقترا. هكذا نصل إلى هذه النتيجة العجيبة: الجاحظ يتهم قارئه بالبخل، وهو بدوره يعتبر بخيلا من طرف قرائه.
لكن المسألة ليست بهذه البساطة، ذلك أن الجاحظ يعطي الكلام أيضا لأنصار الكرم. إننا نجد في الكتاب، من بدايته إلى نهايته، نقاشا واسعا تصطدم خلاله وجهتا نظر متناقضتان. على العموم لا يبادر البخلاء إلى الجدال، فهم في موقف دفاعي، و لا يتكلمون إلا عندما يلامون أو يستفزون. إلا أننا عندما نتأمل فصول الكتاب ونحصي كلامهم، نلاحظ أن خطابهم أغزر وأرحب من خطاب مناوئيهم، سواء خطابهم الشفوي (ما يقومون به من تفنيد ودحض لآراء الخصوم وتأنيب لهم، وما يقدمونه من مواعظ ووصايا ونصائح لأشياعهم(7))، أو خطابهم المكتوب (ثلاث رسائل لبخلاء مشهورين، سهل بن هارون الكندي، ابن الثوأم، مقابل رسالة واحدة لنصير للكرم، أبي العاص). وبداهة يخلق هذا اختلالا لصالح البخل.
ليس البخيل الجاحظي شحيحا بكلامه، فهو ينفقه بسخاء ويلقي بالمجان دروسا في الاقتصاد ويعلم مبادئ تنمية المال وتثميره. ثم إن صحبته مرغوب فيها لأنه “يتغلغل عند الاحتجاج (…) إلى الغايات البعيدة والمعاني اللطيفة”. وفي الواقع فإن كل بخيل جاحظي يتميز بمزاج خاص، بطبع قد يكون غاية في التعقيد. فهذا أحمد بن الخراكي كان “بخيلا، وكان نفاجا. وهذا أغيظ ما يكون” (ص 125). وهذا أبو سعيد المدائني كان “مع بخله، أشد الناس نفسا و أحماهم أنفا” (ص 141)، وقد غضب يوما فمزق صكا بقيمة ألف دينار… إن تقلبات وتغيرات مفاجئة من هذا النوع ليست بالنادرة. ذلك أن إغراء البخل قد يطمسه أحيانا إغراء الكرم، بل التبذير. فهذا بخيل يشق قميصه عندما يشرب النبيذ أو عندما يسمع المغني، وهذا آخر “ينفق على مائدته وفاكهته ألف درهم في كل يوم، وعنده في كل يوم عرس”، وثالث بخيل على الطعام سخي بالدراهم، ورابع “غلب عليه حب القيان، واستهتر بالخصيان”(ص159). كل هذا يؤدي إلى المفارقة التالية: بخلاء يقيمون الولائم الفاخرة، بينما خصومهم الذين يسخرون من بخلهم يحبون “أن يدعوهم الناس، ولا يدعوا الناس” (ص 70). إننا أمام صورة لعالم مقلوب: بخلاء أسخياء مسرفون، وأنصار للكرم أشحاء جشعون. البخل يكتشف عند من يغض من شأن البخل، والسخاء يشاهد في سلوك من ينتقص السخاء.
إذا كان الخطاب الجدالي، إجمالا، من نصيب البخلاء، فإن الحكايات يرويها في الغالب رواة من طبقة الكرام (أو هكذا يعتقدون)، لمستمعين يقاسمونهم وجهة نظرهم. هناك لذة أكيدة يشعر بها من يروي حكايات البخل أو يستمع إليها، حكايات الهدف منها كما هو معلوم إثارة الضحك وتلقين السخاء بصفة ضمنية.
بيد أن كتاب الجاحظ يشتمل أيضا على حكايات عن البخلاء يرويها رواة بخلاء لمستمعين بخلاء. أبو سعيد المدائني “كانت له حلقة يقعد فيها أصحاب العينة والبخلاء الذين يتذاكرون الإصلاح” (ص 137). وكذلك المسجديون، وهم أناس ” ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة، والتثمير للمال، من أصحاب الجمع والمنع. وقد كان هذا المذهب عندهم كالنسب الذي يجمع على التحاب، وكالحلف الذي يجمع على التناصر. وكانوا إذا التقوا في حلقهم تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه، التماسا للفائدة، واستمتاعا بذكره” (ص 29). السرد مصدر للمتعة والمعرفة، فهو يعلمهم مآثر بخلاء فاقوا غيرهم بفضل تقشفهم وقهرهم لشهوات النفس وإذلالهم للجسد، بخلاء صاروا أبطالا، بل صاروا من الصالحين حسب المعجبين بهم، أو كما قال بعضهم: “لا تعلم أنك من المسرفين، حتى تسمع بأخبار الصالحين” (34). وإلى جانب النماذج المعاصرة، يستشهد بخلاء الجاحظ كثيرا بعمر بن الخطاب والحسن البصري. بهذا المعنى يعتبر البخل عند أصحابه نوعا من الزهد و النسك، وصراعا عنيفا ضد النفس الأمارة بالسوء، التي لها “عند كل طارف نزوة (…) فإنك متى رددتها ارتدت، ومتى ردعتها ارتدعت. والنفس عزوف، ونفور ألوف، وما حملتها احتملت وإن أهملتها فسدت” (ص 92).
بقدر ما يحب البخيل الحكايات التي تحث على البخل، بقدر ما يرتاب من الحكايات التي تحرض على الجود وتشيد بفضائل شخصيات مشهورة بالكرم: “دعني من حكايات المستأكلين ورقى الخادعين (…) ودعني مما لا نراه إلا في الأشعار المتكلفة والأخبار المولدة والكتب الموضوعة” (ص 176). وازدراء البخلاء لهذا الصنف من الحكايات لا يعادله إلا احتقارهم للشعر، بدءا بالشعر الجاهلي الذي يمجد ويفخم الإنفاق المفرط قصد المباهاة، أو “البوتلاتش” كما يسميه البعض(8). فالنموذج الذي يقترحه الشعر الجاهلي هو السيد، رئيس القبيلة الذي، علاوة على شجاعته في المعارك، يطعم عشيرته ويقوم بأعمال تؤدي إلى إتلاف المال كالعطاءات الخارقة والميسر ومجالس الشرب(9). هذا النموذج الجاهلي هو بالضبط ما يناضل البخلاء ضده ويسعون إلى تقويضه.
من عدة جوانب، يمكن أن نعتبر كتاب الجاحظ موجها ضد البوتلاتش، ضد ثقافة العطاء المفني للمال، ضد القيم التي ينقلها الشعر الجاهلي. البوتلاتش يبدو حينئذ سلوكا أخرق، عملا في غير موضعه، عملا قد يكون له ما يبرره، عند الاقتضاء، في مجموعة قديمة، في تنظيم عشيري، ولكنه غير لائق إطلاقا في مراكز حضارية كبرى كالبصرة حيث يتجاور أفراد من مختلف الأصول والثقافات، وحيث ينعدم الإجماع حول القيم. لقد تغير الزمن، والفضاء بدوره تبدل: فالبيداء التي يصفها الشعر، معوضة، في كتاب البخلاء، بالحيز المدني، الحضري، مع مشاهد داخلية (دور، قصور، مساجد) ومشاهد خارجية (أزقة، دكاكين، أسواق، أنهار، سفن). والعرق والأصل، رغم أهميتهما، لم يعد لهما دور أساسي. في السياق الحضري الجديد، المتعدد الأجناس، والذي يتميز بشيوع الكتابة وبالأهمية القصوى التي يكتسيها المكتوب، صار الفرد يعي أن العشيرة والنسب لا يسعفانه كثيرا وأن عليه أن يعتمد قبل كل شيء على جدارته الشخصية(10). فإذا كان بخلاء الجاحظ متشائمون، وهم الذين “وفروا نصيب الخوف وبخسوا نصيب الرجاء” (ص 2)، كما يلاحظ خصومهم، فلأنهم مقتنعون أن لا شيء يرجى من الغير(11) وأن الغنى هو الميزة الوحيدة التي يمكنهم الاعتزاز بها.
إلا أنه رغم التحول الذي طرأ على الحياة الاجتماعية، فإن ثقافة البوتلاتش تستمر في التأثير، عن طريق الأمثال والأقوال المأثورة وعلى الخصوص عن طريق الشعر. فالشعراء، وهم قوم بودهم “أن الناس كلهم قد جاوزوا حد المسرفين إلى حدود المجانين” (ص 90)، هم أشد أعداء البخلاء، وهؤلاء يتصدون لهجوماتهم وينعتونهم بالشحاذين والطفيليين: ” فاحذر رقاهم وما نصبوا لك من الشرك، واحرس نعمتك وما دسوا لها من الدواهي. واعمل على أن سحرهم يسترق الذهن ويختطف البصر” (ص 175). الجدير بالملاحظة أن بخلاء الجاحظ لا يقرضون الشعر، فهم يتعاطون النثر والنثر فقط. إن تبخيس الكرم يتماشى مع تبخيس الشعر، وإعلاء شأن البخل يرافقه إعلاء لشأن النثر. وبما أن الشعر مرادف للكذب (لأنه يغر ويخدع ويفتن)، فإن النثر مرادف للصدق. أي نثر؟ النثر المؤسس على العقل والاستدلال والمبني على الحجة والبرهان: إن البخلاء أهل جدال، والشكل الذي يفضلونه هو الرسالة، الرسالة التي لم تعد في السياق الجديد مقصورة على الدوائر الرسمية، والتي أخذت شيئا فشيئا تزيح الشعر لتحل محله.
الهوامش
1 – تحقيق طه الحاجري، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة، 1981 (الأرقام بين عارضتين تحيل إلى صفحات هذه الطبعة). بالإضافة إلى مقدمة طه الحاجري، انظر فدوى مالطي-دوغلاس، بنيات البخل، البخلاء في الأدب العربي القروسطوي (بالفرنسية)، ليدن، 1985، وعبد الفتاح كيليطو، “الكتاب والكتاب المضاد”، ضمن لسان آدم، توبقال، 1995.
2 – يعود الجاحظ إلى هذه المسألة في رسالة أبي العاص: “وكانوا يعيبون من يأكل وحده، وقالوا: “ما أكل ابن عمر وحده قط”، وقالوا: “ما أكل الحسن وحده قط” (ص 167).
3 – إذا تنبهنا لهذه النقطة، فإن الفصل الأخير من الكتاب، المكرس لـ “علم العرب في الطعام”، يبدو من صميم الموضوع، وليس استطرادا كما اعتقد البعض.
4 – هذا ما يسمى بالإحماض. “يقال حمضت الإبل، فهي حامضة إذا كانت ترعى الخلة، وهو من النبت ما كان حلوا، ثم صارت إلى الحمض ترعاه، وهو ما كان من النبت مالحا أو حامضا(…) وفي حديث ابن عباس: كان يقول إذا أفاض من عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير: أحمضوا، وذلك لما خاف عليهم الملال أحب أن يريحهم فأمرهم بالإحماض بالأخذ في ملح الكلام والحكايات” (لسان العرب). وإلى هذا يشير الجاحظ في مقطع من البخلاء: “كان أبو نواس يرتعي على خوان إسماعيل بن نيبخت، كما ترتعي الإبل في الحمض بعد طول الخلة” (ص 72).
5 – راجع أيضا الفصل المتعلق بتمام بن جعفر (ص 116-118).
6 – عن العلاقة بين الأدب والمأدبة، من المفيد الإطلاع على دراسة ميشيل جانري، أطعمة وكلمات، الولائم وأحاديث المائدة في عصر النهضة (بالفرنسية)، باريز، 1987.
7 – راجع على الخصوص خطابات الثوري وابن المؤمل وخالد بن يزيد (هذه الشخصية الأخيرة فريدة من نوعها ولا يمكن مقارنتها إلا بشخصية فاوست).
8 – عن هذه الظاهرة، انظر مارسيل موص، “دراسة حول العطاء”، في كتابه سوسيولوجيا وأنتروبولوجيا (بالفرنسية)، باريز، الطبعة الرابعة، 1991.
9 – انظر أندراس هاموري، عن فن الأدب العربي القروسطوي (بالأنجليزية)، برينستون، 1974، ص 11.
10 – عن هذه النقطة، وبصفة عامة من مسألة العطاء في الثقافة العربية، انظر أطروحة نعيمة بنعبد العالي، الهبة و تقويض الاقتصاد (بالفرنسية)، كلية الحقوق، الرباط،1991.
11 – يقول أحد خصومهم: “وإنما صارت الآفات إلى أموال البخلاء أسرع، والجوائح عليهم أكلب، لأنهم أقل توكلا وأسو بالله ظنا (…) واعتلال البخيل بالحدثان، سوء الظن بتقلب الزمان، إنما هو كناية عن سوء بخالق الحدثان، وبالذي يحدث الأزمان وأهل الزمان” (ص 159-160).


