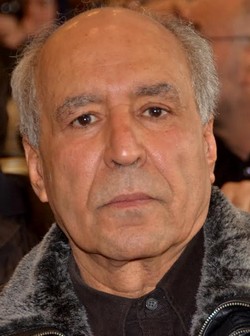
أ – أسئلة التنظير الروائي:
(1-1) لعل إحدى أهم الخاصيات المميزة لتجربة المبدع أحمد المديني الأدبية تتمثل في حرصه على إنتاج خطاب تنظيري مواز للممارسة الإبداعية(1). وهو الأمر الذي قل ما نعثر على نظير له في حقل الإبداع الروائي العربي بالمغرب. ترى، ما هي أبرز العناصر المؤسسة لهذا الخطاب؟ وهل يشكل نواة دعوة إلى تأسيس (تيار) أو اتجاه) روائي قائم بذاته ضمن مجرى مشروع التأصيل الروائي العربي بالمغرب؟
(1-2) يرى المديني أن الفهم التبسيطي الساذج للواقعية في العالم العربي-سواء عند النقاد أو الأدباء قد أدى ويؤدي إلى مضاعفات سلبية كثيرة تنعكس على مجرى تطور الوعي الفني والنظري مما ينتج عنه كثير من المزالق والملابسات. يقول: “إن إحدى المثالب الكبرى في المادة الروائية والنقدية العربية التي رافقتها جاءت نتيجة فهم أو تأويل ضحل وتوثيقي لنظرية الانعكاس ولمفهومي المحاكاة Mimesis والواقعية Réalisme دون أن يتم التساؤل: بأي واقعية يتعلق الأمر، وبالاستفسار عن مفهوم الواقع نفسه؟ وهل القصد هو واقعية الشخوص والنماذج والأنماط الروائية أم واقعية الأحداث والوقائع وعموما المسار الحدثي أم واقعية الممكن والمحتمل في النص الروائي!”(2). إنه السؤال نفسه الذي سبق للمديني أن قدم عنه أجوبة متكاملة في غير موضع. يقول: “إن الواقعية هي كتابة الاحتمالات في معاينة أو معاناة أو قراءة الواقع المعيش، وإن تنوع المعالجة وضروب القراءة ينتج، بالضرورة، عدة مستويات لهذا الواقع، ويلغي، بالنتيجة، وحدته المزعومة، وانسجاميته المفترضة، وهذه العملية التي تخلق تعدد المستويات تسمح بالإمكانية الخلاقة للواقع الذي يتجدد باستمرار من زاوية رؤيه للعالم (التناغم بين هموم الطبقة وتطلعاتها + انتقال ذهنيتها وانعكاسها على صعيد الكتابة في الرواية مثلا) من منظور الفنان الذي يعيش كفردية، أجل يعيش بهذه الفردية المتوحدة وإلا فهو ليس بفنان، قمة العزلات التي تستوعب حلبة العالم في صمت اللغة الهادرة، والصورة الحبلى بسلالة المتخيل.
ثم تسمح هذه العملية، من نحو آخر، بإنتاج مستويات مختلفة في الكتابة الإبداعية، وفقا للجنس المطروق، فالأساليب وتقنيات السرد في المحكى الروائي تتعرض لمناوبات من التبدل والتولد تبعا لطبيعة التجربة المرصودة والزاوية المنظورة. ثم إن علينا أن نتحدث عن مستوى ثالث ينجم عن المستويين السابقين فلنسميه جدل الكتابة”.(3)
(1-3) بهذه المنطلقات النظرية يقترح المديني تصوره الخاص للواقعية؛ وهو التصور الذي يمتد ليؤكد منهجيا ومفهوميا على مسألة التراتبية النسبية لمفهوم الواقعية في الأدب المغربي الحديث (حيث) يذهب إلى تنضيد المراتب التالية:
-الواقعية الاجتماعية
-الواقعية النقدية
-الواقعية الجديدة، وأخيرا
-واقعية الكتابة أو النصية المطلقة”(4).
ما هي مرتكزات “واقعية الكتابة” أو “النصية المطلقة”؟ وكيف يؤشر إلى أفقها خطاب التنظير الروائي عند المديني؟
“الشكل هو مضمونه والمضمون هو شكله في الآن عينه”(5).
هذه أول قاعدة ينص عليها المديني باعتبارها المرصد الذي يكشف مآزق الفهم التقليدي للواقعية. فالذي يفصل بين القالب الأدبي ومحتواه يسقط ضحية الاستيعاب المحدود والضيق لقضايا الواقعية والمحاكاة. لأن النص الأدبي-والروائي منه خاصة- ينبغي أن يطرح في مستوى الخطاب ذي البنيات والعلائق، ولأن المعظلة كمنت وما تزال تكمن، في تقديرنا- يقول المديني- في فهم الواقع كإمكانية واحتمال، وأخيرا الواقع كخطاب شعري Discours Poétique“(6).
أما القاعدة الثانية فتتمثل في مبدأ (الانسجام) وفق التصور الذي يراهن عليه جورج لوكاتش وامتدادات صيغته المتطورة مع غولدمان في مفهومه لـ”البنية الدالة”، يقول: “والمسألة كما يقول جورج لوكاتش، تتعلق بالواقعية، لا بوصفها، فحسب كما يذهب الظن غالبا، نمطا وتشكيلا للعلاقات الخارجية، والرصد لمنعطفات التضاد والمفارقة وتعدد المصائر وتشابكها، ولكن بوصفها، أيضا، جمالية، أي أسلوب نقل الرؤية، والأدوات والتقنيات المستعملة لذلك، بل طبيعة الرؤية ذاتها، وبوصفها تمثل الوحدة والانسجام في العالم الروائي ضمن العالم الخارجي”(7).
(2-1) تلك كانت بعض المداخل الأولية المؤسسة لخطاب التنظير الروائي عند المديني، وهي كمداخل تتفرع وتمتد إلى مستويات التحقق النصي في ممارساته الإبداعية. وإذا كان المديني يضع من (الواقعية) حجر الزاوية في تصوره النظري للعملية الأدبية، فلذلك أسباب وحيثيات، أهمها، أن سؤال الواقع والواقعية هما ما شكل الهاجس المركزي لجيل السبعينات الذي ينتمي إليه المديني. ولكي يكتمل التصور حول الإطار العام الذي تحكم في إنتاج هذا الخطاب، فقد يكون مفيدا الإشارة إلى أصداء هذه الأسئلة في بعض مستويات التبادل السجالي-الحواري الذي كان يطبع المرحلة.
(2-2) ففي ندوة (الرواية العربية – واقع وآفاق) التي انعقدت بمدينة فاس عام 1978 – وكان المديني أحد المساهمين ضمن وقائعها بورقة ضمنها بذور تصوره الذي سيعيد صياغته في كتاب (الأسئلة)(8) افتتح محمد برادة أيام الندوة بورقة عمل تحت عنوان (رواية عربية جديدة)، ومن بين ما جاء فيها انتقاده لمسألة تنظير الرواية العربية انطلاقا من أطروحات لوكاتش. إذ اعتبر أنهاقد “ضيقت الأفق بدلا من أن تفسح أرجاءه، لأن النقد العربي لم يقرأ لوكاش، قراءة كاملة أي في سياقه وتطوره وعلى ضوء الطرف المناقض له، أي من خلال المبدعين الذين كان يمثلهم برتولد بريشت في خصومته الجدالية مع جورج لوكاش. فإذا كان لوكاش قد ميز تمييزا جيدا بين الواقعيين والطبيعيين، وبين الملحمة والرواية، فإن ربطه لمستقبل تطور الرواية بانتصار البروليتاريا وعودة المناخ القريب من المناخ الملحمي، أي توحد الرؤية والتحامها، يجعل هذا الاستنتاج بالنسبة للرواية اختزالا منخلا يقفز على خاصيتها الجوهرية وهي الارتباط بالحاضر المتبدل، والاستمداد من التناقضات والصراعات ومن إمكانيات التشكيل التي لا يمكن أن تخمن مسبقا. وهذا ما يجعل موقف بريشت على جانب كبير من الأهمية، لأنه يضيء أمامنا آفاقا جديدة من التفكير والممارسة…إن بريشت عارض أن يتخذ نموذجا له الواقعيين الكبار مع تجاوز محدودية رؤيتهم التاريخية على نحو ما دعا إلى ذلك لوكاش… كما رفض فصل التقنية عن التطور المجتمعي بدعوى أنها تنتج أشكالا متدهورة.. فالواقعية عند بريشت لا يمكن أن تفصل عن مجموع المظاهر الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية وعن كل ما يعيشه الإنسان من مغامرات ونزوع إلى الاكتشاف..فالواقع ممتد لا ينتهي عند حد، ومن ثم فإن الواقعية تعني أيضا البحث عن أشكال جديدة أي عن كل ما يرافق حياة الناس”(9).
بهذه الأسئلة المتناسلة، وبهذا الجدل الخصب، وهذا البدء في إعادة النظر وتصحيح مغالطات المرحلة السابقة، سيتساوق تبلور خطاب المديني التنظيري مع ظهور خطابات تنظيرية موازية، مما يؤكد تنامي الوعي النظري في الحقل الثقافي العام بمغرب نهايات السبعينات. وإذا كانت ندوة “الرواية العربية” قد توجت هموم وأسئلة ما يتجاوز عقدي (الستينات والسبعينات) بالمغرب، فقد أكد الطابع الحواري المتقدم لأسئلة كل من (المديني وبرادة وغيرهما) حول الواقعية، مؤشرات النقلة النوعية التي يبشر بها الوعي النظري للظاهرة الإبداعية عند الكتابة والنقاد العرب (والمغاربة منهم بصفة خاصة).
لقد حرصت مداخلة محمد برادة على التذكير بالسياق السوسيو-ثقافي لتبلور تصورات وآراء لوكاتش(10) وهي خلفية للتنبيه إلى ضرورة أخذ مسألة (الخصوصية التاريخية) بعين الاعتبار. إن الهاجس نفسه نجده متحكما في القراءة الجديدة التي يقترحها المديني لمرجعيات الواقعية (لوكاتش-غولدمان)؛ فالواقعية التي ينبغي اتباعها -من هذا المنظور- هي بالأساس: سؤال في المثاقفة، وجواب على الواقع. والعكس صحيح أيضا ما دام الحوار الأدبي مع النموذج الغربي (واقعية الكبار) لا يتنافى مع الانفتاح على اللحظة التاريخية، المغربية، العربية والإسلامية. إن الهوية الفنية للخطاب الروائي تقتضي الأخذ بعين الاعتبار أطراف هذه المعادلة، وبذلك -فقط- تتحقق “اللحظة الروائية التي تريد أن تتخذ لها من الواقع مادة عملها، ثم استثمار هذا الواقع مصوغا صياغة فنية في ما يشبه القيام بإنجاز معادلة شاملة بين ما هو فني وما هو مجتمعي”(11). ويمكن أن نضيف، بين ما هو غربي مستورد وما هو شرقي أصيل.
(2-3) لقد دعا المديني إلى التمرد على الفصل الزائف بين الشكل والمضمون، وألح على وحدة المكونين وانسجامهما، ومفهوم الانسجام هذا، هو بالذات ما شكل قاعدة دعوته المتواترة إلى ردم المسافات الوهمية بين أطراف ثنائيات زائفة من قبيل (النثر والشعر- الشكل والمضمون- المكتوب والشفوي- المشخص والمجرد-الخاص والعام- الفردي والجماعي-الذاتي والموضوعي(…) الخ). ففك التعارضات الوهمية بين أطراف هذه المعادلات التقليدية هو ما من شأنه أن يدشن زمن التداخل الروائي. وهي القاعدة – الأم في مراتب مرتكزات الطرح التنظيري عند المديني. إن “واقعية الكتابة” أو “النصية المطلقة” تمر عبر جسر التداخل الروائي، وهي استراتيجية لا تتعارض مع أفق الحوار المنتج مع مكونات اللحظة التاريخية (المحلية والقومية والعالمية). كما أن تأسيس زمن التداخل الروائي لا ينفي أولوية “الوعي الثاقب بأهمية المعمار الروائي، وبنياته الدالة”(12).
أما المبدأ الناظم لقواعد هذا التصور، فهو مبدأ الرؤيا: فتجديد الخطاب الواقعي وفق المرتكزات السابقة هو ما يؤهل الكتابة إلى الانخراط في مرحلة المشروع الروائي (الرؤيوي-التركيبي)،(13) حيث ينتفي” التناقض العظيم بين الوجود واللاوجود” وتنهار “الهوة العميقة التي تفصل بين الوجود والزمن، بين الزمن والتاريخ، بين الأنا الذاتية-الجماعية والمصير الماساوي”(14).
إن تخطي كل مآزق الفهم التقليدي للواقعية لا بد وأن يأخذ بعين الاعتبار مؤشرات هذا الخطاب التنظيري؛ وإلا، فإن التراكم الروائي سيبقى أسير النزعة الموازية للتجربة الإبداعية عند المديني. وإذا كانت تلح على أهمية صوغ الواقع “في إطار رؤيا وليس عبر المرآة التسجيلية-الانعكاسية-(15)، فلأن الواقع الجديد- كما يقول المديني- “هو المؤهل أكثر من سواه ليطلع لنا ليس ما انتبه له وكأنه محض صدفة، بأنه يمثل رواية عربية جديدة، ولكنه هو الرواية بالفعل، وقد جللتها الرؤيا المأساوية، واكتسبت أكثر فأكثر أدوات تعبيرها الصحيحة”(16).
ب – فرضية العمل:
(3-1) من خلال مرتكزات الخطاب التنظيري الموازي للمشروع الروائي عند الكاتب المديني يتضح أن الإشكالية المحورية التي تنتظم تجربته الإبداعية تتمثل في : إشكالية الواقعية. وهي الإطار النظري الذي يضع المهاد الاستراتيجي لمقاربة نص (الجنازة) باعتباره الحلقة الثالثة ضمن تراكم التجربة الروائية المدينية(17).
كيف تتعامل رواية المديني مع سؤال الواقع؟ وكيف تكون نصا واقعيا، وفي الوقت نفسه تعتبر رواية تجريبية؟ وما علاقة الواقعية بالتجريب من خلال الجنازة؟ وهل تضيف جديدا إلى إنجاز التراكم الروائي الواقعي بالمغرب؟
تجدر الإشارة إلى مدى مراهنة مشروع التأصيل الروائي العربي بالمغرب على الواقع والواقعية في بدايات النشأة المتواصلة. ومن بين المآزق التي ظهرت، جنوح التراكم الروائي إلى التقليل من شأن الوظيفة الجمالية للكتابة، بحكم ما كان لتوجيه الخطاب الانتقادي-الحامل لشعار الواقعية-من سلطة. فالرواية الواقعية في أعقاب (النص المرجعي) ظلت أسيرة التأطير الاجتماعي والمسبقات الإيديولوجية- مع استثناءات قليلة-وهذا ما جعلها تحاور الواقع من خارج الكتابة، فراكمت ما اصطلحنا على تسميته بـ(الواقعية المضمونية) التي تخلص لوصت الخيال والجمال.
إنها الاعتبارات نفسها التي حفزت الخطاب التنظيري -الآنف الذكر- على التصدي للأوهام والمغالطات التي كرستها المرحلة.
وهي نفسها الاعتبارات التي تقدم عناصر السؤال الإشكالي لهذه المقاربة.
-إذن، كيف تتصدى رواية _الجنازة) لمغالطات الفهم التقليدي للواقعية؟ وما هي العناصر التشكيلية الجديدة التي تقترحها لمساءلة الواقع من زوايا غير مسبوقة في الخطاب الواقعي؟ وهل وفقت إلى المزاوجة بين الانخراط في سيرورة التجريب، وبين الحفاظ -في الوقت نفسه- على المبدأ الواقعي منطلقا وأفقا للكتابة؟ وبماذا يمكن القول إن (الجنازة) قد تخطت بعض مآزق امتدادات (النص المرجعي)؟ وهل ظل التحقق النصي وفيا لأسئلة التنظير الموازية؟
بهذه الأسئلة وبغيرها تتقدم مقاربة هذا النص الروائي كمدخل لمساءلة قضايا وأسئلة تعتبر من صميم هموم وإشكاليات المشروع الروائي العربي بالمغرب قيد التشكل. فإلى أي حد يمكن اعتبار “الأسلوبية” المنهج الأكثر ملاءمة لاستخلاص بعض مقومات جماليات الخطاب “الواقعي” في “الجنازة”؟
ج – تقديم نظري عام:
(4-1) يقول باختين: “نحن لا نفحص اللغة كنظام من المقولات النحوية المجردة بل كلغة متخمة إيديولوجيا، كمفهوم للعالم، كرأي ملموس، أو مثل ما يضمن حدا أقصى من الفهم المتبادل في كل مجالات الحياة الإيديولوجية”(18). وهذه النظرية الجديدة إلى اللغة الروائية هي ما يقدم المهاد الملائم لتجسير العلاقة بين المكون الأساسي في النص الروائي (اللغة) والمرجع الخارجي (الواقع)، وذلك عبر تصور إجرائي متطور للعلائق بين أقطاب الظاهرة الأدبية. من هنا، فإن معنى الإيديولوجيا هو الآخر يكتسب بعدا مغايرا لمعناه “المضموني” المبتدل. إنها “مجموع الانعكاسات والانكسارات داخل العقل البشري، للواقع الاجتماعي والطبيعي الذي يعبر عنه ويثبته عبر الكلمة، الرسم، الخط، أو بشكل سيميائي آخر. فقولنا إيديولوجيا: يعني داخل علامة، كلمة، حركة، خط بياني، رمز…الخ”(19).
إن إعادة النظر في العلاقات القائمة في الرواية بين اللغة والإيديولوجيا وبين اللغة والواقع، هو نفسه المبدأ الذي ترتب عنه الإقرار بوحدة الشكل والمضمون باعتبارهما وحدة أسلوبية في الخطاب المفهوم كظاهرة اجتماعية: فهو اجتماعي في كل مجالات وجوده وفي كل عناصره، بدءا بالصورة السمعية وانتهاء بالتصنيفات الدلالية الأكثر تجريدا(20).
إن النقلة المنهجية في التحليل الأسلوبي وفق بعض آراء باختين المتشعبة، تذهب إلى أبعد من ذلك، فتطرح تصورا جديا لعلاقة اللغة بالمؤلف، وعلاقتها بمؤسسة الجنس الروائي. فبعيدا عن التصور الكلاسيكي لتفرد أسلوب الكاتب ومطابقته لأسلوب الجنس التعبيري، يتحدث باختين عن “أسلوبية الجنس الروائي” حيث تعدد الأصوات والرؤى، و”تنوع اللغات، وليس وحدة لغة مشتركة معيارية، هو ما يبدو بمثابة قاعدة يقوم عليها الأسلوب”(21). ففي هذا السياق يأخذ صوت المؤلف موقعه إلى جوار بقية الأصوات والأساليب المتحاورة. وهذا النزوع صوب التعدد اللساني، هو ما يجعل المشكلة المركزية لأسلوبية الرواية ربما تصاغ باعتبارها مشكلة التشخيص الأدبي للغة، ومشكلة صورة اللغة”(22). هنا -كما يوضح محمد برادة- لا يتعلق الأمر بـ”اللغة -النسق ذات البنية الثابتة، وإنما اللغة -الملفوظ-الكلمة- الخطاب، المحملة بالقصدية والوعي والسائرة من المطلقية إلى النسبية، والتي تبتعد عن دلالة المعجم لتحتضن معاني المتكلمين داخل الرواية، فتكشف لنا عن أنماط العلائق القائمة بين الشخوص وعن القصدية الكامنة وراء كلامهم وأفعالهم”(23). إن الرواية ظاهرة متعددة الأساليب والأصوات واللغات، وتنطوي على وحدات أسلوبية عليا. وهذه المنطلقات المنهجية هي ما يحفز هذه المقاربة إلى البحث عن بعض مظاهر التنوع الأسلوبي وممكنات التعدد اللغوي في مجرى التحقق النصي لرواية الجنازة. أما الأدوات الإجرائية والآليات الاصطلاحية التي سنسترشد بها في توصيف بعض تلك العناصر التشكيلية، فيتمحور أهمها حول سؤال التشخيص الأدبي للغة ومجموع صور اللغة التي تتقاطع بعض مظاهرها مع الطرائق التالية. يسجل برادة، نقلا عن باختين الآتي: “إلى جانب سياق التضمين وخطاب الكاتب في تشخيص لغة الآخر يورد باختين ثلاث طرائق لتشييد صورة اللغة في الرواية:
-الحوار الخالص، الصريح
-التهجين: أي مزج لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد، والتقاء وعيين لغويين مفصولين، داخل ساحة ذلك الملفوظ، ويلزم أن يكون التهجين قصديا.
-تعالق اللغات والملفوظات من خلال الحوار الداخلي: أي دخول لغة الرواية في علائق مع لغات أخرى، من خلال إضاءة متبادلة بدون أن يؤول الأمر إلى توحيد للغتين داخل ملفوظ واحد. وصيغ هذا التعالق هي:
-الأسلبة:أي قيام وعي لساني معاصر بأسلبة مادة “أجنبية” عنه، يتحدث من خلالها عن موضوعه “فاللغة المعاصرة تلقي ضوءا خالصا على اللغة موضوع الأسلبة، فتستخلص منها بعض العناصر وتترك البعض الآخر في الظل..”
-التنويع: نوع من الأسلبة يتميز بأن المؤسلب يدخل على المادة الأولية للغة موضوع الأسلبة، مادته “الأجنبية” المعاصرة (كلمة، صيغة، جملة…) متوخيا من وراء ذلك أن يختبر اللغة المؤسلبة بإدراجها ضمن مواقف جديدة مستحيلة بالنسبة لها.
-الباروديا: نوع أساسي من الأسلبة يقوم على عدم توافق نوايا اللغة، المشخصة مع مقاصد اللغة المشخصة، فتقاوم اللغة الأولى الثانية وتلجأ إلى فضحها وتحطيمها. لكن يشترك في الأسلبة البارودية ألا يكون تحطيم لغة الآخرين بسيطا وسطحيا، بل عليها “أن تعيد خلق لغة بارودية وكأنها كل جوهري مالك لمنطلقه الداخلي وكاشف لعالم فريد مرتبط ارتباطا وثيقا باللغة التي بوشرت عليها”(24).
(4-2) تلك كانت بعض آليات المنهج الأسلوبي كما تراهن عليه بعض كتابات باختين المتنوعة. وإذا كان هذا الأفق المنهجي لا يمكن أن يتطابق أو يفي بكل ما يقترحه نص (الجنازة) من خصائص أسلوبية، فلعله يكون مجرد حافز ناظم لخطوات التحليل. تلك الخطوات التي تأخذ بعين الاعتبار:
-“الطابع الوظيفي لكل ملمح أسلوبي في النص الروائي باعتباره كلا.
-علاقة الخصائص الأسلوبية للرواية بالخصائص المميزة لهذا النوع ذاته.
-الأثر الحاسم لزاوية نظر الكاتب/والراوي الذي ينوب عنه في صياغة الشكل الأسلوبي العام للرواية”(25).
فبهذا المنحى ستعمد هذه المقاربة إلى تلمس بعض مظاهر النمذجة الأسلوبية للواقع والإيديولوجيا وفق ما تراهن عليه بعض تمظهرات التحقق النصي. على أن السؤال المركزي الذي سيبقى بمثابة الموجه الأساس لكل إجراءات التحليل يتمثل في محور (الواقعية). إذ كيف يؤسس المديني -عبر هذا النص- مساهمته في تجديد خطاب الرواية الواقعية بالمغرب؟
مقاربة تحليلية لرواية (الجنازة)
I – فسيفساء النص:
(5-1) في هذا النص تتمايز (الكتابة) عن الرواية ويتداخلان في الآن نفسه. أما الفصل الأول (الجنازة1) فلا يحضر فيه ما هو روائي إلا في حدود دنيا، بينما تنهض الكتابة كأفق للسرد المركب، بأوسع معاني السرد(26). وفقط، مع بداية الفصل الثاني وامتدادا مع الفصول الموالية (الجنازة 2، 3، 4، 5، 6) تبدو “الرواية” أكثر وضوحا وتبلورا، ويتنامى عنصر الحكي في اتجاه أكثر تبنينا وبروزا. ما الفرق بين الكتابة والرواية؟ وأين ينتهي نسيج هذه ليبدأ نسيج تلك؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي القيام بتقطيع إجرائي لوحدات النص. وقبل ذلك تتعين الإشارة إلى أن هذا التقسيم يتكرس مع (السارد الكلي المعرفة) نفسه، حيث يعلن في منتصف الفصل الرابع تبنيه لهذا التمييز، إذ يقول:
“إلى هذا الحد تنقطع الرواية، ولا تنتهي الكتابة”(27). وبهذا المعنى، فإن “الكتابة” لا تقتصر على الفصل الأول، بل تمتد إلى فصول لاحقة لأنها أشمل من الرواية.
إن الفصل الأول يشكل وحدة أسلوبية متكاملة العناصر، ويمكن فصلها إجرائيا عن بقية الفصول باعتبار هذه الأخيرة تشكل وحدة أسلوبية قائمة بذاتها هي الأخرى (الجنازة 2، 3، 4، 5، 6). وفي تفاعل الوحدتين، تنهض الوحدة الأسلوبية العليا التي تؤسس رؤيا النص. فما هي -ياترى- العناصر التشكيلية التي تميز التشكل النصي لكل وحدة سردية من بين وحدتي الخطاب الروائي ككل؟ وما الذي يجعل من “الكتابة” تتسع لتتجاوز العنصر الروائي، بينما تتميز هوية الروائي لتنفلت عن امتداد الكتابة؟
II – الرواية في درجة الصفر:
(5-2) في معرض دراسته لبعض جماليات (الرواية الجديدة) بفرنسا، يتحدث جان ريكاردو Jean Ricardou عن ما يسميه بـ” حرب المحكيات”، و”حرب البلاغات”، و”معركة الأساليب”(28)، وهي جميعا صيغ اصطلاحية تؤشر إلى أفق الكتابة حين تجنح صوب المزج بين الفنون والأجناس التعبيرية المتباينة. وفي حالة (الجنازة)، ومنذ الفصل الأول، يقف القارئ (الممكن) على ضروب من التجاور والاصطراع والتداخل بين قوالب حكائية، وآفاق بلاغية متنوعة تضطلع بصوغها أسلوبيا جملة “معارك” أو “حروب” بين أجناس تعبيرية متخللة.
أما الصراع المحوري بين تكوينات النسيج السردي فيمثله التداخل النوعي بين الفن الشعري والنثر الفني. فالصراع بين فعالية هذا وذاك تضع الكتابة على تخوم (المحكي الشعري) وفق المفهوم الذي يحدده له تاديي Jean-yves Tadié في دراسته التي تحمل العنوان نفسه(29). فحركية السرد ونموه تقترنان بـ”صراع ثابت بين الوظيفة المرجعية، بمهامها الاستدعائية والتشخيصية والوظيفة الشعرية التي تثير الانتباه إلى شكل المرسلة نفسها”(30).
وهذا ما يضفي على فسيفساء الكتابة ضروبا من التمازج والتداخل بين العناصر النوعية المتمايزة. فمن جهة، هناك وحدات شعرية قائمة بذاتها تتخلل مسافات النسيج السردي، وهي في اشتغالها الأسلوبي تتملك كل خاصيات اللغة الشعرية (صور شعرية + بنية إيقاعية + وحدة عضوية (…)). وهذا هو الأفق الذي تدشن به (الجنازة1) سيرورتها النصية، حيث نقرأ:
“إن البدايات مدهشة وإن الصحو معتمل
وقد خرجت لك اليوم
وهبت على محياك الأعاصير
فاستف ما في الطريق من ملح
ما بين الجناحين أهتف يصعد التيار
ها إن اللون يشتعل
إن البدايات صاخبة (…)
(…)
إن البدايات صاعقة (…)
(…)
إن البدايات موحشة (…)
(…)
لا شيء يموت
لا شيء يعيش
الأمس حداد واليوم كذلك
آخر الخطاب لن يأتي
وأول الخطاب فات
والساعة تدق:
موت، موت، موت”(31).
ومن جهة أخرى، هناك ما يمكن أن نعتبره غزوا من طرف الشعري للنثري، وهو غزو يتخذ له تجليات متنوعة تطبع الصوغ الفني لنسيج السرد. إنه اشتغال الوظيفة الشعرية في حقل النثر الفني، وهو اصطراع يمد الكتابة بمقومات جمالية من قبيل (الإيقاع الصوتي) على سبيل المثال. كيف ذلك؟
(5-3) هناك مجموعة من العناصر التشكيلية المستمدة من الشعر يمكن رصدها في عينات متنوعة من نسيج هذه الوحدة الأسلوبية. ومنها – بصفة خاصة- (التكرار والتضاد والرجع والسجع…) وهي جميعا مقومات فنية تؤهل النثر الفني إلى امتلاك “بنية إيقاعية” شأنه في ذلك شأن الفن الشعري. وكأمثلة على ذلك، نقرأ: – في مستوى (المعاودة) وعلى صعيد المفردة: “وقلت السيبة والسيبة، والمخزن والمخزن كل يوم، من شروق الشمس إلى غروبها، ثم إنها لا تشرق مع السيبة، والمخزن وبوغابة الذي يمنعنا من الحطب، وقائد الحرس، وكلاب الحرس، وديدان الحرس، وقمل الحرس، وظللنا نهرس زمنا طويلا فتآكل الجلد، وهتكت الأعراض، وفسق في الطين والتين، واعتصم الرجال كلهم في “كتامة” يدخنون الكيف ويحلمون في الظلام بانقشاع الظلام”(32).
-“وطوبة لكم وطوبى وطوبى وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين-المرسلين. فهل أكون أنا، إذن، من المرسلين إليكم يا “أولاد حريز”. الخبزة أغوتني، والخبزة شردتني، والخبزة نشرتني في البلاد”(33).
-“وأخيرا فقد ابتدعوا الصراخ عوض الكلام: يؤشرون بالصراخ، يبيعون بالصراخ، يضاجعون بالصراخ. والأدهى من هذا أنهم يطلبون الزيادة في الأجور بالصراخ، وتلك علامة أخرى عن قرب خروج الدابة. والحقيقة أنهم يصرخون ضد اللغة العربية الفصحى”(33).
-“وتردد الصدى فوق كل القمم الأطلسية يحمل نحيب نسائنا الريفيات، ثم انضغاط الريف بين فكي المخزن والسيبة والمخزن، زن، زن، ززززز”(34)
-أما في مستوى التضاد، فنقرأ مناورات تركيبية تخضع المعجم لسيرورة لعبوية تنسف المعنى التقريري وتراهن على تعدد الدلالة:
-“واشتبه علينا أننا نسمع من ينادي أن يا أهل المغرب أزفت شمسكم على الغروب، ومغربكم على الشروق، وأنت يا ابن آدم أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك. أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك. أقتلت الدنيا أن الدنيا قتلتك. إلتفتتم حولكم أم التفوا عليكم”(35).
-” وليس ما بين القتل والصمت إلا الكلام
وليس ما بين الكلام والصمت إلا القتل
وليس ما بين الصمت والقتل إلا القتل”(36)
(5-4) إن هذه العناصر التشكيلية (التكرار – التضاد – الصدى…) مدعومة بوحدات شعرية مشبعة بالانزياحات الدلالية والمجانسات الصوتية والتوازيات الدلالية، هي كلها مكونات فنية تؤسس لسيرورة الاقتصاد السردي (بنية إيقاعية) تتوجه نحو استثمار حاسة السماع في المكتوب عبر تكريس لعب تركيبي ومعجمي له التصادي والإيحاء. وبشكل مواز تضطلع عناصر تشكيلية مساوقة بأغراض مناظرة من قبيل (السجع)، حيث نقرأ:
-“نحن عسكر المدينة، صرخوا، ولن يفلت منا هذا الآبق، المارق، المفارق، الملاحق، الناعق”(37).
وهناك التشغيل الوظيفي لعلامات الوقف التي تعكس بمستوى استثمارها درجة العناية القصوى التي تحظى بها أدق عناصر اللغة (النقطة، الفاصلة، الحرف، المفردة، الجملة، الخطاب…) وكمثال على ما تحظى به المفردة الواحدة من “تحكيك” و “صقل” تبلغ معه حدود منح أنفاسها الأخيرة، نقرأ:
-“ومن برد السنين يعم عمر الناس صهدك، يحبو، يزحف، يركض، يلهث، ينهج، ينقطع النفس. عرق. نار هي، جحيم، فلوات قطعت، كثبانا نهضت”(38).
***
إنها بعض مظاهر غزو الشعري للنثر الفني، وهو حوار أجناسي تتبادل فيه الأساليب والبلاغات جمالياتها، فتغدو المرسلة مسرحا للاحتفاء واللعب المرآوي مع “النفس”. وهي البذور الأولية لنمو وعي جديد بالانعكاس، تكتفي فيه الكتابة بالإحالة على صورتها، جاعلة – بذلك- من فعل الخلق – في حد ذاته – هدفها الأساس. لقد اصطلح ميشيل منسوي Michel Mansuy في مقال له حول الرواية الجديدة بفرنسا(39) على ألعاب المرآة هذه بما أسماه “نرجسية المتخيل”. وفي ذلك ما يؤشر |إلى تفاعل هذا النص مع أفق انتظار الرواية الغربية المتمردة، إذ؛ ما أسرع ما يتطور هذا التنويع الصوتي إلى مستوى جعل الخيال -ككل- يتأمل صورته المكررة في مرآة السرد إلى ما لا نهاية”(40).
(6-1) بشكل محايث ومساوق لاصطراع وظيفتي (الشعري والمرجعي)، ينهض الصوغ الأسلوبي لهذه الوحدة السردية (الجنازة1) باستيعاب حوار داخلي متنامي بين بنيات فنية وقوالب تعبيرية أخرى مغايرة تضفي على سيرورة التشكل النصي طابع اللاتمركز. إنه منحى تدميري يراهن على المزج والتداخل بين أجناس متخللة، يتمرد اشتغالها على ضوابط النوع الروائي التقليدية، بحيث يغدو هاجس التقويض أفقا لتكريس منزع انقلابي، له البحث والكشف عن إمكانات تعبيرية لا نهائية: هو الطموح إلى إعادة تجنيس النوع الروائي من خارج حدوده وقيوده ضدا على أوهام (النقاء النوعي)، وابتغاء معانقة “مطلقية الكتابة”. فبهذا المنطق الفني المتمرد على كل معيارية، تصهر هذه الوحدة الأسلوبية -ضمن صوغها الحواري الداخلي- فنيات زخرفية لكل من (الرحلة والسيرة والخرافة والحديث والحلقة والمسرحية والأسطورة (…) وهو تبادل حواري يؤسلب بلاغات وأساليب، قوالب وبنيات جمالية متنوعة في أفق لا نهائية الكتابة. يقول الراوي بصدد تأطير شخصية مولاي علي:
-“من القليعة إلى غفساي
-من غفساي إلى القليعة
-من غفساي إلى القرويين
-من القرويين إلى الشاوية
-من الشاوية إلى الشاوية في برشيد
-من برشيد إلى الدار البيضاء”(41)
إنه قالب (الرحلة) الذي جاء متداخلا مع قالب (السيرة) أو (الترجمة الذاتية) لشخصية روائية قيد النمو. وهو نفسه الصوغ الأسلوبي المزدوج الذي تخضع له شخصية روائية أخرى من عالم الأشياء (مدينة الدار البيضاء) التي يؤرخ الراوي للحظة ميلادها بقوله:
-“في البدء كان هنا البحر وروث البهائم وطائر اللقلق (…) الخ”. وهي (رحلة-سيرة) لمدينة ستتولى بنفسها- بصوتها عملية تأطير حياتها ومماتها، بما يرافق ذلك التأطير من دفاع عن النفس ضد كل التهم الموجهة إليها بدعوى “المخالفات”:
-“إنني الدار البيضاء أشهد أنه باطل، وأنه لاحق اليوم إلا وهو باطل، وأني ما أجرمت في حق أحد، فلا أنا ضيقت، ولا أنا وسعت، ولا دفعت الجدران إلى الاعوجاج، ولا السقوف إلى الانخراق، كما المجاري، والحديث في الأسواق والقيساريات بالصراخ بدل اللغة العربية الفصحى، المقدسة، فكله لم يحدث وحدث ويحدث وسيحدث بتدبير من العزيز الحكيم، يوتي الملك من يشاء(…)”(42).
(6-2) في هذا المسار المراهن على تداخل البنيات الفنية وتمازج القوالب الجمالية، تنفتح سيرورة التشكل الأسلوبي على فنيات زخرفية أخرى تراثية ومستحدثة. كـ(الخرافة) أو ما يمكن الاصطلاح على تسميته بـ(الحكاية أو الطرفة الخرافية)، من ذلك قول الراوي:
-“وكان أول مواطن حوكم هو سيدي عبد الرحمن بن المجذوب، لأنه حسب القضاة والمستشارين ووكلاء الدولة وكتاب الضبط، ونواب كتاب الضبط، والمستكتبين، والآذنين، حسب هؤلاء جميعا، شتم مدينة الدار البيضاء، ومعنى هذا أنه شتم المساجد والأئمة والصالحين، ومصالح كنس الأزبال، والساهرين ليل نهار على راحة وأمن المواطنين، إذ رفع عقيرته وجأر:
-” الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود”(43).
أما تقنية السند (المرتبطة في التراث العربي الإسلامي، بقالب الحديث النبوي أو المقامات وكتاب الأغاني (…)) فيتم استثمارها خارج مقامها الديني لتضطلع بوظيفة الزخرف الفني. فكلام الخوري (وهو رمز ثقافي معاصر) يتحول إلى حجة شأنه في ذلك شأن أي نص ديني يعتمده علماء المسلمين لتحديد مراتب السنة ودرجات صحتها وتمييز المقبول منها والمردود. وهو صوغ تهكمي لا يخلو من تندر ورمزية:
-“هذا وإن حجتنا وعمدتنا وأساس روايتنا متواتر لا يصل إليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنتهي في السند الصحيح إلى الفاضل العالم العلاّمة، الكاتب التحرير، شيخنا إدريس الخوري، نزيل “درب غلف” وهو الملقب بـ” بّا ادريس” وقبته منصوبة وعالية في ساحة “مرس السلطان” تزورها الخلائق من كل فج عميق، أمد الله في عمره، ونفعكم ونفعنا ثم نفعكم جميعا بآياته وفضائله “شاي الله أبّا ادريس”(44).
(6-3) في نفس سياق الانفتاح على جماليات القوالب الفنية التراثية والمستحدثة تستثمر -هذه الوحدة الأسلوبية- بعض تقنيات (الحلقة) والكتابة الدرامية (المسرحية):
أما المستوى الأول، فيتجلى مع تحول القائم بالسرد إلى (راو شعبي) على غرار راوي الحلقة الذي يتفنن في صنع الفرجة عن طريق مهارات الأداء الشفوي والحركي، المطوح بالمتفرجين في مسارات التشويق والتسلية:
-“أيها السادة. سنفتتح الفرجة قريبا فأمهلونا. عندنا مغان وطيب وزبرجد. بغداد وإرم ذات العماد. عندنا الإنس والإنس الجان. وعندي لكم في آخر الحفل مشاهد تحتار فيها الألباب. فأمهلوني قليلا”(45).
وهو السعي الدؤوب لخلق فضاء سحري متخم بالحس الدرامي الرفيع، ومفتوح على صور مسرحية قيد الكتابة الدرامية. هذا ما تزكيه تقنية (الإرشاد المسرحي) في المقطع التالي:
“مقطع وصفي. ديكور قبل بدء الحفل. الشاهد
والشهيد والمشهود عليه. سطوب. عم الجفاف وجاء
الجراد. سطوب. خرجوا حفاة عراة يستسقون الغيث
ثم خرج قوم آخرون يستعجلون القيامة. سطوب,
ينزل الستار قبل أن يرتفع”(46)
فهذا الاستثمار الأخير يكشف كيف أن الصوغ الحواري لأسلوبية هذه الوحدة السردية لا يقف عند حدود الأجناس التعبيرية (اللفظية)، بل، أكثر من ذلك، فهو يستوعب الزخارف الفنية للفنون غير اللفظية من قبيل (المسرح). إن الإرشاد المسرحي ينهض على ترك الفجوات والبياضات والفراغات في نسيج الكتابة. وهي مستويات تظل مشرعة وقابلة للملء والتحويل والتشخيص: إنه أفق “المسرحة” كهامش في حيز (القوة)، وهو مرهون لأية عملية “إعادة كتابة”، حتى يخرج إلى حيز (الفعل). أما امتدادات فعل (التمسرح) الذي تدشنه تقنية (الإرشاد المسرحي) ويزكيه (الراوي الشعبي) بمهاراته الفرجوية، فتبدأ مع التوزيع الهندسي الثلاثي الأقطاب الذي تعكسه الوحدات السردية الصغرى في مختتم (الجنازة1). ففي عملية التوزيع -هذه- تتقدم ثلاثة (أصوات) في صيغة أدوار متبادلة، كل منها يحمل قناع (شاهد)، فيتناوبون (كممثلين) على أداء شهادات “مسرحية” حول مشهد “يوم الحشر” (كناية عن انتفاضة مدينة الدار البيضاء وتمويها لمشهد جنازتها – قيامتها)، فهناك:
1-الشاهد – المبعوث الأول
2-الشاهد-المبعوث الثاني
3-الشاهد-الشهيد
(رأس المبعوثين)
والخلفية “التناصية” التي تسند محكيات هؤلاء الشهود تمتح من حقل (علم الأخرويات)، جاعلة من الدنيوي -بذلك- أفقا للتمازج مع ما هو “أخروي”. إنه تخييل إيحائي مضاعف الدلالة. ينفتح – بشكل متساوق – على مأسوية المعيش (انتفاضة البيضاء العظيمة)، وفجائعية اللامرئي (زمن الحشر العظيم)، وهي “رؤيا قيامية” تصهر العالمين: “الدنيوي والأخروي” في صوغ أسلوبي واحد، يلازم نمو النص ويؤسس نواته الرؤيوية – التركيبية:
يقول الشاهد – المبعوث الثاني:
“(…) فما هي إلا ساعة، ولا شيء قبلها، حتى اختلط النور بالظلام، هبت ريح صرصر، تبعها رعد. ثم إن الدوي اشتد، ولم يكن فصل شتاء، ولكن أوائل صيف في العصر الشمسي الثالث أو الرابع، واشتبه علينا أننا نسمع من ينادي أن يا أهل المغرب أزفت شمسكم على الغروب، ومغربكم على الشروق، وأنت يا ابن آدم أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك. أجمعتك الدنيا أم الدنيا جمعتك. أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك. التفتتم حولكم أم التفوا عليكم. هذا أوان الصعق. هذه نفخة الصعق ثم تليها نفخة الفزع، فتسير الجبال سيرا، وتمور الأرض مورا وترجف الأرض رجفا مثل السفينة في الماء، وتضع الحوامل حملها وتذهل المراضع عن رضائعها وتصير الشياطين حائرة وقد تناثرت عليهم النجوم وكسفت الشمس وكشطت السماء من فوقهم، والناس من ذلك في غفلة وأي غفلة، ثم إنا ما زلنا في أمرنا هذا حتى مال كل ما تحتنا وحولنا، وتسارعت الطلقات من كل صوب، وشجت الرؤوس، ودهست الأجساد، أشباح كالأشباح وأجساد كالأجساد. وإن لمتعجب أن يتعجب كيف جنت مدينة الدار البيضاء وهي الرزينة، الثابتة، فإن أحياء كاملة تزحزحت عن مواقعها متجاوزة الأرصفة وعلامات المرور بين صارخة ومقهقهة ومعولة وهو صراخ لا كالصراخ، وعويل لا كالعويل، فما هو إذن؟ لكننا ما لبثنا أن بدأنا نفعل فعلها، فاشتبه علينا الأمر إن كانت أرواح خفية قد سكنتنا. ولكن الرصاص كان يلعلع، ينفذ إلى الصدور فتصدح الحناجر بالتهليل والغناء (…)”(47).
(7-1) إن هذا الردم للفجوات الزمنية، والتذويب “التناصي” للمسافات النصية بين مرجعيات (الدنيوي) و(الأخروي)، هذا التداخل الإيحائي بين التراثي الموروث والمعيش المشهود، هو ما يؤهل سيرورة الاقتصاد السردي إلى امتلاك (بنية أسطورية) يدعمها الاقتراض المرجعي (التناص) وضروب المحاكاة الساخرة.
ففي هذا السياق تتخلل تكوينات النسيج السردي “قصاصات” و”شذرات” و”نصوص” مستجلبة من مصادر وأطر مرجعية متنوعة. وهو تحيين يتخذ له أكثر من مظهر: فحيث نجد “تضمينات” تحافظ على “نصية” الوحدة الشذرية المقترضة – كما هو الشأن بالنسبة لبعض الأحاديث النبوية (القدسية) أو كلام إخوان الصفا (أو الابشيهي لاحقا)- فإننا نقف على مناورات لعبوية موازية تراهن على ضرب من المحاكاة الساخرة للنصوص المقدسة (أو الأصلية عامة) ممتصة أسولبيتها ومحورة صوغها بأشكال هزلية لا تخلو من تندر وسخرية. فبالنسبة للمستوى الأول، نقرأ:
-“أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد” أنني حين غادرت لم يكن بنيتي أن انفصل، أو أخون عهدا قطعته على الجبل وسرا ائتمنتني عليه “ورغة”(48).
وبشكل أكثر انخراطا في سيرورة اللعب الذي يتحول معه النسيج الأسلوبي إلى فسيفساء زخرفية تتخلل ثنايا تكوينه شذرات مموهة، نقرأ:
“قال النبي (ص) أن الله تعالى خلق على النار جسرا وهو الصراط على متن جهنم مدحضة مزدلفة عليه سبع قناطر. كل قنطرة منها مسيرة ثلاث ألف سنة “فالتبس على المتسللين، الهاجمين، أمرهم. ورغم أن الطريق إليه واضحة والسبل مسيرة، إلا أن هذا النور الخفيف الصادر من القبة يذعر نفوسهم، وتجمد أصابعهم على الزناد “ألف منها صعود وألف منها استواء وألف منها هبوط” فهل هذا النور أجمة، أم وجه شمس، وهم يربطون الحبال، وقد أخرجوا الأطفال، وسدوا المداخل، ولكن عينيه ما زالتا تتفرسان في هذا المسار: “أدق من الشعرة وأحد من السيف وأظلم من الليل، كل قنطرة عليها سبع كل شعبة كالرمح الطويل محدد “الأسنان”. نحن عسكر المدينة، صرخوا، ولن يفلت منا هذا الآبق، المارق، المفارق، الملاحق، الناعق، لنمر إليه، وبهلاكه تهلك العامة جمعاء “وروي أن من يمرون على الصراط تحت اقدامهم وفوق رؤوسهم وعند إيمانهم ومن خلفهم وأمامهم”(49).
أما المستوى الثاني، حيث المحاكاة والاستنساخ التمويهي، فنقرأ:
-“فتسير الجبال سيرا، وتمور الأرض مورا وترجف الأرض رجفا مثل السفينة في الماء، وتضع الحوامل حملها وتذهل المراضع عن رضائعها وتصير الشياطين حائرة وقد تناثرت عليهم النجوم وكسفت الشمس وكشطت السماء من فوقهم، والناس من ذلك في غفلة(…)”(50).
إن محاكاة النص المقدس (القرآن)، هنا، تجنح صوب التماهي مع أسلوبيته والإيهام بالتطابق مع نسغه القدسي. لكن، وبشكل مساوق – تماما – تخرج هذه المحاكاة في أطوار متواترة عن “جدية” التماهي الأسلوبي لتنخرط في ضروب من التمويه السخري، المحين لموروث المتخيل، إنما في تندر وهزل مقصودين:
يقول مولاي علي: “ولكن لماذا أفترض أن هؤلاء جميعا، ممن هم حولي، وخلفي، وقدامي، والذين راحوا، والذين سيجيئون، والذين ماتوا، والذين سيموتون “والكاظمين الغيظ” “والمؤلفة قلوبهم” “وأبناء السبيل” “والنطيحة والمتردية وما عاف السبع”(51).
تلك كانت بعض تجليات التناص وضروب المحاكاة الساخرة، التي تعمل على بنية عمق أسطوري لسيرورة السرد. ويبقى أن نشير إلى زخم المعجم الصوفي الذي يرشح به النسيج اللفظي في غير موضع. وهو العنصر الذي يرقى إلى مراتب (الجذب) أو (الشطح) الصوفي في أكثر من سياق:
-“أنا الحق، أنتم العكس. أنت العكس، نحن الحق، يختلف الشبه، يتشابه الاختلاف. أنا لست أنتم، أنت نحن، أنت جننت، أنا جننت فيكم”(52).
(8-1) إن هذه الوحدة الأسلوبية تشكل نموذجا حيا للكتابة المركبة والمنفتحة على آفاق التنويع والتعدد. فهي فسيفساء من القوالب والنصوص والزخارف الفنية المتداخلة والمتحاورة، بل إنها – بتعبير ريكاردو – مسرح لحرب ومعارك البلاغات والأساليب والأجناس المتخللة. فمن الصراع الجوهري بين النثر الفني وجماليات الفن الشعري، إلى التداخل والحوار الفني بين بنيات وقوالب أجناس تعبيرية وفنية مستحدثة وتراثية:
(الرحلة – السيرة – الخرافية – الحديث – الحلقة – المسرحية – الأسطورة). من (بينة الإيقاع) التي تضع الكتابة على تخوم (المحكي الشعري)، إلى (بنية الأسطورة) التي تردم الهوة بين (الدنيوي) و (الأخروي). إنه جدل المدنس والمقدس. حوار النصوص والفنيات القديمة والحديثة. فمحاكاة الواقع لا تنفصل عن محاكاة الموروث التخييلي. والتندر والسخرية من المعيش لا تبتعد عن التندر والسخرية من القدسي والمسترجع. فهي فسيفساء نصية، تراهن على (التمويه) و (الإبهار). على (الغموض) في لعبة (مرايا متقابلة) بين عنصر الحكي ومقومات الأنواع المجاورة. وبهذا المعنى، يتسع أفق السرد، فتمتلك الكتابة مرونة مورفولوجية تؤهلها لتشييد صوغ حواري داخلي متمرد ومناهض لكل معيارية جاهزة.
إن سيرورة “التجنيس”، هي نفسها سيرورة الانقلاب المتواصل على الضوابط. وأسلوبية المحكي هي نفسها هاجس البحث عن آفاق جديدة ولا نهائية للكتابة. ترى، كيف سيتواصل مد التدمير والتمويه واللاتمركز في الفصول الموالية؟
III – التشخيص الأدبي للغة:
(9-1) مع الفصول الموالية (الجنازة 2، 3، 4، 5، 6) تخرج الكتابة من طور “اللاتجنيس” إلى أفق امتلاك وضع روائي محدد. فهناك (قصة-إطار) تنتظم خطوط-مصائر وتوجه مسار السرد: شخصية راوٍ متعدد الأقنعة (أنا الكاتب؟ أنا السارد؟ أنا الراوي؟ هو؟) تضطلع بتحديد فضاءات المحكي وفق صوغ أسلوبي متنوع تنشطر فيه (المحكيات-الصغرى) وتتحرك صيغ الضمائر في كل اتجاه: (المتكلم-المخاطب-الغائب).
يقوم هذا الراوي بما يشبه (الرحلة الرمزية) في طرق وأجواء مدينة الدار البيضاء. يذهب إلى مكان معلوم لحضور اجتماع حزبي مرتقب. ويرجع ليذهب مرة أخرى بحثا عن (هو) بقصد أن يتسلم منه (وصية؟ سرا؟) لكن هذا الأخير (ضمير الغائب هو!) يتعرض للاغتيال قبل الاتصال المقرر).
وبين الذهاب والإياب فالذهاب (…) الخ. ينهض التلفظ المونولوجي لشخصية الراوي، وهو تلفظ ينمو ويتطور مع ازدياد حركة الراوي وفعل اختراقه للزحام البيضاوي:
-“(…) وفي الوقت الذي أنت فيه ليس ثمة سوى حركة واحدة تقطعها إلى القدام، إذ لا بد أن تعبر آيت يفلمان، وتعبر نفسك، عليك أن تنتسب بهذا الفعل، إن هذا الشيء يمسك عليك هذا النفس، وهذا العبور اليوم يكاد يكون استثنائيا بالنسبة للمرات السابقة(…)(53).
-“(…) تصر أنت على مواصلة العبور تقول إنني لا بد أن أصل، من التواء هذه الأزقة وعمق عتمتها أصل، وسأفتح لي في الزحام، وداخل الحشد، وفي كثافة الغابة، وعند الانسداد، والأسوار، وفي وجه المتاريس(…)(54).
-“(…) وسيكون عليك أن تستعد للعبور كما لو كنت ستخترق دغلا كثيفا. هنا يبدأ الزحام، والصخب، البشر المتراكم. ولكأنما تكون مرفوعا فوق الأصوات أو مندفعا فيها. إن لهذه الروائح الحادة، والعطنة، وللعرق الذي يبلل الملابس، قذرة كانت أو مرتقة، ما يجعل الحشد جسدا والجسد مدينة أخرى داخل مدينتها(…)”(55). بهذا التلفظ المونولوجي المقترن لدى الشخصية المحورية باختراق الزحام البيضاوي في اتجاهات طرق ملتوية وفضاءات متداخلة، ينشطر المحكي إلى عالمين: عالم خارجي (المرئيات والمسموعات والأصوات والعرق وضجيج الشوارع وكل ما تراه أو تسمعه أو تشمه حواس الراوي) وعالم داخلي قوامه (الاستبطان والاستذكار والهذيان). ف(أنا الكاتب؟ أنا الراوي؟ أنا السارد؟ هو؟) تتحول إلى (شاشة كبرى) تنعكس عليها الوقائع والعلائق والأزمنة والأمكنة والوجوه والذكريات والحالات والمواقف. إنها مرآة لسرد يعكس عنف الباطن وشراسة الدواخل وتصدعات اللاشعور. أما (المحكيات الصغرى) التي تتخلل مسارات تدفق الوعي، والاستيهام والحوار الداخلي، والتأمل والتداعي، فتخضع في تشظيها السردي لمبدأ التقعير La mise en abyme الذي تتوزع بموجبه سير ومصائر الشخوص الروائية المستذكرة.
من الغياب إلى الغياب تبدأ الرواية وتنتهي. وفي إطار الصوغ المونولوجي يتأسس الحكي ويتصدع، ينبني ويتفكك. وضمن مجرى قالب (الرحلة الرمزية) تنطلق وتلتوي تكوينات الأساليب ومسارات اللغات. ورغم المنحى المونولوجي لاقتصاد السرد، فإن الأفق الحواري يتخلل نسيج الكتابة. وهو أفق يجنح إلى معاكسة مركزة حياة اللغة مشيدا حياة الخطاب وسلوكه داخل عالم مصنوع من المونولوج الداخلي. إنه المدخل الحواري الحاضن لتعددية اللغات والأصوات والرؤى. وهو اشتغال أسلوبي ينوع على تيمات وحكايا وسير تمتح من الواقع شراسته وقرفه وعنفه.
(الموت – الجنون – العاهة والهذيان)، تلك هي التيمات المحورية التي تنتظم (محكيات صغرى) لشخوص روائية محطمة ومهمشة ومنهكة وشائهة. إن الخلفية الرؤيوية لهذا التكون الأسلوبي تنشد إلى ضرب من الوعي الممزق بالعالم. وعي مأسوي يلتقط من الواقع علاماته الدالة، منمذجا إياها أسلوبيا، ومحينا جوهرها الاجتماعي، بحيث تتحول اللغة الروائية إلى ملفوظ روائي ينفتح على اليومي والشعبي، الشفوي والاجتماعي، الإيديولوجي والتاريخي، وهو عمق “حواري” يجسر العلاقة بين النصي والخارج-نصي، بين التخييلي والواقعي، فتغدو الكتابة المونولوجية قابلة لامتصاص “الحواري” في شتى أبعاده وبمختلف تنويعاته.
(9-2) أما الأبعاد الزمنية والمكانية لهذه الرؤيا، فتتخذ لها من التحولات الاجتماعية والتاريخية التي عرفها المغرب بين عهدين (الاستعمار والمقاومة/فالاستقلال) خلفيتها المرجعية: فحرية الانتقال الزمني بين المرحلتين تجعل الوحدات الأسلوبية المندمجة لأزمنة وأمكنة التحول “تسجل لحركة الانتقال من زمن لآخر، بينهما ارتباط جدلي بحكم أن الثاني يشكل امتدادا تاريخيا واجتماعيا للأول، وهي في ذات الوقت تسجل حركة لاستبدال الرموز وتناسخها، هذا الاستبدال الرمزي يظل مستمرا، ومنبرا من خلال صوت (الإبن/الانتقال على مستوى الزمن يصاحبه انتقال فضائي من البادية إلى المدينة، في إطار حركة متوازية”.(56) وبعيدا عن سيرورات الاستبطان وتهويمات اللاشعور المطوحة بدلالات كلام المونولوج في مدارات المجهول والعدمي و اللامحدد والخواء، نستخلص – ضمن الوحدات الأسلوبية الفرعية التالية- عينات نموذجية لانعكاس القوى المؤثرة في الحياة الاجتماعية داخل الملفوظ الروائي. وهو انعكاس تحويلي يراهن على عناصر تشكيلية تتراوح بين (الحوار الخالص، الصريح، والتهجين، والأسلبة، والتنويع، والباروديا).
******
أ – لغات الأحقاب والأجيال:
1 – جيل الاستعمار (الزمن المخزني)
(10-1) تمثل هذا الجيل عدة شخوص روائية مستذكرة (مولاي علي – المنصوري – عباس…)، وحيث أن صوت (مولاي علي) يخترق طولية الخطاب بشكل متقطع يراوح بين الظهور والخفاء، فإننا نقف على سيرورة (تهجينية) يخضع لها تلفظ هذه الشخصية وهي تستذكر أيام زمان. يقول:
“فسيدي لكبير ما أن يملأ ما شاء له أن يملأ من المطامير ويقبض ثمن ما باع، ويدفع للمخزن الضريبة الفلاحية حتى يجمع الدراري من كل الخيام، ويحضر الحجامين للختان، فيختن الجميع، ويقيم لكل الخماسين وليمة كبرى يذبح فيها لكل عشرة خروفا، وتعد أطباق الكسكس الفوار، وتتبارى زوجات الخماسين في إظهار حنكتهن وإرضاء جوع الرجال. وحين تشبع الكرش تقول للرأس غني، وفي هذه الساعة هات ما عندك من طعاريج وبنادر وكنبري، فتتجاوب أصوات الغناء مع الشطيح والرديح، وينشط الناس، يقصرونويفرحون، ويظلون على هذه الحال إلى أن يأمر الله بالصباح، فينصرفون إلى مراقدهم كل واحد على خاطرو، وناشط مع رأسه بعد أن عب مقادير لا يعرفها من خمر “النصراني” فتطلع السكرة والتعربيطة بالقاعدة وعلى كل حال هذه هي حال أولاد حريز، الطاسة والقرطاسة حتى يبان الحق! والله يكثر خير سيدي لكبير، وحق الله العظيم وما تسالوني حلوف، أنه كان يترك سرادقه، وأي سرادق، فيكرمنا بعض الوقت (…) وفي الجهة التي تكون مواجهة مباشرة للأرائك الوثيرة التي يجلس عليها أهم الضيوف تجلس فرقة الشيخات التي تكون قد جيء بها خصيصا لهذه المناسبة، ولكنها، في الحقيقة، أكثر من فرقة، هذي الحاجة فلانة، وهذاك الشيخ الرايس فلان، وهذيك القايدة فلتانة، كل الفرق التي يسمع عنها الجميع من وادزم وسطات وخنيفرة وحتى المغنيات الجديدات في الراديو كاينات، وهاك على رشوق ونشاط، وكل فرقة تنسيك في الأخرى، وما تشوف غير أوراق المائة درهم تتعلق، وكاس من عندي وكاس من عندك، وسيدي لكبير في نهاره، غادي، جاي، جيبوا، خذوا، كلوا، اشربوا، غنوا، الدار داركم، هذا نهار كبير، والله يكبرنا في طاعة المخزن، حتى يقرب الفجر، شي فايق وشي ناعس، وكل واحد على من وقعت عينه، ومن عندي لعندك الخير موجود وضيافة النبي ثلاثة أيام. هادوا هم أولاد حريز وإلا فلا! النشاط والزهو والدنيا غادية بما فيها، واللي بغا يربح العام طويل(…)(57). إن التهجين قصدي في هذا الملفوظ الذي تتحول ساحته إلى ملتقى وعيين لغويين مفصولين. فالحواجز بين (الفصحى) و(العامية) تنهار، وإعادة تنبير الصوغ الأسلوبي تكسب الصوت المتلفظ عمقه الاجتماعي ونكهته الإقليمية”، بحيث تغدو “صورة اللغة” حلبة لتشخيص اللغة الروائية وفق سيرورة تركيبية كرنفالية. هكذا تنفتح طقوس الأسلبة على مأثور الأقوال والحكم التي تحبل بها الذاكرة الشعبية، والتي تشكل رصيدا ثقافيا تراثيا أصيلا لأمكنة العتاقة، فنقرأ:
“-الله يكبرنا في طاعة المخزن
-ضيافة النبي ثلاثة أيام
-اللي بغا يربح العام طويل”
إنها زخارف شعبية وإيديولوجية تغني الملفوظ الروائي وتتخم صوغه الحواري تهجينا وتنبيريا. وما يأخذ صوت جيل المقاومة حيزه ضمن النسيج الأسلوبي للسرد، كذلك نقف على أصوات أخرى موازية، تعكس لغات وأساليب حقبة ما بعد الاستقلال.
2 – أصوات جيل أيام الاستقلال:
– (ساعات المسامرة)
(11-1) يتشكل هذا الجانب عينة الشخوص المستذكرة من لدن (الراوي) وهي: (سعيد-بشير-عبد الله-الهواري- الحيمر…). وهذه النماذج الروائية تمثل جيلا طوحت به الخيبة والفشل والإحباط في أوضاع ومواقف تبدو “عبثية”. إنه جيل يعترف بخرابه ويتخذ من “العدمية” أسلوبا للتمرد على الواقع العنيد. وبذلك فهو يستبدل جحيم العالم الخارجي بنعيم العوالم الكرنفالية لأجواء (الحانات) الحمراء. ومن خلال (صورة اللغة) التي تشخص أصوات ولغات هذا الجيل، يمكن الوقوف على ضروب “التنويع” التي تخضع لها اللغة الروائية مشيدة بذلك أفقا للأسلبة وتعالق اللغات الحية:
-“نحن سادة الدار البيضاء. اخرجوا إلينا. لنا البحر، سيدي عبد الرحمن، ومال الغابة مقلقة، وكل أمجاد علال بن عبد الله هي هذا الشارع من الحانات القذرة والمطاعم الرخيصة، وليكن لنا حظ فيها مع بقية المرفوعين، وخاصة في هذا الحان، الذي يحمل اسم جلد البقر”(…)
قالت فاطنة بنت الحسين:
-ارجانا فالعالي
قال الهواري:
-ألم أقل لكم إنها “تحيي العظام وهي رميم”.
قالت نعيمة سميح بصوتها المجروح الذي يسبح به البشير:
-“ياك أجرحي جريت وجاريت
حتى شي ما عزيتو فيك”
وعبد الله، هو، هو، بالمرصاد:
-حياة العرب كلها بؤس وجراح، أوف، يالطيف منو جنس..
قال جيلالة قبل أن يتحولوا إلى مهرجين:
-“وأنا يا مال حالي أنايا
مال حالي أنايا
مال حالي في عيشتوا ما يشبه لحوال”
قال البشير، وكأنه ينطق بالحكمة، مسيكين البشير:
-ومن بعد الكاس، اضرب الحايط أو اشرب لبحر
وقال الهواري، وهو خير القائلين:
-اليوم خمر وغدا بعر…
كا كا كا كا، هق، هق، هق، واشري تربح …ثم طارت ثم جاءت هفهافة، مختالة ونحن نواصل مباركتها بمزيد من الأدعية(…) وهاك، ثم هاك، خذ الدقة والله يحضر السلامة
“دقة تابعة دقة وشكون يحد الباس
لا تلومونا في الغربة يا هاد الناس”(58)
إنه حوار خالص وصريح ينهض كمشهد تنسج عبره فسيفساء الكتابة. فالصوغ الأسلوبي لأغنيات الشوارع، والمرددات الشعبية والتحيين البارودي لموروث المتخيل المقدس (تحيي العظام وهي رميم) بما ينطوي عليه من سخرية سوداء، كل هذه التنويعات الحوارية، وما تنجزه من تحطيم بارودي لمأثورات وأقوال ولغات الآخرين، تكشف طبيعة الوعي المنزعج بالوجود لفئة اجتماعية تبحث عن خلاصها في طقوس ليس لها من “الكرنفالية” سوى الأصداء والأضواء والنبرات.
ب – لغات الأيام الجارية:
لغة يوم خاص:
(12-1) يقول الراوي: “وتجد الواحد إذا احتككت به في الطريق خطأ هو الذي يبادر إلى الاعتذار إليك ويلهج باللطف:
-” واسمح لي أسيدي وسيد أسيادي، ياك ماكاين باس، والله ماشفتك أسيدي!!” حتى تمرض أنت من سماع أسيدي وسيدي التي تظل تطن في سمعك طنينا لا يتراجع بسهولة. وما ألذها من سعادة أن يطلب هذا الواحد برادا من الشاي بالمقهى، ويجلس مع رأسه ساعة وساعتين وهو يحدث نفسه.
“الله على راحة، هذي هي الدنيا وما فيها، واللي بغا يربح العام طويل”(59).
لغة التجمعات الاجتماعية: (أحياء القصدير):
وهي (صور لغوية) تعيد صوغ نبرات اليومي وحياة اللغة الاجتماعية في طبقاتها الدنيا التي يتداخل فيها السياسي بالخرافي، المخزني بالأخلاقي، الشعبي بالديني. وإذا كان مجرى هذا التنوع اللغوي يرد في سياق أسلوب السرد غير المباشر، فإنه مع ذلك يعكس الخلفية الحوارية لملفوظ تتبادل فيه نبرات الأصوات الإضافة والتلوين، والتهجين والأسلبة:
-“بدأ الجيران يتهامسون: إن المنصوري يقرأ الكازيطة، وكازيطة محددة بالذات، يقولون ضد البلاد وضد الناس الكبار، ردوا بالكم، المنصوري يعمل السياسة والسياسة أعباد الله دايما تخرج على صاحبها، ولعن الله السياسة والسياسيين والشياطين أجميعن! يقول المنصوري إنه لا يفهم ما يعنون، وإنه دائما رجل داخل سوق راسه، وكل ما في الأمر أن الجريدة تقول الحق. وبالذات الحق عن من هم في مثل وضعه ووضعنا جميعا نحن سكان البراريك: “يا المنصوري يالمنحوس واش ضربك الله، كل الخبز واسكت، ما تنساش أنك بو وليدات”(60).
-“حين انسحب المهندسون والدرك ارتفع اللغط بين السكان، وبدأوا يحلفون ويتراهنون في التقدير، والتخمين. في البداية تصدر الكلام حماد العيساوي، وهو من أقدم السكان، ويدعي فيهم الفهم دائما، وأعلن أن المخزن جاء لينظر في كيفية تحويل الحي من القصدير إلى البناء العتيد، وذلك لما فيه الصالح العام. وبما يجلب الخير العميم لجميع المواطنات والمواطنين، وأن المخزن سيحول حياتهم من بؤس إلى نعيم. ردد الجميع وبصوت مسموع: آمين يارب العالمين، من فمك للسماء!
ورغم أن الهلالي أصغر سنا من حماد العيساوي، ومعروف ببعض نزواته من خمر ونساء إلا أن كلمته، هو الآخر، مسموعة، وإدراكه للأمور يجد طريقه سريعا إلى الناس وهو لذلك لم يتردد في تسخيف قول حماد، وإن بلهجة متحايلة حتى لا يساء فهمه ويحسب السامعون، وهم خليط وفيهم عيون، وآذان طويلة، أنه يسيء الظن بالمخزن. حاشا معاذ الله، المخزن هو المخزن، وكلمته هي الكبيرة، ولكن من رأيي أن الطريق هي القضية الأولى في هذا الوقت، والأطوروت، كما قالوا أسيادنا فيها الخير والتيسير، وهي أحسن من مليون براكة على كل حال، والفاهم يفهم!”(61).
ج – لغات المهم وساعات العمل:
1-فضاء الجريدة:
(13-1) لعل ذروة التدمير البارودي لملفوظ الرواية-حيث التقطع والتندر والسخرية- ترتبط بـ”صور اللغة” المشخصة لدقائق ومجاري الحياة اليومية في المجتمع المغربي. من هنا فإن سيرورة هذا التلفظ المونولوجي تنفتح على هوامش مرافق الحياة الاجتماعية مؤسلبة ومعيدة تنبير الخطاب الروائي في ضوء عناصر وخصائص المعيش. هذا ما يمكن رصده بدءا بهذه الوحدة الأسلوبية الصغرى، حيث شخصية (ابّا جلول) تنجز هذا التلفظ:
“أي حياة هذه… من الصبح إلى المساء… كله في الجريدة..المكالمات الهاتفية لا تتوقف..آجي.. سير..اشكون، اطلع، اهبط.. الأقاليم، فاس، بني ملال، أكادير، تطوان، يخ..يخ..يخ.. ثم الرباط دائما واقفة على الراس… السي محمد…السي فلان.. السي علاّن.. والسي محمد دائما… انتبه، الخطبة غدا.. رد بالك، الصورة والعنوان البارز.. والقايد سوط المناضلين ورجال الدرك هجموا على مقر الحزب، ثم الكتابة الإقليمية، والمركزية والجنية.. وابراهيم بوكايو لم يحضر المراسلات، وصاحب الصفحة ضربها بسكرة البارحة وبقيت مواده معلقة، كلهم يهجمون عليك بأصواتهم. هذي هي الدنيا والإخوان هنا هدوا.. ما عندك ما تعمل، والنضال هو هذا..النضال..!آش اقضينا..”(62)
2-فضاء المحاماة والقضاء:
(13-2) يقول الراوي مستذكرا مأساة المحامي (سعيد) الذي أودى به المبدأ وشرف المهنة إلى السجن:
“(…) ولم تكن صورة الطلبة المقيدين لتبارح مخيلته، ولا أصواتهم لتنقطع عن مسمعه:
-لماذا تظاهرتم؟
-لنعبر عن أنفسها
-وهل التعبير عن النفس هو الشغب والفتنة؟
-إننا تظاهرنا باسم القانون، ومن أجل حقوقنا
-وحقوق الأمن، حقوق البلاد، هل يتلاعب بها صبية مثلكم؟
لم يتذكر أنه رافع في حياته بحرارة، وإيمان، واقتدار، مثلما فعل يومه ذاك، ورغم صرخات النائب العام لم يتراجع (…) يعيش الطلبة، تعيش النار، كان مرفوعا وقال إنهم ضربوهم، حرقوهم بأعقاب السجائر والكهرباء، رفسوهم كالثيران/ و…كل هذا باسم القانون. حين أنهى مرافعته كان مبتلا تماما، والقضاة والمتهمون، والكراسي، والملفات، والحراس، كل تأثيث المكان كان يدور في مخه(…)”(63).
د-لغات السلطات والدوائر:
1-دائرة الرقابة:
(14-1) ومع هذا الملمح الأسلوبي، تمتزج اللغات وأنماط الوعي الإيديولوجي داخل ساحة الملفوظ، فيبدو تحطيم تمركز اللغة وتنسيب مطلقيتها ضربا من الأسلبة المضيئة لنبرات لغة الآخرين (السلطة ورموزها)، وهي أسلبة تستثمر الطبقات الدنيا لرطانة السوقي والمبتذلفي ارتباطهما بالمنطق الداخلي لدوائر القمع والتسلط. يقول الهواري، أحد أصدقاء الراوي مسترجعا وضعية علاقته بالمهنة (صحفي مناضل) والحزب والمال:
-“صحيح تماما أن الخمر طيب، ولكن من أين لنا بالمال، والعمل أين؟ الجريدة تظهر يوما وتغيب يوما، وأين أكتب؟ حين ذهبت عندهم لتجديد بطاقة التعريف قلت إنها مهنتي تلك، واليوم لا أستطيع أن أكتب لأن الجريدة غائبة، قالوا: أكتب في طيز أمك يا ابن القحبة! والدفع قليل على كل حال، المحاسب المالكي، حتى في أحسن الأحوال، يعدّ السطور بالمقالة، والصحف الأخرى أصبح الأقزام والمخبرون مسؤولين عنها، والزعماء في أبراجهم، أوف.. إنني أعرفهم واحدا واحدا. يأتون مزهوين إلى المهرجانات ليخطبوا وهم منفوخين كالتيوس، منمقين كالطواويس، وأنا علي أن أزدرد المبادئ وأن أشرب القيم، وأن آكل الخرا، نعم الخرا، إنني أعرفهم واحدا واحدا، وإذا كنت قد خسرت فمعهم أمّا هم فقد ربحوا وحدهم. هاهو ذا جيل كامل اسمه عمر الاستقلال لم أربح منه سوى ضياعي الخاص في نهاية كل مساء، والمهم تدبير ثمن المشروب خير من قعدة المتقاعسين هذه!”(64).
2-دائرة السجن:
(14-2) “كنا نسأل الزوار حين يطلون علينا تلك الهنيهات في كل أسبوع:
-كيف الحال برّة؟
-لاباس، لاباس
-يعني الدنيا هانية؟
-هانية والحمد لله. الناس كلهم بخير وعلى خير
-والوضع؟
-أف، الوضع دائما هو الوضع..
-والعمل؟ ونحن؟
-الصبر، ماينفعكم غير الصبر، هذا ما كان…”(65)
3- دائرة الحزب:
(14-3) وتشخص هذا المستوى خطبة الزعيم مولاي اسماعيل أثناء الالتقاء المشهود لمناضلي (الحركة) قبل شن (التوقف) -أي الإضراب- حيث يقول:
-“أنتم تعلمون جميعا سبب لقائنا، اليوم، هنا، وسنلتقي غدا وفي الأيام المقبلة أيضا. لا أستطيع أن أحدد لكم الوقت بالتدقيق، عليكم أن تتأملوا الأجواء حولكم لتعرفوا الميقات، وبقينا، دائما، مخلصين لزمن واحد رغم تبدل الوجوه والأيام. ونحن اليوم نلتقي بامتحان جديد، وعلينا أن نواجه الأمر، ونوجه الأحداث. لسنا وحدنا، ونحن لن ننطوي في الصمت، وسوف (…) وقد نلتقي غدا أو بعد وقت طويل، فلا أحد يقدر ماذا يمكن أن يحدث، وهم لن يتركوا المدينة تفلت منهم، ولكن علينا أن نتسلح بهدوئنا، ثم ماذا بعد؟ فلم يعد لدينا، ومن العشر سنوات الأولى، ما نخسره!”(66).
******
هـ- تنويعات:
(15-1) تلك كانت عينات من (صور اللغة) التي حفلت بها سيرورة التشخيص الأدبي في مجرى التلفظ المونولوجي لشخصية الراوي. فبين حدي الوقوع والتوقع، وبين ما حدث وما يحدث أو سيحدث، يتصدع السرد وينشطر إلى (محكيات صغرى) وتنويعات أسلوبية يؤسسها حوار داخلي محكوم بتعالق اللغات والملفوظات. وبموازاة التحطيم البارودي، وتنويعات الأساليب، وإعادة تنبير الملفوظات، يزخر النسيج اللفظي بزخارف فنية مساوقة من قبيل الانفتاح على رصيد “الثقافة الشعبية” ممثلة في الزجل والأناشيد والمرددات الشعبية وقصاصات موثقة ومضمنة من كتاب (المستطرف) للأبشيهي. وهي سجلات تراثية يراهن التشخيص الأدبي على تذويبها في بوتقة أسلوبية واحدة: فلا حدود بين اليومي والماضوي، بين الشعبي والرسمي، بين المقدس والمدنس، بين الدنيوي والأخروي، وبين المونولوجي والديالوجي عموما، فالرؤيا محك كل العناصر. وكمثال على استثمار سجل “الذاكرة الشعبية”، نقرأ للمجذوب:
-“تخلطت ولا بغات تصفى
ولعب خزها فوق ماها
ريَّاس على غير مرتبة
هما سباب خلاها
للبحر نشكي بهمي
ينشف يولّي تنيه
الريح والسحاب رشّات
والغيم ظلام عليه
الاحباب كاع كاع كفات
بقيت فريد العمد عليه”(67)
أما “المرددات الشعبية” فنقف على توظيف فني لها مع نمط (العيطة المرساوية):
-” يا أنا ارجانا فلعالي
ورجاي فلعالي
عار أنا أمّي بوجداني
يا اداويني داويني
يا كي ما داويتي يالعالي داوي محبوبي
يا رانا سطات يسطي
يا وبرشيد يداوي
على كازا جامعا لكواوي”(68).
بينما نقرأ على سبيل استثمار موروث المتخيل الشعبي نصوصا وقصاصات شذرية مبثوثة في ثنايا النسيج الأسلوبي وفق سيرورة (تناصية) متواترة:
-” وفي الحديث أن جرادة وقعت بين يدي رسول الله (ص) فإذا مكتوب على جناحها بالعبرانية: نحن جند الله الأكبر، ولنا تسع وتسعون بيضة ولو تمت لنا المائة لأكلنا الدنيا بما فيها… وفي الحديث أن رسول الله (ص) قال: إن الله تعالى خلق ألف أمة، ستمائة منها في البحر وأربعمائة في البر، وإن أول هلاك هذه الأمة الجراد، فإذا هلك الجراد تتابعت الأمم مثل الدر إذا قطع سلكه”.
(عجائب المخلوقات/الأبشيهي)(69).
إن هذه الفسيفساء النصية، وهذا التوليف الأسلوبي يمتد إلى أعماق الذاكرة الشعبية، وفلسفة الحياة اليومية مشخصا جدلية المنحط والسامي، المدنس والمقدس. وهذا ما يعكسه التنشيط المتواصل لفعاليات اللغات والأصوات ومخزونات التراث وإفرازات المتخيل الجمعي. فبقدر ما يتدرّج التلفظ المونولوجي هبوطا في اتجاه الواقع بتعددية مشاربه وتنوّع مساراته، بقدر ما يصعد التخييل ويسمو مع تحيين عينات حكائية تراثية، مما يضفي على سيرورة الكتابة عمقا إيحائيا له الأسطورة أفقا إنها رواية الصعود إلى الأصول باستمرار. تنسج بين العناصر علاقات صوفية. تذوب الحدود بين الدلالات المتعددة للسماوي والأرضي. تفكك الأزمنة. تستنسخ وتكرر وتتداعى. تتخذ من الاحتمال والحلولية والتصدع ذبذبات لصوغ نسيج أسلوبي منسجم في تنافره. موحد في تنوعه. متكامل في تعدده. مستحدث في تراثيته. منكتب في شفويته. مؤسطر في واقعيته، وبكلمة جامعة “متداخل في زمنيته الرؤيوية”.
(1-2) وإذا كان الغزو الشعري لا يتوقف عن اقتحام وتخلل طولية السرد، فإن للمونولوج سطوته الكبرى أيضا. وهو ما ينهض كمحور ناظم لكل دوائر وتداعيات النسيج الأسلوبي. فذات الراوي التي تتحول إلى شاشة كبرى، أو مسرح سردي لتبادل الحوار بين الأصوات واللغات والرؤى. هذه الذات تؤسس للكتابة عمقا لا شعوريا، يجعل من مكونات (اليومي) و(الذاكرة الشعبية) مجرد روافد تكميلية لرافد (اللاوعي): المكون الأساس لمجرى المونولوج، والمدخل السيكولوجي لتأسيس لغة شطح منعدمة التواصل. لغة سيكولوجية تطوح بالسرد في متاهات الهلوسة واللامعنى. وهو اشتغال “تجريدي” يتعارض مع منحى “التشخيص” الذي يعكسه أفق النص الحواري، لكنه يتكامل معه على صعيد الوحدة الأسلوبية العليا وما تؤسسه من رؤيا شمولية. يقول الراوي في استبطان سيكولوجية السجين:
-“في الطقس المفتوح على أرض تتخرب ولا تفنى ثقوب للكد تحفر لها وثقوب للشوق وغربة ممتدة اتصلت فيها الأيام غير مكترثة بالأيام إذ تراجعت هكذا يتهدل النجم ولا يهوي في كل الليالي المشتعلة بأصوات الاجتماع الحزبي إنني لا أتذكر ولكنني زمن أول منه الوقت المتمدد حتى لو جعلوني ذكرى أو قالوا مرة مرة في لقاءاتهم “ذكره الله بخير” فأذكر احتراقي لأكون في الظلمة لا أفجع اليوم من العتمة عمود الكهرباء ائتلف معي في وحدة الشارع حين يخلو ويقترب وجهي من وجهي نأخذ معا في قراءة بعضينا خارطة البلاد تنشأ موقعا موقعا أرسم مواقعي الفائتة والقادمة كل شبر له في صدري متسع أرضي وله أعلام غير ملونة بعد رغم أن التغير المصطنع فوق الكلام المدبج وطنين المناسبات الوطنية يحترف هذه الشوارع في طريق مديونة بقية من أقواس لا أعلم متى ابتدأ الفرح وقد كانوا يهللون يكبرون يرددون الحمد الشكر للعلي الذي وهبهم من كل النعم ما لم يوهبوا فتضامت الرؤوس فتشابكت الأعناق بأمر من الوالي بأن التعبير عن الفرح فرض عين من كل ذكر أو أنثى حتى ولو لم يبلغ سن الرشد القانوني التصويت على المجالس البلدية القروية أقل تعبير عن المواطنة من الفرح المطلوب الذي لم يكن قبله يوم ولا بعد له يوم يأتي بعده وبناء عليه تتضام الرؤوس تتشابك الأعناق الأرومة المغربية الصاعقة عقد عهود مواثيق لا تنفك لها عروة أشهد أني ما رأيت شيئا سابقا على هذا ما ينبغي لي أن أرى أدهس أشغف من هذا الذي أرى الأجساد منبطحة قد تسطحت بسطا من أعضائها التفت التعريشات فلكل بشرة لون لكل آدمي حين تطأ القدم البساط صوت مسبح مكبر أشهد أن لا كائن إلا كل الألوان الأرض السماء ما بينهما تترنح الأيدي الأرجل الرقصات السوسية الزايانية الجبلية الحوزية الصحراوية الأطلسية الريفية الحشود المحملة على الغيم وعلى الشاحنات المباركة البركة وحدها ترقص الشوق مداه بهاؤك الرؤوس مقطوعة مثل التين دانية الأرض الخدود لك نفرح نحزن نعود دائما إلى الفرح مؤيدين جميع القرارات المحلية الوطنية الدولية وتتسرب عنوة مع الضوء هنا، يلتفت الحارس الليلي فلا يراك من حيث تراه، نواصل تسمع الخطى، أواصل انبهاري وأشده في الكائنات”(70).
إنه حوار داخلي واستغوار لأعماق اللاشعور. فالتلفظ المونولوجي يضع اللغة الروائية في مجرى الهذيان والشطح والجذب. وهو تدمير شامل لكل دلالة ممكنة قابلة للتواصل الغيري. وهذا التدفق السردي المراهن على التداعي، إذ يلغي من سيرورته كل علامات الوقف، فهو يطوح بالتخييل في نرجسية مرآوية تنتفي معها كل إحالة خارج لواعج الذات وبواطن لا وعيها.
(16-1) لقد ألف هذا النص بين تيمات (الموت والجنون والعاهة والهذيان)، وراكم اللغات والأصوات الاجتماعية وأنماط الوعي الإيديولوجي في تبايناتها. كما شيد للذات (ذات الراوي) آفاقا للاستبطان والاستذكار فانشطرت (قصة الراوي) أو (رحلته الرمزية) إلى (محكيات صغرى)، تستحضر سير ومصائر شخوص روائية منهكة ومحطمة وهامشية. حكايات دشنت للتلفظ المونولوجي أفقا حواريا، فكانت الرحلة متعددة الأبعاد والوجوه: فهي رحلة الكتابة في البحث عن روائيتها، ورحلة الرواية في البحث عن تجنيسها المجهول، كما أنها رحلة “التجنيس” في البحث عن أساليبه ولغاته وأصواته ورؤاه. بهذا كان التمرد على قواعد القالب الروائي التقليدي صيغة مبتكرة للخروج عن الإطار الضيق والفهم الآلي لنظرية المحاكاة. فنهضت معمارية النص عبر جدلية الهدم والبناء لتمتد صوب أسئلة متشعبة منها ما يطال الذات في دواخلها اللاشعورية، ومنها ما يرتبط بالتراث الشعبي وموروث المتخيل الشرقي، كما منها ما يمتد صوب أسئلة الحياة اليومية وما يحبل به الواقع والخيال الجمعي من تنوع وثراء.
أما السمة البارزة لمجموع الوحدات الأسلوبية الفرعية التي أسست التراتب الداخلي للوحدة الأسلوبية العليا، فقد تثملت في الجنوح صوب تكسير أحادية الملفوظ الروائي بما هو وضع لماهية اللغة موضع تنسيب: لقد تحول نظام اللغة إلى مسرح للتشخيص الأدبي بعد أن خضع تمركزه الإيديولوجي واللفظي لتحطيم ممنهج فانتفت عن اللغة أوهام المطلقية، وآلت قوتها المؤسلبة إلى سلطة تجميع وتذويب ينصهر ضمنها الشفوي والمكتوب، الفصيح والعامي، الرسمي والشعبي، اللفظي وغير اللفظي، الفئوي والمهني والإقليمي.
إن هذا التكسير، والتنسيب، والتدمير الممنهج، وهذه (الصور اللغوية) وكل مناورات التهجين والأسلبة والتنويع والباروديا، كل هذه العناصر التشكيلية والزخارف الفنية ستمكن اللغة الروائية من امتلاك جوهر اجتماعي، فضلا عن الماهية الميتافيزيقية لأسولبية الشعري المخترق. فبقدر ما يسعى النثري إلى تكريس وظيفة مرجعية قوامها الاستدعاء والتشخيص، بقدر ما يسعى الشعري إلى الاحتفال بذاته والالتفات إلى جماليات جسده وفق رهان تخييلي نرجسي.
ترى، كيف يتأطر هذا الجدل بين مكونات لا نهائية في تنوعها؟ وهل يكفي الوقوف على تجليات الصوغ الحواري لأقنومي (الكتابة) و(الرواية) حتى يتسنى لنا ترسيم أهم مرتكزات هذه الاستراتيجية النصية؟
إن انتظام التكوين الحواري ضمن المجرى المونولوجي يدعو إلى التساؤل حول طبيعة (وجهة النظر) التي تؤطر الصوغ الأسلوبي العام للنص. فالطابع الوظيفي لمجموع الخصائص الأسلوبية الآنفة الذكر لا يمكن أن يتضح أكثر إلا بتحديد علاقتها بمكون (المنظور السردي)، وهو مرتكز لا يقل أهمية عن بقية المقومات الجمالية، خاصة إذا كان النص الروائي معتبرا في كليته. إنه سؤال (المحفل السردي)، وهو أفق الخطوات الموالية.
IV – نرجسية المتخيل:
(16-1) يبدأ هذا المستوى مع غزو الشعري للنثري وتمكينه من بنية إيقاعية، ويمتد مع طغيان المونولوج وتدفق اللاوعي، وينتهي إلى مستوى ثالث يتمحور حول مسألة المنظور السردي. فإذا كان المستوى الأول يعكس ضربا من الاحتفال بجسد المرسلة، تغدو معه الكتابة مرآة سمعية ترقص على إيقاعات اللعب (التكرار، التضاد، السجع، الرجع، القلب…) دون إعارة كبير أهمية لمسألة الدلالة والتواصل، فإن المستوى الثاني (المونولوج) هو الآخر ينسف كل قواعد الإحالة الممكنة، جاعلا من الهذيان اللغوي أفقا للانغلاق دون أي جوهر غيري للتواصل. فالمعنى أو الدلالة ينعدمان، وفي المقابل تحيل سيرورة التدمير اللغوي على ذاتها، خارج أي سنن تواصلي معهود.
أما المستوى الثالث، فيتعلق بما يصطلح على تسميته لدى نقاد الرواية الجديدة الفرنسية بـ(الشكلنة) Formalisation كمدخل لإنتاج خطاب الرواية النقدي المحايث(71). إنه تشخيص مضاد تنهض وظيفته بمهمة جعل الخيال الروائي الممارس في الكتابة موضوع تأمل وتفكير نقديين(72). وهو انخراط لسيرورة التكون النصي في إنتاج خطاب (ميتا-سردي) يكرس لعبا مرآويا مع الذات (الخطاب)، ويجعل من (النقد الذاتي) محورا مساوقا لتشكل المعمار النصي.
(16-2) لقد حظيت مسألة (المنظور السردي) باهتمام موسع من طرف عدة باحثين أمثال: بيرسي لوبوك Persy Lubbok، وواين بوث W.C. Booth، وبويون J. Pouillon، وستنزيل F.K. Stanzel وغيرهم(73). أما أهمية هذا الجانب في دراسة النص الروائي، فتكمن -بالأساس- في كون الكثير من المشاكل التي تتشعب عن علاقات القائم بالحكي بما يحكيه ولمن يحكي(…) ترتبط في تنوع درجاتها اللامتناهية، بحسب ما إذا كان السارد مشخصا أو غير مشخص في المحكي، متحكم في مجريات الأحداث والأوضاع بشكل مطلق أو نسبي..الخ. وكلها اعتبارات تجعل من اختيار هذا (المنظور السردي) أو ذاك، يلعب دورا في تحديد هوية ومسار الرواية(…)
وفي ما يخص رواية (الجنازة) التي ينتظم تكويناتها تلفظ مونولوجي قد يبدو السؤال ملحا حول: من يحكي في هذا النص؟ وما علاقته بالمؤلف الفعلي (أحمد المديني)؟
فالطابع المونولوجي رغم الفجوة الحوارية يعني -ضمن ما يعنيه- أن القائم بالحكي له (حضور غامر Omni presence)، وهذا ما يلقي بظلال من الريبة حول مدى انفصال هذا المحفل السردي عن شخص المؤلف الفعلي. من هذا المنطلق، فإن أحد النقاد(74) لم يتردد في القفز على ميثاق الرواية المعلن، والتأكيد على هوية المتلفظ المركزي السير-ذاتية. وإن كان قد برر حكمه ذاك بقوله: “من المؤكد أن الرواية تحاول إلغاء سلطة الصوت البيوغرافي عن طريق خلق فضاء سردي لتعددية الأصوات، ومن خلال إصباغ الطابع الشعري على هذا الصوت قصد تعريته من فرادته الضيقة، ومحاولة إعطائه، إمكانية للتحرك داخل فضاء دلالي أرحب… كل هذه طرائق لتشخيص حضور الذات في النص”(75). إن ما يضع حدا لمثل هذا التصور، هو التوظيف التشكيلي لعنصر (المؤلف) نفسه ضمن منظومة المحكي. فالنص يورد هذا الأخير كشخصية روائيية مشاركة في سيرورة الأحداث والوقائع المستذكرة. ويذهب أبعد من ذلك إلى التمييز-ليس بين الراوي والمؤلف فحسب، بل بين الراوي والسارد كذلك، منتجا خطابا (ميتا-روائيا) يضع مسألة المحفل السردي موضع مساءلة.
إن القائم بالسرد هو الراوي باعتباره شخصية روائية مشاركة. ولكنه لا يحتكر مهمة الحكي هذه لوحده. بل هنالك منظور سردي آخر متفوق عليه. ينتسب إلى سارد مجرد كل المعرفة، غير مشارك في القصة، ولكن معرفته الروائية والنقدية أشمل من معرفة الراوي النسبية. فهذا السارد يتدخل باستمرار ويريك سيرورة السرد بشكل متواتر منصبا من نفسه دور (المراقب) صاحب الامتيازات. أما هويته فهي نقدية بالأساس. إنه يتجاوز -في مسلسل اقتحاماته- التبئير السيكولوجي لشخصية الراوي، إلى جعل صوته يتخذ وضع المرآة التي تعكس وتسائل إجراءات الكتابة. فهو أداة الرواية الداخلية لممارسة (نقد ذاتي) تتأمل عبره متخيلها. يقول في تدخله المعنون:
(فاصلة)
“إلى هذا الحد تنقطع الرواية، ولا تنتهي الكتابة.
ما ذا حدث في ما بعد؟
لا يعرف المؤلف إن كانت روايته قد تمت أو أن أوراقا جديدة اختلطت عليه، وبين يديه، وعليه فإنه يقر بما يلي:
1-إن انقراضا واسعا ربما عم المنطقة الجغرافية التي تدور فيها روايته، وعم الدار البيضاء على الخصوص.
2-إن انقراضا أوسع عم البشرية التي تسكن هذه المدينة، وإن مشاهداته ومصادره انقطعت منذ إعلان التوقف الشهير.
3-إنه أراد اعتماد الخيال، واستخدام المخيلة والحدس والتوقع، فلم ينفعه ذلك في شيء، لأن الواقع، على ما يبدو، أوسع من الخيال اليوم وأغرب.
4-وعليه لا بد من التوثيق، وإلا فلن يكون هذا الكتاب عمدة، ولن يجدي صاحبه نفعا ولا عذرا أن يكتفي بالقول إنها مجرد رواية.
5-سيما وأن شخصياته تكتسب صفتي الحلول والتناسخ، فما عاد بمقدوره أن يضع يده عليها. فهي زئبقيبة، حاضرة، غائبة، ساكنة ومسكونة، وما حدث لها بمكابداتها لا ندري على وجه التحديد، متى تم. وكل ما في الأمر أن الكتابة تحاول أن تقترب من الزمن الذي يصر على أن يظل منفلتا.
6-ثم إن المؤلف ضيع الراوي في الزحام الذي يخوضه الشخص الآخر، وقد كانت في حوزته كل عدة الرواية، فأسقط، بالطبع، في يد المؤلف الذي لم يعرف ما يقدم أو ما يؤخر! ولهذه الأسباب جميعا، اضطر إلى أن ينقطع عن إتمام الكتاب. وكان بوسعه الاعتماد على أي حيلة فنية كما يفعل البعض، فيصنع النهاية بطريقة اتفاقية، خاصة وأن بطله واقع في أكثر من مأزق، فيستثمر واحدا من هذه المآزق. وهلم جرا.
فقد بلغ إلى علمه أن حول المدينة الكبيرة التي كانت تسمى قديما الدار البيضاء والتي توجد في أقاصيها مديونة جنوبا وسيدي البرنوصي شرقا وسيدي مسعود في الجنوب الغربي؛ توجد بقايا من ذاكرة بعض الأفراد الذين لم يشملهم الانقراض، لسبب مكتوم، أو لأنهم كانوا منقرضين قبل ذلك. فشددت إليهم الرحال، يقول المؤلف، ومن عجب فإني، وأنا في الطريق، التقيت بالراوي، وكان قد التقى بالرواة الآخرين، فلم أسأله عن سبب أو مكان اختفائه، وفرحت به. فقد كفاني مؤونة ما لا طاقة لي به”(76).
إن خطاب هذا السارد المجرد لا يكتفي بتكسير إيهامية (تبئير الراوي)، بل ينصب نفسه كناقد أدبي، تتجاوز وظيفته دور التشويش أو تنسيب وجهة نظر الراوي، إلى دور آخر جديد. يعيد تشخيص المشخص، ويصورنه ويستخرج ما يشبه المنطق الجديد الذي تضمره الرواية كمشروع لتجديد الخطاب الروائي. إنه (سارد-ناقد) يضاعف المحكي وينشر بذور وعي مفهومي للسرد المنجز داخل الكتاب. وبذلك، فهو يبشر بنوعية (القراءة) التي يفترض أن تنجز لهذا المحكي المتمرد. إنه نموذج القارئ (المفترض) الذي سيكون عليه أن يغادر موقعه التقليدي كمستهلك سلبي لكي يشغل موقعا جديدا يتولى فيه مهمة المساهمة في إنتاج دلالات النص. القارئ الذي لا يخلد إلى وهم (اليقين السردي) الذي يوهم به (الراوي المطلق المعرفة)، بل يتخذ من التأمل في إجراءات السرد الجديدة موضوعا لاهتمامه الجديد. فإذا كانت الرواية التقليدية تغلق الدائرة على متلقيها في حدود سؤال: – كيف نكتب؟ فإن هذا النص يتطلع إلى استبدال الأسئلة وجعل سؤال: ما هي الكتابة؟ في الصدارة، فضلا عن التحريض على ضرورة المشاركة في توليد الدلالات وتحمل المسؤولية في إنتاج المعنى، والكشف عن أدواته. يقول أحد الباحثين مبررا تعددية المنظور السردي في رواية الجنازة:
-” ويظهر أن الراوي يحاول التخفيف من غياب الأبطال التقليديين في رواية (الجنازة)، وذلك باصطناع بطولة سارد كامل المعرفة، بل والذهاب إلى ابعد من ذلك في إيهامنا بالاختلاف، بين هذا السارد وكاتب الرواية، وأحيانا بتفوق السارد على الكاتب، لأنه يحذره وينبهه إلى ضرورة معاملة الند للند (ولا تظنن أن لزومي لك خضوع). فجدلية اللعب الروائي في (الجنازة) تعتمد على التباعد المعرفي والزمني، وعلى ثنائية وشبه تناقض بين الراوي وسارده:
“ثم أردف حديثه قائلا: إنني قد أعود إليك دائما، وقد أغيب عنك دائما، وقد أكون غائبا وحاضرا، فأنا الحضور والشمول، فحذار أن تقولني ما لم يقله أحد، ولا تظنن أن لزومي لك خضوع: إنني صاحب نزوات ولي في السرد فنون وتقلبات، وقد سننت لنفسي خطة أولها الهذيان، وعليك أن تكتشف بقيتها، وبعضها قائم على المداورة، وهي إحدى سنن الله في خلقه. أنت حر في أن تتركني أو تلحق بي. لكن اعلم على كل حال، أن أطواري خطرة، وأنك قبلت أم أبيت مخاطر، فحاذر…”(77).
وأيا كانت درجة رجاحة هذا التأويل، فإن المؤكد هو أن هذا الاشتغال (الميتا-سردي) يشكل جانبا أساسيا من جوانب تصفية الحساب مع التقاليد الروائية الكلاسيكية في هذه الرواية. فبالإضافة إلى ما يعكسه من استكمال لسيرورة اللاتمركز – التي ابتدأت منذ الفصل الأول – فهو تأكيد على اعتناق هذا النص لمبدأ النسبية، ومنطق الاحتمال، ومناهضته التامة لكل أوهام المطلقية أو اليقين السردي.
إن تعددية المنظور، وشكلنة المسار الحكائي، وتكسير إيهامية السرد، وتنويع وجهات النظر، كلها وظائف تترتب عن هذا الاشتغال “التغريبي”. وهو اشتغال يتكامل مع كل المبادئ المنظمة السابقة لاقتصاد السرد (من تنوع وتداخل وتعدد وتفكك ولعب)، على أن العمق الاستراتيجي -الأساس- بالنسبة لهذا المستوى يكمن في دعم تراتبية المنحى النرجسي في المحكي الذي أشرنا إلى مستوياته سابقا. وبهذا تتسع قواعد النص الإحالية وتتنوع لتتراوح بين مرجعيات: (الواقع والذات والخيال) وهي أطر مرجعية تتفاعل أسلوبيا لتبلور رؤيا شمولية، يصطلح المديني على تسميتها بـ”الرؤيا المأساوية”.
مجلة الجابري – العدد السابع
الهوامش
من بين كتب وأبحاث أحمد المديني المعروفة في هذا المجال، هناك:
-في الأدب المغربي المعاصر. دار النشر المغربية. 1985
-أسئلة الإبداع في الأدب العربي المعاصر. دار الطليعة بيروت.1985
أحمد المديني: (أسئلة الإبداع…) المرجع نفسه، ص 78
أحمد المديني: (في الأدب المغربي المعاصر) مرجع سابق، ص 106-107
المرجع نفسه، ص 108.
(أسئلة الإبداع…)، ص 85
المرجع نفسه، ص 83
المرجع نفسه، ص 83
أحمد المديني: (ثلاثة أزمنة في زمن واحد) ضمن كتاب (الرواية العربية-واقع وآفاق) دار ابن رشد للطباعة والنشر 1981.
محمد برادة: (رواية عربية جديدة) ضمن كتاب (الرواية العربية: واقع وآفاق) المرحع نفسه، ص 10-11
من المعروف أن بعض أفكار لوكاتش لا يمكن استيعابها بشكل متكامل إذا لم توضع في سياقها السجالي. وينطبق هذا -بصفة خاصة- على مفهومه للواقعية المقرون بمناظرته الشهيرة مع بريشت. فإثر صعود الفاشية وانتشار “أدب المنفى” في الثلاثينات، تصدى بريشت للوكاتش محاولا سحب مفهومه للواقعية من مستوى الأفكار العامة إلى مستوى “النظرية”، أو إلى مستويين في النظرية: مستوى لوكاتش “الإنساني”، ومستوى بريشت “البروليتاري”، والمستويان يتمايزان بما يجعلنا أمام “نظريتين” واضحتي الاختلاف. انظر
*Brecht: Sure le réalisme. Paris: 1970, Lesarts et la révolution. L’arch 1970.
*G. Lukacs: Problèmes du réalisme. L’arche 1975.
أحمد المديني (أسئلة الإبداع…) ص 82.
المرجع نفسه، ص 85.
المرجع نفسه، ص 86
المرجع نفسه، ص 84
المرجع نفسه، ص 86
المرجع نفسه، ص 84.
صدرت لأحمد المديني خمس روايات هي:
أ-زمن بين الولادة والحلم (دار النشر المغربية) 1976
ب-وردة للوقت المغربي (دار النشر المغربية) ط. ثالثة 1985
ج-الجنازة (دار قرطبة للطباعة والنشر) 1987
د-حكاية وهم (دار الآداب، 1992، ط. أولى
هـ-طريق السحاب (الدار المغربية للنشر) البيضاء، 1994.
18 – Mikhail Bakhtine – (Esthétique et théorie du roman) Ed. Gallimard 1978, p. 95.
19 – Tzvetan todorov (Le principe dialogique) Ed. Seuil, p. 32, suivi de E.C.B.
ميخائيل باختين. مرجع سابق، ص 85
المرجع نفسه، ص 129
المرجع نفسه، ص 156
ميخائيل باختين: (الخطاب الروائي) تقديم وترجمة : محمد برادة. دار الأمان. الرابط ط.2، 1987. ص، 12.
المرجع نفسه، ص 14.
حميد لحميداني: (أسلوبية الرواية – مدخل نظري) منشورات دراسات سال 1989، ص79.
انظر التحديد الشامل للسرد عند بارت في :
Introduction à l’analyse structurale des récits – communication-8 EdK du seuil.
الجنازة (دار قرطبة الدار البيضاء -1987، ص 97-98.
28 – Jean Ricardou (Le nouveau roman) Ed. Seuil, p. 102-103-108.
29 – Jean-yves Tadié (Le récit poétique) Ed. Puf, p. 8.
المرجع نفسه.
الجنازة، ص 9-10.
الرواية، ص 14
الرواية، ص 28
الرواية، ص 14
الرواية، ص 36
الرواية، ص 18-19
الرواية،ص 18
الرواية، ص 1.
39 – Michel Mansuy ( l’imaginnation dans le nouveau roman) in : (Nouveau roman :hier, aujourd’hui – 1 Problèmes générauxf U.G.Rý.E – Paris, p.87
40 – Françoise Van Rossum Guyon (le nouveau roman comme critique du roman) Ibid. p. 400-415
الرواية، ص 16-17-29
الرواية، ص 22
الرواية، ص 23
الرواية، ص 32
الرواية، ص 32
الرواية، 36-37
الرواية، ص 13
الرواية، ص 18
الرواية، ص 36
الرواية، ص 20
الرواية، ص 22
الرواية، ص 53
الرواية، ص 50
الرواية، ص 51
الرواية، ص 51
أحمد زيادي: (جدلية النص والمرجع وأفق التجريب: “الجنازة” لأحمد المديني) م.ج. الاتحاد الاشتراكي. العدد 273. 16 أبريل 1979.
الرواية، ص 111-112
الرواية، ص 67 – 68
الرواية، ص 124 – 125
الرواية، ص 72
الرواية، ص 73-74
الرواية، 86
لرواية، ص 61
الرواية، ص 59
الرواية، ص 130
الرواية، ص 99-100
الرواية، ص 117-118
الرواية، ص 108
الرواية، ص 115
الرواية، ص 80-81
فرنسواز فان روسوم. مرجع سابق
المرجع نفسه
73 – Voir: Françoise van rossum Guyon. (point de vu ou perspective narrative) Poétique, n° 4, 1970,
p. 476-496.
أحمد زيادي، مرجع سابق
المرجع نفسه
الجنازة، ص 97-98
سعيد علوش: (الوظيفة اللغوية في الرواية المغربية) مجلة الفكر العربي المعاصر. العدد 49 و 48، ص 104.


