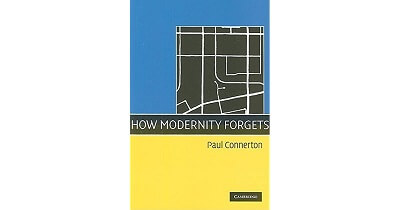| الكاتب | بول كونرتون |
| مراجعة | مصطفى شلش |
تآكل ذاكرة الحداثة
في مسرحية العاصفة التي تقع في خمسة فصول، يقدم الشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، أحد أنبياء عصر الحداثة الغريبة، بروسبيرو، يطلق نبوءته الخالدة في الفصل الرابع من The Tempest[1]، قائلًا: “هؤلاء الممثلون، ليسوا سوى أرواح وقد تفرقوا في مهب الريح. ونظير مَن يتخيل مشهدًا لا وجود له، ها هي الأبراج التي تناطح السحاب والقصور الفخمة والمعابد المهيبة والأرض العظيمة، مثل كل ميراث تذوب وتضمحل. وهكذا في هذا الإستعراض المشؤوم يغيب الواهمون ولا يتركون وراءهم أي أثر. إننا كسائر الحالمين يسيطر الخيال على حياتنا الوجيزة كأننا غائصون في نوم عميق يشل كُل حركاتنا.”[2]
النسيان، أو الخوف مِن النسيان، أي الذاكرة، التي برزت أولًا كشئ حاسم للهوية، ثم مع تشققاتها وتصدعاتها، أصبحت قضية مركزية في التفكير الفلسفي مع بيرجسون، وفي التفكير التحليلي النفسي مع فرويد، وفي سيرته الذاتية الأدبية مع بروست. في بداية القرن العشرين، كانت الذاكرة نفسية، وفي نهاية القرن كان الدور على الذاكرة الثقافية.
كيف يمكننا أن نفسر المناقشة المتكررة والقيمة العالية الظاهرة للذاكرة؟ لا شك في أن التداعيات المتراكمة لأحداث الحروب بالقرن الماضي قد لعبت دورًا حيويًا في هذه الانشغالات الحالية؛ لكني هناك زعم آخر، يعتقد أنه السبب الجوهري، إن لم يكن التفسير الأساسي بالفعل، هو أن الحـداثة لديها مشكلة خاصة في النسيان.
يقدم بول كونرتون في كتابه المعنون: بـ ” how modernity forgets“، والمترجم للعربية تحت عنوان: “كيف يغزو النسيان ذاكرة الحداثة – للمترجم، الدكتور على فرغلي”، فكرة فقدان الذاكرة الثقافية، مقدمًا رؤى حول الأساس الرخو والمُضمحل للحداثة. وذلك، بالنظر إلى مدى سيطرة الماضي على الثقافة المعاصرة، كما يتضح من الدراسات التراثية، وولعها للاحتفال، وفتنتها بالحنين إلى الماضي وملاحم عصور أخرى غير تلك الموجودة في الحاضر الكئيب، فإن وصفًا لكيفية نسيان الحداثة قد يبدو منحرفًا. لقد تم الاعتراف أخيراً بأخطار النسيان في ذكرى الموتى العائدين من الحروب. لذا يهتم كونيرتون بدرجة أقل بالإجراءات التي تضعها المجتمعات لتتذكر، خوفًا من الوقوع في غطرسة النسيان، لذا اهتم كونرتون بالهياكل والطبوغرافيا وأماكن الذاكرة التي يولد أساسها المتغير فقدانًا للذاكرة الثقافية. بمعنى ما، ” how modernity forgets” هي دراسة للنسيان، تولد روح الحداثة العابرة، حيث يتم التخلص من العلامات المميزة لاندفاع الحياة في المدينة.[3]
ينقسم الكتاب لثلاث فصول، لدراسة فُقدان الذاكرة الثقافي الناتج عن الانفصال عن المكان والممتلكات والسلع، حيث لا يُعطى زوال الحياة الحضرية أي تحسين طوبوغرافي أو ثبات. ويتوسع كونرتون في الدراسة، ليشير إلى ثمن السرعة وانضباط الوقت، والموضة والتسليع الذي لا هوادة فيه، ولكن مع التركيز الأصلي على فقدان الذاكرة الثقافي. وحرصًا عن توصيل فكرته الأساسية المتعلقة بالخصائص الهيكلية للحداثة التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة الثقافية، يتم التقليل من شأن التمرد الفردي، والفاعل ضد هذه الروح الغارقة التي تدرك النسيان. والنتيجة هي أن فقدان الذاكرة الثقافي يبدو مصيريًا.[4]
فقدان الذاكرة الثقافي كمصير[5]
أن نقول هذا لا يعني الادعاء بأن الحداثة تحتكر فقدان الذاكرة الثقافي ، لأن هناك أنواعًا مختلفة بشكل واضح من النسيان الهيكلي الخاص بالتكوينات الاجتماعية المختلفة ، حيث كان علماء الأنثروبولوجيا والكلاسيكيون من بين أول من أشاروا عندما حققوا في خصوصيات الانتقال في المجتمعات المتعلمة. كما أنه لا يمكن الادعاء ببساطة أن سحابة من النسيان قد هبطت على الأفق المعاصر. أي تأكيد من هذا القبيل سيكون سخيف.
ومع ذلك ، في حين أن النسيان لم ينزل في الواقع كبطانية مغلفة بالكامل على العالم المعاصر ، وبينما تظهر التشكيلات الاجتماعية المختلفة قبل بداية الحداثة أشكالًا مميزة من النسيان خاصة بها ، تظل الحالة أن هناك أنواعًا من النسيان البنيوي الخاص بثقافة الحداثة.[6]
يشتبه عدد من المفكرين بنفس القدر. جادل فريدريك جيمسون بأن “نظامنا الاجتماعي المعاصر بأكمله بدأ شيئًا فشيئًا يفقد قدرته على الاحتفاظ بماضيه” . ويعتقد إريك هوبسباوم أن “تدمير الماضي، أو بالأحرى الآليات الاجتماعية التي تربط تجربة المرء المعاصرة بالنسبة إلى الأجيال السابقة، هي واحدة من أكثر الظواهر تميزًا وغرابة في أواخر القرن العشرين. حيث نشأ معظم الشباب والشابات في نهاية القرن في نوع من الحاضر الدائم يفتقر إلى أي علاقة عضوية بالماضي العام في الأوقات التي يعيشون فيها. ” وقد أشار أندرياس هويسن إلى “تناقض رئيسي ومحير في ثقافتنا. وهو تضاؤل التاريخ والوعي التاريخي بلا منازع، والرثاء من فقدان الذاكرة السياسي والاجتماعي والثقافي، والخطابات المختلفة الاحتفالية أو المروعة، حول ما بعد التاريخ ، قد صاحبها في العقد ونصف العقد الماضي طفرة ذاكرة ذات أبعاد غير مسبوقة. وينضم إليه جاك لو جوف في ربط تثمين الذاكرة بالنسيان الثقافي عندما يقول إن “الجمهور العام، مهووس بالخوف من فقدان ذاكرته”. [7]
نوع من فقدان الذاكرة الجماعي – الخوف الذي تم التعبير عنه بشكل محرج في ذوق أزياء الأزمنة السابقة ، واستغله التجار الذين يحنون إلى الماضي بلا خجل ؛ أصبحت الذاكرة من أكثر الكتب مبيعًا في المجتمع الاستهلاكي “.
وتعليقًا على العمل الجماعي الصادر في ثلاثة أجزاء والمكوّن من سبعة مجلدات” تراجع الذاكرة” الذي حرره بيير نورا على مدار الأعوام 1984-1992، يلاحظ توني جوت أن” بالنظر مِن خلال الاختفاء التقريبي للتاريخ السردي في المناهج الدراسية في العديد من الأنظمة المدرسية، بما في ذلك النظام الأمريكي، فقد يأتي وقت نجد لدينا العديد مِن المواطنين الذين يُشكل ماضيهم عالمًا منسيًا، أو مجهولًا، إذ لن يتبقى شئ يُمكن نسيانه”.
بينما ركز ريتشارد تيرديمان المشكلة من منظور أعمق عندما كتب: “بدءًا من أوائل القرن التاسع عشر، يمكننا القول أن القلق بشأن الذاكرة تبلور حول تصور لاثنين من الاضطرابات الرئيسية: ذاكرة قليلة جدًا، ومعلومات كثيرة جدًا مِن الصعب إستيعابها.” [8]
يركز أولريش بيك على مسألة النسيان مِن منظور مستقبلي؛ على الرغم من أن كلمة النسيان لم تذكر أبدًا في مناقشته للمخاطر المستقبلية التي يتسبب فيها الإنسان، على سبيل المثال تلك الناتجة عن الملوثات النووية أو الكيميائية والملوثات في المواد الغذائية، فإن النسيان هو النص الفرعي لمناقشته؛ لأنه حتى مع التخمينات أو التكهنات ، نظرًا لأن الأخطار التي قد لا تكون مرئية في الوقت الحالي وفي بعض الحالات قد تصبح سارية فقط خلال عمر الأطفال الذين أصبحوا الآن منشغلين بالمخاطر ، فإن مركز الوعي بالمخاطر لا يكمن في الوقت الحاضر ، لكن في المستقبل، ونتيجة لذلك، “يفقد الماضي في مجتمع المخاطرة القدرة على تحديد الحاضر. يأخذ المستقبل مكانه، باعتباره “سبب” التجربة والعمل الحاليين.” [9]
أخيرًا، أنطوان كومبانيون، يشير ضمنيًا إلى أننا يجب أن نفكر في حرية تنقلنا المكاني الحالية بوصفها سبب في النسيان، حيث التنقل بين المُدن يُفقدك إحساسك بأنك في موطنك، وذلك سواء في أي لغة أو ثقافة، فالرحيل يعني إنك ستنسى على الفور جميع الأرقام والأسماء باستثناء تلك الخاصة بأقرب اثنين أو ثلاثة من أصدقائك أو أهلك. لكن، عندما تعود قد تتذكرها مرة أخرى. بدون هذه القدرة غير الطبيعية على النسيان، فالمرء لا يدري أين تسوقه قدماه.
ومع ذلك، على الرغم من كُل ما سبق، فإن معظم هذه الملاحظات هي اقتراحات بديهية. إنها تثير الشهية وتتركنا نتوق للمزيد. إن موضوع “كيف تنسى الحداثة؟” لم يخضع حتى الآن للتدقيق المنهجي، ومن الواضح أن هذا يستحق.[10]
لنبدأ بمفهوم الحداثة نفسه: أعني بالحداثة التحول الموضوعي للنسيج الاجتماعي الذي أطلق العنان لظهور السوق العالمية الرأسمالية التي تمزق القيود الإقطاعية والإرتباط مع الأجداد على نطاق عالمي، ومن الناحية النفسية توسيع فرص الحياة من خلال التحرر التدريجي من التسلسلات الهرمية للحالة الثابتة. ترتيبًا زمنيًا ، يغطي هذا الفترة من منتصف القرن التاسع عشر المتسارع إلى الوقت الحاضر. على الرغم من أن هذه عملية عالمية، إلا أن الأمثلة التي يقدمها كونرتون عن النسيان محددة وتقع معظم الوقت في الولايات المتحدة وأوروبا، على افتراض أن هذين المكانيين منتجا ظاهرة النسيان.
إن القول بأن الحداثة تتميز بنوع معين من النسيان هو افتراض مسبق لمفهوم التذكر. لذلك ، يجب تحديد التذكر لتوضيح معنى النسيان. هناك بالطبع أنواع مختلفة من الذاكرة. ولكن هناك نوع معين سيعود إليه كونرتون مرارًا وتكرارًا في نوع من الإصرار الدائري فيما يلي هو: الذاكرة المكانية.[11]
تلك الذاكرة التي تعتمد على الطبوغرافيا هي فكرة قديمة. كان ما يسمى بـ “فن الذاكرة” يقع ضمن النظام الخطابي العظيم الذي سيطر على الثقافة الكلاسيكية، وولد من جديد في العصور الوسطى، وازدهر خلال عصر النهضة، ولم يدخل إلا عند زواله خلال الفترة من اختراع الطباعة إلى العصر الحديث. في مطلع القرن الثامن عشر. أعطى شيشرون بيانًا موجزًا في مطلع أحد أعماله كالتالي: “يجب على الأشخاص الراغبين في تدريب كُلي للذاكرة، اختيار الأماكن وتشكيل صور ذهنية للأشياء التي يرغبون في تذكرها وتخزينها، بحيث يحافظ ترتيب الأماكن على ترتيب الأشياء. ” وفقًا لذلك، تم وصف” فن الذاكرة “هذا بأنه” طريقة تحديد المواقع “.
يمكن تحديد المكان كمكان يسهل على الذاكرة استيعابه، مثل منزل أو قوس أو زاوية أو عمود أو مساحة بين الأعمدة. يمكن بالفعل إدراك الموقع أو الأماكن المعنية أو يمكن تخيلها ببساطة. يعمل المكان الحقيقي أو المتخيل أو مجموعة الأماكن كشبكة توضع عليها صور العناصر التي يجب تذكرها بترتيب معين ؛ ثم يتم تذكر العناصر عن طريق إعادة النظر في شبكة الأماكن واجتيازها خطوة بخطوة. وفرضية النظام بأكمله تقوم على أن ترتيب الأماكن سيحافظ على ترتيب الأشياء التي يجب تذكرها.[12]
يجب التأكيد هنا على سمتين من سمات فن الذاكرة. أحدها أنه يعتمد بشكل أساسي على نظام مستقر للأماكن. والآخر هو أن التذكر يتعلق ضمنيًا بجسم الإنسان، وأن أفعال الذاكرة يُنظر إليها على أنها تحدث على نطاق بشري ؛ يتحدث بعض ممارسي الفن عن الخطيب البلاغي باعتباره يتجول في بناء ذاكرته بينما يسعى إلى أن يطبع في ذهنه التسلسلات الطويلة للفكر التي يرغب في تذكرها.
هاتان السمتان لفن الذاكرة تعطينا أدلة حيوية، على ما أعتقد ، لفهم نوع النسيان الذي يميز الحداثة. يزعم كونرتون أن أحد المصادر الرئيسية للنسيان مرتبط بالعمليات التي تفصل الحياة الاجتماعية عن المكان وعن الأبعاد البشرية: السرعة الفائقة، والمدن الضخمة، والنزعة الاستهلاكية المنفصلة عن العمل، والعمر القصير لـ العمارة الحضرية، اختفاء المدن التي يمكن المشي فيها. ما يتم نسيانه في الحداثة بالغ العُمق على نطاق الحياة البشرية، تجربة العيش والعمل في عالم من العلاقات الاجتماعية المعروفة. هناك تحول عميق فيما يمكن وصفه بمعنى الحياة على أساس الذكريات المشتركة، جراء تأكل هذا المعنى بفعل التحول البنائي في فضاءات الحياة الحداثية.[13]
نوعان من ذاكرة المكان[14]
العديد من أعمال التذكر خاصة بالموقع ، لكنها ليست كلها قائمة بنفس الطريقة. ضع في اعتبارك، على سبيل المثال، الحالتين التاليتين.[15]
يأتي المثال الأول، من تجربة الفلسطينيين المعاصرين، الذين يعتبرون الحدث الأساسي في ذاكرتهم الجماعية هو الاقتلاع الكارثي لعام 1948 ، ونزع الملكية والاحتلال الناجم عن إقامة دولة إسرائيل. تم تدمير المئات من قراهم ، وهُدمت جميع منازلهم ومبانيهم تقريبًا ، وأعاد المحتلون الجدد تشكيل المواقع. في الوثائق ، في القصص القصيرة ، في الرسوم والخرائط في الذاكرة ، يعطي مصير الأشجار صورة مكثفة لكارثة الاقتلاع والتوق إلى الجذور. يرتكز الوضع الرمزي للأشجار على المصير الفعلي للأشجار. يوثق كتيب أشجار الزيتون تحت الاحتلال تجربة قرية ميديا عام 1986 عندما اقتلع أكثر من 3300 شجرة زيتون ، رفعت لافتات سوداء عند مدخل القرية وعلى بيوت الأفراد ، كما لو كانت حداداً على وفاة شخص. في القصة القصيرة لغسان كنفاني “أرض البرتقال الحزين” عام 1987 ، يتذكر الراوي ، وهو صبي صغير ، عند رؤيته ألم عمه عندما يفكر في أشجار البرتقال “المهجورة لليهود” ، أن أحد الفلاحين في الوطن أخبره ذات مرة أن كانت أشجار البرتقال تذبل وتموت إذا تركت في رعاية الغرباء. وفي لوحة لأمين شتي عام 1977 ، تم تمثيل صورة مشتركة لشجرة زيتون ورجل ، تم تمييزهما على أنهما فلسطينيان بغطاء رأس تقليدي ؛ يندمج الجذع الشجري والجذع البشري في وحدة واحدة. عندما يحاول الفلسطينيون إعادة بناء خرائط الذاكرة لقراهم المدمرة ، فإن الأشجار هي التي تُحي ذكراهم، وتمنع نسيانهم.[16]
يأتي المثال الثاني من التجربة المؤلمة للرهاب من الأماكن المكشوفة التي أبلغ عنها عدد من النساء الأوروبيات في المدن في أواخر القرن التاسع عشر. مصطلح “رهاب الخلاء”، إلى جانب دراسات الحالة الأولى المتماسكة للمرض، صاغه ويستفال لأول مرة في عام 1872. وقد كان كُل مرضاه من الرجال آنذاك، وقد عانوا مِن مخاوف شخصية لا يمكن تفسيرها، جراء المحرمات الاجتماعية المفروضة على الحركة في الأماكن العامة المفروضة على النساء البرجوازيات. [17]
في الدراسات اللاحقة لرهاب الخلاء، شكلت النساء الغالبية العظمى من المرضى المعالجين ؛ اشتكوا من قلق شديد جعلهم غير قادرين على التنقل كما فعل أي شخص آخر – غير قادرين على مغادرة منزلهم ، أو عبور شارع أو ساحة مهجورة ، أو دخول قاعة حفلات مزدحمة. في الواقع ، كانوا يعانون بؤس هستيري من التعاسة اليومية في القرن التاسع عشر. بالنسبة للعقل البرجوازي في ذلك الوقت ، كان الشارع مكانًا خطيرًا ؛ اندلعت الحرب الاجتماعية الكامنة في علاقات الإنتاج الرأسمالية بشكل صارخ في الشارع. عندما وصف إنجلز حالة الطبقة العاملة في إنجلترا في أربعينيات القرن التاسع عشر ، أظهر أن ظروف الطبقة العاملة وظروف شوارعها هي نفسها. ووصف شوارع مانشستر في لندن ودبلن وغلاسكو وفي ليدز وبرادفورد وإدنبره. [18]
ونظرًا لأن التجارة أصبحت عملًا للرجل بينما كانت المرأة تعمل داخل المجال المنزلي ، كان وجود الرجل في الشارع أمرًا مشروعًا ، ولكن يُفترض أن النساء في الشارع ليذهبن إلى العمل الضروري لأن أزواجهن لا يستطيعون إعالة الأسرة بمفردها. ومن ثم شعر الرجال أنه مسموح لهم بممارسة الوقاحة تجاه النساء اللائي ظهرن في الشارع. وقد تعرفنا على القيود المفروضة على ظهور النساء البرجوازيات في المجال العام قبل كل شيء من كتيبات “الاتكيت”، وفي كتابها عن الأخلاق الحميدة، كرست السيدة فان زوتفين فصلاً عن “التجنب والاستبعاد”، وهو يتحدث عن ضرورة تجنب النساء البرجوازيات عدد من الأماكن مثل: الأحياء الفقيرة والقطارات المحلية وعربات الترام وحانات الدرجة الثالثة والمقاعد الرخيصة في دور السينما والحشود والاحتفالات في الشوارع.
بالنسبة لهذين المثالين، كلاهما يتعلق بذكريات مؤلمة، لكن هذه ليست أهمية الإستعانة بهم هنا، بل ود كونرتون لفت الانتباه والإشارة إلى طريقتين مختلفتين تمامًا يمكن من خلالهما أن يرتبط فعل التذكر بمكان معين أو يعتمد عليه. وسيكون هناك عدد من الشكوك والاستفسارات في أذهان القارئ فيما يتعلق بالحجة التي كان كونرتون يقدمها حول النسيان. لكن، ما الذي يُنسى بالتحديد؟ للإجابة على هذا السؤال، نحتاج إلى التمييز بين فئات التذكر المختلفة ؛ على وجه التحديد ، بين الذكريات المعرفية والذكريات الشخصية والذكريات المعتادة.
الذاكرة والنسيان[19]
تدعي الذاكرة المعرفية أنها تغطي استخدامات فعل “أن نتذكر” عندما يُقال لنا أن نتذكر ، على سبيل المثال ، معنى الكلمات أو سطور الشعر أو القصص أو حقائق المنطق. عند تطبيقه على الأماكن ، يمكن أن يعني فشل الذاكرة المعرفية ، على سبيل المثال ، عدم القدرة على تذكر وحدة المدينة، وتذكر الشكل العام الذي لا غنى عنه إذا أردنا أن نكون قادرين على توجيه أنفسنا في تلك المدينة. إن نسيان تخطيط الشارع المتنوع لمدينة كبيرة قد يستلزم مجموعة كاملة من النسيان: من المعالم ، والمسارات ، وتقاطعات الشوارع ، فضلاً عن الهيكل المعقد غالبًا لأنظمة مترو الأنفاق التي تشكل نظامًا جغرافيًا متوازيًا تحت مستوى الأرض.[20]
بالمقارنة مع المدن الحديثة، تم تأصيل الذاكرة المكانية للمدن الأوروبية ما قبل الحديثة ونطاقها الصغير ، والذي تم تعزيزه بدوره بميزتين: المحيط، الذي يسهل التعرف عليه، وبالتالي لا يُنسى معرفيًا، والخطوط العريضة للتحصينات والبوابات والأبراج والجدران الحجرية الثقيلة ونقطة تركيزهم المركزية ، والتي تم توفيرها في الثقافات الأوروبية من قبل تلك الكاتدرائيات القوطية التي أسفرت عن شخصية لا تُنسى مقابل الأرضية المحيطة. على النقيض من ذلك ، أصبحت المدينة الحديثة لا حدود له. مع التفكيك الرمزي لأسوار المدينة في القرن التاسع عشر، تطورت المدينة الحديثة الناشئة إلى ما لا نهاية وأصبح تاريخها قصة تشتت مكاني. عندما يتم توزيع السكان على مناطق تتوسع باستمرار، سواء كانت ضخمة في النطاق أو غير متبلورة الشكل ، تصبح المدينة كيانًا ماديًا لا يُنسى قد يُسفر عن نقطة تركيز. يولد اختفاء المدينة ذات المركز الإشعاعي نمطًا من التمركز يسهل نسيانه.[21]
تستلزم الذكريات الشخصية ، المتميزة عن الذكريات المعرفية ، فئة من ادعاءات الذاكرة الشخصية التي تشير إلى أفعال التذكر تلك التي تأخذ تاريخ حياة الفرد كشيء خاص بها. نتحدث عنها كذكريات شخصية لأنها موجودة في الماضي الشخصي وتشير إليه ؛ من خلال ادعاءات الذاكرة الشخصية ، يتمتع الأشخاص بوصول خاص إلى الحقائق حول تاريخهم الماضي ، وهي طريقة للوصول ، من حيث المبدأ ، لا يمكنهم أبدًا الوصول إلى التواريخ السابقة لأشخاص آخرين. قد يتم التعبير عن ادعاءات ذاكرتنا الشخصية في شكل عبارات مثل: لقد فعلت هذا وذاك ، في كذا وكذا ، في مكان كذا وكذا. في تذكر حدث ما ، أنا أفكر في نفسي أيضًا. عندما أقول “لقد زرت روما لأول مرة منذ عشرين عامًا” ، فإنني أفكر في نفسي وكذلك عن روما. أنا على دراية بحاضري الفعلي ، وأنا أفكر في نفسي أيضًا بصفتي الشخص الذي فعل هذا وذاك في الماضي، وأنا، الذي أتحدث الآن عن ذلك الحدث الماضي في حياتي، مختلف في بعض النواحي ومتطابق في بعض النواحي.
تعتبر ادعاءات الذاكرة الشخصية من هذا النوع ضرورية لوصف الذات، لأن تاريخنا الماضي هو مصدر غني لتصورنا ومعرفتنا بأنفسنا مِن وجهة نظر شخصية، ويتم تحديد إلى حد كبير الطريقة التي نرى بها أفعالنا الماضية. وكل هذه الإجراءات السابقة كانت موجودة في مكان ما. حيث هناك علاقة حيوية بين الهوية الشخصية ومجموعة متنوعة من الحالات الماضية، والمتعة والندم؛ الأشياء المناسبة للسعادة أو الحزن.
متى ظهرت بالضبط عملية النسيان الثقافي هذه على أنها “قطيعة” أو “قطيعة” يمكن الإشارة إليها على أنها أكثر أهمية بلا شك من أي عملية أخرى؟[22] ما حدث هو في الواقع سلسلة من “التمزقات”. إلى حد ما، بالطبع، تقوم حجة كونرتون على التفسير الماركسي الكلاسيكي الذي يضع الفاصل الأكثر أهمية في حوالي عام 1800 فصاعدًا. ولكن فيما يتعلق بظهور المدينة العملاقة ، وميزة أقل أهمية ، فإن التداول الجماعي للصحف ، الذي يعود تاريخه بعد قرن من الزمان ، حوالي عام 1900 وما بعده ، يعد علامة كرونولوجية مهمة. مرة أخرى ، فإن ظهور المدن الكبرى ، والأهمية المتزايدة لوسائل الإعلام الإلكترونية وتطور تكنولوجيا المعلومات ، تعني تاريخًا من منتصف القرن العشرين تقريبًا فصاعدًا ، أو حتى بعد ذلك ، كتغيير هام إضافي في الخطوة. بشكل عام ، تتسارع عملية النسيان الثقافي للحداثة وتتميز بسلسلة من التغييرات التدريجية.
أين حدثت عملية النسيان هذه؟[23] من الواضح أن حجة كونرتون تشير إلى أن النسيان أصبح مشكلة للبشرية بشكل عام ، ولكن من الواضح أيضًا أن العملية بدأت في وقت مبكر وذهبت إلى أبعد من ذلك في بعض أجزاء العالم أكثر من غيرها. الجواب على سؤال “متى؟” يمكن صياغتها فقط إذا تم الاعتراف ببعض الاختلافات الجوهرية. معدل هدم الأمريكيين ، في الشمال والجنوب ، للمباني ، على سبيل المثال ، يختلف اختلافًا كبيرًا عما يفعله الإيطاليون ، أو حتى البريطانيون.
مع إشارة محددة إلى المكان ، ما يمكن نسيانه ، بالإضافة إلى النسيان المعرفي للتخطيط المكاني ، والمعالم ، والمداخل والمخارج ، ومسارات التسوية البشرية ، قد يكون مجموعة من الذكريات الشخصية وذكريات العادة. في ظل ظروف الحداثة والأماكن المميزة لها ، بالإضافة إلى مجموعة من الذكريات المعرفية ، يضيع تشابك قوي بشكل خاص للذكريات الشخصية وذكريات العادة ، لأنها تشكل طبقات من المعاني المعززة بشكل متبادل.[24]
يمكن لعملية إنتاج الأشياء أن تولد النسيان الثقافي لأنك إذا كنت تعيش في مدينة كبيرة ، فقد تنتج مصنوعات أو خدمات وتستهلك السلع في سوق له ، في الواقع ، روابط واسعة مع الأشخاص والأماكن التي تظل غير مرئية لك ، وغير معروفة لك. أنت ، ربما لم تتخيلها أنت. قد لا تكون على دراية بهذه الروابط ، وفي هذه الحالة تكون جاهلاً. أو قد تعرف عنها بدرجة أكبر أو أقل من الدقة ، ولكن في العملية المستمرة لحياتك اليومية ، يمكنك تعديلها خارج نطاق اهتماماتك الواعية ، وفي هذه الحالة ستنسى أمرها ؛ سيتم حجب العلاقات التي يكون فيها تدفق البضائع متشابكًا عن وجهة نظرك. هذا هو النسيان المعرفي في المقام الأول ، بمعنى أنه قد يكون لديك عادة عقلية معززة ثقافيًا تتمثل في النسيان.
تُميِّز الأشياء الاستهلاكية الآن إلى حدٍّ متزايد جودة حياة تمركز الإنسان في المراكز الأكثر تقدمًا من الناحية المادية في العالم ، حيث تُنسى ندرة وإفقار مساحات شاسعة والعديد من المجموعات في جميع أنحاء العالم في معظمها ، وهي عادة عقلية للنسيان. تم إنشاؤها من خلال الأخذ بعين الاعتبار توافر المستهلك في المدينة. بمجرد أن حوّل رواد الأعمال الرأسماليون انتباههم بشكل منهجي من إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة إلى إنتاج خدمات المستهلك ، أصبحت “دورة حياة المنتج” للأشياء المستهلكة أقصر من أي وقت مضى ، وظهرت الفروق الاجتماعية بفوارق زمنية أصغر دائمًا في أفعال الأشياء المستهلكة. يؤثر نظام تصنيف المواد الاستهلاكية ، الذي ينظم دورانًا سريعًا ، على كل من الأطفال والبالغين.[25]
الأطفال، الذين حصلوا على تدريب مبكر في معنى التقادم؛ والبالغون، الذين تقيدهم سرعة الموضة لأن الموضة تختفي بالسرعة التي تظهر بها. يؤدي تناقص عمر الأشياء الاستهلاكية إلى حدوث انعكاس ثقافي مثير للسخرية. يزداد متوسط العمر المتوقع للأشخاص بينما ينخفض متوسط العمر المتوقع للأعمال الفنية والأشياء والمباني ؛ نظرًا لأن الأول يتمتع بطول عمر أطول ، فإن الأخير يتميز بإيجاز أكبر من أي وقت مضى. هذا يولد النسيان الثقافي لكل من الذكريات الشخصية والعادة. [26]
إن إنتاج المعلومات الحديثة منظم لدرجة أن مبادئ التقارير الصحفية – الحداثة الواضحة ، والإيجاز ، والانفصال بين العناصر المنفصلة التي قد تكون ، في الواقع ، مترابطة بطرق معقدة – تعزل ما حدث عن المجال الخاص حيث كان من الممكن أن يكون قد دخل في وقت سابق. بشكل أكثر عمقًا ، وبشكل لا يُنسى ، في الحياة الفعالة للأشخاص. هذا يولد النسيان الثقافي لعناصر المعلومات ؛ وهذا أيضًا له عواقب على السمات السائدة ثقافيًا للحياة العاطفية وعلى عادات الإدراك السائدة ثقافيًا ، وبهذا المعنى فإن النسيان يتعلق بكل من الذكريات الشخصية والذكريات المعتادة. هذه الأشكال من النسيان تعززها حقيقة أن إحدى أهم سمات الطوبوغرافيا المعاصرة هي الهندسة المعمارية المصغرة للشاشة ، حيث يشير ظهور الجسيمات المتحركة إلى تداول الأخبار ونسخة الإعلان. بالنسبة للمتحدث عن بُعد ، يصبح حتى الماضي القريب تراكمًا سريع الزوال للصور يؤدي نقلها إلى إضعاف الروابط بين العناصر ، وبالتالي ذاكرة هذه العناصر ؛ ولكنه يضعف أيضًا الروابط داخل التجربة الشخصية ، حيث كان من الممكن في السابق أن يكون لجزء من المعلومات فرصة أكبر “للاستقرار” ، وبالتالي تصبح لا تُنسى. [27]
تكنولوجيا المعلومات ، من خلال إبراز “الذاكرة” من الخارج ، تجرد الذاكرة الشخصية للعديد من أدوارها الاستيعابية السابقة. من خلال توجيه انتباه المتابعين إلى قدراتها الهائلة على التخزين والمواد ، وإلى التتابع السريع للأحداث الصغيرة ، يولد عادة عقلية مستحثة ثقافيًا مما يجعل من الصعب بشكل متزايد تصور الماضي قصير المدى على أنه “حقيقي” ؛ كل من سرعة وانفصال عناصر المعلومات المنقولة يشكلان عادة نسيان حتى الماضي القريب.
إن وتيرة انتشار تقنيات أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين ، مثل أجهزة الكمبيوتر ، أسرع بكثير من تلك التي كانت في تقنيات القرن التاسع عشر ، مثل الكهرباء ، بحيث أصبحت أسواق العمل المؤقتة مؤسسية وعقود العمل المؤقتة منتشرة بشكل متزايد. تأثير ذلك هو أن ذاكرة المهارات المعتادة قد تم التقليل من قيمتها ، وربما يتم نسيانها أيضًا ، بينما يتم تقليل قيمة الذكريات الشخصية أيضًا ، عندما تصبح احتمالات الحياة المهنية متغيرة بشكل متزايد ، ويتقلص أفق الماضي بالنسبة إلى المهنية السابقة وكذلك للعمال ذوي الياقات الزرقاء. يؤثر هذا على طول عمر كل من ذكريات العادة والذكريات الشخصية. تأثير هذه العملية على تجربة الأماكن دراماتيكي. تنظر الشركات الكبيرة إلى الاستثمار في أماكن معينة بشكل متزايد على أنه مسألة قصيرة الأجل ، بحيث تصبح ذكريات الهوية المحلية من جانب المجموعات التابعة مهددة أكثر فأكثر. وهذا بدوره يؤدي إلى تآكل الثقة الثقافية ، من جانب الموظفين أو الموظفين المحتملين ، لأن الثقة تحتاج إلى تاريخ ، وماض ، ومصفوفة لها. تم طمس الرابط بين الشخص وعمله ، وهو أحد أهم المواضيع في شبكة التذكر الشخصي ، ويزداد نسيانه. في المناطق الأكثر تقدمًا ماديًا في العالم ، يتم تقويض زيادة متوسط العمر المتوقع للأشخاص بسبب انخفاض متوسط العمر المتوقع لمهنهم. أكثر وأكثر ، قد يتم نسيان هذا الأخير. [28]
تنتج ثقافة الاستنساخ الميكانيكي الذاكرة بشكل مختلف عن طريقة إنتاجها عندما سادت أنظمة الكتابة السابقة. أنتجت ثقافة الكتابة حصادًا مجازيًا: استعارات الكتابة على أنها “أثر” ، و “علامة” على وجود مفقود ، والذي يظل مع ذلك حاضرًا أمام العيون ، ومتاحًا للتدقيق التأملي ؛ جنبًا إلى جنب مع فكرة “النقش” في أذهاننا على “الانطباعات” الدائمة ، و “الخلفية”، و “العمق” ، و “طبقات” المعاني. سوف تجعل الاتصالات الإلكترونية الحالية مثل هذه الاستعارات قديمة بشكل متزايد ، لأن سلسلة الصور التي تولدها يمكن بشكل أقل معقولية أن يُزعم أنها تولد شكلاً من أشكال “النقش” ، وهو نمط نشط للتذكر.
ومن الجوهري لسياسات الذاكرة التي يتبعها أولئك الذين يمارسون السيطرة داخل نظام الاتصال التجاري أن الصور المقدمة لن تؤدي إلى تقييم عالٍ أو إلى فعل التذكر ، ولكن إلى القدرة على التخلص ، والإنتاج. من الصور التي يزيد تسلسلها النسيان. هذا مهم ثقافيًا لأنه كلما كان من الممكن القول بدقة أن الشخص “يتذكر” ، فإن هذه الذكرى تشير إلى الشخص الذي يشارك في نشاط التذكر. يشير كل شخص أو مكان أو فكرة أو قطعة أثرية تم تذكرها – ضمنيًا ، إن لم يكن صريحًا – إلى الشخص الذي يتذكر. تضعف وسائل الإعلام المعاصرة من التهديدات التي تنطوي عليها تلك المرجعية المحددة ، وبالتالي تقلل من الذاكرة الشخصية كقيمة ثقافية.[29]
لقد ولّدت حالة البروليتاريا الحضرية في القرن التاسع عشر ، المتشككة بشأن العمالة والسكن ، في المدينة اقتلاعًا كبيرًا ، وتمزقًا هائلاً بين الأشخاص والأماكن ؛ وقد تأثر هذا الاقتلاع التاريخي بعيد المدى لاحقًا بإنتاج السرعة. أدى الغزو على استبداد المسافة ، والإحلال الميول لمكان معين ، إلى نشوة اللحظية والنسيان المفروض في كثير من الأحيان للمكان في مكان معين. عندما ولدت الميكنة تنقلًا سريعًا ، فقد قوضت أيضًا الافتراض بأن ما كان مرئيًا كان مستقرًا أيضًا ؛ ما شوهد اكتسب صفة التلاشي ، مما جعل الذكريات الشخصية وذكريات العادات أكثر فأكثر في طي النسيان ، لأن فرصهم أقل في أن يصبح لها وزنً ثقافيًا.
على أن ذلك، وإن كان أمرًا مُسلم به، فإن الأرشفة المكثفة لا تؤدي إلى النسيان الثقافي ، ولكن إلى الإفراط في الذاكرة الثقافية. تتيح شركات النقل الجديدة لـ “البيانات” عمليات فرز “المعلومات” والسعي للحصول على المعلومات التي تتم إدارتها على أساس أكثر شمولاً وفعالية من أي وقت مضى. تتزايد باستمرار تلال الصور المؤرشفة ، والتسجيلات الشريطية ، ومقاطع الفيديو ، على الرغم من أنها أكثر هشاشة ، فيما يتعلق باستقرارها على فترات زمنية طويلة ، عند مقارنتها بالكلمة المطبوعة. لكننا نعيش الآن في مثل هذه الثقافة “المبالغة في المعرفة” بحيث تتكون الفطنة ، ليس في تجميع المعلومات ، وهو ما يمكن أن يقوم به اليوم أي طفل على الإنترنت ، ولكن في رفض المعلومات. مزيج لا ينفصم من الفن ، يؤدي السوق ووسائل الإعلام إلى وضع يصبح فيه من الصعب أكثر فأكثر على المبدعين أن يكونوا “نسيين”. تعمل الإذاعة والصحافة والتلفزيون باستمرار على إنتاج نسخة فوضويّة من وديعة أرشيفية شاملة.
هذا يشير إلى مفارقة، إن الإنتاج اللامتناهي تقريبًا للكتب والمقالات حول الذاكرة الثقافية، إذ رسمت بيانيًا ترتيبًا زمنيًا، على مدار العشرين عامًا الماضية وأكثر من حمى الانشغال المتزايدة باطراد تشبه الحمى الجسدية المتزايدة لمريض في المستشفى يتم تسجيل حالته بالرسم البياني الطبي. وبهذا المعنى، وبسبب انتشار الأرشفة حاليًا، فإننا نعيش في ثقافة فرط الذاكرة. ومع ذلك، إذا قمنا بفحص هياكل الوقت التي تشكل نمطًا منهجيًا للاقتصاد السياسي المعاصر – من حيث الدقائق الزمنية للاستهلاك، والمهن العملية، وإنتاج المعلومات ، وإنتاج المساحات الحديثة – فإننا نصل إلى نتيجة معاكسة على ما يبدو، وهي أننا نعيش في ثقافة ما بعد التذكر، وهي ثقافة منسية.
ختامًا، كلا الاستنتاجين صحيحان. لدى كونرتون إن التناقض في الثقافة التي تظهر العديد من أعراض فرط الذاكرة والتي في نفس الوقت تمثل ما بعد التذكر هي مفارقة يمكن حلها بمجرد أن نرى العلاقة السببية بين هاتين السمتين. إن عالمنا مفرط في الذاكرة في العديد من مظاهره الثقافية، ومفرط في النسيان في هياكل الاقتصاد السياسي. حيث تنتج الأعراض الثقافية لفرط الذاكرة عن نظام سياسي اقتصادي يولد بشكل منهجي ثقافة ما بعد التذكر، أو بعبارة آخرى: حداثة لا تُنسى.[30]
الهوامش:
[1] HOW MODERNITY FORGETS by Paul Connerton. KIERAN FLANAGAN ,First published: 02 December 2010
[2] العاصفة، وليم شكسبير، تعريب أنطون مشاطي.
[3] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[4] HOW MODERNITY FORGETS by Paul Connerton. KIERAN FLANAGAN ,First published: 02 December 2010
[5] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[6] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[7] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[8] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[9] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[10] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[11] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[12] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[13] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[14] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[15] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[16] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[17] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[18] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[19] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[20] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[21] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[22] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[23] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[24] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[25] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[26] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[27] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[28] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[29] How Modernity Forgets by Paul Connerton
[30] How Modernity Forgets by Paul Connerton