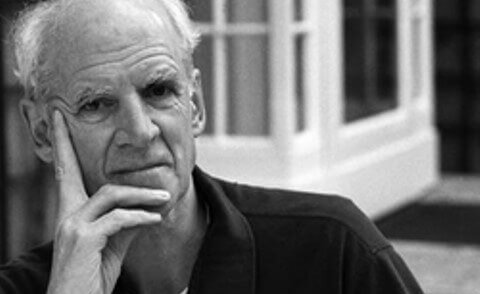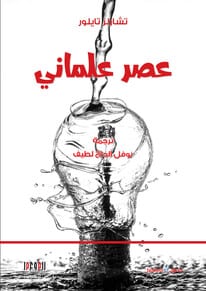
يمكنك شراء نسخة كندل من الكتاب عبر هذا الرابط
يتمثل جزء مهم من قصتنا هنا في الاهتمام المتزايد بالطبيعة، لا بوصفها مجرد تجلٍ للذات الإلهية وإنما كما هي عليه في حد ذاتها. وهو الاهتمام الذي نعثر عليه في العلم (خاصة مع الاهتمام المتزايد بأرسطو من جديد في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ميلادي)، وفي الفن (على مستوى “واقعية” غيوتّو Giotto الجديدة بالخصوص حيث تكاد تعكس لوحاته الأشخاص المحيطين به ممن يعايشهم عن قرب)، وفي الأخلاق (مع استئناف الأخلاق الطبيعية التي كان يقول بها بعض الأقدمين مثل أرسطو والرواقيون). وقد مرَّ هذا المسار الذي بدأ يستعيد مكانته من جديد بمراحل عديدة. إنه وجه من وجوه “نهضة القرن الثاني عشر ميلادي” الأكثر أهمية. بيد أن هذا الاهتمام بالطبيعة عرف تعبيرات مختلفة لدى أصحاب النزعة الإسمية Nominalistes في القرن الخامس عشر ميلادي، وكذلك لدى أصحاب النزعة الإنسانية Humanistes في عصر النهضة. وقد لعبت الثورة العلمية التي أعقبت التحوُّل الغاليلي-النيوتني في القرن السابع عشر ميلادي دورًا حاسمًا في ذلك واستمر إلى العهود اللاحقة.
ويبدو اقتران هذا المسار بحركة العلمنة الحديثة جليًّا اليوم. وكما بيّنت ذلك أعلاه، وفقًا للطريقة الأكثر شيوعًا لسرد هذه القصة، بدأت العلمنة عندما بدأ الناس يهتمون بالطبيعة وبالمحيط الذي يعيشون فيه، و”لأجل ذواتهم”، لا بوصف ذلك كله تجلٍ للقدرة الإلهية. فإذا كان الناس قبل ذلك يتمثلون ويتصورون الطبيعة أو الحياة البشرية وفق هدف واحد، فإن هدفهم اليوم تضاعف، وقد قطعوا خطوة أولى في الاتجاه الذي قادنا إلى ما نحن عليه لما بدأوا يهتمون أكثر فأكثر بالطبيعة في حد ذاتها (بما هي طبيعة فحسب)، وقد تنامى هذا المنظور تدريجيًا بقدر تقهقر المرجعية الإلهية، حتى قيل عنهم أنهم ذوو نزعة إنسانية حديثة محضة أو علمانيون على أقل تقدير. وبطبيعة الحال فإن هذه القصة تنطوي على فكرة أساسية مفادها أن هذه المحطة النهائية ينبغي أن تكون بداهةً هي الأمثل، لأن الاهتمام فيها سيتركز على الطبيعة بما هي طبيعة فحسب، بمعزل عن كل مرجعية خارجة عنها ما عدا نحن البشر باعتبارنا المرجعية الوحيدة المعقولة. وما كان لهذا ألا يرى النور وإن استغرق وقتًا طويلًا من دون مقاومة، خطوات إلى الأمام وأخرى إلى الوراء، ولكن إجمالًا أصبح مع مرور الوقت واقعًا لا سبيل للاعتراض عليه.
إن النظرة الأحادية هي الأخرى من جنس قصة “الطرح” التي ناقشتها في آخر المقدمة (الصفحة الأخيرة). نحن بحاجة فقط لتنحية المرجعية الإلهية جانبًا، والاهتمام بالطبيعة في ذاتها قصد تسخيرها في ضوء مصالحنا كما يتجلى ذلك في الموقف “الطبيعاني”.
تبدو هذه الطريقة في معالجة الأمور معيبة، فالقصة الحقيقية تبدو أكثر إثارة للاهتمام من ذلك بكثير. فلعل أبرز عيوب تلك الطريقة الأساسية أنها تضع الاهتمام بالطبيعة في ذاتها منذ البداية في تعارض مع المرجعية الإلهية، بينما لم يكن الأمر كذلك في الواقع، حيث كان هناك دائمًا توازٍ متوازن بين المرجعيتين، كما هو الحال بالنسبة للتوليف بين الأرسطية الجديدة والمسيحية الذي أخذ شكله الأكثر تأثيرًا وشهرة في فلسفة توما الأكويني. وقد أدى ذلك إلى ما يمكن تسميته تمكين الطبيعة من آليات تفسير ظواهرها ذاتيًا في استقلال تام عن أيّ قوة خارجة عنها، بحيث أصبح بإمكاننا النظر إلى الأشياء من حولنا انطلاقًا من طبيعتها الخاصة، وهي في سعي دائم للتجسُّد في أشكال معينة، وبالتالي تنزع إلى نوع من الكمال الذي يخصها. كما أنها مدعوة إلى الكشف عن نوع آخر من الكمال في علاقة بالنعمة لكن ذلك البعد لا يلغي أو يرمي عرض الحائط كمالها الطبيعي الكامن فيها، بل إنه يساعد على بلوغه.
ولكن النظر للأشياء من زاوية كمالها الطبيعي، على الرغم من أنه يضع دور النعمة بين قوسين، لا يترتب عنه بالضرورة الاستغناء عن الله. فلما كانت الطبيعة من صنع الله فإنها تمنحنا دليلًا آخر لتعقب أثر الله فيها، فدقة انتظامها تشهد على عظمته ودقة صنعه. وهذا ما جعل توما الأكويني يقول: “بناء على ذلك من ينتقص من كمال المخلوقات كأنما ينتقص من كمال القدرة الإلهية”([1]).
يعلم الجميع، طبعًا، أن الأمر يتعلق هنا بالمذهب. إن الفرق بين المقاربة الأحادية وبين المقاربة التي أتبناها هنا يكمن في أن مقاربتي تنسجم مع مسألة مدى جدية اتخاذ مثل هذه المقاربة كحافز للتغيير. يمكن القول بأن الانجذاب الطبيعي فقط لوجهة النظر المعقولة بدأ يتشكل فينا كانطباع قائم بذاته. لقد مثل تمكين الطبيعة من آليات تفسير ظواهرها في استقلال تام عن أيّ قوة خارجة عنها خطوة أولى على احتشامها على درب نفي كل قوة فائقة للطبيعة. وبطبيعة الحال لم يكن الناس عصر ذاك قادرين على تمثل الطبيعة بهذه الصورة، ولا التعبير عنها من خلال هذه المصطلحات، فقد كان لديهم أسبابهم التي يرونها مقبولة لأن يردوا كل ما يحدث إلى الله. ولكن لعب الاهتمام المتزايد بالطبيعة بما هي طبيعة فحسب دورًا حقيقيًا ورياديًا في اتجاه التخلي عن المرجعية الإلهية.
ذلك ما أُريد الاعتراض عليه. ولكن حتى نفسح المجال لمعالجة هذه المسألة هنا، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار سمة بديهية ميَّزت الوضع آنذاك والآن، وربما هي التي جعلت الأمور تشتبه علينا. فحتى في “عصر الإيمان”، لم يكن حجم الإخلاص هو نفسه لدى جميع المتدينين. وبالفعل لنا أن نتساءل عما إذا كانت نسبة السكان شديدي الإخلاص غير ثابتة إلى حد ما أيًّا كانت طبيعة الروحانية السائدة في أي عصر من العصور. ليست المشكلة في الإيمان إذن. يُفترض أن الشخص الذي استخدم خبز القربان المقدَّس تعبيرًا عن حب سحري، يتمتع ببعد نظر ولو نسبي حول سلطة التقديس. ولكن مستوى الإخلاص أو “الاعتماد على الله كمرجع” ليس واضحًا تمامًا.
وبالمثل، يمكن أن تكون لوجهات النظر التي تقول باستقلالية الطبيعة سلسلة كاملة من المعاني. كما يمكن أن يكون ما نتأمله فيها أو ما نتعلمه منها جزءًا من مشاريع متنوعة، على طول الطريق بدءًا من تمجيد الله حتى نبلغ أنجع وسيلة للقيام بهذه الأمور مرورًا بالتفكير الأخلاقي والتقدير الجمالي. وعليه لا يمكننا الحديث هنا عن هدف واحد.
إن السؤال المثير للاهتمام هو، ما الهدف (أو الأهداف) الذي كان (التي كانت) مهيمنًا (مهيمنة)؟ ما الذي يُفسِّر هذا التحوُّل في اتجاه الاستقلالية؟ لماذا التركيز على هذا العامل من بين جميع العوامل الأخرى التي أدَّت إلى ذلك؟ ما الذي يُفسِّر استمرار أثره؟ ما هي المعاني التي نقدِّر أنها مناسبة أو أنها الأفضل؟ بطبيعة الحال ليس ثمة ما يبرر هنا ولا في أي مستوى آخر البحث عن سبب واحد، ولكن أريد أن أُبَيِّن أن المعاني التي تتضمن اعتماد الله كمرجع لعبت دائمًا دورًا مهمًا جدًا.
ومن الواضح أن رجال الدين من المدرسيين قد مهدوا الطريق لهذا التحوُّل مستفيدين في ذلك من أعمال توماس الأكويني. فالنظرة الأحادية لا يمكن لها أن تأخذ في الاعتبار بشكل جدّي الطريقة التي تسمح بأن يكون للطبيعة القائمة بذاتها إخلاصها الخاص بها. وفي الحقيقة، قد يفتح هذا الأمر الباب على مصراعيه أمام تصارع أنواع مختلفة من الإخلاص، ولهذا السبب يُفترض لأي تغيير في هذا الاتجاه أن يواجه مقاومة (وذلك ما ينبغي)، كما يُفترض أن يكون عرضة لانتقادات عنيفة كما لو كان إفكًا وإثمًا لكن ذلك لم يحدث يقينًا.
ومن بين الصيغ المختلفة للإخلاص يمكن أن نذكر تلك التي تركز على الأشياء بوصفها موضع أعمال الله وآياته العظيمة. وتنهل هذه الطريقة بشكل موسَّع من الكتابات المقدَّسة كما تنهل أيضًا من المعجزات والآيات التي حدثت منذ الأزمنة التوراتية بدءًا من الاعتقاد بوجود ترابط بين الخبز والمن الذي أُنزل في الصحراء، إلى طقوس عيد الفصح اليهودي وإلى العشاء الأخير وإلى المائدة السماوية([2]). والتركيز على دورها في تمثل تجليات الله لا يترك أي مكان للنظر إليها في طبيعتها في ذاتها من حيث هي خاضعة في وجودها لانتظامية مجردة من هذه التجليات. كانت تلك هي الروحانية التي اتبعها على نطاق واسع الرهبان المدرسيون في القرون الوسطى العليا التي ركَّزت، كما ركَّز هم أيضًا على الأسفار المقدَّسة، وعلى التأويل المجازي للأحداث التي تُروى عنها.
وما نفتقده هنا هو معنى الكون ككلّ منظم، الكوسموس أو الكون بأسره universitas mundi، كما أطلق على تسميته. ويمكن القول بأن واحدة من صيغ الإخلاص ركزت على تجليات خطاب الله في حين ركزت أخرى على اللغة محكمة الترتيب الرائعة التي تجعل تلك التجليات ممكنة. أن ندفع بهذه الصورة عن الله إلى الأمام فذلك شأن أولئك الذين يتبعون الصيغة الأولى حتى يبدو أن الصيغة الثانية تقلل من شأن قدرة الله ومعجزاته بحيث يبدو الله كما لو أنه لا يستطيع استعمال لفظ في معنى جديد. أما بالنسبة لأولئك الذين يتَّبعون الصيغة الثانية، فيبدو أتباع الصيغة الأولى وكأنهم تغافلوا عن واحدة من أعظم معجزات الله، وهي خلقه لكل شيء في أحسن تقويم ووفق ترتيب وتدبير محكمين([3]). وقد ظهر هذا في استخدام هونوريوس دي أوتون Honorius of Autun لصورة عن العالم كما لو كان آلة قانون موسيقية ضخمة (شبيهة بالقيثارة):
“لقد خلق الصانع الأعظم الكون كآلة قانون موسيقية ضخمة خيوطها متناغمة بصورة تبعث على الروعة رغم تمايز أصواتها”([4]).
وغني عن القول إن استقلالية الطبيعة بالنسبة لأتباع الصيغة الثانية لا تنطوي بأي معنى على استبعاد المعاني الرمزية أو المجازية للأشياء. وهكذا يجب أن تفهم تلك المعاني فقط في سياق النظام المتناغم. وتقترب تجليات الخطاب من لغة محكمة البناء نحويًا ومعجميًا. وكون الأشياء ذات طبيعة ثابتة فإن ذلك لا يمنعها من أن تحمل علامات تحيل إلى الله، وهذا ما نعثر عليه في قول هيوجز القديس فيكتور Hugues of St. Victor: “إن العالم المحسوس بأسره أشبه ما يكون بكتاب خطته يد الله”([5]).
هكذا تكون لاستقلالية الطبيعة مصادرها الروحانية الأصيلة والنافذة على غرار “الواقعية” الجديدة في الرسم والنحت. وغالبًا اعتبرت الواقعية كما لو كان من لواحق تلك المصادر. إن لوحة العذراء والطفل تعكس الملاحظة الواقعية في النماذج المعاصرة، وتشهد على حضور التجسيد كثرة وفردًا في الرسوم الدينية، فما يتم تجسيده ليس مجرد بعد كوني ومعياري للشخص أو الكائن المعني، كما هو الحال بالنسبة للتمثال المثير للإعجاب للسيد المسيح معلّم الناس كافة على قبب الكنائس البيزنطية، ولكن سمات الحياة الفردية للأشخاص بدأت في الظهور. ويُنظر إلى ذلك، في كثير من الأحيان، على أنه ظهور لدافع أكثر من ديني بالتوازي مع أغراض دينية([6]).
ولكن مرة أخرى يبدو التباين في غير محله هنا. وبصرف النظر عن تأثير إدراك الطبيعة بوصفها كلًا منظمًا على الفنون البصرية، يمكننا أن نعثر على أسباب روحانية أخرى لهذا التغيير في القرنين الثاني عشر والثالث عشر.
مع أن الروحانية الرهبانية في القرون الوسطى العليا كانت تميل إلى التركيز على الدير كفضاء للحياة القريبة جدًا من الحياة الرسولية([7]) بقيادة أقليات اعتزلت العالم، فإننا نلاحظ أن تحرّكات الناس العاديين في بدايات القرن الثاني عشر كانت تستصرخ نمطًا جديدًا من الوجود الرسولي ضمن العالم، بل وبالنسبة للعالم. ويتطلب هذا النمط انبثاق نمط حياة جديدة عن العالم وتبشِّر به، نمط حياة رسولي (أملته جزئيًا تلك التحركات) بالمعنى الذي اكتسبه هذا اللفظ (أو استعاده). وفي نهاية المطاف تحوَّلت بعض التحركات إلى ضرب من الهرطقة كتلك التي قادها بيتر والدو Peter Waldoفي حين ثوّرت أخرى حياة الكنيسة ممثلة خاصة في التنظيمات الجديدة التي أسسها فرنسيس ودومينيك ([8])Francis and Dominic.
قد يكون هذا التحوُّل الجديد مقترنًا بالتطور الروحي الذي تحدثت عنه أعلاه، حيث تنامى خلال هذه القرون الإخلاص إلى المسيح الإنسان، وإلى معاناة المسيح، قبل الإخلاص إلى دينونة المسيح (وهو ما تعكسه على سبيل المثال صورة السيد المسيح معلم الناس كافة) الذي ساد قبل ذلك في العالم المسيحي اللاتيني. وهذا ما تعكسه أيضًا الندبات التي قال القديس فرنسيس أنه تلقاها من المسيح على سبيل المثال. إن الإجهاد الذي أصاب المسيح الإنسان جراء المعاناة يتناسب بداهة مع تطلع البشر في عصرنا إلى عودة المسيح لتخليصهم من معاناتهم. والمهم أن يكون المسيح بيننا أخًا كان أو جارًا، فالأمر يتعلق بوجهين لذات الفكرة الرائدة.
ذلك هو الاتجاه الروحي الجديد الذي نعنيه هنا على وجه الدقة. ومن الموضوعات الرئيسة في المسيحية، كالإيمان في تجسّد المسيح، التي ما انفكت تتكرر في التاريخ المسيحي في صيغ مختلفة: التطلع إلى عودة المسيح إلى الناس ولأن يكون بينهم، إلى أولئك الذين همَّشوا أو حرموا من الحصانة الروحية في ما مضى، وخاصة إلى الفقراء. وتهدف هذه التحركات الجديدة لنقل مركز الثقل في “الحياة الرسولية” من الدير إلى الفضاء العادي، ولا سيما في الفضاءات الجديدة في المدن حيث التجار والحرفيون والمعوزون أيضًا. ولم يكن ذلك صدفة فلقد كان والد والدو كما كان والد فرانسيس من الحرفيين.
لذلك ليس غريبًا البتة أن تلفت محاولة التبشير بعودة المسيح للعالم، العالم الدنيوي، العالم المدنس فيما مضى، الانتباه من جديد إلى هذا العالم. وهذا فرض من جهة رؤية جديدة للطبيعة، كما هو الحال في الروحانية الفرنسيسكانية التي ترى أن حياة الله تتجلى في الكائنات الحية وغير الحية التي تحيط بنا، ومن جهة أخرى الاهتمام بالناس العاديين.
ويمكننا أن نضيف الناس العاديين في فرديتهم على اعتبار أن جانبًا مهمًا آخر من الروحانية الفرنسيسكانية ركز بكثافة على شخص يسوع المسيح. وهذا الضرب من الإخلاص، كما يقول لويس دوبري Louis Dupré، ينتهي بتدشين “منظور جديد للخصوصية الفردية للشخص”. وعلى المستوى الفكري، استغرق هذا الأمر وقتًا طويلًا لتمهيد الطريق أمامه انطلاقًا من كتابات كبار المفكرين الفرنسيسكان من أمثال بونافنتورو دون سكوت وأوكام، لكنه انتهى بإعطاء وضع جديد للفردي بوصفه شيئًا أكثر من أن يُختزل في مجرد تعيين للكوني. وتعني المعرفة التامة بالأشياء، استيعاب “صورتها الفردية”، هويتها الفردية المتعينة الآن وهنا، (“هو-هو الآن وهنا”، هايكسايتاس haecceitas) بلغة سكوت“([9]).
على الرغم من أنه لم يكن لدينا إلمام واضح بهذا في ذلك العصر، فإننا بعد فوات الأوان، ندرك أن هذا الأمر مثل نقطة تحول رئيسة في تاريخ الحضارة الغربية، وخطوة مهمّة نحو الاعتراف بأسبقية الفرد التي مثلت سمة غالبة في ثقافتنا. ولكن بطبيعة الحال، ما كان لهذا أن تكون له أهمية قصوى إلا لأنه مثل أكثر من مجرد تحوُّل فكري انعكس في إبداع مصطلحات مدرسية جديدة يتعذر نطقها، لقد كان في الأصل ثورة في الإخلاص، في التركيز على الصلاة والحب: النموذج الإنساني الفردي، الله -الرجل، وحده القادر على أن يجعل إنسانية الآخرين كافة قابلة لأن تُعرف حقًا، وأن تُفصح عن نفسها بشكل أكثر وضوحًا.
وهكذا ليس من قبيل المصادفة، في ما يبدو، أن تتجلى أولى انعكاسات هذا التركيز في الرسم في جداريات غيوتو في كنيسة أسيزي. إن هذا الاهتمام بتنوع وتفصيل ملامح أناس معاصرين حقيقيين لم يتطور بالتوازي مع وجهة النظر الدينية من الرسم وخارجها، إنه ينبع من موقف روحي جديد من العالم.
لقد حددت اثنين من الدوافع الروحية لتجدد الاهتمام بالطبيعة بوصفها مستقلة: الإخلاص لله بوصفه خلق الكوسموس المنظم وأحكم تدبيره حيث تشهد مختلف مكوناته على حضور معجزات الله وآياته في أدق تفاصيله (وهذا ينطبق، بطبيعة الحال، على الكائنات البشرية خاصة، ولكن ليس عليها فقط)، وتحوُّل في موقف الإنجيليين الجدد تجاه العالم على أساس الاعتقاد في عودة المسيح بين الناس. ومن الواضح أن ثمة توافقًا تامًا بين هذين الوجهين. وتدعونا الحركة الإنجيلية في اتجاه المجتمع أو في اتجاه فضاء لم يطله الإنجيل في ما مضى بالشكل المطلوب، بما هي كذلك إلى أن نرى كيف أن الله حاضر دائمًا في حياة من نتوجه لهم بالرسالة التبشيرية ليخاطبهم مباشرة. وإن أقصى ما يتعيّن على المبشرين فعله باستمرار، بعد حركة الإصلاح، هو محاولة تكييف الإنجيل مع ثقافة وتقاليد الشعوب التي يدعونها إلى قيمهم التبشيرية. ونلاحظ في التبشير الإنجيلي بصفة عامة أن على المبشِّر بذل قصارى جهده للاقتراب أكثر من المعنيين برسالة التبشير واحترام نمط حياتهم لكسب ثقتهم واهتمامهم حتى لا يشعرون بتفوقه عليهم، حتى يبدو ذلك كما لو كان من بركات الإنجيل. ومرة أخرى، ليس من قبيل المصادفة أن تصدر إحدى الصياغات ذائعة الصيت للفهم الجديد للطبيعة بوصفها مستقلة عن أعضاء تنظيم رهباني عُرف رسميًا باسم تنظيم الرهبان المبشرين.
لم يكن ظهور هذا التوجه المزدوج الجديد غريبًا اعتبارًا للتطور الاجتماعي في تلك القرون، فقد ساعد خاصة على تنمية الأوساط الحضرية الجديدة المتحررة نسبيًا من البنى الإقطاعية للمجتمع التي طوَّرت الفضاءات الجديدة للحكم الذاتي، المدينة، النقابة، الجمعية، وبإحساس جديد بالارتباطات الجانبية التي بإمكانها أن تتجاوز حدود المحلية. وبالفعل، فإن التنظيمات الجديدة التي تكوَّنت على وجه التحديد من المبشِّرين المتجوّلين، ساهمت بقوة في توسيع دائرة هذا الشعور بالارتباط ليشمل جميع أنحاء الريف. حتى أصبحت تلك التنظيمات بمثابة القنوات التي تبث الأفكار والصور، والإحساس بالارتباطات التي توحِّد بين الأفراد حيثما كانوا. وكان الرهبان المسافرون بمعنى ما بمثابة وسائل الإعلام والاتصال التي ينتشر من خلالها المتخيّل الاجتماعي للعلاقة البينذاتية بين الناس العاديين بشكل مكثف حتى اختراع الطباعة التي ساهمت في تكثيف هذه العملية أضعافًا كثيرة، وأحدثت فيها نقلة نوعية([10]).
ولكن لفهم الأساس الاجتماعي لا يعني بالضرورة أن نُقلل من أهمية الدوافع الدينية محور اهتمامنا هنا. فالاهتمام المتزايد من جديد بالطبيعة ليس خطوة خارج الرؤية الدينية ولو جزئيًا، بل كان طفرة داخل هذه الرؤية، ومن هنا كان لا بد للنظرة الأحادية العلمانية الحديثة ألا تتمادى إلى ما لا نهاية له. وأقترح بدلًا من ذلك مقاربة عديدة الاتجاهات، حبلى بالتحوُّلات، غنية بالنتائج غير المقصودة. فاستقلالية الطبيعة في نهاية المطاف (بعد عدد متزايد من التحوُّلات التي ما زالت مستمرة إلى الآن) أسدت خدمة كبيرة لصالح النزعة الإنسانية الحصرية ولا شك في ذلك، كمن يصب القمح في المطحنة. أما أن نعتبر ذلك خطوة في هذا الاتجاه ففيه تجنٍّ ومجانبة للصواب على نحو عميق. فقد كان لهذا التحوُّل معنى مغايرًا تمامًا لما كان عليه الحال ذلك الوقت، وفي ظروف أخرى ربما ما كان له أن يتصادف مع المعنى الذي نعثر عليه لدى المؤمنين اليوم.
هناك طريقة أخرى للوصول إلى هذه النقطة التي أحاول أن أهتم بها هنا والتي تتمثل في القول بأن الاهتمام بالطبيعة في ذاتها في الدراسات العلمية، أو في الإبداع الجمالي، أو في التفكير الأخلاقي، ليس هو نفسه. ويمكن أن يكون شيئًا مختلفًا جدًا بحسب الخلفية النظرية التي تحدد كيف ينبغي أن تظهر لنا أشياء الطبيعة. تحيل الجملة الأخيرة على تصور هايدغر بل لعلي أقصده مباشرة. فقد أثار هايدغر مسألة “معنى الوجود”، وهي عادة مسألة يقل الحديث في شأنها، وكذلك الخلفية النظرية التي تتحدد وفقها الكينونات، وهي خلفية تتغير من حقبة إلى حقبة.
غني عن القول في زمننا هذا أن أشياء الطبيعة موجودات مخلوقة تُبيِّن ضمن بعض الوجه حقيقةً أنها صنيعة يد الله. وكما كان يقول هايدغر دائمًا، كانت الكينونات توصف في القرون الوسطى بشكل رئيس على أنها “حادثة”. ويبدو أنه فكَّر أساسًا في الحقبة المدرسية التي خصَّها بأول أعماله. ولكن في الواقع، كما رأينا، كان هناك أكثر من سياق لفهم هذا الوصف الرئيس. إن اعتبار الأشياء بمثابة مواضع عجائب تجلّي القدرة الإلهية يفترض أيضًا اعتبارها كمخلوقات، لكن رؤية الأشياء على هذا النحو تبدو مختلفة تمامًا عن وجهة النظر التي تدمجها ضمن الكوسموس المنظم.
أما الآن، فمن المهم بالنسبة لقصتنا أن إطار تلك الأوصاف قد تطوَّر أبعد من ذلك وفي اتجاهات مختلفة. سبق أن أشرت إلى تأثير الفن البصري في التحوُّل الجديد في تصورنا للعالم. لكن الرؤية المتصلة بالطبيعة بوصفها نظامًا منتظمًا، وبوصفها كوسموسًا موحدًا ومتماسكًا يبدو أنها أيضًا بدأت تشق طريقها كمقاربة ممكنة مع مرور الوقت. والفن الذي لا يزال يعتبر الأشياء كمواضع تتجلى فيها قوة متعالية، لا يحتاج لأن يهتم بمكانة تلك الأشياء في علاقتها بنظام متماسك. ليست المسألة في مدى تناسب الرؤوس مع الأجساد أو الشخصيات مع خلفية الصورة. أما مع فن الرسم في القرن الخامس عشر، وخاصة مع فن الرسم المنظوري، فقد أصبح بإمكاننا أن نرى الأشياء تمتد في فضاء واحد متماسك بشكل واضح([11]). هذه الطريقة الجديدة في محاكاة الطبيعة تتنزل بوضوح في سياق فهم مختلف تمامًا لما يكون الشيء ولما هو مهم في الشيئية.
تماسك الفضاء يعني وجوبًا تماسك الزمن أيضًا. ففيما مضى، كما ناقشنا في مواضع أخرى، كان مفهوم الزمن معقدًا. فكما أنه يوجد زمن علماني، زمن الوجود “الزمني” العادي حيث تحدث الأشياء على نحو متعاقب الواحد تلو الآخر وعلى نفس الوتيرة، توجد أزمنة عليا وأنماط من الأبدية. فقد كان هناك ما سمَّيته الأبدية الأفلاطونية التي تُحيل على عالم المثل (الماهيات/الجواهر) الذي لا يتغيَّر أبدًا بحيث لا تعدو أن تكون النسخ المتدفقة إلا صورًا باهتة عنها. كما كانت هناك أبدية الله، حيث يقوم الله شهيدًا على تدفق التاريخ والزمن المستمر في آنيته. وكان هناك أيضًا زمن الأصول، زمن أعلى يتعلق بالأحداث التأسيسية الأصلية يمكننا الاقتراب منه دوريًا في بعض المناسبات العظيمة.
كما تُشير إلى ذلك الجملة الأخيرة، يشهد وعي الزمن على أن هذه الأنماط العليا من الزمن تبدو كما لو كانت مغروزة في الزمن العلماني ومتداخلة مع النظام البسيط والمتماسك للزمان والفضاء العلمانيين. وعلى هذا النحو يمكن لحدثين متباعدين جدًا في الزمن العلماني أن يتقاربا كلما كان أحدهما قريبًا من زمن الأصول. من ذلك مثلًا تستحضر عشية عيد القيامة الزمن الأصلي لعيد الفصح أقرب من آخر يوم من صيف السنة الماضية على الرغم من أنه الأقرب حسب الزمن العلماني وحده. فحسب الطوبولوجيا يقترب العشاء الأخير جدًا من عيد الفصح الأصلي في مصر رغم أن دهورًا تفصل بينهما في الزمن العلماني، وهكذا دواليك.
ولكن عدم التجانس في الزمن يترتب عنه عدم تجانس في المكان. بعض الأماكن المقدَّسة مثل كنيسة أو مزار أو موقع مخصص للحج، هي الأقرب للزمن الأعلى من الأماكن العادية التي نرتادها كل يوم. ولكي نتبيّن حقيقة هذا التعقيد، أو بالأحرى لنتبين حقيقة هذا التراتب المعني هنا، يتعيَّن على المرء أن يُعطِّل الفضاء، أو ألّا يحاول أن يجعله متماسكًا، وهذا الأخير هو الخيار الذي كرَّسه التقليد الإبداعي، الذي كان له الأثر البالغ على الرسوم الجدارية في الكنيسة في عصر ما قبل النهضة.
إلا أن الخيار الأول تكرَّس عندما كان التماسك مطلب الإبداع الفني في الرسم، وهو ما تشهد عليه بعض اللوحات في العصر الباروكي الكاثوليكي كما في لوحة القيامة للرسام تينتوريتو في معهد دي سان روكو، التي تعكس ظهور شخص المسيح من قبر في منطقة الانقطاع الحاد عن بقية اللوحة حيث الحرَّاس. وفي ذلك، مثال جيّد عن الكيفية عاد من خلالها المعنى الديني العميق ذاته للظهور في صيغة مختلفة تمامًا بعدما تم الاعتراف باستقلالية للطبيعة.
هناك سلسلة أخرى من التحوّلات التي نحت تراكميًا بالوصف الرئيس للعالم على أنه “حادث” في اتجاه مختلف جذريًا، وهو الأهم بالنسبة لقصتنا. وقد شهد هذا الاتجاه بدايته مع الثورة الإسمانية ضد فكرة توماس الأكويني حول استقلالية الطبيعة المهيمنة آنذاك. ومرة أخرى، كان الدافع الأساسي لاهوتيًا. وإذا كان مفهوم أرسطو للطبيعة فيما يبدو يحدد لكل شيء كماله الطبيعي، وخيره الخاص، فأنّى لشيء ما أن يكون مستقلًا عن إرادة الله وهو الذي خلقه. فهل يا ترى أن الله اكتفى بخلق الشيء ثم تركه وشأنه من دون أن يحدد خيره؟ ألسنا نميل إلى القول بأنه لمّا كان الله الكائن الأسمى خيرًا فإنه يلزم عن ذلك ضرورة أنه لا يريد إلا الخير. أفلسنا مرغمين على أن نريد الخير (خ) لشيء ما (ش) لأن (خ) هو الخير الطبيعي لـ(ش).
فكيف إذا كان (ش) المعني هنا هو الكائن البشري. يبدو إذن، وكأن الله ليس له من بد إلا أن يريد الخير للبشر بحسب ما تسمح به طبيعتهم وقد خلقهم. ولكن هذا يبدو بالنسبة لبعض المفكّرين محاولة غير مقبولة للحد من سيادة الله. فتحديد الخير يبقى دائمًا من مشمولات الله وله مطلق الحرية في ذلك. فلا خير إلا ما أراده الله على أنه كذلك. فليس الله هو الذي يريد الخير مرغمًا (طالما أن الطبيعة هي التي تحدده). ذلك هو الدافع القوي الذي يقف وراء رفض أوكام وأتباعه “واقعية” الجواهر/الماهيات.
إننا هنا إزاء وجه آخر مهم جدًا من هذا البعد في التفكير البشري برمته. إن هذا الإطار الذي يتحدَّد في صلبه معنى الوجود على علاقة لا فقط برؤية ما للعالم، ولكن أيضًا بفهم منزلة الفاعل فيه. تشهد واقعية الجواهر على المأزق الذي يجد فيه الفاعل نفسه كلما تصوَّر الفعل قياسًا إلى مثل (جواهر) ينبغي لها أن تدرك في الأشياء أولًا. وفي مقابل ذلك، يتصل الفاعل الأسمى، حسب الإسمانية، وهو الله بالأشياء بكل حرية ليتصرّف فيها وفقًا لمقاصده المستقلة بذاتها.
لكن إذا كان هذا ما يحدث حقًا، فمعنى ذلك أننا نحن بني البشر، الفاعلين المخلوقين والتابعين، يتعيّن علينا أن نتصل بالأشياء لا عبر مُثل معيارية كامنة فيها، وإنما من خلال أسمى غايات خالقنا. ألا إن غايات الأشياء سُخّرت من أجلها خارجة عنها. تلك هي إحدى أهم السمات الأساسية للعقل الأداتي.
والآن نحن نعلم أولًا، بطبيعة الحال، أن ذلك إنما سُخّر خدمة لمقاصد الله حتى حدث تحوُّل جديد في فهم الوجود استبعدت فيه كل غاية في ذاتها ولم يعد فيه للعلة الغائية أيّ اعتبار، ولا مكان فيه إذن إلا للعلة الفاعلة دون سواها، ومن هنا جاء ما يسمى “ميكنة صورة العالم”. وهذا بدوره فتح الطريق أمام رؤية علمية للعالم يتوقف فيها صدق فرضية ما على مدى الأثر الذي تُحدثه فينا، وكانت تلك وجهة نظر بيكون Bacon تحديدًا.
وهذا معناه أننا إزاء تحوُّل جذري سيما أننا لا نزال في مجال “الحدوث”ENS creatum أي أن العالم من خلق الله. وعلاوة على ذلك، عالم منظور إليه ككل منظم. ولكن من هنا فصاعدًا لم يعد النظام معياريًا، بمعنى أن العالم يعرض تعيينات (الأكثر أو الأقل نقصانًا) من نظام مثل معيارية ينبغي أن نقتدي بها، فلقد أصبح العالم بدلًا من ذلك بمثابة ميدان شاسع تتبادل مكوناته التأثير في ما بينها حتى لكأنه صُمِّم، ضمن بعض الوجوه، من أجل تحقيق نتائج بعينها.
إنها غايات خارجية، بمعنى أننا لا يمكن أن نفهم الأشياء كما لو كانت مثلًا معيارية علينا أن نعمل وفقها. ولكننا نستطيع إدراك المقاصد إن كنا قادرين على تبيّن أن ما ينتهي إلى ميكانيكية من هذا النوع صُمِّم بإتقان من أجل تلك المقاصد. لا يوجد مثال معياري، ولكن الأشياء ستعمل بسلاسة عندما تُسخَّر من أجل تحقيق نتائج بعينها.
تك النتائج أعدّها الله. ذلك ما تعلمناه إما من الكتابات المقدسة، أو من خلال معاينة مخلوقاته. وما علينا إلا أن نسعى جاهدين لتعقب تلك المقاصد ومن ثم الالتزام بتحقيقها.
إن معنى الحياة الإلهية في هذا العالم يختلف تمامًا عمّا كان عليه الأمر في الكوسموس الأرسطي المنظم كما يقول به توماس الأكويني، أو في النظام التراتبي للعالم الذي يُنسب عادة إلى ديونيزوس، فلم تعد المسألة مسألة إعجاب بالنظام المعياري حيث تتجلّى الذات الإلهية من خلال العلامات والرموز، وإنما بالأحرى عالم يسكنه فاعلون تحكمهم عقلانية أداتيه قادرة على أن تدعم النظام على نحو فعَّال من أجل تحقيق مقاصد الله. لأنه من خلال هذه المقاصد، وليس من خلال العلامات يكشف الله عن نفسه في عالمه. وهذان الموقفان ليسا فقط متباينين بل كلاهما يفتقد للاتساق. علينا أن نتخلى عن محاولة تأوّل الكوسموس بوصفه موضع حس الله والعلامات الدالة عليه، بل وأن نرفض ذلك بوصفه وهمًا، حتى يتسنى لنا تبنّي موقف أداتي يكون أكثر نجاعة. فلا ينبغي أن يُطلب نزع السحر عن الكون فقط للرقي بمستوى إيمان العامة قياسًا لما كان عليه الحال في عالم الأرواح، وإنما أيضًا لإحداث تحوُّل مماثل في مستوى عال على صعيد الثقافة العلمية ومقايضة ذلك الكون المسحور بكون من العلامات المنظمة يكون فيه لكل شيء معنى، كون أشبه ما يكون بآلة صامتة لكنها ذات فائدة.
هكذا نتبيّن كيف يتوافق هذا التحوُّل بشكل تام مع نزع السحر ضمنيًا في علم اللاهوت في حقبة الإصلاح الديني. وليس من قبيل الصدفة أن يزدهر هذا النوع من العلوم في إنكلترا وهولندا. السمات الأساسية نفسها تتكرر هنا كما في قصة النتائج النهائية للإصلاح حيث يمكن أن نغنم منه عديدًا من الفوائد: نزع السحر، وموقف أداتي نشط تجاه العالم، وتعقب مقاصد الله. هذه هي السمات الرئيسة للنزعة الإنسانية المحضة الجديدة الناشئة آنذاك.
بيد أن هذا الجزء من قصتنا لم يكتمل بعد. ولما كان ذلك، يبدو التحوُّل من الرمزية إلى الميكانيكية، عندئذ، استجابة لمتطلب لاهوتي بالأساس. إن وجهة النظر الوحيدة التي تتفق مع سيادة الله تنتهي إلى اتخاذ موقف إنساني جديد من العالم المعياري. يقينًا ثمَّة شيء ما يدعم هذه القصة، فصلتها الوثيقة بإصرار الإصلاح على السلطة السيادية لله لا تخطئها العين. لكن مع ذلك، كانت هناك قوى أخرى تدفع نحو تحديد الفعالية البشرية بحسب نجاعتها الأداتية. وفي ذلك إعادة صياغة للنزعة الإنسانية على أساس الفعل المنظم. تجد هذه النزعة الإنسانية الجديدة جذورها العميقة في عصر النهضة حيث تلتقي بالإيمان الديني، إلا أنها تظل رغم ذلك مستقلة عنه وإن بصفة جزئية.
وهكذا تكون لدينا منذ البداية فكرة جديدة ناشئة حول ما يتعيّن علينا فعله عندما نمارس العلم. وحتى نصل إلى فهم الأشياء علينا بناء نظام تفكير. وقد طوَّر نيكولاس دي كوزا Nicholas of Cusa في القرن الخامس عشر مقاربة في هذا الاتجاه. إلا أن هذه المقاربة البنائية لم تدخل مباشرة في منافسة مع تمثل الكوسموس بوصفه نظامًا يحمل معنى. اعتمد فيشينو Ficino في البداية صيغة من بين الصيغ الأكثر تأثيرًا من الأفلاطونية لفائدة حلقته في فلورنسا، ثم ما لبث أن تبنّاها بعد ذلك.
إذ استطاع رجل أن يُراقب نظام السماوات وهي تتحرَّك، وإلى أين تمضي قدمًا ووفقًا لأيّ تدابير، وما الذي قد ينتج عن ذلك، فمَن ذا الذي يستطيع أن ينكر أن هذا الرجل يمتلك تقريبًا العبقرية نفسها التي يتمتع بها بديع السماوات؟ ومَن ذا الذي يستطيع أن ينكر أن هذا الرجل يمكن بطريقة أو بأخرى أيضًا أن يُبدع السماوات إذا توفرت له الأدوات والمواد السماوية، إنه لقادر على إبداعها منذ ذلك الحين حتى الآن وإن بمواد مختلفة، بطبيعة الحال، ولكن وفق نظام مماثل تمامًا([12]).
لقد طوَّر ليوناردو دي فنشي بعد ذلك فكرة مماثلة. فبإمكاننا العثور على الأسباب في الأشياء، ولكن يتعلق الأمر هنا بخلق ثان. وبالتالي نجد أنفسنا أمام ضربين من الخلق: واحد من خلال السبب، وهو الخلق العلمي، والثاني من خلال الخيال، وهو الخلق الفني.
لكن النظر إلى الفعالية البشرية بوصفها فعالية نشيطة وبنَّاءة، وخلّاقة، لا تقتصر على الأنشطة التي تقف عند حدود تأمل العالم على غرار العلم والفن خاصة. ولكنها بدأت تشق طريقها بثبات في مجال الأخلاق أيضًا حيث تتَّخذ صورة فهم جديد للكمال الأخلاقي ولكيفية تحقيق الحياة الطيبة. وهذا ما أود أن أنظر فيه الآن.
2
وبالقياس إلى قصتنا هذه فإن فكرة المدنية اقترنت أساسًا بعصر النهضة، ومن ثم فإن ما بلغناه اليوم من “تمدّن” سليل “مدنية” عصر النهضة بالأوج نفسه الذي كان لها عصر ذاك. ذلك ما يُميّزنا عن الأقوام المتوحشين الذين يفتقرون لما لدينا من خبرات رفيعة ومتميزة وما حصل على نمط عيشنا من تحسينات بفضل ما حققناه من إنجازات عظيمة. وهكذا يتبيّن لنا من خلال هذه المميزات حقيقة التباين الكامن بين الحياة في الغابة والحياة في المدينة.
فقد اعتبر القدماء المدينة فضاء حياة الإنسان في أفضل وأبهى صورها. وأوضح أرسطو أن البشر لا يحققون كمالهم الطبيعي إلا في البوليس (المدينة). ولفظ “مدنية” مشتق من الترجمة اللاتينية لـ”بوليس” (سيفيتاس civitas). وفي الواقع، استخدمت الاشتقاقات من اللفظ اليوناني أيضًا في علاقة بمعنى قريب جدًا منه: ففي القرن السابع عشر، تحدث الفرنسيون عن “دولة بوليسية” اعتبارًا لجملة من الأشياء تتوفر لديهم ويفتقر لها المتوحشون.
لذلك يعني هذا المصطلح فيما يعنيه نمط حكم. يتعيّن علينا أن نُحكم بطريقة منظمة تحت طائلة قوانين يُمارس بموجبها الحكَّام و”القضاة” وظائفهم. ولمّا كنا نُسقط على المتوحشين صورة “إنسان الطبيعة”، فإننا نزعم أنهم يفتقرون إلى مثل هذه الأشياء. ولكن ما كان ينقصهم فعلًا في معظم الحالات، هو ما نعتبره من مقومات الدولة الحديثة، وهو أن تكون أداة ضمان استمرار الحكم في قبضة أيدي أولئك الذين حازوا قدرًا أكبر من السلطة على المجتمع، حتى يكونوا قادرين على إعادة تشكيل ذلك المجتمع بصورة أفضل([13]). وشيئا فشيئًا تطوَّرت صورة الدولة تلك حتى أصبح مقومها ذاك أحد أهم مقومات “الدولة المدنية”.
ثالثًا، يضمن نمط الحكم الذي تفترضه المدنية قدرًا من السلم الأهلي. وإذن نمط حكم لا ينسجم مع الغلظة والعنف العشوائي وغير المشروع، أو الشجارات العامة الفظّة، سواء في الصراعات الدموية بين الشباب الأرستقراطيين أو بين عامة الناس. وبطبيعة الحال، عرفت بداية الأزمنة الحديثة الكثير من هذه المظاهر. وينبّهنا هذا إلى الفارق المهم بين منزلة “المدنية” في خطاب عصر النهضة، ومنزلة “التمدّن” في خطابنا المعاصر. وعندما تطالعنا الصحف كل صباح بأخبار عما يجري من مجازر في البوسنة أو رواندا، أو انهيار الحكومة في ليبيريا، ينتابنا شعور بأننا سلكنا طريق ما نسميه “الحضارة” بكل سلاسة، رغم الشعور ببعض الحرج الذي يلازمنا كلما هممنا بأن نصدح بذلك بصوت عال. فمن شأن بعض الشغب الناتج عن بعض الممارسات العنصرية عندنا أن يُربك سير حياتنا العادي لكن سرعان ما نستعيده.
لقد أدركت النُخب، التي كانت على بيّنة، في عصر النهضة، بأن الأمر يتعلق بمثل أعلى ينبغي تعميمه. إن هذا المثل الأعلى ليس فقط مفقودًا في الخارج، ولكن أيضًا تكاد تكون إمكانية تحقيقه في مجتمعهم معدومة. لقد كان أمام عامة الشعب طريق طويل لا يزال عليهم أن يقطعوه حتى وإن كانوا ليسوا في المستوى نفسه مع متوحشي القارة الأميركية، وأنهم أرقى بكثير من مستوى الشعوب المتوحشة في تخوم القارة الأوروبية (الإيرلنديون والروس على سبيل المثال)([14]). ويتعين على أعضاء النخب الحاكمة هي أيضًا الخضوع إلى نظام صارم مع كل جيل جديد، كقانون البندقية للتعليم العام في 1551.([15]) وهكذا ليست المدنية شيئًا يمكننا بلوغه في مرحلة معينة من التاريخ، ومن ثم الازدهار إلى أجل غير مسمى، ذلك على وجه الدقة ما نميل للاعتقاد في أنه التمدّن.
يعكس ذلك حقيقة التحوُّل الذي شهدته المجتمعات الأوروبية منذ القرن الرابع عشر تقريبًا. كما يعكس هذا المثل الأعلى الجديد (أو الذي وقع اكتشافه من جديد) نمط عيش جديدًا. لقد كان الفارق بين نمط عيش النبلاء والأعيان في إنكلترا قبل حرب الوردتين ونمط عيشهم في ظل حكم تيودرز Tudors صادمًا. فلم يعد القتال جزءًا من نمط الحياة العادية لهذه الطبقة إلا إذا كان ذلك في نطاق الحروب التي تخوضها دفاعًا عن العرش. وقد استمر ذلك على مدى أربعة قرون، إلى حدود عام 1800، حيث اعتبرت الدولة “المتمدنة” أنها هي التي تستطيع أن تضمن استمرار السلم الأهلي، وتحلّ فيها التجارة إلى حد كبير محل الحرب باعتبارها أهم نشاط يهتم به المجتمع السياسي نفسه. أو على الأقل لأنه يتقاسم المرتبة المتفوقة نفسها مع الحرب.
بيد أن هذا التغيير لم يحدث من دون مقاومة. وكان الشباب النبلاء قادرين على تفجير الفوضى، من ذلك أن المهرجانات تتأرجح على خيط رفيع بين عنف زائف وآخر حقيقي، وكان قطَّاع الطرق يملؤون الشوارع، ولم يعد الناس يأمنون حتى المتشردين الذين أصبحوا يُمثلون تهديدًا خطيرًا لحياتهم، هذا وقد اندلعت أعمال الشغب في المدن وانتفض الفلاحون في الأرياف نتيجة ظروف عيش لم تعد تُطاق ما فتئت تتكرَّر باستمرار. فكان لا بدّ للمدنية من أن تُناضل من أجل أن تفرض نفسها كبديل عن هذه الفوضى.
لقد كان واحدًا من وجوه تلك المدنية إحلال حكومة منظّمة، ولكن أيضًا كانت لها وجوه أخرى منها تطوير الفنون والعلوم، وما نسميه اليوم التكنولوجيا (وهنا مرة أخرى على غرار “التمدُّن” في أيامنا). كما تشمل تطوير القدرة على ضبط النفس عقلانيًا وأخلاقيًا. وبشكل أساسي أيضًا، تحسين الذوق وتهذيب الأخلاق وتنمية الخبرات وصقل المواهب. وباختصار، التربية السليمة والسلوك المنضبط([16]).
ولكن هذه الأشياء لا تقل أهمية عن الحكومة المنظمة وعن السلم الأهلي، لأنها ثمار الانضباط والدربة. وتكمن صورة المدنية الأساسية في أنها ثمرة تحويل حالة طبيعية في الأصل متوحشة أو طبيعة خام، عن طريق التربية والدربة إلى حالة مدنية([17]). ذلك هو السبب الكامن بالنسبة إلينا وراء نزعة أجدادنا الإثنيمركزية الصادمة. فهم لم يعتبروا الفرق بينهم وبين الهنود الحمر مثلًا على أنه فرق بين “ثقافتين”، كما نعبّر عن ذلك اليوم، وإنما كما لو كان فرقًا بين الطبيعة والثقافة. ومن ثم نحن فقط المتعلمين والمنضبطين والمتكونين بينما هم لا. النيّئ يلتقي بالمطبوخ.
من المهمّ ألا يغيب عن ذهننا أبدًا أن هذا التباين ينطوي على تناقض. وقد زعم الكثيرون أن المدنية سبب وهننا وعجزنا، وربما نعثر على الفضيلة في أتمّ معانيها على وجه التحديد في الطبيعة البكر([18]) وبالطبع، كانت هناك استثناءات مشرِّفة كمواقف بعض المفكّرين ممن اعترضوا على هذه النزعة الإثنيمركزية التامة، مثل مونتانيMontaigne ([19]). إلا أن الفهم العام لدى أولئك الذين يعتقدون في وجود تباين بين المتوحش والمروَّض، بغض النظر عن الطرف الذي يضحّون به، يعتبرون أن عملية الانتقال من حالة إلى أخرى تفترض أن تقوم هذه الحالة الأخيرة على الانضباط الصارم. وقد شبَّه ليبسيوس Lipsius هذه العملية بما يعرف بـ”مخصرة سيرس التي إن تمسّ أيًّا من البشر أو البهائم تُصبه بأذى، فإذا رُفعت في وجه أيّ كان أرهبته، لذلك فإنها تحمل الجميع رغمًا عنهم على شراستهم وجموحهم على الطاعة”([20]). وإذا كانت “مخصرة سيرس” صورة أدبية عظيمة تعطينا انطباعًا بأن العملية تبدو سهلة للوهلة الأولى فإن الجزء الأخير من هذا الشاهد يوحي بأن عملية التحويل تلك، عملية شاقة ومضنية. ومن ثم تتطلب المدنية انهماكًا في ذواتنا وفي شؤوننا الخاصة، فليس لنا أن نترك الأشياء على نحو ما هي عليه، وإنما علينا أن نُغيِّر فيها الكثير، ففي ذلك صراع من أجل إعادة تشكيل ذواتنا.
وكما بيّنت أعلاه، يعكس هذا التركيز على النضال في جزء منه تصورًا للمدنية كمثل أعلى مسيَّج، وقد كان هذا التصوُّر أكثر انتشارًا بين عامة الناس، ولا شك في ذلك، أكثر منه لدى النخب. إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحًا: لماذا كان عامة الناس معنيين أكثر بهذا التصوُّر؟ لقد كان لدى الكثير من النخب عبر التاريخ إحساس بتفوق نمط عيشهم، بل إنهم لا يتورعون في بنائه على السيطرة و/أو استغلال من هم أقل منهم حظًا حتى أنهم لا يتخيَّلون أن بإمكان هؤلاء تقاسمهم نمط عيشهم ذاك. وهذا ما كان سائدًا في المجتمعات العبودية على أن ذلك لا يعني أنه حكرًا عليها دون سواها. ولنا في الإمبراطورية الإسلامية في بداياتها خير مثال على ذلك. فلم يكن الحكَّام العرب يكترثون بدعوات التبشير بين رعاياهم المسيحيين. وكانوا يفضلون أن يعيشوا تجربة الوحي الجديد من تلقاء أنفسهم. في حين لم تحدث التغيرات ذات الثقل الشعبي إلا في فترة متأخرة تحت تأثير مبادرة الشعوب التابعة لها.
بطبيعة الحال، كان بعض الأعضاء من جماعات النخبة يميلون، في البداية، إلى اتخاذ الموقف نفسه من المدنية. إلا أن اللافت للنظر هو كيف تسارعت وتيرة الأحداث في القرن السادس عشر في أعقاب الإصلاحات، ومن ثم تكثفت محاولات إعادة تنظيم الطبقات الأقل حظًا. وعلى وجه التحديد لم تترك على ما هي عليه وإنما أرغمت تحت الضغط والتهديد على أن تنتظم من جديد بكيفية تفرض عليها التخلي عن الأساليب الفولكلورية مثل التراخي واللامبالاة والفوضى وأن تنضبط لشروط السلوك المدني. ولم يكن الأمر متعلقًا، في البداية، بالطبع، بحملها بشكل تام على الاستجابة على نحو صارم لمثل أعلى مطلق. إلا أنه لم يعد ممكنًا كذلك أن نتركها على وضعها ذاك. وفي اللحظة التي ندرك فيها نهاية هذه العملية، ندخل عالم آخر، إنه عالمنا حيث يُفترض أن يكون كل من حولنا “متحضرًا”.
لماذا هذا الموقف الاستباقي؟ يبدو الدافع معقدًا بحيث لا يمكن فك طلاسمه بسهولة من ذلك أنه بالنسبة لأيّ نخبة في أيّ مكان ينبغي على عامة الناس أن يكونوا منضبطين لأن الفوضى التي تحدث في عالمهم تهدّد النخبة. وبدا ذلك بديهيًا على نحو مخصوص، حتى أن حزمة الإصلاحات في هذا الشأن في إنكلترا سُمّيت “قوانين الفقراء”، حيث تم ضبط شروط مساعدة المعوزين بدقة، ومنع التسوّل أو تم تقييده بصرامة، وحظر التشرد، وما إلى ذلك. ويبدو أن تزايد عدد السكان إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة في القرن السادس عشر ساهم في تزايد عدد المعوزين فضلًا عن كثرة ترحالهم ونزوحهم إلى المدن الكبرى طلبًا للعون والرزق أمام انسداد الأفق في مسقط الرأس، حيث فُقد السند وعمَّت الفاقة. وقد ساهمت كثرة عدد هؤلاء المعوزين والنازحين في خلق ظروف أدت إلى إرباك النظام العام وتهديد الأمن العمومي وتفشي الجريمة والأوبئة والأمراض. ومن هنا تتنزل محاولات تشديد الرقابة على المساعدات التي تمنح للفقراء، ووقف التسوّل الهمجي ومنع النزوح في سياق التحوُّط من هذه التهديدات ولعلها لأجل ذلك تعتبر تلك التدابير مفهومة ومبررة.
بيد أن هذا الدافع سرعان ما تحوَّل من انهمام سلبي إلى انهمام إيجابي. فإصلاح المجتمع بدا وكأنه جزء أساسي من الكفاءة السياسية في إدارة شؤون الحكم باعتباره عاملًا أساسيًا لحفظ سلطة الدولة وتعزيزها. ولن يتأتى لها ذلك إلا من خلال إحداث نقلة نوعية أولًا في العمل الحكومي، بحيث يجب أن تتوسَّع مجالات تدخّله فيساعد على تحسين الأداء الاقتصادي، وثانيًا، أن هذا الأداء هو شرط أساسي لتعزيز القوة العسكرية. وهذه الأخيرة تظل المجال الحاسم لسياسة الدولة لأنها تمكِّن الحكام من مقاومة الاعتداءات الخارجية، أو توسيع سلطتهم في الداخل. إلا أن عصب الحرب يكمن في عائدات الضرائب، ولكن لا يمكن الزيادة في عائدات الضرائب في أي شيء ما لم يكن هناك نمو في الإنتاج على المدى القصير، أو ما لم تتعاظم الفوائض التي يمكن أن نغنمها من المبادلات التجارية. فلقد كان الحكام منهمكين دائمًا في ما يمكن أن نسميه مسائل التوزيع: نقص في الحبوب في العاصمة يمكن أن ينتج عنه ارتفاع في الأسعار مع ما قد يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على النظام العام. ونقص في اليد العاملة يمكن أن يرفع أجر العمل إلى مستويات قد لا يتحملها الأعيان وأرباب العمل، وقد تلتقي الفئات المعدمة القادمة من كل الجهات المفقرة طلبًا للمساعدة وتتجمع في المدن، كما أشرت إلى ذلك أعلاه مما يستدعي اتخاذ تدابير رقابية على الأسعار أو على تبادل السلع.
ولكن منذ القرن السابع عشر ومع تقدّم التكنولوجيا العسكرية، وحيث أصبحت بعض الدول تغنم عديدًا من الامتيازات بفضل نمو إنتاجها (هولندا وإنكلترا على سبيل المثال)، تركز التدخل على العرض. وبدأت الحكومات تعنى بالإنتاجية، كما تُوجِّه اهتمامها إلى اتخاذ جملة من التدابير شملت مستوى العيش والصحة والازدهار، بل حتى عادات السكان، وقد كان لتلك التدابير الأثر البالغ إن بشكل مباشر أو غير مباشر على تطوير القوة العسكرية.
ولكن هناك حكومات تحتاج لشعب كثير العدد وينعم بالصحة ومنضبط مما يساعدنا على انتقاء مقاتلين ذوي بأس شديد، وأخرى تحتاج إلى شعب منتج، قادر على أن يوفر عائدات كبيرة تساهم في تسليح ودعم أولئك المقاتلين، وأخرى تحتاج إلى شعب رصين ومتعفف وكادح للحفاظ على الإنتاج في أعلى مستوياته. فقد كانت الحكومات معنية، أكثر فأكثر، بإعادة تشكيل رعاياها بطريقة أكثر جذرية، لا فقط للحفاظ على النظام ومنع أعمال الشغب، ولكن من أجل كسب التحديات الكبرى الضرورية لتوازن القوة العسكرية في أوروبا.
لذلك كان التدخل ممزوجًا بمشاعر متناقضة من الخوف والطموح، إذ علينا مواجهة تحدٍ مزدوج: مواجهة الفوضى وتنمية القوة العسكرية، إذن نحن إزاء دافع سلبي وآخر إيجابي في الآن ذاته. لكن على ما يبدو لا يمكن اختزال كل القصة في ذلك. فثمة خوف آخر وطموح إيجابي آخر.
في البداية، كان هناك نوع آخر من الخوف الفعَّال انتشر في أوساط النخب ذاك الذي نشعر به، عبر مجاهدة النفس بانضباط صارم، عندما نرى الآخرين يفاخرون بسلوكهم الجامح. ولنا أن نتصوَّر حقيقة الإزعاج الذي يخلفه الفجور الجنسي العلني لدى أولئك الذين يسعون بكل ما أوتوا من جهد إلى كبح جماح رغباتهم في حياتهم الخاصة. إذا كان الخوف تواليًا من انتشار الجريمة والأوبئة والفوضى هو الدافع وراء إعلان قوانين الفقراء، فما الذي يُفسِّر إذن محاولات القضاء على بعض مكونات الثقافة الشعبية مثل الكرنفال والاحتفالات “الفوضوية” وأنواع مختلفة من الرقص، وما شابه ذلك؟
هنا ندرك بداهة أن الهدف لم يكن المدنية فقط، فكثيرًا ما كان الدافع وراء هذا النوع من التغيير هو المطالبات المتكررة بإصلاحات دينية. وهذا يقودنا إلى إحدى النقاط الرئيسة التي أريد أن أناقشها. وعلى الرغم من أنه يمكننا أن نميّز تمييزًا واضحًا بين أهداف المدنية وأهداف الإصلاح الديني (سواء البروتستانتي أو الكاثوليكي) نظريًا، إلا أنها قد تتطابق بسلاسة في كثير من الأحيان على صعيد الممارسة. فمحاولات ضبط الناس وإخضاعهم للنظام، تُعتبر في أغلب الأحيان تقريبًا واجبًا دينيًا يفرض على الناس الإنصات إلى خطب الوعظ التي يلقيها عليهم الرهبان المبشرون، أو تلقّي التعليم المسيحي catechism، على سبيل المثال، وأنّى يكون الأمر على خلاف ذلك في حضارة لا ينفصل فيها السلوك القويم عن الوعظ الديني؟ وفي الوقت نفسه، كانت الإصلاحات الدينية أحد مقومات النظام العام الرئيسة، ولا مفر من ذلك فيما يبدو، بما أن من بين ثمار التحوُّل الديني المفترضة حسن تدبير حياة الناس وتنظيمها، وهذا بدوره يفرض إمكانية تطابق ذلك التحوُّل مع مقتضيات نظام اجتماعي معيَّن. ومن بين المحاولات الأكثر شهرة لإصلاح الناس في القرن السادس عشر، تلك التي قام بها كل من كالفن عن كنيسة جنوة عن الشق البروتستانتي، وتشارلز بوروميو عن كنيسة ميلان عن الشق الكاثوليكي، وقد تركزت الجهود في تلك الإصلاحات على توحيد قضايا الدين والأخلاق والنظام العام. وقد كانت تدابيرها في معظمها مبالغ في تحديدها بحيث لا يستطيع المرء أن يُميِّز بدقة قضايا الدين عن قضايا النظام المدني حَسَن التدبير. فقد هاجم القديس تشارلز الكرنفال والرقص، وحاول أيضًا تنظيم وضبط الفقراء. ولا يعدو أن يكون ذلك كله سوى جزء من برنامج واحد للإصلاح.
ولكن لا يعني ذلك أن هذين البرنامجين المتمايزان نظريًا للإصلاح يتَّجهان إلى الاندماج في سياقات معينة. وأعتقد أيضًا أنهما تبادلا التأثير وأن كلاهما أثرى الآخر. لقد كان الإصلاح الديني، في صورته التي ذُكرت أعلاه، مطلبًا ملحًا، وقد بلغ أوجه في أواخر العصور الوسطى المتأخرة وبداية العصر الحديث، لا فقط بالنسبة للنخبة، ولكن أيضًا وبصفة خاصة بالنسبة لجميع المؤمنين الأوفياء إلى تعاليم الإنجيل. وقد يكون هذا المطلب وُجد قبل ذلك، ولكن ربما كدافع كامن وراء محاولات العصور الوسطى لإعادة تأصيل معاني الممارسة والإخلاص لدى الناس العاديين. غير أن هذا الأمر شهد نقلة نوعية مع إصلاحات القرن السادس عشر، حتى أن من مبادئ الإصلاح البروتستانتي إنكار أي تراتب في المواهب، فقد دعا هذا الشق الإصلاحي الجميع لأن يعيشوا تجربة إيمانهم على أتمّ وجه. وهذا يعني أنه لا يجب تجاهل حياة وممارسات الناس العاديين أو أن نتركهم على ما هُم عليه، بل كان لا بد من حض ودفع الناس أو حتى تهديدهم وحملهم بالقوة في بعض الأحيان على التخلي، على سبيل المثال، عن التبجيل المبالغ فيه للقديسين والقربان المقدَّس والرقص حول الناغط، وما إلى ذلك. وكأن هناك ديناميكية تدفع في اتجاه كوننة بعض المعايير، يمكن أن تتجلّى جزئيًا في الحاجة الملحة لإشاعة روح الإخاء والمحبة بين بني البشر، ولكن أيضًا هي التي ستجعل من فكرة أن الله سيعاقب مجتمعًا برمته على معاصي ارتكبها بعض أعضائه الضالين، فكرة حافة وملحة.
أزعم أن ذلك، في جزء منه، قد حض أو يكاد على وضع خطة لفرض متطلبات المدنية على عامة الناس. ولم يُنظر عمومًا إلى هذين الهدفين على أنهما في صراع (خارج بعض السياقات الخاصة، والتي سأذكرها)، وهو ما يُمكن أن نتوقعه اليوم بين هدف “علماني” وآخر “ديني”. فقد كانا بصفة عامة متوافقين بوصفهما جزأين من نظرة معيارية متماسكة. فلا ينبغي أن نتفاجأ، عندئذ، من أن يكون من بين معاني واجب كوننة بعض المعايير الذي تضمنه الإصلاح الديني، أثر على الإصلاح العلماني. ذلك أنه، إلى جانب هذين الضربين من الخوف المذكرين سلفًا، يبدو أن مقتضيات المدنية فُرضت في جزء منها من أجل خير الناس، ولم تكن مجرد عقلنة للنفاق (رغم أن الأمر كان كذلك في الغالب ضمن بعض الوجوه)، وإنما من باب الإحساس بالواجب.
ولكن هذا التأثير قد يذهب كذلك في الاتجاه الآخر، ذلك أن التحوُّل الديني، كما ذكرت أعلاه، ساهم، بطبيعة الحال، في حسن تدبير الحياة وتنظيمها. إذن تصبح الفوضى كما الصراع عندئذ نتائج حتَّمها ارتكاب الآثام والمعاصي. وحسب كالفن، يسعى الشخص العاصي دائمًا إلى الهيمنة على الآخرين، وفي ذلك كتب: “تكمن طبيعة الإنسان، فيما أعتقد، في نزوع كل إنسان إلى السيادة والهيمنة على جيرانه، فلا أحد يرغب بمحض إرادته أن يكون خاضعًا”([21]). ولكن على أيّ حال لا نتوقع أن يُراعي النظام الاجتماعي قدسية الشخص في عالم آثم.
وبالتالي إذا كان نموذجنا للحياة الرسولية يتطابق مع نمط عيش الرهبان في دير معزول في البرية، فإننا لا نعتقد بأن مراعاة تلك القدسية، حتى في أعلى درجاتها، ستضع بالضرورة حدًا للعنف والفوضى في العالم. ومن البديهي أن يكون الوضع مختلفًا جدًا إذا كنا نعني بذلك الحياة المسيحية، لا من حيث هي حياة تخص قلة من الطوائف، وإنما بوصفها تحتضن الجميع. ولكن رغم ذلك لا يعني هذا أن على النظام الاجتماعي أن يراعي قدسية الشخص. علينا أن نتذكر أن جميع الأطراف خلال الإصلاح، ولكن خصوصًا البروتستانت منهم، انجذبوا إلى موقف أوغسطينوس المتشدّد الذي يُفيد بأنه لا يمكن إنقاذ إلا قلة قليلة من البشر. إذن فإن النظام الذي عملت الحياة المسيحية على إرساء قواعده في صلب المجتمع لم يكن ينهض، مهما تكن درجة اتساقه، على اعتبار كل عضو منه بمرتبة قديس. كانت تلك هي وجهة نظر الطوائف الانفصالية التي ناهضها بشدة كل من لوثر وكالفن. وخلافًا لذلك كان يجب أن تتولى قلة من الرهبان زمام الأمور حتى لا ينفلت العقد.
يمكننا الآن أن نرى كيف أن هذا التبرير يجد أساسه في الاعتقاد، الذي تعرضت إليه أعلاه، بأن الله سيعاقبنا بصفة جماعية على معاصي ارتكبها بعض أبناء وطننا الضالين. ولكن رغم ذلك، من الصعب أن نتفق تمامًا مع الإيمان المسيحي حول الاعتقاد بأن قلة تقيّة ينبغي لها أن تتولى زمام الأمور حتى لا ينفلت العقد. وقد اتخذت قلة قليلة من الرهبان في العصور الوسطى موقفًا مختلفًا عن ذلك إلى حد ما([22]).
ومن ثم نجد أن بعض فروع العائلة البروتستانتية على الأقل (الكالفينية، على وجه الخصوص) تحمَّلت في هذا الاتجاه مسؤولية تفسير العالم. ومن المرجح أن جزءًا من هذا التفسير هو ذاته الذي تقول به النخب السياسية المعاصرة من أجل فرض أجندتها للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
وبعبارة أخرى، فإن حسن تدبير الحالة المدنية وحسن تدبير مجال التقوى لم يعد يجري في مقصورات منفصلة ينعدم فيها التواصل. فلقد بلغا مستوى من التواصل إلى درجة تسمح باندماجهما أو التأثير المتبادل. فقد أدت هذه الديناميكية التي عرفتها التقوى إلى تجميع المسيحيين الحقيقيين (وقد كانوا أقلية، بطبيعة الحال، ممن تم إنقاذهم، ولا تشمل من وقعت إدانتهم حتى لو كانوا إسميًا أعضاء في الكنيسة) وحفزتهم على أن يعيشوا حياة التقوى على أتمّ وجه، خطة الإصلاح الاجتماعي وأعطتها بعدًا خيريًا-كونيًا. بدورها أعطت متطلبات المدنية التي تفترض شيئًا من إعادة تنظيم المجتمع، بعدًا اجتماعيًا جديدًا لحياة التقوى ولحسن تدبير الحياة بصفة عامة.
هذا الربط السلس بين التقوى والنظام الاجتماعي يجد تعبيره في كتاب واحد من المبشرين المتجولين المصلحين في منتصف القرن السادس عشر، الراهب البولندي يان لاتشكي Jan Laski الذي يقول، في مجتمع حَسُن إصلاحه:
“ينبغي أن يكون الأمراء والقضاة أكثر سلمية، وينبغي وضع حد للحروب بين النبلاء، وردع ادعاءات الأساقفة، وأن يقوم الجميع بواجبهم أثناء دعوتهم، وتنشئة الأطفال على الانضباط المقدَّس في سن مبكرة، والتبشير بالعقيدة بإخلاص، وأن نتعاطى مع الأسرار المقدَّسة بالشكل المناسب، وضبط السكان، وتثمين الفضيلة وتأثيم الرذيلة، والحض على التوبة النصوحة من خلال تنزيل عقوبة الحرم الكنسي على كل عنيد وعاص، وألا نغفل عن ذكر الله تقدَّس جلاله والابتهال له، وأن تستعيد مؤسسة الزواج بوصفها أشرف مؤسسة على الإطلاق صورتها الأصلية. وأن تُغلق بيوت الدعارة، وأن نعتني بالفقراء فنقضي بذلك على كل مظاهر التسوُّل، وأن نزور المرضى ونواسيهم. ونُكرم دفن الأموات في جنازات مهيبة صادقة، خالية من الخرافات”([23]).
ربما بلغ هذا المشروع الشامل أَوجه في المجتمعات الكالفينية، وخاصة في أوساط البروتستانت الطهرانيين (البيروتانيون) في أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر في إنكلترا وأميركا. وأكثر ما يخشاه الطهرانيون، هو أن تعمّ الفوضى نفسها والعنف نفسه، فضلًا عن أولئك المارقين من المتشردين الذين “لا رادّ لهم”، مما يُلقي الرعب في قلوب الناس من حين لآخر. وهذا طبيعي، برأيهم، بالنسبة لشرذمة من العصاة، فأنّى لنا أن نتوقع منهم غير ذلك. ولكنهم يعتقدون أيضًا أن إصلاح الحياة بعد تغييرها هو العلاج المناسب للقضاء على هذه الفوضى. ووجهة نظرهم هذه من تبعات القدسية، كما رأينا، لا تنبع بالضرورة من وجهة نظرهم من تبعات المعصية. وقد زعم البعض أن على المسيحي الصادق إما أن ينعزل أو أن يعيش على الصدقات، وإما أن يتبنّى موقفًا مسالمًا، أو أن ينتصر للفوضوية. ولم يكن مكيافيلي Machiavelli الوحيد الذي يعتقد أن المسيحي الصادق مواطن سيّئ.
بينما يرى التصوُّر الطهراني Puritain للحياة الطيبة، على النقيض من ذلك، أن “القدّيس” دعامة لنظام اجتماعي جديد. وفي مقابل خمول وفوضى الرهبان والمتسولين والمتشردين وكسل الأثرياء، ينبغي على “القدّيس أن يشغل نفسه بمهنة شريفة ولائقة حتى لا يشعر بالخزي والهوان المصاحب للكسل”([24]). ولا يعني هذا أن عليه أن ينتقل من نشاط إلى نشاط، ولكن أن يُكرِّس نفسه لمهنة واحدة طوال حياته. وكما بيّن ذلك المبشِّر الطهراني صموئيل هيرون في قوله: “مَن ليس له عمل شريف يقضي فيه يومه، ومَن لم تكن حياته مستقرة يُكرِّس لها نفسه، لن يُرضي الله”([25]).
إن هؤلاء الأشخاص كادحون ومنضبطون ويقومون بعمل مفيد، وفوق كل ذلك يمكن الاعتماد عليهم. ولأن “حياتهم مستقرة” فإنه يمكن لكل منهم التنبؤ بما يُتنظر من الآخر على نحو متبادل. ويمكن لتوافقاتهم المتبادلة كذلك أن تكون لبنة صلبة لبناء نظام اجتماعي متين وجدير بالثقة. ينبذون الكسل لأنه أصل جميع الشرور. “فدماغ الشخص الكسول يسهل على الشيطان إغوائه بسرعة… فمن أين يأتي هذا التذمر المتصاعد من القضاة وعصيانهم في المدن؟ بطبيعة الحال ما من سبب وراء ذلك أعظم من الكسل”([26]).
بمثل هؤلاء الأشخاص، يمكن أن نبني مجتمعًا حسن التنظيم، مستقر وآمن. ولكن، بطبيعة الحال، لن يكون الجميع بقيمتهم نفسها. ومع ذلك، استطاع المشروع البروتستانتي الطهراني التعامل مع هذه الصعوبة: ينبغي أن يحكم الأتقياء، أما أولئك الذين لا فائدة تُرجى منهم فلا ينبغي لهم ذلك. ويتوجّب على القاضي، كما كان يعتقد باكستر Baxter، إرغام الجميع على “أن يتعلّموا كلمة الله، وأن يثابروا، وألا يستعجلوا… إلى أن يتهيؤوا إلى تعليم المسيحية بمحض إرادتهم وباسمهم الخاص”([27]). ولا يخرج هذا، بطبيعة الحال، في جوهره، عن النظام نفسه الذي أقامه كالفن في جنيف.
وهكذا يبدو أن الإصلاح الكالفيني قد استطاع أن يجد حلولًا مناسبة في الآن ذاته لمختلف الأزمات الاجتماعية الخطيرة والرهيبة التي كادت تعصف بالمجتمع لهذا العصر عبر ترسيخ المنهج المسيحي الأصيل. هناك قلق اجتماعي ذو طابع إنساني محض يمكن أن يكون، إضافة التعطش للخلاص والخوف من الإدانة، من الأسباب التي تجعل الشخص ينتصر لهذه العقيدة، وهذا من شأنه تجديد الإيمان وربما أيضًا وضع حدود لحالة قد تنذر بالفوضى وعدم الاستقرار. وهذا معناه أن الانتعاش الروحي وإنقاذ النظام المدني يسيران جنبًا إلى جنب.
ومن ناحية أخرى، يمكننا القول إنه بينما كانت النُخب في العصور الوسطى المتأخرة، ورجال الدين بطبيعة الحال، إضافة إلى لفيف من غير المتدينين، في تزايد مستمر، تُطوِّر مثلًا عليا للإخلاص وتُطالب بإصلاح الكنيسة، كان من بين أعضاء هذه النخب ذاتها، وفي بعض الأحيان أشخاص آخرون، وأحيانًا أخرى الأشخاص أنفسهم يسعون إلى تطوير/استعادة مثل أعلى مدني، من أجل وجود اجتماعي أكثر تنظيمًا وأقل عنفًا. لقد كان هناك بعض التوتر بين الفريقين، إلا أنهما رغم ذلك ظلا متكافلين، بل يتبادلان التأثير، لا سيما وأن مشروعيهما يتقاطعان في العديد من النقاط.
وفي هذا السياق، تقف قصة سببية معقدة وراء تطوير هذا المثل الأعلى المدني لمشروع ديناميكي إصلاحي. وقد تعزز ذلك، مع مرور الوقت، من دون شك، من خلال تزايد الطلب على الخدمة العسكرية، وتزايد العائدات الضريبية وتطوير الأداء الاقتصادي حيث أصبح الناس أكثر تعليمًا وانضباطًا وأكثر إقبالًا على العمل. لكنه كان أيضًا في جزء منه نتيجة للتكافل والتأثير المتبادل بينه وبين مشروع الإصلاح الديني، حيث أصبح يُنظر إلى “الازدهار” كواجب لذاته كما هو الشأن بالنسبة لأخلاقيات الرواقية الجديدة كما سنرى ذلك.
ومن الناحية السلبية، يتعلق الأمر في جزء منه بمحاولة لدرء أخطار حقيقية تهدِّد النظام الاجتماعي، ويتعلّق في جزء آخر منه بردّ فعل على بعض الممارسات، مثل الكرنفال، والاحتفالات “الفوضوية” وما إلى ذلك، وهي ممارسات كانت مقبولة في ما مضى، إلا أنها أصبحت مصدر إزعاج شديد لأولئك الذين يُكافحون من أجل المثل العليا الجديدة. ومرة أخرى يلعب هذا التكافل مع الإصلاح الديني دورًا مهمًا في هذا الصدد، من حيث أن هذا النوع من الحساسية المفرطة إلى حد الاستياء من شيوع الرذيلة كان السمة الغالبة للوعي الديني الصارم.
هذا ما يدل عليه العديد من الأمثلة الواضحة في مجال الأخلاق الجنسية. فقد كانت الدعارة مسموحًا بها في حقبة العصور الوسطى في أنحاء كثيرة من أوروبا، كإجراء حمائي معقول في ما يبدو للحد من جرائم الزنا والاغتصاب، رغم عواقبها الوخيمة([28]). حتى أن مجلس الكنستانس هيَّأ بيوت دعارة مؤقتة لأفواج المشاركات في هذه الممارسة التي ما فتئت تتدفق نحو المدينة. ولكن الاتجاهات الجديدة في الإخلاص تميل إلى التأكيد على أهمية الطهارة الجنسية، بدل التركيز بشكل أساسي على الآثام التي قد تنجم عن العنف والانقسام الاجتماعي. ومن ثم تغيَّر الموقف من الدعارة حتى أصبح تأييدها مشينًا، بل أكثر من ذلك مزعجًا للغاية. وبدأ يتنامى نوع من النفور-السحري من الدعارة انعكس في جهود بذلت على نطاق واسع واستمرت كذلك لتخليص النساء اللائي وقعن في هذه الرذيلة. فلم يعد ممكنًا السكوت على تفاقم مثل هذه الظواهر، وعليه كان لا بد من التدخّل.
كان من آثار ذلك، أن مواقف النُخب التي جعلت نُصب عينيها هذين المثلين الأعليين، في بدايات العصر الحديث، بدأت تتَّجه أكثر فأكثر إلى مناهضة الممارسات الشعبية لتشمل كل الطبقات. فقد تراجع تساهلهم مع يعتبرونه أساس الفوضى والعنف الجامح. وما كان مقبولًا في السابق لم يعد كذلك، بل أصبح يُنظر إليه بوصفه مشينًا. وأدَّت الدوافع المعقدة التي عملت على تحديدها، خلال القرن السادس عشر وربما امتدت إلى ما بعده، إلى إطلاق خمسة أنواع من البرامج.
-
يتعلق الأول بوضع قوانين جديدة للفقراء، كنت أشرت إليها سلفًا. وقد ساهمت تلك القوانين في إحداث منعطف حاسم حيث تم القطع تمامًا ما كان سائدًا من قبل. وأحيط الفقر في العصور الوسطى بهالة من القداسة، لا لأن المجتمع القائم على الطبقية لا يحتقر المعوزين والضعفاء ممن هم في أسفل السلم الاجتماعي، لكن تحديدًا لأن مساعدة الفقير توفر فرصة لممارسة شعائر التقديس. فحسب خطاب متّى Matthew الخامس والعشرين، مَن أغاث فقيرًا كأنما أغاث المسيح نفسه. ومن ثم يعدّ توزيع المساعدات على الفقراء بمثابة الكفارة التي يقدم عليها المتنفذين والأغنياء عبر العالم عسى أن تُغفر خطاياهم وسيئاتهم. وقد كان الملوك والرهبان في الأديرة والبورجوازيون الأغنياء يفعلون ذلك أيضًا. وكان الميسورون من الناس يوصون بعد مماتهم بجزء من ممتلكاتهم كصدقات توزَّع على عدد معين من الفقراء المعدمين في جنازاتهم مقابل الدعاء لهم بالمغفرة. وذلك خلافًا لما يرويه الإنجيل، عن دعاء أليعازر، الذي تردد صداه في أرجاء السماء، بأن يعجَّل بارتمائه في حضن إبراهيم([29]).
ولكن في القرن الخامس عشر، حدث تغيير جذري في المواقف نظرًا لتزايد عدد السكان خاصة، وقلة المحاصيل، وما ترتب على ذلك من تدفّق للمعوزين نحو المدن، حيث اعتمدت لائحة جديدة من قوانين الفقراء تقوم أساسًا على التمييز الصارم بين أولئك القادرين على العمل وأولئك الذين لا خيار أمامهم سوى الصدقة. وكان على الفئة الأولى إما العمل، وغالبًا في ظروف قاسية مقابل أجور زهيدة جدًا، أو الطرد. أما الفئة الثانية التي تستحق المساعدة فإنها بدورها تعاني من ظروف رقابية شديدة، وكثيرًا ما ينتهي بها الأمر بحجزها في مؤسسات أشبه ما تكون بالسجون ضمن بعض الوجوه. كما بذلت جهود لإعادة تأهيل الأطفال المتسوّلين لتعليمهم حرفًا حتى يكونوا أعضاء فاعلين وكادحين في المجتمع([30]).
وقد يترتب على كل هذه العمليات جملة من المزايا كتوفير العمل وتوزيع المساعدات والدربة والتأهيل، الاحتجاز، سواء كتدبير اقتصادي أو كتدبير رقابي. ودشَّن ذلك عصر ما يمكن تسميته حسب ميشيل فوكو “الاحتجاز الكبير”، الذي شمل فئات أخرى من فاقدي السند، وأشهرها المجانين([31]).
ومهما كانت الدوافع، فمن الواضح الآن أن هناك تحولًا عميقًا في الموقف وفي السجل الذي يمكن أن نستوعب فيه الفقر برمته. ففي العصور الوسطى، كما يشير إلى ذلك جيريميك Geremek كان الفقر الطوعي الطريق الملكي إلى القداسة([32])، في حين لم يكن يُنظر للفقراء غير الطوعيين، بصفة عامة، على أنهم قديسين، وبدل أن يتحمل هؤلاء حظهم العاثر بما يلزم من الصبر، فإنهم يشعرون بالحقد وقد يلجؤون إلى الجريمة. لكن مع ذلك، كان الفقير يوفر للأغنياء فرصة لممارسة شعائر التقديس. فمن يغث فقيرًا كأنما أغاث المسيح. أما الموقف الجديد فقد نحَّى جانبًا هذه الفكرة ونظر إلى الفقير في سجل مختلف جذريًا وهو موقف مزدوج في الحقيقة، ذلك أنه يفترض، من جهة، أن يتم التحقق عما إذا كان يستحق المساعدة أم أن عليه أن يكدح من أجل سد حاجاته بنفسه؟ ومن جهة أخرى أن يتم تقييم التعامل معه بعقلانية أداتية. ومن ثم وقع الاهتمام بالفقراء بشكل كبير من أجل الاستفادة أكثر من أموالهم (بحسب العمليات الأوروبية). ففي القرن السابع عشر في إنكلترا انتشر العمل في المنازل كنمط إنتاج يساهم في توفير حاجيات الاقتصاد. وقد استطاعت حياكة الصوف أن تُخرج الصناعة آنذاك من عنق الزجاجة. وبذلك استطاع العمال في المنازل توفير ما يلزمهم من المال لسد رمقهم إضافة إلى المساهمة في إنقاذ المجتمع. وقد تمت إعادة التأهيل بالصرامة الأداتية نفسها. أما في أمستردام، فكان الكسالى عادة ما يوضعون في مسابح Rasphuis حيث يصعد الماء ببطء على قدر كسلهم من دون أن يُمنحوا فترات استراحة مطوَّلة لتلقف الأنفاس، وبلا شفقة ولا رحمة([33]).
كان الموقف الطهراني المتطرّف أشد قسوة من ذلك حيث يُنظر إلى المتسوِّل نظرة دونية. فالمتسولون حسب، بيركنز Perkins، “هم بمثابة الساقين أو الذراعين الفاسدين اللذين ينبغي تخليص الجسم منهما”([34]). فلا مكان للمتسولين في المجتمعات حسنة التنظيم حيث تكون تنمية الثروة عملًا مشتركًا.
لقي هذا التحول الجذري في التوجه مقاومة. ففي البلدان الكاثوليكية عارض لفيف من رجال الدين، بناءً على اعتبارات مذهبية، هذا التوجه ولا سيما الأوامر المنظمة للتسوُّل. وفي إسبانيا، البلد الأكثر “تخلفًا” آنداك، أوقفت الإصلاحات في مجال التنمية الاقتصادية تمامًا([35]). فقد كانت هناك قطيعة تكاد تكون تامة مع الموقف اللاهوتي من الفقر في القرون الوسطى. ولكن ذلك لم يكن كافيًا في جزء كبير من أوروبا الكاثوليكية لوقف تقدّم هذا النهج الجديد، فقد بدأ العمل به فعليًا في باريس، فيما برز بشكل واضح في البرنامج الإصلاحي الذي أعلن عنه تشارلز بوروميو في ميلان.
ولم يكن المصدر الثاني للمعارضة قادرًا بدوره على وقف هذا التغيير، لأنه نابع من الشعب نفسه الذي اعتاد أن ينتفض كلما تم سحب فقير إلى الخارج، أو حتى حمايته أو إخفائه.
-
كثيرًا ما هاجمت الحكومة القومية والحكومات المحلية، والسلطات الكنسية، أو بعض المؤسسات التي تجمع بينها، بشدة بعض مقومات الثقافة الشعبية: الألحان والأغاني التهكمية الصاخبة، والكرنفال، والاحتفالات “الفوضوية”، والرقص في الكنيسة. وهكذا نجد أنفسنا إزاء نكوص آخر. فما كان من تلك الأشياء عاديًا في ما مضى وكان الناس يستعدون للمشاركة فيه بشغف، أصبح منذ ذلك الحين فصاعدًا، مدانًا لما فيه من إرباك شديد للنظام العام، وبالتالي مثيرًا للإزعاج بمعنى من المعاني.
أدان أراسموس Erasmus كرنفالًا حضره في سيينا في 1509 بأنه “ليس مسيحيًا”، وذلك لسببين: أولًا، لأنه يحتوي على “آثار الوثنية القديمة”. وثانيًا، لأن “الناس أطلقوا العنان لشهواتهم إلى درجة الفجور”([36]) وهاجم الإليزابيثي الطهراني، فيليب ستبّز Stubbes “الفجور المفزع أثناء الرقص الماجن لما فيه من خطر على المجتمع”، لأنه ينتهي إلى “ممارسات قذرة ونجسة “ومن ثم “فتح الباب على مصراعيه أمام الزنا والعهر والنجاسة، وسبيلًا لجميع أنواع الفجور”([37]).
وكما يُشير إلى ذلك بورك Burke، كان رجال الكنيسة ينتقدون هذه المظاهر من الثقافة الشعبية لقرون عديدة([38]). أمّا ما هو جديد فهو (أ) تكثيف الهجوم الديني، بسبب مخاوف جديدة من إمكانية تراجع منزلة المقدس. و(ب) أن ينتهي المثل الأعلى المدني، وقواعده المتعلقة بالنظام واللياقة والتهذيب إلى اغتراب الطبقات الحاكمة إزاء تلك الممارسات.
وقد تؤدي المدنية في حد ذاتها إلى ما يسميه بورك “انسحاب الطبقات العليا” من الثقافة الشعبية.
في 1500(…) كانت الثقافة الشعبية ثقافة الجميع. وفي حين كانت الثقافة الثانية بالنسبة للمثقفين، فإنها كانت الثقافة الوحيدة بالنسبة لغيرهم. بيد أنه بحلول عام 1800، وفي معظم أنحاء أوروبا، تخلّى رجال الدين والنبلاء والتجَّار ورجال الأعمال والحرفيون، وزوجاتهم عن الثقافة الشعبية لفائدة الطبقات الدنيا، حتى انتهى بهم الأمر إلى هجرها تمامًا، وهو ما لم يحدث من قبل، بسبب اختلافات في النظرة للعالم([39]).
تعني المدنية في القرن السادس عشر أن:
النبلاء كانوا يتبنون أخلاقًا أكثر “تهذيبًا”، أي سلوكًا جديدًا وأكثر وعيًا، مستمدًا من كتب البلاط وأشهرها كتاب أحد أهم مؤلفي البلاط كاستليوني Castiglione. كما كان النبلاء يتدرَّبون على ممارسة ضبط النفس، وحذق نوع من اللامبالاة المدروسة، والتصرف بلباقة، والتحرك بأناقة على غرار تناسق الحركات في الرقصات الرسمية. وقد تضاعفت الأطروحات حول الرقص أيضًا على أن الرقص في البلاط يختلف عن الرقص في المزارع. وتوقف النبلاء على تناول طعامهم مع الخدم في قاعات فسيحة ومفتوحة وانسحبوا إلى غرف منفصلة (ناهيك عن “الغرف الخاصة”، التي هي بدورها “غرف معزولة”). ثم أنهم توقفوا عن المصارعة مع الفلاحين كما كانوا يفعلون في لومبارديه Lombardy، وتوقفوا عن قتل الثيران في الساحات العامة، كما كانوا يفعلون في إسبانيا. وتعلَّم النبيل التحدث والكتابة “بشكل صحيح” وفقًا للقواعد الرسمية وتجنب المصطلحات التقنية والكلمات الدارجة المستخدمة في لهجة الحرفيين والفلاحين([40]).
إن المثل الأعلى المدني كافٍ بذاته لإحداث هذا الانسحاب. وفي القرن الثامن عشر نأى المثل الأعلى المدني بنفسه عن التقوى التقليدية المشحونة “حماسًا” مبالغًا فيه، إلا أنه يلتقي رغم ذلك مع الإصلاح الديني في محاولاتهما قمع ثقافة الشعب وإعادة تشكيلها. ويمكن أن نذكر هنا على وجه الخصوص محاولات ماكسيميليان دي بافاريا Maximilian of Bavaria، حيث نهى برنامجه في الإصلاح في أوائل القرن السابع عشر عن عديد من الأشياء من بينها خاصة السحر، والتنكّر، والفساتين القصيرة، والاستحمام المختلط، والكهانة، والإفراط في تناول الطعام والشراب، واللغة “المخزية” في حفلات الزفاف([41]).
-
خلال القرن السابع عشر، أصبح هذان النوعان الأوّليان من الممارسات يندرجان تحت نوع ثالث: فقد بدأت تتنامى محاولات، من قبل هياكل حكومية مطلقة النفوذ والتوجيه، في فرنسا وأوروبا الوسطى، لتشكيل رفاه رعاياها من خلال المراسيم الاقتصادية والتعليمية والروحية والمادية، لا فقط خدمة مصالح السلطة، ولكن أيضًا من أجل توفير أسباب التقدم. وتجدر الإشارة إلى أن المثل الأعلى الذي آلت إليه الدولة المدنية “Polizeistaat”([42]) في ألمانيا في فترة ما بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر أعطى زخمًا لهذا النشاط التوجيهي بسبب ما آل إليه الوضع في أعقاب الإصلاح، حيث أُسديت التعليمات لجميع حكام الأقاليم بمراقبة ومتابعة إعادة تنظيم الكنيسة (في المناطق البروتستانتية) وفرض الامتثالية (في جميع الأقاليم). ولكن محاولات التحكم هذه توسعت أكثر في القرن الذي تلاه، لتشمل مراقبة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأخلاقية. وقد شملت هذه المحاولات في جزء منها المجال نفسه الذي درسناه في (1) و(2)، تنظيم توزيع المساعدات على الفقراء، وقمع بعض المهرجانات والممارسات التقليدية([43]). بيد أن هذه المحاولات تفرَّعت في القرن السادس عشر لتشمل الاهتمام بالتعليم، وتنمية الإنتاجية، وتأصيل قيم العقلانية في نفوس الرعايا حتى يُقبلوا أكثر على العمل والإنتاج بكل جدية ومثابرة وعزم. ينبغي على المجتمع أن يكون منضبطًا، بحيث يكون الانضباط أصيلًا فيه ونابعًا منه([44]).
باختصار، يعني هذا فرض بعض ميزات المثل الأعلى للتمدن على أكثر ما يمكن من الفئات الشعبية. مما لا شك فيه، يتمثل الدافع المهم الذي يقف وراء ذلك في خلق أناس على شاكلة جنود مطيعين وناجعين مع ضمان توفير الموارد اللازمة لاستخلاص جراياتهم وتسليحهم. ولكن العديد من هذه المراسيم يفترض أن يكون التقدم (كما يرونها) غاية في حد ذاته. وكلما تقدَّمنا أكثر في القرن الثامن عشر، كلما اندمجت التشريعات أكثر فأكثر مع أفكار التنوير، مع الحرص المتزايد على الإنتاجية والجوانب المادية في النشاط البشري، باسم الفوائد التي ستعود على الأفراد وعلى المجتمع ككل([45]).
-
ما جعل هذه الإصلاحات الاجتماعية ممكنة هو تطوير هياكل حكم فعَّالة متشبعة بروح الاستقامة والانضباط. وقد تكون محلية وأكثر طوعية، كما هو الحال في البلدان المنخفضة، أو أنها قد تتخذ أشكالًا بيروقراطية أكثر عقلانية في الدولة المركزية. وربما عرف هذا الشكل الأخير صيغته الأكثر إثارة في بروسيا التي تمكنت منذ أواخر القرن السابع عشر من فرض نفسها كقوة بين القوى الكبرى في أوروبا، رغم أن قاعدة سكانها وثرواتها كانت أقل بكثير من مجموعة الدول الأخرى التي تُكوِّن تلك العُصبة.
وما جعل هذه الهياكل ممكنة أيضًا، هو مزيج من الانضباط والتفاني سمح لبروسيا، على سبيل المثال، بتوفير المزيد من المداخيل، وانتداب وتدريب المزيد من الجنود رغم قلة عدد سكانها وندرة ثرواتها قياسًا لكل منافساتها من القوى الأخرى. وقد بيّن فيليب غورسكي Philip Gorski بطريقة مقنعة أن منابع هذا الأداء الاستثنائي تكمن في جزء منها في فلسفة الرواقيين الجدد التي شاعت في أوساط النخب، ولكن أيضًا في الكالفينية أو في السلالة التقيّة من الحكام وكبار الشخصيات السياسية. وقد مثلت ديناميكية الإصلاح هذه عاملًا رئيسًا في هذه القصة الاستثنائية([46]).
-
يمكن أن ننظر في هذا التطور في كافة وجوهه من زاوية أخرى، آخذين بعين الاعتبار تكاثر أنماط الانضباط، و”المناهج”، والإجراءات. بعضها نشأ في الفضاء الفردي مثل أساليب ضبط النفس والتطور الفكري أو الروحي، وبعضها حظي بتأييد جماعي كما هو الشأن بالنسبة للنخب السياسية في هولندا وبروسيا، وبعضها الآخر ترسَّخ وفرض نفسه في سياق تحكم تراتبي. وفي هذا السياق لاحظ فوكو أن برامج التدريب القائم على تشريح دقيق للحركة الجسدية، وتقسيمها إلى أجزاء ثم إيجاد نمط تدريب موحد لجميع الناس، تضاعفت في القرن السادس عشر. ويعتبر المجال المميز لهذا التدريب، بطبيعة الحال، القوات العسكرية حيث يتم في كل مرة إبداع أنماط جديدة للتدريب، ومن ثم يتم تطبيق بعض تلك المبادئ لاحقًا في المدارس، والمستشفيات، والمصانع([47]).
من بين البرامج المنهجية التي تهدف إلى تغيير الذات، تعد تدريبات لويولا Loyolaالروحية أكثرها شهرة، فقد بدأ التأمل يتَّجه رأسًا صوب التغيير الروحي. ولكن هاتين الفكرتين الرئيستين، التأمل الذي يخضع لمنهج، ستظهران خلال القرن اللاحق في البرنامج الذي اقترحه ديكارت (ناهيك أن الرجل في نهاية المطاف تلقى تعليمه على يد اليسوعيين في لافلاش La flèche).
3
لقد كانت فكرة ترويض الطبيعة الأولية للأشياء، فكرة حاسمة، لأنها تُبيِّن لنا أن صورة المثل الأعلى للمدنية تستحثنا على تبني موقف، يمكن أن نسميه بإعادة تشكيل ذواتنا، هذا التصوُّر الذي أخذ صورته داخل أساليب وبرامج “تشكيل الذات”([48]) على النحو الذي تعرضنا إليه سابقًا في المجموعة الخامسة (5) بصفة خاصة. ذلك أننا نتعامل مع طبيعتنا الأولية كمادة خام يجب التحكم فيها وينبغي إعادة تشكيلها أو طرحها أو التغافل عنها أحيانًا من أجل إخضاع حياتنا إلى نموذج أسمى، وبالفعل تقترب هذه الفكرة من تلك التصورات الأخلاقية التي نعثر عليها في المسيحية القديمة. فالأمر يتعلق دائمًا بطريقة معينة في التحكم والمراقبة أو بمسألة القضاء على أسس الأشياء باسم شيء مثالي ونموذجي. لكن هذا المنظور الجديد يتَّضح من خلال نظريات أخرى، أي من خلال التركيز الذي نوليه للإرادة ولعملية فرض صورة على مادة أولية غير متشكلة، وغير فاعلة وغير مقاومة.
وبالفعل، دعت أهم النظريات الأخلاقية الكبرى القديمة، الأفلاطونية والأرسطية والرواقية، إلى إخضاع الرغبات والانفعالات الحقيرة وحتى إلى القضاء عليها كما هو الشأن مع الرواقيين – (فهؤلاء يعتبرون الانفعال رأي خاطئ لا ينتمي إلى روح الحكيم). ذلك أن الصورة المهيمنة للفضيلة هي تلك التي تتعلق بتناغم الروح وانسجامها. لقد كانت الفكرة المحورية متمثلة في تلك الصورة المتحققة أصلًا في الطبيعة البشرية والتي ستساعد الإنسان الفاضل على إظهارها، تلك الصورة التي لم تكن أبدًا نموذجًا يقع فرضه من الخارج. إن صورة تحويل المادة، وصورة النموذج الذي يقع فرضه، والتي نجدها في صلب الفعالية الإنتاجية الإنسانية المتحققة، لم تكن تحتل مكانة أساسية في الأخلاق. لأن البويزيس poiesis والبراكسيس Praxis كانا متنافرين تمامًا، ومثلما لاحظنا ذلك في العديد من المرات، فإن تلك الأخلاق لم تعطِ قيمة لما يسمى بالإرادة، على النحو الذي سيمنحه لها زمن الحداثة.
ويتنزل هذا، بالنسبة إلينا، ضمن بعدين، إذ نميِّز بين الإرادة الخيّرة والإرادة الشريرة، وأحيانًا بين إرادة قوية وإرادة ضعيفة. أما التباين الأول فمصدره المسيحية، ونحن، في الغرب، مدينون في ذلك إلى صياغته الأكثر شهرة إلى أوغسطينوس وتتضمن فكرتين تترجمان المحبة، وهما الخيرية والشهوة الجنسية. في حين يتعلق التباين الثاني بالمحور الرئيس الذي طبع المناخ الجديد للفكر الحديث. فالفضيلة تستدعي إرادة قوية يكون بمستطاعها فرض الخير ضد قوى أخرى مقاومة. ولما أصبحت الإرادة مفهومًا مركزيًا، فإننا بذلك لم نبتعد فقط عن القدامى، بل حوّلنا محور هذا المفهوم بفصله عن الخط الرئيس الذي نزّله فيه الفكر المسيحي.
إن هذا الدور الحاسم للإرادة لم يتبلور بوضوح في التصور الحديث، كما أن المفاهيم القديمة للانسجام لم تكن غائبة تمامًا، مثلما سنرى ذلك في ما سيأتي مع الرواقية الجديدة. ولكن مهما يكن من أمر، فإن التحوُّل حدث لا محالة.
وأعتقد أن مسألة إدراج وجهة نظر البويزيس ضمن مجال البراكسيس ارتبطت بجملة التحولات التي ذكرتها في المقطع السابق. فحسب كوسانوس Cusanus وفيشينو Ficino وليوناردو Leonardo ما كان للعلم أن يكون لولا فعاليتنا البناءة وبفضل تطور العلوم الطبيعية، أو ما سمَّاه شيلر Scheler “فعالية المعرفة” Leistungswissen حيث تتأكد حقيقة العلم عبر نجاعته الأداتية. لكن توجد، بطبيعة الحال، أسباب لاهوتية تفسر ذلك التحوُّل، كنت أشرت إليها أعلاه، وبأثر رجعي، كانت للعلم الجديد هو أيضًا نجاحاته. (ولكن بطبيعة الحال لم يكن ذلك بصفة مباشرة بحسب مقتضيات النجاعة الأداتية). ولنا أن نلاحظ أيضًا أن مجموعة فائقة من المفاهيم الأساسية حول الحياة الطيبة كان لها دور ريادي في هذا الصدد. إذن ثمة نمطين من الشاعرية دعم كل منهما الآخر على نحو متبادل، الموقف الأخلاقي البنائي والتصوُّر الأداتي وليس الفهم التأملي للعلم.
إن هذا التحوُّل التاريخي في تمثل الطبيعة وموقفنا منها، سواء كنا على وعي به أم لا، هو ثمرة العديد من التغيّرات المستقلة من دون أن تكون عاملًا حاسمًا. فمن الواضح أن فكرة سلطة الله العليا اللامحدودة كانت لها مساهمة فعالة في تقويض التصور القديم للكون كتعيّن للصورة، وهذا ما كان يقول به الاسميون وبعض روَّاد العلم الجديد في القرن السابع عشر لاحقًا. ومن بينهم خاصة ديكارت ومارسان Mersenne. فلما كان الله يتمتع بقدرة مطلقة على الخلق، ولما كان معنى ذلك أنه لا يشترك مع الأشياء في أيّ من خواصها باعتباره خالقها، فإنه يجب أن يُنظر إلى الواقع على أنه مادة خاضعة لتدبير الله ومشيئته بشكل مطلق، وهذا ما يتوافق أكثر مع التصوُّر الميكانيكي للطبيعة الذي قطع نهائيًا مع فكرة الغائية الكامنة في الأشياء ذاتها.
ولكن إذا كانت تلك هي طبيعة الأشياء، فإن لها إذن، آثارها على موقفنا من العالم أيضًا. فالأمر لا يتعلق فقط بتغيير النموذج العلمي عبر الكف عن البحث عن نموذج يضاهي النموذج الأرسطي والأفلاطوني، بل يجب التركيز على العلاقات التي تحددها السببية (العليّة) الفاعلة في عالم الأشياء، فاكتشاف الكون الخاضع لتدبير الله ومشيئته يدعونا إلى تطوير فعالية العلم أو تطوير علم أكثر قدرة على التحكم. وفي ذلك استباق لحلم ديكارت الذي صاغه في عبارته ذائعة الصيت “أن نكون مالكين للطبيعة وأسيادًا عليها”([49]) وهو ما سيجعلنا أقرب إلى الله، فنخضع لإرادته، ونستعمل الأشياء كما قدّر لها أن تكون.
إنه لمن المغري إذن أن نجد هنا مفتاح التطور التاريخي الذي أدى إلى التحوُّل من البحث عن مكانتنا في الكوسموس إلى بناء نظام في صلب الكون ذاته، بحيث يتعلق الأمر بصيغة جديدة من الخضوع إلى الله أو بنوع من رد الفعل على قدرته الحاضرة في كل شيء، بحيث أفقدتنا أيّ مكانة في هذا الكون حتى حطمت فينا شعورنا القديم بأن لنا مكانة شرعية في الكوسموس المنظم. وبالفعل تتضمن هذا الفرضية الأخيرة “تفعالية” قوامها “إثبات الذات”، كان بلومنبارغ Blumenberg على ما يبدو يتبنَّاها([50]).
ومع ذلك يبدو أن إرادة إعادة البناء هذه تنهل من منابع أخرى، كما تنبع أيضًا من دوافع أقل تفعالية. فلم تنتظر إعادة البناء تدمير التصور القديم للكون. فقد تنامت فكرة تقول بأن الكائنات البشرية التي يجب أن تتعاون في ما بينها في عملية التشكيل مدعوة لاستكمالها، وهي فكرة نجدها أيضًا حتى في التصور الأفلاطوني الذي يعتبر أن العالم متشكل حسب المثال. وفي هذا الاتجاه منح عصر النهضة دورًا مهمًا للفنان. لقد عبَّر مارسيلو فيشينو Marsilio Ficino عن هذه الفكرة قائلًا “يُحاكي الإنسان كل أعمال الطبيعة الإلهية، بينما يسعى لأن يرقى بأعمال الطبيعة الدنيا إلى مرتبة الكمال عبر تقويمها وتطويرها”، حتى أن مايكل-أنجلو Michelangeloنفسه كرَّس عمله الفني في هذا الاتجاه، واعتبر ليوناردو Leonardo أنه إذا كان على الفنان أن يخضع إلى “ragioni” الأسباب التي توجد في الطبيعة، فإنه ينبغي أن يظهرها للعيان بشكل كامل بواسطة فعاليته العقلانية والبناءة. إن التجربة في حاجة إلى العقل، ومعلم وصيّ على الطبيعة وإذن، فالفنان نفسه “يخلق” بطريقته الخاصة، فهو لا يحاكي الطبيعة محاكاة عمياء بل هو ينافسها كما ذهب إلى ذلك بيكو Pico([51]).
وبطريقة مماثلة، منذ فجر الثورة العلمية الحديثة، أجمع علماء النهضة “السحرة” أمثال جون دي، وبرونو، وروبير فلود، ولفيف من علماء الكيمياء، حول أولوية المثال، بل حتى إنهم اعتقدوا في أن الطبيعة تسكنها الروح، وقد كانت لهم أجندتهم للتطوير والتغيير. فبفضل اكتشاف الأحجار الفلسفية تسنى لنا استخراج الذهب ولكن أيضًا استطعنا أن نرقى بالحياة الإنسانية إلى أسمى درجات الكمال([52]).
غنيّ عن التذكير، طبعًا، أن الأنماط غير الميكانيكية ذات الطابع الشاعري، لم تنجح في أن تكون أنماطًا مستقبلية لأنه سرعان ما حلّ محلها التصور الغاليلي-البيكوني. لكنها رغم ذلك عادت لاحقًا في صيغة أخرى مختلفة تمامًا من قبل جيل الرومانسية. لكن شأنها شأن ظواهر أخرى عديدة لم تكن كافية لبيان أن ما قاد فعلًا إلى إعادة البناء لا ينفصل عن التحوُّل إلى الميكانيكية، أو كانت له علاقة بالضرورة مع الثورة على القدرة الإلهية المطلقة.
فإذا كانت هذه الشاعرية ذات الوجوه المتعددة لها مكانة محورية في المدنية بوصفها مثلًا أعلى، فلنا أن نتخيَّل مدى الأهمية التي يمكن أن يحظى بها الموقف الداعي إلى إعادة البناء حينما نطبِّق ممارسة إعادة تشكيل الذات على المجتمع ككل، أو عندما تُهندس الدولة الوليدة الممارسات الاجتماعية والأخلاقية.
ومن أجل الوقوف عند حقيقة هذا التحوُّل الذي أتحدث عنه، أريد أن أنظر في موقف جوستوس ليبسيوس أحد أهم الرواقيين الجدد وأكثرهم تأثيرًا في القرن السادس عشر، وهو شخصية رئيسة في قصتي، لا لأنه صاغ نظرية في الأخلاق حول الاهتمام الجديد المتمثل في مجال إعادة البناء، ولكن لأنه كأن من الأوائل الذين بيَّنوا كيفية تطبيق هذا المبدأ في المجال السياسي والعسكري.
لقد أنشأ ليبسيوس (نوعًا من) رواقية مسيحية حذت حذو مذهب الرواقيين. رغم ما يوجد من اختلافات جوهرية على الصعيد الإيتيقي بين المسيحية والرواقية: (أ) فيما تعتبر المسيحية أننا في حاجة إلى نعمة الله لأنها وحدها القادرة على تحرير الإرادة الخيّرة الموجودة فينا بالقوة، تعتقد الرواقية في قدرة العقل وحده وفي ضبط النفس. (ب) وفي حين ترى المسيحية أن الإرادة الخيّرة تدرك كمالها الأفضل فينا وفي الحب الإلهي وفي محبة جيراننا. تعتبر الرواقية أن الحكيم هو الذي يبلغ الأباثيا apatheia، أي غياب الشغف أو العاطفة الشديدة. ولا يعني ذلك بالضرورة أن هناك تنافرًا بين هذين الأمرين: إذ يمكن أن نتصوَّر الحب الإلهي على أنه حالة خلوة من أيّ عاطفة تمكن من بلوغ حالة من الخيرية ليست في المتناول. إلا أن اللاهوت المسيحي يرفض هذه القراءة الرواقية حجته في ذلك ما جاء في الكتاب المقدَّس حيث صُوِّر المسيح في الإنجيل ربًّا “أحشاؤه” تتحرَّك رحمة وشفقة وشغفًا بالناس، ويشهد بكاؤه فوق الصليب على أنه لم يكن قط مفتقدًا للعاطفة والشغف (لم يكن المسيح أباثيًّا). وهذا ما مثّل صعوبة قصوى بالنسبة للاهوت المسيحي في القرون الأولى وذلك تحديدًا بسبب فكرة سادت لدى الإغريق عن إله يفتقد للعاطفة والشغف (أي إله أباثيّ)، وقد مثَّل فشل المسيح الصريح في الاستجابة لهذا المعيار حجة لصالح الأريانية([53]).
وهذا عينه ما تبنَّاه ليبسيوس. فقد رفض الشفقة أو الرحمة، شفقة التعاطف لصالح شفقة التدخل الفعلي. على أن هذا الفرق الدقيق لم يكن خافيًا عن علماء اللاهوت في ذلك العصر، ولكن طرحت الجمل التي ورد فيها انتقاد للشفقة من الترجمة الإسبانية للكونستانتيا، رسالة في الثبات([54]) De Constantia.
أما في ما يتعلق بالمسألة الأخرى، فقد لزمت الرواقية الجديدة الصمت بشأن الحاجة إلى النعمة، ولأننا لم نُدرك بعد النزعة الإنسانية الحصرية، فما زال الله، بالنسبة للنموذج الكلاسيكي، هو سيِّد الموقف ودوره أساسي في حياتنا، فهو المصدر الذي ينشأ عنه جزء كبير من تدبيرها. وبالفعل “ينزل العقل إلينا من السماء، من الله ذاته، وقد هلل سينيكا Seneca به كما لو كان جزءًا من الروح الإلهية المتجذر ة في الإنسان” حتى كأن “الله ذاته، يُقرِّبنا بذلك من صورته أو بالأحرى يحلّ فينا”([55]).
لقد صيغت الفكرة الرواقية هنا اعتمادًا على مصطلح صورة الله في الكتاب المقدَّس. ولقد شدد ليبسيوس كذلك على أهمية مذهب آخر يجمع بين الرواقية والمسيحية: مذهب العناية الإلهية. فكل ما يحدث في العالم يصدر عن العناية الإلهية. وإن كل ما يُعرض لنا من الآلام مبرَّر إلهيًا. ومن الحماقة والوهم عندئذ أن نقاوم. بل يجدر بنا أن نطيع مثل الجنود في المعسكرات أو في ساحات الوغى. وكما جاء على لسان سينيكا “لقد وُلدنا في مملكة: أن نكون أحرارًا يعني أن نُطيع الله”([56]).
ما معنى أن نطيع الله أو العقل؟ الإجابة رواقية في جوهرها: الظن الصادر عن الجسم وعن الأرض يضللنا، والآلام الخارجية، وخسارة الثروة، والصحة وحتى الحياة لا تُصيب إلا الأشياء المتغيرة والمحكوم عليها بالفناء، ومن ثم يملي العقل بأن نتشبث بما لا يتغيّر. وقد جاء على لسان أحد أسلاف ليبسيوس ومُواطنه الذي كان له أثر كبير في نشأة النزعة الإنسانية في القرن السادس عشر، قوله: “حوّل حبك للأشياء الباقية والإلهية، والتي لا تفسد، وليكن حبك لجسدك العابر والزائل أكثر فتورًا”([57]). فمن خلال التشبث بما هو باق، نحقق الثبات وهو فضيلة محورية في رؤية ليبسيوس “عليك بالثبات فهو علامة دالة على قوة العقل غير المتبدل والسديد، غير المتبجح ولا المسبل بالظروف الخارجية أو الطارئة، وفي ما أعتقد لا تتأتى الشجاعة والثبات المتأصلين في النفس من الرأي وإنما من الاستبصار والتفكير الصارم”([58]).
يوفر الثبات، إذن، معيار النهج المستقيم لما يتميَّز به من تناغم. فإذا ما اخترنا أن نجعل من طاعة الله مبدأنا الأول أو اتخذنا من الطبيعة أو العقل سبيلنا، فلن نحيد عن ذات النهج المستقيم، فالمعايير متعاضدة ومتسقة.
فمن سمات الإنسان الخيّر الثبات والصبر والصلابة Constantia، Patientia، Firmitasلذلك فهو لا يتأثر بالفوضى أو الاضطراب أو العنف أو المعاناة، فلا شيء يقلقه أو يزعجه. غير أن هذا لا يعني أنه لا ينفعل بذلك. وعلى النقيض من ذلك، استطاع ليبسيوس أن ينسلخ في نضاليته عن الرواقية وهو ما يُعتبر أمرًا خارقًا في ذلك العصر. لكن ظل ليبسيوس قريبًا من الرواقية الرومانية، أو هو بالأحرى من تأويل سينيكا أكثر منه إلى ايبكتاتوس Epictetus، وإن كان يستلهم منهما أفكاره من دون اعتبار لاختلافهما. لكنه ذهب أبعد من الرومانيين أنفسهم، كي يُبيِّن لنا أن القضية لا تتعلق بمجرد القيام بالواجب في العالم، ولكنها تتمثل في نضال مستمر من أجل بلوغ الخير الأسمى. وتعجّ كتابات ليبسيوس بالاستعارات العسكرية، حتى أن قرَّاءه الأوائل كانوا من بين المعنيين مباشرة بالشؤون العسكرية بالدرجة الأولى، كما سنرى ذلك لاحقًا.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ نشهد مع ليبسيوس انسلاخًا عقائديًا عن الرواقية الإغريقية المعمَّدة Stoa. فلقد آمن هذا الأخير بشكل صارم بالإرادة الحرَّة. أي أننا مسؤولون عن عالمنا. وأنه ينبغي على العقل أن يحفز الإرادة الحرَّة ويُعززها، وأنه يتعيّن على هذه الأخيرة أن تفرض الانضباط بوصف سلاحنا في نضالنا ضد الشر والفوضى. إن الصلابة والمثابرة لا تترجمان فقط قوة سلبية لتحمّل المعاناة، بقدر ما تعنيان، على العكس من ذلك، قدرة على الانخراط في جهاد خيّر من دون سأم.
كيف يمكن تفسير النجاح الذي حققته هذه الرواقية شبه المسيحية في ذلك العصر؟ وعلى جانبي الحاجز الطائفي في كل من هولندا الموطن الأصلي لليبسيوس، وفرنسا وألمانيا؟ فقد كانت هذه الرواقية شبه المسيحية محل ترحيب وإشادة بين مختلف الطوائف: الكالفينية، اللوثرية والكاثوليك. حتى إن ليبسيوس استطاع أن يُدرِّس في جامعات اشتهرت فيها الطوائف الثلاث، كجامعة لوفان Louvain وجامعة جينا Jena وجامعة ليدن Leiden، وهو إنجاز نادر جدًا في ذلك العصر.
ويعود هذا النجاح إلى سببين واضحين: أولًا، إذا كان العديد من أعضاء النخبة من المفتونين بالمثل الأعلى للمدنية، أقل تسامحًا من أسلافهم تجاه العنف والفوضى، فإنهم كانوا أكثر فزعًا منهم، فقد اعتبروا أن الإصلاح عمَّق الفرقة وغذَّى الفتنة والصراع في كثير من المناسبات وبشكل ضار أحيانًا، بدلًا من أن يساهم في تكريس مزيدٍ من السلام والنظام. فقد انصب همّ هؤلاء الناس على إيجاد صيغة أخرى للإيمان تكون أقل أرثوذوكسية طائفية وأكثر حرصًا على المبادئ الأساسية المشتركة بين جميع الكنائس. وبمعنى ما، كانوا يلتقون حول فكر أراسموس إلا أنهم ما لبثوا أن نُعتوا وفي تلك الظروف باسم “السياسيين”. فقد كان أعظم همَّهم، أولًا وقبل كل شيء، تحقيق السلم والوفاق، والتصدّي بشدّة للتعصب الطائفي في الجامعة. ومن أبرز أتباع ليبسيوس فرنسيان كاثوليكيان هما شارون Charron وفار Vair. أما الأول، فكان كاهنًا في حين كان الثاني أسقفًا.
وثانيًا، كغيرهم من السياسيين، لم يكتفِ قرَّاء ليبسيوس باستنكار الصراعات العنيفة، بل كانوا يتطلعون إلى وضع حدّ لها، وإقامة نظام سياسي جديد. فكثير منهم تحمَّلوا مسؤوليات عسكرية وحكومية، فمنهم، إذن، حكام وجنرالات وموظفون مدنيون، ومن بينهم منخرطون وآخرون على وشك الانخراط في الأنماط الخمسة من البرامج التي عرضتها أعلاه. وسعى هؤلاء إلى فلسفة توجههم في مهامهم حتى ضالتهم في كتابات جوستوس ليبسيوس.
أما الآن فسأحاول، ولو قليلًا، بيان السبب الذي من أجله استطاعت الصيغة الحديثة للرواقية أن تخدم بالفعل هذا النوع من نضالية الدولة. ولكن قبل ذلك أودّ أن أُنوّه بالتحوّل الذي حدث آنذاك، والذي مهَّد الطريق للألوهية ومن ثم للنزعة الإنسانية الحصرية.
وعلينا، مرة أخرى، تجنب مفارقة تاريخية تتمثل في اعتبار هذا التحوُّل كما لو كان مجرد خطوة ضمن مسار خطي. فقد كان تصور ليبسيوس توحيديًا في جوهره، إذ الإله الذي يحتكم إليه لم يكن ذاك الإله الذي يترأس الكون المتناغم ويسهر على رعايته كما يصوّره لاهوت القرن الثامن عشر. لقد ساهم غسق بعض العناصر الأساسية في المسيحية، كالنعمة والحب الإلهي، في زحزحة مركز ثقل هذا التصوُّر بشكل كبير. وعلاوة على ذلك لم يعد الاهتمام منصبًا على عبادة الله، بل على استخدام العقل وعلى الثبات. وهنا تكمن، ضمن بعض الوجوه، قوة فلسفته. في حين كان يُفترض أن تكون مسألة عبادة الله قطب الرحى في سجالات القرن السادس عشر، كما يمكن أن يُفهم هذا الصمت على أنه دعوة مبطنة للانتماء إلى “الكنيسة التي نختارها” في استعادة لتعبير عفا عليه الزمن (كنيسة الحكام الذين تختارهم) ولكن ذلك قد يعني أيضًا، أنه يمكن الاستغناء عن العبادة وأنها لم تعد ضرورية أو ذات أهمية.
أما لله فلا غنى عنه البتة لأنه مصدر العقل، فطاعته لست شيئًا سوى الخضوع إلى صورته الحالّة فينا. ولكن يبدو أن الشيء الوحيد الذي يتعيَّن علينا القيام به، لتأكيد الخضوع لمشيئته، هو أن نكون كائنات بشرية مميزة لا أكثر. وهو ما مهَّد الطريق للنزعة الأنثروبومركزية للصيغة الأخيرة للألوهية، بعدما جذرت هذه الأخيرة الفصل بين قدراتنا على التفكير وما هو انعكاس لحضور الله فينا. وهذا يعني أن تحولًا مهمًا حدث. فإذا كانت الرواقية قد أحدثت منعرجًا داخل الألوهية في البداية، فإن هذه الأخيرة ما لبثت أن أحدثت منعرجًا نحو الإنثروبومركزية.
لقد لعبت مؤلفات ليبسيوس دورًا مهمًا داخل البرامج العسكرية، وفي إعادة بناء المجتمع التي انطلقت مع نهاية القرن، لأن تصوره الأخلاقي كان يدعو إلى المشاركة الفعَّالة في الحياة العامة، وبسبب إصراره على المعنى الرئيس للانضباط.
تتَّخذ العقيدة السياسية لليبسيوس، كما وردت في كتاب Politicorum sive civilis doctrinae, libri sex of 1589، طابعًا أعتبره “سياسيًا” لأنه كان مهتمًا أساسًا باستعادة النظام والاستقرار، في عصر مزقته الحروب الأهلية والطائفية في أغلب البلدان الأوربية. في حين كان اهتمامه بمطالب كل دولة على حدة محدودًا، وكان يفضِّل نظام الحكم الملكي، على أنه يعتقد بأن على الأمير الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الصارمة، وأن يُكرِّس جهوده لخدمة الصالح العام.
لا يكتفي ليبسيوس في هذا الكتاب بإعطاء بعض النصائح العامة، بل يعرض مواصفات لإصلاح الجيش بشكل تفصيلي، تبرز أهمية الدربة والنظام في تشكيل قوات مسلحة ناجعة وفعَّالة، غير أن تصوره للانضباط لا يتوقف عند هذا الحد، لأنه يريد إحداث تغيير أخلاقي جذري. فقد كان يسعى إلى تكوين جيش محترف، بحيث يقع التخلي عن القيم القديمة كالشرف الفردي والنهب والاستعاضة عنها بالمبادئ الرواقية: ضبط النفس، والاعتدال والعفة([59]) Continentia, modestia, abstinentia.
وبعبارة أخرى، لا يهدف التدريب فقط إلى الانضباط الذي يعلّم تناسق الحركات، وطاعة الأوامر وإنما يهدف أيضًا إلى جعل الجندي منضبطًا أخلاقيًا إلى أبعد حد، ويغرس فيه أخلاقيات الاحترافية ويعلّمه واجب الخدمة وضبط النفس. أما الجيوش المرتزقة فهي لا تلتزم بأي إيمان ولا أي قانون، وبذلك فهي تمثل تهديدًا لا فقط للأعداء، بل وأيضًا للذين انتدبوهم. ومن ثم وُجب استبدالهم بفرق منضبطة تلتزم بميثاق شرف تمتنع بموجبه عن السلب والنهب.
تكمن أهمية ذلك على مستويين، أحدهما خاص والآخر أكثر عمومية. فأما على المستوى الخاص، فقد اعتمدت نصائح ليبسيوس من قبل أولئك الذين بادروا بالقيام بإصلاحات عسكرية في هولندا سنة 1590 ومن بينهم بعض تلاميذه السابقين، (خاصة منهم موريس أورونج Maurice of Orange) وذلك عن طريق اعتماد تدريبات صارمة جدًا ساهمت في تكوين قوة عسكرية ناجعة، وقع الاقتداء بها لاحقًا بها في أوروبا على نطاق واسع، على غرار جيش أدولف غوستاف السويدي Gustavus Adolphus ونموذج جيش كرومويل الجديد Cromwell’s New Model Army.
أما على مستوى أكثر عمومية، فقد مهَّد ليبسيوس الطريق للمصلحين الذين سعوا بكل جدية إلى إعادة تأسيس الأخلاق على مبادئ سامية في القرن الذي تلاه، سواء أكانوا حكامًا، (في بعض الأحيان)، أم مسؤولين وموظفين مدنيين وإداريين وجنرالات في غالب الأحيان، وقد كان هؤلاء مصدرًا للعديد من الإصلاحات التي استهدفت إعادة بناء المجتمع في مناحيه المختلفة. وقد اقترح ليبسيوس بداية، أن تهدف الأخلاق النبيلة إلى خدمة الصالح العام، وأن تستند إلى أخلاقيات التقشف والانضباط الذاتي، وبذلك تتم إعادة تأسيس الحياة المؤسساتية والاجتماعية بشكل عميق من خلال الانضباط وتدريب الجماهير الخاضعة بما يؤدي إلى نشر قيم ضبط النفس والكدح بين الرعايا.
باختصار، شيء مثل ما كان يُطلق عليه اسم: “أخلاقيات العمل البروتستانتية” في سياق يوحي “بالزهد الدنيوي الذاتي” على نحو ما عبَّر عنه ماكس فيبر([60])، وهو ينتج أساسًا عن جهود السلطة السياسية بصفة خاصة، نحو إعادة بناء المجتمع. وبالفعل يمكن لنا أن نعتبر أنه طوال هذه الفترة من الحكم المطلق، أدت أخلاقيات التدخل الفعال للدولة إلى إدخال أنماط حياة معقلنة ومنضبطة ومحترفة. كما هو الشأن بالنسبة لأخلاقيات الدعوة الكالفينية. فلقد عملت الرواقية الجديدة، بمساعدة الكالفينية، بطريقة فوقية من خلال بيروقراطية الدولة على إحداث التغيّرات التي عملت عليها الكالفينية والنزعة التقوويّة انطلاقًا من القاعدة من خلال ورجال أعمال متفانين وإيثاريين والجمعيات التطوعية([61]).
لقد كان هناك تقارب كبير جدًا بين الرواقية الجديدة والكالفينية. بحكم طبيعة نضالهما وتفانيهما في الزهد، فقد بادر كالفن في بداياته بنشر دراسة حول سينيكا. وقد كان باستطاعة أعضاء المجتمعات الكالفينية ممن لم يكونوا لاهوتيين متشددين، الجمع بينهما من دون عناء. (ولم يكن، في الواقع، عصيّ البتة على كثير من الكاثوليك واللوثريين أن يحذو حذوهم). إن الدوافع التنظيمية متشابهة جدًا: ذلك أن الأمر يتعلق بإقامة نظام اجتماعي مستقر انطلاقًا من تدريب الأفراد ضمن “دورات منتظمة” على التفاني من خلال مهن غايتها خدمة إخواننا من بني البشر: في القطاع الخاص، من خلال العمل المنتج. وفي القطاع العمومي، من خلال تفاني الحكومة في السعي لتحقيق خير رعاياها. وبالفعل ابتكرت الكالفينية، في المجال السياسي أشكالًا متباينة وأحيانًا متناقضة جذريًا مع الحكم المطلق. غير أنه لا بد من التأكيد بأن هناك توازيًا يكاد يكون تامًا بين صورة النظام الاجتماعي وصورة النضال الذي يمكن توخيه في إنتاجها، وضرورة تحقيق الغاية من هيمنة الأتقياء والفضلاء.
وما يبعث على الاستغراب حقًا وبشكل متوازٍ أيضًا، هو الاعتقاد بأن ذلك كله يمكن أن يتحقق. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بالذات، أنَّى لهذا أن يتحقق في ظل العنف المتطرف والفوضى العارمة لا في ذلك العصر فقط وإنما أيضًا على امتداد العصور المتعاقبة، وفي مواجهة جموح البشر الشديد نحو التغيير، فقد بدأ الناس يتطلعون بجدية إلى إحداث تغيير مصيري، لا بل تغيير لا رجعة فيه نحو الأفضل؟
من الواضح، إذن، أن تغييرًا قد حدث في وجهة النظر، قياسًا لما كان عليه الحال في العصر الوسيط الذي كان، فيما يبدو، مستغرقًا في ذات الرؤية التي سادت لدى معظم الناس على امتداد العصور لمسألة وجود حدود صارمة يستحيل معها استبعاد الخطيئة أو الفوضى من هذا العالم. بطبيعة الحال يُفترض في كل عصر وجود عصر ذهبي يسبقه يمكن أن نستعيده متى كانت الظروف مواتية. وذلك ما اعتقد فيه إنسانيو عصر النهضة في أوج العلاقة بالثقافة الكلاسيكية. وفي إطار هذه الذهنية عمل الكارولنجيون على استعادة مجد “الإمبراطورية الرومانية”، وحلم أباطرة بيزنطة بإحياء مُلك جستنيان Justinian.
لكن هذه المسألة على أهميتها القصوى لم تحظَ باهتمام طموح كما في برامج الكالفينيين أو الرواقيين الجدد الإصلاحية خلال القرن السابع عشر. وذلك لغرضين: أولًا، من أجل وضع حد نهائي للعنف والفوضى الاجتماعية على حد سواء، والتخلي عن الجريمة الفردية على أحد طرفي شبح المثالية والعنف الشرعي للدولة في زمن الحرب أو قمع الجريمة على الطرف الثاني. وثانيًا من أجل ترسيخ، على الأقل، بعض معايير التمدن والحياة المنظمة بشكل جيّد في نفس كل فرد. وبطبيعة الحال، لا ينفصل الهدف الأول عن الثاني، ذلك أنه من خلال تحقيق الثاني فقط يمكن لنا أن نتطلع إلى تحقيق الأول.
لقد كان ذلك الطموح غير مسبوق في التاريخ الأوروبي رغم ما شهدته الصين من محاولات شبيهة في هذا الاتجاه في فترات مختلفة. وبالفعل فقد كان رواده على وعي بأنهم مجددون. وبمعنى آخر، فرغم أنهم يستلهمون في محاولاتهم التجديدية بعض مآثر “العصور الذهبية ” السابقة، فإنهم واعون جيّدًا بأنهم لا يكتفون بمجرد إحيائها من جديد، بقدر ما يجتهدون في تجاوزها في بعض النواحي المهمة بشكل باتّ.
وهكذا عاد الكالفينيون إلى الأيام الأولى للكنيسة على الرغم من إحساسهم بتدني شأنهم عن المسيحيين في ذلك العصر المقدس، وكانوا على وعي باستحالة إقامة مجتمع مسيحي بشكل كامل في تلك الأيام الأولى، ولهذا السبب نجدهم كثيرًا ما يقتدون بنماذج العهد القديم الإسرائيلي، التي تصوِّر المجتمع اليهودي كمجتمع تقيّ، تحاصره الأعداء من كل الجهات. وبالفعل فإن تلك السمات التي تفترض تجاوز نموذج المجتمع الإسرائيلي توجد بصورة صريحة في الأركان الأساسية للاهوت المسيحي.
وبالمثل، اهتم ليبسيوس وخلفاؤه من الرواقيين الجدد بالإنجازات القانونية والعسكرية والسياسية العظيمة للإمبراطورية الرومانية. فقد حدث، بمعنى ما، تحوُّل في تمثل المصلحة الإنسانية من الأدب اليوناني واللاتيني إلى مؤرخي روما القديمة، بما في ذلك بوليبيوس Greek Polybius والتركيز على تاسيتوس Tacitus بصفة خاصة. ففي مجال الخطابة، كان لأسلوب تاسيتوس أفضلية على أسلوب شيشرون المغالي، مع التركيز أيضًا على الصيغة الرواقية التي يقول بها سينيكا. حتى أصبح الناس يتحدثون عن القرن السابع عشر بوصفه “قرنًا رومانيًا”([62]). لكن أيًّا كان الافتتان بكفاءة الرومان في إدارة شؤون الحكم وبانضباطهم العسكري وبالفلسفة الرواقية، فمن الواضح، أن البرامج التي نسعى من خلالها إلى إصلاح العادات وإلى تغيير عقليات الشعوب، بدأت تشمل تدريجيًا ميادين جديدة.
ونجد في الجمهورية الرومانية الصاعدة (بمعنى ما)، وفي المدن (البوليس) اليونانية في أوجها (أكثر ندرة)، نموذج آخر مختلف لمجتمعات قائمة على الأخلاق الصارمة والسامية. وقد كان لذلك النموذج أثر كبير في فترات لاحقة من تاريخ أوروبا الحديث: على المفكرين من ذوي النزعة الإنسانية المدنية في إيطاليا في عصر النهضة، وبطبيعة الحال، على الثورتين الفرنسية والأميركية العظيمتين في القرن الثامن عشر على وجه الخصوص. فقد كان هناك وعي تام باستحالة العودة إلى تلك المجتمعات الصغيرة القائمة على حكم ذاتي مباشر([63])، على الأقل في الفترة الأخيرة. ولا يُعزى سبب هذه الاستحالة فقط إلى حجم الدولة الحديثة، بقدر ما يعود كذلك إلى عدم قدرة الجمهوريات القديمة على إدماج مجموع سكانها، وأن قسمًا مهمًا من العمال، وهم من العبيد عادة، يُقصى([64]).
فأنَّى لهم أن يحصلوا على الثقة الضرورية لاقتحام هذا الميدان المجهول؟ يبدو هذا السؤال غريبًا بالنسبة إلينا بوصفنا نحيا في عصر هُم من أنشأه. وفي عالم شمال الأطلسي، نقدِّر “بداهة”، أنه لا بد من وضع حد للعنف والفوضى ودرء طرفي شبح المثالية، الجريمة الفردية والحرب التي تقودها الدولة. وبقطع النظر عن هول الفاجعة أو الصدمة التي أصابتنا جراء أعمال الشغب في جنوب لوس أنجلوس أو تلك التي وقعت في ضواحي باريس، فإننا نعتبرها علامة على اختلال وظيفي خطير في مجتمعاتنا. وإننا لنتوجس خيفة من بعض دول ما كان يُعرف بالاتحاد السوفياتي، لأنها تذكرنا بما كان سائدًا في زمن ما قبل الحداثة. فلقد نجحنا، بمعنى ما، في ترسيخ “التمدن” لدى الجميع وفي نشر الثقافة والتعليم بين غالبية الشعب وتقاسم بعض القيم مثل العمل المنضبط والحياة المنظمة والمسالمة، وليس لنا عندئذ إلا أن نفزع ونصدم تجاه عودة الشباب إلى العنف. وقطعهم مع الروابط الأسرية ومع أخلاقيات العمل. فالمعيار المسكوت عنه، والذي أشرنا إليه، هو أعمق من مشاريع الإصلاح التي عرفناها منذ أربعة قرون على أيدي الإلهيات الكالفينية والكهنوتيات ذات النزعة الرواقية الجديدة.
ومع ذلك يجب علينا تجاوز هذه المفارقة التاريخية وتبيّن إلى أيّ مدى كان هذا التحوُّل حاسمًا ومذهلًا في ذلك العصر. ولكن لنا أن نتساءل من جديد: ما الذي جعل هؤلاء واثقين من حدوث ذلك التحوُّل؟
في الحقيقة، ما يُنذر بكل هذه البرامج، وما يكمن وراء الرغبة في المزيد، هو الثقة الفائقة في القدرة على إعادة تشكيل الكائنات البشرية، فلا يسعنا إلا أن نندهش من الطموح المطلق لبعض المشاريع الطهرانية من أجل السيطرة على الطبيعة الآثمة عبر قوة القانون، ولقد أعلن وليام ستاوغتن William Stoughton في نص كتبة سنة 1604: “ليس هناك جريمة تأخذ بعين الاعتبار أي وصية إلهية أو متواردة مع أيّ من جدوَلَيْ شرع الله المقدس ولكن […] القوانين الدنيوية والملكية كانت دائمًا وأبدًا تُعاقب مرتكبيها”. لذلك كان هناك دائمًا تجريم للوصايا العشر. ولم يتوقف ستاوغتن عند هذا الحد بل ناقش أيضًا مسألة الهرطقة والانقطاع عن ممارسة الشعائر الكنسية، بينما كان غيره من الطهرانيين منشغلين بوضع قوانين تمنع صيد الدببة، والرقص وأداء اليمين، وتعاطي الرياضة يوم الأحد، والأبرشيات، وما إلى ذلك([65]).
وبالمثل تجلى طموح كبير آخر لا يقل أهمية عن سابقه بشكل واضح في مراسيم الدولة المدنية Polizeistaat. فإرادة إعادة تشكيل الرعايا من خلال تنظيم جيد لأدق تفاصيل حياتهم تنم عن ثقة غير محدودة أو تكاد في القدرة على تشكيل الناس وفق قالب جديد. وكما نوَّه بذلك رائف Raeff: “لقد ظلت “فرضية قابلية الطبيعة البشرية للتطويع بشكل كامل” ضمنية ولم يُصرح بها أبدًا في عبارات واضحة ودقيقة تقريبًا […]. وذلك لزعم مفاده “أن الطبيعة البشرية في جوهرها قابلة للتطويع، لأنها لا يمكن أن تتشكَّل إراديًا أو بحسب الظروف الخارجية”([66]).
وبالنسبة للبعض، بطبيعة الحال، ليست إعادة التشكيل هذه ممكنة إلا من حيث المبدأ، وأن حظوظ انطباقها على الجماهير محدودة جدًا. ولكن مع ذلك ساد اعتقاد بأنه لا شيء يمنع مثل هذه الهندسة الاجتماعية من حيث المبدأ.
فما الذي يمكن أن يمنع ذلك؟ قطعًا، أولًا وقبل كل شيء، ذلك التمثل التقليدي للأشياء الذي يحول دون إمكانية إصلاح شامل. أما في ما يتعلق بالقرون الوسطى الأوروبية فقد تكفَّل أوغسطينوس بعرض أهم ملامحه من خلال تمييزه بين صنفين من الاجتماع، مدينة الله ومدينة الأرض، وهما تتعايشان جنبًا إلى جنب إلى حد الانصهار، فمدينة الأرض موطن الخطيئة، والعنف والفتنة فيها أصيلان. ونظام الحكم فيها، هو بدوره، يمكن اعتباره عنيفًا إلى أبعد حد، ومع ذلك لا غنى عنه، لأنه في غياب ذلك ستؤول الحياة الاجتماعية إلى الفوضى لا محالة.
من خلال وجهة النظر المتدنية هذه للدولة يصبح دورها مقتصرًا على ضمان حد أدنى من النظام في عالم منحط، إلا أنها رغم ذلك تعمل على إقناع المواطنين بأن الفضيلة ليست من صلاحياتها وبالتالي لا شأن لها بها.
أما مدينة الله فهي بيننا، بطبيعة الحال، على امتداد الأراضي المسيحية، ربما يكون بمستطاع الدولة المسيحية أن تفعل الكثير؟ لم يكن أوغسطينوس يعتقد في ذلك، وهو الذي كان يعيش في ظل الإمبراطورية المسيحية، فالدولة المسيحية يمكنها أن تساعد الكنيسة عن طريق الهراطقة والطوائف الزائفة، إلا أنه لا يمكنها تحسين وضعية مواطنيها، وحدها مدينة الله ممثلة في الكنيسة تطمح إلى ذلك.
وعلاوة على ذلك، فإن الأرقام لا تؤيد مدينة الله، ذلك أن عدد الأفراد الناجين ظل محدودًا جدًا، وكانوا ثلة قليلة من النخب من بين الجماهير المدانة، وهو ما أكده كل من أوغسطينوس مستفيدًا في ذلك من كاثوليكية العصور الوسطى المتأخرة، والكالفينية في وقت لاحق.
ولما كان أوغسطينوس رائد المصلحين، فكيف لهؤلاء أن يتخيّلوا إمكانية تجاوز تلك الحدود التي وضعها بطريقة مقنعة جدًا؟ ما يُبرِّر ذلك ليس اعتقادهم في أهمية المنتخبين وكثرة عددهم، ولكن لأنهم يعتبرون، كما رأينا ذلك سابقًا، أنه يوجد إعفاء يمنح للشخص المنتخب صلاحية تأديب وحكم المجتمع بأسره.
وفي وقت لاحق، كان لا بد، بطبيعة الحال، من تبني رؤية مختلفة نسبيًا، فالحد الفاصل بين ثلة من الناجين وغالبية من المدانين، أدى في نهاية المطاف، إلى تقسيم المجتمعات التقيَّة التي يُفترض أنها تحتوي على أكبر عدد ممكن من المنتخبين، بدلًا من أن يخرق كل مجتمع بطريقة أقل أو أكثر تكافؤًا، وخاصة تلك المجتمعات التي رزحت تحت نير روما وغيرها من الإمبراطوريات اقتدت بها واقتفت أثرها، أو تحت نير ظلمات الوثنية. وقد ناضل نفر قليل من ذوي النفوس الشجاعة ضد الاضطهاد على الرغم من خطورة الموقف إذ في ذلك حتفهم. وعلى ما يبدو لم يكن ممكنًا تفادي هذا الانزلاق. وإنه لمن العسير جدًا أن نعظ جمهورًا ما لم نفترض على الأقل، بأن أيّ منهم، لديه فرصة في أن يكون من بين المنتخبين، وعلاوة على ذلك ساهم موقف أغلب المجتمعات الكالفينية المحدود والمحاصر في بلورة رؤية “نحن في مواجهة الآخرين”، وهي رؤية لعبت دورًا مهمًا في الاقتراب أكثر من العهد الإسرائيلي القديم.
وفيما لم تؤخذ تلك الحدود التي وضعها أوغسطينوس على محمل الجد في أوساط الكالفينيين، فإنها ألغيت تمامًا في إطار الرواقية الجديدة الأقل أرثوذوكسية.
غير أن الأمر يبدو أكثر من تحوُّل في اعتقاداتنا حول إمكانية التغيير، إذ كان لا بد، قبل ذلك، من تحطيم فهم كامل لبنية المجتمع ولعلاقتها بالشر من أجل بناء الثقة في قدرتنا من جديد.
لقد سبق أن أشرت إلى بعض التحوّلات العميقة التي طرأت على وجهة نظرنا من بعض ملامح المجتمع مثل المقاربة الجديدة للفقر والاغتراب والتخلي عن الطقوس الاجتماعية القديمة لاقترانها بالرذيلة والفوضى، ولم تكن وجهة النظر السابقة في شأن كل ذلك ناشئة عن عقيدة بعينها بقدر ما كانت انعكاسًا لإطار شامل للتمثل.
قد يكون ذلك، إن جاز لنا القول، بمثابة إطار يميل إلى اعتبار المجتمع ككل خاضع لنظم تراتبية ولكن وظائفها متكاملة في الآن ذاته. ولنا في التاريخ أمثلة عديدة تؤكد ذلك، كمجتمع الطبقات الثلاث: المصلون (الرهبان ورجال الكنيسة) والمحاربون (النبلاء) والعمال (الفلاحون). وثمة تماثل بين المملكة وجسم الإنسان، فالرأس، الملك، والذراعين، النبلاء، وهكذا…
ما يميّز هذه الاعتبارات هو أنه رغم الفوارق الصريحة في القيمة بين الطبقات المختلفة – الأمر يتعلق لا محالة بنظام تراتبي – فإن تحسين الأمور لا يكون من خلال القضاء على الطبقات المتدنية أو أن نجعل من الجميع رهبانًا أو فرسانًا. فالطبقية ضرورية للمجتمع ككل.
ينطبق هذا الفهم، في تقديري، على الوعي العام وكذلك على مختلف الفوارق الأخرى، حتى وإن لم تُبيِّن عقيدة أخرى ذلك بوضوح. وهكذا فإنه لا مفر من اتخاذ موقف ما من الفقراء طالما أنه، وهذا ثابت إلى حد ما، “سيكون بينكم فقراء على الدوام”، وفي ذلك أكثر من معنى، فإذا أغاث الأغنياء الفقراء في الدنيا، فقد وفَّر الفقراء، بالمثل، فرصة للأغنياء للخلاص في الآخرة. إذن، ثمة تكامل رغم الفارق في القيمة. (على أن الفارق قد يذهب في الاتجاهين على السواء: قد يحظى اللورد أو البورجوازي بمرتبة أرقى في الدنيا قياسًا للمتسوِّل، ولكن هذا الأخير قد يحظى بمكانة دينية أرقى في الآخرة). وفي هذا الاتجاه، يبدو من المستحيل أن نتخيّل أن هناك مسعىً جدّيًا للقضاء على الفقر.
وفي ما أعتقد، قد ينطبق هذا الأمر على نحو مماثل على العلاقة بين القداسة الصارمة وإطلاق العنان لذوي الأنفس المتهورة أو حتى على المتعة الحسية بملذات الجسد. إنها حالة صعبة التحقق ذلك أنه لا توجد عقيدة تُعنى بهذه الحالة صراحة، كما هو الشأن بالنسبة للفقراء. ولكن يبدو أن شيئًا ما يشبه ذلك متضمن في طقوس الكرنفال، وفي الاحتفالات “الفوضوية”، وفي كل الطقوس التي تقلب العالم رأسًا على عقب، ثم ما يلبث أن يستعيد النظام سيره العادي. وذلك ما سعيت إلى بيانه في المقطع السابق.
وبطبيعة الحال، يمكن أن نفسر ذلك استنادًا إلى نظرية “منفذ الهواء” (صمَّام الأمان)، ذلك أن المجتمع كان في حاجة في كل مرة إلى فجور مؤقت للتنفيس عن الضغط (البخار) وترميم المعنويات عن طريق التحرّر من ضغوطات الحياة اليومية، ومن ثم العودة من جديد بأكثر حماسة إلى الانضباط المعهود. غير أن هذه الطقوس يمكن أن تُؤَوّل بطريقة أخرى، ففي الكرنفال يُوضع الأكل والجنس والعنف (عادة بشكل ساخر) في الميزان، وإذا كان في ذلك اعتراف واضح بأن الرغبات الجسدية هي أقل حدة في الكرنفال منها في الزهد زمن الصوم الكبير. فإنه علينا رغم ذلك ألا نلفظها تمامًا، وأن نوليها ما تستحق من الاهتمام. وبطبيعة الحال، تفسر نظرية “منفذ الهواء”، ضمن بعض الوجوه، هذا الأمر. فما أردت قوله، إذن، إنه من الضروري أن يقع تصريف تلك الرغبات، لا لأن ذلك يمنع البرميل من الانفجار ولكن لأن تلك الرغبات تساهم في ثبات توازن الأشياء، على الأقل إلى حين عودة المسيح. ففي غياب الغرائز يتعطل سير العالم، ولذلك نحتفي بها في الاحتفالات الطقوسية، لأننا نعلم تمام العلم، بأنها ستترك مكانها لما هو أسمى عندما تعود الأمور إلى نصابها.
ويعكس هذا التوازن بعمق تلك الفكرة التي طوَّرها تورنر Turner، التي تقول بأن تأول المجتمع يتنزل ضمن سجل مزدوج، نظامه واجتماعيته وبُنيته. مع تجذّر كل ذلك في الفوضى. لأنه من المستحيل منع هذه الفوضى، وليس لنا، عندئذ، إلا أن نبحث لها عن مخرج.
ففي كل الحالات يفترض الكرنفال مثلما سبق أن بيّنت ذلك (في الفصل الأول) تمثلًا للزمن بوصفه كايروسيًا، وفي مستويات متعددة.
قد يكون هذا التمثل للزمن، ضمن بعض الوجوه، سابقًا للمسيحية، من حيث أصوله، لكنه لا يتعارض معها بالضرورة. فقد ورد في الإنجيل أن الشر والخير متلازمان بحيث لا ينفصلان بشكل بات قبل بلوغ نهاية الأشياء، وبعبارات إنجيلية، لا يمكن أن نُميز بين القمح والزوان قبل الحصاد.
وبدا جليًا، في العصر الحديث، أن النُخب غيّبت هذه الفكرة تمامًا، وشيئًا فشيئًا بدأ تصور جديد للعالم وللزمن يفرض نفسه على أرض الواقع، وينص هذا التصوّر على أن التكامل بين النظام والفوضى لم يعد ضروريًا. ولم تعد تعني الفوضى خيارًا لا مفرّ منه اعتبارًا للصورة الكايروسية للزمن، وإنما تنازلًا مجانيًا نحاول به أن نجتث كل إمكانيات التوافق مع الشر. وهكذا أصبحت الأصوات الخرقاء التي تصم الآذان المنتقدة لعناصر الثقافة الشعبية تواتر أكثر فأكثر بين النخب في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
إنها لقصة طويلة. ولكن يمكن اختصارها في هذا التصوُّر الجديد للعالم وللزمن. تصوُّر نشأ أصلًا في صلب الرؤية المسيحية ذاتها، وساهمت في تشكيله صيغ علمانية عديدة، أو بالأحرى بدأ يتخذ تدريجيًا منحى علميًا أكثر فأكثر انطلاقًا من الرواقية الجديدة مع جوستوس ليبسيوس. وبالفعل يمكننا القول إن ذلك التصوُّر ساعد في تشكيل الرؤية العلمانية الحديثة حيث يمثل “الزمن المتجانس والفارغ” أحد أهم مكوناتها. وبالتوازي مع ذلك، نشأت تصورات جديدة عن النظام لا تحفل بالاتفاق: نظام حياتنا الخاصة، والنظام الاجتماعي.
ومن بين أمور أخرى كثيرة، كانت الصيغ الحديثة لهذا البعد الأخير للنظام أقل تسامحًا تجاه العنف والفوضى الاجتماعية، مقارنة بالصيغ السابقة. فقد كان القرن السادس عشر، قرن ترويض الطبقة الأرستقراطية العسكرية غير المنضبطة وتأهيلها خدمة للشؤون المدنية. أما القرن الثامن عشر فقد شهد بداية ترويض الشعب بأسره. فتراجعت وتيرة القلاقل وأحداث الشغب والانتفاضات القروية والاجتماعية في شمال غرب أوروبا عسى أن نبلغ مستويات عالية من اللاعنف على الصعيد الأهلي هي أقصى ما كانت تتطلع إليه معظم المجتمعات الأطلسية (في مستوى هذه النقطة ونقاط أخرى عديدة تبدي الولايات المتحدة الأميركية تراجعًا غريبًا إلى عهود خلت).
لقد غذّى هذا التطوُّر وعزَّز ثقتنا في “قدرتنا” على تطبيق هذا النظام في حياتنا، وقد كانت هذه الثقة في صميم برامج الانضباط المتعددة، سواء الفردية أو الاجتماعية أو الدينية أو الاقتصادية أو السياسية، وهي برامج ساهمت في تحولنا منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد اقترنت هذه الثقة بذلك الاعتقاد بأنه ليست لدينا رغبة في التوافق مع الشر ولسنا في حاجة إلى التكامل مهما تكن ضرورية، وبأن إحلال النظام لا يحتاج إلى فرض الاعتراف بحدود أيّ مبدأ يناهض الفوضى. وقد أضعفت المهرجانات الفوضوية وأربكت هذا التطور نحو النظام. لذلك لم يكن من السهل على النظام أن يتحمَّل هذا العالم المقلوب رأسًا على عقب.
وهكذا يصبح من السهل أن نخسر، من حيث المبدأ، الإحساس بوجود حد لتطويع الناس وبوجود أناس أسمى من غيرهم. فقد تأبى الطبيعة البشرية المتوحشة الخام حياة التمدن، ولكن هل ثمة أفظع من اختلال التوزان القاتل، أو تدمير وحدة المجتمع؟ وهل يمكن تعويض خسارة التوازن ووحدة المجتمع؟ وإنك لتمضي قدمًا إلا بقدر استطاعتك. وينطبق هذا الأمر على الشيوعية في البارغواي وعلى الدولة البوليسية في أوروبا الوسطى.
وقد جذرت النظريات السيكولوجية الناشئة، لاحقًا، وجهة النظر هذه. فالكائن البشري عبارة عن صرّة من العادات، كُتب عليه أن يبدأ دائمًا من صفحة بيضاء، فلا حدود للإصلاح. لكن التجاهل غير الحكيم لهذه الحدود ليس ناشئًا عنها، بقدر ما كان نتيجة تمثل جديد للنظام أعطى مكانة أساسية إلى الجهد الإرادي البنَّاء من أجل إعادة ترتيب الحياة الإنسانية.
يمكن أن نتبيّن ذلك بشكل أفضل من خلال التساؤل التالي: أنَّى لهذه النخب أن تأمل إيجابيًا في إمكانية تغيير المجتمع فعليًا؟ لقد اعتقد الكالفينيون، في أن العناية الإلهية اختارتهم للمشيخة على الأقل في المجتمعات التي انتخبت بوصفها مجتمعات اختارها الله، ولكن تنامت في الأوساط التي تأثرت بالرواقية الجديدة، تصوُّر جديد للنظام الطبيعي، ساهم على ما يبدو في ترسيخ الأمل في عالم مُصلح.
تبدو فكرة النظام الطبيعي فكرة تقليدية. فهل كان أفلاطون وأرسطو وأتباعهما في العصر الوسيط وما بعده يعلمون شيئًا آخر غيرها؟ غير أن الأمر يتعلق هنا بنظام مختلف تمامًا. نظام معياري، ولكن بطريقة مختلفة جدًا.
يبدو الفهم القديم لنظام الكون، المستمد في النهاية من أفلاطون، سواء في تجديد النظرية الأرسطية مع توما الأكويني، أو في عالم ديونيسيوس الإريوباغي، كما لو أنه إحدى الصور المتحققة في الواقع. ويُعبِّر العالم المرئي الذي يحيط بنا عن هذه الصور أو يُظهرها سواء اعتبرناه نتيجة فيض (انبثاق) أو أنه بشكل أكثر أرثوذوكسية، خُلق على أساس أفكار قائمة في روح الله.
يعتبر القول بأن الصور متحققة في الواقع، فكرة جوهرية في التقليد الأخلاقي القديم الذي افترضت، سابقًا، أنه يتناقض مع الرؤية البنائية الحديثة التي ترى بأن الإرادة الإنسانية تفرض على الطبيعة صورة تتجاوزها. ومن ثم أصبح الفهم الجديد للطبيعة بنائيًا. إن النظام في ذاته لا يتحقق ولا يسعى إلى التحقق ولكن الله قدَّر أن تكون الأشياء متوافقة في ما بينها، بحيث أنها إذ تتبع خطة الله تؤول إلى ما كان مقدرًا لها بشكل تام ومُحكم. بيد أن هذه الخطة في حد ذاتها ليست فاعلة في الطبيعة الساعية إلى تحققها الخاص. إن النظام يتوافق، ضمن بعض الوجوه، مع كيفية تحقق الأشياء في الواقع، إلا أنه وفي سياقات أخرى لا يمكنه أن يتحقق إلا عن طريق كائنات عاقلة تمتلك إرادة.
في هذه الحالة الأخيرة يكون المجال الرئيس هو المجتمع الإنساني حيث تكون الخطة معيارًا يُقترح على العقل وليست مبطنة في الوجود، وبعبارة أخرى فإن الطريقة الوحيدة التي تكون من خلالها فاعلة في الوجود هي أن تكون مقبولة من كائنات عاقلة. فلا يجب أن تكون فقط متوافقة مع موقف من إعادة بناء العالم والمجتمع، بل يتطلبها([67]).
لقد طوَّرت هذه الفكرة في سياقها المفاهيم الأكثر تأثيرًا في نظرية القانون الطبيعي في القرن السابع عشر. ولقد لعبت دورًا مهمًا في الفكر الأكويني (Saint Thomas D’Aquin) وكذلك بالنسبة لمفكرين كبار من الإسبانيين مثل فرانسيسكو سواراز Suarez وأتباعه. إلا أن أولئك الذين نعتبرهم اليوم مؤسسي نظرية القانون الطبيعي الحديثة، ونخص بالذكر منهم غروتيوس Grotius وبوفندروف Pufendorf ولوك Locke، هم الذين أعطوها بعدًا جديدًا.
لم يقتفِ غروتيوس في استخلاصه للقانون الطبيعي أثر النهج الغائي للطبيعة البشرية كما كان سائدًا عند أرسطو وتوما الأكويني، بل توخى في ذلك نهجًا هندسيًا، ففي الصفحات الأولى من مؤلفه قانون الحرب والسلم De jure belli ac pacis، يعرّف القانون الطبيعي كما لو كان شيئًا “مناسبًا”([68]) للكائن العاقل والاجتماعي في الآن ذاته. ورغم أن هذا التوخي الهندسي في استخلاص القانون الطبيعي مختصر بشكل محكم إلا أنه يحتاج إلى بعض التشذيب عسى أن نتبيّن معنى أن يكون الكائن العاقل، كائنًا يتصرَّف وفق قواعد وقوانين ومبادئ، ولأن هذا الكائن العاقل هو كائن اجتماعي أيضًا، فإن وجوده يحتاج ضرورة إلى قوانين تضمن العيش المشترك، ذلك أن معايير الحظر وأوامر الزجر التي يفترضها القانون الطبيعي التقليدي مستخلصة من هذا المبدأ. ولا توجد أيّ صورة يمكن اعتبارها صورة متحققة هناك دائمًا، وإنما توجد طريقة تجعل الأشياء (البشر تخصيصًا في هذه الحالة) متوافقة في ما بينها “عقلانيًا”، طريقة قابلة لأن تكون بمثابة قاعدة إلزامية.
لقد كان غروتيوس، وهو من أتباع ليبسيوس Lipsius، يعتقد أن هذا القانون مُلزم عقليًا فقط (ومن ثم تأكيده الشهير على أن القانون يجب أن يسود ويستمر حتى “وإن لم يوجد إله”)([69])، في حين اعتقد كل من بوفندروف ولوك من بعده بأن القانون إلزام إلهي لا مندوحة عنه. بيد أن جميعهم يتَّفقون حول الحجَّة ذاتها، وهي أن الله قد خلق الإنسان عاقلًا واجتماعيًا، وخلق فيه غريزة حفظ الحياة، ومن هنا نتبيّن بوضوح لماذا فرض الله هذه القواعد على خلقه وليس لهم إلا أن يتقيَّدوا بها، فعلى الجميع أن يحترموا، بلا مواربة، وعلى نحو متبادل، الحق في الحياة والحرية والملكية.
لا بد أن تكون هذه القوانين مُلزمة لأن من حق الخالق أن يفرض ما يرتئيه من قواعد على مخلوقاته، إلا أننا لسنا في حاجة للوحي ليبيّن لنا ما هي تلك القواعد، فهي بيّنة اعتبارًا لطبيعة تلك المخلوقات.
لقد تطوَّرت فكرة القانون الطبيعي أو النظام الطبيعي بالتوازي مع إعادة تشكيل بنية المجتمعات الأوروبية. وقد أحدث لوك نقلة نوعية في الموقف من إعادة البناء مستفيدًا من خلفيته السيكولوجية التي ترى في العقل البشري صفحة بيضاء تنتظر أن تخطَّها العادات (التجربة). وقد انشغل كثيرًا بمسألة إعادة بناء مجتمعه، كما رأينا، لا سيما في أطروحاته حول التربية. ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة، فالرجل واحد من أبرز أقطاب التقليد الحديث في نظرية القانون الطبيعي.
ما الذي يقف وراء ترابط هاتين المسألتين؟ لماذا احتاج المؤسسون إلى شيء مثل القانون الطبيعي؟ لماذا لم يكتفوا بتطوير نظرية في الطبيعة البشرية بوصفها طبيعة طيّعة ومرنة (وهو ما أفلح فيه لوك على نحو لافت جدًا) ألم يكن حريّ بهم الاكتفاء بذلك؟
إنهم إنما احتاجوا ذلك لحاجتهم إلى أساس صلب لنظام عمومي يقبل به الجميع. ولقد نشأت الرواقية الجديدة في خضم الصراع الطائفي المرير والعنيف، فكان من الضروري، عندئذ، توفير قاعدة لاتفاق العقلاني حول مقومات الحياة السياسية بعيدًا عن الاختلافات الطائفية التي لا سبيل لإنكارها. وفي هذا المضمار طور غروتيوس، مقتفيًا أثر ليبسيوس، نظرية كاملة ليس فقط في طاعة الدولة، وإنما أيضًا في احترام قانون دولي قادر على تجاوز، بحكم صلاحياته، الانقسامات الطائفية. وبالفعل فقد كان الهدف من نظرية القانون الطبيعي توفير أرضية تفاهم ووفاق عقلاني تقوم بديلًا عن النظريات الدينية الأحادية المتطرفة، وقد استطاعت نظرية القانون الطبيعي في صيغة لوك أن تستبعد، لاحقًا، نظريات أخرى خطيرة ومعيبة إلى أبعد حد نشأت كردَّة فعل على الصراعات الدينية كنظريات السيادة المطلقة التي لا يحدّها أيّ قانون.
وإذ أشير إلى ذلك هنا لاعتقادي الراسخ بأنه يجب أن نضع في الاعتبار أن هناك نظريات منافسة للنظام الناشئ عن القانون الطبيعي صممت خصيصًا لحلحلة الصراعات الدينية ومأسسة إعادة بناء المجتمع. وذلك ما نسيناه منذ ذلك الحين لأن الخاسرين تواروا عن الأنظار في التاريخ، إلا أن أهم نتائج فوضى الحروب الدينية خلال القرن السابع عشر تتمثل في بروز الحكم المطلق، وهو نمط من الحكم يقوم أساسًا على تصوره الخاص به للنظام. وإذا كانت وجهة النظر هذه قد توارت عن أنظارنا، فلأنها تأخذ بعين الاعتبار أفكارًا أقل راديكالية من الأفكار الحديثة. وذلك، أولًا، لأنها حافظت على تراتبية نظام الحكم بحيث يبدو المجتمع كما لو كان منتظمًا في شكل مستويات عديدة ومراتب مختلفة، لا تختلف كثيرًا عن تصنيفات العصور الوسطى في بدايتها. وثانيًا لأنها اكتفت بالحفاظ على الفهم العضوي القديم للمجتمع. ومن جهة أخرى كانت مختلف الصيغ التي اقترحتها نخب المفكرين حديثة إلى أبعد حد، وهو ما نعثر عليه في مؤلفات بوسياي Bossuet، على سبيل المثال.
تنطلق هذه الصيغ من الفكرة الحديثة للسلطة كبناء للنظام، وليس باعتبارها تطابقًا مع ذاك الذي يوجد فعلًا في “الطبيعة”. وقد اعتبر النظام السياسي، مثلما هو الحال بالنسبة لنظرية القانون الطبيعي، من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي وعلى المدنية، شأنه في ذلك شأن فعاليات أخرى منافسة لها. يكمن حل هذه المعضلة في الحكم المطلق وفي التراتبية الاجتماعية الثابتة، ولا يمكن أن نستمده من طبيعة الكوسموس. فالحكم المطلق يخضع جميع الأشخاص إلى إرادة شخص واحد لا سبيل للاعتراض عليها أو مناقشتها تعيّن موضع السيادة التي بدونها تصبح استمرارية المجتمع مهددة بحسب هذه المقاربة الحديثة المرتكزة على فكرة الإرادة، أما التراتبية الاجتماعية فتمنح النظام شكله النهائي عبر تعيين الدور والوضع اللذين يناسبانه، وعبر وضع سلسلة من الأوامر العليا التي يتعيّن على جميع أفراد المجتمع الالتزام بها.
يبدو هذا الحل، بالنسبة للكثيرين في القرن السابع عشر، أكثر إقناعًا من الناحية المنطقية وأكثر نجاعة من الناحية السياسية على حد سواء من ذلك الذي يرتكز على نظريات الحقوق الطبيعية Natural Rights. وبالفعل، فقد أقامت الصيغة القديمة، ما قبل لوك، نظرية القانون الطبيعي اتفاقًا مع نموذج صريح للسيادة لا ينفصم. فالغاية من العقد الاجتماعي، في تقدير غروتيوس وبوفندروف، هي تحديدًا إقامة حكم ذي سيادة من هذا القبيل.
إضافة إلى ذلك، يستند هذا التصوّر التراتبي للنظام إلى مذهب العناية الإلهية، ذلك أن طاعة هذا النوع من السيادة، هي في الآن ذاته، خضوع للإرادة الإلهية على النحو الذي يتجلّى بوضوح بصفة خاصة في الصيغة ذائعة الصيت لهذا التصوّر في أيامنا هذه لنظرية مَلكية الحق الإلهي.
يبدو أن هذا التصور للنظام بحسب وجهة نظرنا اليوم، يقع في منطقة وسطى بين تصنيف القرون الوسطى والحداثة التي تُهيمن عليها فكرة الحق الطبيعي. ويبدو أن هذا الحكم قد عفا عليه الزمن ضمن بعض الوجوه، ذلك أن وجهة النظر هذه رغم أنها هيمنت في الماضي فإنها لا تعبّر إطلاقًا آنذاك عن وضع انتقالي. ومع ذلك لا يخلو هذا الحكم من بعض الصواب على اعتبار أن مفهوم النظام هذا يحتفظ ببعض رواسب التصنيف الذي كان سائدًا في ما مضى، وهو بذلك مواصلة للأنظمة المَلكية السابقة.
يعكس الحكم المطلق من حيث بنيته امتدادًا لنظام الحكم الذي كان سائدًا في العهود القديمة، ولأنه يقوم أساسًا على فكرة التكامل، فإنه لا يختلف كثيرًا عن الكنيسة الكاثوليكية ما بعد الثالوثية Post-Tridentine، ومع أن هذا التوازي قد يشي بالتنافس، فإنه يمكن أن يقود إلى تقارب بين الكنيسة والأنظمة الملكية التي تعتنق وجهة النظر هذه. وبفضل هذا التقارب سيتعزز الوجه الكارثي للكنيسة الذي كان سائدًا في النظام القديم أكثر فأكثر. وعليه قد نجانب الصواب إذا اعتبرنا هذا التصوُّر التراتبي للنظام “باروكيًا” baroque على الرغم من أن الفن والعمارة اللذين ازدهرا تحت هذا الاسم لم يهيمنا في المجتمعات التي تبنت هذه الصيغة النظرية-السياسية (ففي فرنسا، كان لويس الرابع عشر يعتبر نفسه “كلاسيكيًا” Classical) ومما لا شك فيه تعكس هذه الأشكال الفنية هذا الخليط بين التراتبية والتعالي الذي يُميّز هذه الصيغة.
لقد اتخذت نظرية الحق الطبيعي كما صاغها لوك منحى آخر. وإذا كانت هذه النظرية، بطبيعة الحال، تؤكد على البعد الإرادي بوصفه الضامن لإعادة بناء المجتمع، فإنها كانت في حاجة أيضًا إلى تصوُّر معياري للنظام حتى تكون قادرة على مأسسة قواعد وغايات إعادة البناء هذه. فالمفاهيم الأساسية هي التي تحدد تلك الحالة وليس التراتبية والنظام. فهذه النظرية تأخذ في المقام الأول تنافسًا بين أشخاص متساوين معنيين بالدخول جميعًا في مجتمع قوامه المنفعة المتبادلة.
لقد بدأ هذا النظام المعياري يفرض نفسه تدريجيًا كخطة توجِّه هذا النوع من المجتمع، والتي على ضوئها يتحدد الهدف من إعادة بنائه. وبالفعل فهذه الكائنات العاقلة والاجتماعية إنما خُلقت لتعيش معًا في كنف احترام حق كل شخص في الحياة والحرية. كما يتعيّن عليهم أن يحافظوا على أرواحهم عبر الاستغلال الدؤوب للطبيعة التي تحيط بهم([70]) على أن يُفضي هذا الاستغلال إلى النماء الاقتصادي. فحق الملكية الذي انبثق مباشرة عن هذا الاستغلال للطبيعة هو الذي جعل هذا التطور ممكنًا في الآن ذاته، ومن ثم تحقيق النماء الاقتصادي.
إن أهم ما تمخَّض عن هذا التفكير في القانون الطبيعي هو قاعدة نظام مستقر يتكوَّن من أشخاصٍ مجتهدين، مثابرين في عملهم، نذروا أنفسهم في سبيل تحقيق النمو والازدهار، بدل الحرب والنهب، ويقبلون أخلاقًا قوامها الاحترام المتبادل وأخلاقيات قوامها تنمية الذات. ولا يبدو النظام فقط فكرة جيّدة، بل أكثر من ذلك إنه الأكثر عقلانية، وهو هبة الله لعباده، وأسلوب عيش. ولا تتمثل الغاية في موافقة هوى النفس واتباع التفضيلات الأنانية وإنما في التوجُّه حيث تتَّجه الأمور نحو مستقر لها.
ليس النظام الطبيعي للأشياء كما سيكون متحققًا في التاريخ – وهي الفكرة التي ظهرت مع هيجل الذي أدمج وجهة النظر البنائية هذه مع الثيولوجيا الأرسطية – وإنما بمعنى ما نحققه عبر ما نبذله من مجهودات من أجل غاية معقولة بل وتحظى بعناية الله.
ولنا أن نتبين راهنا كيف استطاعت هذه المجهودات أن تفرض نفسها على المدى البعيد. ونشهد كذلك ميلاد مفهوم جديد أصبح يُعرف اليوم باسم “التنمية”، حتى إنه لم يعد ممكنًا فهم المجتمع والتاريخ الإنسانيين، بل على ما يبدو ليس في وسعنا أن نفعل أو أن نعرّف الخير الاجتماعي بدونه.
من البديهي إذن أن يتغيّر فهمنا للزمن بشكل جذري. كما أن الجهاز الذي يُمكّننا من التفكير في التوازن التراتبي يتماشى مع فهم للزمن تلعب فيه الدورات الزمنية دورًا مهمًا، وحيث تتمايز الفترات الزمنية نوعيًا: كان هناك زمن الكرنفال وزمن “الفوضى”، ثم زمن العودة إلى النظام. وأن الزمن الممتد هو زمن إعادة البناء الحديث، وهو خطِّي ومتكوِّن من زمن “متجانس وفارغ”([71]).
ستشهد فكرة النظام الطبيعي مزيدًا من التطوُّر خلال القرن الثامن عشر، وستستكمل التحوُّل الذي طرأ على الفهم القديم للسلسلة الكبيرة للكائنات ونظامها التراتبي، والتي ستتحقق صورها في الوجود وفي العوالم الطبيعية التي تم خلقها من أجل تلبية حاجات تلك الكائنات واستجابة لأنشطتها، ففي إطار هذا التطوُّر المتواصل تتعاضد ويساعد بعضها البعض.
من المثير جدًا أن نفتقد اليوم ذلك التوازن الذي كان حاضرًا في فهم القرن السابع عشر. فقد وقع إحداث توازن في فكرة الصراع مع الطبيعة من خلال فكرة التناغم مع مصيرنا النهائي. ففي القرن الثامن عشر وقع إدراج تناغم المصالح منذ البدء في الطبيعة البشرية. إن الانسجام والاشتراك في المصالح كفيلين بخلق نظامٍ خالٍ من النزاعات، ولنا أن نبحث عن القوى الشريرة التي جعلت الأمور تسوء: الملوك أم الكهنة أم حرَّاس الأرض؟
لا مجال للمبالغة، فالتحوُّل أبعد من أن يكون كليًّا. ولكن الصعب ولّى وانقضى وهذا ما يعكسه الوضع الجديد. فقد ساد اعتقاد في أوساط النخب الصاعدة في أوروبا بأننا بلغنا “الحضارة”، وأن التغيير الكلي للمجتمع أصبح في متناولنا، إنه يحتاج فقط لحزمة من الإصلاحات: السياسية (حكومة تمثيلية) والاقتصادية (دعه يعمل، دعه يمر) والاجتماعية (القضاء على الطبقية والامتيازات). وفي الواقع اعتبرت بعض هذه البرامج الأخيرة مناهضة لـ”لحضارة” كما ينبغي فهمها (وهي الحقيقة التي أكدتها العديد من كتابات روسو).
هنا يكمن المأزق الذي يثيره الوعي بنظام كامل، أي ذلك الإحساس بأن القوى التي راهنت على إعادة البناء قادرة على النجاح في مهمتها، وأنها ستساعد على ازدهار النزعة الإنثربومركزية وتهيئة الظروف الضرورية لولادة النزعة الإنسانية الحصرية من رحم التاريخ.
4
ولكن قبل التحوّل إلى هذه المسألة، أريد الاهتمام مرّة أخرى ببيان كيف ساهم التقليد الرواقي الجديد، ضمن بعض الوجوه، في بلورة بعض الأسس التي قامت عليها هذه النزعة الإنسانية.
لقد أشرت أعلاه إلى كيف أن الرواقية الجديدة نزّلت الموقف البنائي منزلة متميزة. فقد انتقل التركيز من فكرة وجود صورة تسعى إلى التحقق ذاتيًا، ولكنها تقتضي مساهمتنا في ذلك، إلى تلك الصورة التي تفرض ذاتها على حياتنا من خارجها عبر قوة الإرادة. وقد تم هذا الانتقال إلى أخلاقيات البويزيس في القرن السابع عشر، عبر تطوير نظرية جديدة عن الفعالية المتحرّرة، وتصوُّر جديد للفضيلة بوصفها هيمنة الإرادة على الانفعالات. وتعتبر مقاربة ديكارت لهذه المسألة واحدة من أهم المقاربات الأكثر تأثيرًا في هذا الشأن.
ما من شك أن ديكارت تأثَّر بتيار الرواقية الجديدة وخاصة بتلاميذ ليبسيوس الفرنسيين أمثال غيّوم فار Vair وبيار شارون Charron. ومما لا شك فيه أيضًا، أنه قد اكتشف فكر ليبسيوس أثناء دراسته في معهد لافلاش على يد معلميه من اليسوعيين. فقد أخذت الرواقية الجديدة منعرجًا جديدًا مع ليبسيوس حيث هجرت، كما رأينا، نموذجها الأصلي من خلال تركيزها على فكرة الإرادة، وكذلك على ثنائية العقل والجسد. وفي ذات الاتجاه لقد عمَّق ديكارت هذه القضايا عبر تطوير وجهة نظر مختلفة تمامًا.
ويُفهم هذا الانتقال كتحوّل من ايتيقا ترتكز على نظام متحقق في الواقع، إلى أخلاقيات تعتبر النظام عملًا من أعمال الإرادة. لقد قوّض ديكارت تمامًا كل مقومات هذا التصوّر الأوّل للأخلاق، وذلك عبر تبنّي وجهة نظر ميكانيكية صارمة للعالم المادي. فلم يعد للقول بأن أشياء الطبيعة تعبير عن صور متحققة أي معنى. وبالتالي لم يعد لأي تفسير سببي (علّي) لنظام الأشياء معنى أبدًا. إن الصور والتعبير عنها تنتمي حصرًا إلى مجال العقل. أما المادة فلا يمكن تفسيرها إلا ميكانيكيًا.
وعلاوة على ذلك، فهذا التمييز ضروري بالنسبة إلى الأخلاق. فالفضيلة تتمثل في العقل وفي الإرادة، وهذا يفرض أن تكون النفس سيّدة على الجسد وأن تتحكم فيه. وعلى مجال الأشياء التي تنشأ على اتحاد النفس والجسد، وخاصة الانفعالات. ففي انعدام تمييز واضح لن يتسنى لنا أن نُميّز مَن عليه أن يتحكم في ماذا.
يفرض علينا العلم كما الفضيلة نزع السحر عن العالم، وأن نميّز بشكل صارم بين العقل والجسد، وأن نُنزِّل الأفكار والمعاني إلى العالم العقلي الداخلي. فلا بد من رسم حد فاصل على نحو صارم حتى يتَّسنى لنا تحديد الأنا العازلة كما بيّنا سابقًا.
ولن يتسنى لنا، حسب ديكارت، أن نرسم هذا الحدّ الفاصل، إلا إذا أدركنا الواقع على أنه واقع ميكانيكي خالص، ولا غنى عن ذلك. في حين يتم التركيز في المجال الإيتيقي على البراكسيس بالأساس، حيث يتعيَّن علينا معالجة ما لا يحيط به العقل ضمن منظور ميكانيكي، وهذا يفترض اتخاذ موقف أداتي أو موقف بنائي منها. ولا ينبغي لهذا الموقف أن يتعلَّق فقط بما هو جسدي، بل يجب أن يشمل كل ما ليس عقليًا خالصًا. وبعبارة أخرى، يجب عليه أن يشمل كل الأشياء التي تنشأ في العقل فقط، بسبب اتحاد النفس والجسد، وخاصة الانفعالات.
إذن استطاع ديكارت أن يُطوِّر نظرية حول الانفعالات، تختلف تمامًا عن تلك التي تقول بها الرواقية. إن الانفعالات بالنسبة إلى هؤلاء هي آراء خاطئة. ومن ثم فإن الحكمة تعني التحرّر من وطأتها فتزول كما تزول الأوهام. وبالتالي يتنزل فهم ديكارت لعالم الانفعالات ضمن سجلّ مغاير تمامًا. فالانفعالات استجابات وهبنا إياها الخالق، من أجل مساعدتنا على أن نستجيب بالصرامة المناسبة ضمن بعض الظروف المناسبة، وبالتالي ليس هدفنا اجتثاث الانفعالات بقدر ما هو إخضاعها للتحكم الأداتي للعقل.
لا ينبغي التحكم في الانفعالات من أجل التخلص منها، بل لمعرفة قوانينها، فقد تكون بالنسبة لأفضل الناس عامل قوة أكثر من غيرها، فالمسألة الأهم بالنسبة لديكارت تتعلق بالتحكم فيها عن طريق الإرادة حتى نحسن استعمالها، فالانفعالات تتعلق بالطبيعة وإذن بالجسد. وهي ليست ضارة بالنفس بالأساس، طالما تتحكم فيها الأخلاق والإرادة الحرة القادرتان على تقييم الانفعالات. وقد كان ديكارت معجبًا “بالنفوس العظيمة التي تمتلك تحليلات منطقية قوية وعميقة جدًا. لأنه برغم انفعالاتها التي قد تكون أكثر شدّة وعنفًا من انفعالات عامة الناس، في أغلب الأحيان، فإن العقل يبقى دائمًا بالنسبة إليها سيِّد الموقف”([72]). إذا ما أردنا التخلص من هذه الانفعالات “يكفي إخضاعها إلى العقل، فحينما تُروَّض، ربما تُصبح أكثر نفعًا”([73]).
إنّ ما أخذه ديكارت حقيقة عن التقليد الرواقي وعن الرواقية الجديدة، هو قاعدة الانفصال. إنّ ما يُمليه علينا العقل هو اختيار الأفضل، وأنه علينا أن نعمل في سبيل تحقيق ذلك، ولكننا، على امتداد ذلك الزمن كله، في انفصال تام عن النتيجة. فـ”الأنفس العظيمة” يواصل ديكارت كلامه:
“تفعل كل ما في وسعها لتسخير أسباب الثروة لمصلحتها في هذه الحياة، إلا أن ذلك يظل قليلًا قياسًا لحياة الأبدية، ولا تعتبر الأحداث إلا كتلك تحيكها الكوميديات”.
فما زالت هناك بعض الرواسب الرواقية، تجلَّت خاصة في أهم مفاهيمها المحورية مثل الانفصال والثبات والصلابة فضلًا عن فكرة ضبط النفس بواسطة العقل. إلا أن الأنثروبولوجيا الكامنة وراءها قد تحوَّلت بشكل جذري.
يمكن رؤية الفرق بشكل أوضح عندما يتعلق الأمر بما يمكن أن يكون خيّرًا للحياة الخيّرة. أو من زاوية مختلفة نسبيًا، بطبيعة الغبطة أو الرضا اللذين يشداننا إليها.
ويتجلّى هذا الرضا، بالنسبة للنظرية الأخلاقية القديمة للصور المتحققة على مستويين: أولًا بما أننا تجسيدات على هيئة كائنات بشرية، فإن الميل إلى طيب العيش متأصل في طبيعتنا ومتوافق معها، لذلك ننفر من التمزق والاضطراب الدّاخلي، وننشد التناغم، حتى لا تعصف بنا القوى المعادية. فيكون بوسعنا الثبات. ولا تؤلمنا الأشياء التي تتوافق معنا البتة ومن ثم نحقق الاكتفاء بالذات.
أما على المستوى الثاني، فإنّ الصور متحققة في الكوسموس الذي يحيطنا بأسره، وهذا أمر على غاية من الأهمية بالنسبة إلى بعض النظريات الأخلاقية، من ذلك مثلًا أن العقل بالنسبة لأفلاطون ليس سوى القدرة على تمثل نظام الكوسموس وعشقه. فهذا العشق هو الذي يحملنا على الرغبة في محاكاته. والاقتداء به في تنظيم حياتنا([74]). فالقوة التي تدفعنا إلى الخير، لا تتأتى لنا من الصورة التي تُعيّن وجودنا، ولكن من التوافق مع الوجود المنتظم في كليته عبر مثال الخير الأسمى. وبعبارة أخرى، لا يتأتى لنا الرضا والغبطة من التوافق مع طبيعتنا فقط، ولكن أيضًا من توافق وجودنا مع الوجود في كليته.
لم تلجأ كل النظريات الأخلاقية القديمة، إلى هذا الانعطاف من خلال الكليّ، باستثناء أرسطو، ربما. أما الراقيون فقد كانت صيغتهم الخاصة. فالحكيم هو الشخص السعيد، لأنه يعيش في توافق مع طبيعته، ولكنه يرضى بكل ما يحدث له، باعتباره تجليًا من تجليات العناية الإلهية.
بيد أن تلك العناصر في معظمها، في نظرية ديكارت، اختفت أو أنها على الأقل قامت على أسس أخرى مغايرة. رغم أن مفهوميّ الصلابة والعناية الإلهية حافظا على معنييهما. أما الكون فلم يعد يعكس صورة النظام المتحقق في الأشياء. وأقصى ما يمكننا الحصول عليه من ذلك كله، تمثل نمط اشتغال الأشياء بتبصر. وهذا ما يتعيّن علينا تحقيقه كما في براديغم الانفعالات.
فما هو أشدّ أهمية في كل ذلك، هو ما يترتَّب عنه من سعادة، إلا أنها سعادة لا تُضاهي البتة تلك التي تترتَّب عن التناغم أو غياب الصراع. إن الإنسان الخيّر هو تحديدًا إنسان محصَّن، وهو مُطالب بممارسة كل قوته. ففي خضم انفعالاته الأكثر شدَّة وعنفًا من انفعالات الشخص العادي “يبقى عقله سيِّد الموقف على الدوام”، فلا يقوده ميله الطبيعي وإنما يناضل من أجل فرض النظام الذي أنيط بعهدته. ولن يتأتى له ذلك إلا من خلال انتصار الإرادة([75]).
لم يعد التناغم-الخالي من الصراعات تاج الفضيلة، وإنما النضال-من أجل السيطرة. فالغبطة التي تترتب عن ذلك هي في الرضا بانتصار العقل، لأن الإنسان هو أساسًا إرادة عاقلة.
علاوة على أن الإرادة الحرَّة في حد ذاتها بوصفها أنبل الأشياء فينا إذ تجعلنا ضمن بعض الوجوه شبيهين بالله، فإن حُسن استعمالها، هو أعظم جميع خيراتنا، فلا شيء أهم من ذلك بالنسبة إلينا، إذ من خلال ذلك فقط نحقق أعظم اطمئنان([76]).
وهكذا فالاطمئنان معناه أن أرتقي إلى مستوى الكرامة التي أنا جدير بها بوصفي كائنًا عاقلًا، وأن هذه الكرامة تقتضي أن أتصرَّف بموجب العقل.
وبطريقة تبدو مثيرة للدهشة، أقحم ديكارت مصطلحًا رئيسًا حول أخلاقيات الشرف، هو “النبل”. وقد كان لهذا المصطلح معنى مختلف في القرن السابع عشر. فهو يُفيد بأن الشخص له من الحظوة والشرف ما يحفزه على العيش وفقًا لمتطلبات وضعه. فقد كان أبطال كورناي Corneille يتبجَّحون دائمًا بأن “نبلهم” هو الذي يدفعهم إلى خوض المعارك والأعمال القيّمة، وأحيانًا المرعبة التي ينوون القيام بها.
بيد أن ديكارت ينقل المعنى من الفضاء العمومي، ومن مجال مراتب محددة اجتماعيًا إلى فضاء معرفة الذات الحميمي. إذ النبل الحقيقي “الذي يجعل من الإنسان يحترم نفسه قدر استطاعته إلى أعلى درجة يمكنه بحق أن يحترم ذاته بها، يقوم في جزء منه فقط في أن هذا الإنسان يعرف بأنه ما من شيء ينتمي إليه حقًا غير هذا التصرّف الحرّ في إرادته، وأنه ما من داعٍ لأن يقرظ أو يلام إلا لحسن أو سوء استخدامه للحرية الموضوعة تحت تصرفه، أما الجزء الآخر من النبل فيقوم على أن ما يحدو الإنسان في ذاته من تصميم صلب وثابت في أن يستعمل هذه الحرية استعمالًا جيدًا، أي في ألا تنقصه الإرادة أبدًا كي يبادر إلى القيام بكل الأشياء التي يحكم بأنها الأفضل وينفذها”([77]).
إن المرتبة التي يجب أن أرتقي إليها هي مرتبة الفاعل العقلاني غير المحدد اجتماعيًا. ذلك هو معنى الكرامة التي قال عنها ديكارت: “إنها مفتاح كل الفضائل والعلاج العام ضد انحرافات الانفعالات”([78]). بعبارة أخرى إنه الفضيلة التي تدعم كل الفضائل الأخرى، حتى أن المكانة المتميزة التي احتلها النبل لدى ديكارت تضاهي مكانة الحكمة لدى سقراط أو الاعتدال لدى فلاسفة آخرين. إن الدافع الرئيس هو ما يتطلبه وضعي ككائن عاقل، والرضا يتأتى لي من خلال ارتقائي لما يستحقه ذلك الوضع من كرامة.
إن ما يحفزنا الآن لم يعد ذلك الإحساس بأن نكون في مواجهة مع الطبيعة ومع الكوسموس وإنما شيء ما يشبه الشعور بقيمتنا الذاتية، إنه شيء ذو مرجعية ذاتية بشكل واضح. شيء قريب من الفكرة الكانطية عن التشريع الذاتي. وهو ما يمكن اعتباره عنصرًا حاسمًا في ظهور النزعة الإنسانية الحصرية([79]).
تفترض الأخلاقيات الجديدة التي تقوم على التحكم العقلي، كما رأينا سابقًا، نزع السحر. وهي، بالفعل، أحد أهم العوامل الرئيسة في هذا المضمار، شأنها في ذلك شأن حركة الإصلاح التي ترفض ضروب التقديس القديمة. وبذلك ساهمت في خلق الهوية الجديدة التي سميتها بالذات العازلة بل وعززتها أيضًا.
إن الذات العازلة هي ذات فاعلة لا تخشى الشياطين أو الأرواح الشريرة وقوى السحر لأنها تعتبرها قوى فاقدة أصلًا لكل فعالية وتأثير. بل لا وجود لها بالنسبة للذات العازلة لأنه مهما يكن حجم تهديدها أو ما تحمله من دلالات فليس لها أن “تنفذ” إليها، وبالمثل يلعب الحكم العقلي المتحرِّر بالدور ذاته تجاه الرغبة.
بطبيعة الحال، تؤثر رغباتنا فينا على الدوام بوصفها ميولًا لا سبيل لإنكارها، ولكنها تفتقر إلى أيّ معنى من القداسة والتسامي لأنها ليست سوى إغراءات يتعين علينا اتخاذ مسافة منها، وإيجاد الطريقة الفضلى للتصرُّف فيها وفق مقتضيات العقل.
تتمثل الوظيفة الأساسية لعقلنا في ما يتعلق بتدبير حياتنا في معاينة قيمة كل كمالات النفس والجسد التي يمكن تحصيلها عن طريق سلوكنا بمعزل عن الانفعالات [….] بحيث قد نضطر، أحيانًا، إلى أن نحرم أنفسنا من بعض الخيرات من أجل الحصول على خيرات أخرى لأنه يجب علينا أن نختار الأفضل دائما”([80]).
من الواضح، إذن، أن على أيّة أخلاق متعالية تريد السيطرة على الانفعالات أن تقوم بعملية فضح من هذا القبيل. لأن انفعالاتنا “الدنيا” عادة ما تُحيط بها هالة كبيرة جدًا. وكثيرًا ما استثمر الدافع للعنف، على سبيل المثال، كما لو كان وعيًا بلحظة زمنية عظيمة. فقد يُخيّل إليّ أن أيّ إهانة لي إنما تضع شرفي في الميزان بحيث أجد نفسي مضطرًا، ربما، لأخوض معركة عنيفة تبدو في الظاهر من أجل غرض نبيل. وفوق ذلك كله، وكأننا بالعنف أصبح في ظاهره أكثر إثارة من حيث أنه يبدو كما لو كان يسمو بنا عن تفاهة الوجود اليومي ويرتقي بنا إلى أعلى درجات التسامي والمجد. ولعله في هذا المستوى بالذات يقترب من ميدان الرغبة الجنسية إلى حدّ التشابك أحيانًا. وسواء تشابكا أو انفصلا، فكلاهما يمنحانا الإحساس بالرغبة في الهروب من الحياة اليومية، ومن رتابة العالم العادي. ولعله لأجل ذلك أيضًا يظهران بشكل متشابك أو منفصل أثناء ممارسة الطقوس، كما في الكرنفال مثلًا.
ومن المواضيع المهمة التي أثارتها كل المقاربات الأخلاقية القديمة تلك المتعلقة بفضح زيف هيبة الرغبات وتبديد ما أحاط بها من هالة مزعومة. وفي هذا المضمار، لا تختلف أخلاقيات التحكم العقلي عن ذلك في شيء، فقد بذل أفلاطون وكذلك الرواقيون من بعده قصارى جهدهم من أجل بيان أن كل ما يبدو لامعًا في العتمة ليس إلا وهمًا لا يمكن أن يصمد أمام ضوء النهار مهما يكن خافتًا، إذ تختفي تلك الهالة التي أحاطت به تمامًا. وقد تجلّى فضح هذا زيف أكثر في التهجم المتواصل على أخلاقيات الشرف منذ أفلاطون مرورًا بالرواقيين وأوغسطينوس وانتهاءً بالعصر الحديث. وأعني هنا الأخلاقيات في صورتها الأصلية التي تجعل من الاعتراف العمومي مجدًا وغاية تستحق التقدير، ولا أقصد النسخة المتسامية ذات الصبغة الذاتية التي نجدها عند ديكارت مثلًا، تلك النسخة التي تسعى إلى أن تقوم بديلًا عن سابقتها ذات الطابع العمومي. لقد انتقد المجد باعتباره مجرد مظهر زائف ناتج عن التكبّر (أفلاطون)، ومصدرًا للشر (أوغسطينوس) و”مجدًا-عبثيًا” (هوبز).
لكن فضح الزيف هذا لم يُبدِّد تمامًا تلك الهالة التي تحيط بالرغبة في النظريات القديمة. فالرغبة الجنسية في شخص جميل هي، حسب أفلاطون، اعتراف باهت ومشوّه بفكرة الجمال التي تصبو إليها النفس، أما في صورتها الحالية، فإن الرغبة عاجزة عن الوفاء بوعدها وأن الوعد ليس خاطئًا تمامًا، فكل ما هنالك حقل إغراءات لا يمكن إنكارها، ولكنها ليست أكثر من عالم خارجي تمَّت مكننته، لا يمكن أن يكون موطنًا للمعاني السامية، بحيث لا تعدو أن تكون تلك الإغراءات إلا إغراءات مشوشة ومشبوهة. إذن، هذا الحقل فاقد لأيّ معنى، ولا يتعلق الأمر بمجرَّد أن الهيبة الزائفة للرغبة يمكنها أن تشوِّه ما يمكن اعتباره عبثًا الأساس الحقيقي للهالة التي تحيط بها، بقدر ما أن تلك الهالة ذاتها هي وهم محض.
معنى هذا أننا لسنا في حاجة إلى معرفة مخصوصة حتى نتبيّن زيف هذه الهيبة. وأن كل ما علينا فعله مرة واحدة وإلى الأبد هو اتخاذ موقف سليم يأخذ بعين الاعتبار فعالية العقل وتحكمه، وبذلك نضع نهاية لعالم الانفعالات بكل ما تعنيه العبارة من معنى. ومن ثم يكشف عن طبيعته الحقيقة بوصفه عالمًا منزوع السحر.
إن هذا الفاعل هو، بمعنى ما، عازل إلى أقصى حد. إذ لن يكون بمقدور الشياطين أو الأرواح الشريرة أن “تقترب منه” ولكنه أيضًا وبشكل أساسي لا يكترث البتة بتلك الهالة التي تحيط بالرغبة. ففي الكون الميكانيكي، وفي المجال الذي تُفهم فيه الانفعالات فهمًا وظيفيًا، لا مكانة أنطولوجية فيه لمثل هذه الهالة. لا شيء يمكن أن يتوافق معها، فهي مجرد أحاسيس مثيرة للقلق ومُعكّرة لصفونا، وتستحوذ على ذواتنا إلى أن نستعيد من جديد ملكاتنا العقلية ونضطلع بهويتنا العازلة بشكل تام.
غنيّ عن التذكير أن الحداثة لا تتوقف على أخلاقيات التحكم العقلي. فهذه ليست سوى إحدى النقاط الحسَّاسة التي تعكس عدم الرضا عن هذا التأويل للهوية الحديثة الذي أثارته نزعة فكرية وحسية أطلق عليها أحيانًا اسم “الرومنسية”. وليست تلك الفكرة التي تقول بأنه يمكن أن نجرِّد هذا الأحاسيس من كل هالة خاطئة فقط، ولكن أيضًا من شأنها أن تؤدي إلى تفقيرنا بشكل مفزع من كل أحاسيسنا وإلى إنكار إنسانيتنا.
ولكن ضمن هذه الهوية للعقل المتحرِّر، تحذو عملية نزع السحر بالتحكم الأداتي حذو النعل بالنعل وهذا تحديدًا ما مهَّد الطريق للخيار الجديد، خيار النزعة الإنسانية الحصرية.
5
لقد أصبح هذا الموقف المتحرِّر والمنضبط تجاه الذات والمجتمع مقومًا جوهريًا من مقومات الهوية الحديثة، وهو تحديدًا وجه من أهمّ وجوه العلمانية بالمعنى الثالث. وقد ساهم الموقف المنضبط في بناء الوجه الثاني لما سميته الذات العازلة. وقد بيَّنت أعلاه أن نزع السحر يمكن أن يعني أيضًا رسم الحدود ووضع حد لمَساميّة الذات والتصدِّي لعالم الأرواح.
هكذا إذن، أفضى فك الارتباط إلى رسم الحدود وإلى التراجع عن بعض أنماط الحميمية واتخاذ مسافة من بعض الوظائف الجسدية، وهو ما بيّنه نوربرت إيليا Norbert Elias ببراعة في كتابة الرائع([81]).
نقيم علاقة حميمية مع شخص ما عندما يكون هناك تدفق في المشاعر بيننا وهي بصفة عامة العلاقة التي نقيمها مع أفراد الأسرة أو مع الأصدقاء المقرَّبين.
ولهذه العلاقات أولوية أنطولوجية وجينية لأنها تمنحنا منذ سن مبكرة من طفولتنا وفي سن الحداثة الاعتراف، لأن ازدهارنا وارتقاءنا إلى المرتبة الإنسانية يمر عبر تلك العلاقات الحميمية. فإذا حُرمنا من تلك الحميمية على مستوى معيَّن، يصبح من المستحيل علينا أن نعرف من نحن أو أن عالمنا يلقى نهايته.
ومن هنا يمكن أن نعتبر هويتنا وإحساسنا بما هو مهم حقًا، كما لو كانا مشدودَيْن إلى علاقات معيَّنة على نحو جوهري: ما كان لنا لنفهم من نحن حقًا، وما يكون مهمًا بالنسبة إلينا إلا من خلال علاقة ربما تكون علاقة حب أو علاقة ما تشدنا إلى بطل أو قديس أو زعيم أو قدوة. وهكذا، كلما جدّ طارئ داخل تلك العلاقة من شأنه أن يُهدد تلك الهوية. وهؤلاء فراقهم إذا ما ماتوا صعب، ولكن سرعان ما نتجاوز ذلك من دون أن نفقد علاقتنا بهم، إلا أن الأسوأ من ذلك هو عندما يتحلل الحامض النووي وتنقطع صلتنا بهم تمامًا، وتتغيَّر نظرتنا لهم كليًا، عندها تتأكد مصيرية هذه العلاقات.
وبطبيعة الحال، نشعر بحاجتنا خاصة أثناء مرحلة الطفولة إلى علاقات حميمية، لكن، في وقت لاحق، يتم تدريب الأفراد على هوية متنصلة من تلك العلاقات المتينة والحميمية التي تصلهم بذوي القربى. من ذلك مثلًا أنه في المجتمعات التي تخوض حربًا، يُفصل الأطفال الذكور عن البنات في سن معينة. ولما كانوا في حاجة دائمة للاعتراف، فسيلقونه، هذه المرة، من قبل أناس آخرين، قادة الحرب الذين يتبادلون معهم علاقات تفتقر إلى الحميمية وأقرانهم، حيث المزاح الأشج والفض والمفاخرة، خلافًا لما كانت تتَّسم به علاقاتهم بالنساء من انفتاح وعطاء وليونة، وهي علاقات أصبحت من الماضي ولم يعد لها أيّ أهمية.
وهكذا يأخذنا فك الارتباط هذا خطوة أخرى في اتجاه قريب نسبيًا، في الحقيقة، من أخلاقيات الحرب (كما في إحالة ديكارت على “الكرم”)([82]) إلا إذا كان الانضباط في تمامه يتعلق في الزمن الحاضر بمبدأ لا شخصي، ففي الحد الأقصى يمكن تبنّي الأمر الاحترازي التالي: لا تعتمد إلا على ذاتك ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، ولتكن علاقتك بالله أو بالمبدأ علاقة شخصية، فإذا قُدِّر لك أن تُبدي نوعًا من الحنان فلا تبديه في علاقة مصيرية. ففي النهاية، “تذوب” كل العلاقات المصيرية في الله وفي المبدأ.
وبطبيعة الحال، من الصعب جدًا بلوغ هذه النقطة النهائية، إنها فقط أقصى ما يمكن أن يبلغه الطموح، لا بدايته. نحن في حاجة جميعًا إلى الاعتراف حتى نتدبَّر أمر هويتنا في البداية، لأنه لن نستطيع تدبير أي شيء بدونها. ومن ثم لا يمكن لهويات أولئك الشباب أن تزدهر إلا من خلال العلاقات التي يقيمونها مع زعمائهم أو مع زملائهم، لكن هذه العلاقات التي تظل هي بدورها علاقات مصيرية هي علاقات تقوم على القسوة والغلظة والانضباط وغياب الحميمية.
فالمراد من وراء ذلك متضمن أصلًا في طبيعة تلك العلاقات ذاتها: نوع من الاعتماد على الذات، نوع من الاكتفاء بالذات، أو الاستقلالية والسيادة المطلقة على الذات. ولن يتأتى لنا ذلك إلا من خلال الاعتراف. إلا أننا نحاول الالتفاف على ذلك عبر القفز على هذه المرحلة.
وبالتالي يُعيّن الانضباط غير الملتزم نمطًا جديدا من تجربة الذات تكون غايتها تحقيق السيادة المطلقة على ذاتها، ولنا في المعنى الفرويدي للأنا المعتد بعزلته خير مثال على ذلك. فالفضاءات المشتركة بين البشر لم تعد مهمة. فأعظم مشاعرنا ذاتية.
ولاحقًا، كردَّة فعل على هذا النوع من الانضباط نكتشف من جديد مشاعرنا العميقة وحميميتنا كما لو كانت قارّة مفقودة، فنعيشها بطريقة جديدة تحت أنوار جديدة. كما هو الشأن بالنسبة لإعادة اكتشاف المشاعر الدفينة المظفر عند ديفيد هيربرت لورنس D. H. Lawrence (قد يكون هناك تماثل مثير للقلق من حيث أن بعض القصص حول الأشباح ما زالت تثير بعض البشر رغم أن الاعتقاد في ذلك قد ولّى منذ أمد بعيد).
لقد نوَّه إيليا Elias بأهمية التحوُّل الهائل في العادات الذي تزامن مع تطور المثل الأعلى للتمدن وللحضارة في وقت لاحق. وهو تحوُّل حدث أولًا، بطبيعة الحال، في أوساط النخب ثم امتد تدريجيًا ليشمل المجتمع ككل خلال القرن التاسع عشر. وقد اقتضى هذا التحوُّل ارتفاعًا مطردًا لعتبة التبرم إلى حد الاشمئزاز أحيانًا، وهو ما لم يكن خافيًا على أحد البتة. وقد يفاجئنا ذلك، ولكن من دون أن يصدمنا كثيرًا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، مرة أخرى، ما حدث في القرن السادس عشر.
لقد أوصت الكتب الباكرة حول آداب السلوك واللباقة بعدم تنفط الأنوف باستعمال مفارش الطاولات (143-144) حتى أن كتابًا يعود إلى سنة 1558 ينبهنا إلى أنه ليس “عادة رائقة جدًا” أن يعثر أحدنا على براز على قارعة الطريق فينبّه الآخر بشأنه ثم يحمله إليه حتى يشم رائحته (177)، وكان يُطلب من الناس عدم التغوُّط في الأماكن العمومية (177) وبداهة نحن في زمن غير ذاك الزمن وقواعد السلوك في عصرنا تختلف تمامًا عن تلك التي كانت سائدة آنذاك.
لا يعتبر أن هذا التحوُّل حدث بغتة، وإنما تم بموجب ارتفاع تدريجي لعتبات الحساسية. وفيما كانت الكتب الباكرة حول معايير السلوك تنصح بعدم تنفط الأنوف باستعمال مفارش الطاولات، توصي المتأخرة عنها باستعمال المناديل الخاصة بذلك، وتمنع تنفط الأنوف أثناء الجلوس حول طاولة الأكل وما إلى ذلك… وإذا طُلب من الناس فيما مضى عدم التغوُّط في الممرات، فقد أصبح من غير اللائق حتى مجرد ذكر الغائط في كتب تهتم بآداب السلوك، حتى شهد الخوض في تلك الأشياء “فترة من الصمت”، بل وحجر حتى ذكر تلك الوظائف الجسدية (183-184).
يعزو إيليا هذا الانتقال برمته إلى عاملين رئيسين، يتمثل الأول في أن مقتضيات العيش المشترك تجبرنا على فرض قواعد صارمة، فيما يتمثل الثاني في أن هذا الانتقال يفترض أن على الناس أن يتحملوا العيش في مجتمعات تزداد كثافتها وتفاعليتها يومًا بعد يوم. إن تهذيب السلوك، إذن، هو “عملية التمدن” ذاتها (E332).
وبالتوازي مع ذلك، يحدِّد إيليا ديناميكية أخرى في عملية التمييز بين الطبقات أو الأوضاع، ذلك أن متطلبات التهذيب واللباقة تساعد على التميُّز بين الطبقات الراقية والدنيا، حيث تصبح هذه الأخيرة ضرورية أكثر، إذ يجد النبلاء أنفسهم مجبرين على اتّباع نمط عيش مهذب ولبق، حيث الموارد والقدرات الموضوعة تحت تصرفهم لا تكفي لتميزهم بشكل واضح عن البورجوازيين. وولّد هذا بطبيعة الحال، لدى بعض” البورجوازيون اللبقين” وغيرهم الرغبة في التشبّه بالطبقات الراقية وتقليدها، وهو ما تطلّب القيام بخطوة أخرى في عملية التهذيب حتى نحافظ على مسافة أمان (136-139, E83-85). ويضرب إيليا على ذلك مثلًا الأسلوب اللبق للغة الفرنسية، مما مكَّنها من بسط سيطرة هذه اللهجة لاحقًا على كل اللغات التي نتحدث بها في الزمن الحاضر (145-152).
وفيما يبدو لم تُجانب مجمل هذه الروايات الحقيقة، إلا أنه يمكن فهم التطورات التي يتحدَّث عنها إيليا في سياقين آخرين على علاقة بذلك، فلقد أردت أن أُبيّن أن تلك التطورات تعكس الكيفية التي ضيَّق من خلالها الموقف المتحرر والمنضبط مجال الحميمية، ومن ثم اتخاذ مسافة من مشاعرنا الأكثر قوة ومن وظائف أجسادنا.
وإذا ما تدبرنا مدى تأثير هذه التحولات فينا، فما سيقفز إلى الصدارة هو ارتفاع عتبة الحساسية وهذا ما نشعر به، خاصة عندما نقرأ عن الممارسات الأكثر إثارة للاشمئزاز كتلك التي ذكرتها. ولكن، في الواقع، نجد في بعض الكتب الباكرة حول آداب السلوك واللباقة أن المتلقي العادي ليس فقط غير معني بالنصائح المسداة لتجنب عن هذه الممارسات، بل يبدو أنه غير معني أيضًا حتى بنصحه بالتصدي لها بوصفها مثيرة للاشمئزاز، فما هو على المحك شيء آخر أهم من ذلك، يهم العلاقات الحميمية المسموح بها.
وفي الواقع، عديد القضايا التي أثيرت في تلك الكتب لها علاقة واضحة بالحميمية، مثل قضية الظهور العاري في الفضاء العام. أو السماح لطرف آخر لمتابعة أحدهم أثناء القيام بالوظائف الجسدية، أو تناول الطعام في الطبق نفسه. ولكن، من البديهي، أن هذا الاعتراض لا معنى له كلما تعلق الأمر بأشخاص يتبادلون علاقة حميمية، ناهيك أن الاعتراض على “اختلاط السوائل” مع شخص غريب عن طريق تبادل الملعقة نفسها، مثلًا، لا معنى له بالنسبة للعشاق، ذلك أن ممارسة الجنس هي في حد ذاتها اختلاط للسوائل باستهتار.
إن أولى المحاذير التي يثيرها ما جاء في كتب النصح في القرون الوسطى المتأخرة وحتى بدايات العصر الحديث، تبدو على صلة بمزاعم غير مبررة حول الحميمية. ذلك أن مجمل النصائح التي وردت فيها لا تنطبق على الجميع على قدم المساواة، وإنما تحذر من هُم أدنى مكانة من التجرؤ على التقرّب ممن أرفع منهم مقامًا.
وقد جاء في كتاب النصائح أو “آداب السلوك” Galateo في القرن السادس عشر ما يلي: “ليس من المناسب، فيما اعتقد، أن نخص شخصًا بعينه ببعض ما يوجد في طبق مشترك مخصص لجميع الضيوف، إلا إذا قام بذلك شخص أرفع مقامًا بِنيّة تكريم ذلك الشخص بصفة خاصة. لأنه لو كان الخادم والمخدوم متساويين لبدا كما لو أن الخادم أراد أن يُقدِّم نفسه على أنه أرقى من الآخرين” (ِE114)، إذن فالحظر يخص بشكل واضح الحميمية الوقحة. فإذا أقدم أحدهم ممن هم أرفع منك مقامًا على التقرُّب منك فلا ضير في ذلك، لأنه بقطع النظر عما إذا كان يُسئ إليك، فإنه يُشرفك، ولعله لهذا السبب بالذات يكون من غير المقبول مطلقًا أن تبادر أنت. ويوصي كتاب النصائح Galateo بعدم إظهار الحميمية للآخرين، ولكن، يضيف “لأننا لا نأتي بمثل هذه الأشياء وأخرى شبيهة بها ما لم يكن من بين الحاضرين من يثير خجلنا. فإذا ما أتى لورد كبير هذا الصنيع في حضور خدمه أو صديق أدنى منه مقامًا، فليس في ذلك تكبّرًا، بقدر ما يعكس صداقة ومودَّة خاصة” (E113).
وتقدم الآداب القديمة قيودًا غير متكافئة على الحميمية، وهي قيود أصبحت اليوم تخص طرفي العلاقة الحميمية على السواء وبشكل متكافئ تمامًا، ففيما يتعلق بالقيود غير المتكافئة ذات الصلة بالتراتبية السائدة، كان الملوك يرتدون ملابسهم على مرأى من حاشيتهم، بل حتى أثناء ترتيب أنفسهم للجلوس على كرسي العرش، وبالمثل ظهرت الماركيزة دي شاتلي، عشيقة فولتير عارية أمام خادمها عندما كانت تستحم، ولم يُربك المشهد الخادم قدر ارتباكه لإهانته لأنه لم يعدل الماء الساخن بشكل مناسب (E113).
ورغم ذلك فإن هذه المحظورات لم تتراجع تحث تأثير تقدم المساواة داخل العلاقات، بل على العكس من ذلك، تم تعميمها على الأشخاص المنتمين إلى الطبقة نفسها حتى أصبحت، في النهاية، كونية. لقد كانت القيود المفروضة على الحميمية الجسدية ذات صبغة ذاتية إذ لم تكن في البداية سوى تدابير لاحترام من هم أرفع مقامًا، ثم ما لبثت أن أصبحت محرمات تشمل جميع العلاقات حتى صرنا نتبرم من التعري على الملأ ونشمئز من الاختلاط (كما في استخدام شخص ملعقة شخص آخر مثلًا)، وما يثير دهشتنا أننا نقرأ كيف أن عظماء القرن الثامن عشر لا يشعرون بالحرج أو الهوان أن يتعرّون على الملأ. ربما نفكر اليوم في أن من بيدهم سلطة تعسفية يمكن أن يفرضوا على مرؤوسيهم بكل قسوة التعرّي على الملأ من أجل إذلالهم على نحو ما يفعل السجانون بمساجينهم. أما أن يتعرَّى العظماء على الملأ، فإن الأمر يبدو غريبًا.
يُترجم هذا الانقلاب في معنى التعري على الملأ إلى محظور معمَّم، فيما اعتقد، في مستوى أول، القطيعة مع العلاقة الحميمة المختلطة التي تمثل جزءًا من الانضباط الذي ميَّز الموقف الحديث. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا النوع من الحميمية يخص حلقات ضيِّقة من الأشخاص، وعمومًا الأسرة المقرّبة جدًا. إن لهذه المحظورات فاعليتها وإن بشكل جزئي. عليك أن تحتفظ لنفسك بوظائف جسدك العضوية من سوائل وإفرازات وأشياء أخرى كثيرة، وأن تحافظ على مسافة احترام معيَّنة بينك وبين الآخرين، فلا تتواصل معهم إلا عبر الصوت والوجه وعبر السمع والبصر، واحتفظ بالتعامل عبر اللمس لأقاربك أو ضمن طقوس معينة تسمح بذلك مثل المصافحة.
كما كان لهذا التحوُّل وجهًا آخر تمثل في تكثيف العلاقات الحميمية التي يمكن أن تنشأ في الأسرة أو بين المحبين، وعزلها عن العالم الخارجي في فضاءات جديدة أكثر خصوصية حسب قواعد أخرى عن الحميمية، حتى تغيَّر معنى الحميمية ذاته تغيّرًا جذريًا في ذلك العصر، حيث كانت علاقات الاختلاط القديمة مثلًا بين الأسياد والعبيد تُعبِّر عن تقارب ما، ومن دون تحفظ على أية حال. أما في العصر الحديث، فقد أصبحت الحميمية، في إطار حلقات ضيّقة حيث العلاقات أكثر كثافة، تعني ما هي عليه اليوم بالنسبة إلينا، أي الانفتاح وتبادل مشاعرنا “الشخصية” الأكثر قوة وعمقًا. وبطبيعة الحال، نشأ هذا البعد المتعلق بتبادل المشاعر كجزء من فهمنا الحديث في عصر أصبح فيه وجود مشاعر عميقة وكثيفة يُنظر إليه على أنه كمال إنساني أساسي. إن الزواج المتكافئ والعائلة التي تنشأ عنه يتطلب خصوصية لم تكن العهود السابقة تُعنى بها، على اعتبار أن الزواج أُعتبر فقط كموضع تبادل المشاعر، في حين يُنظر إليه اليوم كخير إنساني أساسي، وبالنسبة للكثيرين يمثل الزواج جزءًا من الحياة الإنسانية في تمامها وامتلائها. أما على درب الزمن المعاصر فلم تعد غاية الزواج تكوين أسرة متناغمة وإنجاب الأطفال وتحمُّل أعباء ذلك، بل أصبحت غايته الرئيسة كمالًا عاطفيًا من الخيرات الأساسية للإنسان([83]).
وبصفة عامة لم يعد الجسد يمثل وسيطًا بينا وبين العالم، كما كان بالنسبة لأسلافنا. ولم يعد الجسد مركز الثقل في علاقتنا بذواتنا وفي علاقتنا بالآخرين، لقد تزحزح الجسد عن مركزيته لفائدة فاعل منضبط ومتحرر وقادر على التحكم بحيادية من دون تحيز في الانفعالات. تلك هي الشخصية التي نبرزها للآخرين، كما يبرزها لنا الآخرون بشكل متبادل بما يساعدنا على تبيّن حقيقة المسافة العقلية التي اتخذناها من انفعالاتنا، ومدى ارتقائنا إلى هذا المستوى المثالي من التسامي.
ولهذا السبب، يُعتبر الشخص الذي يعتدي على المحظورات شخصًا مزعجًا جدًا، وهو إذ يفعل ذلك لا يجعل نفسه أضحوكة فقط، بل أيضًا يُربك الانضباط المشترك القائم. وليس ذلك بهيِّن. وتفترض “عملية التمدن”، حسب إيليا، أن نأخذ في الاعتبار هذه المسافة التي نتخذها من طائفة واسعة من انفعالاتنا الشديدة: فالغيظ، والافتتان بالعنف، والشهوة الجنسية، وكذلك الافتتان بالعمليات الجسدية والإفرازات، انفعالات مرتبطة، ضمن بعض الوجوه، بالشعور الجنسي. فلم يكن أسلافنا يكظمون غيظهم، وكانوا يُفاخرون بالعنف صراحة حتى أنهم كانوا يتداعون إلى حضور مشاهد العقاب القاسي الذي يؤذي البشر والحيوانات، وكل ما من شأنه أن يُلقي في قلوبنا الرعب على أيامنا هذه. فلقد تم كبت هذه الأشياء، فضلًا عن كبت العلاقة الحميمية الجسدية بالقوة. فنحن لا نسعى فقط إلى التحكم في غضبنا على النحو الأمثل، أو أننا على الأقل نطالب بعضنا البعض بذلك، ولكننا أيضًا نعمل على كظم مشاعر الغيظ والاستياء. بيد أننا قد نستمتع ببعض مشاهد العنف كلما كانت غير واقعية، كما في أفلام الخيال أو في المشاهد التلفازية الشبيهة بها (280).
إذن تتمثل الطريقة الوحيدة للتحكم في تلك الانفعالات في إيقاظ الشعور بالاشمئزاز أو حساسية النفور اللذين ميَّزا الذات المنضبطة والمهذبة من كل المشاعر المتواطئة مع هذا التسيّب الجسدي والجنسي أو العنيف. وبهذا المعنى تكون “الحضارة” قد تخطت مجرد حظر بعض الممارسات التي لا تُثير أي اشمئزاز أو نفور في حد ذاتها من أجل الإعلاء من شأن ممارسات أخرى. وحتى نمضي قدمًا في اتجاه الانضباط المتحرِّر، يتعيَّن علينا اتخاذ مسافة من هذا التسيّب، كما يتعيّن علينا الاعتراف بأن هذا التسيّب مخزٍ ومذلٍ من وجهة نظر نبل التحكم العقلي.
وبهذا المعنى، يفترض كلا الإحساسين الآخر كما لو كانا وجهين لعملة واحدة: تسامي الإحساس بالحيادية غير المتحيّزة للانفعالات، من ناحية، وأن الإحساس بالغيظ وبالشهوة الجسدية بمثابة سجن يشدنا إلى الأسفل، بعيدًا عن كل أشكال التسامي حيث نسيطر على كل شيء، من ناحية أخرى. وقد بُذلت العديد من المحاولات في القرن الأخير (ليس أقلها محاولة برتراند رسل Bertrand Russell) للحد من وطأة المحظور التي أثقلت الرغبة الجنسية الأولية، ولا ترى في الغضب والعنف إلا انحرافات للعقل غير المتحيز. ليقع التركيز على ايتيقا الإحسان والإيثار. وهذا ممكن، على ما فيه من مخاطر لا سبيل لإنكارها عبر ثبط الرغبة وموضعتها خلال هذه العملية. ولو حدث ذلك لاعتبر إبداعًا آخر من إبداعات الحداثة. إلا أن عملية التمدن خلال هذه القرون الأخيرة، في الحقيقة، قاومت الجنس والعنف على حد سواء.
وهكذا فإن الحضارة تقدَّمت بعدما وقع رفع مستوى الحساسية أو الاشمئزاز تجاه حميمية الجسد والرغبة الجنسية الأولية والعنف. لقد أصبحت “الرقة” كما “الحساسية” من فضائل المجتمع المهذب. نظف الملعقة أولًا قبل أن تغمسها مرة ثانية في الطبق المشترك، يقول كورتان Courtin سنة 1672 “هناك من الناس الحسَّاسين لا يتناولون من الحساء نفسه بعدما احتسيت منه بفمك مهما غيّرت الإناء الذي تضعه فيه” (154) فالمسألة لم تعد تتعلق بالاستخفاف بمن هم أرفع منك مقامًا بقدر ما تتعلق بسلوك يثير الاشمئزاز.
وبما أن الحضارة، كما سبق أن ذكرت، هي لعبة نلعبها معًا، وتصل بيننا وبين الآخرين عبر شخصيتنا المتحررة وبالتالي تحفظ هذه المعايير، فإن انتهاك المحظورات لا ينبغي أن يثير فينا لا فقط الاشمئزاز بل أكثر من ذلك الشعور بالخجل الرهيب. وبهذا المعنى تكون الحضارة تعبيرًا عن الخجل حيث يجب أن نشعر به.
بهذا المعنى، يكمل الفاعل المنضبط والمتحرِّر وجهًا آخر من وجوه الذات التي سميتها ذاتًا عازلة. وبالفعل، ففي العالم منزوع السحر لا يوجد فقط فصل صارم بين الداخلي والخارجي، بل أيضًا حواجز ترفع ضد الرغبات الجسدية الأكثر حدة وضد الافتتان بالجسد. وهي حواجز ترفع باسم وبواسطة الهوية المركزية بوصفها فاعلًا منضبطًا ومتحررًا يحافظ على المسافة التي تفصله عن منطقة التسيُّب. ولكن بما أن هذه المنطقة هي أيضًا منطقة تدفق المشاعر بين الناس وحيث يمكن أن ينشأ بسهولة نوع من الحميمية نتيجة الإثارة الجنسية المتبادلة، فإن هذه المسافة قد تضيّق بشكل جذري من نطاق الحميمية المسموح بها. وخارج الحلقات الضيّقة من الحميمية القائمة، فنحن مجبرون على التواصل في ما بيننا بنبل وتحكم عقلي، لا اعتبارًا لعلاقات حميمية وإنما اعتبار لعلاقات مصيرية.
لا يكون العزل هنا ضد منطقة حياة الجسد فقط ولكن أيضًا ضد الآخر إلى حد ما. وبالتالي ليس غريبًا أن يقع الفاعل المجبر على هذا الانضباط بسهولة فريسة لأيديولوجيات النزعة الذرية حيث “يتزايد الناس كما يخرج الفطر من الأرض”.
6
إننا على استعداد للمضي قدمًا في القصة، وأن ننظر في السبب الذي يكمن وراء التحوُّل إلى النزعة الإنسانية الحصرية. ولكن قبل أن نسترسل في ذلك أريد أن أتوقف قليلًا كي أوضح جميع هذه العناصر في إطار آخر يُسلط عليها الضوء بأكثر دقة. في هذا الصدد لنا أن نتساءل حول معرفة كيف أمكن لنا الانتقال من وضعية القرن الخامس عشر حيث كان من الصعب عدم الإيمان بالله إلى وضعيتنا الحالية في بدايات القرن الحادي والعشرين، حيث أصبح من السهل جدًا على الكثيرين عدم الإيمان بالله. ويمكن التعبير عن وضعيتنا هذه بالقول إن معظم الناس راضون بمتابعة غايات محايثة بشكل خالص ولا علاقة لها بالتعالي.
إني أقترح هنا مقاربة من مرحلتين. ففي مرحلة أولى، طوَّرنا وجهة نظر وطريقة عيش (خصصنا بهما النخبة بالدرجة الأولى)، نفصل فيها تمامًا بين المحايث والمتعالي، وبلهجة الفكر الغربي المسحي، الفصل بين الطبيعي وبين الخارق للطبيعة. ولا أعني فقط التأكيد على أن هذا التمييز كان لافتًا على المستوى النظري (اللاهوتي) على الرغم من أن المسيحية اللاتينية كانت قد رسمت الحدود بينهما (بصورة مبكرة جدًا في العصور الوسطى العليا) بشكل مميّز. وهذا في حد ذاته مثير للاهتمام لأنه يُميز هذه الحضارة عن سائر الحضارات الأخرى. انطلاقًا من هذا الفصل بالذات سيتحدَّد كل ما سنشهده من تحوّلات.
ما يهمنا ليس التمييز نظريًا بين التحايث والتعالي بقدر ما هو طريقة ترتيب هذ التمييز الذي يُمكن من خلاله التعامل مع بعض الوقائع “الطبيعية” البحتة، في نطاق التجربة، عبر فصلها عن المتعالي حتى يصبح ممكنًا، في نهاية المطاف، اعتبار أن ما يحيط بوجودنا مباشرة، يوجد على هذا المستوى “الطبيعي” حتى وإن كنا مقتنعين بأنها تؤشر على وجود شيء ما خارق.
ومن البديهي أن لا أحد بمقدوره أن يختبر حقيقة الأشياء المحيطة بنا بهذه الطريقة في عالم مسحور مليء بالأرواح والقوى الخارقة، ولا في عالم متشكّل من المثل والنسخ، ولا في عالم يتشكّل حول المقدَّس. وبالتالي ينبغي أولًا أن ندمِّر هذه العوالم أو أن نقوّضها، وأن نجعلها بعيدة عن التجربة، ومن ثم ترتيب مستويات التحايث والتعالي.
لقد كانت هذا الترتيب المرحلة لأولى رغم أنه كان في البداية متوافق مع استمرار الإيمان بالله بإخلاص وبأكثر وعي وحماسة. إخلاص، غذَّته عمليات نزع السحر التي ساهمت في ترتيب هذا التمييز.
لقد اقترنت العلمنة دائمًا بتعزيز الإيمان الديني. “إن رسالة الإصلاح أو الإصلاح المضاد والدافع القوي الكامن وراءهما” تتمثل في أن “الدين في طريقه لأن يصبح اختيارًا شخصيًا خالصًا”، ففي القرنين السابع عشر والثامن عشر “تطوَّرت مسيحية جديدة حول الالتزام الشخصي في صلب مجتمع يشهد تناميًا علمانيًا متزايدًا”([84]). ويُعزى اقتران نزع السحر بالإيمان الشخصي إلى أن الثاني (الإيمان الشخصي) قد قاد الأول (نزع السحر)، في البداية من خلال “السخط على نظام” الكنيسة. لكن قد يذهب هذا التفسير في اتجاه آخر: في عالم يعكس صورة الله بشكل باهت، ما كان للمسيحيين من خيار سوى التعويل أكثر على مصادرهم الشخصية.
لكن الدافع المسيحي لترتيب الأشياء لا يُعزى فقط إلى السخط على نظام الكنيسة. لقد تطوَّر هذا الإيمان المسيحي الجديد ذو الطابع الشخصي الخالص في اتجاه آخر. فقد تكرَّرت محاولات المسيحية الغربية لدمج الإيمان في الحياة اليومية بشكل تام منذ العصور الوسطى العليا. وغالبًا ما اقترنت هذه المحاولات بالرغبة في تقليص المسافة بين “السرعات” المختلفة في صلب الكنيسة، إلا أن الأمر لم يكن كذلك في الحقيقة. أعني بالأحرى محاولات دمج حياة التعبُّد الحصرية في محاريب الوجود الشخصي والاجتماعي التي كانت غائية حتى ذلك الحين.
لقد كان من ثمار ذلك تأسيس تنظيمات جديدة استفادت من تخصصات الرهبنة كالفقر والعزوبية أو التبتل، ولكنها غادرت الدير إلى العالم مثل الرهبان المتسولين في القرن الثالث عشر، ثم اليسوعيين في وقت لاحق. وقد استمرت هذه الحركة إلى أيامنا هذه في صلب الكنيسة الكاثوليكية في بعض التنظيمات من قبيل ذلك التنظيم الذي أسسته الأم تيريزا Mother Teresa.
يمكن أن نستحضر على مستوى آخر تلك الحركات التي ظهرت في العصور الوسطى المتأخرة مثل حركة إخوة الحياة المشتركة، التي تهدف تحديدًا إلى جعل حياة التعبُّد قريبة جدًا من الحياة اليومية. والحقيقة أن عملية الإصلاح ذاتها كانت تعي جيّدًا هذه الغاية، وتجلّى ذلك في ما سميته تكريس الحياة العادية. فالمسيحي يعبد الله في وجوده اليومي، في العمل وفي حياته الأسرية، وليس في ذلك تدنيس لتلك العبادة.
أعتقد أن هناك علاقة بين هذا الطموح وتلك التحوّلات العميقة التي أثرت في التمثيل على النحو الذي نلاحظه في فن الرسم الغربي في ذلك العصر. وفي هذا المضمار أقتفي أثر لويس دوبري Louis Dupré في موقفه، الذي أشرت إليه أعلاه، الذي يقول بوجود ترابط بين حركات الفرنسيسكان و”النزعة الواقعية الجديدة” والاهتمام الجديد بتصوير أناس معيّنين حول شخصية رئيسة في اللوحات الدينية، وقد ظهرت هذه النزعة مع غيوتو. وخلال القرون التي أعقبت عصر النهضة الإيطالية والهولندية لاحقًا، غادر فن الرسم فلك الرمز، بعدما كان يميل إلى تمثيل المسيح ومريم العذراء والقديسين كشخصيات نموذجية تقريبًا رُفعت إلى زمن أعلى من أجل رسمها ككائنات بشرية حاضرة تمامًا في زماننا، وكأشخاص يمكن أن نلقاهم في عالمنا الخاص.
وغالبًا ما اعتبر النقاد هذا التطوُّر في حد ذاته وجهًا من وجوه العلمنة وتحولًا للاهتمام نحو أشياء العالم على نحو ما هي عليه. فإذا كنا نفكر مثلًا في لوحات الأمراء أصحاب النفوذ، فهذا ممكن، إلا أنه من الخطأ، على ما أعتقد، أن تنطبق وجهة النظر هذه على معظم اللوحات الدينية. فقد كان حري بهم اعتبارها كوجه من وجوه محاولة السعي إلى جعل الإيمان قريبًا من الحياة اليومية، وهو ما يُترجم قوة روحانية تجسيدية ومحاولة لرؤية أو تصوّر المسيح ومريم كما لو أنهما بيننا حقًا، مما يضفي على ملابسات الحياة اليومية نوعًا من القداسة.
هكذا، بدل تأويل واقعية ورقّة ومادية وخصوصية معظم تلك اللوحات (انظر “النهضة الإسكندنافية”) على أنها انفصال عن المتعالي، يمكن تنزيلها في سياق تعبّدي كتكريس قوي للتجسيدية، وكمحاولة لأن نعيشها بعمق وذلك من خلال دمجها في عالمنا بشكل تام.
تعكس هذه اللوحات هذا التلازم بين التحايث والتعالي. إلا أن الاهتمام بالتحايث قد يتزايد انطلاقًا من طبيعة الأشياء، لكن في أغلب الأحيان انطلاقًا من طبيعة التحايث ذاته، فينشأ عن ذلك بعض التوترات مما يُهدد هذا الترابط بالانقطاع. إذن، ثمَّة حاجة ماسّة لتصوير الحقيقة العليا التي تخترق الأشياء مثل التكلف في الكثير من اللوحات الباروكية. إن الشخصيات التي تتعالى عن وضعنا أو أيّ انقطاع في اللوحات يسمح لنا بتمثل دفق الزمن الأعلى كما في لوحة القيامة لتينتوريتو Tintoretto التي أشرت إليها أعلاه، ولكن قد يُحافظ على هذا الترابط من خلال الأمثولة.
ما منزلة هذا في قصتنا؟ أعتقد أن هذا التركيز على الهُنا والآن، ساهم في نهاية المطاف، في ترتيب مستويات التحايث والتعالي. فقد أشرت أعلاه كيف أن اكتشاف وجهة النظر حول العلاقات المكانية والاهتمام بها ساهم في إضفاء معنى على انسجام المكان. فالمشهد محكم التنظيم، عند مشاهدته من زاوية معينة، “نافذة مفتوحة من زجاج شفاف” مثلًا، حسب عبارة ألبارتي Alberti الشهيرة([85])، يُمثّل عالمًا صلبًا، بحيث لن تستطيع الشخصيات الساكنة في الزمن الأعلى أن تخترقه، فذلك الزمن لا ينسجم مع زمننا. وهكذا أصبح العالم الذي تمّ تمثيله على هذا النحو أكثر فأكثر أشبه بالعالم المعيش، بحيث يصبح اللقاء المباشر بين الأرواح والقوى الخارقة والأزمنة العليا مستحيلًا أو يكاد. لقد أصبحت موضوعات اعتقاد علاقتها بالتجربة تكاد تكون منعدمة.
لقد أدت العديد من التحوُّلات التي شهدتها المسيحية إلى القطع بين التحايث والتعالي. وعليه لا يمكن أن نعزو ذلك إلى السخط على النظام الكامن بشكل كبير في التقوى العميقة حيث الدافع لنزع السحر لا غبار عليه، ولكن يمكن رده أيضًا وبشكل خاص إلى الحاجة إلى أن نجعل من الله حاضرًا على الدوام في حياتنا اليومية وفي حيثياتها المختلفة حتى أفعم الناس تلك الحيثيات بمضامين جديدة أكثر صلابة.
ولعله من سخرية القدر، أن ما غنمناه من الإخلاص والإيمان هو الذي هيّأ الأرضية للهروب من عالم الإيمان إلى عالم المحايثة الحصرية. وستكون هذه الحيثيات محور الاهتمام تحديدًا في الفصول التالية.
الهوامش:
([1]) Aquinas, The Summa Contra Gentiles, trans. The English Dominican Fathers (London: Burns Oates & Washbourne Ltd., 1928).
وردت باللاتينية في:
M.-D. Chenu, La Théologie au XIIe Siècle (Paris: Vrin, 1957), pp. 25–26.
([2]) Cf. Chenu, Théologie, p. 184.
([3]) نتحدث الآن عن بنيات ثقافية متطورة جدًا ولكن يمكن أن نلاحظ وجود تماثل مع العالم المسحور كما عاشه الناس العاديون حيث لا تترك الأولوية للأفعال المتبادلة موضعًا لفهم الأشياء استدلاليًا انطلاقًا من انتظام القوانين المتحكمة فيها.
([4]) M.-D. Chenu, Nature, Man, and Society in the Twelfth Century: Essays on New Theological Perspectives in the Latin West, trans./ed. Jerome Taylor and Lester K. Little (Chicago and London: University of Chicago Press, 1968), p. 8
عن الأصل اللاتيني: Liber XII Questionum, c.2, P.L., 172, 1179, in Chenu, Théologie, p. 24.
([5]) المصدر نفسه ص 117، عن الأصل اللاتيني نفسه، ص 170.
- Ullman, Principles of Government and Politics in the Middle Ages (New York: Barnes and Noble, 1966), pp. 300 ff.
([7]) انظر مناقشة النموذج الرهباني للحياة الرسولية في:
Chenu, Nature, Man, and Society, pp. 226–233.
([8]) انظر المصدر نفسه، الفصل العاشر.
([9]) Louis Dupré, Passage to Modernity (New Haven: Yale University Press, 1993), pp. 36–41.
([10]) انظر مناقشة هذه المسألة في Chenu, Nature, Man, and Society, chapter XI.
([11]) John Hale, The Civilization of Europe in the Renaissance (New York: Atheneum, 1993), pp. 219 ff.
([12]) Ficino, Platonic Theology, trans. Josephine I. Burroughs, in Journal of the History of Ideas 5 (1944), p. 65; quoted in Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare (Chicago: University of Chicago Press, 1980), p. 18.
([13]) يشمل ذلك، إن لم يتجاوزه، مسألة على غاية من الأهمية وهي “احتكار الاستخدام المشروع للقوَّة المادية” التي يتحدث عنها فيبر، انظر:
“Politics as a Vocation”, in H. H Gerth and C. Wright Mills, eds., From Max Weber (New York: Oxford University Press, 1946), p. 78.
([14]) John Hale, The Civilization of Europe in the Renaissance (New York: Macmillan, 1993), pp. 362.
([15]) المصدر نفسه، ص 367-368.
([16]) المصدر نفسه، ص 366، لفظ “مهذب Polite” مشتق هو أيضًا، بطبيعة الحال، من “مدنيCivil ” الذي نترجم به اللفظ الإغريقي.
([17]) المصدر نفسه، ص 367، تأمل صورة البطل المظفر شارل الخامس كرمز من رموز القضاء على التوحش.
([18]) المصدر نفسه، ص 369-371.
([19]) “Des Cannibales”, in Michel de Montaigne, Essais (Paris: Garnier-Flammarion, 1969), Volume 1, chapter XXXI, pp. 251–263.
([20]) Justus Lipsius, Six Books of Politickes, trans. William Jones (London: 1594, p. 17); quoted in Hale, Civilization of Europe, p. 360.
([21]) Jean Calvin, Job, Sermon 136, p. 718, quoted in Michael Walzer, The Revolution of the Saints (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965) p. 31.
([22]) لا يعني ذلك أنهم لا يتدخلون في أي شيء على الإطلاق، ولكن فقط لم يكن نجاحهم في فرض نظامهم دالًا على قداستهم. بل على العكس من ذلك، عمّقت وجهة نظرهم الفجوة الموجودة أصلًا بين نمط العيش في الدير وخارجه. وينطبق الشيء نفسه على الرهبان البيزنطيين، بشكل لافت، حيث كان في تدخلهم، في كثير من الأحيان، نوع من التهديد العنيف.
Philip Benedict, Christ’s Churches Purely Reformed (New Haven : Yale University Press, 2002), p. xvi.
([24]) Henry Crosse, Virtue’s Commonwealth;
وردت في .Walzer, Revolution of the Saints, p. 208
([25]) وردت في Walzer, pp. 211–212.
([26]) Dod and Cleaver, Household Government, sig. X3;
وردت في Walzer, Revolution of the Saints, p. 216.
([27]) Baxter, Holy Commonwealth (London, 1659), p. 274;
وردت في Walzer, Revolution of the Saints, p. 224.
([28]) انظر John Bossy, Christianity in the West: 1400–1700 (Oxford: Oxford University Press, 1985), pp. 40-41.
Bronislaw Geremek, La potence et la pitié : l’Europe et les pauvres du Moyen Age à nos jours, trans. Joanna Arnold-Moricet (Paris : Gallimard, 1987), p. 32.
([30]) المصدر نفسه، ص 180 وما بعدها.
([31]) Michel Foucault, Folie et déraison: Histoire de la folie à l’âge classique (Paris: Plon, 1961).
([32]) Geremek, La potence et la pitié, pp. 40–41.
([33]) المصدر نفسه، ص 277-278، ثم انظر أيضًا:
Philip Gorski, The Disciplinary Revolution (Chicago: University of Chicago Press, 2003), pp. 63–64.
([34]) Perkins, Works (London, 1616), I, 755; quoted in Walzer, Revolution of the Saints, p. 213.
([35]) Geremek, La potence et la pitié, pp. 186, 201.
([36]) Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe (New York: New York University Press, 1978), p. 209.
([42]) بطبيعة الحال لا يتعلق الأمر هنا بـ”الدولة المدنية” في معناها الحديث. فلفظ “بوليتزي Polizei” (وهو لفظ مشتق أيضًا من “بوليس polis” مدينة) يمكن أن يحمل على معنى التنظيم الإداري في مفهومه الواسع، أي الوسائل والإجراءات الضرورية لتأمين السلم والنظام لجميع السكان المقيمين في حدود دولة ما،
Marc Raeff, The Well-Ordered Police State (New Haven: Yale University Press, 1983), p. 5.
([43]) المصدر نفسه، ص 61، 86-87، 89.
Philip Gorski, The Disciplinary Revolution (Chicago: University of Chicago Press, 2003), chapters 2 and 3.
حتى أن فريديريك الأكبر ذُهل عندما دوَّت أصوات قواته تتغنى بالنشيد الرسمي بعد نصر بشق الأنفس، Nun Danket alle Gott (“الآن لنشكر الله جميعًا”). ومن ثم صدح العاهل بكل تلقائية يقول welche Kraft hat die Religion!” “Mein Gott (“إلهي، يا لقوة هذا الدين!”)
Hans-Joachim Schoeps, Preussen (Frankfurt: Ullstein, 1992), p. 74.
([47]) Michel Foucault, Surveiller et Punir (Paris : Gallimard, 1975), Part III, chapter 1.
([48]) Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
([49]) Discours de la Méthode, Part II, in Œuvres de Descartes, éd. Charles Adam et Paul Tanner (Paris : Vrin, 1973), Volume VI, p. 62.
([50]) Hans Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit (Frankfurt: Suhrkamp, 1983), Volume 1, p. 209. Translation: The Legitimacy of the Modern Age, trans. Robert M.Wallace (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983), pp. 177–178.
Dupré, Passage to Modernity, pp. 48–49, 51, 124–125.
وأنا مدين في ما أنا بصدده هنا لمناقشته المفيدة جدًا.
([52]) يتعيّن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كثرة المنابع عندما يتعلق الأمر بميكنة صورة العالم ذاتها. إذ يمكننا أن نعتبر أن تجانس الموضع والزمان الذي ساهم في تطوير منظور الرسم الإيطالي في القرن الخامس عشر، والتي نوقشت أعلاه في المتن، من العوامل التي مهَّدت الطريق أمام التمثل الجديد للكون في الزمن العلماني بشكل كامل. لكننا لا نستطيع أن نفترض أن أسباب هذا التغيير في التمثل لها صلة ما مع التوجه نحو الميكنة، أو رفض الكوسموس المتشكل حسب المثال.
([53]) الأريانية أو الآريوسية، مذهب مسيحي ظهر في القرن الرابع على يد كاهن من الإسكندرية اسمه آريوس 256م– 336م. يرى أن يسوع كائن فان وليس إلهيًا بأي معنى، وليس بأي معنى شيئًا آخر سوى معلّم يُوحى إليه، يقول آريوس إنّ يسوع المسيح لعب دورًا مميزًا في خلق العالـم المادي وفدائه، ولكنه ليس الله ذاته. فلا يمكن إلاّ أن يكون هناك إله واحد، ولهذا فلا بد أن يكون المسيح قد خلق في زمن ما. ولا بد أن يكون المسيح (ككل الخليقة) معرضًا للتغيّر والخطيئة، وأنه (مثل كل الكائنات المخلوقة) لا يملك معرفة حقيقية لفكر الله. (المترجم).
([54]) Gerhard Oestreich, Neostoicism and the Early Modern State (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), pp. 29, 35.
([55]) المصدر نفسه، ص 19، مع تعديل في الترجمة عن
Justus Lipsius, A Discourse on Constancy in Two Books (London: Printed for Humphrey Mosley, 1654).
([56])De vita beata, VII, 15, 7
ورد في Oestreich, Neostoicism, p. 22.
([57]) Erasmus, Enchiridion, chapter 14, p. 104.
([58]) ورد في Oestreich, Neostoicism, p. 19، مع تعديل في الترجمة أيضًا.
([60]) Max Weber, Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (Weinheim: Beltz Athenäum, 2000), p. 119; see the translation by Talcott Parsons, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: Scribner, 1958), p. 151.
([61]) Oestreich, Neostoicism, pp. 72–73
([63]) James Madison in the Federalist Papers, no. 10
حيث يؤكد على أن هذه الوضعية الجديدة تمثل مكسبا.
([64]) كما بيّن ذلك هيجل وبنيامين كونستون، انظر
Charles Taylor, Hegel (Cambridge : Cambridge University Press, 1975), pp. 395–396 ; Benjamin Constant, “De la liberté des anciens comparée à celle des modernes”, Constant, De l’Esprit de Conquête et de l’Usurpation (Paris : Flammarion, 1986), pp. 265–291.
([65]) Walzer, Revolution of the Saints, pp. 225, 227.
([66]) Raeff, Well-Ordered Police State, p. 177.
([67]) يتوافق هذا مع مرحلة مهمّة غسق فيها تمثل متوارث من العصور القديمة، تمثل يذهب أبعد من حضارتنا وقد وصفه ريمي براغ ببراعة في مؤلفه القيّم: La Sagesse du Monde (Paris: Seuil).
بحسب التصوُّر الموروث عن الإغريق، نحن جزء من كوسموس دلالته أغنى بكثير من لفظ “كون” السائدة في حضارتنا المعاصرة، وهذا يعني أن كل شيء منظم وأن هذا النظام يسعى إلى الحفاظ على نفسه، وأن الصور متحققة في الواقع كما بيّنت ذلك أعلاه. وينطبق هذا على البشر وعلى حياتهم، كما ينطبق على أيّ جزء آخر من الكون.
من المؤكد أن الحياة البشرية ناقصة، وفي الصيغة الأرسطية ذاك شأن عالم ما تحت القمر بأسره، وحده عالم ما فوق القمر، “السماء”، نموذج النظام الكامل وعليه ليس لنا إلا أن نحاكيه، وبذلك نهجر ممارستنا المنحرفة. (المصدر نفسه ص 128-136، 152-171، يُثير أفلاطون شيئًا من هذا القبيل ذائع الصيت في الكتاب السابع من “الجمهورية”).
ولكن إن كان علينا دائمًا أن نحاكي السماء، فسننقاد إلى نزوعنا الطبيعي مع العمل على تحقيق صورتنا ذاتيًا. وقد فقدت هذه الفكرة قوتها مع النظرية الاصطناعية الجديدة New artificialist stance. إذ ينبغي على النظام الإنساني أن يُبنى إراديًا. ولكن كما سنرى في الجزء التالي، فقد حطم مفهوم الكون الخارق للإنسان، من حيث هو يقدّم لنا نموذجًا لا يزال قائمًا، حتى بعد الثورة العلمية، موضعية أن يكون العالم تعبيرًا عن الصور أو تمظهرًا لها. ولنا أن نتبين أن ذلك النموذج لا يزال قائمًا خاصة في بعض الحركات البيئية. ومع ذلك، فإن هذا المفهوم يشهد في القرون الأخيرة منافسة شديدة مع صور لطبيعة ذات “أنياب ومخالب دموية” red in tooth and claw كصور مضادة للنموذج. وإلى جانب ذلك، فإن التصوُّر الميكانيكي للكون لم يعد ينسجم مع الفكرة الحقيقية “حكمة الكون”، إلا بوصفها استعارة واهية. (المصدر نفسه، الجزء الرابع).
([68]) Hugo Grotius, De jure belli ac pacis. Translation: The Rights of War and Peace, trans. A. C. Campbell (New York and London: Walter Dunne, 1901), Book I, Introduction, paragraph 10, p. 21.
([69]) Hugo Grotius, On the Law of War and Peace (De jure belli ac pacis), trans. Francis W. Kelsey (Oxford, 1925); Prolegomena, paragraph 11, p. 13.
([70]) John Locke, Second Treatise of Civil Government, chapter 5.
([71]) Benedict Anderson, Imagined Communities (London: Verso, 1991), p. 24, quoting Walter Benjamin, Illuminations (London: Fontana, 1973), p. 263.
([72]) Letter to Elizabeth, 18 May 1645, A&T, IV, 202; English translation in Descartes; Philosophical Letters, trans. Anthony Kenny (Oxford: Oxford University Press, 1970).
([73]) Letter to Elizabeth, 1 September 1645, A&T, IV, pp. 286–287 .
([75]) أقبل عن طواعية الإيحاءات التي تتضمنها هذه العبارة الأخيرة، لا لأني أحمل الحداثة مسؤولية الفظاعات التي عرفها القرن العشرين، فليس ذلك غرضي أبدًا، ولكن حتى أبيّن أن هذه الانحرافات مثلت منعطفًا حاسمًا في محور اهتمامنا في عصرنا.
([76]) Letter to Queen Christina of Sweden, 20 November 1647, A&T, V, 85; English translation in Letters, p. 228.
انظر أيضًا: Traité des Passions de l’âme, art. 152.
([77]) TPA, art. 153, A&T, XI, 445–446; English translation: The Philosophical Works of Descartes, trans. E. S. Haldane and G. R. T. Ross (hereafter H&R) (Cambridge: Dover, 1955), I, 401–402.
ويقتفي ديكارت في ذلك أثر دي فار Vair في إضفائه صبغة ذاتية على أخلاقيات الشرف: “الشرف الحقيقي هو ألق فعل حسن وفاضل يفيض عن وعينا أمام المحيطين بنا ومن خلال ارتداده إلينا يحمل شهادة الآخرين فينا، فيعقبه “اطمئنان عظيم” وهكذا فإن “الطموح انفعال عذب جدًا يتدفق بيسر من النفوس الأكثر نبلًا” La Philosophie Morale, pp. 267–268.
([78]) TPA, art. 161, A&T, XI, 454; H&R, I, 406.
انظر أيضًا المقالات من 156 إلى 203 (انفعالات النفس).
([79]) لقد ناقشت التحول الديكارتي بشكل مستفيض في كتابي، منابع الذات، الفصل الثامن.
Sources of the Self (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989), chapter 8.
([80]) Letter to Elizabeth, 1 September 1645, A&T, IV, 286, Letters, p. 170.
([81]) Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation (Frankfurt: Suhrkamp, 1978); English translation: The Civilizing Process (Oxford: Blackwell, 1994).
الأرقام الموجودة بين قوسين تحيل على الطبعة الألمانية، فإذا كانت مسبوقة بحرف E فتحيل على الترجمة الإنكليزية.
([82]) انظر مناقشتي لهذه المسألة في الفصل الثامن من كتابي منابع الذات.
([84]) John McManners, “Enlightenment: Secular and Christian”, in J. McManners, ed., The Oxford History of Christianity (Oxford: Oxford University Press, 1990), pp. 277, 298.
Erwin Panofsky, Renaissance and Renascences in Western Art (Stockholm: Almquist & Wiksells, 1965), p. 120.