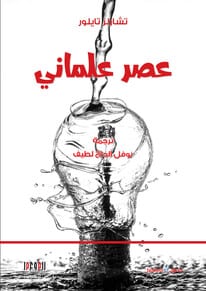
الفصل الرابع (المتخيلات الاجتماعية الحديثة) من كتاب (عصر علماني) لتشارلز تايلور
1– النظام الأخلاقي الحديث([1])
أستهل النظر في هذه المسألة مبتدئًا بالنظرة الجديدة إلى النظام الأخلاقي التي لعبت دورًا محورًيا في تطوُّر المجتمع الغربي الحديث. وقد تجلَّت هذه النظرة بشكل واضح في نظريات القانون الطبيعي الجديدة التي ظهرت في القرن السابع عشر كردَّة فعل صريحة على الاضطراب المحلي والدولي الناتج عن الحروب الدينية. ويُعد كل من غروتيوس ولوك من بين أكثر المنظرين أهمية ممن سنستشهد بهما فيما نحن بصدده هنا.
يستمدّ غروتيوس النظام المعياري الكامن وراء المجتمع السياسي من طبيعة الأعضاء المكوّنين لهذا المجتمع، فالكائنات البشرية عناصر اجتماعية عقلانية وُجدت لكي تتعاون من أجل المنفعة المتبادلة في كنف السلم.
وانطلاقًا من القرن السابع عشر، بدأت هذه الفكرة تُهيمن على فكرنا السياسي وطريقة تخيّلنا للمجتمع أكثر فأكثر، وكان ذلك، بداية، مع النسخة التي اقترحها غروتيوس كنظرية عما يكون عليه المجتمع السياسي، أي في ما يساعد على قيامه وتكوّنه. بيد أن أيّ نظرية هذا شأنها يمكن لها، لا محالة، أن تقترح فكرة ما عن النظام الأخلاقي، ذلك أنها تسوغ لطريقة ما عن العيش سويًا في صلب المجتمع.
ليست صورة المجتمع سوى انعكاس لصورة الأفراد الذين يجتمعون سويًا فيشكلون كيانًا سياسيًا استنادًا إلى خلفية أخلاقية معينة تسبق وجود المجتمع نفسه، فضلًا عن غايات معينة تحكمها وجهات نظر معينة. ولهذه الخلفية الأخلاقية علاقة بالحقوق الطبيعية، ذلك أن المجتمعين لديهم منذ البداية واجبات أخلاقية محددة تجاه بعضهم البعض. والغايات التي يسعون إليها إنما تعكس فوائد مشتركة معينة يكون الأمن الأكثر أهمية من بينها جميعًا.
تلح الفكرة الكامنة وراء النظام الأخلاقي على حقوقنا وواجباتنا تجاه بعضنا البعض بوصفنا أفرادًا، وذلك حتى قبل الرابطة السياسية أو خارجها. ويُنظر إلى الواجبات السياسية على أنها امتداد أو تطبيق لهذه الروابط الأخلاقية الأساسية جدًا. ولا شرعية للسلطة السياسية إلا بقدر ما تكون محل اتفاق من قبل الأفراد (العقد الأصلي)، ويخلق هذا العقد واجبات مُلزمة بمقتضى مبدأ موجود مسبقًا يفرض علينا الالتزام بتعهداتنا.
وعلى ضوء ما ترتب لاحقًا عن هذه النظرية التعاقدية، وذلك حتى في وقت سابق من القرن ذاته على يد جون لوك، ما يبعث على الدهشة حقًا أن ما انتهى إليه غروتيوس من استنتاجات أخلاقية وسياسية انطلاقًا منها تبدو داجنة. ولا يرد غروتيوس المشروعية السياسية إلى أرضية التوافق تلك من أجل وضع مؤهلات الحكومات القائمة موضع تساؤل، بقدر ما يهدف من وراء مناقشته هذه إلى نقض أسباب التمرد ضدها، وعدم الاعتراف بها بوصفها برمتها موضع تشدّد غير مسؤول من لدن المتعصبين مذهبيًا. ويفترض غروتيوس أن جميع الأنظمة الشرعية الموجودة تقوم، في نهاية المطاف، على مثل هذا القبول. ويسعى غروتيوس أيضًا إلى وضع أساس متين، يتجاوز الاعتراضات المذهبية التي لا طائل من ورائها، تقوم عليه المعايير الأساسية في الحرب والسلم. ويعتبر هذا التأكيد مفهومًا تمامًا بالقياس إلى بدايات القرن السابع عشر التي شهدت حروبًا دينية باستمرار أكثر ضراوة ومرارة.
ويُعتبر جون لوك أول من استخدم هذه النظرية لتبرير “الثورة” ولوضع الأساس للحكومة المحدودة حتى أصبح بالإمكان الأخذ بالحقوق على محمل الجد في مواجهة السلطة، كما لم يعد الاتفاق مجرَّد اتفاق أصلي على قيام الحكومة، بل هو الحق المستمر في الاتفاق على فرض الضرائب.
ورغم أن استخدام لغة العقد، قد تراجع أو ظل حبيس ثلة من المنظرين، منذ زمن لوك، أي ما يزيد عن ثلاثة قرون، حتى زماننا هذا، فإن الفكرة المضمرة التي تقول بأن المجتمع مسخَّر من أجل المنفعة (المتبادلة) للأفراد، ومن أجل الدفاع عن حقوقهم، اكتسبت أهمية متزايدة. وهذا يعني أنها أصبحت وجهة نظر سائدة فتدفع النظريات القديمة عن المجتمع، ومعها النظريات المنافسة الجديدة، إلى هامش الحياة السياسية والخطاب السياسي. وهي لها أيضًا آثارها المتزايدة بعيدة المدى على الحياة السياسية. وأصبح مقتضى الاتفاق الأصلي، مرورًا باتفاق الضرائب لدى لوك، عقيدة راسخة للسيادة الشعبية كما نفهمها الآن. وتنتهي نظرية الحقوق الطبيعية ببسط شبكة كثيفة من الحدود على الفعل التشريعي والتنفيذي عن طريق مواثيق مستقرة أصبحت من ميزات الحكومة المعاصرة. وقد طُبِّق الافتراض القَبْلي للمساواة، وهو افتراض مضمر في نقطة البدء المتمثلة في الحالة الطبيعية حيث لا مجال لعلاقات التفوق والدونية([2])، في سياقات متزايدة، تنتهي بالمعاملة المتعددة المتساوية أو في أحكام عدم التمييز التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من معظم المواثيق الراسخة.
بعبارة أخرى، شهدت فكرة النظام الأخلاقي المضمرة في هذه النظرة إلى المجتمع، خلال هذه القرون الأربعة الأخيرة، توسعًا مزدوجًا: في الامتداد (إذ أصبح عدد متزايد من الناس يعيشون وفقها حتى أصبحت فكرة مهيمنة)، وفي الحدّة قياسًا لغيرها (حيث أصبحت متطلباتها أكثر وزنًا وتشعبًا). وقد عرفت هذه الفكرة سلسلة “تعديلات” متتالية، وكان كل تعديلٍ منها أكثر غنى وتطلبًا من سابقه، وصولًا إلى يومنا الحاضر.
يمكن تتبع هذا التوسّع المزدوج بطرق شتى. فقد بدأ الخطاب الحديث الخاص بالقانون الطبيعي انطلاقًا من مجال متخصص إلى حد ما. وقد زوَّد هذا التوسّع الفلاسفة ومنظري القانون بلغة يمكن استخدامها في ما يتعلق بمشروعية الحكومات وقواعد الحرب والسلم، وكذلك بالمذاهب الوليدة في ميدان القانون الدولي الحديث. غير أن تلك اللغة تسرَّبت أيضًا إلى الخطاب في مجالات أخرى، وأحدثت فيه تغييرًا. ومن بين تلك الطرق تلك التي لعبت دورًا حاسمًا في القصة التي أرويها هنا، حيث غيَّرت فكرة النظام الأخلاقي الجديد وأعادت صياغة تعبيرات العناية الإلهية والنظام الذي خصَّت به البشر والكون.
إن الأكثر أهمية بالنسبة إلى حياتنا اليوم هو الطريقة التي أصبحت بها هذه الفكرة عن النظام تزدادُ مركزية في ما يتعلق بتصوراتنا حول المجتمع والسياسة، وبإعادة تشكيلهما في سياق هذه العملية. وقد انتقلت هذه الفكرة، في مسار هذا التوسّع، من مجرد نظرية تحرك خطاب ثلة من الخبراء إلى جزء لا يتجزأ من متخيَّلتنا الاجتماعي، أي من طريقة تخيّل معاصرينا للمجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها ويعملون على استدامتها. وسأهتم بهذه العملية بمزيد من التفصيل لاحقًا.
هذا التوسُّع الذي ينتقل من مجال واحد إلى أكثر من مجال، ومن النظرية إلى المتخيّل الاجتماعي، يمكن معاينته أيضًا على امتداد محور ثالث تفرضها طبيعة متطلبات هذا النظام الأخلاقي.
قد لا يحمل تصوُّر النظام الأخلاقي في طياته أحيانًا توقعًا فعليًا حول إمكانية تحققه الكامل، من دون أن يعني ذلك انعدام التوقع إطلاقًا، وإلا لما كانت هناك فكرة نظام أخلاقي أصلًا بحسب المعنى الذي استخدم به هذا المصطلح. وينظر إلى هذا المفهوم بوصفه شيئًا ينبغي العمل من أجله، وأنه سيتحقق على يد بعضهم. لكن الانطباع العام يميل إلى أن قلة من الناس فقط ستنجح في اتباعه، على الأقل في ظل الظروف الحالية.
إذن، فإن الإنجيل المسيحي يُولِّد فكرة جماعة قديسين ملهمين بحب الله، وبالحب المتبادل بين أفرادها، وبحب البشر. فلا مجال فيها للتناحر والبغضاء المتبادلة، والتكسّب والطموح إلى الحكم، وما إلى ذلك. وكان التوقع العام في القرون الوسطى هو أن قلة من القديسين فحسب هم الذين يطمحون إلى ذلك، وأنّ عليهم أن يعيشوا في عالم مغاير تمامًا عن هذا النموذج. لكن لن يكون ذلك إلا عند امتلاء الزمن حيث يتعلَّق النظام بأولئك المتحدين حول الله عند الإعفاء النهائي. ولنا أن نتحدث عن نظام أخلاقي هنا، وليس على مجرد مثل أعلى، لأن الناس كانوا ينظرون إليه بوصفه عملية تسير نحو تحققها الكامل. لكن أوان هذا التحقق لم يحن بعد.
ربما ثمة ما يشبه ذلك وإن في سياق آخر، ذلك المتعلق بجملة من التعريفات الحديثة للطوباوية التي تحيلنا إلى وضعية الأشياء التي يمكن أن تتحقق ضمن ظروف تصبح ممكنة في آخر المطاف، لكنها، حتى ذلك الوقت، تعمل بمثابة معيار يُحتكم إليه.
لعل ما يختلف عن هذا نسبيًا هي تلك الأنظمة التي تتطلَّب، أكثر أو أقل، تحققًا كاملاً، الآن وهنا. ويمكن أن يُفهم بطريقتين مختلفتين إلى حد ما، تتمثل الأولى في أن النظام ينبغي أن يتحقق، وهذا ما يفترضه المسار العادي للأشياء. وتلك هي السمة الغالبة في النظام السياسي في القرون الوسطى. كأن نفهم من مقولة “جَسَدَيّ المَلَك”، أن وجود الملك البيولوجي الفردي تحققًا لـ”جسده” الملكي الذي لا يموت، وشكلًا متعينًا له. وفي غياب ظروف استثنائية وفوضوية على نحو فضائحي، كما يحدث في بعض حالات الاستيلاء على الملْك المرعبة مثلًا، فإن النظام يتحقق تمامًا. وهو ما لا يمنحنا البتة وصفة تكون مفتاحًا لفهم الواقع، كالتي تتيحها “سلسلة الوجود” في ما يتعلق بالكون المحيط بنا، لكنه يعطينا المفتاح الهرمنوطيقي حتى نفهم هذا الواقع.
لكن قد تكون للنظام الأخلاقي علاقة أخرى بالواقع، وذلك بوصفه نظامًا لم يتحقَّق بعد، لكنه يتطلب تحقيقه والتقيّد به على نحو كامل، أي أنه يوفِّر هنا وصفة واجبة التحقق.
وإذا جاز لنا تلخيص هذه التمييزات، يمكننا القول إن فكرة النظام الأخلاقي أو السياسي قد تكون قصوى، مثل جماعة القديسين، أو أن تكون فكرة من أجل الآن وهنا. وفي الأخير، يمكنها أن تكون إما هرمنوطيقية أو منظورية.
اعتبرت الفكرة الحديثة عن النظام منذ البداية، على نقيض المثال المسيحي في القرون الوسطى، باعتبارها فكرة من أجل الآن وهنا. لكن من المؤكد أنها تمتد على مسار ينطلق من الحالة الأكثر هرمنوطيقية إلى الحالة الأكثر منظورية. ومثلما استخدمت هذه الفكرة في مجالها الأصلي على يد مفكرين مثل غروتيوس وبوفندورف، فإنها كانت توفر تأويلًا لما يجب أن يكون كامنًا خلف الحكومات القائمة التي تمتّعت بمشروعية لا شك فيها، إذ تقوم على افتراض وجود عقد تأسيسي. هكذا كانت نظرية القانون الطبيعي، في أصلها، هرمونيطيقا المشروعية.
لكن النظرية السياسية أصبحت، مع لوك، قادرة على تبرير الثورة، بل جعلها واجبًا أخلاقيًا في بعض الظروف، كما توفر في الآن ذاته سمات عامة أخرى للمعضلة الأخلاقية الإنسانية هرمونيطيقا المشروعية من حيث علاقتها بالملكية، على سبيل المثال. ولاحقًا، ستطرأ على هذا المفهوم للنظام “تعديلات” تقتضي تغييرات أكثر ثورية تطال علاقات الملكية؛ وهذا ما انعكس في نظريات أكثر تأثيرًا من قبيل نظريتي روسو وماركس، على سبيل المثال.
هكذا، ومع الانتقال من مجال واحد إلى مجلات شتى، ومن النظرية إلى المُتَخَيَّل الاجتماعي، فإن الفكرة الحديثة للنظام تنتقل أيضًا وفق محور ثالث، وتنتقل أشكال الخطاب التي تولدها على امتداد مسار ينطلق من الهرمونيطيقا إلى المنظورية. وفي سياق هذه العملية، تتفاعل فكرة النظام مع شبكة واسعة من المفاهيم الأخلاقية، إلا أن الأشكال المختلفة للمزيج الناتج عن ذلك تشترك كلها في استخدامها الأساسي لهذا الفهم للنظام السياسي والأخلاقي. وهو فهم سليل نظرية القانون الطبيعي الحديثة.
هذا التوسُّع وفق المحاور الثلاثة جدير بالاهتمام حقًا. وهو يستدعي تفسيرًا. لكن تقديم تفسير سببي لظهور المتخيَّل الاجتماعي الحديث ليس جزءًا من اهتماماتي هنا. ولكم يسعدني إن تمكنتُ من تقديم بعض التوضيح للأشكال التي اتخذها. لكن من شأن هذا، بحكم طبيعته ذاتها، أن يُساعد على التركيز على مسائل التفسير السببي على نحو أكثر دقة، وهو ما سأقدِّم بعض الأفكار العارضة عنه في موضع آخر لاحقًا. أما الآن، فإنني أود المُضيّ في استكشاف السمات الفريدة لهذا النظام الحديث.
يجب أن يكون واضحًا في أذهاننا منذ البداية، أن مفهوم النظام الأخلاقي الذي أستخدمه هنا يتجاوز بعض البرامج المقترحة للمعايير التي يجب أن تحكم علاقاتنا الطبيعية و/أو حياتنا السياسية. فما يضيفه فهم النظام الأخلاقي إلى إدراك المعايير وقبولها هو تحديد لسمات العالم أو الفعل الإلهي أو الحياة البشرية التي من شأنها أن تجعل قواعد بعينها صحيحة وقابلة للتحقق (عند نقطة محددة) في آن. وبعبارة أخرى، فإن صورة النظام تحمل معها تعريفًا، لا لما هو صحيح فحسب، بل أيضًا للسياق الذي يكون فيه السعي إلى تحقيق ما هو صحيح أمرًا منطقيًا (على نحو جزئي على الأقل).
من الواضح أن صور النظام الأخلاقي التي تنحدر عبر سلسلة من التحولات مما هو موصوف في نظريات القانون الطبيعي لغروتيوس ولوك، هي صور مختلفة عن تلك المنغرسة في المتخيَّل الاجتماعي للعصر ما قبل الحديث.
وثمة نمطان مهمَّان من النظام الأخلاقي قبل العصور الحديثة يستحقان الذكر هنا لأنهما قابلان لأن ينزاحان، أو يُستبدلان، أو يُهمَّشان، من خلال خط غروتيوس ـ لوك في مسار الانتقال إلى الحداثة السياسية. يستند أحد هذين النمطين إلى فكرة قانون الشعب الذي يحكم هذا الشعب منذ زمن يتخطى حدود العقل، بل يحدده بوصفه شعبًا، بمعنى من المعاني. والظاهر أن هذه الفكرة كانت واسعة الانتشار لدى القبائل الهندو-أوروبية التي ظهرت إلى أوروبا في حقب مختلفة. وكان هذا النمط قوي الحضور في إنكلترا القرن السابع عشر في صيغة “الدستور القديم”، وأصبح واحدًا من الأفكار الرئيسة التي تبرِّر التمرد ضد الملك([3]).
إن هذه الحالة كافية لبيان أن هذه المفاهيم ليست محافظة على الدوام من حيث ما توحي به ضمنيًا، لكن علينا أن نُدرج في هذه الفئة أيضًا فكرة النظام المعياري التي يبدو أن أجيالًا قد تناقلتها في المجتمعات الفلاحية، وطوَّرت من خلالها صورة “الاقتصاد الأخلاقي” التي انتقدت عن طريقها الأعباء الملقاة على عاتقها من طرف مالكي الأراضي أو الجبايات المفروضة عليها من طرف الدولة والكنيسة([4]). وثمة فكرة كثيرًا ما تكرَّرت، ألا وهي أن توزيع الأعباء الذي كان مقبولًا في الأصل قد حل محله استيلاء لا بد من التراجع عنه.
ينتظم النمط الآخر من النظام الأخلاقي حول مفهوم التراتبية في المجتمع، وهي تتطابق مع تراتبية الكون وتعبّر عنها. وهذا ما جرى تشكيله نظريًا في لغة مستمدة من مفهوم “الصورة” الأفلاطوني –الأرسطي. لكن الفكرة الكامنة خلف هذا تحضر بشكل قوي في نظريات التطابق: كالملك في مملكته مثل الأسد بين الحيوانات، أو النسر بين الطيور، وهكذا دواليك. وانطلاقًا من هذه النظرة نشأت فكرة مفادها أن ما يحدث من اضطرابات في المجال الإنساني يتردد صداه في الطبيعة لأن نظام الأشياء أصبح مهددًا. لقد اضطربت الليلة التي قُتِل فيها دنكن بفعل “صرخات الموت النكراء وعويلٍ تردد في الفضاء”؛ واستمر الظلام مخيمًا رغم انبلاج الصبح. وفي يوم الثلاثاء السابق، كانت بومة تقتات على الفئران قد قتلت عُقابًا، وكانت خيول دنكِن فد استحالت خيولًا برية في الليل، “وشقت عصا الطاعة كما لو أنها تشن حربًا على بني البشر”([5]).
في كلتا الحالتين، وفي الحالة الثانية تخصيصًا، لدينا نظام يميل إلى فرض نفسه عن طريق مسار الأشياء، وتلقى انتهاكاته رد فعل عنيف يتجاوز المجال البشري المحض. وتبدو تلك سمة غالبة في الأفكار قبل الحديثة المتعلقة بالنظام الأخلاقي. ويشبَّه أنكسيمندرس Anaximandre أي انحراف عن مسار الطبيعة بانعدام العدالة حيث يقول إن من شأن كل الأشياء التي تقاوم الطبيعة أن “ينال كل طرف جزاءه وقصاصه لقاء الظلم الذي اقترفه في حق الآخر وفقًا لأحكام الزمن”([6]).
ويتحدث هيرقليطس Heraclitus عن نظام الأشياء بتعابير مماثلة عندما يقول إن الشمس إذا انحرفت عن مسارها المحدد لها، فإن الإيرينيات ستستولي عليها وتعيدها إلى سيرتها الأولى([7]). وبطبيعة الحال، فإن الصور الأفلاطونية تساهم بفعالية في تشكيل الأشياء والأحداث في عالم التغيّر.
من الواضح جدًا في هذه الحالات أن النظام الأخلاقي ليس مجرد مجموعة من المعايير، إذ يحتوي أيضًا على ما قد ندعوه مكونًا “وجوديًا” يحدد سمات العالم التي من شأنها أن تجعل المعايير قابلة للتحقق. على أن النظام الحديث الموروث عن غروتيوس ولوك ليس نظامًا ذاتي التحقق بالمعنى الذي يطرحه هيزيود Hesiod أو أفلاطون، أو بالمعنى الذي تثيره ردود الفعل الكونية على مقتل دنكن Duncan. ومن المغري إذن، أن نفكر بأن مفاهيمنا الحديثة عن النظام الأخلاقي تفتقر تمامًا إلى مكونٍ وجودي. لكن هذا سيكون خطأ وآمل أن أبيّن ذلك لاحقًا. ثمة اختلاف مهم كامن في حقيقة أن هذا المكون أصبح الآن سمة تتعلق بنا نحن البشر، وليس سمة تخص الإله أو الكون. ولا تتعلق المسألة بالغياب الكليّ المفترض للبعد الوجودي.
وإذا ركّزنا على كيفية اختلاف عمليات إضفاء الطابع المثالي للقانون الطبيعي على تلك الأشكال التي سادت من قبل، فسيتبيّن لنا ما يُميز فهمنا الحديث للنظام بشكل واضح. فـ المتخيلات الاجتماعية ما قبل الحديثة، وخاصة تلك التي تتعلق بالنوع الثاني المذكور أعلاه. مبنية عن طريق أنماط مختلفة من التكامل التراتبي. ويُنطر إلى المجتمع على أنه يتكوَّن من أنظمة مختلفة بحيث أن كلّ نظام مكمل لغيره ومحتاج إليه، من دون أن يعني ذلك أن علاقات هذه الأنظمة في ما بينها متبادلة حقًا، لأنها لا توجد على المستوى نفسه. وقد شكلت بدلًا من ذلك تراتبية يكون لبعضها فيها قيمة وشرف أكبر من غيرها، وخير دليل على ذلك، المثال الذي يكثُر الاستشهاد به حول مجتمع الطبقات الثلاث في القرون الوسطى: رجال الدين، والمحاربون، والعاملون – أي من يصلّون، ومن يقاتلون، ومن يعملون. ومن الواضح أن كل طبقة من هذه الطبقات في حاجة إلى الأخرى. لكن ما من شك فيه أن هناك تراتبية في المنزلة والشرف حيث ثمَّة وظائف أسمى بطبيعتها من وظائف أخرى.
وما هو أساس في هذا النوع من المثل الأعلى أن يكون توزيع الوظائف ذاته جزءًا مهمًا من النظام المعياري. ولا يقتصر الأمر على أن من واجب كل طبقة أن تؤدي وظيفتها المميزة لها من أجل باقي الطبقات شريطة دخولها هذه العلاقات التبادلية، على أن يظل ترتيب الأشياء على نحو مختلف مفتوحًا على إمكانيات أخرى، في عالم يقوم فيه كل امرئ بالصلاة وبالقتال وبالعمل على سبيل المثال. كلا، إنما يُنظر إلى التمايز التراتبي نفسه على أنّه النظام السليم للأشياء، وأنه جزء من الطبيعة أو شكل من أشكال المجتمع. وفي التراثين الأفلاطوني والأفلاطوني الجديد، اعتبرت هذه الصيغة متحققة في العالم أصلًا. وكل محاولة للخروج عنها تضع الواقع في مواجهة نفسه. وقد تؤدي محاولة من هذا القبيل إلى تشويه المجتمع. ومن هنا تأتي تلك القوة الهائلة للاستعارة العضوية في هذه النظريات المبكرة. يبدو الكائن الحي موضعًا نموذجيًا للصور المتحققة إذ يسعى إلى شفاء جروحه ومعالجة أمراضه. وفي الآن ذاته، فإن ترتيب الوظائف وما ترتب عنه ليس فقط ترتيبًا ممكنًا، بل إنه “عادي” وصائب. فأن تكون القدمان أسفل الرأس فذلك ما ينبغي أن يكون.
تختلف عملية إضفاء الطابع المثالي الحديثة للنظام جذريًا عن هذا التصوُّر. ولا يقتصر الأمر على وجود موضع للصورة ذات النمط الأفلاطوني المتحقق: مهما يكن توزيع الوظائف في المجتمع، فإنه يظل توزيعًا ممكنًا، ولا شيء يبرِّر هذا التوزيع غير قيمته الأداتية، ولا يكفي بذاته لتحديد ما هو خير. وفي الواقع يتمثل المبدأ المعياري الأساسي هنا في أن الأفراد في المجتمع يخدم كل منهم حاجات الآخر، ويساعد كل منهم الآخر، وباختصار يسلك كل منهم سلوك الكائنات الاجتماعية العقلانية بما هي كذلك. وعلى هذا النحو، فإن كلًا منهم يُكمَّل الآخر. لكن التمايز الوظيفي الخاص الذي يحتاجه الناس للقيام بذلك على النحو الأكثر فعالية لا قيمة أساسية له. فهو عرضي، بل إنه قابل للتغيير أيضًا. وقد يكون مؤقتًا فحسب في بعض الحالات، كما هو الحال بالنسبة لمبدأ البوليس القديم حيث يمكن أن نكون حكامًا ومحكومين أيضًا. وفي حالات أخرى، يتطلب الأمر خصخصة طوال الحياة. لكن ما من قيمة متأصلة في ذلك، لأن كل النداءات متساوية في نظر الله. ولا يمنح النظام الحديث، بشكل أو بآخر، أي قيمة وجودية لأي تراتبية أو لأي بُنية بعينها من بنى التمايز بين الناس.
بعبارة أخرى، إن النقطة الأساسية في النظام المعياري الجديد هي الاحترام المتبادل والخدمة المتبادلة بين الأفراد المكونين للمجتمع. وأن على هذه البنى الفعلية خدمة هذه الغايات، ويكون الحكم عليها أداتيًا في ضوء ذلك. ربما يكون الاختلاف غامضًا على اعتبار أن النظم القديمة كانت تضمن أيضًا نوعًا من الخدمة المتبادلة: يُصلي رجال الدين من أجل عامة الناس، ويعمل عامة الناس، ويقاتلون، من أجل رجال الدين. لكن النقطة الحاسمة هي وجود هذا الانقسام ضمن أنماط من الانتظام التراتبي، في حين نبدأ، في الفهم الحديث، بالأفراد وبواجبهم من حيث الخدمة المتبادلة، ويتراجع الانقسام بحيث يتمكنون من أداء واجباتهم على نحو أكثر فعالية.
وهكذا، فإن أفلاطون يبدأ في الكتاب الثاني من “الجمهورية” مناقشة عدم قدرة الفرد الذاتية على الوصول إلى الحاجة إلى نظام للخدمة المتبادلة. ولكن، سرعان ما يتضح أن بنية هذا النظام هي النقطة الأساسية بالنسبة إليه. ويزول آخر الشكوك عندما نرى أن هذا النظام يُراد له أن يكون في تماثل وتفاعل مع النظام المعياري في النفس. وعلى النقيض من ذلك، نجد في المثل الأعلى الحديث أن الأمر كله متعلق بالاحترام والخدمة المتبادلين، كيفما تحققا.
أوردت اختلافين اثنين يُميزان هذا المثل الأعلى عن سابقه من أنظمة التكاملية التراتبية ذات النموذج الأفلاطوني حيث لا تتحقق الصورة في الواقع، ولا يظل توزيع الوظائف معياريًا في ذاته. وبالتوازي مع هذين الاختلافين يوجد اختلاف ثالث. فبالنسبة إلى النظريات المنبثقة عن الأفلاطونية، تشتمل الخدمة المتبادلة بين الطبقات، عندما تكون علاقتها صحيحة، على توفير شرط تحقيق كل طبقة من هذه الطبقات أسمى فضائلها. والواقع أن هذه هي الخدمة التي يقدمها النظام كله إلى أعضائه جميعًا. أما في المثل الأعلى الحديث، فإن الاحترام والخدمة المتبادلين موجهان صوب أهدافنا العادية: الحياة، والحرية، وتوفير قوته وقوت أسرته. فالحكم على تنظيم المجتمع، مثلما ذكرت من قبل، لا يتم اعتمادًا على صيغته المتأصلة فيه، بل هو حكم أداتي. ولنا أن نضيف الآن أن هذا التنظيم إنما يكون صالحًا من الناحية الأداتية لتوفير الظروف الأساسية لوجود الناس باعتبارهم فاعلين أحرارًا، وليس متعلقًا بتميز الفضيلة، على الرغم من أننا قد نحكم بأننا بحاجة إلى درجة عالية من الفضيلة للقيام بدورنا المناسب في هذا المجال.
إن الخدمة الأولى التي يقدمها كل منا إلى الآخرين (إذا استخدمنا لغة العصر الحديث) هي توفير الأمن الجماعي حتى تكون حياتنا وممتلكاتنا آمنة في ظل القانون. لكن كلًا منا يخدم الآخر أيضًا من خلال التبادل الاقتصادي. والأمن والازدهار، هما الآن الهدفان الرئيسان للمجتمع المنظم منظورًا إليه باعتباره شيئًا من طبيعة التبادل المفيد بين الأفراد المكونين له. فالنظام الاجتماعي المثالي هو نظام تتشابك فيه غاياتنا، ويساعد كل منا غيره من خلال سعيه خلف غاياته هو نفسه.
لم يكن ينظر إلى هذا النظام المثالي على أنه نظام من اختراع البشر، بل على أنّه نظام من تصميم الله: نظام تنسجم فيه الأشياء كلها وفقًا لغايات الله. وفي وقت لاحق من القرن الثامن عشر، تم إسقاط هذا النموذج نفسه على الكوسموس، وذلك في رؤية للكون تعتبره مجموعة أجزاء متراكبة تراكبًا متقنًا بحيث تتشابك غايات كل نوع من المخلوقات مع غايات الأنواع الأخرى كلها.
يضع هذا النظام هدفًا لنشاطنا البنَّاء، وذلك بقدر ما يكون في مستطاعنا أن نحقق هذا النظام أو أن نبطله. وبطبيعة الحال، فإننا نرى مقدار تحقق هذا النظام عندما ننظر إلى النظام بكليته. أما عندما ننظر إلى شؤون البشر، فإننا نرى كم انحرفنا عنه، وكم عطلناه. عندها يصبح ذلك النظام معيارًا يتعيَّن علينا أن نسعى إلى أن نعود إليه.
كان يُنظر إلى هذا النظام على أنّه واضح في طبيعة الأشياء نفسها. وإذا ما عُدنا إلى الوحي، فإننا نجد أيضًا أننا مطالبون بأن نلتزم به. لكن العقل وحده قادر على إنبائنا بغايات الله. فالكائنات الحيَّة، بما فيها نحن، تسعى إلى حفظ أنفسها. ذلك هو فعل الله:
خلق الله الإنسان وغرس فيه، كما في غيره من الحيوانات كلها، غريزة حب البقاء. وهيَّأ في العالم أشياء مختلفة تصلح للمأكل والملبس وغير ذلك من ضروريات الحياة، تحقيقًا لرغبة إلهية في بقاء الإنسان ردحًا من الزمن على وجه البسيطة حتى لا يفنى هذا المخلوق الغريب فورًا جراء إهماله وانعدام ضروريات الحياة لحظات بعد ولادته، أقول، إن الله بعدما خلق الإنسان والعالم، خاطبه كذلك، أي أشار عليه إلى استخدام هذه الأشياء الصالحة لبقائه عن طريق حواسه وعقله، ومنحه أسباب المحافظة على ذاته… وهذا لأن غريزة حب البقاء الشديدة التي طبعه الله عليها كمبدأ لأفعاله استلزمت أن يرشده عقله وهو “صوت الله في الإنسان”، ويعلّمه ويؤكد له أن السعي على سجيته الطبيعية للبقاء ليس إلا خضوعًا لإرادة خالقه([8]).
ولأننا كائنات وُهبت عقلًا، فإنه يتعيّن علينا أن نحافظ على حياة البشر كافة، وليس على حياتنا فحسب. وفضلًا عن ذلك، فقد جعلنا الله كائنات اجتماعية. بحيث يكون “على كل امرئ أن يحفظ ذاته، وأن يلتزم مقامه الخاص بإرادته. وبناء على الحجة ذاتها فهو مُلزم بأن يحافظ على سائر البشر ما استطاع إلى ذلك سبيلًا ما لم يتنافَ ذلك مع مبدأ الحفاظ على الذات”([9]).
على نحو مماثل، يقول لوك إن الله وهبنا قدرة على التفكير والانضباط حتى نستطيع، على نحو فعال، أن نسعى إلى حفظ أنفسنا. ويترتب عن ذلك أن نكون “مجتهدين عقلانيين”([10]). فأخلاق الانضباط والتطوير هي في حد ذاتها مطلب من متطلبات النظام الطبيعي الذي رسمه الله. كما أن فرض الإرادة البشرية للنظام هو، في حد ذاته، أمر تستدعيه هذه الخطة الإلهية.
نستطيع أن نرى في صياغة لوك كيف ينظر إلى الخدمة المتبادلة من حيث تبادل النافع بين البشر. فقد أصبح النشاط “الاقتصادي” (أي النشاط المنتج السلمي المنظم) نموذجًا للسلوك البشري ومفتاحًا للتعايش المنسجم. وعلى نقيض نظريات التكامل التراتبي، فإننا نلتقي في مجال التوافق والخدمة المتبادلة، لا إلى حد يجعلنا نتجاوز أهدافنا وغاياتنا العادية، بل على العكس، في سياق تحقيقها طبقًا لما رسمه الله لنا.
لم تكن هذه الأمثلة، في البداية، منسجمة تمامًا مع سير الأمور الواقعي، وبالتالي مع المُتخيَّل الاجتماعي الفعلي على مستويات المجتمع كلها تقريبًا. وكانت التكاملية التراتبية هي المبدأ الذي تسير وفقه حياة الناس العملية، وذلك من المملكة إلى المدينة إلى البطريركية إلى الأبرشية إلى العشيرة فالأسرة. وتزخر الأسرة بمشاهد حيَّة عن عدم المساواة، لأن الصور القديمة للتكامل التراتبي بين الرجال والنساء لم تواجه تحديًا شاملاً إلا في زماننا هذا. لكن هذه مرحلة متأخرة من “مسار طويل”، وعملية تتصل فيها الأمْثلَة الحديثة، المتقدمة وفق المحاور الثلاثة التي ناقشناها أعلاه، بمُتخيَّلنا الاجتماعي على المستويات كلها، وتتجاوزه، مع ما لذلك من نتائج ثورية.
وقضى الطابع الثوري للنتائج أن يُخفق من أخذوا بهذه النظرية قبل غيرهم في رؤية تطبيقها في جملة من الميادين التي تبدو جليّة الآن. فالقبضة القوية لصيغ الحياة التكاملية التراتبية في الأسرة، وبين السيد والخادم في المنزل، وبين الإقطاعي والفلاح في الحقل، وبين النخبة المتعلمة وبقية الجمهور، تُظهرُ أنه من “البديهي” تطبيق المبدأ الجديد للنظام ضمن حدود بعينها. وفي أغلب الأحيان لم يكن يُعتبر ذلك عائقًا. وهو ما يبدو الآن لأعيننا عدم اتساق فاضح، عندما دافع الويغيون Whigs في القرن الثامن عشر عن سلطتهم الأوليغارشية باسم الشعب على سبيل المثال، كان في أنظار قادة الويغ أنفسهم أمرًا منطقيًا تمامًا يفرضه الحسّ السليم.
والواقع، أن الويغيين استلهموا ذلك من فهم قديم لمعنى “الشعب”، فهم نابع من المفهوم قبل الحديث عن النظام، من النمط الأول المذكور أعلاه، حيث يتحدَّد الشعب بصفته هذه بفعل قانون موجود أصلًا على الدوام، منذ “زمن يتخطى حدود العقل”. وفي وسع هذا القانون أن يسبغ القيادة على بعض الأشخاص بحيث يتحدثون باسم الشعب بشكل طبيعي تمامًا. بل إن الثورات نفسها (أو ما نعتبره كذلك) في بدايات أوروبا الحديثة كانت تحدث في ظل هذا الفهم ذاته، كما هو الحال، مثلًا، في النزاعات التي شهدتها الحروب الدينية في فرنسا، حيث اعتبر التمرد من حق “القضاة التابعين” وليس من حق الجماهير غير المنظمة. وكان هذا أيضًا أساس تمرد البرلمان على شارل الأول Charles I.
لعل هذه المسيرة الطويلة لم تبلغ نهاياتها إلا في يومنا هذا، أو لعلنا، نحن أيضًا، واقعون فريسة قيدٍ عقلي سيجعل أحفادنا يتهموننا بالتناقض أو بالنفاق. وعلى أي حال، فإن بعضًا من القطاعات المهمة جدًا في هذه الرحلة لم يحدث إلا بصفة متأخرة جدًا. وأشرت سابقًا في هذا المضمار إلى العلاقات الجندرية المعاصرة، لكن علينا أيضًا تذكُّر أنه لم يمضِ زمن طويل جدًا على تلك الفترة التي كانت فيها قطاعات بأسرها من مجتمعنا، الذي يُفترض أنه حديث، لا تزال باقية خارج هذا المُتخيّل الاجتماعي الحديث. يُبين إيوجين فيبر Eugen Weber أن عديد من الجماعات المحلية من الفلاحين الفرنسيين لم تصبح جزءًا من الأمة الفرنسية التي تعد أربعين مليونًا من المواطنين إلا في أواخر القرن التاسع عشر([11]). ويوضح فيبر كم كان نمط الحياة السابق لهؤلاء الناس معتمدًا على أنماط الفعل التكاملية وهي أنماط بعيدة كل البعد عن المساواة، بين الجنسين خصوصًا، لكن ذلك لا يقتصر على ذلك وحده: بل تشمل أيضًا مصير الأخوة الأصغر سنًا الذين يتخلّون عن حصصهم من الإرث من أجل المحافظة على ملكية العائلة موحدة وقابلة للاستمرار. وفي عالم من البؤس وانعدام الأمن، ومن العوَز الذي يُهدِّد الناس دائمًا، تبدو قواعد العائلة والجماعة المحلية الضامن الوحيد البقاء. وتبدو الأنماط الحديثة للفردانية ترفًا، أو إسرافًا محفوفًا بالمخاطر.
يسهل نسيان هذا لأن المتخيَّل الاجتماعي الحديث، ما إن نوجد فيه حقًا حتى يبدو لنا المُتخيَّل الممكن الوحيد، أو المُتخيَّل الوحيد الذي يحمل معنى. أولسنا جميعًا أفرادًا فوق كل ذلك؟ أوليس اجتماعنا من أجل المنفعة المتبادلة؟ وهل من طريقة أخرى نقيس بها الحياة الاجتماعية؟
وهكذا يصبح من السهل علينا أن نحمل نظرة مشوَّهة بشأن تلك العملية وذلك من ناحيتين اثنتين: الأولى، هي أننا ميالون إلى قراءة مسار هذا المبدأ الجديد للنظام، وإزاحته الأنماط التقليدية من التكامل، باعتباره صعودًا لـ”الفردانية” على حساب “الجماعة”. على أن الفهم الجديد للفرد يحمل وجهًا آخر، لا مفرَّ منه يتمثل في فهم جديد للسعي إلى الاجتماع، وإلى مجتمع المنفعة المتبادلة الذي ينطوي على اختلافات وظيفية ممكنة إلى أقصى حد، ويكون أفراده متساوين أساسًا. ذلك ما أردت التأكيد عليه في هذه الصفحات لأنه بكل بساطة كثيرًا ما يغيب عن وجهة نظرنا. ويحتل الفرد في ما يبدو المكانة الأولى لأننا نقرأ إزاحة الأشكال القديمة من التكامل باعتباره تآكلًا للجماعة كجماعة. والظاهر أننا نظل نواجه مشكلة قائمة تتعلق بكيفية حث الفرد، أو إرغامه، على نوع من أنواع النظام الاجتماعي وجعله يُطيع القواعد ويلتزم بها.
هذه التجربة المتكررة من التعطل واقع لا سبيل لإنكاره. لكن لا يجوز أن تحجب عنَّا حقيقة أن الحداثة، هي أيضًا، صعود لمبادئ جديدة من الاجتماع. والتعطل يحدث، كما في حالة الثورة الفرنسية، لأن الناس يُجبرون على التخلي عن صيغهم القديمة، عبر الحرب أو الثورة أو التغيُّر الاقتصادي السريع قبل أن يتمكنوا من العثور على موطئ لأقدامهم في البنى الحديثة، أي قبل أن يربطوا بين بعض الممارسات التي تحوَّلت والمبادئ الجديدة، من أجل تشكيل مُتخيَّل اجتماعي قابل للحياة. لكن هذا لا يُبيِّن أن الفردانية الحديثة، في جوهرها، مذيبة للجماعة. ولا يُبيِّن أيضًا أن المعضلة السياسية الحديثة هي تلك التي حددها هوبز: كيف نُنقذ الأفراد المتذررين Atomic من معضلة السجينين؟ وكانت المشكلة الحقيقية التي لا تفتأ تعاود الظهور قد حظيت بتعريف أفضل على يد توكفيل، أو على يد فرانسوا فورياي François Furet في أيامنا هذه.
التشوُّه الثاني، تشوُّه مألوف. يبدو المبدأ الحديث بديهيًا: أولسنا أفرادًا من حيث طبيعتنا وجوهرنا؟ إلى حد أنه يُغرينا بتفسير مجيء الحداثة عن طريق “الطرح”. لقد كان علينا أن نتحرَّر من الآفاق القديمة، ومن ثم كان مفهوم النظام المستمد من الخدمة المتبادلة بديلًا بديهيًا. ولا يحتاج الأمر إلى تبصّر خلّاق، ولا إلى جهد بنَّاء. فلن يتبقى لنا بعد أن نتخلص من الأديان القديمة والميتافيزيقا سوى الفردانية والمنفعة المتبادلة كفكرتين بديهيتين.
بيد أن الأمر لم يكن كذلك. فقد عاش البشر تاريخهم في أغلب ردهاته، في أنماط من التكامل الممزوج بالتراتبية بنسب متفاوتة. وكان مستويات المساواة محدودة جدًا، كتلك التي كانت بين مواطني البوليس، وهي مستويات لا تعدو شيئًا قياسًا إلى تضخم التراتبية. وغني عن التذكير أن هذه المجتمعات بعيدة كل البعد عن الفردانية الحديثة. وما يبعث على الاستغراب هو تمكّن الناس من النجاح في العبور إلى الفردانية الحديثة، لا على مستوى النظرية فحسب، بل على مستوى تحويل المُتخيَّل الاجتماعي واختراقه. وأصبح هذا المُتخيَّل متصلًا الآن بمجتمعات لا سابق لقوتها في تاريخ البشر، لذلك تبدو مقاومة الأمر مستحيلة، بل تبدو جنونًا، لكن علينا ألا نقع في المفارقة التاريخية المتمثلة في الاعتقاد بأن الأمر لا يكون إلا كذلك دائمًا.
الترياق الأفضل لهذا الخطأ هو أن نتذكر من جديد بعض مراحل المسار الطويل والمتصارع الذي انتهت عبره هذه النظرية إلى الهيمنة على مخيلتنا.
سأذكِّر ببعض من هذا مع تقدم النقاش. أما في هذه المستوى فسأكتفي بحوصلة ما تقدم ورصد السمات الأساسية لهذا التصور الحديث للنظام الأخلاقي. ويمكن اختصار ذلك في نقاط ثلاث، أضيفت إليها نقطة رابعة:
1- تظهر الأًمْثلَة الأصلية لنظام المنفعة المتبادلة هذا في نظرية الحقوق ونظرية الحكم الشرعي. وتبدأ بالأفراد وتتصوَّر أن المجتمع أُقيم من أجلهم. ويُنظر إلى المجتمع السياسي كأداة في خدمة شيء ما سابق عن السياسي.
تُشير هذه الفردانية إلى نبذٍ لمفهوم التراتبية الذي كان مهيمنًا في السابق، ومفاده أن البشر لا يستطيعون أن يؤدوا دور الفاعل الأخلاقي الصحيح إلا عندما يستقرون ضمن كلًّ اجتماعيًّ أكبر تتمثل طبيعته ذاتها في إظهار التكاملية التراتبية. وتقف نظرية غروتيوس-لوك، في صيغتها الأصلية، ضد جميع النظريات التي يُعتبر أرسطو أبرز القائلين بها، والتي تنكر أن يكون المرء ذاتًا بشريةً حقَّةً خارج المجتمع.
مع تقدم هذه الفكرة عن النظام وما ترتب عنها من تفريعات جديدة، تصبح من جديد متصلةً بالأنثروبولوجيا الفلسفية التي تُعرِّف البشر بوصفهم كائنات اجتماعية غير قادرة على الفعل أخلاقيًا بمفردها. ويعتبر كل من روسو وهيغل وماركس من أوائل الأمثلة على ذلك، وخلفهم في ذلك جمهرةٌ من المفكرين في زماننا هذا. لكنني ما زلت مقتنعًا بأن هذه ليست سوى صيغ منقحة من الفكرة الحديثة لأن ما تطرحه بوصفه مجتمعًا حسن التنظيم يتضمن علاقاتٍ من الخدمة المتبادلة بين أفرادٍ متساوين، باعتبارها عنصرًا أساسيًا. هذا هو الهدف، حتى لدى من يرون أن “الفرد البورجوازي” محضُ خيال، وأن الهدف لا يمكن تحقيقه إلا في مجتمع شيوعي. ورغم ارتباط هذه المفاهيم الأخلاقية تتناقض مع مفاهيم منظري القانون الطبيعي، ومع قربها من أرسطو الذين يرفضونه، فإن نواة الفكرة الحديثة تبقى الفكرة الرئيسة في عالمنا.
2- إن المجتمع السياسي، باعتباره أداة، يُمكَّن هؤلاء الأفراد من أن يخدم أحدهم الآخر من أجل المنفعة المتبادلة، سواء من حيث توفير الأمن أو من حيث تعزيز التبادل والازدهار. ويجب تبرير أي فوارق في المجتمع انطلاقًا من هذه الغاية، فما من شكل تراتبي أو سواه صالح وحسن في ذاته.
تكمن أهمية هذا، مثلما رأينا أعلاه، في أن الخدمة المتبادلة تُركِّز على حاجات الحياة العادية، وليس على تحقيق أعلى مستوى من الفضيلة للأفراد. فهي تهدف إلى تحقيق شروط وجودهم بوصفهم فاعلين أحرارًا. وهنا أيضًا، تشتمل التنقيحات اللاحقة على نوع من المراجعة وإعادة النظر. من ذلك مثلًا أن الحرية نفسها، عند روسو، هي أساس حدّ الفضيلة الجديد.
ويصبح نظام المنفعة المتبادلة الحقيقية غير قابلٍ للانفصال عن النظام الذي يؤمن فضيلة الاستقلال الذاتي. لكن تركيز روسو المركزي، ومن اتبعه، يظل منصبًّا على ضمان الحرية، والمساواة، وحاجات الحياة العادية.
3- تبدأ النظرية بالأفراد الذين يتعيّن على مجتمعهم السياسي أن يخدمهم. والأهم من هذا هو أن الخدمة التي يُسديها لهم تتحدَّد وفق شروط الدفاع عن حقوق الأفراد تلك التي تكون الحرية على رأسها. وتتجلّى أهمية الحرية في متطلب تأسيس المجتمع السياسي على اتفاق أولئك الذين يلتزمون به.
إذا ما تدبَّرنا هذه النظرية في السياق الذي سطعت فيه، فسنتبيّن أن التأكيد الحاسم على الحرية فيه إسراف. فنظام المنفعة المتبادلة بمثابة مثل أعلى يتعيّن بناؤه. وهو بمثابة مرشد لأولئك الراغبين في إقامة سلم مستقر، وفي إعادة تشكيل المجتمع حتى يقترب أكثر من هذه المعايير. وينظر خصوم النظرية إلى أنفسهم على أنّهم فاعلون يستطيعون، من خلال تحررهم وانضباطهم، إعادة تشكيل حيواتهم الخاصة، إضافة إلى إعادة تشكيل النظام الاجتماعي الكبير. فهم ذواتٌ عازلة ومنضبطة. وتحتل الفعالية الحرَّة مكانة محورية في فهم الذات. كما أن تأكيد الحقوق وأولوية الحرية بالنسبة لهؤلاء ليس نابعًا من المبدأ القائل إن على المجتمع أن ينوجد من أجل أعضائه فحسب، بل يعكس أيضًا إحساس أصحاب هذه الفكرة بفاعليتهم وبالوضعية التي تتطلبها الفعالية في العالم معياريًا، أي الحرية.
ومن ثم، فإن الأخلاق الفاعلة هنا يجب أن تتحدد وفق شروط الفعالية، كما يجب أن تتحدَّد بحسب متطلبات النظام المثالي بوصفها أخلاقيات الحرية والمنفعة المتبادلة. ويحتل كلاهما مكانة أساسية في هذا التعبير. وبذلك يلعب الاتفاق دورًا مهمًا في النظريات السياسية المنبثقة عن هذه الأخلاقيات.
تلخيصًا لما تقدم، نقول إن نظام المنفعة المتبادلة (1) يقوم بين أفراد (أو، على الأقل، بين فاعلين أخلاقيين مستقلين عن النظم التراتبية الكبيرة)؛ تشتمل المنافع. (2) وعلى نحو شديد الأهمية، على الحياة ووسائل الحياة، على الرغم من أن تأمينها يتصل بممارسة الفضيلة؛ يهدف النظام إلى ضمان الحرية. وهو يجد، على نحو سهل، تعبيرًا (3) عنه بالعلاقة مع الحقوق. ولنا أن نضيف إلى هذا نقطةً رابعة (4) يجب ضمان تلك الحقوق، وتلك الحرية، وتلك المنفعة المتبادلة، بشكل متساوٍ لجميع المشاركين. وسيتنوع المعنى الدقيق للمساواة. لكن تثبيت هذا المعنى على نحوٍ ما يبقى واجبًا يُمليه رفض النظام التراتبي.
تلك هي السمات الحاسمة، أي الثوابت التي طبعت فكرة النظام الأخلاقي الحديثة على الرغم من تنوع صيغها.
2- ما هو “المتخيّل الاجتماعي”؟
استخدمت مصطلح المتخيّل الاجتماعي مرات كثيرة فيما تقدم من صفحات، ولكن آن الأوان لتوضيح ما يعنيه هذا المصطلح.
أعني بالمتخيَّل الاجتماعي شيئًا أوسع وأعمق من الصيغ الفكرية التي قد يعتمدها الناس عندما يفكرون في الواقع الاجتماعي من دون الانخراط فيه، أي الطرائق التي يتخيَّل من خلالها الناس وجودهم الاجتماعي وكيفيات توافقهم فيما بينهم وكيف تجري الأمور بينهم وبين أتباعهم، وكذلك في التوقعات التي تجري تلبيتها عادة، إضافة إلى الأفكار والصور المعيارية الأعمق الكامنة خلف هذه التوقعات.
ثمة اختلافات مهمّة بين المتخيَّل الاجتماعي والنظرية الاجتماعيـة وأنا أتبنى مصطلح “المتخيّل” لأنّ (i) تركيزي منصبّ على الطريقة التي يتخيّل بها الناس العاديون محيطهم الاجتماعي وهذا ما لا يجري التعبير عنه على نحو نظري غالبًا، لكنه يكون محمولًا في الصور والقصص والأساطير، كما أن النظرية (ii) غالبًا ما تكون في حيازة أقلية صغيرة في حين أن ما يثير الاهتمام في المتخيّل الاجتماعي هو أنه موضوع مُشترك لدى مجموعات واسعة من الناس، إن لم يكن مُشترك لدى المجتمـع كله. وهذا ما يقودنا إلى اختلاف ثالث (iii) يتمثل في أن المتخيّل الاجتماعي هو ذلك التمثّل المشترك الذي يجعل الممارسات الاجتماعيـة ممكنة إضافة إلى الإحساس العام المشترك بالمشروعية.
يحدث في أكثر الأحيان أن يتسرَّب إلى المتخيّل الاجتماعي ما يتَّخذ بداية شكل صورة نظرية يحملها بعض الناس، وربما يتسرَّب أولًا إلى النُخب، لكنه سرعان ما يتجاوزهم إلى المجتمـع ككل بعد ذلك، هذا ما حدث على نحو عام لنظريات غروتيوس ولوك على الرغم من أنها شهدت إجمالًا تحوّلات كثيرة على امتداد هذا المسار بحيث تمخضت عنها صيغ متنوعة في نهاية المطاف.
أيًّا كان الزمن المعني فإن متخيَّلنا الاجتماعي معقّد، إذ يشتمل على حسّ بالتوقعات العادية التي تكون لدى كلّ منّا تجاه الآخر، وعلى نوع من التمثل المشترك الذي يمكّننا من القيام بالممارسات الجمعيّة التي تكوِّن حياتنا الاجتماعية، ويتضمّن نوعًا من الحسّ المتعلّق بكيفية تآلفنا معًا في القيام بالممارسات العامة المشتركة. وهذا التمثل واقعي و”معياري” في الآن ذاته، أي أن لدينا حسًّا بمجريات الأمور في سيرورتها المعتادة، إلا أنه لا ينفصل عما لدينا من أفكار حول ما يجب أن تكون عليه مجريات الأمور، ذلك أن من شأن خطوات خاطئة أن تقوِّض الممارسة. فلنأخذ مثلًا اختيار الحكومات عن طريق الانتخابات العامة، حيث يتمثل قسم من خلفية الفهم الذي يمنح معنى للتصويت بالنسبة لكل واحد منّا في وعينا بالفعل الكلي، بما في ذلك جميع المواطنين، بحيث يختار كل منهم بمفرده، ولكن من بين البدائل نفسها، ثم تجتمع هذه الاختيارات الصغرى كلها ضمن قرار جمعي ملزم، ومن بين الأمور الأساسية في كل ذلك، قدرتنا على تمثل المخالفات في ما يتعلق بفهمنا لما يشتمل عليه هذا النوع من القرارات الكبرى: بعض أشكال التأثير، وشراء الأصوات والتهديدات وما إلى ذلك، وينبغي لهذا النوع من القرارات الكبرى، إن جاز لنا التعبير بلغة أخرى، أن يُلبي معايير بعينها حتى يستجيب لما هو مُنتظر منه، من ذلك مثلًا، إذا تمكنت أقلية من إرغام الآخرين جميعًا على الانصياع لأوامرها، فإن القرار لم يعد ديمقراطيًا.
يقوم هذا التصور للمعايير على قدرتنا على تمييز حالات مثالية، مثل الانتخابات التي يُعبِّر فيها كلّ مواطن عن رأيه بكل استقلالية حيث ينصت فيها الجميع بلا استثناء لأصواتهم، وخلف هذا المثل الأعلى يقف تمثل لنظام أخلاقي أو ميتافيزيقي يضفي معنى على المعايير والمثل العليا.
ما أسميه المتخيَّل الاجتماعي يمتدّ إلى ما يتجاوز التمثل المباشر الذي يضفي على ممارسات معينة معنى، ولا يتعلق الأمر هنا بامتداد اعتباطي لهذا التمثل لأنه لا يكون للممارسة وحدها من دون تمثّل أيّ معنى بالنسبة إلينا، وبذلك لا تكون ممكنة، إذ إن هذا الفهم يفترض، حتى يكون له معنى، إلمامًا واسع النطاق بوضعنا في كليته: كيف يقف كلّ منّا تجاه الآخر وكيف وصلنا إلى ما نحن فيه وكيف نرتبط بالجماعات الأخرى، وهكذا دواليك.
ليس لهذا الإلمام واسع النطاق أيّ حدود واضحة، وهذه هي الطبيعة الحقة لما سمَّاه الفلاسفة المعاصرون “بالخلفية”([12]). إنها في الواقع ذلك التمثل غير المبني عمومًا وغير المحكم لوضعنا ككلّ، والذي تظهر لنا فيه سمات عالمنا الخاصة على نحو ما هي عليه، وليس من المناسب أبدًا التعبير عن هذا التمثل في شكل عقائد صريحة، لأنه تمثل ذو طبيعة غير محدودة ولا محدّدة. وهذا سبب آخر يدعونا إلى الحديث هنا عن “متخيّل” وليس عن “نظرية”.
ليست العلاقة بين الممارسات، وخلفية التمثّل التي تقف وراءها، علاقة أحادية الجانب. فإذا كان التمثّل هو ما يجعل الممارسة ممكنة، فمن الوارد جدًا أيضًا أن تحمل الممارسة هذا التمثّل على نطاق واسع. يمكن أن نتحدث عن “مخزون” من الأفعال الجمعيّة موجود في متناول جماعة ما ضمن المجتمع، ويتعلق الأمر هنا بتلك الأفعال المشتركة التي تحذقها الجماعة بدءًا من الانتخابات العامة التي تعني المجتمع ككل، إلى تبادل أطراف الحديث بشكل مهذب، ولكن عرضي مع جماعة جمعتنا بها الصدفة في قاعة استقبال. والتمييزات التي يتعيّن علينا اعتمادها في ذلك، مع من نتحدث ومتى وكيف، تخضع لـ”خريطة” ضمنية للفضاء الاجتماعي تُعيّن أيّ صنف من البشر يمكن أن نرتبط بهم، وبأي طرق وفي أي ظروف، وقد أضطر إلى الامتناع عن أي محادثة على الإطلاق إذا كانت المجموعة التي ألتقيها صدفة ذات مكانة اجتماعية أعلى من مكانتي، أو إذا كانت تفوقني مرتبة ضمن التراتبية البيروقراطية، أو إذا كانت مكوَّنة من النساء فقط.
يُميز الإدراك الضمني لهذا الفضاء الاجتماعي خلافًا للوصف النظري له بين أصناف مختلفة من البشر ويحدّد المعايير الخاصة بكل صنف منهم. فعلاقة الفهم الكامن في الممارسة بالنظرية الاجتماعية تُماثل العلاقة التي تربط قُدرتي على تدبّر أمري في بيئة مألوفة في خريطة (بالمعنى الحرفي) لهذا الفضاء. فأنا قادر تمامًا على توجيه نفسي من دون أن أتبنّى وجهة النظر التي توفرها لي تلك الخريطة، وبالمثل في ما يتعلق بالجزء الأكبر من تاريخ البشرية والجزء الأكبر من الحياة الاجتماعية، فإننا نفعل من خلال إلمامنا بالمخزون المشترك من دون أن نحتاج في ذلك إلى وجهة النظر النظرية. فقد كان الناس يعملون على نحو جيِّد من خلال المتخيّل الاجتماعي قبل أن يتحوَّلوا هم أنفسهم إلى موضوع النظرية([13]).
ويمكن أن نُقدِّم مثالًا آخر يُساعدنا على تمثل امتداد هذا الفهم الضمني وعمقه على نحو أفضل: هب أننا نريد تنظيم تظاهرة. وهذا يعني أن هذا الفعل موجود في مخزوننا، إذ نعلم كيف نجتمع وكيف نحمل اللافتات، وكيف نسير. ونعلم أن هذا يعني ضرورة البقاء ضمن حدود معيَّنة سواء من حيث الفضاء (لا يجوز أن نجتاح بعض الفضاءات) أو من حيث الاحتكاك بالآخرين (تجنُّب العدوانية وتجنُّب العنف). إننا نعي جيّدًا هذه الطقوس.
إن خلفية الفهم التي تجعل هذا الفعل ممكنًا بالنسبة إلينا، هي خلفية معقدة في الواقع، لكن ما يمنحها معنى هو تلك الصورة التي لدينا عن أنفسنا عندما نتحدّث إلى الآخرين الذين تربطنا بهم علاقة ما كأبناء وطننا مثلًا، أو بني البشر عمومًا، ويحضر هنا فعل خطابي، إذ هناك مُخاطِب ومخاطَبون، وثمة فهم ما لموقع كلّ منهم بالنسبة للآخر ضمن هذه العلاقة، وثمة فضاءات عمومية ونحن نتبادل الحديث في ما بيننا. وككل فعل خطابي تتعلق المخاطبة بكلمة منطوقة قبلًا ضمن منظور كلمة يُراد قولها([14]).
يوحي نمط المخاطبة بوجهة النظر التي نتبناها بشأن من نخاطبهم، وهذا الفعل قصري لأن المقصود منه التأثير، بل لعله يمكن أن يكون تهديدًا بعواقب معينة ما لم يُنصت إلى رسالة المخاطِب، لكنه يقصد الإقناع أيضًا، وذلك هو وجهه العنيف، وهو يفترض أن المخاطِب على حق.
يتأتى المعنى المباشر لما نفعله مثل إيصال رسالة إلى الحكومـة وإلى نظرائنا من المواطنين مفادها أن من الواجب إيقاف الاقتطاعات المالية، وضمن سياق أوسع نطاقًا نعتبر فيه أنفسنا في علاقة دائمة مع الآخرين. ونخاطبهم بهذه الطريقة وليس عن طريق الاسترحام المذل أو التهديد بالعصيان المسلح على سبيل المثال. ويمكن أن نوجز ذلك بالقول إن لهذه المظاهرة مكانها الطبيعي ضمن مجتمع مستقرّ ومنظم وديمقراطي.
لا يعني هذا أنه لا وجود لحالات يكون فيها العصيان المسلح مبررًا، مانيلا Manilla في عام 1985 أو تيانانمان Tienanmen في عام 1989، لكن الغرض من هذا الفعل ضمن هذه الظروف على وجه التحديد، هو دعوة الطغاة إلى قبول الانتقال الديمقراطي.
ومن ثم نرى كيف أن فهم ما نقوم به في الوقت الراهن (الفهم الذي لولاه ما كنا لنستطيع القيام بهذا الفعل) يضفي على الفعل معناه، بسبب إلمامنا بالوضع في مجمله: كيف نتموقع على الدوام في علاقتنا بالآخرين وبالسلطة. وهذا يفتح بدوره منظورات أوسع نطاقًا على تموقعنا في الزمان والمكان: علاقتنا بالأمم وبالشعوب الأخرى، أي النماذج الخارجية للحياة الديمقراطية التي نحاول محاكاتها أو للطغيان الذي نحاول أن ننأى بأنفسنا عنه. وكذلك إلى تموقعنا في التاريخ ضمن قصة صيرورتنا حيث ندرك هذه القدرة على التظاهر السلمي بوصفه من منجزات الديمقراطية كسبه أسلافنا يشق الأنفس، أو نطمح إلى الوصول إليه عن طريق هذا الفعل المشترك.
هذا المعنى للتموقع على المستوى الدولي والتاريخي أيضًا إنما تثيره صور وأيقونات التظاهر نفسه كما حدث في ساحة تيانانمان عام 1989 التي تُحيل على الثورة الفرنسية، فضلًا عن “إحالته” على الحالة الأميركية من خلال تمثال الحرية.
إذن فإن الخلفية التي تُضفي المعنى على أي فعل معطى كانت عميقة وممتدة. ورغم أنها لا تضم كل شيء في عالمنا إلا أن السمات المتصلة بها التي تعطيها المعنى لا حصر لها. ولهذا السبب لنا أن نقول إن إضفاء المعنى هذا مستند إلى عالمنا كله، أي إلى إدراكنا لوضعنا برمته في الزمان والمكان وبين الآخرين وفي التاريخ.
هناك جزء مهم من هذه الخلفية الممتدة، هو ما اعتبرته أعلاه إحساسًا بالنظام الأخلاقي. وأقصد بهذا ما يتجاوز مجرد إدراك المعايير الكامنة في ممارستنا الاجتماعية من حيث هي جزء من تمثلنا المباشر الذي يجعل هذه الممارسة ممكنة. يجب أن تتوفر أيضًا، كما أشرت سابقًا، فكرة عما يجعل من هذه المعايير قابلة للتحقق. وهذا بدوره جزء أساسي من سياق الفعل. لا يتظاهر الناس من أجل المستحيل أو من أجل ما هو طوباوي([15])، وإذا فعلوا فإن الأمر يغدو نتيجة ذلك مختلفًا حقًا. عند سيرنا في ساحة تيانانمان ينتابنا إحساس، ولو جزئي، بأنه بإمكاننا تحقيق مجتمع أكثر ديموقراطية على الرغم من ريبية حكامنا المتمسكين بالماضي.
تنبع هذه الثقة بكل بساطة، مثلًا، من فكرة مفادها أننا كبشر قادرين معًا على تحقيق نظام ديموقراطي مستدام من حيث هو جزء من إمكانياتنا البشرية، ومن حيث هو ينطوي على الصور الخاصة بالنظام الأخلاقي الذي نفهم من خلاله حياة البشر وتاريخهم. ويجب أن يكون واضحًا مما تقدَّم أن صورنا عن النظام الأخلاقي ليس ضروريًا، بأي حال، أن تكون منحازة إلى الوضع القائم رغم أنها تمنح معنى لبعض أفعالنا. وقد تكون هذه الصور أيضًا أساسًا لممارسة ثورية كما في مانيلا وبيكين Beijing مثلما يمكن أن تكون أساسًا للنظام القائم المستقر.
منذ البدء أودّ أن أُقدِّم في الصفحات اللاحقة، صورة عن التحوُّل، وعن العملية التي تغلغلت من خلالها النظرية الحديثة للنظام الأخلاقي إلى متخيَّلنا الاجتماعي على نحو تدريجي وغيرته. وفي هذه العملية يتطوَّر ما كان مجرّد أمثلة في الأصل ليصبح متخيّلًا معقّدًا عبر اعتماده في الممارسات الاجتماعية واقترانه بها وهي ممارسات تقليدية في جزء منها، لكنها غالبًا ما تتغيَّر عن طريق الاحتكاك. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى ما سمّيته أعلاه امتداد تمثل النظام الأخلاقي. وما كان لهذا التمثل أن يكون تمثلًا مهيمنًا في ثقافتنا من غير هذا التغلغل/التغيير لمتخيّلنا.
ونلاحظ تحوُّلات من هذا النوع حدثت في الثورتين العظيمتين المؤسستين لعالمنا الغربي المعاصر: الأميركية والفرنسية. لقد كان التحوُّل أكثر سلاسة وأقل كارثية في واحدة من الحالتين، لأن أمْثَلة السيادة الشعبية كانت متَّصلة اتصالًا نسبيًا وعلى نحو غير إشكالي بممارسة قائمة للانتخاب الشعبي للمجالس. أما في الحالة الأخرى، فقد كان انعدام القدرة على “ترجمة” المبدأ نفسه ضمن منظومة مستقرة ومقبولة من الممارسات أرضية ملائمة للنزاع والارتياب على امتداد ما يزيد عن قرن بأكمله. لكن كان هناك وعي ما بالأولوية التاريخية للنظرية في هذين الحدثين العظيمين على حد سواء. وهو وعي مركزي بالنسبة إلى الفكرة الحديثة حول “الثورة” حيث ننطلق في إعادة تشكيل حياتنا السياسية تبعًا لمبادئ مُتفق عليها. وقد أصبحت هذه “النزعة البنائية” سمة مركزية في الثقافة السياسية الحديثة.
ما الذي يعنيه بالضبط أن تتغلغل النظرية في المتخيّل الاجتماعي وتُغيّره؟ يتولىّ الناس في معظم الأحيان أمر القيام بممارسات جديدة أو ارتجالها أو يقع حثّهم على ذلك. وتكتسب هذه الأشياء معناها عن طريق نظرة عامة جديدة تبسّطها النظرية أول الأمر. هذه النظرة هي السياق الذي يمنح الممارسات معناها. وهكذا يغدو التمثل الجديد متاحًا أمام المشاركين على نحو لم يكن موجودًا من قبل. وهو يبدأ في تحديد السمات الخارجية لعالمهم ويستطيع في نهاية المطاف أن يُعتبر شكلًا مسلّمًا به للأشياء وهو أوضح من أن يُذكر.
لكن عملية تغيير المتخيَّل الاجتماعي ليست أحادية الجانب. فعندما تمنح النظرية الفعل معناه، “تشذب” وفق شكل معيَّن، وبحسب سياق هذه الممارسات. وعلى نحو يُشبه مفهوم كانط عن المقولة المجردة التي تصبح “ذات مخطط محدد” عند تطبيقها في الواقع في إطار الزمان والمكان، فإن النظرية تكتسب شكلًا محددًا في مجال الممارسة العامة المشتركة الكثيفة([16]).
على أن العملية لا تتوقف عند هذا الحد، فالممارسة الجديدة مع الفهم الضمني الذي تولده يمكن أن يكون أساسًا لتعديلات على النظرية تستطيع بدورها أن تؤثر في الممارسة وهكذا دواليك.
ما أسميه “المسيرة الطويلة” هي عملية تتطوَّر بموجبها الممارسات الجديدة أو الممارسات القديمة المعدّلة بشكل مرتجل لدى مجموعات معينة من الناس أو لدى طبقات معينة من السكان (كالفضاء العمومي لدى النخب المتعلمة في القرن الثامن عشر أو كالاتحادات لدى العمال في القرن التاسع عشر) أو تطلقها نخب في المجتمع على نحو يُجنِّد لها قاعدة تتسع أكثر فأكثر (كالتنظيم اليعقوبي لـ”أقسام” باريس على سبيل المثال). وفي المقابل فإن من شأن منظومة من الممارسات في مسار تطورها وتشبعها التدريجيين أن تُغيِّر معناها في نظر الناس على نحو متدرّج، فتساعد على إنشاء متخيّل اجتماعي جديد (“الاقتصاد”). وقد أعقب ذلك كله تحوّل عميق للمتخيّل الاجتماعي في المجتمعات الغربية، ولاحقًا في العالم الذي نعيش فيه.
3- الاقتصاد بوصفه واقعًا موضوعيًا
توجد في الحقيقة ثلاثة أشكال رئيسة للفهم الاجتماعي للذات، وهي أشكال حاسمة بالنسبة للحداثة، ويمثل كل منها تغلغلًا أو تحويلًا للمتخيَّل الاجتماعي بحسب نظرية غروتيوس-لوك حول النظام الأخلاقي. وهي على التوالي: (1) “الاقتصاد”، و(2) الفضاء العمومي، و(3) ممارسات الحكم الذاتي الديمقراطي ونظرياته.
(1) كان الاقتصاد مرتبطًا بشكل واضح بفهم الذات في الحضارة “المتمدنة” كما قامت في المجتمع التجاري. لكننا نستطيع العثور على جذور هذا الفهم قبل المجتمع التجاري، وذلك في فكرة غروتيوس-لوك عن النظام نفسه.
لقد ذكرت أعلاه أن هذا المفهوم الجديد عن النظام أحدث تغيرًا في فهم الكوسموس الذي كان يُنْظَر إليه بوصفه من منتجات العناية الإلهية. ولدينا هنا في الحقيقة واحدٌ من أبكر الأمثلة على النموذج الجديد للنظام، وهو يتحرَّك متجاوزًا ميدانه الأصلي، ويُعيد تشكيل صورة حكم العناية الإلهية.
إن التصوُّر القائل إن الله يحكم العالم تبعًا لخطةٍ حميدة مفهومٌ قديم العهد، بل إنه سابق على المسيحية وله جذوره في اليهودية وفي الرواقية أيضًا. أما الجديد فيتمثل في طريقة فهم هذا المخطط الخيِّر. وهذا ما نعثر عليه في المحاجات المختلفة حول تصميم العالم ووجود الله الخالق الخيِّر. وهذه هي تصورات قديمة أيضًا. لكنها كانت تصر في ما مضى على التصميم الرائع للإطار الكليّ الذي جُعل فيه عالمُنا (النجوم والكواكب… إلخ)، ثم على التصميم الدقيق والمثير للإعجاب الذي صُمِّمَت عليه المخلوقات، بما فيها نحن أنفسنا، حيث تُلائمُ الأعضاءُ وظائفها تمام الملاءمة، وكذلك على الطريقة العامة التي استدامت بها الحياة بفعل سيرورات الطبيعة نفسها.
ما من شك بأن هذه التصوّرات لا تزال قائمة. لكن ما يُضاف إليها في القرن الثامن عشر هو الإعجاب بالطريقة التي صُمِّمَت وفقها الحياة البشرية بحيث تنتج منفعة متبادلة. ينصب التركيز في بعض الأحيان على فعل الخير المتبادل، لكن هذا التصميم الموفق غالبًا ما يُحدد بوجود ما قد نسميه عوامل “اليد الخفيّة”، وأعني بذلك الأفعال والمواقف التي “بُرمجنا” لها، وتكون لها دائمًا نتائج نافعة لها أثرها على السعادة العامة، حتى إن لم يكن ذلك جزءًا مما هو مقصود بالفعل، أو مما هو راسخ في الموقف الكامن خلف الفعل. لقد قدَّم لنا آدم سميث Adam Smith في كتابة “ثروة الأمم” أكثر هذه الآليات شهرة، حيث يُفضي بحثنا عن ازدهارنا الشخصي إلى الازدهار العام. لكن ثمَّة أمثلة أخرى نستطيع استخلاصها من كتابة نظرية المشاعر الأخلاقية، حيث يذهب إلى أن الطبيعة جعلتنا شديدي الإعجاب بالثروة والحظوة، لأن النظام الاجتماعي يتمتع بأمنيات أكبر إذا ما استقر على احترام الفوارق الظاهرة المرئية بدلًا من خصال الفضيلة والحكمة التي هي أقل إثارة للانتباه([17]).
يتعلق النظام هنا بنظام ميكانيكي مTحكم الانتظام، تلعب فيه السببية الفعالة دورًا مهمًا. وهو يختلف في هذا عن التصورات القديمة للنظام حيث يأتي التناغم من التوافق بين الصور أو المُثل كما تتجلى في مستويات مختلفة من الوجود أو في مراتب مختلفة في المجتمع. والأمر المهم في التصور الجديد هو أن مقاصدنا تتشابك مهما كانت متباعدة في الإدراك الواعي لدى كل منا، وهي تُدخلنا في تبادل للمنافع. فنحن نُعجب بالأغنياء وأصحاب النسَب الحسن، وندعمهم أيضًا، وفي المقابل ننعم بالنظام المستقر الذي يكون الازدهار مستحيلًا من دونه. فالتصميم الإلهي تصميم قائم على تقاطع الأسباب وتداخلها، وليس على المعاني المتناغمة.
بعبارة أخرى، إن البشر منخرطون في تبادل للخدمات. ويبدو النموذج الأساسي هو ما أصبحنا نطلق عليه اسم الاقتصاد.
يتضح هذا الفهم الجديد للعناية الإلهية في صياغة لوك لنظريةَ القانون الطبيعي في رسالته الثانية. ولنا أن نتبين هنا حجم الأهمية التي يحظى بها البعد الاقتصادي في المفهوم الجديد للنظام. ويتجلى ذلك في ناحيتين: الأمن والازدهار الاقتصادي هما الهدفان الأساسيان للمجتمع المنظم. ولما كانت النظرية تشدد بشكل كامل على نوع من التبادل المفيد، فإننا نحسب أن المجتمع السياسي نفسه أصبح يُنظر إليه من خلال استعارة شبه اقتصادية.
وعندئذ، فإن شخصًا في أهمية لويس الرابع عشر يُقرّ، في نصيحته لابنه البكر، شيئًا يُشبه هذه النظرة التي تكرِّس هذه النزعة التبادلية: “إن هذه الظروف المختلفة التي تؤلّف العالم لمتحدةٌ في ما بينها فقط عن طريق الواجبات المتبادلة. وليس الاحترام والإجلال اللذان نلقاهما من رعايانا بعطيَّةٍ مجانية منهم، بل لقاء ما ينتظرونه منا من حماية وعدل”([18]).
يسلط هذا، بالمناسبة، الضوء من جديد على (ما اتضح أنه) مرحلة انتقالية مهمة في “المسيرة الطويلة” لنظام المنفعة المتبادلة وصولًا إلى متخيلنا الاجتماعي. واعتُبر هذا النموذج منافسًا للنظام القائم على الأمر والتراتبية. فما اقترحه لويس الرابع عشر وآخرون في زمانه يمكن اعتباره نوعًا من التوفيق بين الجديد والقديم. فما هو جديد هنا هو التبادل الضروري والمثمر للخدمات بوصفه مبررًا لاختلاف الوظائف بين الحاكم والمحكوم. لكن ما يجري تبريره هنا يظل مجتمعًا تراتبيًا، ويظل قبل كل شيء أكثر ضُروب العلاقة التراتبية حدة: علاقة المُلك المطلق بالرعية. ويتم تبرير هذه العلاقة، أكثر فأكثر، من خلال الضرورة الوظيفية. لكن الصور الرئيسة لا تزال تعكس شيئًا من التفوُّق الجوهري، أو شيئًا من التراتبية الأنطولوجية. ولما كان المَلك فوق الجميع، فهو قادر على الإحاطة بالمجتمع ككل وعلى استدامة كل شيء. فهو مثل الشمس، بحسب الصورة المفضلة لدى لويس الرابع عشر([19]).
لنا أن نعتبر هذا بمثابة حلّ “باروكي”([20])، على أنَّ مثاله الأكثر سطوعًا في فرساي يُفهم وفق تعابير كلاسيكية. وقد ساد هذا التوفيق ردحًا من الزمن في معظم أنحاء أوروبا، معززًا الأنظمة القائمة بما لها من عظيم البهاء والطقوس ومتخيّلات التكامل التراتبي، ولكن على أساس تبرير مستمد أكثر فأكثر إلى النظام الحديث. ويتنزل دفاع بوسياي على حكم لويس الرابع عشر المطلق ضمن هذا السجلّ ذاته.
لكن أمكن للاقتصاد أن يصبح أكثر من استعارة حيث أصبح يُنظر إليه، أكثر فأكثر، بوصفه غاية المجتمع الغالبة. وفي زمن نصيحة لويس الرابع عشر لابنه، طرح مونكريتيان Montchrétien نظرية للدولة تعتبرها، من حيث المبدأ، سلطة منظَّمة تستطيع أن تجعل الاقتصاد يزدهر (وبالمناسبة، يبدو أن هذا الرجل هو أول من ابتدع مصطلح “الاقتصاد السياسي”). يعمل التجَّار حُبًا بالكسب، لكن سياسة الحاكم الرشيدة (يد مرئية جدًا في هذه الحالة) يمكن أن توجّه هذا الحبّ صوب الخير المشترك([21]).
يعكس هذا التحوُّل الثاني السمة الثانية (2) للنظام الحديث الذي عرضته أعلاه: تعطي المنفعة المتبادلة التي يُراد لكل منا أن يمنحها للآخر مكانة حاسمة لضمان الحياة وأسبابها. ولا يُعتبر هذا التحوُّل معزولًا ضمن النظريات المعنية بالعناية الإلهية، بل إنه يتنزل ضمن توجُّه رئيس في ذلك العصر.
غالبًا ما يُفهم هذا التوجه وفقًا للتفسيرات المادية القياسية التي عرَّجت عليها في الفصل الثالث، ومن أمثلتها التفسير الماركسي القديم الذي يقول بأنَّ طبقات رجال الأعمال، والتجار، والصناعيين في وقت لاحق، ظلت تزداد عددًا وتكتسب مزيدًا من القوة بشكل لافت. وهذا التفسير، يحتاج هو في حد ذاته، إلى أن يكتمل من خلال الإشارة إلى المتطلبات المتغيّرة لسلطة الدولة. فقد بدأت تظهر، على نحو متزايد، نخب حاكمة ترى في زيادة الإنتاج والتبادل الملائم شرطين رئيسين للقوة السياسية والعسكرية. وتوضح تجربتا هولندا وإنكلترا ذلك. وبطبيعة الحال، ما أن تبدأ بعض الأمم في التطوّر الاقتصادي حتى يكون المنافسون مرغمين على اتّباع المسار نفسه أو التردي إلى حالة التبعية. وبفضل ذلك تعزَّز وضع طبقات التجار إضافة إلى مساهمة تنامي عددها وثروتها في ذلك.
وبقدر ما كانت هذه العوامل مهمة، إلا أنها لا تكفي وحدها لتفسير هذا التحوُّل بشكل كامل للأسباب التي أتيت عليها ذكرها بعمق آنفًا. فالأمر يتعلق بتغيّرات على مستويات عدة، وليس على المستوى الاقتصادي وحده، بل على المستويين السياسي والروحي كذلك. وأعتقد أن فيبر على حق، رغم أن تفاصيل كثيرة من نظريته تفتقد للمتانة.
يحظى الأشخاص العاملون الذين يمارسون مهنة ثابتة بأهمية أولية، لأنهم بذلك يضعون أنفسهم في “مسارات سوية” بحسب التعبير الطهراني (البيوريتاني). ولما أصبحت الحياة المنظمة مطلبًا، لا للنخبة العسكرية أو الروحية/الثقافية فحسب، بل لعموم الناس العاديين أيضًا، فإنه يتعيّن عليهم أن يتقنوا أفعالهم وكل ما يتعيّن عليهم فعله في الحياة بكل جدية، أي العمل في مهنة مُنتجة. فمن مقتضيات المجتمع المنظم حقًا أن نأخذ هذه المهن الاقتصادية على محمل الجد وأن ننظمها. ذلك هو الشأن “السياسي”.
لكن كان ثمَّة سبب روحي ضاغط، في المسيحية التي أُصلحت وفي أوساط الكاثوليك على نحو متزايد أيضًا، من أجل الأخذ بهذا المتطلب الذي يُشير إليه فيبر. وإذا عبَّرنا عن الأمر بمصطلحات الإصلاح نقول: إذا كنا سنرفض الفكرة الكاثوليكية القائلة إن ثمة مسارات أسمى في الحياة، كالتبتل أو حياة الأديرة مثلًا، وذلك طبقًا لخطط الكمال، وإذا ما زعم المرء أن على المسيحيين جميعًا أن يكونوا مسيحيين مئة بالمئة، وأن المرء يستطيع أن يكون كذلك من خلال مهن كثيرة أو مسارات حياة كثيرة، فإن عليه أن يزعم أيضًا أن الحياة العادية التي لا يستطيع أغلب الناس اجتنابها، أي حياة الأسرة والإنتاج والعمل والجنس، حياة تستحق التبجيل مثلما تستحقه أي حياة أخرى. بل تستحق التبجيل أكثر مما يستحقه التبتل في الأديرة، لأن حياة التبتل تلك قائمة على الزعم الباطل والمغرور بأن أصحابها قد وجدوا طريقًا أسمى.
ذلك هو أساس إكساب الحياة العادية صفة القداسة. وأعتقد أن له أثرًا تكوينيًا هائلًا على الحضارة الغربية، إثر تجاوز المسار الديني الأصلي، فطال جملة من الأشكال العلمانية أيضًا. لهذا الأساس وجهان: فهو يحضّ على الحياة العادية باعتبارها موطنًا لأرفع أشكال الحياة المسيحية، وهو يحمل أيضًا توجهًا معاديًا للنخبة: لأنه يخفض أنماط الوجود التي يُزعم أنها أرفع من سواها، سواء في الكنيسة (مهام الكهنوت) أو في العالم (الأخلاقيات المنبثقة عن الأقدمين التي تضع التأمل في مكانة أسمى من الوجود المنتج). لقد أُزيح الأقوياء عن عليائهم، وأُعليَ من شأن الضعفاء المعدمين.
كان لهذين الوجهين دور تكويني في تطور الحضارة الحديثة. فالتشديد على الحياة العادية جزء من خلفية المكانة المركزية التي حظي بها الاقتصاد في حياتنا، إضافة أيضًا إلى الأهمية القصوى التي نعلقها على الحياة الأسرية أو على “علاقتنا”. أمّا الموقف المضاد للنخبة فيشكّل أساس الأهمية الأساسية للمساواة في حياتنا الاجتماعية والسياسية([22]).
تساهم كل هذه العوامل، مادية وروحية، في تفسير الصعود التدريجي للاقتصاد حتى بلغ مكانته المركزية، وهو ما يشهد عليه القرن الثامن بشكل واضح. وقد ظهر عامل آخر في ذلك الوقت، وقد يكون مجرد امتداد للعامل “السياسي” الذي أشرت إليه أعلاه، ويتمثل في تنامي الاعتراف بصدقية الفكرة القائلة إن التجارة والنشاط الاقتصادي هما السبيل إلى السلم والوجود المنظم. وبذلك أصبحت “التجارة الناعمة” نقيضًا للنزعة التدميرية الوحشية المتأصلة في البحث الأرستقراطي عن المجد العسكري. وكلما ازداد التفات المجتمع إلى التجارة، ازداد “تمدنًا”، وتميَّز في فنون السلم. لقد أصبح الدافع إلى كسب المال “هوىً هادئًا”. وكلما استولى هذا الدافع على المجتمع، ساعد في ضبط الأهواء العنيفة وكبتها. وبعبارة أخرى إن كسب المال أصبح يخدم مصالحنا، وإن المصالح تستطيع أن تراقب الأهواء وأن تضبطها([23]). حتى أن كانط ذهب إلى الاعتقاد بأن الأمم يقلُّ لُجوؤها إلى الحرب عندما تصبح جمهورية، لأنها تصبح أكثر تأثرًا بسلطة دافعي الضرائب العاديين الذين تحركهم مصالحهم الاقتصادية.
تُشكّل فكرة النظام الطبيعي التي أصبحت متمركزةً حول الاقتصاد أساس العقائد التي تقول بتناغم المصالح. بل إن هذا التصوُّر الجديد للنظام الطبيعي سُحب على الكون أيضًا، بما أنه يعكس رؤية القرن الثامن عشر للنظام الكوني، لا باعتباره تراتبية من الصور المتحققة، بل باعتباره سلسلة من الكائنات غاياتها متشابكة. والأشياء تلتحم معًا بحيث يساعد أحدها الآخر في استمراره وازدهاره. إنها تشكل الاقتصاد المثالي.
أُنظر إلى النبات يموت فتستمر الحياة،
أُنظر إلى الحياة تتحلل ليحيا النبات من جديد:
كل أشكالٍ تزول ترفد أشكالًا أخرى،
(وبدورنا نلتقط نفحة الحياة ثم نموت)
مثل فقاعات تولد على سطح البحر الأم،
تعلو، ثم تهلك، وإلى البحر تعود.
لا شيء غريبًا: الأجزاء تتَّصل بالكل؛
روح واحدة تمتد في كل مكان وتحفظ الجميع
تربط بين الكائنات جميعًا، عظيمها ووضيعها؛
الوحش يغيث الإنسان، والإنسان يغيث الوحش،
الكل يُخدَم، والكل يخدُم: لا شيء منعزلًا؛
تمتد السلسلة، ولا يعرف أحدٌ أين تنتهي
□ □ □ □
الله موجود في طبيعة كل كائن
يمنحه البركة الحقة ويرسم حدوده السليمة؛
لكنه، ما دام قد شكّل كلًا، فالكلّ مبارك،
على الحاجات المشتركة تقوم السعادة المشتركة:
يتصل الكائن بالكائن، والإنسان بالإنسان.
ومن ثم يخلص الشاعر بوب بكل فخر إلى أن “حب الذات الحقيقي وحب المجتمع سيّان”([24]).
هكذا، قد يتمثل أول تحوُّل عظيم أحدثته هذه الفكرة الجديدة عن النظام، في النظرية وفي المتخيَّل الاجتماعي على حد سواء، في أننا أصبحنا نرى مجتمعنا بمثابة “اقتصاد”، أي منظومة متداخلة من نشاطات الإنتاج والتبادل والاستهلاك، وهو ما يشكل نظامًا له قوانينه وديناميكيته الخاصة. وبدلًا من كونه مجرد إدارة، يقوم بها من هُم في السلطة، للموارد التي نحتاجها كجماعة في بيوتنا أو في الدولة، أصبح “الاقتصاد” الآن يحدد طريقة ارتباطنا في ما بيننا، ومجالًا لتعايش يمكن أن يكون مكتفيًا بذاته من حيث المبدأ، ما لم يكن عُرضة لخطر الفوضى والصراع. وتصوُّر الاقتصاد كنظام هو بمثابة إنجاز لنظرية القرن الثامن عشر، مع الفيزيوقراطيين وآدم سميث، لكن التوصل إلى أن التعاون والتبادل الاقتصاديين هما أكثر غايات المجتمع وبرامج عمله أهمية يمثل تحولًا في متخيلنا الاجتماعي بدأ في تلك الحقبة ولا يزال مستمرًا إلى يومنا هذا. ومنذ ذلك الحين، لم يعد المجتمع المنظم مساويًا للسياسة، وأصبح يُنظر إلى أبعاد أخرى للوجود الاجتماعي باعتبارها تمتلك أشكالها الذاتية وتكاملها الذاتي. وانعكس ذلك في التحوُّل الذي عرفه معنى مصطلح “المجتمع المدني” في تلك الحقبة.
ذلك هو الشكل الأول من الأشكال الثلاثة للمتخيَّل الاجتماعي التي عُنيت بتحليلها. لكن، قبل الانتقال إلى الشكل الثاني، أريد أن أذكر سمة عامة طبعت فهمنا الحديث لذاتنا، وهذه السمة تطفو على السطح حالما نقيم التضاد بين الاقتصاد والشكلين الآخرين. وكلا الشكلين – أعني الفضاء العمومي وسيادة “الشعب ” – يتخيلاننا على أننا فعاليات جمعية. وهذه الأنماط الجديدة من الفعالية الجمعية هي من بين أبرز سمات الحداثة الغربية وما بعدها: فنحن نفهم أنفسنا، بقطع النظر عن أيّ اعتبار، كذوات تعيش في عصر ديمقراطي.
بيد أن اعتبار الحياة الاقتصادية، كما لو كانت يدًا خفية، يبقى أمرًا مختلفًا تمامًا. فلا وجود لفاعل جمعي هنا، وهذا الاعتبار ينتهي إلى إنكار ذلك أصلًا. كلهم هناك فاعلون، أفراد يتصرَّفون بحسب تصوراتهم، لكن النتيجة الشاملة تحدث من خلف ظهورهم جميعًا. ولها شكل معيَّن يمكن التنبؤ به، لأن ثمة قوانين معينة تحكم طريقة تتالي أفعالهم الفردية في مجملها.
يضفي هذا التوصيف طابعًا موضوعيًا على الوقائع الاجتماعية ويتعامل معها كبقية الأحداث الطبيعية، باعتبارها تخضع للقوانين ذاتها. لكن هذه النظرة التي تُضفي الطابع الموضوعي على الحياة الاجتماعية هي مجرد جزء من التصور الحديث، جزءٌ منبثق من النظام الأخلاقي الحديث، وذلك كأنماط جديدة لتخيّل الفعالية الاجتماعية. والأمران مترابطان معًا مثل ارتباط جزأين من رزمة واحدة. فبمجرد أن نكف عن التعامل مع فكرة النظام الاجتماعي بوصفه مثلًا متحققة في الواقع، بالمعنى الأفلاطوني، ونتعامل معه بوصفه صورًا تفرضها الفعالية البشرية على الواقع الخامل، عندئذ نحتاج إلى صور لهذا الواقع الخامل وللعلاقات السببية التي تهيكله، مثلما نحتاج إلى نماذج لفعلنا الجمعي في هذا الواقع. فالمهندس يحتاج إلى معرفة قوانين المجال الذي يعمل فيه بقدر حاجته للتخطيط الذي يعمل على تنفيذه، ذلك أن هذا الأخير (التخطيط) لا يمكن التعرُّف إليه من دون التعرف على الأول.
هكذا، يشهد هذا العصر أيضًا بدايات تشكل نوع جديد من إضفاء الموضوعية على العلوم الاجتماعية، وذلك ابتداءً من المسح الذي أجراه وليام بيتي William Petty في إيرلندا أواسط القرن السابع عشر، وتجميع الحقائق والإحصائيات عن الثروة والإنتاج والسكان حتى تكون أساسًا للسياسة. ومثلت الصور التي تضفي للطابع الموضوعي على الواقع الاجتماعي سمةٌ بارزة من سمات الحداثة الغربية شأنها شأن إنشاء فعاليات جمعية واسعة النطاق([25]). فالوعي الحديث للمجتمع ثنائي البؤرة على نحو لا فكاك منه.
من أجل فهم أفضل لهذا التحوُّل في طبيعة العلم، علينا أن ننظر إليه من الجهة الأخرى لهذا الانقسام. فطالما أن المجتمع كان يُفهم في ضوء شيء يُشبه الغائية بالمعنى الأفلاطوني أو الأرسطي، فإن هذه النظرة ثنائية البؤرة كانت مستحيلة. وإذ أتحدث عن الغائية، فإنني لا أود إثارة أي عقائد ميتافيزيقية من العيار الثقيل. إنني أتحدث عن فهم واسع الانتشار للمجتمع من حيث هو ذو “نظام سويّ”، نظام يسعى إلى أن يتكرَّس مع مرور الزمن، لكنه يمكن أن يتعرَّض للخطر بفعل بعض التطورات التي يمكن، إن تجاوزت مستوى معينًا، أن تدفعه إلى الانزلاق إلى الدمار أو الصراع المدني أو الفقدان الكامل لصورته القويمة. ويمكننا أن ننظر إلى هذا الفهم كفهم للمجتمع مماثل تمامًا لفهمنا لذواتنا بوصفنا كائنات حية عضوية عن طريق المفاهيم الأساسية الرئيسة عن الصحة والمرض.
لقد كان لمكيافيلي نفسه فهم من هذا القبيل عندما يتعلق الأمر بأشكال الحكم الجمهوري. وهناك توازن متوتر بين “العظماء” والشعب لا بد من المحافظة عليه إذا كان لهذه الأشكال أن تستمر. وتجري المحافظة على هذا التوازن في الكيانات السياسية المعافاة من خلال اللعب أو التنافس والرقابة المتبادلة بين الأنظمة. لكن ثمَّة تطورات معيَّنة يمكن أن تضع كل تقدّم في مواجهة الخطر، من قبيل إسراف المواطنين في الاهتمام بثرواتهم وممتلكاتهم الخاصة، إلا أن ذلك يعتبر هذا “فسادًا”، وما لم يُعالج هذا الفساد في حينه، وبجدية، فإنه قد يقضي على الحرية الجمهورية. هنا ثمَّة إسناد سببي: الثروة تقوِّض الحرية. لكن مصطلح “فساد”، بما له من وقع معياري قوي، يُبيِّن أن فهم المجتمع ينتظم حول مفهوم للشكل السويّ.
لمّا كان الفكر الاجتماعي منظمًا على هذا النحو، فإن النظرة ثنائية البؤرة لا تستطيع أن تترسَّخ. فلا يُفهم الواقع باعتباره خاملًا، بل باعتباره متشكلًا وفق صورة سويّة يصمد ضمن حدود معيَّنة من خلال اتخاذ مسافة عن صورته المناسبة، حدود يحدث بعدها انزلاقٌ إلى الخراب، مثلما يحدث في جسد بشري معافى. ويُنظر إلى الفعل الجمعي الناجح باعتباره يحدث ضمن ميدان متشكّل وفق هذه الصورة، بل إنَّ هذه الصورة هي شرطها. وما أن نفقده، حتى يتفكّك الفعل الجمعي إلى أغراض متناحرة فاسدة بين أفراد أنانيين لا تعنيهم إلا مصلحتهم. لا وجود لواقع خامل، ولا لفعل من الخارج يفرض صورة معينة على هذا الواقع.
قد يتبادر إلى الذهن أن مفهوم آدم سميث عن اليد الخفية يُحدد نظامًا “سويًا” جديدًا: نظامٌ من الاغتناء المتبادل. ولعلّه يمكن التعامل مع هذا المفهوم بهذه الطريقة من بعض النواحي، وهذا ما يقوله كثير من دعاة السوق الليبراليين الجدد في زماننا هذا. لكنه ليس نظامًا للفعل الجمعي، لأن السوق نفيٌ للفعل الجمعي. حتى يعمل نظام السوق على نحو سليم، فإنه يتطلب ضروبًا معينة من التدخّل (حفظ النظام، إنفاذ العقود وتحديد الأوزان والمقاييس… إلخ)، و(يُشدَّد عليها بشكل متكرّر) وضروبًا من عدم التدخل أيضًا (فلتتركنا الحكومة وشأننا). لكن ما هو لافتٌ للنظر كثيرًا في ما يخص اليد الخفيّة التي يقول بها آدم سميث، من وجهة نظر العلم القديم، هو أنها نظام تلقائي يظهر عند يعمّ الفساد، أي في أوساط الفاعلين الأنانيين الذي لا تعنيهم إلا مصلحتهم. وهو ليس اكتشافًا يخص الشروط المعيارية للفعل الجمعي السليم، على غرار الصلة التي أقامها مكيافيلي بين الثروة والفساد.
في علم يهتمّ بهذه الشروط، ليس ثمة مجال لفعل غير مؤطَّر بواقع مؤسس معياريًا، ولا لدراسة للميدان الاجتماعي الخامل المحايد معياريًا. وليس لأي مكون من مكونيّ النظرة الحديثة ثنائية البؤرة أي موضع هنا.
إن هذا التحوُّل في طبيعة العلم على علاقة أيضًا بالتغيّر الذي أشرت إليه في عدة فقرات سابقة. فبالنسبة للمحدثين، لم يعد المجتمع المنظم مساويًا لنظام الحكم. فما أن نكتشف أن العمليات المجرّدة مما هو شخصي تتمّ وراء ظهور الفاعلين حتى نتبين وجوهًا أخرى للمجتمع تُظهر نوعًا من الانتظامية الشبيهة بالقانون. والاقتصاد الذي تقوده اليد الخفية واحدٌ من هذه الوجوه. وستتحدَّد في وقت لاحق وجوه أخرى للحياة الاجتماعية أو للثقافة أو للديموغرافيا من أجل إخضاعها للمعالجة العلمية. وستكون هناك أكثر من طريقة يمكن بموجبها اعتبار أن ذلك الجسم نفسه من الكائنات البشرية التي تتفاعل بشكل منتظم يشكل كيانًا واحدًا، أي مجتمعًا. ولنا أن نتحدث عن ذلك الجسم باعتباره “اقتصادًا” أو “دولة” أو “مجتمعًا مدنيًا” (أصبح يتحدد الآن بأوجهه غير السياسية)، أو مجرد “مجتمع” أو “ثقافة”. لقد تمَّ فك الارتباط بين “المجتمع” و”السياسة”. وتحرر مفهوم المجتمع حتى أصبح قائمًا بذاته من خلال عدد من التطبيقات المختلفة.
قامت هذه الثروة العلمية في كثير منها على رفض نمط التفكير المعياري الغائي. كما كان هذا الرفض جزءًا مركزيًا من التفكير الأخلاقي الذي انبثق من فكرة النظام الحديثة، تلك الفكرة التي تجد تعبيرًا عنها في معاداة لوك ومن تأثر به المناهضة للأرسطية. وبطبيعة الحال، فإن رفض الغائية كان يحركه موقف شهير مؤيد للعلم الميكانيكي الجديد؛ لكنه كان مدفوعًا أيضًا بالنظرية الأخلاقية الناشئة حديثًا. فما ميَّز نظرية القانون الطبيعي الذرية الجديدة عن سابقتها، كما صاغها توما الأكويني مثلًا، هو انفصالها التام عن المنظومة الأرسطية التي كانت مركزية لدى الأكويني: لم تُستنتج الأشكال السياسية السليمة من غاية لها فاعليتها في المجتمع البشري. فما يُبرر القانون هو أنه جاء بأمر الله (لوك) أو أن له معنى منطقيًا، بالنظر إلى الطبيعة المنطقية والاجتماعية للبشر (غروتيوس)، أو أنه (وهذا ما حصل في وقت لاحق) يؤمّن الطريق أمام تناغم المصالح([26]).
لا تخلو النظرة الحديثة ثنائية البؤرة من توتراتها الخاصة. وقد ذكرت أن الحرية، بوصفها خيرًا أساسيًا، تحظى بأهمية كبيرة جدًا في النظام الأخلاقي الحديث: فهي واحدة من الخصائص الأساسية للبشر الذين يتوافقون حول المجتمع ويكوّنونه، وهي منقوشة في وضعهم باعتبارهم صانعين يبنون عالمهم الاجتماعي الخاص، لا باعتبارهم مولودين في عالم اجتماعي يمتلك شكله “العادي” أصلًا. والواقع أن من بين أسباب الرفض العنيف للغائية الأرسطية هو أنها تحدّ من حريتنا في تقرير حياتنا وبناء مجتمعاتنا.
لكن قد ينشأ صراع بين النظرتين، لهذا السبب ذاته. فما يقع بالنسبة إلى إحدى المدرستين في ميدان النظرة الموضوعية إلى الواقع الذي لا يمكن تجنبه يُمكن أن تعتبره المدرسة الأخرى انتقاصًا لقدرة الإنسان على تصميم عالمه أمام “موضوعية” زائفة. والأهمية ذاتها التي تحظى بها الحرية لا بدّ أن تبرز هذا النوع من التحدي. كان هذا الصنف من النقد مركزيًا في أعمال روسو، وكذلك في أعمال مَن جاء بعده: فيخته وهيغل وماركس. وغني عن التأكيد على أهيمتهم في حضارتنا، فقد تواتر الطموح إلى تحويل ما هو “في ذاته” إلى شيء يفترض أنه “لذاته”، إذا ما استخدمنا المصطلحات الهيغلية-الماركسية. وهذا ما نلاحظه في المحاولة الدائمة الرامية إلى تحويل ما يكون في البدء فئات اجتماعية موضوعية فحسب كـ”المعوقين”، أو “المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”، مثلًا، إلى فعاليات جمعيّة من خلال حركات تعبوية.
لكن، كان ثمَّة تقليد إنساني مدني سابق على ما كتبه هؤلاء الفلاسفة وكان له أثره في أعمالهم، ألا وهو أخلاقيات الحكم الذاتي الجمهوري. وهنا نصل إلى توتر لا ينفصل عن النظام الأخلاقي الحديث ذاته. وعلى الرغم من تطوره وترسخه في متخيلاتنا الاجتماعية الحديثة، فإنه أيقظ إحساسًا بالشك والقلق. ورأينا أن ترسخه كان على صلة بالفهم الذاتي للمجتمع الحديث باعتباره مجتمعًا تجاريًا، وأن التحوُّل إلى المرحلة التجارية ساهم في تحقيق السلم الأهلي في الدول الحديثة. لقد قضى هذا المجتمع على أسباب الحرب كأسمى نشاط بشري، واستعاض عنها بالإنتاج. فقد ناهض قيم شرف المحارب القديمة، وسوّاها.
وقد أثار هذا مقاومة لم تقتصر على الفئات التي كان لها نصيب في مجريات الأمور في صيغتها القديمة، أي نبلاء السيف. بل شملت أيضًا أناسًا آخرين من مواقع مختلفة من المناهضين لها. ومع مجيء المجتمع التجاري، أصبحت قيم العظمة والبطولة والإخلاص الكامل لقضية ليست نفعية، مهددة بخطر الضمور، لا بل خطر الانقراض من هذا العالم.
من بين أسباب هذا القلق، الخشية من أن يفقد الرجال، ممن يتَّبعون أيتوس المجتمع المتمدن، فضائلهم الرجولية ويصيرون “مُخنثين”. وقد تواترت هذه الفكرة المهمة في القرن الثامن عشر، وبرز ذلك على مستوى بدئي، في تمرد مشاغبي الطبقة العليا ضد مواضعات التمدن في ذلك العصر، وفي مستوى أعلى قليلًا، أدى ذلك إلى عودة المبارزة في إنكلترا في القرن الثامن عشر([27]). وفي المستوى الأعلى، فقد أدَّت هذه المخاوف إلى تشجيع أخلاقيات الإنسانية المتمدنة لتكون منافسًا لمبادئ المجتمع التجاري، أو ربما تعويضًا عن الأخطار – مثل الخَوَر، والفساد، وفقدان الحرية – التي أتى بها الشكل الحديث. ما كان هذا أمرًا هامشيًا، إذ شغل بال معظم المفكرين النافذين في ذلك الزمان، ومنهم آدم سميث([28]).
وما زالت هذه التوترات والمخاوف قائمة في صلب الثقافة الحديثة. وقد أدَّت، في صيغة أولى، إلى “صياغة” منقحة لفكرة النظام الحديثة؛ لإنقاذ الفضيلة المدنية أو الحرية أو الحكم الذاتي غير المغترب، كما في فلسفتي روسو وماركس. وقد اعتُبرت، في صيغة ثانية، كتهديد بالانحلال المتأصل في النظام، لكن أصحاب هذه النظرة لم يكونوا يرغبون البتة في رفض هذا النظام لمجرد التوقّي من مآلاته الخطيرة. ومن بين هؤلاء سميث، وتوكفيل من بعده.
كذلك تحوَّل القلق في ما يخص التعديل، ونهاية البطولة والعظمة، إلى شجب عنيف للنظام الأخلاقي الحديث وكل ما يقف وراءه، كما هو الشأن بالنسبة لنيتشه. لقد فشلت المحاولات التي رمت إلى بناء كياني سياسي حول مفهوم للنظام ينافس هذا المفهوم في قلب الحضارة الحديثة؛ ولقد باءت المحاولات المختلفة من الفاشية والأشكال السلطوية القريبة منها في ذلك. لكن استمرار شعبية نيتشه يُبيِّن أن هذا النقد الهدَّام لا يزال كثير من الناس يُطرب له في أيامنا هذه. ولا يزال النظام الحديث، على الرغم من ترسخه، بل ربما بسبب ترسخه هذا، لا يزال يُوقظ الاحساس بالمقاومة بشكل كبير.
4- الفضاء العمومي
(2) قد يكون البعد الاقتصادي أول أبعاد “المجتمع المدني” الذي تمكَّن من تكوين هوية مستقلة عن الكيان السياسي. لكن ما لبث أن لحق به الفضاء العمومي في وقت قصير.
الفضاء العمومي فضاء مشترك يلتقي فيه أفراد المجتمع عبر جملة متنوعة من الوسائط: المطبوعة، والإلكترونية، والمقابلات الشخصية المباشرة أيضًا؛ وذلك لمناقشة مسائل ذات اهتمام مشترك، والتوصل من خلال ذلك إلى تشكيل تفكير مشترك في هذه المسائل. وأقول “فضاءً مشتركًا” بصيغة المفرد، لأنه على الرغم من تعدد الوسائط، وتعدد التبادلات التي تحدث من خلالها، فهي تعتبر في حالة تواصل داخلي من حيث المبدأ. تأخذ المناقشات التي نراها على التلفزيون الآن في اعتبارها ما جاء في الصحف في الصباح، كما أن ما يُقال في الصحف ينطلق من حوارات تمَّت على الإذاعة قبل يوم، وهكذا دواليك. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نتحدث عادة عن الفضاء العمومي بصيغة المفرد.
الفضاء العمومي سمة مركزية في المجتمع الحديث، إلى حد يستلزم تزويره عندما يُراد قمعه أو التلاعب به. وتشعر المجتمعات الاستبدادية الحديثة أنها مجبرة على مسايرة ذلك. فافتتاحيات الصحف الحزبية، وهي افتتاحيات يُفترض أن تُعبِّر عن رأي كاتبيها، تُقدَّم كي ينظر فيها بقية المواطنين؛ ويجري تنظيم تظاهرات جماهيرية للتعبير عن غضب أعداد كبيرة من البشر. ويحدث ذلك كله لو أن ثمة عملية أصيلة تجري فتشكل تفكيرًا مشتركًا من خلال التبادل، على الرغم من أن النتيجة تكون مضبوطة ضبطًا متأنيًا منذ البداية.
أستند في هذه المناقشة بصفة خاصة إلى كتابين غاية في الأهمية. نُشر الكتاب الأول قبل نحو ثلاثين عامًا، لكنه لم يُترجم إلى الإنكليزية إلا مؤخرًا. وهو كتاب يورغن هابرماس الذي يحمل عنوان التحوُّل البنيوي للفضاء العمومي The Structural Transformation of the Public Sphere([29]). ويتناول الكتاب تطوُّر الرأي العام في أوروبا الغربية خلال القرن الثامن عشر. أما الكتاب الثاني فهو كتاب مايكل ورنر Michael Warner، رسائل الجمهورية ([30])The Letters of the Republic، الذي صدر مؤخرًا ويصف ظاهرة مماثلة في المستعمرات البريطانية في أميركا.
توجد في كتاب هابرماس فكرة مركزية تتمثل في ظهور مفهوم جديد للرأي العام في أوروبا الغربية في القرن الثامن عشر. حيث أصبح يُنظر إلى المطبوعات المتفرقة أو المجموعة الصغيرة أو التبادلات المحلية باعتبارها واحدة من النقاشات الكبيرة التي ينبثق منه “الرأي العام” لمجتمع بأسره. وبلغة أخرى، من المفهوم أن يكون أشخاص متباعدون يحملون الآراء نفسها متصلين عبر نوع من فضاء للنقاش يتمكنون عبره من تبادل الآراء مع الآخرين ومن الوصول إلى هذه النقطة النهائية المشتركة.
ما هو هذا الفضاء المشترك؟ إنه شيء غريب نوعًا ما حين نفكر فيه. فمن المفترض أنه لم يسبق للأشخاص المعنيين بالنقاش هنا أن التقوا قط، لكنهم مرتبطين في فضاء النقاش المشترك عن طريق وسائط، كانت في القرن الثامن عشر، عبارة عن وسائط مطبوعة، حيث كانت الكتب والمنشورات والصحف تُتداول بين جمهور المتعلمين، فتنقل التحليلات والأطروحات والمساجلات وما تنطوي عليه من حجج مضادة وأساليب دحض. كانت هذه الموضوعات تُقرأ على نطاق واسع وغالبًا ما تُناقَش في لقاءات مباشرة، وفي قاعات الانتظار، والمقاهي، والصالونات، و/أو في أماكن أكثر “عمومية” (من زاوية نظر السلطة) كالبرلمان مثلًا. والنظرة العامة المعنية التي تتمخض عن ذلك كله، إن وجدت، تعتبر “رأيًا عامًا” بحسب هذا المعنى الجديد.
هذا الفضاء “فضاء عمومي” بالمعنى الذي استخدمه هنا. وتحدثت في الفقرة السابقة عن النتيجة “باعتبارها” رأيًا عامًا، ويعكس هذا حقيقة أن الفضاء العمومي لا يمكن أن يوجد إلا إذا تمّ تخيّله بما هو كذلك. وإذا لم ينظر المشاركون إلى المناقشات المتفرقة باعتبارها متصلة ضمن تبادل كبير للرأي، فما من معنى لاعتبار حصيلتها رأيًا عامًا. ولا يعني هذا أن سلطة التخيُّل مطلقة. فثمة شروط موضوعية، منها ما هو داخلي، كأن تحيل المناقشات المحلية المجزّأة على بعضها البعض مثلًا، ومنها ما هو خارجي، بمعنى أنه يجب أن توجد مواد مطبوعة متداولة بين مصادر مستقلة عديدة حتى تصبح أسسًا لما يمكن اعتباره مناقشة مشتركة. وكما يُقال عادة، يعتمد الفضاء العمومي الحديث على “رأسمالية الطباعة” حتى يشتغل. لكن الطباعة في حد ذاتها، بل حتى رأسمالية الطباعة، مثلما بَيَّن ويرنر، لا تكفيان وحدهما لضمان اشتغال الفضاء العمومي. عليهما أن يتجذرا في السياق الثقافي القويم حيث يمكن أن تنشأ تمثلات مشتركة أساسية([31]). لقد مثَّل الفضاء العمومي طفرة في المتخيَّل الاجتماعي. وكانت هذه الطفرة حاسمة في تطوُّر المجتمع الحديث. كما كانت أيضًا خطوة مهمّة في مسيرته الطويلة.
إننا الآن في وضع أفضل نسبيًا لفهم ما يكون الفضاء العمومي، ولماذا اعتبر فتحًا جديدًا في القرن الثامن عشر. إنّه نوع من الفضاء المشترك، كما قلت، فضاء ينخرط فيه أناس لم يلتقوا قط في مناقشة، إلى أن يتوصلوا إلى تصوُّر مشترك. وسأعتمد هنا بعض المصطلحات الجديدة. ففي وسعنا الحديث عن الفضاء المشترك عندما يقوم الناس بفعل مشترك يتركز على غرض من الأغراض، كممارسة شعيرة معينة، أو استمتاعًا بمسرحية أو محادثة، أو الاحتفال بحدث عظيم أو أيّ شيء آخر. فمحور اهتمام هؤلاء الناس مشترك، وليس متقاربًا فحسب، لأنه جزء مما يُفهم عامة أنهم يجتمعون حوله على أنه موضوع اهتمام أو غرض مشترك، وليس مجرَّد اهتمام فردي لكل شخص على حدة. بهذا المعنى، فإن “رأي الناس” لا يُشير إلا إلى وحدة تقاربية فحسب، في حين يُشير مصطلح الرأي العام إلى شيء يُفترض أنه تمخض عن سلسلة من الأفعال المشتركة.
ينشأ نوع من الفضاء العمومي، مفهومًا على نحو حدسي، عندما يجتمع الناس لغرض من الأغراض، سواء أكان ذلك على مستوى ضيق من أجل محادثة، أم على نطاق أوسع وأكثر “عمومية” في مجلس تفاوضي، أو في شعيرة ما، أو في احتفال، أو من أجل الاستمتاع بمباراة رياضية أو بمسرحية غنائية. والفضاء العمومي الذي ينشأ نتيجة اجتماع الناس في موضع ما هو ما أُسمّيه “الفضاء العمومي المحلي”.
لكن الفضاء العمومي شيء مختلف. فهو يتجاوز هذه الفضاءات المحلية، ويعلو فوقها. ويمكن أن نقول عنه إنه يمثل نسيجًا من هذه الفضاءات الشبيهة ويوحدها ضمن فضاء أوسع نطاقًا غير قابل للتجميع. والمناقشة العمومية ذاتها هي ما يفترض أنه موضوع مناقشتنا في هذا اليوم، وموضوع محادثة صريحة يُدلي بها شخص آخر في اليوم الموالي، وموضوع مقابلة تجريها صحيفة من الصحف يوم الثلاثاء، وهكذا دواليك. وأنا أدعو هذا النوع الكبير من الفضاء المشترك غير المحلي فضاءً “عبر-محلي”. وقد كان الفضاء العمومي الذي نشأ في القرن الثامن عشر فضاءً مشتركًا عبر-محلي.
تنشأ هذه الفضاءات، جزئيًا، على التمثلات المشتركة؛ إذ بقدر ما لا تُردّ هذه الفضاءات إلى تمثلات من هذا القبيل، بقدر ما إنها لا توجد من دونها. وكل أنواع جديدة غير مسبوقة من الفضاءات تفترض تمثلات جديدة غير مسبوقة أيضًا. ذلك هو شأن الفضاء العمومي.
والجديد هنا ليس ما هو عبر-محلي، فالكنيسة وكذا الدولة هما من صنف الفضاء عبر-محلي. لكن تبيّن موضع الجّدة يحيلنا على السمات الأساسية للفضاء العمومي باعتباره خطوة ضمن مسيرة طويلة.
أعتقد أن الفضاء العمومي خطوة ضمن هذه المسيرة لأن فكرة النظام الحديثة هي ما ألهم هذه الطفرة في المتخيَّل الاجتماعي. وفي هذا المضمار تبرز سمتان. الأولى تضمنها الحديث الذي سقته منذ حين وتتعلق بهوية الفضاء العمومي المستقلة عما هو سياسي. والثانية، تخص قوته التي يتميَّز بها بوصفه معيارًا للمشروعية. ولأجل ذلك كلما بحثنا في أهمية هاتين السمتين استحضرنا أمْثَلتهما الأصلية لدى غروتيوس أو لوك مثلاً.
أولًا، تُعتبر أمْثَلة المجتمع السياسي، كما أشرتُ إلى ذلك بوضوح (النقطة 1)، لدى غروتيوس ولوك بمثابة أداة في خدمة شيء سابق على السياسة. وإذا ما أردنا الحكم على أداء الدولة، علينا أن نكون محايدين. وهذا ما ينعكس في الطرائق الجديدة لتخيُّل الحياة الاجتماعية مستقلة عمّا هو سياسي، على غرار الاقتصاد والفضاء العمومي.
ثانيًا، إنّ الحرية أساس الحقوق التي يتعيّن على المجتمع الدفاع عنها (النقطة 3). وبالاستجابة إلى هذا وإلى مفهوم الفعالية الكامن فيه معًا، تؤكد النظرية على أهمية قيام المجتمع السياسي على توافق أفراده.
وهذا معناه أن نظريات الحكم الشرعي القائمة على التعاقد وُجدت من قبل. أما الجديد في نظريات القرن السابع عشر فيتمثل في أنها تؤكد على أهمية الاتفاق. فلم يعد الأمر مقتصرًا على ضرورة توافق الشعب، بوصفه موجودًا مسبقًا، على من يريد أن يحكمه. فقد أصبح العقد الأصلي يقودنا خارج حالة الطبيعية، بل يُشكّل كذلك أساس وجود الجماعة التي لديها حقًا على الأفراد الأعضاء فيها.
يمكن لهذا المتطلب الأصلي للاتفاق التاريخي، مرة واحدة وإلى الأبد، بوصفه شرطًا للمشروعية، أن يتطوَّر بيسر إلى متطلب اتفاق قائم. فعلى الحكومة أن تحظى بتوافق المحكومين، لا في الأصل فحسب، بل كشرط متواصل لشرعيتها. وهذا ما يبدأ في الظهور في وظيفة الشرعنة التي يقوم بها الرأي العام.
يمكن عرض سمات الفضاء العمومي بترتيب عكسي، ويمكن التعبير عما هو جديد في شأنه بشكل أفضل على مستويين: فعله وماهيته.
أولًا، ما يفعله الفضاء العمومي، أو ما يُفعل فيه بالأحرى، حيث يُمثل الفضاء العمومي مجال مناقشة مفتوح أمام الجميع (رغم أنه كان مقتصرًا في القرن الثامن عشر على المتعلمين أو على أقلية من المتعلمين أو “المستنيرين”)، يستطيع ضمنه المجتمع أن ينتهي إلى تصوُّر مشترك في ما يتعلق بالقضايا الكبرى. وهذا التصوُّر المشترك هو بمثابة نظرة نسبية تنشأ عن المناقشة النقدية، وليس مجرد خلاصة لمختلف الآراء التي تكوَّنت لدى الناس([32]) وعليه فإن لهذا التصور مكانة معيارية: على الحكومة أن تصغي إليه. وذلك لسببين، يسعى أحدهما إلى التغلب على الآخر، وإلى ابتلاعه في آخر المطاف. يتمثل السبب الأول في أنه من الراجح أن يكون هذا الرأي مستنيرًا، وعليه من الحكمة أن تأخذ الحكومة به. وهذا ما نلمسه بوضوح في الشاهد التالي الذي أخذه هابرماس عن لوي سبستيان مرسييه Louis Sebastien Mercier([33]):
“تعتمد الكتب الجيّدة على الأنوار في كافة طبقات الشعب، وهي تُزيّن الحقيقة. وهي التي تحكم أوروبا أصلًا، إذ تنوّر الحكومة، في ما يتعلق بواجباتها وخطئها ومشروعها الحقيقي، على الرأي العام الذي يتعيَّن عليها الإصغاء إليه واتّباعه: فهذه الكتب الجيّدة بمثابة مُعلمين صبورين ينتظرون يقظة المسيَّرين وهدوء انفعالاتهم.”
ونعلم جيّدًا أن كانط يتبنّى رأيًا مماثلًا.
ينشأ السبب الثاني عن فكرة مفادها أن الشعب سيِّد. ومن ثم، فإن الحكومة لا تكون حكيمة فحسب إن هي اتَّبعت الرأي العام، بل هي مُلزمة بذلك أخلاقيًا. فعلى الحكومات أن تشرِّع وأن تحكم في وسط جمهور يُعْمل عقله. وإذا تعلق الأمر بعملية اتخاذ القرارات، فإن على البرلمان والمحكمة على حد سواء التركيز على ما يتمخض عن النقاش المستنير بين الناس، وعلى إنفاذه. وعن هذا ينشأ ما يسميه ورنر، مقتديًا بهابرماس، “مبدأ الرقابة”، الذي يُلح على أن تكون إجراءات أعمال الهيئات الحاكمة علنية ومفتوحة أمام تدقيق المواطنين المهتمين([34]). ومن خلال هذه العلنية، يستنير الرأي العام بالمداولات التشريعية، ويجعلها أكثر عقلانية، ويُمارس عليها ضغطه في الآن ذاته، وبالتالي الإقرار بأن على التشريع أن يُذعن في النهاية للتفويض الواضح الذي يمنحه هذا الرأي([35]).
وهكذا يكون الفضاء العمومي، المجال الذي تتبلور في صلبه الآراء العقلانية التي ينبغي أن تُرشد الحكومة وتلك سمة جوهرية تُميّز المجتمع الحر. وفي ذلك يقول بورك Burke: “في بلد حُر، يعتقد كل امرئ أنه معني بجميع الشؤون العامة”([36]). وهذا شيء جديد تمامًا، بطبيعة الحال، في القرن الثامن عشر، مقارنة مع كان عليه الحال في أوروبا في الماضي القريب جدًا. ولكن لنا أن نتساءل عما إذا كان ذلك جديدًا في التاريخ؟ أليست تلك ميّزة المجتمعات الحرة كافة؟
كلّا، هناك اختلاف دقيق، لكنه مهم. لنقارن بين مجتمع حديث فيه فضاء عمومي وبين جمهورية أو مدينة (بوليس). نستطيع أن نتخيَّل في هذه الأخيرة أن مناقشة الشؤون العامة تجري في جملة من الأوساط: بين الأصدقاء في منتداهم، وبين مَن يلتقون في الساحة العامة (الأغورا)، ثم في الإكليزيا (ekklesia) بطبيعة الحال حيث تُتخذ القرارات في النهاية. تدور المناقشة حتى ينتهي بها الأمر إلى الهيئة التي تمتلك صلاحية صنع القرار. لكن الاختلاف يكمن في أن المناقشة خارج هذه الهيئة تكون إعدادًا للفعل الذي يتخذه الأشخاص أنفسهم داخلها في نهاية المطاف. وليست المناقشات “غير الرسمية” منفصلة عن هذا الأمر، وليس لها مكانة خاصة، ولا يُنظر إليها على أنها تشكل نوعًا من الفضاء فوق-المحلي.
ذلك ما يحدث في الفضاء العمومي الحديث بوصفه فضاءً للمناقشة يُنظر إليه باعتباره خارج نطاق السلطة. ويُفترض أن تصغي السلطة إليه، لكنه، في ذاته، ليس ممارسة للسلطة. إنه بمعنى ما وضع خارج السياسة بالغ الأهمية. وكما سنرى أدناه، هذا يربط الفضاء العمومي بجوانب أخرى للمجتمع الحديث تعتبر خارج السياسة-جوهرية. وخارج السياسة لا يتحدَّد سلبًا كنقص للسلطة، بل يتحدَّد بشكل إيجابي: ما دام الرأي العام ليس ممارسة للسلطة، فيمكن أن يكون متحررًا بشكل مثالي عن الروح الحزبية والعقلانية.
وبعبارة أخرى، ثمة فكرة تأتي مع الفضاء العمومي الحديث مفادها أن على السلطة السياسية أن تخضع لرقابة ومراقبة شيء ما خارجها. فما هو جديد، بطبيعة الحال، ليس وجود مراقبة خارجية بل طبيعة هذا الحدث. فهو ليس حدثًا محددًا على أنه مشيئة الله أو قانون الطبيعة (مع أنه يمكن التفكير فيه بوصفه تعبيرًا عن ذلك)، بل كنوع من الخطاب المنبثق عن العقل، وليس عن سلطة أو مرجع تقليدي. إن السلطة، في تقدير هابرماس، يجب أن تُروّض بالعقل. وإن “الحقيقة هي التي تفرض القانون وليست السلطة” Veritas non auctoritas facit legem([37]).
هكذا يختلف الفضاء العمومي عن كل ما سبقه. وقد تقع مناقشة غير رسمية خارج مجال السلطة إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار حاسم. وهو يفترض بعض الصور من المجالس القديمة – وقد تجلّى ذلك بصفة خاصة في الحالة الأميركية – ليعطي الانطباع أن العمومي برمته يشكل فضاءً واحدًا للنقاش. لكنه، كما يُبيِّن ورنر، متجدد مقارنة مع النموذج الأصلي. فمن ينخرطون فيه أشبه بمتحدثين أمام مجلس. لكنهم، خلافًا لما كان عليه واقع الحال في نموذجهم في المجالس القديمة، يسعون إلى نزاهة ما وحياد ما وتحاشي الروح الحزبية. فهم يسعون من أجل نفي خصوصيتهم حتى يرتفعوا فوق “أي نظرة خاصة أو جزئية”. وهذا ما يُطلق عليه ورنر اسم “مبدأ النفي”. وهذا المبدأ ليس مناسبًا مع الطباعة فحسب، خلافًا للوساطة الشفوية، بل إنه يُعبِّر عن هذه السمة العامة من سمات الفضاء العمومي الجديد، بوصفه خارج السياسة، وبوصفه خطابًا للتفكير في السلطة وللسلطة وليس خطابها هي([38]).
يُشير ورنر إلى أن صعود الفضاء العمومي أحدث شرخًا في المثل الأعلى للنظام الاجتماعي القديم المحصَّن أمام النزاع والاختلاف. فعلى النقيض من ذلك، يعني الفضاء العمومي أن النقاش يتفجَّر، ويستمر بمشاركة الجميع من حيث المبدأ، وهذا أمر مشروع تمامًا. وهكذا تزول الوحدة القديمة إلى الأبد، لتحل محلها وحدة جديدة. وبما أن الجدل المستمر أبدًا لا يرمي إلى أن يكون ممارسة في نطاق السلطة، فإن حربًا أهلية قد تندلع بوسائل جدلية، عواقبها قد تكون مدمرة وتؤدي إلى الانقسام، لأن الأمر يتعلق بجدل يقع خارج السلطة، نقاش عقلاني خالٍ من الميول الحزبية لا يراد منه إلا تحديد الخير المشترك. “إن لغة مقاومة الجدل تصوغ معيارًا للجدل. وهي تُحوّل، صامتةً، مثلًا أعلى للنظام الاجتماعي خال من كل نقاش تنازعي إلى مثل أعلى للنقاش خال من التنازع الاجتماعي”([39]).
هكذا، فإن ما يفعله الفضاء العمومي هو مساعدة المجتمع على بناء تصوُّر مشترك من دون وساطة الفضاء السياسي، ضمن خطاب عقلي خارج السلطة، على الرغم من أنه يظل معياريًا بالنسبة إلى السلطة. ولنحاول الآن أن نرى، ثانيًا، ما الذي يجب أن يكون عليه، أو ما هي ماهيته حتى يتسنَّى له فعل ذلك.
لعل أفضل طريقة لتحديد ماهية الفضاء العمومي هي أن نسعى إلى تحديد ما هو جديد وغير مسبوق فيه. وسأتناول الأمر في خطوتين. أولًا: هناك جانب الجدّة الذي يتَّسم به وتطرقت إليه قبل قليل. عندما نقارن الفضاء العمومي بواحد من المصادر المهمَّة للصور المكونة له، أي الجمهورية القديمة، فإن ما نلاحظه مباشرة هو محله خارج -السياسي. وقاد شاع مصطلح “جمهورية الآداب” Republic of Letters بين أعضاء الجمعية الدولية للعلماء في أواخر القرن السابع عشر. وقد بشَّرت هذه الظاهرة بالفضاء العمومي، بل ساهمت في تشكيله أيضًا. إنها “جمهورية” خارج الفضاء السياسي.
لقد منح كل من التماثل والاختلاف هذه الصورة قوتها ومؤشرها: كانت جمهورية بمثابة رابطة موحدة تجمع المشاركين المستنيرين كافة بقطع النظر عن الحدود السياسية. لكنها كانت أيضًا جمهورية أيضًا باعتبارها خالية من كل إخضاع، ولم يكن “مواطنوها” يدينون بأي ولاء لما عداها في كل ما يتعلق بتجارة الآداب.
ورث الفضاء العمومي في القرن الثامن عشر شيئًا من هذا. حيث كان أفراد المجتمع يلتقون في الفضاء العمومي من أجل غاية مشتركة. ويشكّلون وهم واعون بذلك رابطة بمعزل عن بنيتها السياسية. وهذا لم يكن قائمًا في الجمهورية أو المدينة (البوليس) القديمة. كانت أثينا مجتمعًا، أو كوينونيا (koinonia)، لكن بوصفه مُكونًا سياسيًا فحسب. ويصح القول نفسه على روما. فقد كانت القوانين هي ما يعطي المجتمع القديم هويته. وكانت رايات كتائب روما تحمل الأحرف SPQR التي تعني “مجلس شيوخ شعب روما”؛ في حين تعني كلمة “شعب” مجموع مواطني روما، أي مَن تعرّفهم القوانين كمواطنين. فليس للشعب هوية ولا يُشكِّل وحدة قبل هذه القوانين، أو خارجها. وقد عكس هذا، كما رأينا أعلاه، تصورًا مشتركًا سابقًا على التصوُّر الحديث للنظام الأخلاقي/الميتافيزيقي الذي يُشكّل أساس الممارسة الاجتماعية.
في المقابل، نجد أن أسلافنا في القرن الثامن عشر، مع بروز الفضاء العمومي، تجمَّعوا في إطار رابطة، هي ذلك الفضاء العمومي للمناقشة الذي لم يكن يُدين للبنى السياسية بشيء، حيث كان مستقلًا عنها.
أن يكون الفضاء العمومي خارج السياسة فذلك وجه من وجوه جدّته، ففيه يجب أن يُنظر إلى أفراد المجتمع السياسي جميعًا (أو أفراده الأكفاء المستنيرين جميعًا على الأقل) باعتبارهم يُشكلون مجتمعًا خارج الدولة أيضًا. والواقع أن هذا المجتمع كان أوسع نطاقًا من أي دولة منفردة، فقد امتد لأسباب معيّنة ليشمل أوروبا المتمدنة بأسرها، وهذا الوجه بالغ الأهمية ويتوافق مع سمة حاسمة في حضارتنا المعاصرة نشأت في هذه الحقبة، يبدو أن ظهورها لا يتوقف عند الفضاء العمومي فحسب. سأعود إلى هذه النقطة بعد حين، لأنه يبدو من الضروري التوقف عند الخطوة الثانية أولًا.
من الواضح أن المجتمع خارج السياسي، الدولي، ليس جديدًا في حد ذاته. فلقد سبقته النزعة الكوسموبوليتية لدى الرواقية، والكنيسة المسيحية أيضًا. فقد كان الأوروبيون معتادين على العيش في مجتمع مزدوج منظم وفق مبدأين لا يستطيع أحدهما اختزال الآخر. وهكذا فإن الوجه الثاني لجدّة الفضاء العمومي يتحدد بعلمانيته الراديكالية.
وإني لأستعمل مصطلح علمانية بشكل مخصوص بحيث يكون أقرب إلى معناه الأصلي كتعبير عن نوع بعينه من الزمن. وهو وثيق الصلة، بشكل واضح، بمعنى مشترك “للعلمانية” الذي يرتكز على استبعاد الله أو الدين أو الروحي عن الفضاء العمومي. ولست أتحدث عن هذا تحديدًا، بل عن شيء ساهم فيه، ألا وهو التحوُّل الذي حدث في فهمنا لما يقوم عليه المجتمع. وعلى الرغم من مخاطر التداخل كلها، فثمة سبب لاستخدام مصطلح “علماني” هنا لأنه يحدد، من حيث أصله اللغوي، الشيء الجوهري في هذا السياق، وهو شيء على صلة بطريقة وجود المجتمع البشري في الزمن. لكن هذه الطريقة في توصيف الاختلاف تستلزم بعض الاستكشاف التمهيدي.
إن مفهوم العلمانية هذا مفهوم راديكالي لأنه في تضاد، لا مع الأساس الإلهي للمجتمع فحسب، بل مع أي فكرة عن المجتمع باعتباره متشكلًا وفق شيء يتعالى على الفعل المباشر المشترك المعاصر. وبالعودة إلى الأفكار قبل الحديثة عن النظام التي تناولتها في الفصل الأول، نجد مجتمعات تراتبية، مثلاً، تعتبر تجسيدًا مطردًا لجزء من سلسلة الوجود. وخلف الشحنات التجريبية لبعض شقوق الملكية أو الأرستقراطية أو غيرها، تكمن الأفكار أو الوقائع الميتافيزيقية المستمرة التي يُجسّدها هؤلاء الناس آنيًا. فللملك جسدان: واحد منهما فقط هو الجسد الخاص الفاني الذي يُطعم ويكسى، ويُدفن([40]) وبحسب هذه النظرة، فإنّ ما يُشكِّل المجتمع، باعتباره مجتمعًا، هو النظام الميتافيزيقي الذي يُجسده ذلك المجتمع([41]). يعمل الناس ضمن إطار قائم، سابق عن أفعالهم ومستقل عنها.
لكن العلمانية ليست في تضادٍ مع الكنائس المؤسسة إلهيًا أو مع سلسلة الوجود فحسب. وإنما هي مختلفة أيضًا عن فهم مجتمعنا باعتباره مجتمعًا قائما على قانون أوتي إلينا منذ الأزل. والسبب هو أن هذا يضع فعلنا أيضًا ضمن إطار يجمعنا معًا فيجعلنا مجتمعًا يتعالى فوق فعلنا المشترك.
وفي تناقض مع هذا كله، يُعتبر الفضاء العمومي رابطة لا يشكلها أي شيء خارج الفعل المشترك الذي نأتيه في صلبها: التوصل إلى عقل مشترك، متى أمكن ذلك، من خلال تبادل الأفكار. ولا يكون الفضاء العمومي رابطة إلا بقدر فعلنا المشترك على هذا النحو. ولا يكون هذا الفعل المشترك ممكنًا ضمن إطار يحتاج لكي يقوم إلى أساس يتعالى على الفعل: سواء أكان من خلال فعل الله، أم سلسلة عظيمة، أم من خلال قانون أوتي إلينا منذ الأزل. هذا ما يجعله فعلًا علمانيًا على نحو جذري، ويقودنا، فيما أعتقد، إلى قلب ما هو جديد وغير مسبوق فيه.
قد يكون في هذا العرض بعض الجرأة، إلا أنه من الواضح أن هذا المفهوم للعلمانية يحتاج إلى مزيد من التوضيح. ولعل التضاد واضح بما فيه الكفاية عندما يتعلق الأمر بهيئات صوفية وبسلسلات كبرى. لكني أعتقد أن يوجد اختلاف عن المجتمع القبلي التقليدي أيضًا، أي ذلك الذي كان لدى الشعوب الجرمانية التي أسست الكيانات السياسية شمال الأطلسية الحديثة، أو بصيغة أخرى، المجتمع الذي شكَّل الجمهوريات والمدن القديمة، وقد يعترض على هذا.
تتحدَّد تلك المجتمعات من خلال قانون. لكن، هل هذا هو كل الاختلاف عن الفضاء العمومي؟ وفوق كل ذلك، كلما أردنا أن نفعل في هذا المجال، اعترضتنا بنى عديدة: صحف معينة، وشبكات تلفزيونية، ودور نشر، وما إلى ذلك. ونحن نفعل ضمن القنوات التي توفرها هذه البنى. ألا يشبه ذلك وضع أي فرد في قبيلة، مَن كان عليهم أيضًا أن يفعلوا من خلال بنى قائمة بمشايخها ومجالسها واجتماعاتها السنوية… إلخ؟ إن مؤسسات الفضاء العمومي تتغيَّر بطبيعة الحال؛ تُفلس الصحف، وتندمج شبكات التلفزيون. لكن ما من قبيلة يمكن أن تظل ثابتة ثباتًا مطلقًا ضمن الأشكال الخاصة بها، لأن هذه الأشكال تتطوَّر مع الزمن أيضًا. وإذا ما اعتقدنا أن هذه البنية الموجودة قبلًا تظل صالحة للفعل المستمر، ولكن ليس للأفعال التأسيسية التي نشأ عنها الفضاء العمومي، فليس لنا أن نحددها في دفق الزمن وذلك هو دأب القبيلة. وإذا ما أصررنا على وجوب وجود فترات من هذا القبيل، فإن علينا أن نتبيّن أن لدى قبائل كثيرة أيضًا أساطير عن فعل تأسيسي توارثوها عن أسلافهم مثل أسطورة ليكورغوس الذي شرَّع لقبيلته قوانينها. ومن المؤكد أنه قام بذلك خارج البنى القائمة.
يستحضر الحديث عن الأفعال ضمن البنى التشابهات. لكن ثمة اختلافًا مهمًا يكمن في التمثلات المشتركة المعنية. يتمّ الفعل، في فضاء عمومي على الدوام ضمن بنى سبق وضعها، وأنّ هناك ترتيبًا بحكم الواقع للأشياء، لكن هذا الترتيب لا يتمتَّع بأي مزية إزاء الفعل الذي يتمّ ضمنه. ذلك أنّ البنى السابقة تكوَّنت خلال الأفعال التي نقوم بها في الزمن الحاضر. قد يعدّل فعلنا في الزمن الحاضر هذه البنى، وهذا مشروع تمامًا، إذ لا تعدو أن تكون أكثر من رواسب وميسرات لهذا الفعل التواصلي.
لكن القانون التقليدي لقبيلة ما عادة ما يحظى بمكانة مختلفة. قد يكون علينا، بالطبع، أن نغيّره مع مرور الزمن، وذلك وفق طريقة يحددها القانون نفسه. لكن هذا القانون لا يُنظر إليه باعتباره مجرَّد ترسّب للفعل ومُيسِّر له. فقد يعني إلغاء القانون، إلغاء موضوع الفعل المشترك أيضًا، لأن القانون يحدّد القبيلة بوصفها كيانًا. وفي حين يمكن لفضاء عمومي أن يبدأ من جديد، حتى عندما يتم إلغاء وسائل الإعلام كلها عن طريق إنشاء وسائل إعلام جديدة. إنّ قبيلةً لا تستطيع استئناف حياتها إلا عن طريق فهمٍ يقوم على اعتبار أن القانون لا يزال نافذًا، على الرغم من إمكان انقطاع سريان مفعوله بفعل غزو خارجي مثلًا.
هذا ما أعنيه عندما أقول إن ما يُؤسس المجتمع، وما يجعل الفعالية الجمعية المشتركة أمرًا ممكنًا، يتعالى على الأفعال المشتركة التي تتمّ ضمنه. ولا يقتصر الأمر على أن تلك البنى التي تلزمنا من أجل الفعل المشترك في الحاضر هي نتيجة لفعل الماضي الذي لم يكن مختلفًا عن فعل زمننا هذا من حيث طبيعته، بل إن القانون التقليدي شرط مُسبق لأي فعل مشترك، في أيّ زمن كان، وذلك لأن هذه الفعالية المشتركة ما كان لها أن توجد بدونه. وهو متعالٍ بهذا المعنى تحديدًا. وعلى النقيض من ذلك، تنشأ الفعالية المشتركة في مجتمع علماني محض (وفق المعنى الذي أراه أنا) كترسّب للفعل المشترك، وفيه.
من هنا، يمكن أن يكون التمييز الحاسم الذي يُشكّل أساس هذا التصوُّر للعلمانية مرتبطًا بهذه المسألة: عمّ تنشأ الرابطة؟ أو، بلغة أخرى، ما الذي يجعل هذه المجموعة من الناس فاعلًا مشتركًا بمرور الزمن؟ حيثما يكون ثمة شيء يتعالى على مجال تلك الأفعال المشتركة التي تساهم فيها هذه الفعالية، لا تكون هذه الرابطة علمانية. أما حيث لا يكون العامل المكوّن شيئًا آخر غير ذلك الفعل المشترك ـ وأنه لا أهمية لأن تكون الأفعال المؤسسة قد حدثت في الماضي، أو تحدث في الحاضر ـ نكون إزاء علمانية.
هذا النوع من العلمانية حديث؛ وقد ظهر في فترة متأخرة جدًا من تاريخ البشرية. لقد وُجدت، بطبيعة الحال، أشكال مختلفة من الفعاليات المشتركة المحلية الآنية التي نشأت عن الفعل المشترك فحسب. يجتمع الحشد، ويصرخ الناس محتجين، ثم تُلقى الحجارة على بيت الحاكم أو يُحرق القصر. لكن ما كان يمكن تصوُّر الفعالية المشتركة، المتواصلة، فوق-المحلية، قبل الزمن الحديث، على أساس علماني محض. وليس باستطاعة الناس أن يروا أنفسهم ضمن هذه الفعالية المشتركة إلا عن طريق شيء يتعالى على الفعل ذاته، كأن يكون أساسًا يضعه الله أو سلسلة الوجود ويجسّده المجتمع، أو قانونًا تقليديًا يعرّف الشعب ويحدّده. ومن ثم، مثل الفضاء العمومي في القرن الثامن عشر ظرفية من نوع جديد: فضاء مشترك فوق-محلي، وفعالية مشتركة من دون دستور يتعالى على الفعل ذاته، إنها فعالية ترتكز على أفعالها المشتركة الخاصة بها فحسب.
لكن ماذا عن الفترات التأسيسية التي كثيرًا ما “تتذكرها” المجتمعات التقليدية؟ ماذا عن فعل ليكورغوس عندما وضع قوانين إسبارطة؟ يقينًا، يُقدِّم هذا أمثلة عن العامل المكوّن (القانون في هذه الحالة) النابع من الفعل المشترك: اقترح ليكورغوس قوانينه فقبلها الإسبارطيون. لكن من طبيعة هذه الفترات التأسيسية أنها لا توضع على المستوى ذاته مع الفعل المشترك المعاصر، إذ توضع الأفعال التأسيسية على مستوى أعلى، وفي زمن بطولي، في زمن آني لا يُنظر إليه نوعيًا بنفس مستوى الزمن في العصر الحديث. فالفعل التأسيسي يختلف عن أفعالنا التي نأتيها، ولا هو مجرد فعل مماثل سابق يكون ترسبه أساسًا لبنياتنا. إنه ليس سابقًا في الزمان فحسب، وإنما يوجد في زمن من نوع مغاير: زمان مثالي([42]).
ذلك ما يحفزني لاستخدام مصطلح العلمانية على الرغم من كل ما يمكن أن ينشأ عن ذلك من سوء فهم، وذلك لأني لا أعني به “منفصل عن الدين” فحسب([43]). إن دائرة الاستبعاد هنا هي أوسع نطاقًا بكثير. وهذا لأن كلمة علماني تُفيد في الأصل “من هذا العصر” أي أنها تحيل على شيء ينتمي إلى زمن دنيوي. ويقترب معناها من معنى كلمة “زمني” في الثنائية زمني/روحي. وهذا ما تعرَّضنا إليه في موضع سابق.
في العصور القديمة، كان ثمَّة فهم مفاده أن هذا الزمن الدنيوي تربطه علاقة بأزمان أعلى (تُحيط به، أو تخترقه، يصعب اختيار التعبير الصحيح هنا) تبدو حالات الفهم قبل الحديث للزمن متعددة الأبعاد دائمًا. كانت الأبدية تتعالى على الزمن دائمًا وتثبته في مكانه، سواء في الفلسفة اليونانية أو بالنسبة إلى الإله التوراتي. وليست الأبدية في الحالتين، مجرد زمن دنيوي لا نهاية له، بل كانت ارتقاءً إلى ما لا يتغيَّر، أو نوعًا من اجتماع الزمن كله معًا في وحدة واحدة، ومن هنا اشتقت عبارة “عصور العصور” (saecula saeculorum أو hoi aiones ton aionon).
ليس الربط الأفلاطوني أو المسيحي بين الزمن والأبدية الوحيد، فحتى في المسيحية نفسها، نجد أيضًا معنى ذاع صيته للزمن المؤسس، “زمن الأصول” كما يسميه إلياد([44])، أي الزمن المرتبط بشكل معقد بالفترة الراهنة في الزمن العادي، الذي يمكن مقاربته من زاوية الطقوس وإعادة تملّك قوته بصورة جزئية في فترات متميزة معيIنة. وهذا هو السبب الذي جعل هذا الزمن غير قابل لأن يوضع ببساطة في الماضي على نحو لا لبس فيه (أي في الزمن الماضي العادي). تستند السنة الطقسية المسيحية على هذا النوع من وعي الزمن في استعادة الأحداث “التأسيسية” في حياة المسيح. وهذا نعثر عليه كثيرًا في ديانات أخرى أيضًا.
يبدو أن اعتبار الفضاءات والفعاليات المهمة فوق-المحلية قائمة في نمط ما من زمن أعلى كان بمثابة معيار كوني. وكان يُنظر إلى الدول والكنائس على أنها موجودة، بالضرورة تقريبًا، في أكثر من بعد زمني واحد، كما لو أنه لا يمكن تصوُّر وجودها إلا في الزمن الدنيوي أو الزمن العادي. إن من شأن دولة تجسِّد السلسلة العظيمة أن ترتبط بعالم المُثل الأبدي. ومن شأن الشعب الذي يحدد قانونه أن يتواصل مع الزمن التأسيسي عندما تم إرساء تلك الدولة، وهكذا دواليك.
يمكن النظر إلى “العلمنة” الحديثة ضمن بعض الوجوه، كرفض الأزمنة العليا، وكتنزيل للزمن كله في خانة الزمن الدنيوي. وبذلك، باتت الأحداث تنوجد في هذا البعد الواحد فحسب، تقف فيه على مسافات زمنية متقاربة أو متباعدة وفي علاقات سببية مع بقية الأحداث من النوع نفسه. وتظهر فكرة التزامن الحديث، حيث تُجمع معًا أحداث لا علاقة بينها على الإطلاق من حيث أسبابها أو معانيها، وذلك لمجرد حدوثها المتواقت عند نقطة واحدة من هذا الخط الزمني الدنيوي الوحيد. لقد عوَّدنا الأدب الحديث، ومعه وسائل الإعلام الإخبارية ثم العلوم الاجتماعية، على التفكير في المجتمع وفق شرائح زمنية عمودية يحمل كل منها كثرة من الأحداث المتصلة وغير المتصلة فيما بينها. وأعتقد أن بنديكت أندرسن كان على حق عندما اعتبر أن هذا نمط حديث فعلًا من أنماط التخيُّل الاجتماعي، واجه أسلافنا في القرون الوسطى صعوبة في فهمه، وذلك لأن الأحداث في الزمن الدنيوي كانت على ارتباط شديد الاختلاف بزمن أعلى، وهذا ما يجعل مجرد تجميع هذه الأحداث جنبًا إلى جنب ضمن علاقة التزامن الحديثة يبدو أمرًا غير طبيعي. وهذا يحمل افتراض التجانس الذي سينفيه وعي الزمن المهيمن من أساسه([45]). وسأعود إلى هذه الفكرة لاحقًا.
يرتبط هذا التحوُّل بما أسميه “العلمانية” ارتباطًا واضحًا بهذا الوعي للزمن بما هو وعي مطهّر تطهيرًا راديكاليًا. ويتأتى عندما توضع الروابط كليًا وعلى نحو ثابت في زمن متجانس دنيوي، سواء وقع نفي الزمن الأعلى جملة أو لم يقع نفيه، وسواء ما زال وجود الروابط الأخرى فيه مقبولًا أم لا. ذلك هو شأن الفضاء العمومي، وتلك طبيعته الجديدة التي (تكاد تكون) غير مسبوقة.
ربما استطعت أن أجمع شتات هذه المناقشة وأن أحدد ماهية الفضاء العمومي. فقد كان الفضاء العمومي فضاءًا فوق-محلي جديدًا يستطيع فيه أفراد المجتمع تبادل الأفكار والانتهاء إلى تصوّر مشترك. وقد شكل بذلك فعالية فوق-محلية، لكن وجودها مستقل عن القانون السياسي للمجتمع، وتتحقق كليًا في الزمن الدنيوي.
لقد كان الفضاء العمومي، ولا يزال، فضاءً فوق محلي، علماني، خارج السياسة. تكمن أهمية هذا الفهم، جزئيًا، في أنه لم يكن، في الحقيقة، مجرَّد فضاء، بل كان حلقة من حلقات تطوُّر أدى إلى تحويل تمثلنا للزمن وللمجتمع كله، إلى حد لم نعد فيه قادرين على تذكر ما كان عليه الأمر من قبل.
5- سيادة الشعب
(3) السيادة الشعبية هي المكوّن الثالث في سلسلة الطفرات المتصلة الكبرى في المتخيّل الاجتماعي الذي ساهم في نشأة المجتمع الحديث. وهي أيضًا تبدأ كنظرية، ثم تتغلغل شيئًا فشيئًا في المتخيلات الاجتماعية وتغيّرها. لكن كيف يحدث ذلك؟ نستطيع في الواقع تمييز مسارين مختلفين إلى حد ما. وسأعتبرهما هنا من النماذج المثالية، مع الاعتراف بأنهما متشابكان، أحيانًا، في التطورات التاريخية الحقيقية تشابكًا يعسر فكَّه.
من ناحية أولى، يمكن لنظرية أن تُلهم نوعًا جديدًا من النشاط، مع ممارسات جديدة أيضًا، فتُشكّل على هذا النحو المتخّيل الخاص بالمجموعات التي تتبنى هذه الممارسات. ويُعتبر تشكّل الكنائس الطهرانية الأولى حول فكرة “العهد” المشتركة مثالًا على هذا. وقد أعقب التجديد اللاهوتي بنية كنسية جديدة، وأصبح هذا جزءًا من قصة التغيير السياسي لأن البنى المدنية ذاتها كانت متأثرة في بعض المستعمرات الأميركية بأساليب إدارة الكنائس، كما هو الحال في النظام الكنسي في ولاية كونيكتيكت، حيث لا يتمتع بالمواطنة الكاملة إلا من اعتنق العقيدة.
وفي حالات أخرى قد يأتي تغيُّر المتخيّل الاجتماعي مع إعادة تأويل لممارسة كانت موجودة في الاستخدام القديم. لقد غزا فهم جديد للنظام أشكال الشرعية القديمة كلها، وراحت تتحوَّل بعد ذلك، وفي حالات معينة، من دون قطيعة صريحة.
وتُعتبر الولايات المتحدة واحدة من تلك الحالات. فقد كانت مفاهيم الشرعية التي سادت في بريطانيا وأميركا، أي المفاهيم التي كانت وراء اندلاع الحرب الأهلية في إنكلترا على سبيل المثال، إضافة إلى بدايات تمرد المستعمرات، ارتكاسية أساسًا. وذلك لأنها كانت تدور كلها حول فكرة “دستور قديم”، وحول فكرة نظام قائم على قانون سارٍ “منذ الأزل”، وكان للبرلمان فيه مكانة جنبًا إلى جنب مع الملك، ذلك هو التصوُّر قبل الحديث الأكثر انتشارًا للنظام ويجد أساسه في “زمن الأصول” (حسب عبارة إلياد) وهو ما لا يوجد في الزمن العادي.
تحوّلت هذه الفكرة القديمة المنبثقة عن الثورة الأميركية إلى أساس متكامل لسيادة الشعب، حتى إن دستور الولايات المتحدة يُفتتح بعبارة “نحن الشعب”. وقد سبق هذا لجوء إلى النظام المثالي، نظام القانون الطبيعي، وذلك عبر استحضار “الحقائق البيّنة بذاتها” في إعلان الاستقلال([46]). وأصبح التحوُّل أكثر يسرًا، لأن ما كان يُفهم باعتباره قانونًا تقليديًا كان يمنح مكانة مهمّة للمجالس المنتخبة وتوافقها على فرض الضرائب. وما كان ضروري من أجل تغيير التوازن هو جعل الانتخابات مصدرًا وحيدًا للسلطة الشرعية.
اقتضى هذا التحوّل، تحولًا في المتخيَّل الاجتماعي بحيث تُنتزع فكرة التأسيس من زمنها الأسطوري السابق، فيُنظر إليها كفكرة في متناول الشعب اليوم وفي مقدوره تحقيقها. بعبارة أخرى أصبح ذلك قابلًا للتحقّق عن طريق فعل جمعي واقع في الزمن المعاصر العلماني المحض. حدث هذا مع نهاية القرن الثامن عشر، وليس بدايته. كانت النخب قد أعلنت نظريات الفعل التأسيسي من قبل، لكن هذه النظريات لم تتغلغل في المتخيّل الاجتماعي العام تغلغلًا كافيًا يسمح بالعمل استنادًا إليها. هكذا قُدِّم التحوُّل الجذري في عام 1688، كما يمكن أن يبدو لنا ارتكاسيًا، على أنه فعل استمرار أو فعل عودة إلى شرعية موجودة قبلًا. (قد يخدعنا التحوُّل السيميائي. إن المعنى الأصلي لتعبير “الثورة المجيدة” يُفيد العودة إلى المعنى الأصلي، وليس المعنى الحديث الذي يُشير إلى انقلاب. وبطبيعة الحال ساهم تاريخها الفعلي في هذا التغيّر).
كان هذا التوافق بين النظرية الجديدة والممارسات التقليدية حاسمًا بالنسبة إلى النتيجة. وأمكن استحضار سيادة الشعب في الحالة الأميركية لأنها تستطيع أن تحيل على معنى مؤسساتي متَّفق عليه عمومًا. فقد كان المستعمرون هناك متفقين جميعًا على أنّ الطريقة الصحيحة لتأسيس دستور جديد لا تكون إلا عن طريق نوع من أنواع الجمعية العامة التي قد تكون أكبر قليلًا مما تكون عليه هذه الجمعيات عادة، وذلك كما حدث في ماساشوستس عام 1779. وساهمت قوة المؤسسات التمثيلية القديمة في “تأويل” المفهوم الجديد بالمعنى التطبيقي.
وهكذا باستطاعتنا القول إن الثورة الأميركية قامت على أساس فكرة عن الشرعية، ثم انتهت بترسيخ فكرة أخرى شديدة الاختلاف، من دون قطعية راديكالية. بدأ المستعمرون بتأكيد “حقوق الإنكليزي” التقليدية في مواجهة الحكومة الإمبريالية المتعجرفة المتمنعة. وما أن اكتملت القطعية مع الملك في البرلمان ولم تعد طاعة الحكّام واجبة، حتى انتقلت قيادة المقاومة انتقالًا طبيعيًا إلى الهيئات التشريعية المنتخبة القائمة المجتمعة في المؤتمر القاري بحيث كان هناك تشابه كبير مع الحرب الأهلية في أربعينيات القرن السابع عشر.
لكن الحرب كانت دائمًا منبعًا للنزعة الراديكالية. لقد تحقق الاختراق من خلال إعلان أكد حقوق الإنسان الكونية وليس الإنكليز وحدهم. وعمدت بعض الولايات إلى تبني دساتير جديدة قائمة على الإرادة الشعبية. وفي النهاية، تُوِّجت الحركة كلها بدستور يضع أسس الجمهورية الجديدة، على نحو مباشر، ضمن النظام الأخلاقي الحديث: هو إرادة الشعب التي لا تحتاج أي قانون موجود قبلًا حتى يتصرَّف الشعب باعتباره شعبًا ويرى في نفسه مصدر القانون.
نشأ المتخيَّل الاجتماعي الجديد أساسًا عبر تأويل ارتكاسي. وقد تمَّت تعبئة القوات الثورية بشكل كبير، على أساس فكرة الشرعية القديمة والرجعية. وسينظر إلى هذه الإرادة لاحقًا على أنها ممارسة لسلطة متأصّلة في شعب سيّد. ويكمن دليل وجود هذه السلطة وشرعيتها في الدولة الجديدة التي انبثقت عنها. لكن سيادة الشعب لم تكن قادرة على أن تفعل ذلك لو أنها دخلت المشهد مبكرًا، فقد كانت الفكرة التي سبقتها، أي تلك التي تستحضر الحقوق التقليدية لشعب محدّد بدستوره القديم، مضطرة إلى القيام بالمهمة الأولية الشاقة، مهمة تعبئة المستعمرين من أجل النضال قبل أن يطويها النسيان بفعل ما يُميِّز الثورات الحديثة من جحود لا يعرف الشفقة إزاء الماضي.
لا يعني هذا، بطبيعة الحال، أن شيئًا لم يتغيَّر في الممارسات، وأن التغيير اقتصر على خطاب الشرعية. على العكس تمامًا، اتخذت بعض الخطوات المهمّة التي لم يكن تبريرها ممكنًا من غير هذا الخطاب الجديد. وقد أشرت قبل قليل إلى الدساتير الجديدة في الولايات، كدستور ولاية ماساشوستس عام 1779 على سبيل المثال. لكن الدستور الفيدرالي في حد ذاته هو المثال الأكثر ذيوعًا. فمن وجهة النظر الفيدرالية، كان من الضروري أن تُقام سلطة مركزية جديدة ليست من صنع الولايات فحسب، وكانت هذه غلطة النظام الكونفدرالي الرئيسة التي حاول الفيدراليون تصحيحها. كان يجب أن يوجد ما يتجاوز “شعوب” الولايات المختلفة فيخلق أداة مشتركة، وكان على حكومة الاتحاد الجديدة أن تمتلك أساسًا جديدًا للشرعية في “شعب الولايات المتحدة”. وكان هذا جزءًا لا يتجزأ من المشروع الفيدرالي برمته.
لكن في الآن ذاته، ما كان لهذا الإسقاط إلى الوراء لفعل شعب سيّد أن يكون لولا استمرارية المؤسسات والممارسات التي سمحت بإعادة تأويل أفعال الماضي على أنها ثمرة للمبادئ الجديدة. ويكمن جوهر هذه الاستمرارية في قبول المستعمرين الكونيّ، قبولًا فعليًا، بالجمعيات المنتخبة باعتباره شكلًا شرعيًا للسلطة. وكان هذا محسوسًا على نحو أكبر في واقع أن الهيئات التشريعية المنتخبة التي كانت، منذ أمد طويل، حصنًا رئيسًا لحريات هؤلاء المستعمرين المحلية في مواجهة اعتداءات الموظفين التنفيذيين في ظل الحكم الملكي أو الإمبريالي. وعندما تأتي نقطة انعطاف حاسمة، كتبني دستور جديد للولاية مثلًا، كان هؤلاء المستعمرون يلوذون بالجمعيات الخاصة الموسعة، وأمكن اعتماد السيادة الشعبية معنى دستوريًا غير متنازع فيه. وكان هذا أساس النظام الجديد([47]).
أما الحالة في الثورة الفرنسية فقد كانت مختلفة تمامًا، رغم آثارها المصيرية. وإذا كان “الوصول بالثورة إلى نهايتها”([48]) مستحيلًا، كما أشار إلى ذلك كل المؤرخين، فلأنه، في جزء منه، لم يوجد أي تعبير آخر عن السيادة الشعبية، يتحدَّى التعبير القائم، يحظى بتأييد واسع. وكان جزء من عدم الاستقرار المخيف في سنوات الثورة الأولى نابعًا من هذه الحقيقة السلبية، وهي أن الانتقال من شرعية الحكم الملكي الوراثي إلى شرعية حكم الأمة لم يكن له معنى متفق عليه في المتخيَّل الاجتماعي ذي الأساس العريض.
لا ينبغي فهم ما تقدَّم على أنه “تفسير” شامل لعدم الاستقرار هذا، لكنه يؤشر على الكيفية التي تنتهي من خلالها مختلف العوامل إلى النتيجة التي نعرفها. وبطبيعة الحال، فإن عدم تقبّل عدد كبير من حاشية الملك المبادئ الجديدة، الجيش والنبلاء، مثَّل عقبة هائلة أمام تحقيق الاستقرار. بل إن أولئك الذين أيَّدوا الشرعية الجديدة انقسموا في بينهم أيضًا. على أن ما جعل هذا الانقسام الأخير مصيريًا إلى ذلك الحد هو غياب أيّ فهم متفق عليه للمعنى المؤسساتي لسيادة الأمة.
لقد كانت نصيحة بورك Burke للثوريين هي الإبقاء على الدستور التقليدي، وتعديله تدريجيًا. لكن لم يكن باستطاعتهم ذلك. ولم يقتصر الأمر على أن المؤسسات التمثيلية الخاصة بهذا الدستور، وهي مجالس الطبقات (جمعية ممثلي الشعب الفرنسي، ممثلي النبلاء، وممثلي رجال الدين، ونواب البورجوازية) Estates General، معلقة منذ مئة وخمسة وسبعين عامًا. لقد كان هؤلاء الثوريون أيضًا أبعد ما يكونون عن التوافق حول التطلع إلى المواطنة المتساوية الذي تنامى في أوساط الطبقات المتعلمة، وكذلك لدى البورجوازيين ولدى قسم مهم من الأرستقراطيين، وقد عُبِّر عنه بطرائق شتّى على نحو سلبي من خلال مهاجمة الامتيازات الأرستقراطية، وعلى نحو إيجابي في التحمّس للنظام الجمهوري لروما ومُثله العليا([49]). وهذا هو السبب العلمي الذي جعل نواب البورجوازية عام 1789 يطالبون بإلغاء الغرف المنفصلة وبأن يجتمع كل النواب في جمعية وطنية واحدة.
والأسوأ من ذلك، أنه لم يكن ثمة وعي بما يمكن أن يعنيه الدستور التمثيلي خارج هذه النخب المتعلمة إلا قليلًا. صحيح أن جماهير الشعب استجابت لدعوة مجالس الطبقات بتقديم تظلماتهم، لكن هذا الإجراء كان يفترض برمته استمرار السيادة الملكية، ولا يصلح كقناة للإرادة الشعبية.
كانت آمال المعتدلين منعقدة على شيء منسجم مع نصيحة بورك: تطور الدستور التقليدي بما ينتج نوعًا من المؤسسات التمثيلية التي يفهم الجميع على وجه الدقة أنها تُعبِّر عن إرادة الأمة، وذلك من خلال تصويت المواطنين. وذلك هو شأن مجلس العموم في القرن الثامن عشر، وعلى الرغم من أن “الشعب” كان نخبة صغيرة فقد اعتُبر ناطقًا باسم المجموع من خلال أنماط مختلفة من التمثيل الفعلي.
كان التطوُّر الذي أنتج هذه الصيغ في بريطانيا قد خلق حسًا بأشكال الحكم الذاتي الذي كان جزءًا من المتخيَّل الاجتماعي للجميع الواسع. وهذا هو السبب في أن المطالبة بمشاركة شعبية أكثر اتساعًا اتخذت في إنكلترا شكل مقترحات من أجل توسيع حق الانتخاب. ولجأ الشعب إلى البنية التمثيلية القائمة، وذلك ما بدا واضحًا في الاضطرابات الشارتية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر. وكانت الحالة الأميركية خطوة إلى الأمام ضمن هذا التطوُّر نفسه، وكانت جمعياتها التمثيلية منتخبة عمومًا، على أساس حق الاقتراع للبالغين.
لقد كانت هذه الأشكال من الحكم الذاتي عن طريق جمعية منتخبة جزءًا من المخزون المتوفر عمومًا في المجتمعات الأنكلو-سكسونية. أما في فرنسا فلم تكن هذه الأشكال غائبة عن الطبقات الشعبية فحسب، بل كانت هذه الطبقات قد طوَّرت لنفسها أشكالًا من الاحتجاج الشعبي قوامها منطق مختلف تمامًا. لكن، قبل التحوُّل إلى النظر في هذا الأمر، ثمة نقطة عامة ينبغي التوقف عندها في ما يخص التحوّلات الثورية الحديثة المستلهمة من نظريات جديدة.
لا يمكن أن يحدث التحوُّل، بالمعنى المرغوب فيه، إلا إذا فهم “الشعب” أو أقليات مهمّة من الناشطين على الأقل، النظرية واستوعبوها. لكن فهم النظرية بالنسبة إلى الفاعلين السياسيين، يعني قدرتهم على وضعها موضع التطبيق في عالمهم. فهم يفهمونها من خلال الممارسات التي تفعّلها. ويجب أن يكون لهذه الممارسات معنى بالنسبة إليهم، وهو المعنى الذي تفرضه النظرية ذاتها. لكن متخيلنا الاجتماعي هو الذي يُضفي على ممارستنا معنى. هكذا يكون الأمر الحاسم بالنسبة إلى هذا النوع من التحوُّل هو أن يتقاسم الشعب (أو قطاعات الشعب النشيطة) متخيلًا اجتماعيًا يستطيع الاستجابة لهذا المتطلب، أي يشتمل على أنماط تطبيق النظرية الجديدة.
يمكن أن ننظر إلى المتخيَّل الاجتماعي لشعب ما في زمن ما بمثابة مخزون، مثلما أشرت إلى ذلك في الفصل الثاني، بما في ذلك كل الممارسات التي يكون لها معنى. وإذا أردنا أن نحوِّل مجتمعًا وفقًا لمبدأ جديد من مبادئ الشرعية، يتعيَّن علينا أن نمتلك مخزونًا يتضمن كيفيات تحقيق هذا المبدأ. ويحتمل هذا المتطلب وجهين (1) يجب أن يعلم الفاعلون ما يفعلون، ويجب أن يكون في مخزونهم ممارسات بإمكانها تفعيل النظام الجديد. (2) يجب أن يتوافق جميع الفاعلين حول ما تكون تلك الممارسات.
أستحضر هنا مماثلة مستمدة من الفلسفة الكانطية: تشبه النظريات مقولات مجردة، وهي في حاجة إلى أن “تخطط” حتى تترجم عينيًّا في حقل الممارسة إذا أرادت أن تكون فاعلة في التاريخ.
توجد أوضاع ثورية حديثة معينة غاب عنها الوجه الأول تمامًا (1). ولنأخذ الحالة الروسية على سبيل المثال: لقد كان متوقعًا أن انهيار الحكم القيصري عام 1917 سيُفسح في المجال أمام شرعية جمهورية جديدة ظنت الحكومة المؤقتة أن تحديدها سيتم في الجمعية التأسيسية التي دعت إلى انعقادها في العام التالي. لكن، وفق تحليل أورلاندو فيغز Orlando Figes، نجد أن عموم الفلاحين لم يكونوا قادرين على تصوُّر الشعب الروسي بتمامه كفاعل له السيادة([50]). فما كان يفكر به هؤلاء الفلاحون تمامًا، ويرغبون فيه أيضًا، هو حرية المير (mir) في التصرف، من تلقاء أنفسهم، في تقسيم الأرض التي اغتصبها النبلاء (بحسب رأيهم)، وتوقف قمعهم من قبل الحكومة المركزية. لقد تضمن متخيَّلهم الاجتماعي فعالية جمعية محلية، سكان القرية أو المير. وكانوا يعرفون أن على هذه الفعالية أن تتعامل مع الحكومة الوطنية التي يمكن أن تُلحق بهم أذى كبيرًا، ويمكنها حتى أن تأتيهم ببعض الخير عرضًا. لكنهم لم يكن لديهم تصور لشعب وطني يمكن أن يتولى السلطة السيادية من الحكومة الاستبدادية. لم يكن مخزون هؤلاء الناس يتضمن أفعالًا جمعية من هذا القبيل، على هذا المستوى الوطني. كل ما كان باستطاعتهم فهمه هو الانتفاضات واسعة النطاق، على غرار السلطة المركزية، بل إرغام تلك السلطة على أن تكون أقل لؤمًا وعدوانًا.
في حين أن ما كان غائبًا، على النقيض من ذلك، في حقبة الثورة الفرنسية، هو الوجه الثاني (2). لقد طُرحت صيغ شتى لتحقيق السيادة الشعبية. فمن ناحية أولى، لم تكن المؤسسات التقليدية لمجالس الطبقات مناسبة لهذه الغاية، وذلك لأن (العامة) الشعب كان ينتخب غرفة واحدة فحسب من غرفها الثلاث، وأما النظام برمته فمعني بتمثيل رعايا يتضرَّعون للعاهل صاحب السيادة.
أما من الناحية الأخرى، فقد توفرت سلسة كاملة من النظريات أكثر بكثير مما كان متاحًا في الحالة الأميركية. ويردّ هذا، في جزء منه، إلى حقيقة مفادها أن قوة تأثير المؤسسات التمثيلية في العالم الأنغلو-سكسوني على المتخيَّل الاجتماعي كبحت المخيلة النظرية، لكنه نشأ أيضًا عن المسارات الخاصة المميزة للثقافة والفكر الفرنسيين.
لقد أولت الحالة الفرنسية أهمية خاصة للفيف من النظريات المستلهمة من روسو. وقد تميَّزت هذه النظريات بسمتين مصيريتين في ما يتعلق بمسار الثورة. تتمثَّل السمة الأولى فيما يتقوَّم به تصوُّر روسو للإرادة العامة. وانعكس في “تنقيح” روسو الجديد الأكثر جذرية للفكرة الحديثة عن النظام.
يتمثل مبدأ فكرة النظام هذه، كما رأينا، في كل إنسان حر في تخيُّر الوسائل التي يراها مناسبة لحياته بالقدر نفسه الذي يتوفر لغيره بشكل متوازٍ أو على الأقل لا يمنعه من ذلك. ويمكن القول بلغة أخرى إن متابعتنا لمشاريع حياتنا يجب أن تكون متناغمة. لكن هذا التناغم كان يُتصور وفق أشكال متعددة. فمن الممكن أن يتحقق عبر عمليات اليد الخفيّة، كما في النظرية الشهيرة لآدم سميث([51]). لكن، بما أن أحدًا لم يكن يعتقد أن ذلك كافٍ، كان لا بد من تحقيق التناغم على نحو واع، باتباعنا القانون الطبيعي، وهذا ما اعتبره لوك هبة من الله. وما يدفعنا لطاعة هذا القانون الطبيعي، هو كل ما يجعلنا نطيع الله نفسه: الإحساس بالواجب أمام خالقنا، والخوف من العقاب الأبدي.
في مرحلة لاحقة، حلَّت فكرة الإحسان غير الشخصي محل خشية الله، أو حل محلها مفهوم التعاطف الطبيعي. لكن ما تشترك فيه هذه التصورات السابقة كلها هو أنها تفترض ثنائية الدوافع الموجودة فينا: قد تغرينا خدمة مصالحنا على حساب الآخرين، ومن الممكن أن تدفعنا أيضًا خشية الله، أو يدفعنا الإحسان غير الشخصي، أو أي شيء آخر إلى القيام بفعل من أجل الخير العام. وقد سعى روسو إلى استبعاد هذه الثنائية، فلا يمكن أن يتأتى لنا التناغم الحقيقي إلا عندما نتغلب على هذه الثنائية، وعندما ينسجم حبي لنفسي مع رغبتي في تلبية الأهداف المشروعة لدى الفاعلين الآخرين من حولي (أي الذين يشتركون معي في هذا التناغم). وبلغة روسو، فإن غريزتيّ حب الذات والتعاطف تنصهران معًا في الكائن البشري العقلاني الفاضل في حب الخير العام، وهو ما يعرف سياسيًا باسم الإرادة العامة.
بعبارة أخرى، لم يعد حب الذات منفصلًا عن حب الآخرين لدى الإنسان الفاضل بشكل كامل. لكن أدى التغلب على الفصل بينهما إلى ظهور ثنائية جديدة في اتجاه آخر. فإن كان حب الذات حبًا للإنسانية أيضًا، فكيف لنا أن نفسِّر الميول الأنانية التي تنازع الفضيلة فينا؟ لا بد أن وراءها دافع آخر، وهو ما يسميه روسو “حب الذات”. وهكذا فإن اهتمامي بنفسي يمكن أن يتَّخذ شكلين مختلفين تمامًا، متعارضين مثل الخير والشر.
ويُعتبر هذا التمييز جديدًا في سياق التنوير. لكنه، بمعنى آخر، يفترض عودة إلى طريقة تفكير راسخة بعمق في التقليد. فنحن نميِّز بين سمتين في الإرادة، إذ لو عدنا إلى عالم أوغسطينوس الأخلاقي، سنجد أن البشر قادرون على نوعين من الحب، أحدهما خير والآخر شر. لكن هذا موقف أوغسطينوس بعد أن راجع أفكاره، إذ لو صدر ذلك عن أوغسطينوس البيلاجي (Pelagian Augustine)، فستكون المفارقة صادمة إلى حد كبير، كما ذهب إلى ذلك صراحة المونسنيور دو بومون (Monseigneur de Beaumont).
كما أن النظرية نفسها حديثة جدًا، وهي منخرطة في النظام الأخلاقي الحديث. فالهدف هو تحقيق تناغم بين الإرادات الفردية، حتى وإن كان تحقيق ذلك غير ممكن من غير خلق هوية جديدة، “أنا مشتركة” (moi commun)([52]). وما يجب إنقاذه هو الحرية، الحرية الفردية لكل إنسان. فالحرية هي الخير الأسمى، إلى حدّ أن روسو يُفسِّر التضاد بين الفضيلة والرذيلة من جديد بحيث يجعله منسجمًا مع التضاد بين الحرية والعبودية: “لأن اندفاع الشهوة وحدها عبودية، في حين أن طاعة القانون الذي يُلزم المرء به نفسه هي الحرية”([53]). فالقانون الذي نحبّه ليس اعتداء على الحرية، لأنه يهدف إلى خير الجميع. على العكس من ذلك، إنه ينبع مما هو أكثر أصالة فينا، أي من حب الذات الذي توسَّع وارتقى إلى سجل أخلاقي أسمى. إنه ثمرة العبور من الوحدة إلى المجتمع، وهو انتقال أيضًا من الحالة الحيوانية إلى الشرط الإنسانية:
“أدّى الانتقال من الحالة الطبيعة إلى الحالة المدنية إلى تغيير لافت للنظر في الإنسان، إذ يحل العدل محل الغريزة في تصرفه، ويُضفي على أفعاله الخلقية التي كانت تفتقدها سابقًا… وهو، مع أنه يحرم نفسه في هذه الحالة منافع كثيرة يغنمها من الطبيعة، فإنه يكتسب من عظيم المنافع وتتمرَّس ملكاته وتنمو وتتسع أفكاره، وتنبل مشاعره، وتسمو روحه بأكملها، إلى درجة أنه لولا التجاوزات التي يمكن أن تقع في الحالة الجديدة وتحط مقامه إلى أسفل مما كان عليه في الحالة التي خرج منها، لكان لزامًا عليه أن يُبارك بلا انقطاع اللحظة السعيدة التي انتشلته من الحالة القديمة بلا رجعة، والتي جعلت منه كائنًا ذكيًا وإنسانًا بعدما كان حيوانًا أرعنًا محدود الذهن”([54]).
ما يُعارض هذا القانون، من ناحية أخرى، ليس الذات الأصيلة، بل هو إرادة فسدت وانحرفت عن مسارها الصحيح بفعل التبعية إلى الآخر.
يعطينا هذا “التنقيح” الذي قام به روسو علم نفس أخلاقيًا مختلفًا تمامًا عن التصوُّر المتعارف عليه في عصر التنوير، وهو تصوُّر متوارث عن لوك. فهو لا يكتفي بالعودة إلى إرادة تحتمل خاصيتين، خيّر وشر، بل يقدم أيضًا العلاقة بين العقل والإرادة الخيّرة على نحو مختلف تمامًا. يرى التيار الرئيس لعصر التنوير أن العقل المتحرر الذي يسمو بنا إلى وجهة نظر كونية ويجعلنا مشاهدين محايدين، يحرِّر حب الخير العام فينا أو، على الأقل، يعلمنا تمييز مصلحتنا الذاتية المستنيرة، أما عند روسو، فإن هذا العقل الذي ينزع إلى إضفاء الموضوعية يخدم تفكيرًا استراتيجيًا، من شأنه أن يورطنا أكثر في حسابات القوة التي تنتهي، من خلال سعيها إلى التحكّم في الآخرين، إلى أن تجعلنا أكثر فأكثر تابعين لهم.
إن هذه الذات الاستراتيجية، المعزولة والتوَّاقة إلى كسب رضا الآخرين في الآن ذاته، تقمع الذات الأصيلة بشكل مبرح. وما النضال من أجل الفضيلة إلا تلك المحاولة الرامية إلى استعادة صوت دُفن في أعماقنا حتى كاد يخرس. وما نحن في حاجة إليه هو عكس فك الارتباط تمامًا، الالتزام من جديد بما هو أكثر حميمية وجوهرية في ذواتنا، ذاك الذي لم يعد صوته يُسمع بفعل صخب العالم من حولنا. وهو ما يُعبِّر روسو باستخدام المصطلح التقليدي “الضمير”([55]):
“الضمير! الضمير! الغريزة الإلهية، صوت السماء الخالد، المرشد المضمون لكائن جاهل محدود الذهن، لكنه ذكي وحر، القاضي المعصوم الذي يُميِّز بين الخير والشر ويجعل الإنسان شبيهًا بالله! أنت من يسمو بطبيعة وأخلاقية أفعاله، من دونك، لا أشعر بشيء في ذاتي يسمو بي فوق البهائم غير امتياز حزين ينقلني من خطيئة إلى أخرى يساعده في ذلك فهمٌ من دون قاعدة وعقل من دون مبدأ”.
انبثق عن هذه النظرية نوع جديد من السياسة طبِّق على أرض الواقع في أوج حقبة الثورة الفرنسية 1792-1794. فهي، من ناحية أولى، سياسة تجعل (أ) الفضيلة مفهومًا مركزيًا أو فضيلة تقوم على انصهار الذات في حبّ البلاد. وقد عبّر روبسبيير Robespierre عن ذلك في عام 1792 بالقول: “حب الجمهورية هو الفضيلة، حب الوطن، التفاني السمح الذي يصهر المصالح كلها في المصلحة العامة”([56])، وكأننا، بمعنى ما، نستعيد مفهوم الفضيلة القديم الذي عرّفه مونتسكيو بأنه: “المنبع الرئيس” للجمهورية، و”التفضيل الدائم للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة”([57]). لكن هذا المصطلح أُعيد تعديله بحسب مصطلح روسو الجديد عن الانصهار (“الذي يصهر المصالح كلها في المصلحة العامة”).
(ب) تميل هذه النظرية إلى المانوية. تنزع المساحات الرمادية بين الفضيلة والرذيلة إلى الاختفاء. ولا مشروعية للمصلحة الخاصة، حتى لو أخضعت لحب الخير العام. فالمصلحة الخاصة علامة على الفساد، أي على الرذيلة، ويمكن أن تصبح غير منفصلة عن المعارضة إذا بلغت حدًا ما. وبذلك يصبح الأناني بمثابة خائن.
(ت) كثيرًا ما لوحظ في خطاب هذه السياسة ما تميَّز به بنبرة شبه دينية([58]). وغالبًا ما يُستحضر المقدَّس (الاتحاد المقدَّس، “اليد المدنسة” التي قتلت مارا Marat… إلخ).
(ث) غير أنّ واحدة من السمات المصيرية لهذه السياسة هي فكرتها المعقدة عن التمثيل. ذلك أنّ التمثيل السياسي، كما يُعبَّر عنه غالبًا من خلال المجالس المنتخبة، هو بالنسبة إلى روسو ضرب من اللعنة، وكانت تلك السمة المهمة الثانية في نظريته. وهذا في علاقة بتشديده على الشفافية([59]). والإرادة العامة هي موطن الشفافية القصوى، بمعنى أننا نكون حاضرين إلى أقصى حد مع الآخرين ومنفتحين عليهم عندما تنصهر إراداتنا في إرادة واحدة. فالغموض ملازم للإرادات المنفردة التي نحاول أكثر الأحيان تحقيقها باستراتيجيات غير مباشرة مستخدمين التلاعب والمظاهر الزائفة (ويُحيل هذا على شكل آخر من أشكال “التمثيل” نمطه شبه مسرحي، وهو أيضًا سيّئ وضار). وهذا ما سهَّل على تلك النظرة السياسية أن تُماثل بين السخط والفعل الخفي غير المعلن، بل والمؤامرة أيضًا، والخيانة إذن. ومن ناحية أخرى، فإن الإرادة العامة تنشأ في العلن، على مرأى من الجميع. وهذا ما يفرض، في هذا النوع من السياسة، تحديد الإرادة العامة وإعلانها بل وحتى تكوينها على الملأ على الدوام، في إطار نوع آخر من المسرح وصفه روسو وصفًا واضحًا. فلا يتعلق الأمر بمسرح يُقدِّم فيه الممثلون أنفسهم أمام المشاهدين، بل بما يشبه مهرجانًا شعبيًا حيث يكون كل مشارك ممثلًا ومتفرجًا في الآن ذاته. هذا ما يُميِّز المهرجان الجمهوري الحقيقي عن أشكال المسرح الحديثة المنحطة. وفي ما يتعلق بالنمط الأول من المسرح لنا نسأل([60]):
“لكن، ما عساها تكون مواضيع هذه المشاهد في النهاية؟ لا شيء، إن شئنا. فمع الحرية، حيث تسود الوفرة وكما يسود الرفاه أيضًا. اغرس وتدًا متوَّجًا بالزهور في وسط ساحة عمومية، واجمع الناس فيها، وسيكون لديك مهرجان. لك أن تفعل ما هو أفضل من ذلك أيضَا: دع المشاهدين في المشهد، اجعلهم ممثلين، افعل ذلك حتى يرى كل منهم نفسه ويحبّها في الآخرين، حتى يتَّحد الجميع على نحو أفضل”.
تقتضي الشفافية، أي عدم التمثيل، شكلًا معينًا من الخطاب، حيث تُحدَّد الإرادة العامة علانية، بل إنها تقتضي أشكالًا من الطقوس تظهر من خلالها للعيان أمام الشعب وعن طريق الشعب، لا مرة واحدة وإلى الأبد بل بشكل متكرر، وربما وسواسيّ. وهذا ما يُعطي معنى لبعد حاسم في الخطاب الثوري في تلك السنوات المصيرية في باريس، حيث كان يُراد للشرعية أن تكتسب، من خلال صياغة (صحيحة في النهاية) لتلك الإرادة العامة، إرادة الجمهورية القوية والفاضلة. وهذا ما يُفسِّر الإسراف في الصراع بين الفصائل المختلفة في 1792-1794. لكنه يُبيِّن أيضًا الأهمية التي تحظى بها المهرجانات الثورية، وهذا ما تناولته منى أوزوف بالدراسة([61]). وكانت حاضرة في ذهن روسو محاولات إظهار الجمهورية للعيان أمام الشعب، أو إظهار الشعب للعيان أمام نفسه، وغالبًا ما كانت هذه المهرجانات تقتبس أشكالها من احتفاليات دينية قديمة من قبيل مسيرات عيد القربان.
لقد قلت بأن مفهوم روسو عن التمثيل معقد لأنه يتضمن أكثر من النقطة السلبية تلك المتعلقة بحظر الجمعيات التمثيلية. ولنا أن نرى في الخطاب الثوري نفسه، وكذلك في المهرجانات، نوعًا آخر من التمثيل، نوعًا خطابيًا أو شبه مسرحي. لكن لا يعني ذلك خرقًا لحظر التمثيل عند روسو، بل إن تلك المهرجانات تتطابق مع مشروعه. لكن، كان هناك شيء أقل علانية وأكثر خطرًا. فبقدر ما توجد الإرادة العامة حيث توجد الفضيلة الحقيقية فحسب، أي حيث يوجد الانصهار الحقيقي بين الإرادة الفردية والإرادة المشتركة، ما الذي يمكن أن نقوله عن وضع لا يزال فيه أشخاص كثيرون، بل لعلهم أكثر الناس “فاسدين” أي أنهم لم يحققوا الانصهار بعد؟ ستكون الأقلية الفاضلة الموطن الوحيد لذلك الانصهار في هذه الحالة. وستكون هذه الأقلية هي الحاملة للإرادة المشتركة الأصلية التي هي إرادة الجميع من الناحية الموضوعية التي يشارك فيها كل شخص إن كان فاضلًا.
ما الذي يُفترض أن تفعله هذه الأقلية انطلاقًا من وعيها بصوابية قرارها؟ هل نترك أغلبية فاسدة تُعبِّر عن “إرادة الجميع” الفاسدة بفعل صلاحية بعض إجراءات التصويت المتفق عليها رسميًا؟ ما عساها تكون قيمة هذا الأمر، إذا افترضنا أن الجمهورية الحقّة، لا تقوم حيث تتَّفق إرادة الجميع مع الإرادة العامة؟ من المؤكد أن الأقلية مدعوة إلى التصرّف على نحو يؤدي إلى تحقيق الجمهورية الحقّة. ولن يتأتى ذلك إلا عبر محاربة الفساد وترسيخ الفضيلة.
نستطيع أن نرى هنا إغراء السياسة الطليعية التي أصبحت تلعب دورًا مصيريًا في عالمنا. وينخرط هذا النوع من السياسة في الدفاع عن “تمثيل” من نوع جديد يختلف عن ذلك النوع القديم من التمثيل، حيث الملك “يمثل” مملكته والأسقف كنيسته والدوق خدمه، وهكذا دواليك. فما أن يحتل هؤلاء جميعًا مناصبهم التمثيلية هذه، يحددون تابعيهم باعتبارهم مُمَثلين. يختلف الأمر كثيرًا عن هذا، لكن السلطة الثورية، على غرار هذه الصيغ القديمة، تستخدم أشكالًا شبه مسرحية من التمثيل الذاتي لجعل الوظيفة التمثيلية ظاهرة للعيان.
لكن هذا التمثيل ليس تمثيلًا بالمعنى الحديث الذي يدينه روسو، حيث تختار الدوائر الانتخابية مندوبيها من أجل اتخاذ قرارات تُلزم الجميع. ويمكن القول إن هذا الشكل الجديد، غير المعلن تمامًا، يكاد يكون نوعًا من التمثيل عن طريق “التجسيد”. فالأقلية تُجسِّد الإرادة العامة. وهي الموطن الوحيد لهذا التجسيد. لكن هذا يجعل صياغة المطالب أمرًا صعبًا، ليس فقط لأن الأقلية تسعى إلى تمييز نفسها عن النموذج “الرسمي” للممثلين المنتخبين، بل أيضًا لأن هناك شيئًا مؤقتًا متأصلًا في تحدّث الأقلية باسم الجميع. ومن حيث المبدأ، ليس لهذا مكان في جمهورية قائمة، بل لا يؤدي دورًا إلا في مرحلة الانتقال الثوري. فهو جزء من نظرية الثورة، ولا محل له في نظرية الحكومة([62]). ذلك هو أصل عدم التماسك الذي نراه دائمًا في السياسة الطليعية الذي قاد رأسًا إلى المثال الأكثر شهرة في القرن العشرين الكبير، ألا وهو البولشيفية.
على أي حال، ولّدت هذه النظرية شبه المعلنة عن التمثيل من خلال التجسيد أشكالًا سياسية جديدة. وهذا ما هو كامن خلف النوع الجديد من “نوادي” الطليعة التي تُعتبر اليعاقبة أكثر أمثلتها شهرة. وقد بيّن فوراي Furet، على غرار أوغسطين كوشان Augustin Cochin، مدى الأهمية التي كانت “لمجتمعات الفكر” في فترة تصاعد المطالبة بمجالس الطبقات في فرنسا([63]).
نستطيع أن نرى هنا الأساس النظري لذلك النوع من السياسة الذي أصبح مألوفًا لدينا بفعل سنوات الثورة الفرنسية في أوجها 1792-1794، والذي خلق تقليدًا حديثًا ما زال متواصلًا في الشيوعية اللينينية على سبيل المثال. إنها سياسة الفضيلة، بوصفها انصهار الإرادة الفردية في الإرادة العامة، كما أنها سياسة مانوية، ذات طابع “أيديولوجي” عالي، بل ذات نبرة شبه دينية أيضًا. وهي تُنشد الشفافية وتخشى نقيضها المباشر: المؤامرات والأجندات الخفيّة، وهي تمارس نوعين من “التمثيل”: يُظهر الأول الإرادة العامة خطابيًا وعلى نحو شبه مسرحي، والثاني الادعاء، وإن بطريقة مضمرة، بنوع من التمثيل عن طريق التجسيد.
ومن الواضح أن ولادة هذا النمط من السياسة من الناحية النظرية، جنبًا إلى جنب مع عدم وجود مخزون للحكومة التمثيلية، لا يمكن أن يكون كافيًا لتفسير الأحداث الرهيبة بين 1792-1794. علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار المخزونات الأخرى الموجودة من الفعل المشترك، ولا سيما أشكال الثورة الشعبية التي كانت مألوفة في فرنسا. وهي أشكال أثَّرت بشكل كبير على ما نسميه الإرهاب، الذي مثَّل، بمعنى ما، خلقٌ مشترك للأيدلوجيا الجديدة ولترسخها القوي في العادات الشعبية([64]).
بيد أنه يوجد تناقض بين مسارين مختلفين عبَّرت من خلالهما النظريات عن النظام الأخلاقي الحديث لتُخبر عن المتخيلات الاجتماعية، وبالتالي مخزون ممارسات النخب في البداية، ومن ثم ممارسات المجتمعات بأكملها. لنا أن نتبيَّن أيضًا كيف أثَّر هذان المساران على طبيعة ما ترتَّب عنهما من نتائج. لقد تبيّن أن الأشكال التي “اعتُمدت” في فرنسا مختلفة عن النموذج الأنغلو-أميركي اختلافًا مثيرًا. وقد تعقب بيير روزنفلون Rosanvallon الطريق الغريب الذي تمَّ من خلاله التوصّل إلى حق الاقتراع العام في فرنسا، وهو يُسلِّط الضوء على شكل مختلف من المتخيَّل الاجتماعي في هذا التقليد الجمهوري([65]).
6- مجتمع النفاذ المباشر
لقد وصفتُ متخيَّلنا الاجتماعي الحديث انطلاقًا من فكرة النظام الأخلاقي التي شكّلت أساس هذا المتخيّل واستولت على ممارساتنا الاجتماعية المميزة وشكّلت السمات البارزة لنظرية القانون الطبيعي في القرن السابع عشر التي حوَّلته مع مرور الوقت. لكن من الواضح أن التغيُّر في الفهم الأساسي للنظام قد رافقه العديد من التغيرات.
أشرت آنفًا إلى غياب أساس متعالٍ للفعل، أي إلى حقيقة أن الأشكال الاجتماعية الحديثة موجودة حصرًا في الزمن العلماني. ولم يعد المتخيَّل الاجتماعي الحديث ينظر إلى الكيانات الكبيرة التي تتجاوز البُعد المحلي كما لو كانت قائمة على شيء آخر، شيء أسمى، غير الفعل العادي في الزمن العلماني. وهذا ما لم يكن متاحًا في الدولة قبل الحديثة، كما بيّنت من قبل. فقد كان يُنظر إلى النظام التراتبي في المملكة باعتباره قائمًا على سلسلة الوجود العظيمة. وكان يُنظر إلى الوحدة القبليّة باعتبارها مكوّنة على هذا النحو بفعل قانون القبيلة “منذ الأزل”، أو لعله يعود إلى لحظة تأسيسية ما بمنزلة زمن الأصول بالمعنى الذي يستخدمه إلياد. إن أهمية الثورات قبل الحديثة بما في ذلك الحرب الأهلية الإنكليزية، وأهمية إقامة قانون أصلي، وأهمية العودة إلى الوراء، تأتي من فكرة أن الكيان السياسي بهذا المعنى هو نتيجة فعل متعال. ولا يمكن أن ينشأ عن فعله الخاص. في حين على العكس من ذلك، لا يمكن له أن يفعل باعتباره كيانًا إلا بما هو كذلك. ومن ثم نفهم كيف أن هذه الشرعية اقترنت بالعودة إلى الدستور الأصلي.
من الواضح أن نظرية العقد الاجتماعي في القرن السابع عشر تنتمي إلى نظام آخر من الفكر، إذ تنظر إلى الشعب على أنه خروج من حالة الطبيعية. ولكن إذا كانت المحاجة التي قدمتها أعلاه صحيحة، فإن هذه الطريقة للنظر للأشياء على هذا النحو لم تدخل إلى حيز المتخيَّل الاجتماعي إلا في أواخر القرن الثامن عشر. وفي هذا الاتجاه يمكن اعتبار الثورة الأميركية نقطة التحوُّل الحاسمة. فقد قامت على أساس العودة إلى الوراء، بمعنى أن المستعمرين كانوا يقاتلون من أجل إحقاق حقوقهم باعتبارهم إنكليزًا، بل أكثر من ذلك كانوا يقاتلون في ظل هيئاتهم التشريعية الاستعمارية التي تجمعت في “كونغرس”. وعن هذه العملية نشأت الفكرة الخيالية الحاسمة “نحن، الشعب” التي كانت أول ما نطق به إعلان الدستور الجديد.
تُثار هنا فكرة مفادها أن الشعب أو “الأمة”، كما كان يقال أيضًا في ذلك العصر، يمكن أن يوجد قبل دستوره السياسي، ومن دونه. وبذلك، يمكن للشعب أن يمنح لنفسه دستوره الخاص انطلاقًا من فعله الذاتي الحر في الزمن العلماني. وبطبيعة الحال، فإن هذا الفعل الذي يفتتح عهدًا جديدًا سرعان ما يطعّم بصور مستمدة من المفاهيم القديمة عن الزمن الأعلى. ويستند “النظام الزمني الجديد” أساسًا على النزعة القيامية اليهودية-المسيحية، شأنه في ذلك شأن التقويم الثوري الفرنسي الجديد. ويطعّم الدستور-التأسيسي بشيء من قوة “زمن الأصول”، الزمن الأعلى الذي يعجّ بفاعلين من نوع متفوِّق، ويتعيِّن علينا أن نسعى دائمًا إلى الاقتراب منه. لكن على الرغم من ذلك تبلورت طريقة جديدة في تصوُّر الأشياء. ففي مقدور الأمم والشعوب أن تمتلك شخصية، وأن تفعل معًا خارج أي تنظيم سياسي قَبْلي. وكان ذلك بمثابة واحدة من المقدمات الرئيسة للنزعة القومية الحديثة، لأن المطالبة بحق تقرير المصير للأمم لا معنى لها من دون هذا. ويتعلق الأمر ببساطة بحقّ الشعوب في أن تُقيم دستورها الخاص من دون أن يعوّقها تنظيمها السياسي التاريخي.
أود العودة إلى مناقشة بنديكت أندرسن الثاقبة حتى نرى كيف تُفصح هذه الفكرة الجديدة عن الفعالية الجمعية، أي “الأمة” أو “الشعب”، عن فهم جديد للزمن. يُشدِّد أندرسن على الكيفية التي تمَّ من خلالها التمهيد للمعنى الجديد للانتماء إلى أمة عن طريق فهم جديد للمجتمع في ظلّ مقولة التزامن: المجتمع باعتباره كلًا مكونًا من الحدوث المتزامن لأحداث كثيرة تسم حياة أفراده في فترة بعينها([66]). وهذه الحوادث هي ما يملأ هذا المقطع من الزمن المتجانس. وينتمي هذا المفهوم شديد الوضوح، غير الملتبس عن التزامن، إلى فهم للزمن باعتباره زمنًا علمانيًا على نحوٍ حصريّ. ولما كان الزمن العلماني متداخلًا مع أنواع كثيرة من الزمن الأعلى، فلا شيء يضمن أن تكون كل الأحداث في علاقات غير ملتبسة من التزامن والتعاقب. فالعيد العظيم معاصر لحياتي ولحياة رفاقي من الحجيج على نحو ما، لكنه، من جهة أخرى، قريب من الأبدية، أو من زمن الأصول، أو من الأحداث التي يتمثَّلها مسبقًا.
يسمح لنا الفهم العلماني المحض للزمن بتخيُّل المجتمع على نحو “أفقي” من دون ارتباط بأي “نقاط عليا”، حيث يلامس التسلسل العادي للأحداث زمنًا أعلى، وبالتالي من دون الاعتراف بتمتع أي فعاليات أو أشخاص بأي امتياز، كالملوك أو الكهنة مثلًا، ممن يقفون ويتأملون عند نقاط التماس المزعومة تلك. هذه الأفقية الراديكالية هي، على وجه التحديد، ما يفترضه مجتمع النفاذ المباشر، حيث يكون كل عضو في “علاقة مباشرة بالكل”. ولا ريب في أن أندرسن على حق عندما أكّد على أن هذا الفهم الجديد لم يكن ليرى النور من دون تطورات اجتماعية، من قبيل رأسمالية الطباعة، لكنه لا يعني بذلك أن تلك التطورات كافية لتفسير تحوّلات المتخيَّل الاجتماعي. لقد تطلب المجتمع الحديث تحوّلات أيضًا في طريقة تمثلنا لأنفسنا كمجتمعات. وكانت ثمَّة أهمية حاسمة، بين هذه الأشياء كلها، لهذه القدرة على فهم المجتمع من وجهة نظر جديدة لا مركز لها، ومن دون أن تكون وجهة نظر أحدٍ بعينه. المقصود بهذا هو أن بحثي عن وجهة نظر أكثر صحة وموثوقية من وجهة نظري لا يقودني إلى جعل المجتمع متمركزًا حول ملك أو حول جمْعٍ مقدَّس، أو غير ذلك، لكنه يسمح بهذه النظرة الأفقية، الجانبية، التي يمكن أن تكون لمراقب ليس له مكان مُحدَّد بعينه: مجتمع موضوع في لوحة من غير نقاط مركزية متميزة. وهناك ترابط داخلي وثيق بين المجتمعات الحديثة وضروب فهمها لذاتها وأنماط التمثيل الإجمالية الحديثة في “عصر عالم الصورة”([67]): المجتمع بوصفه أحداثًا متزامنة، والتفاعل الاجتماعي بوصفه نظامًا “غير شخصي”، والميدان الاجتماعي بوصفه ما هو متعيّن، والثقافة التاريخية بوصفها ما هو معروض في المتاحف، وهكذا دواليك.
كان المجتمع، إذن، عموديًا يجد أساسه في زمن أعلى، لكن سرعان ما اختفت هذه العمودية في المجتمع الحديث. وإذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى، فإن ذلك المجتمع، كان مجتمع نفاذٍ غير مباشر. ففي نظام ملكي قديم، كما في فرنسا مثلًا، لم يكن ممكنًا للرعايا أن يجتمعوا معًا إلا ضمن نظامٍ يستمد تماسكه من قمته ممثلة في شخص الملك من حيث هو الذي يمثل همزة الوصل بين هذا النظام والزمن الأعلى، ونظام الأشياء. ولا نكون أعضاء في هذا النظام إلا من خلال علاقتنا بالملك. وكما رأينا في الفصل السابق، فقد كانت المجتمعات التراتبية القديمة ميالة إلى شخصنة علاقات السلطة والخضوع.
يختلف مبدأ المجتمع الأفقي الحديث عن هذا اختلافًا جذريًا. يقف كل منا على المسافة نفسها من المركز، ونقيم علاقة مباشرة بالكل. وذلك ما نسميه مجتمع “نفاذ مباشر”، لأننا انتقلنا من نظام الروابط الشخصية التراتبي إلى نظام مساواتي غير شخصي، أي من عالم عمودي من النفاذ غير المباشر إلى مجتمعات نفاذ مباشر أفقية.
كان هناك توازٍ كامل بين التراتبية والنفاذ غير المباشر في الصيغة القديمة. وإذا كان – مجتمع الطبقات، أو “مجتمع المنظمات” بحسب عبارة توكفيل – في فرنسا القرن السابع عشر تراتبيًا بشكل صريح، فذلك يعني أيضًا أن المرء ينتمي إلى هذا المجتمع بانتمائه إلى بعض مكوناته. فإذا كان الشخص يعمل في الأرض، فإنه يكون مرتبطًا بالسيد الإقطاعي المرتبط بدوره بالملك. ولا يكون عضوًا في مجلس بلدي مَن لم يكن من أعيان المملكة؛ ولا يشغل أيّ خطة في البرلمان مَن لم يكن من ذوي الحظوة والجاه، وهكذا دواليك. أما المواطنة في المفهوم الحديث، فهي على النقيض من ذلك، مواطنة مباشرة: لأنه مهما تكن طرق ارتباطي ببقية المجتمع متنوعة من خلال منظمات توسطية، فإنني لا أحتاج لأعي مواطنتي إلى كل ذلك. فليس انتمائي إلى الدولة مشروطًا أساسًا بهذه الانتماءات التوسطية. إنني أكون شأني شأن مواطنيّ الآخرين جميعًا، في علاقة مباشرة مع الدولة التي نُدين لها بولائنا المشترك.
بطبيعة الحال، لا يُغيِّر هذا بالضرورة في مجريات الأمور. فإذا كنت أعرف شخصًا صهره قاضيًا أو برلمانيًا، فسأتصل به عندما أقع في مشكلة. ويمكن القول إن ما تغيَّر هو الصورة المعيارية. لكن خلف ذلك هناك تغيُّر في الطريقة التي يتخيَّل بها الناس انتماءهم، وهو تغيُّر ما كان للمعيار الجديد أن يُتاح لنا من دونه. ولأجل ذلك، لم يستسغ الناس في فرنسا القرن السابع عشر وما سبقه فكرة النفاذ المباشر التي بدت غريبة بالنسبة إليهم. وإذا كانت الجمهورية القديمة نموذج المتعلمين، فإن غيرهم، وهم كثر، يعتبرون أن الطريقة الوحيدة التي يستطيعون أن يفهموا بها انتماءهم إلى كلّ أكبر، كالمملكة أو الكنيسة الجامعة مثلًا، تتمثّل في تراكب وحدات انتماء أكثر مباشرة وأكثر قابلية للفهم تضمّهم في كيان أكبر، كالأبرشية أو السيد الإقطاعي مثلًا. لقد افترضت الحداثة، إلى جانب أشياء أخرى، ثورة في متخيَّلنا الاجتماعي: إبعاد أشكال التوسُّط هذه إلى الهوامش، وانتشار صور النفاذ المباشر.
تزامن هذا مع تطوُّر الأشكال الاجتماعية التي ذكرتها: الفضاء العمومي الذي يرى فيه الناس أنفسهم مشاركين في نقاش يهمّ الأمة بأسرها (بل العالم كله أحيانًا)، واقتصاد السوق الذي يُنظر فيه إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين باعتبارهم أطرافًا في علاقات تعاقدية مع الآخرين على قدم المساواة، وبطبيعة الحال، المواطنة في الدولة الحديثة، لكن لنا أن نفكّر أيضًا في طرائق أخرى يتجذَّر من خلالها النفاذ المباشر في مخيلاتنا. ففي مجال الموضة، مثلًا، نتبنى ونستخدم أنماطًا معينة، ونرى أنفسنا أيضًا جزءًا من جمهور عالمي لنجم من نجوم الإعلام. إذا كانت هذه الفضاءات تراتبية، بمعنى ما ـ لأنها تركز على شخصيات شبه خرافية – إلا أنها توفِّر للمشاركين جميعًا نفاذًا لا يتوسّطه أي انتماء أو ولاء آخر بالنسبة لأفراد هذا الجمهور. ويشمل شيء ما من هذا القبيل، إلى جانب أنماط مشاركة أكثر جوهرية، حركات متعددة، اجتماعية وسياسية ودينية، وهو ما يُعدّ سمة أساسية من سمات الحياة الحديثة إذ تربط بين أشخاص في مناطق مختلفة، وعلى نطاق دولي أيضًا، فتوحدهم ضمن فعالية جمعية واحدة.
ترتبط هذه الأنماط من النفاذ المباشر المتخيَّل بالمساواة الحديثة والفردانية، بل هي، في الواقع، لا تعدو أن تكون إلا وجوهًا مختلفة لهما. وإذ يلغي النفاذ المباشر تغاير الانتماء التراتبي، فإنه يجعلنا متماثلين، وهذه طريقة تجعلنا متساوين (وأن تكون تلك الطريقة هي الوحيدة لتحقيق المساواة، فتلك مسألة بالغة الأهمية في جزء كبير من السجالات حول التعددية الثقافية في أيامنا). وفي الآن ذاته، قد يؤدي إقصاء مختلف الوساطات إلى التقليل من أهميتها في حياتنا، ومن ثم يتنامى وعيه بذاته كفرد بقدر ما يتحرَّر منها. ولا تعني الفردانية الحديثة، كفكرة أخلاقية، القطع مع الانتماء تمامًا – فذلك شأن فردانية التفكك والشذوذ – بل تعني أن يتخيَّل المرء نفسه أنه ينتمي إلى كيانات أوسع نطاقًا وغير شخصية أكثر: الدولة، والحركة، والجماعة الإنسانية. ذلك هو التحوُّل الذي نعتبره، من زاوية أخرى، كتحوُّل من ” شبكة ” أو هويات “علائقية”، إلى هويات “قطعية” ([68]).
وهكذا نتبيّن أن مجتمعات النّفاذ المباشر، بمعنى ما، أكثر تجانسًا من المجتمعات قبل الحديثة. لكن ذلك لا يعني، ضرورة، أنّه لا يوجد فارق كبير في الثقافة وفي نمط الحياة بين الطبقات المختلفة مقارنة بما كان عليه الحال في القرون القليلة الماضية، فهذا أمر لا سبيل لإنكاره. وذلك الشأن بالنسبة للمتخيّلات الاجتماعية للطبقات المختلفة حيث أصبحت أكثر تقاربًا. لقد كان من سمات المجتمعات التراتبية التوسطية أن الناس في مجتمع محلي، في قرية أو أبرشية مثلًا، يمكن ألا تكون لديهم سوى فكرة ضبابية جدًا عن بقية المجتمع. وأن لديهم صورة لسلطة مركزية، وخلط بين ملك طيِّب وكهنة أشرار، لكن تظل فكرتهم عن بقية أجزاء الصورة محدودة جدًا. وبشكل خاص، فإن إدراكهم لبقية الناس وبقية المناطق التي تتشكَّل منها المملكة كان نسبيًا ضبابيًا. والواقع هو أنه توجد فجوة كبيرة بين النظرية والمتخيَّل الاجتماعي لدى النُخب السياسية، وبين المتخيَّل الاجتماعي لدى الطبقات ذات التعليم المحدود أو لدى سكان المناطق الريفية. واستمر الوضع على ما هو عليه في بلدان كثيرة إلى فترة متأخرة نسبيًا. وهذا ما تم توثيقه على نحو جيِّد في ما يتعلق بفرنسا خلال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر، على الرغم من تصريحات القادة الجمهوريين الواثقة عن أمة “واحدة لا تقبل القسمة”([69]). وهذا الوعي المتشظي لا يتوافق تمامًا مع مجتمع النّفاذ المباشر. وكان علينا أن ننتظر الجمهورية الثالثة ليحصل التحوُّل الضروري، حيث أصبحت فرنسا الحديثة التي وضعت الثورة نظريتها حقيقة واقعة وجامعة فعلًا لأول مرة. إن هذا التحوُّل الثوري (بمعانٍ كثيرة) في المتخيّل الاجتماعي هو ما عبَّر عنه إيوجين فيبر في العنوان الذي وضعه لكتابه: “من فلاحين إلى فرنسيين”([70]).
الهوامش:
([1]) استفدت في هذا الفصل من كتابي Modern Social Imaginaries (Durham: Duke University Press, 2004)
حيث يمكن للقارئ الاطلاع على مزيد من التفاصيل في شأن هذه الحجة. وقد استفدت بشكل كبير جدًا في هذا الصدد من العمل الجبَّار الذي قام به Benedict Anderson in his Imagined Communities (London: Verso, 1991).
وكذلك من أعمال يورغن هابرماس وميكائيل ورنر وبيير روزنفلّون وآخرين، وأنا مدين لهم في بلورة هذه الحجة.
([2]) في الرسالة الثانية في الحكم، يُعرّف جون لوك الحالة الطبيعية بأنها حالة “تكون فيها السلطة والسادة متكافئان تكافؤًا تامًا: فلا يكون حظ أحد منهما أكثر من حظ الآخر، فلا شيء أيقن من أن كائنات من النوع ذاته ومن المرتبة ذاتها تنعم من دون تمييز بالميزات الطبيعية ذاتها وبالوظائف عينها، وينبغي أن تتساوى في ما بينها من دون أن يسّخر أحدهما الآخر أو ينقاد له، ما لم يُنصَّب إله واحد منها رئيسًا على البقية، ويُعلن عن ذلك إعلانًا صريحًا، أو يسبغ عليه حقًا لا مراء فيه بالسيادة والحكم، بشكل واضح لا لبس فيه”. انظر:
John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laster (Cambridge University Press, 1967), part 2, chap.2, para.4, p. 287.
J.G.A. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).
([4]) استعرت مصطلح “الاقتصاد الأخلاقي” من إ. ب. تومسون، انظر:
- P. Thompson, «The Moral Economy of the English Crowd in the English Crowd in the Eighteenth Century» Past and Present, vol. 50 (February 1971), pp. 76-136.
([5]) Shakespeare, Macbeth, 2.3.56; 2.4. 17-18
انظر أيضًا Charles Taylor, Sources of the Self, p. 298.
([6]) ورد في: Louis Dupré, Passage to Modernity (New Haven: Yale University Press, 1993), P. 19.
([7]) “لن تخطئ الشمس مدارها. وإن فعلت، فستكتشفها الإيرينيات، خادمات العدالة”. ورد في:
George Sabine, A Histories of Political Theory, 3d ed. (New York : Holt, Rinehart and Winston, 1961), p. 26.
([8]) Locke’s Two Treatises of Government, part 1, chap. 9, para. 86, p. 223.
([9]) المصدر نفسه، الجزء الثاني، الفقرة السادسة، ص 289؛ انظر أيضًا الجزء الثاني، الفصل 11، الفقرة 135، ص 376؛ وانظر أيضًا
Some Thoughts concerning Education, para. 116.
([10]) Locke‘s Two Treatises, part. 2, chap. 5, para. 34, p. 309.
([11]) انظر Eugen Weber, Peasants into Frenchmen (London: Chatto and Windus,1979), chap.28.
Hubert Dreyfus, Being in the World (Cambridge: Cambridge MIT press 1991).
John Searle, The Construction of Social Reality (New York: The Free Press, 1995).
انطلاقًا من أعمال كل من هيدغر فتغنشتاين Wittgenstein وبولانيي Polanyi.
([13]) تتضح في مناقشة فرانسيس فوكوياما لاقتصاديات الثقة الاجتماعية، طريقة امتداد المتخيّل الاجتماعي امتدادًا كبيرًا إلى ما يتجاوز ما نُظّر له (أو حتى ما يمكن التنظير له)، إذ تجد بعض الاقتصادات صعوبة في بناء شركات كبرى غير حكومية لانعدام مناخ الثقة الممتد إلى أبعد من العائلة أو بسبب ضعفه. يتّسم المتخيل الاجتماعي في هذه المجتمعات بأشكال من التمييز بين الأقارب وغير الأقارب في ما يتصل بالجمعية الاقتصادية لم تأخذها نظريات الاقتصاد التي نتشاركها كلنا بما في ذلك الناس في تلك المجتمعات بعين الاعتبار. ويمكن حث الحكومات على تبني سياسات أو تدابير قانونية وحوافزها وهَلُمَّ جرًّا انطلاقًا من فرضية مفادها أن تشكيل شركات، مهما يكن حجمها، موجود ضمن مخزوننا، ولا يحتاج إلا التشجيع. لكن حصر الثقة في المجال العائلي يمكن أن يُقيّد هذا المخزون تقييدًا كبيرًا وذلك مهما تبيّن للناس نظريًا أن من الأفضل لهم أن يُغيّروا أسلوبهم في القيام بالأعمال، كما أن في الخريطة الضمنية للفضاء الاجتماعي شقوقا عميقة مترسخة تمامًا في الثقافة وفي المتخيّل لا يمكن أن تطاله نظرية أفضل، انظر:
Francis Fukuyama, Trust (New York: Free Press, 1995).
([14]) Mikhail Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays (Austin: University of Texas Press; 1986).
([15]) لا يعني هذا أن الطوباويات ليس لها شكلها الخاص بها من الإمكانيات. وقد تصف بلادًا بعيدة جدًا أو مجتمعات بعيدة جدًا أو مجتمعات بعيدة في المستقبل لا يمكن محاكاتها اليوم، وقد لا يمكننا محاكاتها أبدًا. لكن الفكرة الكامنة هنا هي أن هذه الاشياء ممكنة حقًا بمعنى أنها متأصلة في طبيعة البشر. هذا ما يظنه الراوي في كتاب توماس مور Thomas More: يعيش الطوباويون وفق الطبيعة. انظر:
Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux (Paris: Payot, 1984) p. 75.
وهذا ما رآه أيضًا أفلاطون الذي وفّر أحد النماذج لكتاب مور ولجملة من الكتابات “الطوباوية” الأخرى.
([16]) Emmanuel Kant, “Von dem schematismus der reinen Verstandnisbegriffe” Kritik der reinen Vernunft, Berlin Academy Edition (Berlin: Walter de Gruyter, 1968), vol. 3, pp. 133-139.
([17]) Leslie Stephen, History of English Thought in the 18th Century (Bristol, England: Thoemmes, 1997), vol. 2, p.72.
([18]) Nanerl Keohane: “Mémoires, p. 63” in Nanerl Keohane, Philoshy and the State in France (Princeton: Princeton University Press, 1980), p. 248.
([19]) المصدر نفسه، ص 249-251.
([20]) بطبيعة الحال، فإن أطروحة معقدة كبرى كامنة خلف هذه الإشارة التوضيحية. والفكرة الأساسية هنا هي أن الثقافة الباروكية نوع من التوليف الذي يجمع الفهم الحديث للفعالية باعتبارها شعرية وباطنية، تنشئ الأنظمة في العالم، والتمثل القديم للعالم باعتباره كوسموسًا تشكَّل وفق الصورة أو المثال. وبنظرة إلى الخلف، نجد أننا ميالون إلى رؤية التوليف باعتباره غير ثابت، وباعتباره محكومًا بأن يجري تجاوزه، كما حدث في الحقيقة. لكن، ومهما تكن حقيقة ذلك، فإننا نستطيع أن نرى في الثقافة الباروكية نوعًا من التوتر المكوَّن بين النظام الموجود بالفعل والتراتبي أيضًا، والفعاليات التي تواصله وتكمله من خلال فعلها البنائي، فتميل إلى فهم أنفسها باعتبارها تقوم بالفعل انطلاقًا من ذواتها، وبالتالي باعتبارها قائمة خارج التراتب، وإذن متساوية. ومن هنا تأتي الصياغات الهجينة كتلك التي رأيناها لدى لويس الرابع عشر. لقد تعلّمت الكثير من الوصف شديد الأهمية للفن الباروكي في كتاب دوبري (Passage to Modernity pp. 237-248) حيث يُعتبر عصر الباروك “آخر توليف شامل ” بين الفعالية البشرية والعالم الذي تنخرط فيه، حيث يمكن للمعنى الذي تولده هذه الفعالية أن يرتبط بالمعاني التي نكتشفها في العالم. لكنه توليف مشحون بالتوترات والصراعات. لا تركز الكنائس الباروكية هذا التوتر على الكوسموس بوصفه نظامًا ثابتًا، بل على الله حيث يُعبّر الكوسموس عن قدرته وخيره، لكن الفعالية البشرية هي التي تحمل هذه القدرة “فتخلق التوتر الحديث بين المقدّس والنظام البشري منظورًا إليهما كمركزين منفصلين للقدرة” (226). ويذهب دوبري إلى أن الثقافة الباروكية موحّدة “برؤية روحية شاملة […] يقف في مركزها الشخص الواثق في قدرته على إعطاء العالم الوليد شكلًا وبنية. لكن ذلك المركز – وهنا تكمن أهميته الدينية – يظل مرتبطًا ارتباطًا شاقوليًا بالمصدر المتعالي الذي يستمد الخالق البشري قدرته منه عن طريق سلسلة نازلة من الكيانات الوسيطة. وهذا المركز المزدوج – البشري والإلهي – يُميز صورة العالم الباروكي عن الصورة الشاقولية التي سادت في العصور الوسطى حيث ينحدر الواقع من نقطة متعالية وحيدة، وكذلك من نقطة أفقية على نحو غير إشكالي في الحداثة اللاحقة، وهو ما ظهرت أولى ملامحه في عصر النهضة. ويحمل التوتر القائم بين المركزين إلى عصر الباروك طبيعة ديناميكية قلقة ومعقدة” (237).
([21]) Keohane, Philosophy and the state in France, pp. 164-167.
([22]) لقد ناقشت هذا الأمر بشكل مستفيض في: Charles Taylor, Sources of the Self, chap.13.
([23]) Albert Hirschman, The Passions and the Interests (Princeton: Princeton university press,1977)
أنا مدين بشكل كبير للمناقشة الواردة في هذا الكتاب المهمّ جدًا.
([24]) Alexander Pope, Essay on Man ([n.p]: [n.pb], [n. d.]), part. 3, pp. 9-26, 109-114; part 4, p. 396.
([25])انظر: Mary Poovey, A History of the Modern Fact (Chicago: University of Chicago Press, 1998), chap. 3.
- B. Schneewind, The Invention of Autonomy (Cambridge: Cambridge University: press, 1998), part 1, and Pierre Manent, La Cité de l’homme (Paris: Fayard, 1994), part 1.
([27]) Philip Carter, Men and the Emergence of polite Society (London, 2001), chaps. 3, 4, and Anna Bryson, From Courtesy to Civility (Oxford: oxford university press, 1988), chap. 7.
([28]) الواقع هو أن ما نعتبره ذرى العلم الاجتماعي التنويري، من مونتسكيو إلى فيرغسون، لم يكن وحيد اللون. فلم يستند هؤلاء الكتاب إلى نمط العلم الحديث الموضوعي فحسب، بل إلى الفهم الجمهوري التقليدي أيضًا. ولم يقف آدم سميث عند صياغة اليد الخفية فحسب، بل إنه فكر أيضًا في العواقب السلبية للتقسيم الحاد للعمل في ما يتعلق بالمواطنة والروح القتالية “في جسم الشعب الكبير”.
Adam Smith, The Wealth of Nations (oxford: Clarendon press, 1976), vol. 2, p.787,
أما فيرغسون الذي أنتج واحدة من أهم نظريات المجتمع التجاري وأكثرها تأثيرًا، فقد درس الشروط التي يمكن أن تساعد على تفشي الفساد في هذه المجتمعات انظر:
Adam Ferguson, Essay on the History of Civil Society (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1980), parts 5, 6.
([29]) Translated by Thomas Burger (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989); German original: Strukturwandel der Öffentlichkeit (Neuwied: Luchterhand, 1962).
([30]) Michael Warner, The Letters of the Republic (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990).
([31]) المصدر نفسه، الفصل الأول.
([32]) يشير هذا إلى مدى ابتعاد مفهوم الرأي العام في أواخر القرن الثامن عشر عن موضوع استطلاع الرأي في أيامنا هذه. تتمثل الظاهرة التي تسعى إلى قياسها “دراسة الرأي العام”، بحسب التمييز المشار إليه أعلاه، في وحدة تقاربية لا تحتاج إلى أن تنبثق عن نقاش. وهي تشبه رأي الإنسانية. ويتجلّى المثل الأعلى الكامن في صيغة القرن الثامن عشر في هذا المقطع المقتبس من بورك الذي أورده هابرماس في:
Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, p.117-118
“في بلد حر، يعتبر كل إنسان نفسه معنيًا بجميع القضايا العمومية، وأن من حقه أن يبدي رأيه في ما يتعلق بها. ويتفحص الناس هذه الأفكار ويناقشونها فضولًا وانشغالًا وغيرة. ولما كانت هذه القضايا تمثل جزءًا من اهتماماتهم اليومية واكتشافاتهم، فإن أغلبهم يخلص إلى معرفة كافية بها، بينما يتمكن ثلة منهم من معرفتها بدقة […]. أما في بلدان أخرى، حيث لا أحد يهتم بذلك ما عدا أولئك الذين تفرض عليهم وظيفتهم الانهمام بالشؤون العامة، وحيث لا أحد يجرؤ على فرض رأيه على غيره، تصبح القدرة على ممارسة هذا النوع من الأمور نادرة جدًا أيًا كانت ظروف الحياة. ففي البلدان الحرّة نجد أكبر قدر من الحكمة والتعقل في المتاجر والمصانع أكثر منه في مجالس حكومات الأمراء في البدان التي لا يجرؤ فيها أحد على أن يتخذ رأيًا ما لم يكن عضوًا في تلك الحكومات”.
([33]) Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, p.119.
([34]) Warner, Letters, p. 41.
([35]) انظر عبارة فوكس التي أوردها هابرماس في:
Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, pp. 65-66:
“إن استشارة الرأي العام أمر جيد وحكيم بكل تأكيد… وإذا لم يتفق الرأي العام مع رأيي، أو إذا لم يرَ الخطر مثلما أراه حتى بعدما أدله عليه، أو إذا اقتنع أن ثمة علاجًا أفضل مما أقترحه، فإن من واجبي أمام ملكي وشعبي، وأمام شرفي أيضًا، أن أتركه وشأنه وفق الخطة التي ارتآها هو على أنها الأفضل من غيرها، وذلك باستخدام الأداة المناسبة لها، أي الشخص الذي فكر مع… لكن ثمة أمرًا شديد الوضوح، هو أن عليّ أن أعطي الجمهور الأدوات اللازمة حتى يكوّن لنفسه رأيًا”.
([36]) وردت في: Habermas, Structural Transformation, p. 117.
([38]) انظر: Letters, pp. 40–42.
يُشير ورنر أيضًا إلى العلاقة مع الفعالية غير الشخصية في الرأسمالية الحديثة (63-62)، إضافة إلى الاقتراب من التوافق بين الموقف غير الشخصي والمعركة ضد الفساد الإمبراطوري، وهو موضوع حظي بأهمية بالغة في المستعمرات (65-66)، لا سيما في ما يتعلق بتشكيل هذا النمط المتّسم بفرط التحديد على حد بعيد.
([40]) انظر: E. kantorowicz, The King’s Two Bodies (Princeton: Princeton University press, 1957).
([41]) للاطلاع على مثال فوق ـ أوروبي على هذا النوع من الأمور، انظر: Clifford Geertz’s, Negar (Princeton: Princeton University Press, 1980) حيث يرد وصف حالة بالي قبل الغزو.
([42]) أصف صورة الوعي في الزمن قبل الحديث الذي يشتمل على أنماط مختلفة من الزمن الأعلى، في:
“Die Modernitaet und die saekulare Zeit,” in Am Ende des Milleniums: Zeit und Modernitaeten, ed. Krzysztof Michalski (Stuttgart: Klett Kotta, 2000), pp. 28–85.
([43]) في الحقيقة ليس إقصاء البعد الديني شرطًا ضروريًا في ما يتعلق بتصوري للعلمانية هنا، ناهيك أن يكون شرطًا كافيًا. إن الرابطة العلمانية قائمة على الفعل المشترك وذلك ما يستبعد أي أساس إلهي لهذه الرابطة. إلا أنه لا شيء يمنع الأشخاص المجتمعين على هذا الأساس من مواصلة ممارسة نمط حياتهم الدينية، بل قد يقتضي هذا النمط، مثلًا، أن تكون الروابط السياسية علمانية محضة. وثمة دوافع دينية، لتبنّي فصل الكنيسة عن الدولة.
([44]) Mircea Eliade, The Sacred and the profane (New York: Harper, 1959), p. 80.
([45]) في كتابه الجماعات المتخيّلة، يستعير أندرسن مصطلحًا من بنيامين ليصف الزمن الدنيوي الحديث. حيث يرى في هذا الزمن زمنًا فارغًا متجانسًا. ويعكس مصطلح التجانس هنا الجانب الذي أصفه، وهو أن الأحداث تقع كلها الآن في نوع واحد من الزمن. أما مصطلح الفراغ فيتعلق بمسألة أخرى: طريقة النظر إلى كل من الزمان والموضع باعتبارهما وعاءين يجب أن تقع الأحداث والأشياء فيهما بدلًا من أن يكونا متشكلين بفعل ما يملأهما. وهذه الخطوة الأخيرة جزء من التخيّل الميتافيزيقي في الفيزياء الحديثة، كما هو الشأن عند نيوتن. لكن الخطوة في اتجاه التجانس هي الخطوة الحاسمة في ما يتعلق بالعلمنة، في تقديري.
أما الخطوة في اتجاه الفراغ فهي جزء من إضفاء الطابع الموضوعي على الزمن الذي أصبح ذا أهمية بالغة في النظرة إلى العقل الأداتي الحديث. وبمعنى ما، فإن الزمن أصبح موضعيًا. ينتقد هيدغر هذا التصوّر بشكل لاذع، في فهمه للزمانية؛ انظر خصوصًا:
Sein und Zeit (Tübingen: Niemeyer, 1926), Division 2.
([46]) لم تكن هذه الخطوة كبيرة لأن الحقوق التي يتمتع بها المستعمرون بوصفهم بريطانيين يُنظر إليها، في تصورهم، كتخصيصات للحقوق “الطبيعية”، انظر:
Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992), pp. 187-188.
([47]) “لا شيء تخشاه الولايات المتحدة، كما هو الحال في فرنسا، أكثر من تشبيه علاقة التفويض بشكل محض من الهيمنة”
Pierre Rosanvallon, La démocratie inachevée (Paris: Gallimard, 2000), p. 28.
هذا الاتفاق العميق على أشكال التمثيل لم ينه مناقشات محتدمة في ما يتعلق بالبنى، وذلك ما تشهد عليه المناقشات الصاخبة في ما يتصل بالدستور الفيدرالي الجديد. بل لقد سمح حتى بطرح بعض المسائل العميقة في ما يخص طبيعة التمثيل، انظر:
Bernard Bailyn, the Ideological Origins of the American Revolution (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992), chap. 5.
كما أن هذا الاتفاق الأساسي لم يمنع الانتفاضات الشعبية ضد القوانين التي صوّتت عليها الجمعيات، كما في تمرد شاي Shay’s Rebellion، بل كانت الملجأ الأخير في مواجهة ما كان يُنظر إليه باعتباره ظلمًا ما زال النظام القديم يسببه على الرغم من شرعيته. ومن هذا الجانب، كانت هذه التمردات تشبه انتفاضات زمن النظام القديم في فرنسا. وهذا ما نتناوله لاحقًا. انظر المعالجة المهمة لهذا الأمر في:
Patrice Guenofey, La politique de la terreur (Paris: Fayard, 2000), pp. 53-57.
([48]) François Furet, La révolution française (Paris: Hachette, 1988).
([49]) Simon Schama, Citizens (New York: Knopf, 1989), chap .4.
([50]) Orlando Figes, A People’s Tragedy (London: Penguin,1997), pp. 98-101, 518-519.
([51]) كان لوك قد طوّر بالفعل صيغة جنينية لهذه الآلية. وهو يؤكد لنا في الفصل الذي يتحدث عن الملكية أن “الذي يحوز الأرض بنفسه عن طريق عمله لا يقلل، بل يزيد، رصيد الجنس البشري. وذلك لأن ما يقدمه لدعم استمرار الجنس البشري إنتاج هكتار واحد من الأرض المسيجة المزروعة أكثر بعشر مرات مما يقدمه هكتار من الأرض ذات الخصوبة عينها متروك مشاعًا. وهذا يعني أن من يُسيّج أرضًا مساحتها عشرة هكتارات يحقق من وسائل الحياة أكثر مما يمكن أن يتحقق من مئة هكتار متروكة للطبيعة. ويمكن أن يُقال عنه إنه يعطي تسعين هكتارًا للبشر”، انظر:
John Locke, Second Treatise of Sivil Government ([n.pb.], [n.d.]) V. 37.
([52]) Jean –Jaques Rousseau, Du contrat Social (Paris: Classiques Garnier, 1962), book 1, chap. 6.
([53]) J.J. Rousseau, Du Contrat Social, book 1, chap. 8.
([55]) Jean-Jacques Rousseau: «Profession de foi du vicaire savoyard » dans: Emile (Paris: Editions Garnier, 1964), pp. 354-355.
([56])وردت في Georges Lefebvre, Quatre-vingt-neuf (Paris: Edition Sociales, 1970), pp. 245-246.
([57]) Charles Louis de Secondât (Montesquieu), L’esprit des lois ([s.1.], [s.a.], book (12) 4, chap. 5.
([58]) François Furet, Penser la révolution française (Paris: Gallimard, 1978), p. 276.
([59]) Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: La transparence et L’obstacle (Paris: Gallimard, 1971).
([60]) Jean-Jacques Rousseau: «Lettre à d’Alembert sur les spectacles» dans: Du contrat social (Paris: Classiques Garnier, 1962), p. 225.
نستطيع من خلال هذا أن نرى كم كانت الشفافية التي ينشدها روسو معادية “للتمثيل” بجميع أشكاله، سواء أكان سياسيًا أم مسرحيًا أم لغويًا. وبالنسبة لعلاقات معينة ثنائية المنزلة، فإن الشفافية والوحدة تفرضان ظهور المصطلح نفسه في المنزلتين في الآن ذاته. ويشمل العلاقة “س يحكم ع”، إضافة إلى أن “س يمثل شيئًا أمام ع”.
([61]) Mona Ozouf, La fête révolutionnaire (Paris: Gallimard, 1976).
([62]) يُقدِّم غوينفي في كتابه السياسة (la Politique) استخدامًا جيدًا لهذا التمييز.
([63]) Furet, Penser la révolution française, p. 271.
([64]) لقد فصَّلت القول في هذا بشكل مستفيض في كتابي: المتخيلات الاجتماعية الحديثة، الفصل الثامن، موثّق سابقًا.
Modern Social Imaginaries, chapter 8.
([65]) Pierre Rosanvallon, Le Sacre du Citoyen (Paris: Gallimard, 1992); and Le Modèle politique français (Paris: Seuil, 2004).
([66]) Benedict Anderson, Imagined Communities (London: Verso, 1991), p. 37.
([67]) Martin Heidegger: «Die Zeit des Weltlbildes», in: Holzwege (Frankfurt: Niemeyer, 1972(.
([68]) أستعير هذا المصطلح من كرايغ كالهون. انظر مثلًا:
Craig Calhoun, «Nationalism and Ethnicity» American Review of Sociology, no. 9 (1993), p. 230.
تدين المناقشة الواردة في هذا الفصل كثيرًا لكتاب كالهون الأخير.
([69]) هذا ما تُعقّبه فيبر على نحو يدعو إلى الإعجاب Eugen Weber, Peasants into Frenchmen (London: Chatto, 1979).


