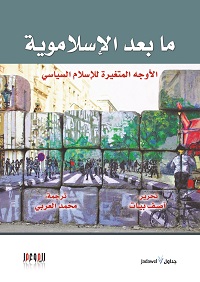
يمكنك شراء نسخة كندل من الكتاب عبر هذا الرابط
ورقة بعنوان (ما بعد الإسلاموية المغربية: اتجاه صاعد أم خرافة؟ – سامي زمني) من كتاب (ما بعد الإسلاموية)
ثار النقاش حول طبيعة الحركات الإسلامية وجوهر الإسلام في الأوساط الأكاديمية والعامة على حدٍّ سواء منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. وأصبح واضحًا أن «طبيعة العلاقة بين الغرب والإسلام السياسي» لا تتعلق فقط بقضايا التحولات السياسية والثقافية الاجتماعية في العالم العربي، و/أو العالم الإسلامي، إذ إنها «أصبحت قضية مُحدِّدة للسياسة الخارجية»[1]. في حقيقة الأمر، هناك «مسألة إسلاموية» صاعدة في النقاشات الغربية العامة تتناول ما إذا كانت السياسة والأحزاب الإسلاموية على استعدادٍ أن تلعب دورًا ديمقراطيًّا على الساحة السياسية. ويعتبر هذا السؤال موضوع نقاشات متكررة وحادة بين المؤيدين والمعارضين، بين هؤلاء الذين يرون في الحركات الإسلامية قوة قادرة على تحديث ودمقرطة العالم العربي[2]، وهؤلاء الذين يرون فيها نسخة إسلامية من الفاشية التي ستسيطر على السلطة ديمقراطيًّا فقط من أجل إلغاء الديمقراطية بعد ذلك[3].
هناك معضلتان في هذه النقاشات. الأولى؛ إنها نقاشات تغلب عليها الأيديولوجية والمعيارية؛ فهي مستقاة من الحركات الإسلامية الموجودة فعليًّا، وتركز على الكشف عن جوهرها. وكما أشار آصف بيات بحق[4] أن السؤال عما كان الإسلام والديمقراطية متوافقين أقل أهمية من السؤال عن الظروف التي يستطيع المسلمون فيها التوفيق بينهما. والثانية؛ إن المسألة الإسلاموية تعكس ضمن النقاشات الأوروبية والأميركية بجدارة ولعنا بكل ما هو إسلامي بدلًا من تحليل أمين وواعٍ عما يحدث على الأرض. كما أن النقاشات حولت الإسلاموية (وبشكل أكبر وأكبر عن الإسلام في العموم) هي نقاشات معيبة؛ بمعنى أنها تبدأ من مواقف جوهرانية وترتبط بشكل أكبر بالمصالح المادية الغربية، وبالأخطاء السياسية والأيديولوجية المتغيرة داخل السياسات الغربية، وبالصعوبات التي تواجهها في التعامل مع قضايا الهجرة والاندماج.
يتخذ هذا الفصل موقفًا أكثر عملية وأكاديمية في مناقشة هذه القضية. فبدلًا من الانطلاق من افتراضات مسبقة عن ماهية وتحولات الأحزاب الإسلاموية، سأركز على ما قامت به هذه الحركات في الماضي وما تقوم به حاليًّا، أي على كيفية تطورها وتغيرها عبر الزمن. ولكون الأيديولوجية الإسلاموية- التي تم اختزالها إلى أفعال عملانية- فقيرة في قدرتها التنبئية بالسلوك الإسلاموي، سأركز في تحليلي على المشهد السياسي الإسلاموي المغربي المتغير بتناول آلياته وتوصيف تطوراته. ولفهم التغيرات الأيديولوجية والخيارات الاستراتيجية لمختلف الحركات الإسلاموية، من الضروري أن نأخذ في اعتبارنا الحدود السياقية للحشد والمشاركة، وكذلك البيئة الإقليمية والعالمية التي تعمل من خلالها هذه الحركات. كما ينبغي أن يكون النظر في الجدالات الأيديولوجية داخل الحركات عاكسًا للتطورات الاجتماعية الأوسع (مثل الفجوة الجيلية والتمدين ووسائل الاتصالات وغيرها) وأن يأخذ بعين الاعتبار العلاقات في مختلف الحركات الإسلامية. بوجود «أميرٍ للمؤمنين»، تتمتع المغرب بمشهد سياسي في غاية الثراء وطيفٍ واسع من الأحزاب والحركات والتيارات. وينقسم الاتجاه الإسلاموي بين العديد من الحركات والأحزاب، بما يعكس مفاهيم متنوعة للعلاقة بين الدين والسياسة، واستراتيجيات وتكتيكات وخيارات متباعدة، وأهدافًا وغايات متباينة. بالإضافة إلى هذا، فإن الحركات الإسلامية في المغرب، كنظيراتها في البلدان الأخرى، قد تطورت وتغيرت وتأثرت بعوامل داخلية (مثل التحولات الأيديولوجية) وبالحقائق الاجتماعية المحلية المتغيرة (مثل التأثير الجيلي على تغيرات العضوية في الحركات، والتمدين، والتحديث)، وأيضًا بالتأثيرات الخارجية. بكلمات أخرى، تتفاعل الحركات الإسلامية مع البيئة التي تعيش فيها.
ليس الهدف من هذه المشاركة إعادة كتابة تاريخ الإسلاموية المغربية كما فعل آخرون باستفاضة ودقة[5]، وإنما التفكير في نماذج التغير التي أثرت على الإسلاموية المغربية. سأحاول تحديد التغيرات في سياق النقاشات الدائرة حول العلاقة بين الإسلام والسياسة. وسأتحقق من تفسيرية مفهوم ما بعد الإسلاموية كأداة تحليلية لتعميق فهمنا للحركات السياسية المنتسبة إلى الإسلام.
من الإسلاموية إلى ما بعد الإسلاموية
منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979م وحتى اليوم ظهرت أدبيات غزيرة عن الإسلاموية بما أنتج العديد من النظرات القيمة والتحليلات المتضاربة. وعلى قدر نموّ المعرفة والمعلومات الواقعية حول الحركات والمنظمات الإسلامية، ظهرت تحليلات أكثر تنظيمًا ومحاولات لبناء نظريات. تحاول النظريات الاجتماعية تكثيف وتنظيم المعرفة بشأن العالم في نظام من الأفكار المجردة المترابطة. لقد أصبح من الجليّ أن المكونات الأساسية للنظريات؛ وهي المفاهيم المستخدمة لوصف الظواهر المفحوصة، في غاية الغموض. فما هي الإسلاموية في الحقيقة؟ هل علينا أن نتحدث عن الإسلام السياسي؟ ماذا عن الأصولية الإسلامية والإحياء الإسلامي؟[6].
إثارة الأسئلة حول المفاهيم وتعريفها ليس من قبيل النقاشات النظرية في البرج العاجي للأكاديميا. بل على العكس، أنظر إليها كمحاولة ضرورية لفهم الظواهر فهمًا علميًّا ودقيقًا ونشر المعرفة الأكثر إحكامًا بين الجمهور. لا زالت هناك حاجة لتجفيف مستنقع الاضطراب التحليلي كما أشار غيلان دينو منذ عشر سنوات[7]. ازدادت أهمية هذا المسعى بسبب التحولات المضادة المتزايدة للحركات والشخصيات موضع الدراسة. رفض العديد من الأحزاب والحركات والشخصيات الإسلامية التسمية التي تُطلق عليهم، والتي حددها وعرفها بالأساس آخرون من خارجها. وفي مناسبات عديدة فرض سعد الدين العثماني؛ الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، أن يطلق على حزبه «حزبًا إسلاميًّا» مفضلًا الوصف الأكثر غموضًا: «حزب ذو مرجعية إسلامية»[8].
لكي نستطيع التحدث عما تمثله «ما بعد الإسلاموية»، فمن الضروري أن نحدد ما الذي تعنيه «الإسلاموية» بالضبط. أُعرِّف الإسلاموية على أنها عقيدة تسعى إلى الاستيلاء على المجال السياسي عبر تعبئة الموارد الدينية الإسلامية وأساليب العمل الاجتماعي التي تتراوح من الدعوة إلى الجهاد (العنف والإرهاب) والتي تمكن المجموعات الاجتماعية المختلفة من التعبير عن رغبتها في السيطرة على الدولة أو تطيح بها أو تعارضها وذلك من أجل بناء نظام يطلق عليه «إسلامي»[9]. ويقع في المركز من هذه الأيديولوجية، وهو ما يميزها عن الدين الإسلامي، المسألة السياسية. تخلط الإسلاموية مسألة النظام السياسي (أي شرعيته وتنظيمه) بالتفسير الديني- الذي غالبًا ما يعاد اختراعه جزئيًّا- للإسلام. وتشغل فكرة النظام السياسي الذي تأمر به الشريعة ويقوم عليها، سواء كان اسمه خلافة أو إمامة أو دولة إسلامية، مكانة مركزية في هذه الأيديولوجية. يتميز هذا التعريف بأنه يتلاءم بسهولة مع فكرة التحول والتغير في الحركات الإسلامية كمجموعات باستطاعتها أن تغير برامجها وأيديولوجيتها واستراتيجياتها وتكتيكاتها.
أما «ما بعد الإسلاموية» فإنما تشير إلى شيء يختلف عن الإسلاموية بل ويتجاوزها، وتشير إلى أشياء عديدة متنوعة. لقد اُستخدم المفهوم للمرة الأولى على يد آصف بيات في مقالته «قدوم المجتمع ما بعد الإسلاموي»[10] عام 1996م، ثم اكتسب هيمنة خاصة في أوساط النقاشات الأكاديمية الفرنسية بعد إصدار العدد الأول من دورية العالم الإسلامي والمتوسطي Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerannée تحت عنوان «ما بعد الإسلاموية»[11] عام 1999م. وبينما كان مفهوم بيات عما بعد الإسلاموية يركز على آليات العلمنة المجتمعية في المجتمع الإيراني خلال التسعينيات، أعاد النقاش الأكاديمي الفرنسي تأطير المفهوم «ليحمل دلالة تاريخية أكثر منها تحليلية، وليمثل فترة معينة أو نهاية تاريخية»[12]. وبالتالي سرعان ما صُك المفهوم في إطار نقاشات معينة عن «فشل الإسلام السياسي» (أو الإسلاموية)، كما يقول العنوان الأخّاذ لكتاب أولفييه روا[13] الذي صدر عام 1992م.
اتجهت النقاشات بشكل رئيس بعدها حول التطور الزمني للإسلاموية، بافتراض صعود الإسلاموية وفشلها. وطبقًا لهذه الرواية، فشلت الحركات الإسلامية في الوصول إلى أهدافها (سواء وصلت إلى السلطة كما حدث في إيران، أو مع محاولتها السيطرة عليها كما حدث في مصر) بما يدفع هذه الحركات إلى إعادة التفكير في تطلعاتها الأيديولوجية والسياسية والاستراتيجية. ومن الواضح أنه من خلال هذا الإطار الضيق، جذب مفهوم ما بعد الإسلاموية انتقادات وتعليقات سلبية.
بينما حاولت ما بعد الإسلاموية أن «تنظم المعلومات الإمبريقية التجريبية عبر الـ35 عامًا الماضية في نموذج تاريخي متماسك»[14]، فقد فشلت في مسعاها، طبقًا للعديد من الباحثين، لعدم قدرتها على تأطير الخصوصيات الموجودة في كل السياقات المتباينة. قام لوزيير بتحليل قصور المفهوم في السياق المغربي[15]، فيما قام يلماظ بتبيان قصوره داخل السياق التركي[16]. جادل خط نقدي آخر أن النموذج الإسلامي الثوري وحده، باستراتيجيته الساعية للاستيلاء على السلطة من أعلى لأسفل، قد أصبح باليًا. وبالتالي، لا تصف ما بعد الإسلاموية التحول في طبيعة الإسلاموية بقدر ما تعبر عن نوعٍ محددٍ منها[17]. وأخيرًا، ركز النقد الثالث على التعريف الإشكالي للإسلاموية والذي يضع أساس أطروحة ما بعد الإسلاموية. على سبيل المثال، أثار فرانسوا بورغا سؤالًا هامًّا: «هل ينبغي لنا، وهذا جوهر المسألة، أن نرسم كل الإسلاميين بفرشاة الحرفية، وأن ننكر وجود كل ما لا يناسب هذا الإطار الذي وضعناه؟»[18].
في عام 2007م، وضّح آصف بيات «ما بعد الإسلاموية» بشكل أكبر كوحدة تحليلية حيث رأى دليلًا إضافيًّا على التحول الكبير في أفكار وممارسات الثوريين الإيرانيين (السابقين). ومن ثم، تُعرف ما بعد الإسلاموية كحالة ومشروع على السواء. كحالة تشير إلى «أن الإسلاموية تصبح مجبرة على إعادة اختراع نفسها، بفعل تناقضاتها الداخلية والضغط المجتمعي»[19]، أما كمشروع فإنها تشتمل على «محاولات لوضع استراتيجيات ومفاهيم لمنطق ونماذج تجاوز الإسلاموية في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية»[20]. وتؤشر ما بعد الإسلاموية على تحول كيفي، وسعي نحو دمج التدين بالحقوق، والإيمان بالحرية، والإسلام بالتحرر. إنها محاولة لقلب المبادئ المؤسسة للإسلاموية رأسًا على عقب من خلال التركيز على الحقوق بدلًا من الواجبات، والتعددية محل الصوت الأحادي السلطوي، والتاريخانية بدلًا من النصوص الجامدة، والمستقبل محل الماضي. إنها تريد أن تزاوج بين الإسلام والاختيار والحرية الفردية، وبين الإسلام والديمقراطية والحداثة[21].
بينما صك بيات هذا المفهوم بالإشارة إلى الحالة الإيرانية، فليس من الواضح دائمًا إذا كان قابلًا للتطبيق على حالات أخرى، وفي أي ظروف. على سبيل المثال، هل تنطبق ما بعد الإسلاموية على الحالات التي وصل فيها الإسلاميون إلى السلطة، ثم أدركوا، بعد حكمهم لسنوات، أن هناك تعارضًا بين مثلهم الأيديولوجية والبرامجية، والبراغماتية الضرورية للحكم؟ وكيف لنا أن نفهم الحالة المغربية، التي لم يكن فيها الإسلاميون في السلطة ولكن الملكية أقامت شرعيتها لفترة طويلة على الإسلام؟ وهل يمكن أن يوصف النمط الذي قامت به الملكية المغربية بتعريف الإسلام عبر قرون أنه ما بعد إسلاموي، حتى إذا كانت الملكية عميقة الجذور- لا الإسلاميون- هي من حاول إعادة التفكير في الإسلام وعلاقته بالسياسة والمجتمع؟
رغم أن هذا قد لا يكون ضروريًّا، يقول بيات إن ما بعد الإسلاموية قد «تجسدها حركة رئيسة (أو متعددة الأبعاد)»[22]. وبالتالي، يبدو أن «ما بعد الإسلاموية» تشير إلى اتجاه مجتمعي أكثر من تصنيف لحركات سياسية. يستحق هذا الفارق الملاحظة. فعندما تشير ما بعد الإسلاموية إلى اتجاه مجتمعي فإنها تضمّن المفهوم في مجال علم الاجتماع الديني (أي بالتركيز على مسألة فردانية الإيمان وعلمنة الممارسات وما إلى ذلك)[23]. أما عندما تكون تصنيفًا حركيًّا، فإنها تصبح معيارًا، نموذجًا لتمييز حركة من بين حركات مختلفة تعزى إلى الإسلام بطريقة أو بأخرى.
سأقوم ببحث إمكانية وجود ما بعد الإسلاموية المغربية من خلال مراجعة تاريخ الحركات الإسلامية المغربية من زاوية «إشكالية» ما بعد الإسلاموية. وكي نستطيع تكوين فكرة أفضل عن آليات التغيير، أفضّل استخدام مقاربة تحقيبية بدلًا من وصف كل حركة أو اتجاه على حدة. وبالتالي سأبدأ بوصف الاستقلال التدرجي للحركات الإسلامية بالعلاقة بالإسلام «الرسمي» في السبعينيات، ثم أصف النماذج المتغيرة للإسلاموية المغربية في الفترة السياسية الانتقالية المعروفة بفترة التناوب، وثالثًا، سأركز على عواقب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر وهجمات الدار البيضاء وقضية العنف. وأخيرًا، سأنظر في تأثير الثورات العربية عام 2011م على المشهد الإسلامي المغربي في العموم والإسلاموية المغربية على وجه الخصوص. وفي كلٍّ من هذه الأقسام، سأركز على الآليات الداخلية للتغيير (مثل تأثير الاستراتيجيات الفاشلة والقمع، وتغير البيئة الاجتماعية والدينية، والتأثير الجيلي)، وكذلك العوامل الخارجية (مثل نمط عنف القاعدة، وأحداث 11 أيلول/سبتمبر، وعملية الدمقرطة، وما إلى ذلك).
الإسلام في مغرب ما بعد الاستقلال
حاولت الملكية المغربية دائمًا أن تنظم وتدير المجال الديني، رغم أنها لم تحقق سيطرة كاملة عليه. تقاسمت المؤسسة الملكية منذ الاستقلال، إلى جانب الجناح المحافظ في حزب الاستقلال والعلماء البارزين، الثقافة السياسية والدينية نفسها التي يلعب فيها الإسلام السلفي والمذهب المالكي الدور الأساسي والأهم[24]. فعلى سبيل المثال، أدين ثلاثة من البهائيين عام 1962م بتهمة الإيمان بأفكار تمّ اعتبارها هرطقة وخروجًا عن الإسلام والمذهب المالكي. وقام علال الفاسي بدور أساسي في هذه القضية محاولًا أن يغلب الملك في إظهاره الالتزام بالدين.
طورت الملكية من تفسيرها الخاص للإسلام باعتباره أساس سلطتها وشرعيتها من خلال دعم الهوية الإسلامية/العربية للمغرب. وأصبحت المؤسسة الملكية موضوعًا لعملية تقديس، فاستمر تبجيلها حتى اليوم عبر دمج ثلاثية الدولة والأمة والإسلام، وبالتالي وضع النظام على لائحة المقدس[25]. ومع صياغة الدستور الأول في عام 1962م، أصبح الملك هو رأس الدولة و«أمير المؤمنين» ويحظى شخصه بكل الحرمة[26]. يُعتبر الملك بكونه أميرًا للمؤمنين قمة السلطة الدينية في البلاد، كما أن الدستور يشير مرارًا إلى الإسلام. ودائمًا ما شجعت الملكية نموّ الجمعيات الدينية القائمة على تفسيرها للإسلام المتسم بالمحافظة والتسامح كأساسٍ لشرعيتها، في الوقت الذي عملت فيه على تحييد الشخصيات الدينية التي حظيت بالشعبية سياسيًّا. نجح الملك محمد الخامس ووريثه الملك الحسن الثاني في منح وظائف عليا للشخصيات الدينية الهامة داخل المؤسسة الملكية. وبالتالي عمل الملك على «ترويض» العلماء، وإبعادهم عن الأحزاب السياسية[27].
دائمًا ما شكّلت المركزية الدينية للملكية سببًا للخلاف بين الملك وبعض رجال الدين، سواءً هؤلاء الذين ينتمون إلى المؤسسة الدينية الرسمية أم إلى العائلات الهامة في البلاد. وحتى إذا كان العلماء مرتبطين في الغالب بالمجال الثقافي، فقد عمل الملك الحسن الثاني منذ السبعينيات فصاعدًا على استخدام خدماتهم لمواجهة قوة الحركات اليسارية النامية من ناحية، ولمواجهة خطاب الحركات الإسلامية الأولى من ناحية أخرى. وخلال العقد نفسه، وقف علماء جدد مستقلون لمواجهة الملكية.
ظهر في السبعينيات تياران أساسيّان للإسلاموية. تمثل الأول في حركة الشبيبة الإسلامية بقيادة عبد الكريم مطيع التي تأثرت إلى حد كبير بكتابات سيد قطب وتبنت توجهات ثورية. دعمت السلطات الشبيبة لموازنة التأثير المتنامي للحركات اليسارية ذات الأيديولوجية العلمانية في الجامعات عبر البلاد. وكما حدث في بلدانٍ أخرى، انقلب التحالف بين النظام والشبيبة عندما بدأت الأخيرة في التحرك خارج أسوار الجامعة. تعرضت الشبيبة لحملة قمع شعواء من قبل النظام بعد اتهامها بمقتل عمر بنجلون القيادي باتحاد العمال عام 1975م. وفيما هربت قيادة الحركة إلى خارج البلاد، وحاولت (بدون جدوى) أن تشعل فتيل الثورة من الخارج، سرعان ما انخرطت المجموعة الأكبر من المتعاطفين مع الحركة في عملية نقاش ونقد ذاتي. وقادت عملية إعادة التقييم الذاتية لاستراتيجية العنف، الحركة إلى التفتت والانقسام إلى حركات متعددة[28]. ومن بين هذه المجموعات المتنوعة، ظهر في النهاية تيار تشاركي أراد أن يدخل الحياة السياسية الشرعية، على النحو الذي سأناقشه لاحقًا.
أما التيار الإسلاموي الثاني في السبعينيات فتشكل أساسًا حول شخصية الشيخ عبد السلام ياسين. تلقى الشيخ ياسين، المولود في العشرينيات من أصول أمازيغية، تعليمًا إسلاميًّا تقليديًّا، غير أنه عمل كمفتش للتعليم الفرنسي في وزارة التعليم. كان أول شخصية عامة تقوم بانتقاد سياسات الملك. وفي عام 1974م كتب أول خطاباته المفتوحة للملك حسن الثاني، وكان هذا أول حركاته السياسية الكبرى. في هذا الخطاب الذي أطلق عليه «الإسلام أو السقوط» والذي كتبه في صورة «النصيحة» المقدمة بشكل لاذع وبليغ، اشتبك ياسين مع شرعية الملكية، ووضع نفسه وحركته بديلًا لها. قدم ياسين في خطابه الإسلام كحل لكل الأزمات السياسية التي تواجه البلاد، وحثّ الملك على اتباع نهجه كما رجاه أن يتخلى عن كل الأفكار «غير الإسلامية» مثل تقديس الملكية، وأن يعود إلى تعاليم الإسلام النقية. أدى هجوم ياسين على أحد العناصر الأساسية لشرعية الملكية، كون الملك أميرًا للمؤمنين، إلى وضعه في نزاع مع الملكية. في البداية لم يستطع الملك أن يقوم بأي شيء تجاه هذا الرجل الذي ينتقد الملكية بلا خجل ولكنه يقف بعيدًا عن الساحة السياسية. لذا، تمّ اعتقال ياسين ووضعه في مصحة عقلية، ثم رهن الإقامة الجبرية لعشر سنوات، ولم يفرج عنه إلا عام 2000م.
سرعان ما تحول ياسين الملتزم بالتقاليد الإسلامية إلى قائد لحركة «العدل والإحسان» والتي تمّ تأسيسها رسميًّا بين عاميْ 1981 و1983م. دائمًا ما رفضت الحركة الشرعية الملكية، غير أنها أبت أيضًا أن تشارك في الإطار السياسي الشرعي. ويقول بعض المراقبين إن الحركة تعمل كطائفة مهدوية أكثر منها حركة اجتماعية أو سياسية[29]. وبهذا المعنى، انخرطت في نقد دائم للملك والملكية والساسة المغاربة، بيد أنها رفضت أن تدخل في أيّ إطار مؤسسي أو قانوني، منتظرةً الوقت الذي سيأتي فيه النظام الإسلامي إلى مقدمة الصفوف.
ولكن هذه القراءة تقلل من أصالة الحركة. فالعدل والإحسان هي حركة روحية في المقام الأول؛ بمعنى أنها تكتسب هويتها من الدعوة إلى الله عن طريق «التعليم والموعظة الحسنة والإقناع والنصيحة»[30]. وترى الجماعة أن العلاج الوحيد لـ«مرض» الأمة- ويتمثل في «الفتنة»- هو الدين. ووحدها «التربية الروحية والتوبة النصوح» بإمكانها أن تشكل أساس العمل «لصالح الأمة»[31]. ويتبع هذا فكرة العمل السياسي والاجتماعي باعتبارهما استكمالًا للإحياء الروحي. وعلى هذا، يشير لوزيير بحق إلى أن ياسين وحركته قد تجاوزا الأبستمولوجيا السلفية للإسلام الملكي[32]، والحركات الإسلاموية الأخرى التي تضم جماعات سلفية عنيفة ظهرت في بداية القرن الحادي والعشرين، كما سأتناولها لاحقًا. وبينما لا ترفض العدل والإحسان الإسلام النصي كليًّا، فإنها تؤكد على الإيمان الباطني عبر إعادة تقويم المفاهيم الروحية والصوفية، وهو ما يضع الحركة في موقع محدد في علاقتها بسؤال الإسلاموية.
الإسلاموية وقضية التناوب السياسي
بدايةً من نهاية الثمانينيات وبشكل أكبر خلال التسعينيات، استجابت الحركات الإسلاموية إلى البيئة السياسية الجديدة التي حاول الملك أن يقيمها. ومنذ بداية التسعينيات، بدأ الحسن الثاني في اختبار فكرة الدمقرطة «المحلية» والتي يشار إليها بـ«التناوب». وفي ظل سقوط الاتحاد السوفيتي وتفاقم الأزمات الدبلوماسية حول قضية الصحراء الغربية، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتصاعد المعارضات السياسية والتمرد الحضري، وتراجع صحته، وضغط الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية الأخرى، أراد الملك الحسن الثاني أن يأتي بالمعارضة القومية التاريخية والموحدة في «الكتلة الديمقراطية» إلى الحكومة. واستكملت هذه المساعي بإقامة نظام سياسي واقتصادي قائم على حكم القانون وإدماج جزئي لبعض السياسات الإسلامية. ونفذ الوريث الملك محمد السادس هذه الإصلاحات على نحو أوسع.
لم يقم الإسلاميون بدور مباشر في النقاشات حول قضية التناوب، غير أنه كان عليهم أن «يستجيبوا» لهذا الموقف الجديد. أيدت مجموعة من المناضلين السابقين في الشبيبة، التفَّت بشكل أساسي حول عبد الإله بنكيران، المشاركة السياسية منذ النصف الثاني من الثمانينيات. كان بنكيران قد انتقد التيار الإسلامي ككل منذ 1976م، واستخلص أن خيار العنف لا يؤدي إلى شيء قط بل له عواقب وخيمة، واقتنع بأنه وحده العمل من خلال المجتمع هو ما يكفل نظامًا أكثر إسلامية. يلخص عضو البرلمان محمد يتيم الأمر:
لقد انتقلنا من مشروع التغيير من أجل إقامة الدولة الإسلامية من أعلى– بكل ما يعنيه هذا من ممارسات تتمثل في العمل والحياة في الخفاء، ورفض المشاركة، متأثرين «بأدبيات الفتنة» في المشرق– إلى تأسيس علاقة إيجابية بالواقع. أدركنا أن الأزمة في المغرب لا تكمن في تأسيس دولة إسلامية؛ إذ إن الدولة مؤسسة دستوريًّا وشرعيتها مقامة على حضور الدين في المجتمع والدستور… منذ 1985م، تحررت الحركة من إرث الشبيبة، وأصبحنا نؤيد الحوار من داخلها»[33].
بين عامي 1982 و1983م، أنشأ بنكيران «الجمعية الإسلامية»؛ وهي منظمة خيرية أرادت أن تعمل في إطار القانون ولم تشكك في إسلامية الملكية والدولة. وحاول بنكيران من خلال فتحه سبلًا للتعاون مع السلطان أن يندمج في الساحة السياسية، بيد أنه رأى محاولاته الرسمية في عامي 1989 و1992م لتأسيس حزب إسلامي تبوء بالفشل. وبعد أن رفضت الحكومة الاعتراف بحركة «الجمعية الإسلامية» كحزب سياسي، غيّر بنكيران اسم المنظمة ليصبح «الإصلاح والتجديد»، ثم في عام 1996م أصبح «حركة التوحيد والإصلاح». تغير الاسم عبر العديد من النقاشات الداخلية حول الاستراتيجيات السياسية الجديدة للحركة، وبإشراك المراكز الفكرية الإسلامية المستقلة والمؤسسات الثقافية الإسلامية في الحركة[34].
بحث بنكيران، الذي كان يعلم جيدًا أن حركته بلا حزب سياسي رسمي، عن طريق لخوض الحياة السياسية. وفهم بنكيران؛ الاستراتيجي السياسي المحنك، أن الدخول في المجال السياسي الصاعد يعتمد على وجود حزب سياسي والمنافسة في الانتخابات. واختار حزبًا سياسيًّا غير فعال بصورة أو بأخرى منذ عام 1965م، وهو حزب «الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية» بقيادة الدكتور الخطيب؛ القائد السابق لجيش التحرير المغربي. أدى اندماج الحزب والحركة إلى تغيير اسم الحزب إلى «العدالة والتنمية» في غضون عدة أعوام. وكان الاندماج ممكنًا؛ إذا إنهما قد اتفقا على الاعتراف بالملك أميرًا للمؤمنين، والإدانة الكاملة للعنف، والاعتراف بالمذهب المالكي باعتباره المذهب المؤسس للدولة، واحترام الدستور[35].
فاز الإسلاميون بتسعة مقاعد في انتخابات عام 1997م. ومع إجراء انتخابات جزئية وحدوث انشقاق عن أحزاب أخرى، أصبحوا ممثلين بـ14 عضوًا برلمانيًّا. دخلوا البرلمان واتبعوا مسار الأغلبية الحرجة، بمعنى أنهم صوّتوا مع الأغلبية الحكومية فيما ظلوا خارج عضوية الحكومة نفسها. وفي انتخابات 2002م، حصد حزب العدالة والتنمية 42 مقعدًا، ليصبح ثالث أكبر حزب في البرلمان. لقد كان دخول الإسلاميين عملية المنافسة الانتخابية بمثابة نجاح لمنهج الملكية الإدماجي والإجماعي في إقامة قواعد سياسية جديدة. ولم يضع هذا الحزب في موقع المعارضة السياسية في إطار العملية السياسية المشروعة، لكنه علامة على استخدام الحزب كعامل للاستقرار خلال فترة الاضطرابات الاقتصادية والتغير الاجتماعي.
أنجز حزب العدالة والتنمية دوره كعامل استقرار خلال عملية التناوب. وكان أحد أهم الأفكار وراء إدماج الحزب في المجال السياسي الشرعي، على الرغم من عدم التصريح عنها رسميًّا أو بوضوح، هو التأكد من وجود حزب على اقتراب من قطاعات كبيرة من الشعب بما سيمكنه من أن يتحدث بصراحة وأن يكون حاجزًا في مواجهة الحركات المتطرفة[36]. كما ذكرت سابقًا، فإن الحزب أصبح ثالث أكبر حزب عقب انتخابات 2002م التشريعية، بيد أنه كان يمثل «حالة غريبة لحزب لا يريد أن ينجح»[37]كما يذكر مايكل ويليس؛ إذ إنه كان راضيًا بأن يخفض من نجاحه عبر تقليل دوائره الانتخابية. ومن خلال هذه الاستراتيجية، أراد الحزب أن يؤكد التزامه باللعبة الديمقراطية، وأن يقلل المخاوف من أن يصل حزب إسلامي إلى السلطة، وأن يؤكد أن التزامه بالعمل لصالح كل المغاربة أهم من مكاسبه الانتخابية المحتملة. أوضح هذا المسار عملية وإصلاحية الحركة على الأقل. وفي انتخابات المحليات عام 2003م، اُنتخب الكثير من أعضاء الحزب كعمد وكأعضاء في المجالس المحلية. أطلق هذا مرحلة هامة تعلم منها الحزب؛ إذ أكد على أن عمله في المحليات حقق نجاحًا عظيمًا اعتمادًا على الإدارة الحضرية الفعالة، والتحكم الدقيق في الميزانية، والإجراءات المناهضة للفساد، إلى جانب استخدامه البراغماتي لبرنامجه الأخلاقي[38].
تقوم إصلاحية حزب العدالة والتنمية على إعادة الاعتبار للاجتهاد. كرر عبد الإله بنكيران مرات عديدة أن حزبه هو حزب سياسي مرتبط بالتيار الإسلامي، وليس حزبًا دينيًّا؛ فهو ينطلق من المرجعية الإسلامية ويبني برنامجه السياسي عبر الاجتهاد. ومن خلال هذه المقاربة، يلعب مفهوم المصلحة دورًا أساسيًّا في توسيع مفهوم الشورى ليشمل أفكارًا ديمقراطية. ولم يؤدِّ هذا فقط إلى القبول بالسياسات الانتخابية كوسيلة مشروعة لتنظيم الهيئات السياسية، وإنما يفتح أيضًا السبيل أمام التفكير في السياسة بعقلانية، كما يضع المبادئ الأخلاقية قبل ضرورات العقيدة الراسخة والأصولية والتقاليد.
وتتضح هذه التغيرات الأيديولوجية أكثر في إطار حركة التوحيد والإصلاح. تقوم الحركة، المعترف بها رسميًّا كجمعية تعليمية وثقافية، على مبدأ التضرع إلى الله وتسعى أعمالها نحو إيضاح الإسلام الذي يتلاءم مع الحساسيات والخصوصيات المغربية. ومع تميزها عن حزب العدالة والتنمية، تسعى الحركة إلى تطبيق الشريعة رغم بقاء معنى الشريعة غامضًا لديها. وتعتبر العلاقة بين الحزب والحركة في غاية التعقيد والصعوبة. فرغم حرص الحركة على البقاء مستقلة عن الحزب، إلّا أنها بشكل واقعي تعمل كمركز فكري للحزب والمجند الأكبر لأعضائه. وأصبح زعيم الحركة الشيخ أحمد الريسوني عالمًا ذا شعبية واسعة تطلب منه الخطابة في القصر الملكي خلال شهر رمضان. تدين حركة ممارسة العنف، وتدعم الملكية ومبدأ البيعة، كما تحترم قواعد الديمقراطية. مع ذلك، تتحدث عن ضرورة إقامة خلافة انتخابية تقوم على الشورى والاختيار الانتخابي[39]. وعند سؤاله عما يعنيه هذا على وجه التحديد، أجاب الريسوني أن النموذج النبوي لم يكن مغلقًا ولا نهائيًّا؛ حيث يعمل النموذج النبوي، أكثر من أيّ نموذج سياسي محدد ملكيًّا كان أو جمهوريًّا، كمصدر إلهام. في النهاية، يفضل الريسوني أن نبحث عن نماذج جديدة للحكومة الإسلامية بما يتلاءم مع العصر في إطار روح التعاليم الإسلامية بدلًا من السعي نحو قالب أوحد ونهائي.
على الناحية الأخرى، ترفض حركة العدل والإحسان، بقيادة الشيخ عبد السلام ياسين، المشاركة فيما تعتبره نظامًا سياسيًّا غير شرعي. بعد رحيل الملك الحسن الثاني، كتب ياسين خطابًا مفتوحًا آخر للملك الجديد هذه المرة، ينتقد الملكية لعدم قدرتها على التعامل مع قضايا الفقر والفساد والاستغلال. غير أنه قام بخطوة أبعد؛ إذ قال لمحمد السادس إن أباه كان آثمًا، إلّا أن باب التوبة لا زال مفتوحًا أمامه إذا أعاد ملايين الدراهم التي «سرقتها» الملكية من الشعب، ويقدرها ياسين بـ30 مليون درهم، يمكن استخدامها لسد ديون المغرب المتضخمة.
بينما كانت قيادة الحركة مستغرقة في فكرة «النصيحة» الإسلامية التقليدية، فهمت أن البيئة السياسية المتغيرة (ومع نجاح الحركة في تقديم الخدمات الاجتماعية التي تتطلب كفاءة أكبر) تحتم أن تكون الحركة أكثر تنظيمًا. أُسست دائرة سياسية للحركة على المستوى الوطني، كان الهدف منها «التعامل مع القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة للأمة، وتتمثل مهمتها في توصيل وترويج أفكار ومواقف الحركة حيال القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية»[40]. ولهذه الدائرة السياسية، التي يقودها فتح الله أرسلان، خمس مهمات؛ هي: تدريب نشطاء سياسيين؛ والقيام بأبحاث وإعداد برامج لاقتراح بدائل ممكنة؛ والعمل على تواصل أوسع مع قطاعات متنوعة من المجتمع؛ خاصةً هؤلاء الذين يملكون تأثيرًا معنويًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا؛ ووضع إطار لتوحيد كل من يخدم قضية الإسلام في البلاد؛ والإعداد لميثاق إسلامي.
أكدت الحركة بوضوح شديد على أن تأسيس الدائرة السياسية ليس انفصالًا عن استراتيجيتها المبكرة وإنه «ليس بدعًا في تفكير الحركة أو في اتجاهاتها». ولاحظت الحركة، التي تفترض أن السياسة مشتقة من التجديد الروحي، أن هذه الدائرة السياسية يجب أن «تدمج شؤون الدولة بأهداف الدعوة لا أن تفصل بينهما؛ فالفصل بين المجالين وظيفي بحت»[41]. ومن الواضح أنه منذ البداية، أصبحت الدائرة بفعل الواقع هيئة سياسية تتناول القضايا محل المناقشة في البلاد. وبغض النظر عن أيديولوجيتها، فمن الواضح أن الدائرة السياسية قد اكتسبت هيمنة داخل الحركة، وأثبتت أن حركة العدل والإحسان لم تكن منعزلة عن سياسات التناوب. وبالرغم من أن الحركة لم ترد دخول الحياة السياسية رسميًّا، فإنها فاعل سياسي بوضوح، وبالتالي تعمل على إظهار تفاعلها واستجابتها للبيئة المتغيرة.
خلال الثمانينيات، أصبح من الجليّ تمامًا أن الدولة قد فقدت احتكارها الديني لإنتاج النماذج الإسلامية؛ ففيما ظلت الملكية المؤسسة المركزية الأهم، أصبح عليها أن تتنافس مع نماذج مختلفة من الإسلام تسعى نحو اكتساب الاعتراف العام. وبينما قررت أن تدمج حزب العدالة والتنمية في اللعبة السياسية الرسمية وأن تمنع حركة العدل والإحسان، فقد «استوردت» أيضًا أشكالًا تقليدية من الإسلام مرتبطة بالأوساط السلفية السعودية كوسيلة لتفتيت المشهد الإسلامي أكثر. وفي حقيقة الأمر، عملت الملكية- منذ التسعينيات- على دعم انتشار توجهات محافظة وحرفية للإسلام داخل المملكة، أو على الأقل قبلت بوجودهم، من خلال نشر الخطابات الدينية القادمة من الشرق الأوسط ودول الخليج. ومع مأسسة الأنواع المختلفة من الإسلاموية سياسيًّا بطرق متنوعة، خلقت الدولة لنفسها مساحات مختلفة تستطيع أن تتدخل بشكل أفضل وأن تسيطر على هذه التوجهات الإسلامية. بدا أن هذا الحل المؤسسي يفسر ، على الأقل لفترة، ما أطلق عليه العديد من المراقبين «الاستثناء المغربي»، والذي يشير إلى دولة عربية معتدلة سياسيًّا تمت «السيطرة على إسلامييها» وغاب عنها العنف السياسي وانخرطت في عملية إصلاح ديمقراطي أطلق عليه التناوب. غير أن هذه الصورة تحطمت في 16 أيار/مايو 2003م، عندما قتلت تفجيرات انتحارية أكثر من أربعين مواطنًا مغربيًّا في الدار البيضاء.
هجمات الدار البيضاء: العنف السياسي والمسألة الإسلاموية
على الرغم من أن حركات التيار الرئيس الإسلامية لم ترتبط بجماعات العنف وأدانت استخدام العنف على جبهات عديدة، ظل السؤال الأساسي عن كيفية اصطفاف هذه الأحزاب حيال قضية العنف المستخدم تحت شعار الإسلام. كان هذا السؤال على قدر كبير من الأهمية السياسية. ومع وقوع هجمات الدار البيضاء في 16 أيار/مايو 2003م، طرح الملك وبعض الأحزاب السياسية «العلمانية» علنًا ومباشرةً مسألة الإسلاموية وحضورها في الحياة السياسية المغربية.
أفسح دعم الدولة غير المتعمد لاستيراد الوهابية في الثمانينيات- والذي نُظر إليه في البداية كأيديولوجية أمر واقع يراد بها الحفاظ على سلطة ومزايا المخزن-[42] لمواجهة القوة المتنامية للحركات الإسلامية، الطريق أمام مجموعات عنيفة ومتطرفة تدين الإسلاموية باعتبارها انحرافًا عن صحيح الإسلام[43]. تُشرّع حركة السلفية الجهادية العنف ضد أيّ شخص يتورط في «سلوكيات غير أخلاقية» تتعارض مع تعريفها الجامد «للشريعة». وجد هذا الشكل من الأصولية، والتي كانت في البداية طهرانية وغير سياسية، صدى لها عند بعض العلماء التقليديين المتزمتين (مثل الشيخ الزمزامي ذي التأثير الواسع) وفي أوساط بعض المجموعات المهمشة. وعندما قام بعض المتشددين في الضواحي الأشد فقرًا في عشوائيات المدن بالدمج بين الشكل السلفي من الإسلام بالقراءة المحمولة على العنف لسيد قطب وأمثال ابن لادن والقاعدة، ظهر شكل جديد مسيّس من الجهاد في المغرب[44].
دفع هذا الملك محمد السادس ليستعيد، أكثر من أيّ وقت مضى، دوره المركزي في النظام الديني وإعادة تنظيم المجال الديني في البلاد[45]. أعلن الملك أنه هو وحده ممثل الإسلام. وعلاوة على تأكيده على دوره المركزي في الشؤون الدينية، أعلن أيضًا أن الإصلاحات القائمة تؤكد على سماحة الإسلام المغربي «لتعزيز أسس وقيم الدين الإسلامي المتسامح والكريم، وحفظ وحدة المذهب المالكي». ويتمّ هذا، طبقًا للملك، «عبر تبني الاجتهاد المنفتح الذي يواكب العصر لحماية أبنائنا من التوجهات الأجنبية الهدامة»[46]. وكرر الملك في مناسبات عديدة أن التهديد ليس مغربيًّا بالأساس، بل هو تهديد مستورد، ويرى أن الإسلام لا يمكن استغلاله في مشروعات الكراهية والحرب، كما أن الهوية المغربية تمتاز بتسامحها. وخلال خطاباته بدايةً من العام 2003م، أكد محمد السادس أن الإسلام المغربي بطبيعته متسامح ومسالم «ولكونه دين الوسطية، فإن الإسلام يدين العنف ويحترم الكرامة الإنسانية ويدافع عن التعايش السلمي ويرفض العدوان والتطرف والسعي إلى السلطة باسم الدين»[47].
كان للبرنامج الجديد للإسلام، وعنف الحركات الجهادية عبر البلاد، وتورط بعض المغاربة في الهجمات الإرهابية عبر العالم أصداء حول مكانة ودور وأفكار الحركات الإسلامية. عمل حزب العدالة والتنمية على إيجاد توازن بين مطالب قواعده الجماهيرية ومطالب الملكية من خلال خلق قنوات في وزارة الداخلية. اختارت قيادة الحزب، التي تمركزت وقت هجمات الدار البيضاء حول سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران والحسن داودي، استراتيجية غير تصادمية مع النظام؛ في الوقت الذي اختار فيه مجموعة من الأعضاء، وهم مؤيدو رئيس المجموعة البرلمانية للحزب؛ مصطفى رميد، إدانة تدخل وزارة الداخلية. منحت الهجمات الفرصة لبعض العناصر السياسية وعناصر في الأجهزة الأمنية للهجوم على حزب العدالة والتنمية. واعتقدت بعض الصحف والجرائد المغربية أن ثمة «اتفاقًا» عُقد بين قيادة الحزب ووزارة الداخلية قبيل الانتخابات البلدية في أيلول/سبتمبر 2003م. أحجم الحزب عن القيام بأيّ مسيرات جماهيرية في الانتخابات المحلية، وقررت الداخلية في المقابل ألّا تقوم بأيّ خطوة من شأنها تفكيك أو حظر الحزب. وضع قرار الحزب بالاستجابة لإملاءات النظام الكثير من الضغط عليه وحد من قدرته على السيطرة على أتباعه.
فيما بدا أن علاقة الحزب بـ«المخزن»؛ وهو تعبير مغربي عن الأجهزة الإدارية والسياسية المحيطة بالملكية والحاكمة في البلاد، قد استقرت بعد عام 2005م ، ذهب كثير من المراقبين إلى أن انتخابات 2007م التشريعية سوف تكلل بنصر كاسح للإسلاميين. غير أن هذه المخاوف أو الآمال –على حسب مواقف المراقبين- تبددت عندما استقر العدالة والتنمية كثالث أكبر حزب. وعلى الرغم من أن انتخابات 2007م لم تحقق توقعاته، إلّا أنه أصبح من الواضح أن الحزب قد أضحى من أكبر الفاعلين السياسيين في البلاد، وقد اندمج تمامًا في الحياة السياسية المغربية. أشّرت انتخابات 2007م على وجه جديد لنموّ الحركة؛ إذ إنها توافقت مع الأزمات والمصاعب المرتبطة بالمشاركة في بيئة سياسية شبه سلطوية[48]. فمنذ انتخابات 2007م، عمل الحزب على نحو دائب على تأمين موقفه في المجال السياسي في مواجهة الأحزاب السياسية الأخرى، وكذلك في مواجهة الحكومة والملكية، إذ إن الأخيرة قد حاولت أن تحجّم من نجاح الإسلاميين على جبهات عديدة[49]. لقد بدا أن الحياة السياسية في المملكة، حتى وقت قريب، تتركز حول كيفية احتواء تأثير وقوة حزب العدالة والتنمية. فمن العدم أنشأ فؤاد علي الهمة؛ صديق شخصي ومستشار للملك، حزب «الأصالة والمعاصرة» والذي رأى فيه المراقبون المنافس الرئيس للإسلاميين. غير أنه كان على هذه الخطة التنحي جانبًا؛ إذ إن الربيع العربي في 2011م قد غير سريعًا من قواعد اللعبة السياسية.
الإسلاميون في مواجهة الثورات العربية
ضرب الربيع العربي بجذوره في المغرب، فجسدت حركة 20 شباط/فبراير مساهمة المغرب في التطلعات العربية نحو الحرية والعدالة. خرج المغاربة في 20 شباط/فبراير 2011م ليعبروا عن إحباطهم في شوارع أكثر من 50 مدينة عبر البلاد مطالبين بتغيير سياسي واقتصادي ملموس. وبينما لم تكن أعداد المحتجين مماثلة لجماهير المحتجين في مصر وتونس، إلّا أن 20 شباط/فبراير مثّل بداية لحركة اجتماعية جديدة غيرت من القواعد السياسية في المغرب، فقد تحدت سياسة الإصلاح التدريجي وأصبحت القضية الأساسية أمام الملكية والنخبة الحاكمة هي كيفية بناء استراتيجية نحو الحركة الشعبية مع عدم فقدانها السيطرة على خياراتها إزاء قضية الإصلاح. وكان خطاب الملك في 9 آذار/مارس، والذي دعا فيه إلى كتابة دستور جديد، خطابًا تاريخيًّا ليس لمحتواه، بل لأنها كانت المرة الأولى في تاريخ مغرب ما بعد الاستقلال التي تستجيب فيها مبادرة ملكية للمطالب الشعبية مباشرة.
من المهم أن نحلل تعامل الحركات الإسلامية الرئيسة مع حركة 20 شباط/فبراير مع عودة سيطرة الملك على برنامج الإصلاح. امتلكت الحركة قواعد دعم كثيرة؛ فإلى جانب الشباب الذي أطلق عليه «شباب الفيس بوك»، تلقت الحركة دعمًا من الحركة الأمازيغية، ومجموعة كبيرة من الصحفيين التقدميين في الرباط والدار البيضاء، وحركة الخريجين العاطلين، وأحزاب اليسار الراديكالي، مع وجود دور كبير لمنظمات حقوق الإنسان المغربية، وحزب «النهج الديمقراطي» الماركسي –اللينيني، وكذلك حركة العدل والإحسان بقيادة الشيخ عبد السلام ياسين. كان «العدل والإحسان» أكبر الداعمين لحركة 20 شباط/فبراير، في حين عارضها حزب العدالة والتنمية الذي اختار دعم المبادرة الملكية. وعندما عبّر الأمين العام للحزب؛ عبد الإله بنكيران، عن معارضته للحركة الاحتجاجية، حدثت انشقاقات في منظومة الحزب المتماسكة. منع بنكيران منظمة الشباب في الحزب من الانضمام إلى الاحتجاجات، كما وضع قيودًا على الأعضاء الذين أظهروا تعاطفهم مع المحتجين في مناسبات عديدة. هدد العديد من كبار الساسة في الحزب بالاستقالة، غير أن الانتخابات البرلمانية كان قد اقترب موعدها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ، فحشد الحزب صفوفه آملًا في أن يفوز بالانتخابات. وطبقًا للدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في تموز/يوليو، فإن زعيم الحزب الفائز سيطلب منه الملك تلقائيًّا أن يكون رئيسًا للوزراء وأن يشكّل الحكومة الجديدة. في مرحلة الإعداد للانتخابات قال بنكيران: إن الحزب لا يدعم حركة 20 شباط/فبراير ؛ إذ «إننا شعرنا أن الملكية كانت في خطر … إننا اليوم نعرف المغرب بالملكية، ومن دونها لا نعرف كيف سنصبح»[50].
بحثت حركة العدل والإحسان عن تحالفات جديدة مع الحركات السياسية والفواعل المدنية الأخرى مثل أقصى اليسار والحركة الأمازيغية. ويظهر هذا قدرة الحركة على بناء جسور تحالفات مع تيارات سياسية وأيديولوجية مختلفة[51]. وبالطبع كان على الحركة، باعتبارها قوة معارضة، البحث عن تحالفات إذا ما أرادت ألّا تنتهي كفصيل سياسي معزول. ودائمًا ما أكّدت الحركة على التزامها بالمؤسسات الديمقراطية، بيد أنها لم يكن لديها الفرصة للقيام بمسؤوليات عملية في هذا الصدد. برهن الخطاب الديمقراطي على قدرته التكتيكية على بناء تحالفات مع الحركات المعارضة الأخرى. غير أن القضية بقيت متعلقة بكيفية إيجاد حركة العدل والإحسان لصيغة توافق بين أوجه الديمقراطية وبرنامجها الديني.
من ناحية أخرى، يلتزم حزب العدالة والتنمية بالإجراءات الديمقراطية في الحياة السياسية المغربية وداخل الحزب أيضًا، بيد أنه من الصعب فهم الكيفية التي تعمل بها الحركة في حل التناقضات الممكنة بين الحريات والقيم الإسلامية، بين مطالب المواطنين والهدف المعلن للسعي نحو إقامة نظام سياسي أخلاقي. فيما يلعب حزب العدالة والتنمية دور «رفيق» الملكية، فإن له الحق أن ينكر دائمًا أيّ مسؤولية في النقاشات الدائرة حول قضية الحريات، إذ إن الملك هو من يضع أجندة الحريات ويحكم على أساسها. بطريقةٍ ما، فإن الحزب مقيد بالدور السياسي والمؤسسي الذي يلعبه، وبتطلعه نحو إقامة مجتمع إسلامي مثالي. لا يعتمد الحزب في شرعيته على الدين بل على الملكية نفسها. وتشكّل أخلقة السياسة مساحة محددة للفعل يمكن للحزب أن يستخدمها كي يصنع «فارقًا سياسيًّا». وكقوة برلمانية، لم يستطع الحزب تناول مشكلات صعبة مثل الفقر والأمية؛ غير أنه استثمر كثيرًا من طاقته في حملات الأخلقة. ليس هناك شك أن هذه الحملات هي جزء من الاستراتيجيات الانتخابية، غير أن فكرة أخلقة الحياة العامة تعد مساحة هامة من المصالح السياسية للحزب. كان الحزب دائمًا ما يحرص على أن تكون هذه العملية في إطار الدعوة والنصيحة، وبالتالي لم يطلب مباشرةً منع أي شيء، غير أننا علينا أن نسأل إذا ما كان التذكير الدائم بأن عادات معينة سيئة أو غير إسلامية ليس من شأنه أن يفرغ بعض الحريات الشخصية من مضمونها. في النهاية، يهتم الحزب، مع عدم قدرته على إحداث تغييرات عميقة في التشريعات، بتقليص مساحة السياسات العلمانية عبر دعم الأخلاق الإسلامية أكثر من اهتمامه بتقديم قواعد وقوانين إسلامية محددة. وبهذه الطريقة، لا يحاول حزب العدالة والتنمية أن يقدم الإسلام كبديل للعلمانية والديمقراطية والحداثة ولكن كطريقة للتعامل مع علمنة القيم والسلوك الواقعة في المغرب. ويعتبر الحزب ما بعد إسلامويّ بمعنى أنه لا يسعى إلى إعادة تأسيس «المدينة الإسلامية الأصيلة»، فيما يحاول أن يبني نظامًا اجتماعيًّا يضمن فيه العدالة عبر احترام القيم الإسلامية التي لها أصول في النصوص المقدسة.
يؤكد حزب العدالة والتنمية، في النهاية، على حقوق وواجبات الفرد على نحوٍ متزامن. فبينما تهتم الأشكال التقليدية من الإسلاموية في معظمها بواجبات الأفراد باعتبارهم جزءًا من الجماعة الإسلامية في مواجهة الدولة صاحبة الحق، يؤكد الشكل الجديد من السياسة الإسلامية على حقوق المواطن الفرد. مع ذلك، لا يؤدي هذا بالضرورة إلى موقف ما بعد إسلاموي يكون فيه للمواطنين حقوق راسخة، ولكنه بالأحرى يؤدي إلى موقف تعيد فيه الأحزاب الإسلامية التفكير في مشروعاتها السياسية في إطار البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية المتغيرة.
ومع انتصاره الانتخابي، أصبح حزب العدالة والتنمية مجبرًا على الارتقاء إلى مستوى تطلعات الناخبين. يواجه بنكيران، الذي سماه الملك محمد السادس رئيسًا للوزراء، مهمة صعبة حاليًّا تتمثل في إيجاد صيغة توازن بين الاستجابة إلى الوعود الانتخابية والبراغماتية والعملية الضرورية في إدارة الشأن العام. ومن المبكر جدًّا الحكم على قدرة الحزب على التحول من دور الحزب المعارض إلى الحزب الحاكم، بيد أنه من الواضح أن التفاعل بين القصر ورئيس الوزراء الإسلامي سيكون محل مراقبة وتحليل السلوك السياسي لحزب العدالة والتنمية.
نحو استنتاجات أولية
يبدو أن ما بعد الإسلاموية أصبحت أكثر فأكثر حقيقة اجتماعية في المغرب. وعلى الرغم من استمرار هيمنة الإسلام على الشؤون العامة والخاصة، فقد أصبح أكثر فردانية ومرتبطًا بالخيار الشخصي أكثر من الإكراه والتقاليد. ومع ذلك، يعتبر مفهوم «ما بعد الإسلاموية» مؤشرًا ضعيفًا على السلوك السياسي، وربما ليس الأفضل في وصف آليات تغير الحركات الإسلامية في الحالة المغربية. بعبارة أخرى، لا يكون الأمر واضحًا حال وصفنا ما يجري لحزب العدالة والتنمية على أنه حركة «ما بعد إسلاموية». إذ إن المفهوم لا يفسر الحركة ولا يساعد بالضرورة على توقع سلوكه السياسي. وتتمثل القيمة المضافة التي يقدمها المفهوم أكثر في النظرة العامة على طبيعة التدين، والسمات الظاهرة للدين، وتحول الحركات الإسلامية (كما قصد به آصف بيات) أكثر من وصفه لفئة واضحة لفهم سلوك الحركات الإسلامية. وفي الحقيقة، إذا ما أردنا التمسك بالمفهوم وجعله مفيدًا (من وجهة النظر الأكاديمية)، علينا أن نحرص ألّا نضفي صفات جوهرانية على الحركات الإسلامية بدعوى حاجتنا إلى فهم آليات التغير والتحول فيها.
غير أن «ما بعد الإسلاموية» تبدو في حقيقة الأمر قادرة على تغطية مساحة واسعة في الأيديولوجية الإسلامية. يشير المصطلح إلى معالم تغيرات مثيرة للاهتمام تتضمن ما بعد الإسلاموية كمفهوم وكمشروع. بينما كانت الحركات الإسلامية ماهرة للغاية في تبني المثل الديمقراطية وآلياتها الإجرائية- سبل ممارسة السلطة (الانتخابات والأحزاب والحوكمة المحاسبية والشفافية وحكم القانون وما إلى ذلك)، فقد واجهت الكثير من المتاعب في التموضع وسط المناقشات حول سبل تأسيس الهيئة السياسية؛ أي سبل شرعنة السلطة. وفيما يؤكد حزب العدالة والتنمية على أن سيادة وشرعية السلطة هي للشعب، فلا زالت هناك تساؤلات عن كيفية ترجمة هذا الخطاب الاستيعابي إلى حقيقة سياسية. وفيما لا يسعى الحزب بوضوح إلى إقامة دولة دينية أو حكومة ثيوقراطية، ويؤكد على الحقوق بدلًا من الواجبات، فربما لا يكون من الواضح دائمًا الكيفية التي ستتم بها ترجمة نموذج الانسجام والوحدة المجتمعية هذا، كما يعبّر عنها الحزب، عندما يواجه حقيقة تنوع المصالح في المجتمع؛ وهي مهمة شاقة بالنسبة لأيّ حزب سياسي، فضلًا عن أن يطلب منه الحكم لأول مرة.
ملاحظة: قام المؤلف بالترجمة من العربية والفرنسية إلى الإنكليزية.
[1] Michael Emerson and Richard Youngs, eds., Political Islam and European Foreign Policy. Perspectives from Muslim Democrats of the Mediterranean (Brussels: Center for European Policy Studies (CEPS), 2007), 1.
[2] انظر على سبيل المثال:
François Burgat, L’islamisme en face (Paris: La Découverte, 2005); François Burgat, Face to Face with Political Islam (London: I. B. Tauris, 2003); Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post–Islamist Turn (Stanford: Stanford University Press, 2007a); John L. Esposito and John O. Voll, Islam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996).
[3] Sheri Berman, «Islamism, Revolution and Civil Society», Perspectives on Politics 1, no. 2 (2003): 257–272;. Magdi Khalil, «Egypt’s Muslim Brotherhood and Political Power: Would Democracy Survive?» Middle East Review of International Affairs 10, no. 1 (2006): 44–52.
[4] Asef Bayat, Islam and Democracy: What Is the Real Question? ISIM Papers no. 8 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007).
[5] Malika Zghal, Les islamistes Marocains. Le défi à la monarchie (Casablanca: Ed. Le Fennec, 2005);. Mohsen Elahmadi, Le mouvement Yasiniste (Mohammadia, Algeria: Imprimerie de Fédala, 2006b).
[6] ماذا عن المصطلحات في اللغات الأخرى، مثل مفهوم الأصولية intégrisme في التقاليد البحثية الفرنسية؟
[7] Guilain Denoeux, «The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam», Middle East Policy 9, no. 2 (2002): 56–81.
[8] انظر على سبيل المثال: سعد الدين العثماني في مقابلة مع نرجس الرغاي le Matin, of April 21,.04. 2003
[9] يكشف تعريفي جذور وتأثيرات العديد من التعريفات والتحليلات الأخرى للإسلاموية مثل تعريفات:
François Burgat, L’islamisme au Maghreb. La voix du Sud (Paris: Karthala, 1988); Burgat, L’islamisme en face; Olivier Roy, L’islam mondialisé (Paris: Le Seuil, 2002); and Bobby Sayyid, A Fundamental Fear. Eurocentrism and the Emergence of Islamism (London: Zed Books, 1997).
[10] Asef Bayat, «The Coming of a Post-Islamist Society», Critique. Critical Middle East Studies no. 9 (1996): 43–52.
[11] Olivier Roy and Patrick Haenni, eds., «Le post-islamisme», theme issue, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée nos. 85–86 (Aix-en-Provence: Edisud, 1999).
[12] Bayat, Making Islam Democratic, 17–18.
[13] The French version of Olivier Roy’s The Failure of Political Islam was published under the title: L’échec de l’islam politique (Paris: Le Seuil) in 1992.
[14] Henri Lauzière, «Post-Islamism and the Religious Discourse of ‘Abd al-Salam Yasin», International Journal of Middle East Studies 37, no. 2 (2005): 241–261, at 257.
[15] Ibid., passim.
[16] Ihsan Yilmaz, «Beyond Post–Islamism. A Critical Analysis of the Turkish Islamism’s Transformation toward Fethullah Gülen’s Stateless Cosmopolitan Islam» (2008), at www.gulenconference.net/files/Georgetown/2008_IhsanYilmaz.pdf (accessed December 14, 2010).
[17] Salwa Ismail, «The Paradox of Islamist Politics», Middle East Report 221 (2001): 34–39.
[18] Burgat, Face to Face with Political Islam, 160.
[19] Bayat, Islam and Democracy: What Is the Real Question?, 19.
[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Bayat, Ibid., 18.
[23] تحدث لوفان على سبيل المثال عن المجال العام ما بعد الإسلاموي، انظر:
Mark LeVine, «Heavy Metal Muslims: The Rise of a Post-Islamist Public Sphere», Contemporary Islam 2 (2008): 229–249.
[24] للاطلاع على سرد تاريخي عن السلفية المغربية، انظر:
Abdeljalil Badou, Al-athr al-Shatibi fi-l-fiqr al-salafi bi-l-Maghrib [The influence of al-Shatibi on Salafi thought in Morocco)] (Mohammadia, Algeria: Seliki Ikhwan, 1996). For a more political analysis of modern Salafi movements, see Abdelhakim Aboullouz, Al-Harakat al-salafiyya fi-l-Maghrib (1971–2003). Bahth enthroupoulougi soucioulougy [(Salafi Movements in Morocco ([1971–20034]). A socio-anthropological study)] (Beirut: Markaz dirasat al-whada al-arabiyya, 2009).
[25] تمّ سجن تلميذ مغربي في العام 2008م بدعوى إهانة الملك عندما بدل عبارة «الله، الوطن، الملك» بعبارة «الله، الوطن، برشلونة» على السبورة.
[26] Mohsen Elahmadi, La Monarchie et l’islam (Casablanca: Najah al-Jadid, 2006a).
[27] تمثلت الاستثناءات من الزعماء الدينيين في علال الفاسي وأبي بكر القادري في حزب الاستقلال، والعربي العلوي في الحزب الوطني للقوات الشعبية/والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أما الآخرون فقد تمت بقرطتهم عبر إدماجهم في الوظائف العامة (التعليم والإدارة وما إلى ذلك).
[28] حاول العديد من المجموعات الثورية أن يحافظ على فكرة الجهاد حية في المغرب ولا سيما منظمة الجهاد المغربية التي كانت موجودة أساسًا في فرنسا وبلجيكا ونشرت منشورًا تحت عنوان: «الثورة الإسلامية: مصير المغرب» في العام 1984م، والذي يصبح فيما بعد مصدر إلهام للمقاتلين الجهاديين في أواخر التسعينيات.
[29] Mohammed Chekroun, Jeux et enjeux culturels au Maroc (Rabat: Editions Okad, 1990).
[30] Al-Adl wa al-Ihsan, «Our identity», at http://www.yassine.net/en/Default.aspx?article=jsm_EN&m=1&sm=16 (accessed October 31/10/ 2011).
[31] Al-Adl wa al-Ihsan, «Our identity», at http://www.yassine.net/en/Default.aspx?article=jsm_EN&m=1&sm=16 (accessed October 31,/10/ 2011).
[32] Lauzière, «Post–Islamism and the Religious Discourse of ‘Abd al–Salam Yasin».
[33] Mohammed Yatim, interview, al-Raya, March 23, 1992, cited in Mohammed Tozy, Monarchie et islam politique au Maroc (Paris: Presses de Sciences Po, 1999), 245.
[34] ‘Abd al-Illah Benkirane, Al–haraka al–islamiyya wa ishkaliyat al–minhaj [The Islamic movement and the problematics of the current] (Casablanca: Mashourat al-Forqan, 1999).
[35] يعترف كل من الخطيب وبنكيران أن الأخير هو من بادر بالمشروع. ووضع الدكتور الخطيب شرطيْن أمام الإسلاميين كي يلتحقوا بالحزب، هما أن يعترفوا بشرعية الملكية وأن يحترموا الدستور. وقدم هذه الشروط على أنها شروطه. غير أن محمد التوزي، وهو عالم سياسة مغربي لديه رؤية أكثر اختلافًا عن هذه الصفقة كما شرحها لي في مقابلة 10/5/ 2000: «أعتقد أن الأمر لم يكن بهذا الوضوح.. فقد كان للخطيب تاريخ قريب من الدين … هذا في بعض المراحل. لقد كان هناك مطلب من قبل بنكيران وهو الإسلاموي الأكثر براغماتية، وربما سيتحالف هو نفسه مع الشيطان، فليس لديه تعقيدات. وأعتقد أن الأمر، أخذًا في الاعتبار نجاحات الخطيب في القصر، قد مرّ بالعديد من المستشارين والصالونات.. فلم يخبروه ألّا تضم الإسلاميين في الحزب … وهو أمر معتاد في النظام السياسي المغربي، فلم يكن هناك خطاب يقول: (العزيز دكتور الخطيب … نرجو أن … ) مقابلة مع المؤلف، 10 آذار/مارس 2000م.
[36] Graham Fuller, The Future of Political Islam (Houndmills, England: Pallgrave Macmillan, 2003).
[37] Michael Willis, «Morocco’s Islamists and the Legislative Elections of 2002: The Strange Case of the Party that Did Not Want to Win», Mediterranean Politics 9, no. 1 (2004): 53–81.
[38] Miriam Catusse and Lamia Zaki, «Gestion communale et clientélisme moral au Maroc: Les politiques du Parti de la justice et du développement», Critique Internationale, no. 42 (2009): 73–91.
[39] Zghal, Les islamistes Marocains.
[40] Al-Adl wa al-Ihsan, the document Our identity.
[41] Al-Adl wa al-Ihsan, the document Our identity.
[42] المخزن هو مصطلح يستخدم لوصف السلطة المركزية في المغرب وهو يرجع إلى قرون عديدة حيث كان مجسدًا في السلطنة ومراكز السلطة المحلية، أما الآن فهو مصطلح تحقيري يصف بنى السلطة المركزية والنخب الموجودة حول الملكية.
[43] Anouar Boukhars , «The Origins of Militancy and Salafism in Morocco», Terrorism Monitor 3, no. 12 (2005), http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=157&tx_ttnews%5BbackPid%5D=180&no_cache=1 (accessed December 15, 2011).
[44] Sami Zemni, «Moroccan Islamism. Between Local Participation and International Islamist Networks of Influence?» in Interregional Challenges of Islamic Extremist Movements in North Africa, ed. Muna Abdalla (Pretoria: ISS, 2010), 77–98.
[45] للاطلاع على تحليل واضح عن تنظيم الشؤون الدينية بعد العام 2003م، انظر:
Sami Zemni, «Islam between Jihadi-Threats and Islamist Insecurities? Evidence from Belgium and Morocco», Mediterranean Politics 11, no. 2 (2006): 231–253.
[46] Ministry of Communication, (30/07/2004) «Discours de SM le Roi a’l’occasion de la Fête du Trône», subheading «French» and «discours du roi») (July 30, 2004), at www.maroc.ma
[47] Ministry of Communication, (29/05/2003) «Discours de S.M le Roi Mohammed VI suite aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003»,. Available at http://www.maroc.ma/ (subheading «French» and «discours du roi» (May 29, 2003), at www.maroc.ma/
[48] Hamzawi, Amr. Party for Justice and Development in Morocco: Participation and its discontents, Carnegie Papers, No 93, Carnegie Endowment, 2008.
[49] في العام 2009م، على سبيل المثال، تمّ التخلص من العديد من عُمَد حزب العدالة والتنمية بسبب ادعاءات بالفساد. وكان أحمد بلكوره، عمدة مكناس الأكثر شعبية من بين هؤلاء، على الرغم أن من القضية التي رفعت ضده كانت متواضعة للغاية. على الأرجح كانت هذه رسالة للحزب بألّا يغير من قواعده الانتخابية وجمهوره باستخدام خدمات الأعيان المحليين خارج المراكز الحضرية الكبرى. إن تحجيم طموحات العدالة والتنمية من شواغل الملكية كونها تريد أن تمارس سيطرة على الحركة إلى حد ما (دون أن تلجأ إلى القمع المباشر).
[50] Abdellilah Benkirane, Iinterview, with Tel Quel (no. 493), (October 22–28, 2011).
[51] Franscesco Cavatorta, «Civil Society, Islamism and Democratisation: The Case of Morocco», Journal of Modern African Studies 44, no. 2 (2006): 203–222.


