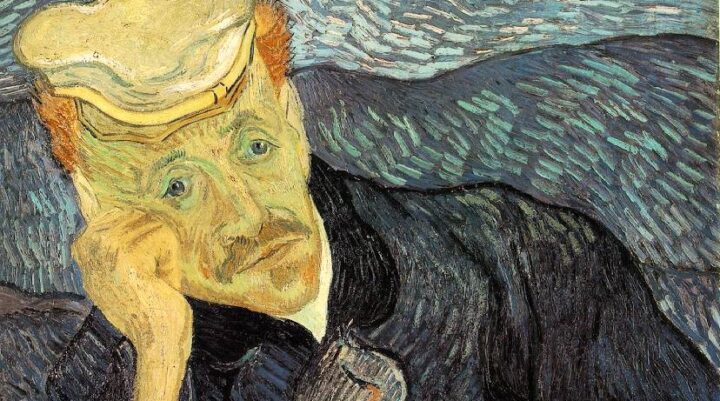حول فلسفة الطب النفسي ، والتفسير الشمولي للطب النفسي، والتطبيق السريري والقضايا المشتركة بين الثقافات؛ نص مترجم لد. دومينيك مورفي والمنشور على (موسوعة ستانفورد للفلسفة). ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة على هذا الرابط، والتي قد تختلف قليلًا عن النسخة الدارجة للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على الأخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة لأخرى منذ تتمة هذه الترجمة. وختامًا، نخصّ بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. نسخة PDF
تدور مناقشات العلل[2] العقلية الفلسفية في ثلاث محاور. أولاً، تلك التي تبرز حين نعامل الطب النفسي على أنه علم خاص ونتعامل معه باستخدام وسائل ومفاهيم فلسفة العلم. وتشمل موضوعات كالتفسير، والاختزال، والتصنيف، الخ. ثانياً، القضايا المفاهيمية التي تبرز حين نحاول أن نفهم فكرة العلّة العقلية وأبعادها الأخلاقية والتجريبية. وثالثًا، التفاعلات بين علم الأمراض النفسي وبين فلسفة العقل؛ إذ استخدم الفلاسفة ظواهر سريرية لإلقاء الضوء على قضايا في فلسفة العقل، وحول النتائج الفلسفية لمحاولة فهم العلة العقلية. لذا سيناقش هذا المدخل قضايا في فلسفة العلم وفلسفة العقل التي تتعلق بالطب النفسي.
-
المقدمة
-
النموذج الطبي والآثار المترتبة عليه
2.1 التفسير الاختزالي
2.2 مفهوم الدليل التشخيصي والاحصائي (DSM) للعلّة العقلية واشكالياته
2.3 التفسير الشمولي للنموذج الطبي
-
التفسير
3.1 مستويات التفسير
3.2 الاضطرابات باعتبارها شبكات إحصائية
3.3 من التاريخ إلى الأسباب
3.4 الاستراتيجيات التفسيرية السببية
3.5 قضايا مشتركة بين الثقافات
3.6 التطبيق السريري
-
علم الأمراض النفسي الفلسفي
4.1 أنواع من علم الأمراض النفسي الفلسفي
4.2 الأفكار الدخيلة
4.3 الاعتلال النفسي(السايكوباثية) وعلم النفس الخُلُقي
4.4 الشخصية المتعددة
-
الأوهام
-
المراجع
-
أدوات أكاديمية
-
مصادر أخرى على الأنترنت
-
مقالات ذات صلة
-
المقدمة
اتفق كلٌ من الباحثين وكتبهم المنهجية على حدّ سواء (بالرغم من أن ذلك لم يكن يعجبهم) على أن الطب النفسي الآن يلتزم “النموذج الطبي” بشدّة، والذي يدعم بدوره “تطبيق ثابت” من حيث التفكير العلاجي الحديث ومن حيث الأساليب” (Black 2005، 3). إذ يمثّل علم الأمراض النفسي “تعبير الوظيفة المضطربة لأحد أجزاء الجسم البشري”(Guze 1992، 44)، أو الدماغ بمعنى أدق. لكن ماذا يعني تبني هذه الرؤية في الطب النفسي؟ وما الفرق الذي سوف تحدثه؟
قد يتبادر إلى الذهن أن النموذج الطبي هذا يلتزم فقط برؤية الخلل الدماغي المسبب للعلّة العقلية مع اتكال طفيف على العلم نفسه، وتلك الرؤية صائبة من حيث أن الاختلافات السريرية أو العلمية عند مختلف الممارسين، لا يكون لها تفاسير متباينة إلا نادراً للنموذج الطبي. وعلى أي حال، فقد ناقش الكثير من المنظرين فكرة أن يكون هناك خلل في التبويب التشخيصي الحالي، كما تم تجميعه في الطبعة الرابعة المنقحة من الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) أو ما يعرف بالمختصر (DSM) (الجمعية الأمريكية للطب النفسي 2000)، إذ أن التبويب برمته أُشتق من متغيرات ومشاهدات لا من استدلال مرضيّ جسديّ. إن هؤلاء المنظرين متشككون حول الكثير من التشخيصات النفسية الحالية، ولا نقصد بأنهم يشككون بالأسس التجريبية حسب؛ بل إنهم يرون تشخيصات الدليل التشخيصي والاحصائي (DSM) عبارة عن تجميع أعراض فقط عوضاً عن رؤيتها على أنها طب يدرك ماهيّة أمراضه بكونها عمليات تدميرية طالت أنسجة الجسم. ومن هذا المنطلق، لا تكون العلل العقلية أصيلة إلا إذا حدثت فيها عمليات تدميرية تطول الأجهزة البيولوجية لا مجرد تجمّع لأعراض مشتركة. وقد اصطلح، بعد مورفي Murphy (2009)، على هذا التفسير بالنموذج الطبي «الشمولي». وهو نقيض التفسير بالنموذج الطبي «الاختزالي» الذي اتخذ التفكير في العلل العقلية على أنها مجموعة أعراض تحدث سوية وتُكشف بطرق مميزة، لكن لم تقدم في تلك أي التزامات حول تفسير الأسباب الكامنة وراء العلّة العقلية.
من الطبيعي أن يكون التفسير الأمثل في أن الطب النفسي يتبنى ممارسات التفسير الطبي، وإن المرض عبارة عن عمليات باثولوجية في الأجهزة الجسدية، إذن يجب أن تكون هناك طريقة لفهم كيف تحدث مثل هذه العمليات في الدماغ؟ وكيف تفسر الحقائق المشاهدة سريرياً في العلّة العقلية؟ لكن ألا يبدو أن منطق النموذج الطبّي يجبرنا على تشريف مستوى واحد من التفسيرات دون غيرها، لا سيّما عدم الالتزام في التشبث بتفسيرات موارد البيولوجيا الجزيئية. وهنا نكتشف أن الطب النفسي هو علم متعدد المستويات. إلا أننا غالباً لا نعلم سوى القليل من العلل العقلية التي يدرسها الأطباء النفسيون، وكذلك لا نعلم الكثير عن تفسيرات الطب النفسي التي لا تشمل أكثر من دراسة حالات أو تقارير سردية تستشهد بخواص الاضطراب، بدلاً من أن تستشهد بالأجهزة المسببة لها. وفي النهاية فأن المنظرين يختلفون في كيف ينبغي النظر إلى ما سبق؟ هل يجب رؤية الأمر على أنه اختلاف في صيغ التفسيرات؟ أو إنه شكل بدائي للتفسير السببي المتكامل؟
-
النموذج الطبي والآثار المترتبة عليه
إن فكرة الطب النفسي كفرع من فروع الطب ليست عالمية، وحتى إن المعتقدين الذين تشبثوا بالنموذج الطبي مع نفس الرؤية العامة للموضوع، نجد أن هناك خلافات حول كيفية فهم هذه الالتزامات المحورية. وقد يكون من المفيد أن نميّز بين التفسيرات الاختزالية والتفسيرات الشمولية؛ إذ لا يقدم التفسير الاختزالي أي التزامات حول البنية الجسدية الكامنة وراء العلّة العقلية، ويتعامل مع المسميات التشخيصية على أنها مسميات استدلالية ذات فائدة بدلاً من المصطلحات الطبيعية بالمعنى العام. بينما، في المقابل، يلزم التفسير الشمولي الطب النفسي أن يرى العلّة العقلية كمرض طبي بالمعنى القوي للكلمة، ويعتبرها عملية باثولوجية تكشف في الأجهزة الجسدية، ويلتزم بفرضيات سببية محدّدة من حيث شذوذ في الأجهزة العصبية البيولوجية الكامنة وراءها.
2.1 التفسير الاختزالي
يعرّف الذين تبنوا التفسير الاختزالي لمفهوم المرض على أنه تركيبة من أعراض يمكن مراقبتها وكشفها بانتظام. إذ طبّق كريبلين Kraepelin هذه النظرية على الطب النفسي وعدّها قاعدة للتشخيص التفريقي، كما فعل في التفريق بين خرف بريكوكس dementia praecox (الشيزوفرينيا حالياً) وغيرها من أشكال الجنون (1899، 173-175). وهذه الفكرة بالذات تعتبر مألوفة في مفاهيم تبويب الدليل التشخيصي والاحصائي (DSM) للعلل العقلية التي اعتمدت على موروثها من كريبلين، وافترض أنه لا يمكن الاعتداد إلا “بالصورة العامة لحالة المريض الطبية من بداية إلى نهاية تطورها، وهذه لا يمكن عدّها تبريراً يمكن ربطه مع مشاهدات أخرى من النوع نفسه” (1899، 3). هذه الصورة الكريبلينية الجديدة المألوفة تفهم أن العلل العقلية عبارة عن تجمّع أعراض وعلامات تحدث بانتظام وتعتمد بدون أدنى شك على العمليات الجسدية، ولكن ليس بالإمكان تعريفها وتصنيفها الآن في هذه العمليات الجسدية.
يُعد غوز Guze (1992)، على سبيل المثال، من المنظّرين الاختزاليين. وقد دافع عن رؤية الطب النفسي كجزء لا يتجزأ من الطب البشري بمعنى أننا نستطيع تصنيف الاضطرابات العقلية من خلال أعراضها المميزة لها ومن خلال مساراتها. وكذلك يبدو أن ميخيو وسلافنيMcHugh and Slavney (1998) قد وافقا على عدّ “المرض على أنه عبارة عن بنية يمكن بلورتها في كوكبة من العلامات والأعراض التي تحدث نتيجة سببية مرضية بيولوجية كامنة وراءها، ناهيك عن امتلاكها آلية حدوث وسبب لاكتمال البنية (302)”. ولكي نقوم بتشخيص مريض يعاني من اضطراب عقلي، بالنسبة لميخيو وسلافني (48)، يجب أن يوضع مسمى له بطريقة يستفاد منها كنقطة انطلاق للتحقّق من العمليات الجسدية.
وينكر ميخيو وسلافني أن المرض عبارة عن عملية جسدية – “ذات جوهر مفهومي واستنتاجي” (48). وكمقدمة لهذه الرؤية، يستشهد توماس سيدنهام بهذه الطريقة في التفكير بالأمراض من منظور الأسباب الكامنة وراء كيان المرض لصالح تكثيف الظواهر المشاهدة، لا من منظور الأسباب الخفية. وعلى أي حال، ما زالت الأمراض تُفهم على أنها عمليات تدميرية تكوّنت على أساسها هيكلية الطب. وبصورة مشابهة، سعت الطبعات المتعاقبة من الدليل التشخيصي والاحصائي (DSM) لتصنيف العلل العقلية على أساس المسارات والأعراض لا على أساس الأسباب بحدّ ذاتها. (توماس سيدنهام: طبيب انجليزي شهير عاش في حدود القرن السابع عشر واشتهر بتمييزه لأصناف متعددة من مرض الجدري على أساس مساراته المميزة وعواقبها).
وعلى أي حال، مات سيدنهام منذ أكثر من ثلاثمئة عام، وتقدم خلال ذلك الطب كثيراً. ولو بقي الطب النفسي ملتصقاً بمفهوم المرض كما رآه سيدينهام، فسيتحتم حينئذ على الطب النفسي أن ينفصل عن بقية الطب. كذلك اتفق الكثير من الباحثين (مثل بينوم Bynum 1994، كارتر Carter 2003، ويتبيك Whitbeck 1977) على أن الطب منذ القرن التاسع عشر قد تغيّر كثيراً، بما في ذلك التحول في التفكير بشأن المرض نفسه. وبدلاً من رؤية المرض على أنه تعريف للأعراض، أصبح المرض يعتمد على ربط الأعراض بالعلوم المرضية المميزة له، وفهمها بصورة منفصلة عن وظيفتها الطبيعية، التي جاءت في تعريف المرض. وأصرّ هاينريش Heinrichs (2001، 271)، مثلاً، على أن يوظّف في الطب النفسي هذه النظرة الطبية الأساسية، واحتاج بالتالي إلى نظرية متقدمة ليعلل كيفية عمل العقل/الدماغ لكي يستخدمها في تحديد الشذوذ النفسي وليفسر منشئها. وبالمقابل، احتضنت أندريسن Andreasen (2001، 172-76) التفسير الشمولي. وادعت أن الطب النفسي الآن يبزغ كشكل من أشكال علم الأعصاب الإدراكي، وكانت تلك سابقة لأول مرة في تمييز الفيزيولوجية المرضية المحدّدة التي تعزز أعراض العلّة العقلية. وكذلك تطابق تطور هذا النمط مع ما اقترح هيمبل Hempel (1965)، الذي توقّع أن يقوم الطب النفسي، عند نضجه، بتطوير مخطط تصنيفي يستدل على منظر يستند على فهم الطبيعة الموضوعية للعلّة العقلية عوضاً عن العوامل البراغماتية فقط (همبل Hempel 1965؛ انظر فلفورد وآخرون Fulford et. al 2006: 324-341: ثورنتون Thornton 2008: 169-74).
2.2 مفهوم الدليل التشخيصي والاحصائي (DSM) للعلّة العقلية واشكالياته:
يعامل الدليل التشخيصي والاحصائي (DSM) الاضطرابات العقلية على أنها متلازمات على غرار النموذج الطبي الاختزالي. إذ يمتلك مستخدمو الدليل مجموعة من الأعراض المشتركة، وغالباً ما تكون هذه المجموعة متفرعة من مجموعة أكبر منها يتشارك أفرادها أعراضاً أكثر شمولية، ربما لا يكون هناك تداخل مشترك بين الحالات. وقد تتكشف الأعراض بمرور الوقت بشكل أعم أو أقل بنفس الطريقة تقريباً. ويتوقع أن هذه المجموعات تستجيب للعلاج بالطريقة نفسها أيضاً. وافترض الإصدار السابق من الدليل التشخيصي والإحصائي أن كل تشخيص يمثل خلل وظيفي في صفة أو قدرة عقلية أو بدنية أو سلوكية (النسخة المنقحة من الطبعة الرابعة) (DSM-IV-TR, xxi). وعلى أي حال، لقد أُدرجت التشخيصات بدون أن يكون هناك ارتباك حول طبيعة السبب الكامن وراءها، وفي معظم الحالات، يكون هناك (ويبقى) تضارب حول السبب الكامن وراء الحالة. وتعرّف الطبعة الخامسة من الدليل (DSM-5) الاضطرابات العقلية بأنها متلازمات تشتمل سريرياً على اضطرابات معتدّة في الادراك أو في العاطفة أو في السلوك بحيث تعكس الخلل الكامن وراءها. وترتبط غالباً هذه المتلازمات بمحنة أو إعاقة اجتماعية، ولكن لا يمكن الأخذ بالتشخيص إذا كان السلوك متعارف عليه في ثقافة المجتمع (Culture) أو كانت محض انحراف اجتماعي، ما لم يعكس التشخيص “الخلل الوظيفي” (الجمعية الأمريكية للطب النفسي 2013، ص20).
تستخدم تشخيصات الدليل عادةً لتعكس المفهوم التقليدي للمرض، على الرغم من الجدل المستمر حول الخلل الكامن وراءه، بسبب تركيز الدليل على المتلازمات فقط وعدم وجود أي فرضيات سببية. وعلى غرار طريقة النموذج الاختزالي، يسمح لنا الدليل بالاستفادة من التفكير الوصفي والإحصائي، ويمنحنا الأمل في التنبؤ الدقيق والرقابة الفعالة. وفي رأي بعض الفلاسفة، إن هذه المحصلة هي كل ما يطمح إليها العلم. ولذلك بدأنا نشير إلى تصريح الكتب المنهجية بأن الطب النفسي يستخدم الأساليب الطبية الاعتيادية، ولا يوجد بالتأكيد أي شيء له علاقة بمنظور ميخيو و سلافني في الأمراض العقلية التي تتخذ الأساليب العلمية غير القابلة للتطبيق.
بينما يصرّ فلاسفة آخرون على فكرة أن وظيفة العلم اكتشاف البنية السببية في هذا العالم. وعلاوة على ذلك، هناك الكثير من طلبة علم الأمراض النفسي ممن يفترض أن إهمال البنية السببية في علم الأمراض النفسي يعني المضي بطريق العلم (بولندا، فون إكاردت وسبولدينغ Von Eckardt and Spaulding 1994، مورفي Murphy 2006، جيرانز Gerrans 2014). إلا أن هؤلاء قلقون من فكرة الدليل القائمة على جمع أفراد مختلفين في مسمى معيّن على أساس السلوك وحده، لأن هذه التشابهات التي يمكن مشاهدتها بين الأفراد قد تساهم في اخفاء الكثير من الاختلافات المهمة الكامنة وراءها، بما في ذلك الاختلافات الموجودة بين الأشخاص الاعتياديين الذين يعانون من اضطرابات وهم في الأساس أصحاء، وبين نظرائهم المرضى. ومن هذا المنظور الفلسفي- السريري يبدو التقصير في المسؤولية حين يقرر أي تخصص علمي، وبالأخص الطب النفسي، أن يعزل نفسه من التحقيق في المسببات. وعلى افتراض أننا استفسرنا لماذا النظرة التقليدية للأمراض ناجحة في تنظيم التنبؤ والمراقبة (ما يطلق عليه الأطباء النفسيون أحياناً “صالحة بشكل متوقع”)؟ يكون الجواب الواضح هو أن هذه الفئات التنبؤية الناجحة تتعقب في الحقيقة البنية السببية التي تمثل الطبيعة المشتركة للحالات، لذا يجب أن نهدف إلى التحقق من صحة التشخيص بشكل أقوى وأنجع من مفهوم “صالحة بشكل متوقع”. أما بالنسبة إلى “موثوقية” التشخيص فأنه معيار للموافقة بين القياسات والمشاهدات، ويعني هذا أن يشمل مفهوم “صحة التحقق” ما هو حقاً موجود. لذلك فإنه حتى في حالة أكثر المشاهدين خبرة يمكنهم إن اتفقوا واجتمعوا على رأي، لكنهم يبقون مع ذلك خاطئون، في حين أن التحقق الصحيح يؤكد لنا أن ما نقيسه هو ما الذي يوجد بالفعل. (يستخدم الأطباء النفسيون مفهوم الصلاحية بعدة طرق؛ للمساعدة في تقسيمهن، راجع فولفورد وآخرون Fulford et al. (2006: 318-19)، شافنر Schaffner (2012) والمقالات التي راجعها زشار وآخرون Zachar et al. 2014).
أما الذين يعتقدون بالنموذج الطبي الشمولي فأنهم يرون أن التحقق من التشخيص كفهم للبنية السببية الكامنة وراءه يعني أن التشخيص صالح في حال اعتمد على عملية بيولوجية تحدد من خلال التجربة والمشاهدة باستخدام وسائل العلوم البيولوجية والإدراكية. لذا يجب على أي منهج في الطب النفسي إن كان يتطلع إلى العلم ليتحقق من صحة فئاته، أن يتواجه باثنين من التحديات المفاهيمية على أقل تقدير: أولاً، التحدي الميتافيزيقي الذي يربط مفهوم الصلاحية مع العمليات العصبي-بيولوجية ، وهذا التحدي يبدو أنه يتبنى موقف فلسفي واقعي، من حيث أن التفكير في العلم يخبرنا كيف العالم في حقيقته؟ ويرى الكثير من الفلاسفة أن الواقعية هي التزام ميتافيزيقي لا لزوم ولا مسوّغ له، وكذلك تخبرنا أغلب العلوم عن مجموع العلاقات بين البيانات. إن هذه العلاقات تسمح لنا أن نتنبأ ونمارس بعض السيطرة على مقدرات الطبيعة، ولكنها لا تخبرنا ماذا حقيقياً يوجد هناك؟ وغالباً ما تركز النزاعات الفلسفية على فكرة عدم قابليتها للرصد، ومثال على ذلك حال الإلكترونات، رغم أن أمثلة الفيزياء الأساسية الأخرى تلعب الدور نفسه. إلا أن الحال في الطب النفسي مختلف: لأنه يستخدم النظريات والبنى على أنها متغيرات أكثر مما يشير إلى عدم قابليتها للرصد. فلو اعتبرنا حالة الشيزوفرينيا مثلاً بناءً، فإننا لن نتمكن من اعتبارها نوع آخر من الاشياء التي تقبع وراء المظاهر وتشرحها: فهي تشكّل الظواهر المرئية. حتى إننا لا نبحث عما لا يمكن مشاهدته، لكننا نسأل عن الظواهر المشاهدة التي تشرح الأعراض مثل (العصبية، الوراثية، التطورية والاجتماعية). إن كان مفهوم النموذج الطبي الشمولي ذا فلسفة واقعية، فذلك في ضوء التزامه بالأسباب، لا بالا المرئيات. قد نبحث عن متغير مخفي يفسر الظواهر المشاهدة، أو عن بعض الأسباب الافتراضية الأخرى. يقترح العالمان النفسيان جولد وجولد Gold and Gold (2014، ص 163-66) على سبيل المثال أن الكثير من الأوهام والأعراض الذهانية الأخرى تعكس خلل وظيفي في “نظام الارتياب” الذي تطور ليكشف التهديدات الاجتماعية ويرصدها. إذا افترضنا وجود هذا النظام فإنه لا يمكن مشاهدته مباشرةً، ولكن مكوناته قد تساعدنا على فتح باب المشاهدة والتلاعب عبر الوسائل القياسية للعلوم الإدراكية. فالطب النفسي، مثل الكثير من العلوم، يتعامل في متغيرات خفيّة أو هياكل سببية افتراضية، ولكن ليس من المفيد أن نعتقد بها كما لو أنها مشاهدة بالمعنى التقليدي.
أما التحدي المفاهيمي الثاني الذي يواجه التفسير الواقعي هو أن الصلاحية عبارة عن أمر معياري. والتحدي يتعلق في أن هناك إحساس مهم بأن التشخيصات لا يمكن التحقق من صحتها على الإطلاق، وإنه من خلال “التحقق من الصحة” نعني أننا “نقدمه على أنه اضطراب حقيقي”. قد يكون عمل جميع أشكال التحققات عبارة عن تقديم نمط السلوك الذي يعتبر معتدّ به سريرياً اعتماداً على عملياته المادية، فيما إذا كان نمط السلوك هذا مرضياً حقاً – أكثر مما يكون غير خُلُقي أو شاذاً- مسألة أخرى. وقد يكون التحدي الثاني من الصعب جداً الوفاء به. ويتطلب أن تكون اجتهادات علم الأمراض شبيهة باكتشافات إيجابية ثمينة، أو بعبارة أخرى أساسها علمي، بدلاً من تكون اجتهادات تافهة. إن كان الأمر كذلك، يصبح من المرجح أن يكون هناك بعض الحقائق الطبيعية حول ما إذا كانت بعض الأجهزة الجسدية غير مختلّة وظيفياً. إن كان غير ممكن القيام بهذا، حينها يكون من الممكن التحقق من صحة تنبؤات الحالات الجسدية، ولكن الاضطرابات لا يمكن.
لقد أشرنا آنفا إلى أن نهج الدليل (DSM) غالباً ما يسمى بـ”الكريبليني الجديد Neo- Kraepelinian”. لكن كريبلين نفسه لم يكن يعتقد الدليل كخيار أولي. إذ رأى التصنيف بطريقة الوصف السريري إجراء مؤقت ليس إلا. بالرغم من أن التصنيف يفي بالمتطلبات الممارساتية للأطباء، ويضع استدلالاً مثمراً للاستقصاء السببي والمرضي اللاحق، حيث “قيمة كل تشخيص تقّيم في الأساس من خلال مدى قابليتها على فتح آفاق موثوقة للمستقبل” (1899، 4). إن قاعدة كريبلين المفضلة للتصنيف والاستقصاء تستند في الحقيقة على اعتقاد أقل استذكاراً بأن “التشريح المرضي يوعد بتوفير أساساً أكثر أماناً” لتصنيف العلل العقلية في الطب النفسي الناضج (1899، 2). واعتبر كريبلين أن التصنيف الصحيح سيكون واحداً يتزامن فيه الوصف السريري، وتختلط فيه المسببات مع الفسلجة المرضية: “وتنشأ فيه الحالات من الأسباب نفسها ودائماً ما تقدّم الأعراض نفسها والنتائج التي تظهر بعد الوفاة والتشريح نفسها” (3).
هناك فرق كبير بين التفكير بشكل سريري، وتصنيف المتلازمات في هذه الطريقة والتفكير بها كما يفعل الدليل (DSM). وقد تم تصميم تصنيف الدليل السابق (DSM-IV-TR, xxiii) لغرض تحسين التواصل بين الأطباء النفسيين وعبر مختلف التخصصات أولاً ولغرض توفير قاعدة للتعليم ثانياً. ولكن لم يتم الإعلان عنه على أنه “نقطة القفز” لنظام ناضج من حيث تصنيف وممارسة سببية. وهذا يعكس التفسير الاختزالي للنموذج الطبي؛ ويوجّه البحوث التجريبية لكنه لا يكشف الهيكل السببي على الاطلاق.
ويترك الدليل (DSM) نفسه معرّضاً لتهمة أنه تصنيف مبني على جمع الظواهر التي يمكن مشاهدتها وتبويبها إلى فئات غير متجانسة، مع تنوع يستر تشابهات سطحية. ونحن نعلم بالفعل من مجالات الطب الأخرى أن ما يبدو مثل الظاهرة نفسها- السعال أو التهاب الحلق أو ألم الصدر، يمكن أن يعكس عمليات بيولوجية مختلفة، وبالتالي يعني ظروف مختلفة-. ويؤدي التصنيف الذي يعتمد على المحتوى ذو الخصائص السطحية إلى مخاطر إغراق الحالات المختلفة معاً وإبقاء العوامل ذوات الصلة متباينة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على هذا الاتهام من مقالات حديثة (أنظر ميرفي Murphy 2006 (الفصول 1-3) ومكنالي McNally. روس وآخرون Ross et al. 2008، 33-34، 200-01) إذ يقترح هؤلاء بعض التعديلات للفئة التشخيصية الحالية للمقامرة المرضية Pathological Gambling (انظر DSM-IV-TR، 671-74) بمعيّة أنها وضعت فئة المقامرة المرضية لتوضيح المفهوم الذي يعرّف، بشكله المبسط: المقامرة التي تسبب مشاكل للمقامر. إلا أن روس وآخرون (Ross et al.) بيّنو السبب على النحو التالي: إن التصنيف المتوفر الحالي “يتسم بخرائط سلسة نسبياً على عدد من الناس الذين يظهرون أنماط كلاسيكية من السلوك الادماني كنتيجة لنوع معين من الخلل الوظيفي في نظام المكافأة الدوباميني وما يترتب عليه من تنميط عصبي يضعف دوائر التحكم في فصّ الدماغ الأمامي. لذلك نعتقد أنه سيخدم… عن طريق استبدال المفهوم السلوكي من المقامرة المرضية مع المفهوم الراسخ بشكل علمي-عصبي للمقامرة الادمانية (200) “.
وأدى الحكم على الدليل بطبعته الخامسة (DSM-5) بأنه غير كافٍ للتحقق من صحة تصنيفاته، إلى قيام المعهد الوطني للصحة العقلية NIMH بإدخال نظام معايير للبحث Research Domain Criteria (RDoC) في مقترحات المنح (إنزيل وآخرون Insel et al. 2010). وأقرّ منظمو معايير للبحث (RDoC) بأن ما ترسخ في الطبعات السابقة من الدليل التشخيصي والإحصائي قد زاد الموثوقية في التشخيص. واعربوا عن قلقهم من أن الدليل مفصول جداً عن طبيعة العلّة العقلية، التي يتصورونها كاضطرابات في دوائر الدماغ: على الرغم من أن مجالات التحقيق نفسها محددة من الناحية النفسية. على سبيل المثال، بدلاً من الفئات المعمول بها حالياً مثل الاكتئاب، يتوخى نظام معايير البحث (RDoC) مجال التكافؤ السلبي الذي يتضمن أعراض القلق أو الاكتئاب المنظور إليها على أنها تعبير عن اضطراب كامن في دوائر دماغية محددة (سانيسلو وآخرون Sanislow et al 2010). ولكن من المتوقع أن تكون هناك نماذج مستقبلية للعلل العقلية، استناداً إلى هذه الرؤية، لكي ترسم على آليات نفسية وعصبية ووراثية، ناهيك عن معلومات في السياق الثقافي الأوسع نطاقاً. ويتوقع أن البحوث الحالية والتشخيصات المستقبلية سوف تستند على هذه النماذج لكي تكون مبررة بشكل صحيح حول الهيكل السببي للعلّة العقلية، وليس على العلامات والأعراض السريرية. ومن الواضح، في هذه الحالة، أن التحقق من التشخيص يفهم على أنه استيعاب للهيكل السببي الكامن: فسوف يكون التشخيص صحيحاً إذا اتكأ على عملية بيولوجية يمكن تحديدها من خلال التجربة والمشاهدة باستخدام وسائل العلوم البيولوجية والمعرفية.
وافترض روس وزملاؤه على منوال مناقشتهم للمقامرة، والتي يمكن اعتبارها مثالاً لنوع القضايا التي يتناولها فريق RDoC. ويعتقدون أن هناك فائدتان من التغييرات المفاهيمية التي يدعون إليها: أولاً، من شأن التوصيف أن يوفر لنا تحديداً أوضح وأكثر مبدئية لمدمني المقامرة بدلاً من مفهوم “مقامرين ذوي مشكلة” الذي يعمل به حالياً بصورته الاعتباطية (201). كما تبيّن الطريق إلى استيعاب أفضل لطبيعة اضطرابات الادمان عموماً من خلال استخدام النهج المفضل، والذي يجمع بين علم الأعصاب وبين الاقتصاد السلوكي. وتعتمد هذه المناقشات على أبحاث سابقة لها (الفصل 6.2) التي تقترح أن القمار الادماني يشابه التعوّد على المنشطات (مثل الكوكايين) أكثر مما يشابه الإدمان على الكحول، وبالتالي فإن استيعابنا للإدمان توسّع بشكل أكبر من المعايير السلوكية البحتة.
ولغرض إثبات هذه الحجج يفترض أن نميز المقامر المرضي حقاً، وهو ذاك المقامر الذي تهيمن المقامرة على حياته (أو دمرتها بشكل مثالي)، من المقامرين الذين تعوّدوا عليها فقط. إذ قد يخوض المقامرون المعتادون في المقامرة أكثر مما يشعرون بأنه ينبغي عليهم ذلك، أو أن يفقدوا مبالغ بشكل دوري أكثر مما يستطيعون تحمله، ولكن هناك فرق نوعي بين هذه الشريحة وشريحة المقامرين المدمنين بحق. ويتم الكشف عن هذا الاختلاف النوعي من خلال مراقبة السلوك وتقييم نتائج الاستبيانات. وعلى أي حال، إن قمنا بتصنيف المقامرين وفقاً للقياسات الكمّية فقط، فإننا سنفقد السبب الذي يدفع هذه الجماعات المتباينة أن تتصرف بهذا الشكل المختلف. والسبب عبارة عن عملية سببية. لأن أدمغة المدمنين بحق لا تعمل مثل أدمغة المضطربين قط. وإن مجرد التفكير في الإدمان من حيث السلوكيات المعتادة لا يسمح لنا بالتفريق بين المقامرين الذين اكتشف أن لديهم دليل علمي-عصبي.
وقدّم هورويتز وويكفيلد Horwitz and Wakefield (2007) حجة مشابهة ولكنها أقوى حيث ادّعوا أن هناك فرضية فقط لأسباب التمييز بين الشريحة الطبيعية من الأخرى المضطربة. وتبدأ بمعايير الدليل (DSM) لتشخيص الاكتئاب الشديد. لذلك يفترض على الشخص ليحصل على تشخيص “نوبة اكتئاب شديدة” أن يعاني من خمسة أعراض من أصل التسعة في مدّة أسبوعين فقط (بما في ذلك إما أن يكون المرء يعاني من مزاج مكتئب أو قلّة اهتمام أو استمتاع في جميع الأنشطة الحياتية تقريباً) وهي؛ المزاج المكتئب، قلّة اهتمام واستمتاع، زيادة الوزن أو فقدانه (دون اتباع نظام غذائي) أو تغيّر في الشهية، الأرق أو النوم المفرط، تخلف أو هيجان الجهاز الحركي-النفسي الملحوظ، التعب أو فقدان الطاقة، الشعور باللا جدوى أو بالذنب المفرط، قلّة القدرة على التفكير أو التركيز، أو عدم الحسم، والأفكار المتكررة حول الموت أو الانتحار أو تخطيط أو محاولة الانتحار.
من الواضح أن الكثير من وقائع حياة الإنسان الاعتيادية قد تسبب سلوكيات أو مشاعر من هذه القائمة، مثلما هو الحال في فقدان الوظيفة. إن المفهوم التقليدي للاكتئاب أو الميلانخوليا، ذا التاريخ المتقادم، يعود إلى عصور كلاسيكية غابرة (رادنRadden 2000)، فأن مآسي الحياة لا بدّ أن تنتج ميلانخوليا إن ترافقت مع سبب مثالي. وترى هذه النظرة التقليدية أن الميلانخوليا مرضٌ فقط حينما لا تبررها ردة فعل الحزن الطبيعية، أي “يعتبر الاكتئاب المرضي شكلاً مبالغاً فيه من ردود الفعل العاطفية للإنسان” (هورويتز وويكفيلد Horwitz and Wakefield 2007، 71).
على أي حال، يتجاهل الدليل التشخيصي والإحصائي (DSM) هذا التقليد. ويعتبر أي شخص تطابق صفاته متلازمة الاكتئاب يعتبر مستحقاً لتشخيص بغض النظر عن كيف كانت حياته تسير. ويستثنى التشخيص الوحيد من القاعدة تشخيص “الحزن بعد الفجيعة” حيث لا يعتدّ به لغرض تشخيص اضطراب الاكتئاب الشديد حتى ينقضي شهران بعد رحيل الفقيد، وبعدها يمكن استخدام تشخيص “الاكتئاب الشديد” له. وتوسّع فيما بعد نطاق تحليل هورويتز وويكفيلد (2012) ليشمل تشخيص اضطرابات القلق. حيث افترضا أن القلق البشري الاعتيادي قد جرى “تمريضه”، وأصبح من الواضح التمييز بين معايير التشخيص للقلق والاكتئاب من تلك المتعلقة بالاكتئاب وحده، مما أحدث صعوبة في تفسير لماذا الاكتئاب والقلق يحدثان سوية؟
خلال فترة تحضير الدليل الأخير (DSM-5)، اقترح عدد من الباحثين إلغاء استثناء “الحزن بعد الفجيعة”. وأثار هذا الاقتراح معارضة كبيرة واجتذاب أكبر للتعليقات السلبية (انظر زشار Zachar 2014، الفصل العاشر للاطلاع على ملخص للمناقشات). من وجهة نظر هورويتز وويكفيلد، يبدو أن المقترح عبارة عن “تمريض” ردة فعل إنسانية طبيعية. على أي حال، لم يكن الاقتراح أبداً أن تكون الفجيعة بحد ذاتها مرضيةً. وبدلاً من ذلك، كان الاقتراح يستند على فكرة أن أحداث الحياة العصيبة غالباً ما ترسب نوبات تستوفي معايير “نوبة اكتئاب شديدة”، ولم يكن هناك سبب لاستثناء الحزن بعد الفجيعة. وإن الكثير من الناس، بعد وفاة شخص قريب عليهم، تظهر عليهم أعراض مشابهة لما ينصّ عليه اضطراب الاكتئاب الشديد، والكثير منهم أيضاً يكون في خطر نوبات اكتئابية مكررة. من هذا المنظور، يبرر الغاء مقترح استبعاد “الحزن بعد الفجيعة” (كيندلر وآخرون Kendler et al 2007؛ لامب وآخرون Lamb et al 2010).
يشير هورويتز وويكفيلد إلى أن الاكتئاب الأصيل ناجم عن خلل وظيفي في جزء من نظام الاستجابة للخسائر الذاتي الذي تطوّر ليتصدى للخسائر المهددة بحرماننا من الموارد الإنجابية. وفي حالة الاكتئاب، فأن النظام يتشتت، ويسبب استجابة للخسارة في حالات لا ينبغي أن تكون بها استجابة. وسواء كانت الحجة التي أدلى بها هورويتز وويكفيلد مقنعة أم لا، فإن إشكال الخلط بين الاكتئاب والحزن يقف على مرتكزاته الخاصة. وإن افتراضهما أن مفهوم الدليل للاكتئاب لا يحترم المنطق النفسي الموروث ولا يحترم احصائيات الطب النفسي السابقة عن موضوعة الاكتئاب. وخلصوا إلى أن مفهوم الاكتئاب الذي تحدده هذه المتلازمة التشخيصية يمثل انقطاع مفاهيمي كبير. إن استخدامنا للمفهوم الجديد، كما اقترحا، يعني أن الكثير من الناس ممن هم في العادة بائسون لأسباب مفهومة وطبيعية يتم تشخيصهم باضطراب الاكتئاب. وهذا يقود إلى إنذار لا ضرورة له عن وباء الاكتئاب، ناهيك عن تحمل عواقب مؤسفة لكثير من الناس الذين يتم تشخيصهم خطأ. على أي حال، من المؤكد أن الأمر مفتوح للمنظرين المعارضين لاستبعاد “الحزن بعد الفجيعة” لغرض اصرارهم على أن الاكتئاب يأتي نتيجة نظام يشتته، وقد يشتت أيضاً في حال الفجيعة. وبالمحصلة فإن الاقتراح لا ينصّ على أنه ينبغي لمن يحزن أن تسمى حالته بالاكتئاب، ولكن هناك ردود فعل على الفجيعة لا تعدّ شديدة بما فيه الكفاية لتلتقي بمعايير الاكتئاب الشديد والذي يجب أن يصنف على غراره (للاطلاع على النقاش أكثر انظر زشار Zachar 2014، الفصل العاشر).
يجمع مفهوم الاكتئاب في الدليل (DSM)، في أحد اشكاله، أنواعاً نفسية وسلوكية مختلفة في الفئة الواحدة نفسها. ويفعل ذلك لأنه يهمل المسببات المتعددة التي تنتج علامات وأعراض مماثلة. ولا توجد طريقة للرد على هذه التهمة، أو للوصول إلى تصنيف مقنع يعكس ما متوفر في الطب العام، إلا إذا اعتمدنا على مرتكز سبيي لعلم تصنيف الأمراض كما اقترح الأطباء النفسيون الذين حثّوا على اعتماد ما يطلق عليه بالنموذج الطبي الشامل. وفي الواقع، من دون حساب للهيكل السببي الكامن، يصبح من الصعب إعطاء إجابة مبدئية على السؤال “لماذا يجب النظر إلى بعض الحالة على أنها مرضية للمضي بها؟”. ويجب أن نفهم هنا أن التصريح وحده بأن أفراد هذه الشريحة لديهم خصائص معينة لا يفهمنا ما إذا كان، ناهيك عن السبب، الذي اعتبرناهم به معتلين عقليين؟ وللإجابة على هذا التساؤل نحتاج إلى اساس لصنع الحكم. وإن الدليل (DSM)، كما لاحظنا، ينصّ على أننا نمتلك مثل هذا الأساس؛ وإن الاضطراب العقلي عبارة عن علامة ظاهرة للخلل الوظيفي. ولكن لإبداء هذه الحجة، نحتاج التزام لإيجاد خلل وظيفي في مكان ما على أساس الظواهر التي يمكن مشاهدتها. ولن تكشف المشاهدة وحدها عن الخلل الوظيفي دون الالتزام لفكرة أن هناك عملية عصبي-نفسية تدميرية تسبب الخلل الوظيفي الكامن. وبعبارة أخرى، فإن النموذج الاختزالي يستطيع فقط أن يجيب عن اسئلة العلاقة بين المصنف الفلاني وبعض المتغيرات الأخرى؛ ولن يفسر لماذا المصنف الفلاني له طبيعة خاصة به؟ أو لماذا ينبغي النظر إليه على أنه نوع من الاضطراب؟
لا ينطوي القيام بذلك على دراسة تجريبية للاضطراب العقلي حسب، بل تفسير شمولي للنموذج الطبي، مع التزام بالنظر للمرض على أنه عملية تدميرية وليس متلازمة فقط. من الممكن جمع البيانات باستخدام مفهوم (DSM) للاكتئاب، وخصوصاً المعلومات المتعلقة بعلم الإحصاء والتاريخ الطبيعي. وبهذا المعنى يمكن استخدام المنطق الطبي الاعتيادي، ولكن هناك الكثير من المنطق الطبي يتوجه بمحاولة لفهم الأسباب. وهنا نأتي إلى التفسير الشمولي، مع الالتزام بفكرة أن الاضطراب العقلي، مثله مثل أي مرض آخر، ليس محض بناء لتوجيه تحقيق معيّن حسب، ولكنه جزء أصيل من الهيكل السببي للعالم البيولوجي – كيان تدميري مع فسلجة مرضية مميزة تساعد على تفسير الظواهر المشاهدة التي يحتويها التفسير الاختزالي للنموذج الطبي.
2.3 التفسير الشمولي للنموذج الطبي:
يتفق مؤيدو التفسير الشمولي مع غوز Guze بأن هناك علل عقلية مستقلة مع أعراض مميزة وتواريخ طبيعية. ولكنهم يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك. فإن كان الطب النفسي حقاً فرعٌ من فروع الطب، فإنهم يشككون بأن تكون رؤية فرضيات سببية أكثر تحديداً حول الآليات المسببة لأعراض العلّة العقلية. لقد افترض كلٌ من أندريسين Andreasen وغوز Guze أن العثور على أسباب محددة للمرض تحتاج إلى فرضية أساسية لهذه الوظيفة الاعتيادية. وإن علم الأمراض النفسي يساعد على تحديده بأنه انفصال النظام النفسي من حالته المناسبة. (يجب أن نلاحظ ما يحسب كخلل وظيفي وغالباً ما يتم الاعتراض عليه في علم النفس وعلم الأعصاب. وعلاوة على ذلك، وجود خلل وظيفي لا يكفي للعلّة العقلية، ويتفق معظم الباحثين أن أفكارنا حول طبيعة المرض حساسة للشذوذ البيولوجي ولكنها أيضاً تسترشد بالأحكام التي شذوذها يعرقل ازدهار الإنسان (انظر كوبر Cooper 2007، مورفي Murphy 2006، سادلر Sadler 2004، ويكفيلد Wakefield 1992)، يرى النموذج الطبي أيضاً شذوذ أو اختلالات عند الضرورة ولكنه ليس كافياً للعلّة العقلية، وسيتم صياغة التساؤل هنا على النحو التالي: إلى أي مدى يستطيع الطب النفسي أن يتبنى التفكير الطبي حول العمليات البايلوجي-عصبية المسببة للأمراض؟).
يسعى التفسير الشمولي إلى شروحات تربط العمليات المسببة للأمراض في أنظمة الدماغ، تماماً كما يتم تفسير الأمراض الجسدية بعمليات الأعضاء الأخرى. ولا يشترط أن تكون العملية تدميرية، بمعنى أنها تؤدي إلى انهيار النظام. وكذلك لاحظ بولتون وهِل Bolton and Hill (2004، 252) أن الكثير من العلل العقلية تبدو وكأنها نتاج أنظمة غير منتظمة ومستقرة، وإن كانت دون المستوى الأمثل. وينطبق المفهوم ذاته على حالات ارتفاع ضغط الدم ومرض كوشينغ (فرط كورتيزول الدم الثانوي): حيث أن فكرة عملية تسبب الأمراض في الطب عموماً تشتمل على عدم الانتظام.
وافترض هاينريش وأندريسن Heinrich and Andreasen بما أن الدماغ عبارة عن جهاز معالجة معلومات، فإن نظرية المرجعية (background theory) الأكثر قبولاً هي علم الأعصاب الإدراكي. وجادل مفكرون آخرون بأن نظرية المرجعية الأكثر صحة في الطب النفسي هي نظرية البيولوجيا الجزيئية (كاندل Kandel 2005، الفصل الثاني).
وأعرب بولتون وهِل عن قلقهم من أن أياً كانت النظرية المرجعية التي يتبناها النموذج الطبي، فأنها تتطلب شروحات من حيث الظواهر البيولوجية أكثر من الظواهر المقصودة. وخلصوا إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن للطب النفسي البيولوجي أن يستوعب من الاضطرابات إلا تلك التي “نفد القصد فيها” (2004، 256). وإذا كان ذلك صحيحاً، فلا بدّ أن يستبعد استخدام النموذج الطبي لشرح الكثير من المرضيات النفسية التي يبدو أنها تنطوي على عمليات مقصودة أو ذوات مغزى ولا يمكن اختزالها (راجع ثورنتون Thornton 2007، الفصل الرابع). يستند هذا القلق على افتراض أن هناك تمييز لا يمكن القفز فوقه بين استيعاب ظاهرة في المصطلحات المقصودة وبين توفير تفسير سببي لها. وفي النهاية فإن الدماغ عبارة عن جهاز أدراكي، بل وجهاز اجتماعي أيضاً. حيث درست الكثير من التخصصات تأثير الإدراك السليم على السلوك، ولا يوجد هناك سبب لنتوقع أن الإدراك سيصبح فجأة غير ذي صلة لشرح السلوك حين ندرس العلّة العقلية. فعلى سبيل المثال، وجد كيندلر وبريسكوت Kendler and Prescott (2006، 148) أن “أحداث الحياة العصيبة” من بين أهم أسباب الاكتئاب الرئيسية، والتي تثير الاكتئاب خصوصاً إذا انطوت على خوض تجربة “الذلّ والإذلال” (160)، ولا يمكن بالمحصلة إعطاء الإذلال فحص التقليل الجزيئي (350). لذلك أطلق كيندلر وبريسكوت على الاكتئاب الشديد بأنه أحد أقدم التشخيصات في الطب (52) والذي يلتزم بإيجاد مسببات محددة. ومع ذلك، فقد كان هذان العالمان سعيدين بتبني فكرة “الهيكل العقلي الكلاسيكي” (350) كأجزاء من النماذج المسببة للعلّة العقلية.
وكما تقدم حتى الآن، فإن التفسير الشمولي للنموذج الطبي يتضمن مطالب لاستيعاب الأنظمة البيولوجية من حيث وظيفتها الطبيعية إن أردنا أن نفهم لماذا أصبحت غير طبيعية؟ وأفترض كينكيد Kincaid (2008، 375) أن الطلب بهذا النحو غير معقول، لأننا نستطيع إجراء بحث عن الاكتئاب (مثل ما ضرب كينكيد مثاله)، حيث أننا نقوم ببحث طبي بشكل أعمّ، على استيعاب سببي “جزئي وغير نظامي”. وقد حدّد كينكيد الطلب على نظرية المرجعية مع البحث عن “مخطط ربط بياني متكامل للكائن الحيّ من الإخصاب حتى النضوج” (377)، وكذلك حدّد أن البحث مع مفهوم العلم كبحث عن قوانين الطبيعة والأنواع الطبيعية. وكانت أسئلته تتضمن: ما نوع التوجه العام نحو الظواهر العقلية الذي يسمح به النموذج الطبي؟ وما أنواع الشروحات التي يمكن أن يقدمها؟ إننا لسنا بحاجة إلى نظرية كاملة عن كيفية عمل الأنظمة البيولوجية من أجل إجراء بحث مثمر. المسألة تكمن فيما إذا كان ينبغي، على أقل تقدير، أن تكون هناك بعض الأطر النظرية والمطالبات التجريبية المشتركة التي يمكن في إطارها تقييم نتائج وتحديد شاذّات أخريات.
يجب أن ندرك، في البداية، أن لا شيء في التفسير الشمولي يقصي الشروحات التي اعتمدت على العمليات الإدراكية في الدماغ: وحيث جادلت أندريسن (1997) أن الشيزوفرينيا والاكتئاب أمراض ادراكية ورأت الطب النفسي شكلاً من أشكال الطب و “أن الالتزام داخل علم الأعصاب الإدراكي يدمج المعلومات من جميع هذه التخصصات ذوات الصلة لأجل تطوير النماذج التي تفسر الخلل الوظيفي الإدراكي للمرضى النفسيين على أساس معرفة وظيفة الدماغ/العقل الاعتيادي” (1586). إن مفهوم الطب النفسي هذا بيولوجي بالكامل رغم أنه لا يلتزم بتفسير ميتافيزيقي معيّن لما يجب أن يبدو عليه الشرح البيولوجي. حيث يرى العلّة العقلية كنتيجة للعمليات المسببة للأمراض والتي تحدث في أنظمة الدماغ دون أن تجبرنا على اختيار شروحات كمسألة منطقية. لذا، فإن قلق بولتون وهِل، بشأن توافق النظرية الطبية مع قرينتها نظرية “التشفير العصبي”، يبدو مبالغاً فيه (2005، الفصل الثاني). بالرغم من أنهم على حق في التأكيد على أن الدماغ يمكن أن ينظر إليه على أنه جهاز اجتماعي، وعضو إدراكي، ولكن هناك مناصرين للنموذج الطبي الشمولي الذين يتفقون بشكل متساوي مع مفهوم علم الأعصاب. وتستشهد الممارسة الطبية والبيولوجية بالفعل العمليات التي تتجاوز مستويات التفسير (شافنر Schaffner 1993، 1994) وتضم معلومات بيئية عن عوامل الإجهاد أو عوامل الخطر الأخرى. وليس هناك -من حيث المبدأ- أي اعتراض على إضافة مستوى مقصود إلى المزيج. وأي مفهوم لأداء الجهاز العصبي الطبيعي يجب أن يأخذ معالجة المعلومات في الاعتبار، لأن معالجة المعلومات هو الدماغ بماهيته وكلّيته.
إن أغلب العلل العقلية قد نتجت من عوامل بيئية ووراثية متنوعة. لا نمتلك سبباً يجعلنا نعتقد أن هذه الأسباب المجتمعة قد وفرت تحليلاً مختزلاً، كما يشير شافنير، لغرض تحديد وقياس المتغيرات البيئية في الجانب الجزيئي البحت “سيكون مشروعاً طويل الأمد جداً” (1994، 287). ربما لا يزال المرء يعتقد أن العمليات الجزيئية هي الأسباب الجذرية للعلة العقلية حتى لو وجدت الكثير من العوامل المساهمة الأخرى والتي يتوضح سياقها ضمن عمل الجينات. يقدم كاندل Kandel (2005) نسخة صارمة جداً من هذا الرأي، والتي تحدد جميع البيانات التوضيحية للأسباب الوراثية القريبة على أساس أن “كل أنواع التريبة يعبر عنها في نهاية المطاف بالطبيعة “(39)” بمعنى أن العوامل السلوكية والثقافية تؤثر على الترميز الجيني، ويبدو أنه كان يعتقد أيضاً أن التفسيرات النفسية تحتاج إلى ترميز جيني لا أكثر، لأنها تقف قبالة كل شيء آخر.
إن اختزال كاندل الوراثي يعتبر موقف ميتافيزيقي يهدف إلى تحديد مستوى متميز في الطبيعة واستراتيجية تفسيرية عامة توّحد الظواهر وتقدم شروحات دستورية. على أي حال، الهدف من الشروح السببية في الطب الوصول إلى وسيلة. فإننا نبحث عن العوامل التي تحدث فرقاً في الحالة، لا مجرد مستوى ميتافيزيقي أو حساب موحد عام. ولا يوجد الكثير مما يدعونا للاعتقاد أن المنهج الاختزالي الذي يحث عليه كانديل مثمر جداً.
في دراسة اضطراب الشره المرضي، على سبيل المثال، نجد أن العوامل الاجتماعية تفسر أنماط ابدميولوجية معينة، مثل مستويات مختلفة من اضطراب الأكل بين الشرائح. إلا أن العوامل الاجتماعية لا تخبرنا لماذا تحصل فتاة واحدة فقط في الأسرة على الشره المرضي؟ لغرض شرح ذلك، يمكننا أن ننظر إلى كيمياء الدماغ التي تضع الفتاة على المحك (ستيغر وآخرون Steiger et al 2001). ولكن هذا لا يثبت أن علم الأعصاب أمر جوهري بحق. بل لنتفق، إنه لا يوجد شيء جوهري. وقد تتطلب الثقافة أو الصدمة تدخل بيولوجي ليكون لها تأثير مرضي، والعكس صحيح. فلا يجدر في المحصلة اعتبار أي من الاحتمالين جوهرياً، بل يجدر النظر إليهما على أنهما أفضل طريقة للإجابة على السؤال حول ما الذي يحدث فرقاً في السياق؟
هكذا ندرك لماذا تكمل المسببات البديلة بعضها البعض الآخر، بدلاً من أن تتنافس مع بعضها، كما ضرب ميهل Meehl (1977) مثالاً للرجل المسن، الذي كان يمتلك مقومات الإصابة بالاكتئاب وراثياً، وتطورت لديه بعد وفاة زوجته. فهنا يبدو من الخطأ أن ندعو هذه النوبة من الاكتئاب ناجمة عن الوراثة: فالجينات تحتاج إلى بيئة غير اعتيادية، وعليه ففي ظروف أخرى لن يكون هذا الرجل مكتئباً. لكنه لم يكن قد تطوّر لديه “الاكتئاب السريري” لو كانت جيناته مختلفة. بمعنى أن كلاً من العوامل ذوات الصلة مسببات.
وبسبب الضغط الحاصل لمعرفة ما الذي يحدث فرقاً في السياق، فإن الطب يعتبر موطن طبيعي لحسابات التلاعب بالسببية، كما رأى ويتبيك Whitbeck (1977، 627-28). وإن الفكرة الأساسية وراء منهج التلاعب يتمحور في الوضع الذي يسمح لنا أن نبدأ في شرح ظاهرة “عندما نحدد عوامل أو ظروف، فإن التلاعب أو التغيير في تلك العوامل أو الظروف من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات في المحصلة التي يتم شرحها ” (وودوارد Woodward 2003، 10). قد يكون لدينا ارتباط – كما بين التدخين وأمراض القلب-. فننطلق من هناك إلى شرح سببي إن استطعنا التدخل من أجل التلاعب في قيمة المتغير السببي في حد ذاته – عن طريق وقف مجموعة من التدخين والسماح بمجموعة مماثلة أن تدخن، على سبيل المثال. فإن كان التدخين يسبب أمراض القلب، سوف نرى تأثيره على متغير السرطان الذي يعكس تدخلنا مع المدخنين. وإن كان التدخين لا يسبب أمراض القلب، لن يكون هناك علاقة بين المتغيرين. (هذا الرأي متوافق مع العديد من المقترحات حول الميتافيزيقيا الكامنة، انظر سبيرتيس وآخرون Spirtes et al 2000، بيرل Pearl 2009).
انشقت نظرية كاندل الجزيئية-الاختزالية من هدفها المنشود، من وجهة نظرة التلاعب. فقد راهن كاندل أن التفسير الجزيئي يختار مستوى الطبيعة المفضل لديه. ويفترض أنه كلما تعلمنا المزيد سيكون بمقدورنا أن نجهز شروحات أساسية على هذا المستوى. بل ويدعونا كاندل إلى التخلي عن المنهج المثمر لصالح صكوك سماح! في وقت لا يوجد لدينا سبب يدعونا إلى دفعها. ولا يبدو أن الشروحات الجزيئية تزدهر لوحدها بين مجموع المناهج الممكنة للعلة العقلية (كذلك يشير شافنر Schaffner (1998) إلى مدى صعوبة تقديم شروحات اختزالية بالنسبة للكائنات النموذجية البسيطة).
في الوقت الذي اتخذت فيه الأمور منعطفاً غير ما كان يتوقعه كاندل، إلا أنها لم تكن واضحة للعيان، استناداً إلى ما لدينا من ذخيرة من أصناف الشروحات النفسية. على أي حال، يبدو أن النموذج الطبي لا يتطلب أي مستوى من التفسير. بل يبدو أنه يعلّم، في تفسيره الشمولي، من خلال البحث عن تفسيرات شكل معيّن ما قد يشتمل على مستويات مختلفة كثيرة. هذه التفسيرات تبيّن كيف أن أعراض العلة العقلية تعتمد منهجياً على تشويش في الأداء الطبيعي للعمليات البيولوجية والمعرفية. وبذا يراهن التفسير الشمولي على التفسيرات المتاحة، والتي تدّعي، أنها مفيدة سريريا عندما يتم الكشف عنها نهائياً. وبالنسبة الى احتمال أن تمنح التفسيرات شكلاً واحداً من أشكال التفسير مسألة اعتباطية يمكن الإجابة عنها حسب الحالة. ومع ذلك، يميّز الطب النفسي حالياً الكثير من العوامل السببية المختلفة، ويجب أن نتوقع له الاستمرار. وإن طريقة واحدة نصرف بها هذه الفكرة من خلال القول أن الطب النفسي يولي اهتماماً خاصاً لمستويات متنوعة للكثير من التفسيرات. والتي سوف نقوم بتناولها، في الفصل القادم.
-
التفسير
3.1 مستويات التفسير
لنبدأ برأي مألوف لأحد فلاسفة علم النفس ومنه ننطلق؛ ميّز الفيلسوف مار Marr (1982، 24-5) بين ثلاثة مستويات من التفسير في العلوم المعرفية: وخصص التفسير الأعلى للمهمة الحسابية التي تنجز بواسطة نظام الفائدة. أما المستوى الوسطي فأنه يصف التمثيل الفعلي والخوارزميات التي تنفّذ الهدف. ويخبرنا المستوى الأدنى كيف ترتكز أنسجة المخ والمواد الأخرى، مثله مثل أجزاء الآلة الأخرى، في كيفية إدارة الخوارزمية. وهنا يجب أن تلاحظ –عزيزي القارئ- أن مستويات وجهات النظر المختلفة ترتكز على العملية العقلية نفسها – إذ إن فكرة مار عن الرؤية باعتبارها هيكل تمثيلي ثلاثي الأبعاد من مدخلات ثنائية الأبعاد، وإن هذه المستويات الثلاثة عبارة عن طرق مختلفة لفهم الهيكل الذي بواسطته يمكن أن نفهم الظواهر المعرفية الأخرى.
وسعى مار إلى فهم القدرات النفسية دون أن يخاف بشأن موضوع البيولوجيا: على الرغم من أنه افترض أن القدرات يمكن أن تتحقق في تنصيب مادي، واقترح ان هذه التفاصيل لن تحدث فرقاً في الطريقة التي يستوعب بها علم النفس. ولكن مثلما أصبح علم “العقل” مهتماً بالدماغ أكثر، نستنتج أن هذه الفكرة ربما تحتاج إلى تعديل. ويمثل علم الأعصاب الإدراكي تعلّم البحث في البنى المادية داخل الدماغ التي تنفذ وظائف معالجة البيانات، أو ما يطلق عليه غلايمور Glymour (1992) بمصطلح “الأجزاء المعرفية”. إن استيعابنا للحقيقة البيولوجية يرتدّ من جديد ويكبل استيعابنا لعمليات الإدراك الملخصة (بكتيل وريتشارسون Bechtel and Richardson 1993). وبدلاً من ربط بعض القدرات النفسية مع بعضها، يربط وصف المستوى الأعلى من العقل/الدماغ في علم الأعصاب الإدراكي جميع القدرات لأجل أن نفهمه كوصف وظيفي لمناطق الدماغ المتعرجة. وإن نظريات النظام العادية تحدد طبيعة وترابط أجزاء المعرفة. أما الأطباء النفسيون فأنهم يشتكون من هذه الافتراضات، ويرون الاضطراب كانهيار في الوظيفة الطبيعية داخل الأجزاء المعرفية وبينها. ويبدو مستوى مار Marr الأول مفيداً كمصدر للنظرية المرجعية لما يفعله الطب النفسي، لأنه يسأل “ما الغرض؟” وإن الكثير من مفاهيم الطب النفسي حول معرفة الأنظمة النفسية تفشل في الغرض الذي عليها القيام به.
وعلى أي حال، ما زلنا نواجه مسألة كيف يرتبط العجز النفسي بمستويات التفسير الأخرى، وهنا تأتي صورة مار تحت ضغط حقيقي. تمثل مستويات مار الثلاثة تمثيلات مختلفة من العملية نفسها. ولكن مستويات مختلفة في الطب النفسي تمثل عمليات سببية مميزة. على سبيل المثال، تشتمل أسباب الكثير من العلل النفسية مزيجاً من الجينات والعوامل البيئية، كما الحال في مثال ميهل Meehl، المذكور آنفاً، لتآمر كل من الوراثة والفجيعة في التسبب في الاكتئاب. فالجينات والعوامل البيئية هي في النهاية عمليات، وعمليات مختلفة جداً، لا مستويات مختلفة لعملية واحدة. وإن كنا نتعامل مع عملية واحدة، موصوفة بأشكال مختلفة، نكون قد استعجلنا حساب مختزل، حيث يتم تعيين متغيرات مستوى عالي على متغيرات من مستوى أدنى منها. ولكن على الرغم من أنه من الصعب بما فيه الكفاية أن نتخيل تخفيضاً جزيئياً أو عصبياً في بنية نفسية مثل الإذلال (الذي سبق أن أشرنا إليه كمسبب للاكتئاب)، فمن الأصعب أن نتخيل تحليل مختزل للعوامل الاجتماعية والثقافية مثل البطالة أو العنف الجنسي عند الأطفال. فأنها تمتلك آثار دماغية، غير أن آثار الدماغ هذه تختلف عبر الأفراد بطرق تعتمد على سياقات بيئية ووراثية أخرى (انظر كيندلر وبريسكوت Kendler and Prescott 2006 لمراجعة شاملة).
يقترح شافنر Schaffner (1993، 1994) أن هذا التركيب عبارة عن أساس لكل أشكال البيولوجيا، كما ويراه يجمع الأسباب والنتائج خلال مستويات تفسير مختلفة. حتى الاعتراض على مستويات التفسير هذه لا يمكن معارضتها إن كانت تشتمل التذكير بأننا نحتاج إلى ربط المتغيرات في أنواع كثيرة. إلا أنه لم يكن من الواضح أننا نمتلك أسس مبدئية لفرز الظواهر إلى مستويات. مع إن الفيلسوف مار امتلك، وقد كانت مستوياته المتخيلة تصف العملية ذاتها (هيكل الصورة ثلاثية الأبعاد من الحزم الشبكية ثنائية الأبعاد) وتصوغها في مفردات العلوم المختلفة. لكننا حين نتحرك خارج نطاق الدماغ ونبدأ بتقديم عوامل بيئية وأسباب من نوع آخر، تبدو الصورة التي رسمها مار أقل عقلانية.
هناك طريقة أخرى في المستويات التي تتحدث عن الفلسفة الحديثة للطب النفسي باعتبارها قيد على أنواع مسموح بها من التفسير. وقد تصوّر كريس فريث Chris Frith (1992، 26) على سبيل المثال، ما الذي يمكننا أن نجيب به إن استطعنا إيجاد علاقة متينة بين ارتفاع مستويات الدوبامين وأوهام الأفكار الدخيلة (حيث يشعر الشخص الذي يعاني من الأفكار الدخيلة بأن أفكار شخص آخر قد دخلت إلى عقله الخاص). وأفترض كريس فريث أن مثل هذه العلاقة “غير مقبولة ببساطة” كتفسير لأننا سوف نبقى في العتمة حول سبب الزيادة الفجائية في الدوبامين نتيجة الأفكار الدخيلة دون سواها. ولغرض فهم لماذا تظهر الأفكار الدخيلة، يعتقد فريث أننا نحتاج إلى قصة إدراكية ليتوضح لنا كيف نتجت عبر إخفاقات معالجة الشخصية الاعتيادية.
فكرة فريث عن التفسير السببي للظاهرة الذهانية، أو لأعراض عقلية أخرى، يجب أن تضع المتغيرات الإدراكية بشكل صحيح لتكون تفسيرية. وهذا يعني أن التفسيرات تتصل بمتغيرات من المستوى نفسه. إن العلاقة بين الدوبامين والأفكار تبقى علاقة مبهمة تماماً لتجيب عن السبب، ولو أردنا للمتغيرات التي ترتبط بطرق شفافة أن تجيب. نجد أن هناك قيود؛ في الفكرة القائلة بأنه لا بدّ لتفسيرات الظواهر النفسية أن تربط السبب والنتيجة بطريقة نستطيع فهمها. كذلك هاجم كامبل Campbell (2008) هذه الصورة، حين نوّه أن الحديث عن مستويات التفسير غالباً ما تتحرك من هذا المنطلق، كما قال فريث، لتوفير علاقات شفافة لتجيب بشكل صحيح.
يحتدم الجدال بسرعة هنا حين يدخل في حيز النقاش التقني حول مفهوم السببية. فلا يخبرنا نقاش كامبل الذي يناقض فريث ويقف مع فكرة هيوم في ألا نتمكن ببساطة من تحقيق مسبق لما له علاقة سببية لما يحدث في الطبيعة. وإن “أي شيء” يمكن أن يسبب “أي شيء”، ولا يوجد مبرر لألا نفترض أن المتغيرات التفسيرية المتعلقة بالذهان أو العوارض العاطفية مردّها معرفي كما اعتماد مفهوم الاختزال وأصرّ على اعتبار مردّها بيولوجي. وقد أظهرت عقود من البحث أن العلّة العقلية نتجت من، وتنتج بدورها، الكثير من العوامل الجسدية والنفسية والاجتماعية المختلفة. وعلينا ببساطة أن نأخذ علاقاتنا السببية حيث نجدها، بما في ذلك العلاقات المتداخلة. ومن ناحية أخرى، يناقش كرافر وبكتالCraver and Bechtel (2007، 554) امتداد مفهوم السببية إلى نقطة انقسام للاعتراف بالأسباب المتداخلة: إنهم يصرحون “لأجل قبول العلاقات المتداخلة كسبب ينتهك الكثير من الأفكار المركزية المرتبطة بمفهوم السببية “. وكذلك ناقش كرافر وبكتال من منظور التفسير الآلي. وفسروا آليات النتائج من حيث الأجزاء المتشابكة، والعلاقة بين المستويات، كما يؤكدون، هي واحدة من القوانين لا الأسباب؛ يمكن أن تكون السببية داخل المستوى. وعلى هذا المنوال، نصل الى شيء يسبب نفسه، لأن المستويات المختلفة هي طرق مختلفة للحديث عن الشيء ذاته. ومع كل ما سبق، فالحديث عن المستويات في الطب النفسي ينطوي على ربط أجزاء مختلفة من العالم، مثلما الحال في مثال ميهل: الذي ينظر إلى الوراثة والحزن بعد الفجيعة على أنها تتطلب مستويات مختلفة، لا طرق مختلفة لوصف العملية نفسها.
في جزء معيّن مما سبق نجد أن مستويات الطب النفسي لا تعتمد على ما أفترضه مار، ومثل هذه الأطروحة ناقش كامبل (2006) المنهج التدخلي للسببية. ففي هذا الرأي حين نقول (س) هو سبب (ص) نعني أن التدخل على (س) هو وسيلة للتدخل على (ص) (وودورد وهيتشكوك Woodward and Hitchcock 2003، وودورد Woodward 2003، بيرل Pearl 2000): بمعيّة أن التلاعب في متغير واحد يحدث فرقاً في الآخر. وليس هذا تحليل اختزالي للسببية، بما أنه يستعمل من الأفكار السببية، فهو يشير فقط إلى أن التساؤلات حول ما إذا كانت (س) سبب (ص) هي أسئلة حول ما الذي يحدث لـ (ص) إذا كان هناك تدخل على (س). كندلر وكامبل Kendler and Campbell (2009) افترضا أن النموذج التدخلي يعطي شكلاً صارماً للتعبير عن فكرة أن أي مجموعة من المتغيرات قد تصف أسباب الاضطراب، والذي يعطي في الوقت نفسه اختباراً واضحاً للمتغيرات التي تنطوي عليها فعلياً، وبالتالي تجنب الفكرة الشمولية البسيطة التي تقول أن الكثير من الأشياء ذات الصلة. كما لاحظا (2009، 997) أن المنهج التدخلي “يسمح بالفصل الواضح للنتائج السببية الناجمة عن التنصيبات الآلیة لتلك الآثار”، مما تدحض المنهج الذي تبناه كرافر وبكتال Craver and Bechtel.
قد يكون التجاذب مع مستويات التفسير في الطب النفسي مجرد تذكير بأننا بحاجة إلى ربط متغيرات أنواع كثيرة من أجل شرح أسباب الاضطراب. ولكنها يمكن أن ترتبط مع وجهات نظر معينة بشأن الاختزال والتفسير والسببية. لن ندخل في هذا الإشكال أكثر هنا؛ بل سنناقش مشكلة أخرى. إذ بالإضافة إلى الاختلاف الكبير في العوامل السببية، يواجه الطب النفسي مشكلة الأعراض المتنوعة أيضاً. فإن الكثير من الأمراض النفسية تتخذ أشكالاً مختلفة في مختلف الأفراد. وبالرغم من أن اثنين لديهما تشخيص الاكتئاب الشديد على حد سواء، فإنهما يتشاركان أعراض قليلة: ربما يشعر كلاهما بحالة بائسة وفقدان الاهتمام بالأنشطة الاعتيادية. لكن مع ذلك، يمكن لأحدهما أن يفقد الوزن، وينام قليلاً ويكون مهتاج جسدياً في حين ينام الشخص الآخر أكثر ويكون خاملاً ومكبّل بمشاعر الذنب وأفكار الانتحار. لذا تبزغ المشكلة الفلسفية من المواجهة بين الاختلاف العظيم في الواقع السريري والحاجة إلى التبسيط لغرض جعل هذا الواقع قابل للتوظيف علمياً. وباختصار، فإن المشكلة بمجملها هي؛ ما الذي نحاول أن نشرحه حينما نشرح العلة العقلية؟ هل هي مجموعة مختلفة من ظواهر العالم الحقيقي؟ أم هي تمثيل مبسط لهذه الظواهر؟
3.2 الاضطرابات باعتبارها شبكات إحصائية:
إحدى طرق البدء في التفكير بما يجب توضيحه في الطب النفسي هو الاستعارة من الفلسفة ثاغارد Thagard (1999، 114-5) باعتبار الأمراض شبكات “علاقات سببية مرتكزة على الاحصاء” والتي يتم اكتشافها باستعمال الوسائل الابديميولوجية والتجريبية. تتوافق هذه الصورة مع صورة كندلر وبريسكوت Kendler and Prescott حول الاكتئاب بدقة كبيرة (على الرغم من أن نماذجها مصممة لدمج العلاقات السببية بين المتغيرات والارتباطات). وتوفر شبكات ثاغارد الإحصائية السببية -مثلما وفرت نماذج كندلر وبريسكوت- نوعاً من الشرح السردي لموضوع “لماذا يصبح المرء مريضاً؟” (ص15). تتضمن هذه الشروحات معلومات عن المسار النموذجي للمرض التي تكتشف مع مرور الوقت، بما في ذلك المعلومات حول عوامل الخطر النموذجية للمرض، كاكتشاف استعمال الأسبرين المفرط يساعد على زيادة إفراز الأحماض المسببة لقرحة الاثني عشري. ولا تحدد الشبكة السببية كيف ينتج كل عامل سببي تأثيره، بالرغم من أنه نموذج وصفي حقيقي يساعدنا على طرح التساؤل: ما الحقائق التي تجعل إصابة الناس بهذه الطرق صحيحة؟
لدينا في النتيجة مجموعة من التعميمات المعرضة للاستثناء حول المسارات التي يتخذها الاضطراب: بعبارة أخرى لا يصبح الناس مكتئبين ما لم يكون هناك مثل هذا التدخل. وعندما يكونوا مكتئبين، سيخوضون على الأرجح التجارب التالية، إلا إذا كانت لديهم أموراً أخرى. فكرة ثاغارد السردية مفيدة هنا؛ تمثل النماذج قصص مثالية حول الطرق المميزة ليصبح الشخص مريضاً. ولكن السرد بحد ذاته لا يفسر شيئاً؛ وإن كان تفسيري، فذلك لأن الأحداث المذكورة في السرد آنفاً تلتقط أسباب الأحداث اللاحقة.
قدمت راشيل كوبر Rachel Cooper (2007) طريقة للتفكير في التفسير النفسي تتناسب مع فكرة أن التشخيص يتيح لنا أن نسرد قصة. إذ غالباً ما نجد أنفسنا نتفق مع القصص التي تتحدث عن الكيفية التي يصبح بها المرء مريضاً، ربما يكون السرد مفيداً إن عزلنا متغيراته السابقة مؤقتاً واتيح لنا معرفة كيف تعتمد الظواهر اللاحقة عليه. ودافع الكثير من المنظرين عن فكرة أن الاضطرابات النفسية عبارة عن أنواع طبيعية. حتى إن هناك تعاملات فلسفية حديثة قد رفضت فكرة أن يكون للاضطرابات النفسية جوهر، ولكنهم دافعوا عن فكرة أن الاضطرابات النفسية هي أنواع طبيعية في منظور بويد Boyd عن تكتلات الملكية التماثلية (بيبي وسبارتون ليري Beebee and Sabbarton-Leary 2010؛ كيندلر وآخرون Kendler et al. 2010؛ بارناس وآخرون Parnas et al. 2010؛ سامويلز Samuels 2009، زاكار Zachar 2014)، التي تحدث فيها خصائص مجتمعة وموثوقة بما فيه الكفاية، لكي تدعم استدلالات التضخيم، حتى لو كانت الآليات المسؤولة عن هذا النوع لا تعامل كل عضو منها كأي عضو آخر. عندما يعمل الاستدلال الاستقرائي، من منطلق بويد، فهو يعمل لأننا نربط الآليات السببية التي تجلب التكتل. وتتعقب الاستقراءات الناجحة المظاهر المشاهدة للآليات السببية المسؤولة عن خصائص هذا النوع. قد ندّعي أن الآليات تترك توقيعاً سببياً محدداً في العالم. ويبدو أن هذا الحساب يتناسب مع الاضطرابات العقلية. وغالباً ما تختلف عبر الحالات، مع غياب أعراض مميزة حتى حين يعرض المريض مجموعة مثالية من العلامات والأعراض. لذلك نفهم لماذا المنظرين المتعاطفين مع النموذج الطبي في الطب النفسي ينبغي عليهم أن يوجهوا أنظارهم إلى فكرة التكتلات الملكية التماثلية.
3.3 من التاريخ إلى الأسباب:
تميّز كوبر التفسيرات القائمة على التاريخ الطبيعي من دراسات الحالات. وتقدم لها أنواعاً متميزة من التفسيرات النفسية، لكنها لا تدخل في تفاصيل ما يمكن أن تكون عليه الأنواع الأخرى، لذلك موقفها العام يصعب الإمساك به. إلا أن هناك فكرة واحدة واضحة جداً؛ على الأقل بعض العلل العقلية هي أنواع طبيعية، وتفسيرات التاريخ الطبيعي تعمل من خلال “استدعاء أنواع طبيعية” (2007، 47). وبمجرد أن نعرف أي نوع ينتمي إليه الكائن، يمكننا أن نفهم ونتنبأ سلوكه اعتماداً على عضويته: ويمكن أن نتنبأ أيضاً لماذا تتوسع المادة بعد تسخينها لو تذرعنا أنها تحتوي القليل من المعدن. أو يمكننا أن نتنبأ إن ترك الكلب في المطبخ مع قطعة لحم مشوية دون رقيب فكرة سيئة، لأن التفاعل بين الكلب واللحوم يأخذ شكلاً يمكن التنبؤ به. ومن المأمول، يمكننا أن نفسر لماذا تسمع لورا الأصوات تناديها بمعيّة أنها تعاني من الشيزوفرينيا. وإننا ندرك أن تصرفاتها الذهانية (التشاؤمية) ستنبئنا بما تؤول اليه حالتها.
كذلك تحدثت كوبر عن تواريخ الحالات وافترضت أن تفسير الوضع الفريد لشخص من خلال الاعتماد على رسم استيعابنا لذهنية أفراد آخرين. واشتمل هذا الادعاء على التزامات في تفسير نظرية العقل (التي من شأنها أن تضللنا بعيداً عما نحاول الوصول إليه). العلاقة بين علم النفس المتعارف عليه وتاريخ الحالات علاقة غير مستكشفة، كما الحال في طبيعة الاستدلال من الحالات عموماً: ربما نحن نفتقر إلى حساب معتدّ لما يفسر تاريخ الحالة أو ما معتدّ بخلاف ذلك، في الطب النفسي أو في أي مجال آخر (ويشير فورستر (1996) Forrester إلى أن الاستدلال مع الحالات يبدو نموذجاً مميزاً ومتميزاً في العلم وفي أي مكان آخر، ولكن لا يوجد لدينا حساب معتد لذلك). حتى الآن، يجب أن نضع تواريخ الحالات جانباً ونمضي.
واكدت كوبر أن تفسير التاريخ الطبيعي يحتاج إلى استشهاد أنواع طبيعية إن كان الاستشهاد مفيداً. ولكن لغرض عمل التفسيرات لا نحتاج إلى الاستشهاد بآليات السببية الفعلية المسؤولة عن سلوك أعضاء من نوع معيّن. فإننا نعلم أن الكلب سيلتهم قطعة اللحم المشوية إن تركناه معها في المطبخ، ويمكننا أن نكوّن تنبؤ على الرغم من الجهل الكليّ لفسلجة الكلاب. يقدم تاريخ الطب النفسي عدداً من الحالات التي دعت علم الأدوية إلى تمييز أنواع جديدة حتى في غياب المعرفة السببية المفصلة. إن اكتشاف كايد Cade (1949)، على سبيل المثال، في أن عقار الليثيوم يمتلك ردة الفعل العصبية وغيرها من أشكال العصاب في خنازير غينيا كان مفيداً حتى من دون معلومات معتدّة عن علم الأعصاب المعرفي الكامن وراءها، لأن ذلك قاد إلى التنبؤ بأن كل ما يحدث قد ينطبق على البشر أيضاً.
يعطينا استدعاء الأنواع سلطة على العالم، من خلال جعل من السهل التنبؤ والتحكم والتخفيف من العواقب التي نهتم بأمرها. وسنستطيع أن نسأل سؤالنا الفلسفي الوحيد، بطبيعة الحال، فيما إذا كان العلم يريد أكثر من ذلك. وإذا اعتقدت أن العلم يهدف إلى الاكتفاء التجريبي، فحينها سوف يبدو أن فرز المرضى إلى أنواع كافي جداً، شريطة أن نستطيع استيعاب مسار المرض.
تلائم تفسيرات التاريخ الطبيعي، على وجه الخصوص، مفهوم الأمراض باعتبارها متلازمات تتكشف مع مرور الوقت ومن ثم توّثق في كل من الدليل التشخيصي والاحصائي (DSM) والتفسير الاختزالي من النموذج الطبي. وهذا لا ينكر أن هناك عمليات سببية، إلا أنه يرى العلل العقلية كمجموعات أعراض وعلامات مع تواريخ مميزة لها. وهذه تعتمد بدورها بلا شك على العمليات الجسدية ولكنها لا تتحدد ولا تصنف من الناحية المادية قط. وتذهب صورة المرض هذه طبيعياً بجانب توظيف تفسيرات التاريخ الطبيعي، لأنها أيضاً تستدعي أنواع طبيعية دون القلق حول الآليات التي تفسر سلوك أعضاء هذا النوع. ويكفي أن نكون قادرين على تحديد عضوية النوع، الذي سوف يمنحنا درجة من السيطرة التفسيرية والتنبؤية.
تتلاءم تفسيرات التاريخ الطبيعي، بإتقان، شبكة المرض التي اقترحها ثاغارد. فإن زوّدت شبكة مرضية حساباً سردياً عن سبب إصابة الناس بالمرض، وتوقعت بعض النتائج، سيكون باستطاعتنا أن نرى أنها تمثل رسماً تصويرياً للمسار التاريخي المثالي لنوع ما. وكذلك يتلاءم الكثير من النتاج الابديميولوجي في الطب النفسي النمط هنا؛ ونحن نحاول عزل العوامل السببية التي تحدد تاريخ المرض من تلك التي يمكن الايفاء بها. وتظهر التواريخ هذه العلاقات بين المتغيرات التي تبين كيف تعتمد الظواهر القادمة، مثل أعراض الاكتئاب أو تعاطي المخدرات، على الظواهر السابقة، مثل الجينات التي ولدت معه، أو اعتداء الوالدين الذي تحملها.
وخلافاً لبعض الأمثلة الكثيرة، يمكن أن يكون التاريخ الطبيعي المكشوف خلال البحث المنهجي تفسيرياً بشكل صميمي وفجائي تماماً. ولكن (كما يوحي ثاغارد وكوبر على حد سواء) أنها تتركنا مع الكثير للقيام به. مهما قال فلاسفة العلوم عن مدى كفاية التجريب، فقد قضى الأطباء قرناً ونصف باحثين عن تفسيرات سببية للظواهر المرضية (كارتر Carter 2003).
3.4 الاستراتيجيات التفسيرية السببية
تقترح كوبر Cooper أن تفسيرات التاريخ الطبيعي تزودنا بما يسميه مورفي Murphy (2006) بـ”التمييز السببي”، بدلاً من “الفهم السببي”. نستطيع أن نعرف نوعين مختلفين سببياً حتى إن لم نكن ندرك السبب في كونهما مختلفين، لأن تفاصيل البنية السببية الكامنة تتملّص من بين أيدينا. نحتاج أن نضع أنواع مختلفة من النباتات في الأرض في أوقات مختلفة، أو في مواسم مختلفة، من أجل أن نزيد غلّة المحاصيل، فعلى سبيل المثال، نستطيع أن نتنبأ بدقة أن هناك مرضى مختلفين يستجيبون لأدوية مختلفة حتى إن كانت القاعدة التي تقف عليها هذه الاختلافات لا تزال غير معروفة. إلا أننا نفترض أن هذه الاختلافات تستند على بنية سببية كامنة. في الطب النفسي، يتبع التشخيص التفريقي منطقاً مشابهاً، ولكن المتشككين يتساءلون عما إذا كانت درجة الاختلاف تجعلنا تنبؤاتنا غير موثوقة للمنهج المعمول به حقاً.
يضع هذا التفسير الكيانات في أنواع، وبالتالي يتتبع العوامل السببية غير المعروفة حتى الآن من خلال جعل النوع ذاته من الاختلاف في المرضى في التقسيم نفسه. وبدلاً من تحديد العوامل السببية، فإن منهج التاريخ الطبيعي يتتبع عمل الأسباب غير المعروفة حتى الآن، من خلال فرز المرضى إلى أنواع بافتراض طبيعة مشتركة بينهم، استنادا إلى التاريخ الطبيعي لظروفهم، أو استناداً لأسس أخرى لم يتحدث عنها، مثل الاستجابات الاختلافية للعقاقير.
إن مهمتنا التفسيرية الكاملة تتمثل في شرح الشبكة السببية-الإحصائية المشاهدة من خلال تحديد الآليات والقوى الأخرى التي تؤدي إلى ذلك، بمعنى، الهيكل السببي للاضطرابات. وإن المشكلة، بالطبع، في التنوع الهائل للظواهر، التي لا تعطينا درجة الأمان الابستيمي الذي نحصل عليه عندما نصنف الظواهر إلى أنواع في العلوم الأخرى. هناك طريقة واحدة لجعل هذا التنوع قابل للتتبع، من خلال اقتراح منهج التاريخ الطبيعي، الذي يبحث عن بعض الظواهر المستقرة التي لا تختلف. ومن غير المرجح أن تتوفر في مستوى التشخيصات، لأنه في حالات كثيرة هناك سيظهر شخصان يمتلكان التشخيص عينه لكنهما يبديا سلوكيات مختلفة وأعراض أخرى تبعاً لحياتهما الشخصية، وخلفيتهما الثقافية، وعللهما العقلية الأخرى. وهناك الكثير من التنوع في مستوى التشخيص. لذلك يتحتم علينا البحث عن وحدات أصغر من التفسير.
يمكننا الاعتقاد في هذا المنهج الأول مثلما نفحص عن قرب على جزء صغير واحد من الشبكة الشاملة، باحثين عن شيء يمتلك ما يكفي من الاستقرار عبر التواريخ للسماح للتفسير الذي فيه علاقات السبب-النتيجة. إن كان الهيكل السببي متنوع جداً، فنحن نبحث عن وحدات سببية تتكرر بثبات بين المرضى، ونشرحها، ثم نضع هذه الأجزاء المفهومة سوية لتفسير الأفراد. وربما هناك ميزة أخرى لهذا المنهج في التعهد بعلاج المرضى كأفراد عوضاً عن تجميعهم سوية في أنواع متلائمة تقريباً لا أكثر.
ويتجلى منهج الفحص عن قرب (Zooming-in) لدى بنتال Bentall (2005) وسبولدينغ وآخرون Spaulding et al (2003). إذ يبحث كلاهما عن الوحدة الأصغر للتفسير أو التلاعب المعتدّ به. وافترض سبولدينغ وزملاؤه من منظور سريري لأجل رؤية المرضى بشكل مجموعات من “المشاكل”، وتستمد هذه المشاكل في كل حالة من ذخيرة ظواهر مأخوذ بها سريرياً لتجلية مرضى مختلفين بطرق مختلفة. كما ويرى بينتال أن تشخيصات مثل الاكتئاب أو الشيزوفرينيا تثبت عجزها في مواجهة التنوع الذي يظهره المرضى. ويجد أن الحالات الفردية شبيهة بالفسيفساء التي تكوّن أعراض متكررة مثل الهلوسة، والتي يمكن فصلها ودراستها بمعزل عن بعضها بعضاً. ووفقاً لهذا المنظور أيضاً، لا يوجد شيء مثل الشيزوفرينيا. ليس لأنه لا يوجد خطأ في حالة الشيزوفرينيا، ولكن لأن الشيزوفرينيا ليست نوعاً طبيعياً. وإن الأنواع الطبيعية للطب النفسي عبارة عن حالات مرضية مميّزة تظهر الشيزوفرينيا في تحول متزامن. وينبغي لهذه الظواهر الذهانية المميّزة أن تتناول بصورة منفصلة وتعامل كأعراض أو شكاوى مميّزة.
ويعتقد بنتال إن “علينا التخلي عن التشخيصات النفسية برمتها ونحاول بدلاً من ذلك أن نفهم ونشرح التجارب والسلوكيات الفعلية للأشخاص الذهانيين” (2005، 141). وبمحاولته هذه يريد أن ينقل التشخيص إلى مستوى أكثر موثوقية. فقد اعترض (في الفصل الخامس عشر)، مثلاً، على النموذج القديم لاستنتاج اضطراب الأفكار على أساس الكلام المضطرب. وكانت رؤيته في موضوع الكلام المضطرب تتمحور حول فشل التواصل، والتي هي احتمال يحدث بالأخص حين يثار الأشخاص عاطفياً. في نموذج بنتال التجريبي، كان النقص المبدئي في الذاكرة العاملة الناجمة عن الإثارة العاطفية يتفاعل مع النقوصات الأخرى في الذاكرة الدلالية، ونظرية العقل، والمراقبة الاستباقية. ليكون في النتيجة هناك فشلاً في التواصل وافتقار للوعي الذاتي من فشل التواصل (الذي يميّز من خلاله مرضى الذهان من الأشخاص العاديين في محيط المشاعر القوية التي يكافحون أن تمر افكارهم خلالها). هذه ظاهرة مستقرة، بمعنى أنه بإمكاننا إعطاء القصة السببية نفسها في جميع حالات اضطرابات التفكير. وبالتالي نحصل على حساب ينتقل لجميع المرضى، وتمتلك نظرية الشيزوفرينيا العامة العديد من الامتيازات والتنوعات التي تنتقل من خلال الطريقة هذه.
يواجه منهج الفحص عن قرب مشكلتين. الأولى، أين نتوقف حين نبحث عن وحدات أصغر؟ هناك دائماً فرصة أن يكشف بعض التمييز السببي عن هيكل أكثر استقراراً. هكذا يناقش دافع الفحص عن قرب فكرة، كما الحال في أي علم آخر، أن يطوّر الجهاز الوصفي تجريبياً بطريقة تناسب النظرية. ويراهن بنتال وسبولدينغ وآخرون على أنه لن تتماشى أي مجموعة من المشاكل أو الأعراض بدقة مع فئات الدليل (DSM)، ومن المحتمل أن يعتبر هذا رهان جيد لأي منهج. ويشدد منهج بنتال الذي اختاره على العلوم المعرفية للظواهر الذهانية، بينما يميل سبولدينغ وآخرون إلى البحث عن الارتباطات بين المشاكل المهمة سريرياً وبين مجموعة كبيرة من الظواهر الكامنة؛ بالنسبة لسبولدينغ وآخرون، تمتد العلوم المتعلقة بتحديد المشاكل من الداخل الخلوي إلى المشاكل الاجتماعية والثقافية. وتتضمن الأمثلة على ذلك انخفاض مستويات الكورتيزول وصعوبة التعلم (127-130).
ومع ذلك، هناك اختلافات دائمة بين المرضى في الظواهر التي نحاول، في نهاية المطاف، أن نفحصها عن قرب. من المرجح أن تكون هذه المشكلة خاصة حين تبدأ هذه الظواهر منخفضة المستوى بشكل مستقل في الخلط بين المرضى الفعليين. ولذلك السبب، ينبغي ألا يُعتقد بالفحص عن قرب كبديل عن المثالية، حيث إن أي بحث في القواسم المشتركة بين المرضى ستشمل درجة معينة من المثالية. وإن المنهج المنافس، في الحقيقة، هو شكل آخر من أشكال المثالية.
يتقبل الفحص عن بعد فكرة أن تعتمد العلة العقلية على تفاعلات معقدة بين مختلف الظواهر ذات المستوى الواطئ، وإذ يحاول التعامل مع هذا التنوع عن طريق علاج شبكات الأمراض على أنها مثيلات تشبه إلى حد ما التاريخ الفعلي. وتستطيع الثيمة المكررة في تاريخ الطب النفسي التي يمكن لتعبير الكتب المنهجية أن تتحقق في الأفراد بطرق مختلفة. إن هياكل شاركو Charcot (1887-88) البدائية (archetypes) المتميزة، وهي أنواع مثالية من الاضطرابات، صح إنها ناتجة عن أشكال غير مثالية، ولكنها أشكال ناقصة للنوع المثالي الذي يتجلى في الأفراد. وكذلك يتشابه تمييز بيرنبوم (1923) بين السمات المسببة لأمراض الذهان وبين سماته المرضية الخاصة. فالأولى تحدد من خلال هيكلها الأساسي، والأخيرة تحدد من خلال الظروف الشخصية للمريض.
افترض مورفي (2006) أن تنوع العلل العقلية يتطلب منا أن لا نشرح الظواهر النفسية من خلال البحث عن انتظامات مستقرة بل من خلال بناء امثولات أصلية. ويرى مورفي أن هذه الأمثولة الأصلية هي مريض خيالي لديه هيئة مثال الكتاب المنهجي المثالي، شيء يشبه شبكة ثاغارد، الذي يوفره السرد للاضطراب، على الرغم من أن الكتاب المنهجي يحتاج تفكيراً كبيان للنظرية النهائية، وليس كأي عمل في الطب النفسي. كما الحال مع عملية الفحص عن قرب، يفترض المنهج أن القواسم المشتركة عبر المرضى ستنكشف من خلال التحقق. فالفكرة تكمن في نمذجة جميع الأسباب التي تساهم في التاريخ الطبيعي لتستكشف كيف تعمل سوية في سياقات مختلفة لإنتاج محصلات متنوعة من الاهتمامات، ومن ثم يفهم المرضى على أنهم حالات توافقية من الأمثولة. فنحن نشرح مرضاً، ومن ثم نبني أمثولة وننمذجها. ولكن الهيكل السببي الذي يشرح الأمثولة يشابه مرضى العالم الحقيقي بدرجات متفاوتة. لذلك حين نتحدث عن الأفراد ونشرح أعراضهم من خلال العمليات ونبين كيف أنها تشبه اجزاء أخرى من النماذج.
اقترح غودفري سميث Godfrey-Smith (2006)، بعد جيري Giere أنه قد لا يكون هناك علاج عام مفيد لهذه العلاقات المتشابه. فإنها ليست بعلاقات رسمية بل نوع من المقارنات بين الحالات الوهمية والحقيقية التي نفترضها كلنا دون عناء. وإن كانت هناك نظرية عامة، بعد ذلك، فمن المرجح أن لا يتم العثور عليها من قبل الفلاسفة لكن من قبل العلماء المعرفيين الذين يدرسون الفكر التناظري (على سبيل المثال هومل وهوليوك Hummel and Holyoak 2005). وبسبب هذه المخاوف الذرائعية التي تدفع بحثنا عن تفسيرات الطب النفسي، كما الحال في الطب عموماً، والعلاقات المهمة سريرياً بين المرض وبين النموذج وبين المريض التي تكون على الأرجح خاصة جداً؛ سيتم تحديد العلاقات جزئياً فيما إذا كانت توفر فرصاً للتدخلات العلاجية الناجحة التي لا تعتمد على كيفية ترتيب العالم حسب، ولكن على مواردنا وفرصنا أيضاً.
تتيح الأمثولة لنا تحديد عمليات قوية (ستيرلني Sterelny 2003، 131-2، 207-8) يمكن تكرارها أو منهجتها بطرق مختلفة، بدلاً من العمليات الفعلية التي تحدث كاضطراب يتكشف في الشخص الواحد. ولكننا لا نتوقف عند هذا الحدّ: والهدف النهائي هو الفهم السببي للمرض. وإذ أننا نبني نموذجاً لتحقيق هذه الغاية. ونهدف إلى تمثيل عملية مسببة للأمراض تمثل لنا الظواهر المشاهدة في الأمثولة. لغرض شرح التاريخ الفعلي في المريض في أن نظهر كيفية تكشّف العمليات في المريض بشكل مشابه لما افترض أن يحدث في الأمثولة. إذ توفر “الأمثولات” شكلاً مثالياً من الاضطراب الذي يهدف إلى تحديد العوامل التي لا تزال ثابتة على الرغم من كل الاختلافات الفردية. ولا يبرر كل مريض أحدى سمات الأمثولات، ولذلك ليس كل جزء من النموذج ينطبق على المريض. ومتى ما فهمنا العلاقات المتشابه التي توجد بين أجزاء من النموذج والأمثولة، نستطيع وقتها أن نتلاعب في النموذج لنغيّر أو نحجب النتائج المختارة في العالم الحقيقي.
للتعليق على هذا المنهج، أشارت ميتشل (2009) إلى أن عملها الخاص (2003) احتوى على منهج بديل للتفسير القائم على النموذج. وتهدف فكرتها القائمة على “التعددية التكاملية” إلى عزل الأسباب الفردية ونمذجتها على حدة، حيث ترى كيف أن كل منها تقدم مساهمة سببية من تلقاء ذاتها. وكذلك وضع المنظرون مجموعة من نماذج الظواهر الفردية وحاولوا دمجها من خلال تطبيق نماذج متعددة تبدو ضرورية لشرح الحالة المعينة. ويشابه منهج ميتشل منهج “الفحص عن قرب” في بحثه عن التحلل، ولكنه يحاول عزل الأسباب التي يمكن أن يعاد جمعها – مثل الجينات أو الصعوبات الشخصية – بدلاً من البحث عن تفسيرات لظواهر سريرية معينة مثل اضطراب التفكير (انظر إلى تابيري Tabery 2009). الذي يشبه طريقة سبولدينغ وآخرون. Spaulding et al. في سعيه إلى تطوير وتكامل النماذج السببية في خدمة تطوير استيعاب سريري شامل للناس ومشاكلهم.
وأشارت ميتشل (2009، 131) إلى أننا قد نحتاج إلى نماذجها وإلى نماذج مورفي على حد سواء وفقاً لما تقتضيه الظروف. وقد يكون هناك مجال لنماذج الفحص عن قرب أيضاً. ولا يبدو أن هناك سبباً في أن البحوث النفسية لا تهدف إلى التعددية حول التفسير وإلى جمع العناصر من جميع هذه الأساليب التوضيحية بما أننا نعلم أكثر عما يحدث حينما نحاول معرفة العلة العقلية.
يقدم غيمي Ghaemi (2003، الفصل الثاني عشر) دفاعاً مختلفاً عن الفحص عن بعد (Zooming out)، حيث يفترض أن تشخيصات الدليل (DSM) الحالية تعمل كأنواع مثالية حسب رأي ويبر Weber. إذ هناك طريقة واحدة لاستيعاب رأي ويبر باعتباره مجرد إشارة رائدة من النمذجة، والذي يعزل المتغيرات الأساسية ويضع المتغيرات غير الضرورية جانباً. على الرغم من ذلك، يقبع مكان غيمي في تراث الفهم الهرمنيوطيقي (التأويلي) الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً في الطب النفسي مع كارل جاسبرز Karl Jaspers (1997). ويبحث هذا المنهج عن علاقات نفسية ذات معنى بين الظواهر ويناقض مع التفسير السببي والعلمي. ففي رأي غيمي قد تم تصميم أصناف الدليل (DSM) لتعزيز فهم هذا النوع من خلال توجيه الانتباه السريري إلى جوانب لها علاقة بحياة المريض المتصلة بالاضطراب. ويراه كتطبيق لوسائل الإنسانيات، بدلاً من العلوم.
على أي حال، يعالج منهج الفحص عن بعد نماذجه كنقاط نهاية على الطيف الذي يلتقط الفروقات بين الشرائح البشرية (غيمي، 199)؛ يتوافق هذا المنهج مع البحث عن القصص السببية التي تفسر النموذج. وعلاوة على ذلك، فإنه بقدر ما يعتمد منهج الفحص عن قرب على المثاليات أيضاً، فإنه يواجه المشكلة نفسها. منهج بنتال، على سبيل المثال، يواجه المسألة ومدى درجة الصعوبات اللغوية التي تعتبر مرضية، ويحتاج سبولدينغ وآخرون أن يجدوا طريقة لتمييز المشكلة السريرية من الظاهرة التي تعتبر طبيعية ولكن غير مرحب بها.
3.5 قضايا مشتركة بين الثقافات
نشرت طبعات متلاحقة من الدليل (DSM) في أمريكا الشمالية، وطرحت أسئلة باستمرار حول قابلية تطبيق تصنيفاتها خارج الثقافة الغربية. حيث تتبع طبعة الدليل الخامس (DSM-5) سابقاتها في التعامل مع التنوع بين الثقافات بطريقتين. اولاً، تعالج بعض الحالات، مثل الاكتئاب والقلق، على أنها عالمية – موجودة في جميع الثقافات، على الرغم من الاختلافات المحلية في الخواص. والتي نطلق عليها بالمشروع التوحيدى. وقد أكد الدليل الرابع المنقح (DSM-IV-TR) أن تصنيفات الدليل الرئيسية تحدث في جميع أنحاء العالم ولكن مع أعراض ومسارات تتأثر بالعوامل الثقافية المحلية. ثانياً، يوظف الدليل الرابع المنقح (DSM-IV-TR) مفهوم “متلازمات مرتبطة-بالثقافة”، والتي تم تعريفها على أنها “أنماط متكررة ومحددة محلياً من السلوك الشاذ والتجارب المثيرة للمشاكل التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بتصنيف تشخيص DSM-IV معيّن” ( ص 898). وتحدث المتلازمات المرتبطة-بالثقافة في عدد محدود من المجتمعات أو الثقافات. وهذه المتلازمات محليّة، وغالباً ما تكون تقليدية، والتصنيفات التشخيصية تجعل أنماط الفكر والسلوك التي تعامل على أنها منحرفة أو مثيرة للمشاكل في هذا السياق.
ومن الناحية النظرية، فإن المتلازمات المرتبطة-بالثقافية هي تلك الأمراض الشعبية التي تظهر فيها تغيير السلوكيات والتجارب بشكل بارز إذا قورنت بالمعايير المحلية. ولا تعتقد تشخيصات الدليل (DSM) القياسية بهذه الطريقة، حتى لو كانت محدودة ثقافياً. فعلى سبيل المثال، تمّ تشخيص “اضطراب الشخصية المتعددة/اضطراب الهوية الانفصالية” على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينيات، ولكن نادراً ما تم تشخيصه في مكان آخر في العالم. إلا أن ذلك لم يدفع الأطباء النفسيون إلى التعامل معه على أنه متلازمة مرتبطة-بالثقافة، على الرغم من أنه يبدو يتلاءم مع التعريف. فقد افترض أن الطب النفسي السائد يتمثل في الحالات الغربية بكونها ليست مرتبطة بالثقافات؛ أي أنها تمثل الشذوذ في الصفات الإنسانية العالمية. وتنطبق هذه الحالة حتى بالنسبة لحالات (مثل بعض أنواع اضطراب تشوّه الجسم) التي توجد بيانات انتشارها في عدد قليل من الدول الغربية ليس إلا.
وقد ابتعد الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس(DSM-5) عن مفهوم المتلازمة المرتبطة-بالثقافة واعتمد مفهوم “المفاهيم الثقافية للضيق” (ص 758). وعرفّ الدليل هذه المفاهيم التي “تخوضها الجماعات الثقافية وتستوعبها وتتبادل معاناتها، ومشاكلها السلوكية أو أفكارها ومشاعرها المثيرة للمشاكل”. ويميّز الدليل الخامس (DSM-5) بين ثلاثة أنواع رئيسية من المفاهيم الثقافية:1) المتلازمات،2) والتعابير (طرق التعبير عن الضيق)،3) والتفسيرات المحلية. وإن النوع الأخير مثير للاهتمام بشكل خاص: لأنه يمثّل صورة قياسية للعلّة العقلية في كلاً من المجتمعات غير الغربية والمجتمعات المتأخرة كما موضح من قبل قوى خارقة للطبيعة مثل تلبّس الأشباح. إلا أن إدغرتون Edgerton (1966) أفاد بأن قبائل شرق-أفريقيا انقسمت حول تفسير الذهان. فالبعض يستوعبها على أنها تلبّس اشباح، ويعتقد البعض الآخر أنه سبب عضوي (ديدان دماغية). لذا فإن الدليل الخامس (DSM-5) وضع مجالاً لهذه النتائج كجزء من دمج التفسيرات المحلية في نظرية العلة العقلية.
يضيف الدليل الخامس (DSM-5) هذا التصحيح المفاهيمي من خلال إجراء إصلاح شامل لـ “المخطط العام للصيغة الثقافية”. ويقدم هذا المخطط في الدليل الرابع المنقح (DSM-IV-TR)، في جزء منه استجابة لمناشدات من الأطباء النفسيين عبر-الثقافات (Cross-Cultural Psychiatrists) الذين لم يكونوا راضين عن الطرق القديمة (على سبيل المثال كانينو والجيريا Canino and Alegria 2008).
ويعكس ذلك استثماراً غير مسبوق في تطبيق الأنثروبولوجيا مع الطب النفسي من قبل المجموعة المشتقة من القضايا الثقافية في الدليل الخامس (DSM-5)، والتي أجرت تجارب ميدانية لمقابلة صياغة ثقافية جديدة (CFI) في ستة مواقع حول العالم (أغروال Aggarwal 2013). وصممت المقابلة لأجل تقييم المجموعات الثقافية أو الإثنية التي ينتمي إليها المريض والطرق التي يفهم بها تلك المجموعات وتؤثر على التجربة بهذا الموضوع. تتألف المقابلة من اسئلة مصممة خصيصاً لجمع المعلومات من منظور المريض وأقرانه الثقافيين، بما في ذلك اسئلة محددة تطلب من المريض عدم تكرار ما قاله الطبيب، بل تطلب منه أن يصف فيها جوانب من هويته ويعبر عن مشكلاته كما يراها هو لا غيره. ويمكن استخدام المقابلة مع أي شخص في أي مكان، وكذلك يقر الدليل بأن جميع العلل العقلية، بما فيها تشخيصات الدليل (DSM)، قد شكلت بواسطة الثقافة المحيطة بها. ومن ناحية أخرى، فإن مقابلة CFI وما يرتبط بها من مواد مفاهيمية تمّ دمجها بشكل ضعيف إلى الدليل الخامس (DSM-5)، حيث أن العديد من التشخيصات لا تولي أي اهتمام للصياغة الثقافية على الإطلاق -وتستمر المتلازمات المرتبطة-بالثقافة في الأمر الواقع. وربما قد أعيد صياغة تسميتها إلى “المفاهيم الثقافية للضيق” ولكن التذييل بحد ذاته استمر، لذلك قد يتساءل كيف يتم التعديل الشمولي؟
يعالج المنهج الآخر في الاختلاف الثقافي، كما ذكر، التشخيصات المختلفة كانعكاس لحالات الدليل نفسها. وحيث تكمن المسألة في كيف يجب أن يكون التشخيص مختلفاً قبل أن يتوقف عن كونه حالة من حالات الدليل (DSM) ويصبح وقتها “متلازمة مرتبطة-بالثقافة”. لقد اقترح ضرورة أن تتوسع اضطرابات القلق، على سبيل المثال، من “مجالات القلق” لأن البشر من الثقافات الأخرى يتضايقون من اشياء لا يتضايق منها الأميركيون الأوربيون (لويس فرنانديز وآخرون Lewis-Fernandez et al 2010). ويرى الافتراض هنا أن اضطرابات القلق شائعة بما فيه الكفاية في جميع الثقافات البشرية لتستحق معالجة كشكل عالمي، ولكن هذا يمكن تفويته إن لم يقدّر الأطباء مختلف المحفزات وردود الأفعال والمفاهيم التي تميز اضطرابات القلق في الشرائح المختلفة. نحن بحاجة إلى التعرف على تنوع أكبر من الأعراض بين الذين يعانون من القلق وبين الذين يعيشون في الثقافات الغربية ولكن لا تظهر أعراض الغربيين المثالية.
افترض لويس-فرنانديز وفريقه (2010) أن غالبية المصابين اللاتينيين من أتاك دي نيرفيوز ataque de nervios –نوبة عصاب بالإسبانية- قد استوفوا معايير اضطراب الهلع، على سبيل المثال، إذا صحح الدليل (DSM) الشرط الذي يقضي بأن تستمر نوبة الهلع بضع دقائق فقط. وأدرجت حالة أتاك دي نيرفيوز كمتلازمة مرتبطة-بالثقافة في الدليل الرابع (DSM-IV-TR). وشملت أعراضها مزيج من أعراض نوبة الهلع الكلاسيكية مثل الخفقان والإحساس بحرارة جسدية وفقدان السيطرة. ولكنها قد انطوت كذلك على صراخ لا يمكن التحكم به وتهديد بالعنف، جنباً إلى جنب مع أعراض أخرى أقل نسبة حدوث في نوبات الهلع، وتتميز أيضاً بأنها تستمر فترة أطول. لقد كان لويس-فرنانديز مهتماً في فكرة أن أتاك دي نيرفيوز يمكن فهمها لغرض تشخيص القلق بشرط أن نأخذ الاختلاف في أعراض أكثر جدية.
ويمكن استخدام هذا المشروع التوحيدي في افتراض أن كيان التشخيص ذاته متشابه في جميع الحالات – حيث تتكيف بعض العمليات الأساسية المشتركة أو تستجيب إلى مختلف التشكيلات الثقافية لإنتاج سلوكيات مختلفة. ويرى بعض الباحثين أن الشذوذ الأساسي، حتى لو كان موجوداً، فإنه بالإضافة إلى هذه النقطة. فإن ردة فعلنا على الحالة تحدد من خلال تعبيره، حتى إن كان هناك نوع نفسي أساسي. وقد افترض كلينمان Kleinman بأن الاكتئاب في الغرب وفي شرق-آسيا مختلفان كفايةً في التعبير والمسار الذي وبطبيعة الحال ينبغي أن يرى كحالات مختلفة (1987، 450): “يعاني المصاب من الاكتئاب تماماً كأعراض آلام أسفل الظهر والاكتئاب كيأس وجودي مصحوب بالذنب هي أشكال مختلفة من سلوك العلّة مع أعراض مختلفة، وأنماط بحث عن المساعدة، ومسارات واستجابات للعلاج التي قد يكون المرض في كل حالة متشابه، وتبقى العلّة بدلاً من المرض عاملاً محدداً “.
اختار هورويتز وويكفيلد Horwitz and Wakefield (2007، ص 199) لأجل التعميم في الاستجابة: “إننا نتفق مع تمييز كلاينمان Kleinman بين المرض كخلل وظيفي شامل والعلة كتعبير بشكله-الثقافي للخلل المعطى… [ولكن] إن كانت هناك اختلالات شائعة، فسوف يفترض أن العلاج يعتمد إلى حد كبير على العلم الذي يحدد ويتدخل في مثل هذه الاختلالات بغض النظر عن عرضها الثقافي “.
يعدّ المشروع التوحيدي رهان تجريبي يستند إلى فرضية أن علم النفس البشري يكفي لعلاج بعض الأشكال الثقافية المميزة على الأقل من الاضطراب العقلي كتعبيرات عن الطبيعة البشرية المشتركة والتي حددت بشكل مختلف من قبل الثقافة المحلية. وكذلك فإن المطالبة بالمتلازمات المرتبطة-بالثقافة رهان جيد تماماً، مما يعكس فكرة أن بعض أشكال السلوك محلية كليّاً ولا يمكن استيعابها في نموذج عالمي. ويمكن السعي إلى المشروع التوحيدي والاعتراف بالمتلازمات المرتبطة-بالثقافة في الوقت نفسه. وعلى أي حال، ينبغي أن نكون أحراراً في السعي وراء هذه الاستراتيجيات من فرضية الدليل الخامس (DSM-5) من أن العقول الغربية هي الرقعة الزرقاء النموذجية للعالم برمته. فقد يكون الشكل الغربي للحالة غير اعتيادياً: فكلما ننظر عن كثب أكثر، كلما سيبدو لنا أن الجوانب المعرفية للاكتئاب “غربية” بامتياز. وقد تعالج هذه الحالات على أنها عالمية ولكنها في الحقيقة متلازمات مرتبطة-بالثقافة موجودة في دول الناتو لا غير.
3.6 التطبيق السريري
تفسر النماذج النفسية مفهوم المثالية بصورة ما. على أي حال، فإن الغرض يأتي من كل هذا حين يكون هناك استيعاب يتيح لنا مساعدة المرضى. وقد أطلق غوز Guze (1992) خطوة الانتقال من المنظور البيولوجي إلى المنظور السريري. وفي سبيل اتخاذ الخطوة يجب أن ننتقل من الوصف العام لعملية الأمراض إلى الوصف المحدد لبيولوجيا الفرد. ويأخذ الطبيب المريض المثالي المتخيل ويحدد من خلاله المزيد من تفاصيل العالم الحقيقي، وذلك لإنتاج وصف لمجموعة أصغر من المرضى، وربما حتى حالة واحدة. ويجعل المشروع العلمي مثالياً، في حين يستخدم المشروع السريري موارد العلم لمساعدة الأفراد. في عرض العلاقات السببية التي تؤدي إلى ميزات النموذج الذي يقدم فرصاً للعمل العلاجي، سواء كنا قد فحصنا عن قرب أو عن بعد. يعرف النموذج مجموعة من العلاقات التي تختلف عن تلك الموجودة في مريض حقيقي على أبعاد متنوعة. أحدها هو الدقة: قد يحتاج تمثيل علاقات النموذج السببية إلى أن يكون أكثر دقة عندما ننظر إلى المرضى الحقيقيين. على سبيل المثال، قد نحتاج إلى أن نكون محددين بدقة في الإعداد السريري، بينما في الأمثولة النموذجية يمكن تعريف الأعراض بأنها تستوطن مجموعة من القيم، ويمكن لأي أحد أن تطبق عليه في الطبيعة. أو يمكننا أن نحدد قصة تقدس تفاصيل المعتقدات وغيرها من حالات المريض المقصودة، بدلاً من مجرد الاستشهاد بحقيقة أن مسار معالجة المعلومات يتورط في المرضى من هذا النوع.
-
علم الأمراض النفسي الفلسفي
4.1 أنواع من علم الأمراض النفسي الفلسفي
يستعرض الجهد المحسوب على موضوعة علم الامراض النفسي الفلسفي حتى الآن في معظمه على حساب فلسفة العلوم، حيث الطب النفسي هو العلم المعني، والفلسفة هي المعنية بموضوعات مألوفة لفلاسفة العلم، كما وضح في التفسير. وهناك تراث آخر في فلسفة الطب النفسي تنتمي إلى ما يطلق غراهام وستيفنز Graham and Stephens (1994، 6) عليها بفلسفة العقل، التي تعد واحدة من الطرق التي تميز في مجال التصنيف الخام للمنهج إلى تطبيقات علم الأمراض النفسي الفلسفي. وقد ميّز التصنيف الفئوي المتبقي أو جهد غراهام وستيفنز النظر في الجوانب الخُلُقية والتجريبية من الاضطراب العقلي.
فالفلاسفة الذين يكتبون في هذا السياق (مثلما قرأنا في غراهام، 2010) بحثوا عن دمج النتائج التجريبية في استنباط فلسفي حول مواضيع مثل الهوية الشخصية أو العقلانية أو الفعل التطوعي. وسعوا أيضاً للحصول على تفسيرات فلسفية مميزة لعلم الأمراض النفسي، الذي يحاول أن يفهمها من حيث الاقتراض من فلسفة العقل. بينما يرى مورفي Murphy (2006)، على سبيل المثال، نطاق العقلية على النحو المتعارف عليه في علوم العقل، ويعتقد غراهام في العقلية كما تمتلك سمات التوائم المميزة من مفهوم القصدية ومن مفهوم الوعي. فإن اضطرابات العمد أو الوعي هي ما تحسب على أنها علل عقلية، ولهذا السبب، تستطيع النظريات الفلسفية التي تعالج حالات القصدية أو الوعي أن تساعدنا على فهم الاضطرابات النفسية بشكل أفضل.
يشمل هذا المشروع الفلسفي، ولكن لا يقتصر على، التوضيح المفاهيمي. وقدم الفلاسفة مساهمات مفيدة من خلال التطرق إلى تفاصيل مفاهيم الطب النفسي. ويمكن الرجوع إلى هذه الطريقة في علم الأمراض النفسي الفلسفي إلى الجزء الأول من بوتر Potter (2009). حيث تطلعت بوتر إلى المفاهيم الاولية في الاستيعاب الحالي لاضطراب الشخصية الحدّية Borderline Personality Disorder (الشخصية غير المستقرة عاطفياً)، التي تتميز بصفات الشعور بالفراغ أو فقدان الذات، والسلوك المتهور أو التدمير الذاتي، ونوبات غضب وعلاقات غير مستقرة. بل إن أحدى المقالات التي تناولت الحالة اعتبرت أن المريض الحدّي يمتاز بصفة التلاعب (بوتر، الفصل السادس). وقد يشعر الطبيب المعالج غالباً بأنه مهزوم من قبل المريض الذي نجح في تحقيق هذه النتيجة التي لا يريدها المعالج، فعلى سبيل المثال، في حالة المريضة التي ما تزال ترغب في الرقود في المستشفى على الرغم من إن حكم الطبيب قد ناقض ذلك، فأنها تعمل على أذية نفسها عمداً لكي تجبر المستشفى على إرقادها. في هذه الحالة، تكون المرضة قد اتخذت بالتأكيد تدابير متطرفة للوصول إلى مبتغاها، ولكن ليس واضحاً أن يكون ما فعلته تلاعباً. لأن المريضة قد احتجت على رأي طبي، لكنها لم تغيّر عقلية الطبيب المعالج أو أنها قامت بخداعه، وإذ أننا نفضل أن نفكر في التلاعب كتصرف متعمد لتغيير عقل شخص آخر من خلال السحر، أو الخداع أو أي عملية نفسية أخرى. هذا النوع من القدرة للحصول على مبتغاك غالباً ما تنسب إلى مرضى الاعتلال النفسي (السايكوباث)، ولكن بوتر جعلتنا نتساءل عما إذا كانت الفكرة نفسها تنطبق على المرضى الحدّيين. وربما يجب أن ننظر إليهم على أنهم أناس يائسون يحاولون التأقلم مع الضيق، أو أنهم غير مؤهلين اجتماعياً (115-16)، بدلاً من أن نعتدّ بعوامل لثني الآخرين عن إرادتهم. وحتى إذا كانوا يحاولون الحصول على مرادهم الخاص، حسناً، لماذا لا يجدر بهم السعي إلى ذلك؟ يرجع مصدر قلق بوتر إلى أن مفهوم التلاعب يستخدم من قبل الأطباء ليعني مجرد مفهوم مبسط مثل “السلوك الذي يجعل عملنا أكثر صعوبة!”.
4.2 الأفكار الدخيلة
وضع غراهام ونظراؤه برنامج بشكل أجندة مختلفة تتجاوز التوضيح المفاهيمي. إذ تنطوي على استخدام مفاهيم من الطب النفسي لتسليط الضوء على مشاكل فلسفية، بل استخدمت مواقف فلسفية لشرح، أو على الأقل لتوضيح، بعض القضايا التي تربك الأطباء النفسيين. خذ مثلاً أوهام الأفكار الدخيلة. حيث يقول الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أن لديهم أفكار داخل عقولهم قد وضعت من قبل شخص آخر أو واقعاً قد فكّر فيها شخص آخر، كما الحال في الحالة الشهيرة التالية التي أبلغ عنها ميلر Mellor (1970): “أنني أنظر من النافذة واعتقد أن الحديقة لطيفة والعشب بارد، ولكن ما زالت أفكار “إيمون اندروز” تدخل إلى عقلي. لا توجد أفكار أخرى هناك، فقط أفكاره … إنه يعامل عقلي مثل شاشة وأفكاره تومض عليها كما تومض في الكاميرا فلاشها”. (كان ايمون اندروز شخصية تلفزيونية بريطانية). من الصعب تخيل ما يمكن أن تكون عليه الأفكار الدخيلة: كيف أستطيع أن أكون على علم استباقي بشيء يشبه النوبة في عقلي، ويجري في الوقت نفسه في عقل شخص آخر غيري؟ واقترح غراهام وستيفنز (2000) بأنه ينبغي أن ينظر للأفكار الدخيلة على أنها “وعي بالذات دخيل”. حيث أنهم استعاضوا من فكرة فرانكفورت Frankfurt (1988، 59) بأن بعض الأشياء التي أفعلها فعلاً تعبّر عمّا أصبو إليه بالمعيّة. قد تكون بعض التحركات الجسدية عبارة عن تحركات أطرافي دون احتسابها أفعال من ذاتي، ربما لأن شخص آخر يسيطر على تحركاتي. ونفس الشيء يمكن أن ينطبق على الأحداث العقلية. إن مرّ لحن غير مرغوب به داخل عقلي، فإنه نوبة في تاريخي العقلي. ولكنه لا يحتسب كنشاط عقلي في الطريقة ذاتها كالحسابات الرياضية الذهنية التي أقوم بها لأوازن دفتر الصكوك خاصتي. إن المثال الأخير، لا الأول، الذي يتألف من التفكير القصدي الذي يعبر عما أصبو إليه بالمعيّة. ويطلق غراهام وستيفنز (2000، 152) على هذه الخصائص من التفكير بالإحساس بالذاتية والإحساس بالمعيّة. إذ يقترحون أن هاتين الخاصيتين يمكن أن يختلّا، لذا يحدث في اضطراب التفكير إحساساً بالذاتية دون الإحساس بالمعيّة. واستناداً إلى هذه الصورة، عزوا أن تكون فكرة الشخص الآخر ذات معنى، لأنه نوع من النشاط العقلي الذي يجب أن ينتج عن طريق شيء ما، ويحمل كما تفعل سمات المعيّة المميزة (وليست معيتي فقط).
ولا تفسر مثل هذه النظرية من أين تأتي التجارب غير الطبيعية؟ وعوضاً من ذلك، فإنها تحاول استخدام الموارد الفلسفية لجعل التجربة أقل ابهاماً إلى حد ما، وربما تكشف بعض الأرضية للتفسير من خلال توجيه الطريق نحو نوع من العمليات العقلية التي تحتاج أن تنطوي تحتها. ويتطلع منهج مختلف لعلم الأمراض النفسية الفلسفية إلى العلم لكشف النقاب عن الإشكال الفلسفي.
4.3 الاعتلال النفسي(السايكوباثية) وعلم النفس الخُلُقي[3]
يبدو أن النقاش حول الاعتلال النفسي (السايكوباثية) يترك في النتائج التجريبية مساهمة فلسفية واضحة. وعلى هذا المنوال، نوقشت موضوعات السايكوباثية في محورين. أولاً، فيما إذا كانت الأحكام الخُلُقية محفزة غريزياً، أو فيما إذا كان من الممكن معرفة ما الذي تحتاجه المنظومة الخلقية لتبقى ثابتة. وقد وصف جيسي برنز Jesse Prinz (2007، 42) السايكوباثية كـ”حالة اختبار”، مما ساعدنا على أن نفرق بين دعوى أن الأحكام الخُلُقية محفزة غريزياً وإنها تدّعي العكس بأن يكون من المستطاع أن تشكل حكماً خُلُقياً دون أن تكون محفزة للفعل بما تقتضيه. وثانياً، وإن كان الموضوع ذا صلة بعلم النفس الخُلُقي، وهو إلى أي مدى تكون الأحكام الخُلُقية نتاج العقل أو الحس العاطفي.
يفترض هيوم (1751، القسم التاسع) مصطلح “العقد المحسوسة”، التي “يعتقد بمقتضاها أنه، في بعض الحوادث، قد يعمل فعل الخطيئة أو الخيانة على إضافة كبيرة إلى ذخيرته، دون أن يسبب خرقاً كبيراً في البنية الاجتماعية والتحالفات. فالصدق سياسة فضلى، وإننا نعدّه قاعدة عامة جيدة. لكنه يبقى عرضة للاستثناءات الكثيرة: وربما قد يتبع الحكمة ذاتها، ويتابع القاعدة العامة، ويستفيد من جميع الاستثناءات. “إذ تدرك عقد هيوم المحسوسة ما تتطلبه الفضيلة ولكنها لا تعبأ، لأنها يفتقر إلى الحس بالطيبة الذي يعارض عادة المصلحة الذاتية. ولا يمكن مقاربة العقد المحسوسة في الفضيلة لا بسبب أن يكون هناك نقص ذكائي. لكنها فقط لا تجذب الفضيلة على الإطلاق. وكذلك افترض شون نيكولز Shaun Nichols (2004) أن المعتلين السايكوباثيين هم حالات حقيقية للعقد المحسوسة، حيث يبدو أنها تناسب معايير هيوم.
وبحسب منظور نيكولز (2004)، فإن المعتلين السايكوباثيين هم عقد محسوسة – لا خُلُقية ولكنهم موكلين بالعقلانية كليّاً. وإنهم يفتقرون إلى العواطف الاجتماعية الايجابية (خصوصاً التعاطف)، ويؤدي هذا النقص إلى تجاهل ادعاءات الفضيلة لأنها لا تستجيب عادة لمعاناة الآخرين. وكذلك افترض نيكولز أنه نظراً للعيوب الخُلُقية للمعتلين السايكوباثيين يمكن تعقب عجزهم العاطفي، بدلاً من أي نقص في المنطق، فإن المعتلين السايكوباثيين يدحضون ما يسميه “العقلانية التجريبية”. وإن العقلانية التجريبية هي فكرة تعتمد على الأخلاقيات، أو هي مجرد مستوطنة، للمنطق العملي. إن أحكامنا الخُلُقية قابلة للتفسير من حيث المعايير العقلانية ذاتها التي تنطبق على الفكر والفعل الاعتيادي. ببساطة، لا يمكن تمييز كونها خلقية عن كونها عقلانية حسب. إذا دحض المعتلون السايكوباثيون وجهة النظر هذه، يعتقد نيكولز، فإنها تحتسب دليلاً لصالح منهج هيوم الموسع للفضيلة.
يميز نيكولز العقلانية التجريبية من العقلانية الخُلُقية. إذ تدعي العقلانية التجريبية أن الحقائق التجريبية التي تتبع الحكم الخُلُقي في البشر هو نوع من الحكم العقلاني، بعبارة أخرة؛ إن أحكامنا الخُلُقية مستمدة من قدراتنا وقابلياتنا العقلانية. وتنصّ العقلانية المفاهيمية على أن الحقائق المفاهيمية التي تجعل البشر يحتاجون أحكام خُلُقية مدفوعة من خلالهم. وذلك يعني، إذا استوعبت ما تتطلبه الفضيلة سوف تسعى إلى فعله (لأنه الشيء العقلاني للقيام به). حيث يركز نيكولز على الحالة التجريبية – مدى علم النفس الخُلُقي الذي يشكل المنطق العملي.
تحدّت هايدي مايبوم Heidi Maibom (2005) معالجة نيكولز لعدة أسباب. السبب الأكثر قرباً، أشارت مايبوم في مقالة تظهر أن المعتلين السايكوباثيين يعانون واقعاً من اعتلالات عقلانية. ويبدو أن المعتلين السايكوباثيين يواجهون صعوبة في التعلم من تجاربهم، ويفتقرون إلى التشبث بالمنطق نهائي المعاني، ويفتقرون إلى القدرة للتخطيط على المدى الطويل أو الصياغة أو السعي إلى الأهداف طويلة الأجل. وافترضت مايبوم أنه بسبب هذه العيوب يفشل المعتلون السايكوباثيون من الوفاء بالقيود العقلانية للمنطق العملي، مثل التماسك والاستقامة. وصرّحت مايبوم أيضاً أنها تدعم موقف هيوم، فإنه لا يكفي أن تربط هذه العيوب في منطق المعتلين السايكوباثيين إلى اختلالات في حياتهم العاطفية. فبالنسبة إلى هيوم، إن العجز العاطفي يجب أن يكون له تأثير مباشر على الفضيلة من خلال غياب التعاطف، وليس بشكل غير مباشر من خلال الفشل المنطقي الناجم عن النقص العام في العواطف.
ويبدو صحيحاً أن المعتلين السايكوباثيين يعانون من خلل عقلاني متنوع. ولكن لا يوجد أحد عقلاني تماماً، ويجب أن تكون الحالة أن المعتلين السايكوباثيين مختلفون بما فيه الكفاية من الأفراد الطبيعيين. ولكي تقوم مايبوم بإثبات قضيتها، فإن القصور العقلاني للمعتلين السايكوباثيين يحتاج أن نجعلهم فئة مميزة من الأفراد، لأن حجة نيكولز تعتمد على كونها أكثر تعقلاً من الفرد الاعتيادي. وما زلنا غير متأكدين من طبيعة العجز العقلاني في السايكوباثية، وحتى حول أهمية النماذج المتنوعة من اللاعقلانية المريضة نفسياً. ولعله من الخطأ أن نعتقد في سبب عملي كظاهرة الوحدوية أو القابلية. ويبدو أن المعتلين السايكوباثيين طبيعيون تماماً عندما يتعلق الأمر بنظرية العقل والذكاء العام، لذلك ربما يكون خلل المنطق مقيّد بطرق معينة تتركهم في الفئة نفسها كالأفراد الاعتياديين عندما يتعلق الأمر بأنظمة المنطق التي تهم الفضيلة. أو ربما يكون في النهاية أن السايكوباثية تنطوي على مزيج من القصور العاطفي والعقلاني الذي يعكس الفشل في التطور العصبي-نفسي الاعتيادي. وإن كانت هذه هي الحالة، فإنها ستكون أقل تلاؤماً للقضاء بين منهج هيوم ومنهج كانت الذي يرى الفضيلة من حيث السبب العملي، بدلاً من الاستجابات العاطفية.
ويبرز الخلاف أيضاً حول مدى الذي يفهم المعتل السايكوباثي للمفاهيم الخُلُقية حقاً، والتي يجب أن يعمل بها من أجل اعتبارهم لا أخلاقيين، بدلاً من أن يكونوا أشخاصاً لا يفهمون الفضيلة. وعلى الرغم من أن المعتلين السايكوباثيين يستطيعون استخدام اللغة الخُلُقية واستخدام المصطلحات العاطفية، فإن بعض المنظرين (مثل هاير Hare 1993، الفصل الثالث) يعتقد بأنهم يبدون غير قادرين على ربط الحس ذاته، مثل بقيتنا، إلى المفاهيم الخُلُقية التي يستخدمونها. وهذا يوحي بأنهم لا يقبضون على المفاهيم الخُلُقية حقاً. وعلى أي حال، قد يعزى فشلهم في القبض على المفاهيم الخُلُقية إلى قصرهم العاطفي بدلاً من بعض العجز في المنطقر (برينز Prinz 2007، 46-47).
4.4 الشخصية المتعددة
بحث الفلاسفة أيضاً في الدعم العلمي ومقاربته بنظرياتهم لانجذابهم إلى حالة اضطراب الشخصية المتعددة، أو اضطراب الهوية الانفصالي (MPD/DID) مثلما يطلق عليها الدليل الرابع (DSM-IV). ويعتبر هذا التشخيص موضوعاً مثيراً للجدل بشكل كبير. حيث اعتقد بعض الفلاسفة أنه يظهر شيئاً مثيراً للاهتمام حول تطوّر الذات في الافراد الاعتياديين. أما المنظرون الآخرون فقد كانوا أكثر تشككاً، سواء حول الادعاءات الفلسفية أو حول الواقع الشديد للحالة ذاتها.
في الصورة الأساسية لاضطراب الشخصية المتعددة/الانفصالية أن المصاب يمتلك عدة حالات شخصية متميزة، والمعروفة باسم “الغير/ alter”. إذ يكون واحد من الغير، في أوقات مختلفة، المسيطر عن سلوك هذا الفرد. وكل “غير” لديه نمط ثابت وحصري وغريب، من إدراك وتفكير متعلق بالنفس والبيئة المحيطة، فضلاً عن أنماط مختلفة أخرى من الكلام والسلوكيات الجسدية. وتبرز مجموعة “الغير” تلقائياً ولا إرادياً للسيطرة على السلوك، وتعمل أكثر أو أقل بشكل مستقل عن بعضها بعضاً. وليست كل “غير” معروفة للمريض. وهذا يؤدي إلى فقدان ذاكرة ملحوظة (لا نسيان اعتيادي) على جزء المريض للفترات الزمنية حين يكون “الغير” هو المسيطر.
وقد تعززت الشكوك حول اضطراب الشخصية المتعددة/الانفصالية في المجتمع الطبي من خلال الظروف التي توضحت في السبعينيات والثمانينيات. إن وجود الانفصال ليس مثيراً للجدل. حتى إن الدليل الرابع (DSM) (477) قد عرّف الانفصال بأنه “خلل بالعادة في الوظائف المتكاملة للوعي، والذاكرة، والهوية، وإدراك البيئة المحيطية. وقد يكون الخلل مفاجئاً أو تدريجياً، عابراً أو مزمناً “. لا يجب على الانفصال أن يكون مرضياً: وقد يحدث في الحياة الطبيعية عندما، على سبيل المثال، واحد يصبح مستغرقاً في مهمة لكي يشتت نفسه من جوانب بيئية أخرى. وافترضت فكرة تغيير الشخصية التحكم في السلوك في القرن التاسع عشر. ولكن المشككين أشاروا إلى أن أقل من اثنتي عشر حالة قد تم توثيقها قبل أوائل السبعينيات، وحين استشرى وباء هذه الحالة المفاجئ في أمريكا الشمالية، والذي يمتلك الفرد فيها من عدد، وأحياناً العشرات، من “الغير”. وذكر أنصار التشخيص أن السبب في جعل التشخيص ممكناً على نطاق واسع يعود إلى عامل زيادة الوعي بالعنف ضد الأطفال، حيث أخذ التشخيص على عاتقه جهوداً للتغلب على التحفظ العام عن هذا العنف كعامل أساسي.
وبحلول منتصف التسعينيات، تراجع الوباء، وبدأ المزيد والمزيد من الأطباء النفسيين باستنتاج أن أعراض اضطراب الشخصية المتعددة/الانفصالية تنتج في العيادة عن طريق الايحاءات والتنويم المغناطيسي، وبالتنسيق مع تصوير الحالة اعلامياً. أثيرت أسئلة في وقت لاحق حول صحة التشخيص في بعض الحالات الرئيسية التي ألهمت الصعود الاعلامي للتشخيص (ماكنالي McNally، الفصل الخامس). ولكن لا يوجد هناك شك في حقيقة الأعراض التي أظهرها الناس الذين حصلوا على التشخيص. وكان هناك ميل إلى التساؤل عما إذا كانت الشخصية المتعددة اضطراب حقيقي أو نتاج ظروف اجتماعية، أو وسيلة مقبولة ثقافياً للتعبير عن الضيق؟ وعلينا أن نرد فرضية أن يكون هناك تبايناً هاماً بين كونه اضطراباً حقيقياً وكونه نتاج ظروف اجتماعية. إن حقيقة كون هناك مجموعة معينة من الأعراض العقلية التي تظهر سوية فقط في سياقات تاريخية أو جغرافية محددة لا تعني أنها ليست حقيقية (انظر هاكينغ Hacking 1998 عن الاضطرابات النفسية العابرة). بل لا يتعرض النقاش الفلسفي للانفصال للضرر إن كان المتشككون يتحدثون عنه. فعلى أي حال، إن النظريات الفلسفية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمزاعم المثيرة للجدل حول طبيعة وسببية اضطراب الشخصية المتعددة/الانفصالية تبدو أقل معقولية.
رسم دينيت وهمفري Dennett and Humphrey صورة عن اضطراب الشخصية المتعددة/الانفصالية لدعم مقترح فلسفي عن طبيعة الذات. ويبدو أنهم ربطوا تفسيرهم للاضطراب بخصوصيات القصة السببية، وتعاملوا مع الحالة كدليل لنظرية معينة حول تطور الذات في الحالات الاعتيادية. وتعبّر مجموع مختلف من “الغير”، كما وضعوها، عن المزاجية المبالغ بها ولكنها تحتفظ بذكريات من فترات السيطرة التي تفتقدها الشخصيات المضيّفة. وتصبح هذه الذكريات متكدسة بذات مستقلة (أو تمثيل ذاتي). إن القصة السببية التي يفضلونها (49-51) تقترض من جمهور اضطراب الشخصية المتعددة/الانفصالية، وتؤكد أن الأطفال الذين يتحملون الاعتداء بوسيلة الانفصال ويتركون وراءهم “الغير” ليتعامل مع الاعتداء. ثم ينفصل الغير إلى قطع تعبّر عن علاقات عاطفية مختلفة بما يجري على أرض الواقع (بما في ذلك المشاعر المتعارضة نحو الوالد الذي يكون المعتدي أيضاً).
هل لهذا العدد من “الغير” ذوات مختلفة؟ هنا ميّز دينيت وهمفري نظريتين للذات
-
“الذات الاصولية”: وهي الذات المراقبة بصورة شبحية والتي تعيش داخل الرأس، والتي تعتبر مقر التفكير والوعي.
-
“الذات الخيالية”: أو “مركز الجاذبية السردية” من السيرة الذاتية، إلا أنها بلا قوة سببية حقيقية، وإن هذا التمثيل يعدّ ماذا يمكن لك أن تكون دون أن توافق أي شيء داخل رأسك.
لا يحبذ كلٌ من دينيت وهمفري بفكرة “الذات الأصولية” لأنهم يعتقدون أنها غير صحيحة بالطريقة التي ينتظم بها العقل البشري. لقد افترضوا أن العقل عبارة عن مجموعة من المكونات الثانوية غير الذكية، مع غياب مركز تحكم تنفيذي شامل. وعلى غرار مستعمرة النمل الأبيض، يتشكّل الإنسان من مجموعة من الأنظمة المستقلة: وحدات وظيفية مسؤولة عن الرؤية (على سبيل المثال)، ومعالجات لغة، ونظرية العقل، والذاكرة العاملة، والتقييم العاطفي، والإدراك المكاني وهلمّ جرا. حيث تؤدي كل هذه الأنظمة البسيطة إلى سلوك ذكي. ولكن على نقيض مستعمرة النمل الأبيض، يكون للإنسان رأس قيادي: أي إن كل واحد منا بإمكانه أن “يخلق أولاً -بلا وعي- واحد أو أكثر من الذوات الخيالة المثالية ثم ينتخب أصلح ذات مدعومة من تلك الذوات في “المنصب” الذي هو العقل داخل الرأس بكل تأكيد ” (1998، 41).
في هذا الرأي، التطور الطبيعي للذات هو مسألة العثور على التمثيل الذي يجعله أكثر منطقية. ولا يجب أن يكون التمثيل المنطقي صحيحاً. ويعكس الرغبة في التماسك (ودور في العلاقات الاجتماعية) بدلاً من الدقة. في اضطراب الشخصية المتعددة/الانفصالية يفترض دنيت وهمفري أن هذه العملية تتشظى إلى الكثير من الأنظمة المتنافسة، حيث أن هناك الكثير من الصور غير المتسقة لـ “أنت الحقيقي”: لذا فإن تبدلات “الغير” تستمر كتمثيلات مختلفة تجعل الإحساس الجزئي بجوانب مختلفة من الذات. إن الاندماج الطبيعي للتمثيلات المختلفة في شكل متماسك تمنع بواسطة سلالات تطور.
وقد طوّر أوين فلانغان Owen Flanagan (1994) نسخة مختلفة عن هذه الرؤية قليلاً. وافترض أن الذات سرد: أي إنها منطق منفتح لما يحدث لك في الواقع. ومن الطبيعي أن نفترض أن هناك ذات واحدة لكل شخص، وأن الذات تسمح استمرارية عبر التغيير كلما تطورنا. ولكن فلانغان يعتقد أن النفس في الحالة الاعتيادية عبارة عن عناصر تعددية (multiplex)، وإنها تسمح بعض التمايز عبر الحالات. وإن مفهوم شخصية كاملة ومتكاملة جيداً هو مفهوم معياري، وهي الطريقة التي نعتقد يجب على الناس أن يكونوها – بدلاً من أي شيء معتاد في علم النفس. فقد وضعناه هدفاً لنعمل من أجل تحقيقه بشتى الطرق.
وتعامل هذه النظريات اضطراب الشخصية المتعددة/الانفصالية كدليل على نظرية معينة لكيفية انفراد الذات من خلال العمل التطوري إلى دمج جوانب متعددة في الشخص الواحد. من ناحية أخرى، فإن إيان هاكينغ (1995، الفصل 16-18) متشكك في أي ادعاءات تفترض أن اضطراب الشخصية المتعددة/الانفصالية دليل على مواقف في فلسفة العقل. وقد ترسم اتجاهات – إذا كنت تؤمن بنظرية دينيت وهمفري عن الذات، سوف تستطيع أن ترى كيف جعلت وجهة نظرهم من معنى لظاهرة اضطراب الشخصية المتعددة/الانفصالية. لكن النظرية الفلسفية يجب أن تؤكد في محل آخر. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن استيعاب المتلازمة يضع النظرية على ما هو حديث جداً: وهنا يفترض هاكينغ أن البشر “قد تمّ تشخيصهم مع وعي مزدوج أو شخصية متعددة لقرنين من الزمان. لكنهم بدأوا يتحدثون عن الطريقة التي يفعلونها الآن، وذلك باستخدام لغة الأعراض التي وصفها دينيت-في الآونة الأخيرة فقط. فاليوم قد قالوا جميعاً مثل هذه الأشياء، أو على الأقل يشتبه في أنهم ملزمون أن يقولها. بهذه الطريقة تعلموا وصف ذواتهم خلال العلاج “(226). فالانفصال قد يكون حالة نفسية حقيقية، ولكن تفاصيل اضطرابات الهوية الانفصالية مثيرة للتشكيك كثيراً لتحمل الكثير من الوزن الفلسفي. لقد شكّ هاكينغ Hacking إن تكون هناك حالة مستقرة لنعلم بشأنها، لأن الفعل الذي يجري تصنيفه يغير السلوك البشري عبر ما يطلق عليه “التأثير اللولبي” Looping Effect (1995، 2007. للاطلاع على المناقشة، انظر كوبر Cooper 2004، مورفي Murphy 2001، 2006 (الفصل السابع)، تسو Tsou 2007). ويأتي التأثير اللولبي عندما يغيّر الأفراد سلوكياتهم استجابة للتصنيف. ويستطيع هذا اللولب الرجعي، مبدئياً، أن يحافظ على السلوكيات مستقرة، ولكن هاكينغ Hacking كان مهتماً في تلك الحالات التي تجعل السلوك غير مستقر. وكذلك درس (1998) حالة العلل العقلية المؤقتة، التي يبدو أنها تنفجر ثم تخرج من الوجود.
4.5 الأوهام
من بين جميع المفاهيم النفسية، ربما الأوهام بالذات نالت القدر الأكبر من المعالجة الحديثة المستفيضة بين الفلاسفة. وتؤيد هذه القضايا فلسفة العقل وفلسفة العلم. وأثار بعض المنظرين صعوبات مفاهيمية فيما يخصّ الأوهام، وسعى آخرون إلى تأطير فرضيات علمية يمكن أن تفسر الأوهام من حيث النقص في معالجة المعلومات أو المشاكل الشخصية الأخرى. وبحث بعض الفلاسفة عن تفسير فلسفي مميز للأوهام، والذي يعتمد على المفاهيم التي صيغت سابقاً في فلسفة العقل.
ومثل حال الكثير من المفاهيم النفسية، فإن مفهوم الوهم له استخدام علمي ذو وعي ذاتي وصريح تماماً، وكذلك استخدامات متنوعة من مفاهيم الحسّ السليم. وهناك تداخل معتبر بين بعض الاستخدامات النفسية وبعض التوظيفات اللارسمية لمصطلح “الوهم”. ولكن من الواضح أن هناك مناسبات يومية نشير فيها الى مصطلح “الوهم” على أنه اعتقاد يبدو خاطئاً بوضوح أو غير مسوّغ للمتحدث. فقد أدعوك أنا بالواهم عندما تعلن أنك ستشتري منزلاً ذا أربعة غرف نوم في منطقتكم يمكنك تحمل نفقاته، دون أن يعني ذلك أن المنطق الذي تحدثت به ينتمي إلى أعراض علّة ذهانية. إنها محض أمنية. ولكن الأوهام بالحس التقني تعبير عن الذهان. ويعرّف الدليل الرابع المنقح (DSM-IV-TR) (819) الوهم بأنه “اعتقاد كاذب استناداً إلى استدلال غير صحيح حول الواقع الخارجي الذي يستمر بثبات على الرغم مما يعتقده الجميع تقريباً وما يشكّل دليلاً أو برهاناً واضحاً وغير قابل للنقاش إلى النقيض …”. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون الوهم غير قابل للتفسير من الناحية الثقافية، بحيث لا تحتسب المعتقدات الدينية أوهاماً، مهما كانت غريبة. حتى إن حقيقة كون المريض ينتمي إلى ثقافة أو مجتمع يعامل فيه المعتقد ذي الصلة بعدّه مطالبة دينية لا يعتبر وهماً. وقد بدا هذا الشرط غريباً لكثير من الناس. وربما استشهد به في تنحي الأطباء النفسيين جانباً وقت النزاعات الدينية، ولكن ربما الطريقة الأفضل لرؤيته كاعتراف بأهمية الشهادة أو السياق الاجتماعي في حيازة المفهوم الاعتيادي على معتقداتنا. بل إننا نتوقع من الناس أن يكتسبوا معتقدات دينية، أو خصوصيات ثقافية تصدم المتفرجين من خارجها فيعتبرونها غريبة الأطوار. ولكن غرابة المعتقدات لا تزعج الحال الطبيعية لعملية انتقال المعتقد المحدد ثقافياً، وبالتالي لا ينبغي أن تعامل منتجات الانتقال الثقافي على أنها مرضية، بغض النظر عن كيف نظنها غريبة الأطوار.
كذلك تعرضت جوانب أخرى من تعريف الوهم إلى التهجّم. واختصر غيبس وفلفورد Gipps and Fulford 2004 بعض الاعتراضات الرئيسية. حيث شملت فكرة وجوب أن يكون الوهم خاطئاً. وكذلك ناقش جاسبرز (1997، 106)، على سبيل المثال، بأن الشخص الذي يعاني من غيرة مرضية، من إن معتقداته الوهمية حول خيانة شريكه “متلازمة عطيل” قد تكون في الواقع صحيحة. وإن الشريك فعلاً غير مخلص. وفي هذه الحالة تقف مصداقية المعتقد إلى جانب النقطة، لأننا يمكن أن نميّز الغيرة المرضية مهما كانت صحة المعتقد. وأشار ريان Ryan (2009، 24) إلى أن الشخص المصاب بمتلازمة إكبوم Ekbom’s syndrome (يعتقد فيه المريض بأن الحشرات غزت جسده!) قد يعاني فعلياً من داء الجرب.
وذكر فلفورد (1989، 204-5) أيضاً مريضاً جلّ أعراض مرضه النفسي هي الوهم وبالتالي فالمريض معتلٌ عقلياً، وإن كان معتل عقلياً حقاً، وثم لا يمكن أن يكون وهماً. من ناحية أخرى، شكك العديد من المنظرين، مثل غراهام وستيفنز (2007، 194)، في أن تكون الأوهام معتقدات حقاً على كل حال. إذ غالباً ما تفتقر الأوهام إلى خصائص المعتقدات التي من الممكن أن تمتلكها. على وجه الخصوص، تبدو الأوهام غالباً فقيرة التكامل مع بقية المعتقدات، ويمكن أن تفتقر إلى الولع المرتبط بالمعتقدات الراسخة. وفندّت ليزا بورتولوتي هذه الاعتراضات (2009)، وكذلك نوقشت الحدود بين الوهم والحالات الأخرى، مثل الخداع الذاتي (باين وفرنانديز Bayne and Fernandez 2009. لمواضيع فلسفية عامة عن الوهم انظر بورتولوتي Bortolotti 2009، رادن Radden 2010).
يمكن أن تبدو تحليلات الوهم وكأنها انعكاسات لمحاولات قام بها علماء الابستميولوجية التحليلية لتعريف المعرفة. فقد نتفق على أن الوهم اعتقاد خاطئ، مثلما المعرفة اعتقاد صائب، ولكن، كحال المعرفة، إننا لن نجد الاستقرار هناك. فالمعرفة اعتقاد حقيقي بالإضافة إلى شيء يربط المعتقد الحقيقي إلى العالم بالشكل الأمثل. لذلك أيضاً، نحاول أن نجد خصائص إضافية للمعتقد الخاطئ لنحوله من معتقد خاطئ إلى وهم. ويرى هذا البرنامج المفاهيمي كمقدمة لتطوّر النظريات التجريبية للوهم، تلك التي يعمل الفلاسفة عليها جنباً إلى جنب مع علماء المعرفة (ديفيز وكولثيرت Davies and Coltheart 2000).
وتميل هذه النظريات إلى افتراض أنه حين يستخدم مصطلح “الوهم” بالحس التقني فإنه يدل على نوع طبيعي نفسي (سامويلز Samuels 2009) الذي يمكن أن يتم بناء هيكله النفسي الأساسي من خلال الانتباه إلى حالاته النموذجية. وباستدعاء هذا المشروع التوضيحي، نستطيع التمييز بين نسختين. واحدة تنطوي على شرح الأوهام على إنها سببت من خلال فشل العلاقات الطبيعية بين مكونات هيكلتنا المعرفي، أو على الأقل تلك الأجزاء التي لها علاقة مع تثبيت المعتقد. والطريقة الأخرى أكثر فلسفية، ولا تزعج نفسها كثيراً بالنظريات السببية للهيكلة المعرفية، وأكثر اهتماماً لإيجاد الموارد في فلسفة العقل التي تميّز الأوهام بطريقة مستنيرة.
صنفت نظريات النفسي-عصبية الأوهام أحادية الصورة (تلك التي تمتاز بمعتقد وهمي سائد حول مسألة واحدة محددة) ضمن معسكرين: نظرية العامل الواحد ونظرية العاملين. وحسب النسخة المألوفة من نظرية العاملين (ديفيز وكولثيرت Davies and Coltheart 2000)، فإن التجربة غير المألوفة تعتبر العامل الأول في التسبب بالوهم، ولكن يجب أن يكون هناك عامل ثان. ويتمثل العامل الأول في عجز يؤثر على استقبال المعلومات عن العالم. ويقوم الوهم بشرح المدخلات-مثلاً: يبدو زوجك غريب الأطوار، لذلك يمكن استنتاج أنه تم استبداله برجل آلي (روبوت). هذا ما يفسر الغرابة، ولكن ليتمكن من بلورة المعتقد لا بدّ أن يكون هناك عجز ثاني، في النظام الذي يشكّل أو يقيّم المعتقدات. يوجد هذا الشأن في النقص العصبي المعرفي الذي يتفاعل مع التجربة. ويمنع العجز في النظام الاستدلالي من رفض المعتقد التوضيحي، على الرغم من عدم وجود مبرر. فإن عدم التوافق مع نظريات العامل الواحد (ديفيز وآخرون Davies et al. 2005) تفتح فكرة أن يكون النقص الأول هو المسبب للوهم.
يبرز المنهج الفلسفي الخالص في شرح الأوهام على الدور الذي يلعبه الوهم في حياة الفرد العقلية، مثلما هو مفهوم في نظريات فلسفة العقل. ويمكن القول إن هذه المحاولات في الاستيعاب الفلسفي للأوهام بدأت مع مفهوم جاسبرز Jaspers (1997) للوهم الأولي، والذي هو تحول ذو مغزى ذاتي في تجربة المريض في العالم. واشتملت الأعمال الحديثة في هذا التراث فكرة الموقف الوهمي لغراهام وستيفنز (2007). وفي سياق مماثل شرحا اضطرابات التفكير من حيث تحديد الأفكار الخاصة أو أن تكون غريبة عن هذه الافكار، واقترحا (194) أن تتشكل الأوهام بموقف أعلى رتبة تجاه حالات قصدية أقل رتبة. وينطوي هذا الموقف على تحديد مع الحالات ذوات الرتب الدنيا، والتي ينظر إليها على أنها تعبير عن معيّة الفرد الخاصة أو الطبيعة العقلية. وكما الحال في معالجة جاسبرز، فإن دور الوهم في الحياة العقلية الذاتية للشخص الواهم لها أهمية كبيرة جداً.
ويمثّل هذان المنهجان طريقتين لما يعمله علم الأمراض النفسي الفلسفي، كمساهمة أساسية في التحقيق العلمي أو كنموذج من فلسفة العقل. وإنها غير متعارضة؛ يمكن أن تساعدنا المشاريع الفلسفية في وصف الظواهر التي يحفل بها الأطباء النفسيون أفضل وأن نجعل المشروع التفسيري أسهل. ومن ناحية أخرى، لا يجدر بنظرية العاملين الاثنين، أو بعض الحسابات النفسي-عصبية الأخرى، أن تزيف وصفاً فلسفياً للأوهام. أو أن تعمل الحسابات الفلسفية افتراضات تجريبية لا مبرر لها، ولكنها قد توجه الأنظار ببساطة إلى الحالة كما خاضها أولئك الذين عانوا منها، أو توجه نحو حساب فلسفي للعقل يعرّف بواسطة الحالات الحقيقية عوضاً عن الحالات غير العملية. لقد شهد العقد الماضي زيادة كبيرة في العمل على نظرية المعرفة (الأبستمولوجيا) وعلى الأهمية الفلسفية للطب النفسي، بل قد أصبح الموضوع حقلاً فلسفياً يمكن تمييزه. لكن ما زالت آثار هذا التطور، فكرياً ومهنياً، بعيدة المنال.
المراجع
Aggarwal N.K., 2013“Cultural Psychiatry, Medical Anthropology, and the DSM-5 Field Trials,” Medical Anthropology, 32: 393–398
American Psychiatric Association, 2000. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, textual revision, Washington, D.C.: American Psychiatric Association; referenced above as DSM-IV-TR.
American Psychiatric Association, 2013. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , 5th edition, Arlington, VA: American Psychiatric Association; referenced above as DSM-5.
Andreasen, N.C., 1997. “Linking Mind and Brain in the Study of Mental Illnesses: A Project for a Scientific Psychopathology,” Science, 275: 1586–93., 2001. Brave New Brain, New York: Oxford University Press.
Ankeny, R.A., 2000. “Fashioning Descriptive Models in Biology: Of Worms and Wiring Diagrams,” Philosophy of Science, 67 (Supplement): S260-S272., 2002. “Reduction Reconceptualized: Cystic Fibrosis As A Paradigm Case For Molecular Medicine,” in L.S. Parker and R.A. Ankeny (eds.), Mutating Concepts, Evolving Disciplines: Genetics, Medicine and Society, Dordrecht: Kluwer: 127–141.
Bayne T. & J. Fernandez (eds.), 2009. Delusion and Self-Deception, New York: Psychology Press.
Beebee, H. & N. Sabbarton-Leary, 2010. “Are Psychiatric Kinds ‘Real’,” European Journal of Analytic Philosophy, 6: 11–27.
Bentall, R.P., 2003. Madness Explained, London: Penguin.
Birnbaum, K., 1923. “The Making of a Psychosis,” Tr. H. Marshall, in S. R. Hirsch & M. Shepherd (eds.), Themes and Variations in European Psychiatry, Bristol: John Wright. 1974: 197–238.
Black, K., 2005. “Psychiatry and the Medical Model,” in E. Rubin & C. Zorumski (eds.), Adult Psychiatry, 2nd edition, Malden, MA: Blackwell, 3–15.
Bolton, D. & Hill, J., 2005. Mind, Meaning and Mental Disorder: The Nature of Causal Explanation in Psychiatry, 2nd ed., New York: Oxford University Press.
Bortolotti, L., 2009 Delusions and Other Irrational Beliefs, New York: Oxford University Press.
Broome, M. & Bortolotti, L. (eds.), 2009. Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical Perspectives, Oxford: Oxford University Press.
Bynum, W.F., 1994. Science and the Practice of Medicine in the Nineteenth Century, Cambridge: Cambridge University Press.
Campbell, J., 2008. “Causation in Psychiatry”, in Kenneth Kendler and Josef Parnas (eds.), Philosophical Issues in Psychiatry, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 196–216.
Canino, G. & Alegria, M., 2008. “Psychiatric diagnosis: Is it Universal or Relative to Culture?” Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49: 237–50.
Carter. K.C., 2003 The Rise of Causal Concepts of Disease, Aldershot: Ashgate.
Charcot, J-M., 1987. Charcot, the Clinician: The Tuesday Lessons, C.G. Goetz (trans.), Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.
Cooper, R., 2004. “Why Hacking is wrong about human kinds,” British Journal for the Philosophy of Science, 55: 73–85., 2007. Psychiatry and Philosophy of Science, Stocksfield: Acumen Publishing.
Craver, C. F. and Bechtel, W., 2007. “Top-down causation without top-down causes,” Biology and Philosophy, 22: 547–563.
Davies, M & Coltheart, M., 2000. “Pathologies of Belief,” Mind and Language, 15: 1–46.
Davies, M., Davies A., & Coltheart M., 2005. “Anosognosia and the Two-Factor Theory of Delusions,” Mind and Language, 20: 241–57.
Dennett, D. & Humphrey, N., 1998. “Speaking for Ourselves,” in D. Dennett, Brainchildren, Cambridge, MA: MIT Press, 31–57.
Edgerton, R. B., 1966. “Conceptions of Psychosis in Four East African Societies,” American Anthropologist, 68: 408-425
Flanagan, O., 1994. “Multiple Identity, Character Transformation and Self-Reclamation,” in G. Graham & L. Stephens (eds.), Philosophical Psychopathology, Cambridge, MA: MIT Press, 135–162.
Frankfurt, H., 1988. The Importance of What We Care About, Cambridge: Cambridge University Press.
Fulford, K.W.M., 1989. Moral Theory and Medical Practice, Cambridge: Cambridge University Press.
Fulford, K.W.M, Thornton, T. & Graham, G., 2006. Oxford Textbook of Philosophy of Psychiatry, New York: Oxford University Press.
Ghaemi, S. N., 2003. The Concepts of Psychiatry, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Giere, R., 1988. Explaining Science: A Cognitive Approach, Chicago: University of Chicago Press.
Gipps, R. and Fulford, K. W. M., 2004. “Understanding the Clinical Concept of Delusion: From an Estranged to an Engaged Epistemology,” International Review of Psychiatry, 16: 225–235.
Glymour, C., 1992. “Freud’s Androids,” in J. Neu (ed.), The Cambridge Companion to Freud, Cambridge, Cambridge University Press, 44–85.
Godfrey-Smith, P., 2006. “The strategy of model-based science,” Biology and Philosophy, 21: 725–740.
Gold, J. & Gold, I., 2014. Suspicious Minds: How Culture Shapes Madness, New York: Free Press.
Graham, G., 2010. The Disordered Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Mental Illness, London: Routledge.
Graham, G. & Stephens, L. (eds.), 1994. Philosophical Psychopathology, Cambridge, MA: MIT Press., 2000. When Self-Consciousness Breaks: Alien Voices and Inserted Thoughts, Cambridge, MA: MIT Press., 2007. “The Delusional Stance”. In Chung, M., Fulford, K.and Graham G. (eds.) Reconceiving Schizophrenia, New York: Oxford University Press, 193–215.
Guze, S. B., 1992. Why Psychiatry Is a Branch of Medicine, New York: Oxford University Press.
Hacking, I., 1995a. Rewriting the Soul, Princeton: Princeton University Press., 1995b. “The looping effects of human kinds,” in D. Sperber, D. Premack & A.J. Premack (eds.), Causal cognition: A Multidisciplinary Debate, Oxford: Clarendon Press: 351–394., 1998. Mad Travelers: Reflections on the Reality of Transient Mental Illnesses, Charlottesville, VA: University Press of Virginia., 2007. “Kinds of people: Moving targets,” Proceedings of the British Academy, 151: 285–318.
Hare, R. D., 1993. Without Conscience, New York: Guilford press.
Heinrichs, R.W. 2001. In Search Of Madness; Schizophrenia and Neuroscience, New York: Oxford University Press.
Hempel, C., 1965. “Fundamentals of Taxonomy,” in C. Hempel, Aspects of Scientific Explanation, New York: The Free Press, 137–154.
Horwitz, A. & Wakefield, J., 2007. The Loss of Sadness, New York: Oxford University Press.
Hummel, J. E., & Holyoak, K. J., 2005. “Relational Reasoning in a Neurally-plausible Cognitive Architecture: An Overview of the LISA Project,” Current Directions in Cognitive Science, 14: 153–157.
Hume, D., 1751. An Enquiry Concerning The Principles of Morals. In Enquiries concerning Human Understanding and concerning the Principles of Morals, edited by L. A. Selby-Bigge, 3rd edition revised by P. H. Nidditch, Oxford: Clarendon Press, 1975.
Insel, T. R., Cuthbert, B., Garvey, M., Heinssen, R., Kozalk, M., Pine, D. S., Quinn, K., Sanislow, C., and & Wang, P., 2010. “Towards a New Classification Framework for Research on Mental Disorders,” American Journal of Psychiatry, 167: 748–751.
Jaspers, K., 1997 General Psychopathology, 7th edition, J. Hoenig & M. W. Hamilton (trans.), Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Kandel, E., 2005. Psychiatry, Psychoanalysis and the New Biology of Mind, Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Kendell, R. E., 1975. The Role of Diagnosis in Psychiatry, Oxford: Blackwell Scientific Publications.
Kendler, K. S. & Campbell, J., 2009. “Interventionist Causal Models in Psychiatry: Repositioning the Mind-Body Problem” Psychological Medicine, 39: 881–887.
Kendler, K. S. & Prescott, C. A., 2006. Genes, Environment, and Psychopathology: Understanding the Causes of Psychiatric and Substance Use Disorders, New York: The Guilford Press.
Kendler, K.S., Zachar, P.&Craver, C., 2011. “What Kinds of Things Are psychiatric Disorders?” Psychological Medicine, 41: 1143-1150.
Kincaid, H., 2008. “Do We Need Theory to Study Disease? Lessons from Cancer Research and Their Implications for Mental Illness,” Perspectives in Biology and Medicine, 51: 367–378.
Kleinman, A., 1987. “Anthropology and psychiatry. The role of culture in cross-cultural research on illness,” British Journal of Psychiatry, 151: 447–454.
Kraepelin, E., 1899. Psychiatry: A Textbook for Students and Physicians, 6th ed. Repr. Canton, MA; Science History Publications 1990.
Lamb, K., Pies, R., & Zisook, S., 2010. “The Bereavement Exclusion for the Diagnosis of Major Depression: To Be, or Not to Be,” Psychiatry, 7: 19–25.
Lewis, D.A. & Levitt, P., 2002. “Schizophrenia as a Disorder of Neurodevelopment,” Annual Review of Neuroscience, 25: 409–432.
Lewis-Fernández R, Hinton D. E., Laria A. J., Patterson E. H., Hofmann S. G., Craske M.G., Stein D.J, Asnaani A.& Liao B., 2010. “Culture and the Anxiety Disorders: Recommendations for DSM-5,” Depression and Anxiety, 27: 212–229.
Maibom, H., 2005. “Moral Unreason: The Case of Psychopathy”. Mind & Language, 20: 237–57.
Marr, D., 1982. Vision, San Francisco: W.H.Freeman.
McHugh, P. & T. Slavney, 1998. The Perspectives of Psychiatry, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
McNally, R.J., forthcoming. The Meaning of Madness, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Meehl, P.E., 1977. “Specific Etiology and Other Forms of Strong Influence: Some Quantitative Meanings,” Journal of Medicine and Philosophy, 2: 33–53.
Mellor, C.S., 1970. “First Rank Symptoms of Schizophrenia,” The British Journal of Psychiatry, 117(536): 15–23.
Murphy, D., 2001. “Hacking’s Reconciliation: Putting the Biological and Sociological Together in the Explanation of Mental Illness,” Philosophy of the Social Sciences, 31: 139–162., 2006. Psychiatry in the Scientific Image, Cambridge, MA: MIT Press., 2008. “Levels of Explanation in Psychiatry,” in K. Kendler & J. Parnas (eds.), Philosophical Issues in Psychiatry, Johns Hopkins University Press, 99–125., 2009. “Psychiatry and the Concept of Disease as Pathology,” in M. Broome & L. Bortolotti (eds.), Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical Perspectives, Oxford University Press: 103–117.
Nichols, S., 2002. “How Psychopaths Threaten Moral Rationalism, or is it Irrational to Be Amoral?” The Monist, 85: 285–304.
Parnas, J. Nordgaard, J. & Varga, S., 2010. “The Concept of Psychosis: A Clinical and Theoretical Analysis,” Clinical Neuropsychiatry, 7: 32–37.
Pearl, J., 2009. Causality, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
Poland, J., Von Eckardt, B. & Spaulding, W., 1994. “Problems with the DSM Approach to Classifying Psychopathology,” in G. Graham & L. Stephens (eds.), Philosophical Psychopathology, Cambridge, MA: MIT Press.
Potter, N., 2009. Mapping the Edges and the In-between: A Critical Analysis of Borderline Personality Disorder, New York, Oxford University Press.
Prinz, J., 2007. The Emotional Construction of Morals, Oxford: Oxford University Press.
Radden, J. (ed.), 2000. The Nature of Melancholy from Aristotle to Kristeva, New York: Oxford University Press.
–––, 2010. On Delusion, London: Routledge.
Ross, D., C. Sharp, R. E. Vuchinich & D. Spurrett, 2008. Midbrain Mutiny: The Picoeconomics and Neuroeconomics of Disordered Gambling, Cambridge, MA: MIT Press.
Ryan, C., 2009. “Out on a Limb: The Ethical Management of Body Integrity Identity Disorder,” Neuroethics, 2: 21–33.
Sadler, J.Z., 2004. Values in Psychiatric Diagnosis, New York: Oxford University Press.
Samuels, R., 2009. “Delusion as a Natural Kind,” in M. Broome & L. Bortolotti (eds.), Psychiatry as Cognitive Neuroscience: philosophical perspectives, Oxford: Oxford University Press, 49–79.
Sanislow, C. A, Pine, D. S., Quinn, K. et al., 2010. “Developing Constructs for Psychopathology Research: Research Domain Criteria,” Journal of Abnormal Psychology, 119: 631–639.
Schaffner, K.F., 1993. Discovery and Explanation in Biology and Medicine, Chicago: University of Chicago Press.
–––, 1994. “Reductionistic Approaches to Schizophrenia,” in J. Sadler, O. Wiggins & M. Schwartz (eds.), Philosophical Perspectives on Psychiatric Diagnostic Classification, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 279–294.
–––, 1998. “Genes, Behaviour, and Developmental Emergentism: One Process, Indivisible?” Philosophy of Science, 65: 209–252.
–––, 2012. “A Philosophical Overview of the Problems of Validity for Psychiatric Disorders,” in K. Kendler and J. Parnas (eds.), Philosophical Issues in Psychiatry II: Nosology, Oxford: Oxford University Press, 169–189.
Spaulding, W., Sullivan, M. & Poland, J., 2003. Treatment and Rehabilitation of Severe Mental Illness, New York: Guilford Press.
Spirtes P., Glymour C. & Scheines, R., 2001, Causation, Prediction and Search, 2nd edition, Cambridge, MA: MIT Press.
Steiger, H., Gauvin, L., Israel, M., Koerner, N., Ng Ying Kin, N.M.K., Paris, J. & Young, S.N., 2001. “Association of Serotonin and Cortisol Indices with Childhood Abuse in Bulimia Nervosa,” Archives of General Psychiatry, 58: 837–843.
Sterelny, K., 2003. The Evolution of Agency and Other Essays, Cambridge: Cambridge University Press.
Tabery, J., 2009. “Difference Mechanisms: Explaining Variation with Mechanisms,” Biology and Philosophy, 24: 645–664.
Thagard, P., 1999. How Scientists Explain Disease, Princeton: Princeton University Press.
Thornton, T., 2007. Essential Philosophy of Psychiatry, New York: Oxford University Press.
Tsou, J. Y., 2007. “Hacking on the Looping Effects of Psychiatric Classifications: What Is an Interactive and Indifferent Kind?” International Studies in the Philosophy of Science, 21(3): 329–344.
Wachbroit, R., 1994. “Normality As A Biological Concept,” Philosophy of Science, 61: 579–591.
Wakefield, J., 1992. “Disorder As Harmful Dysfunction: A Conceptual Critique of DSM-III-R’s Definition of Mental Disorder,” Psychological Review, 99: 232–47.
Weisberg, M., 2007. “Who is A Modeler?” British Journal for the Philosophy of Science, 58: 207–233.
Whitbeck, C., 1977. “Causation in Medicine: The Disease Entity Model,” Philosophy of Science, 44: 619–637.
Widiger, T.A. & Sankis, L.M., 2000. “Adult Psychopathology: Issues and Controversies,” Annual Review of Psychology, 51: 377–404.
Woodward, J.F., 2003. Making Things Happen, Oxford: Oxford University Press.
Zachar, P., 2014. A Metaphysics of Psychopathology, Cambridge, MA: MIT Press.
Zisook, S., Shear, K & Kendler, K.S., 2007. “Validity of the bereavement exclusion criterion for the diagnosis of major depressive episode,” World Psychiatry, 6: 102–107.
أدوات أكاديمية
| How to cite this entry. | |
| Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society. | |
| Look up this entry topic at the Indiana Philosophy Ontology Project (InPhO). | |
| Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database. |
مصادر أخرى على الأنترنت
مقالات ذات صلة
causation: and manipulability | delusion | health | mental illness | models in science | neuroscience, philosophy of | scientific explanation
[1] Murphy, Dominic, “Philosophy of Psychiatry”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/psychiatry/>.
[2] «المترجم» سيتم الاشارة الى مفردات المرض (disease) والعلّة (illness) والاضطراب (disorder) بشكل مختلف في سياق الترجمة، لغرض التمييز بين دلالاتها المختلفة استناداً إلى الاختلاف في السببية المرضية وإلى توفر العلاج الناجع لواحدة دون الأخرى.
[3] «المترجم»: شاعت ترجمة المفردتين الانجليزيتين ethical اخلاقي وmoral خُلُقي بمصطلح واحد، ولأن الفرق بينهما معروف؛ إذ يشير الأخلاقي ethics إلى المعايير والقوانين العامة والانصياع لها، بينما يشير الخُلُقي moral إلى التعقل والتصرف وفق قيم الفضيلة morality التي تتجاوز المصلحة الخاصة. اعتمدت ذلك من ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم لكتاب “الحقيقة والمنهج” لهانز غادامير، وترجمة فلاح رحيم لكتاب “الذات تصف نفسها” لجوديث بتلر