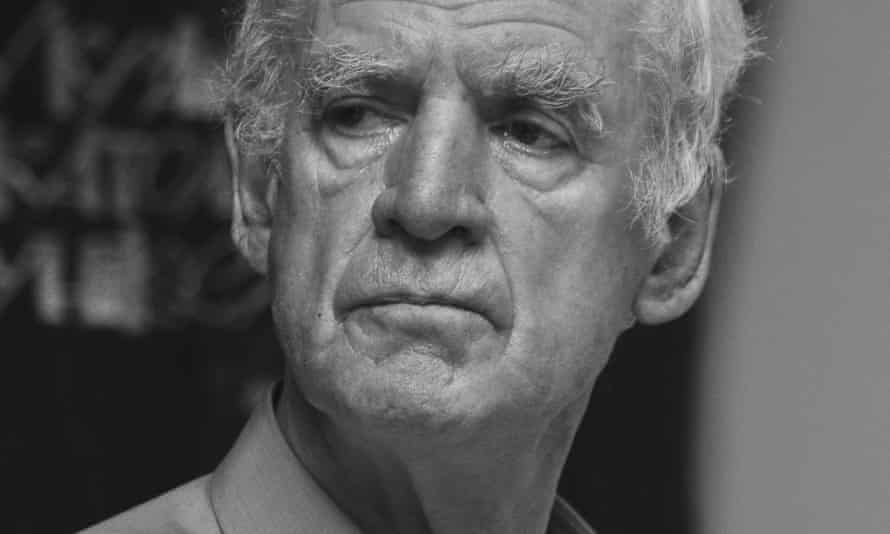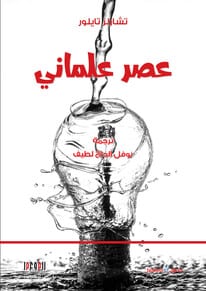
يمكنك شراء نسخة من كتاب (عصر علماني) عبر هذا الرابط
مقدمة المترجم
يميل غالبية الناس إلى اعتبار العلمانية إقصاءً للدين، وليست ظاهرة قائمة بذاتها. أو أنهم يعتبرونها ببساطة انفصالًا قطعيًا بين الكنيسة والدولة – مع ما في ذلك أيضًا من إقصاء للدين. وقد مثّل ذلك جوهر القصة الاجتماعية المعيارية للعلمنة. ويُفهم هذا ضمن بعض الوجوه على أنه تراجع للدين و/أو خصخصة للدين بحيث يتم استبعاده من الحياة العامة ومختلف الفضاءات العمومية.
ولعله لهذا السبب بالذات اعتُبر كتاب عصر علماني المورد الوحيد الأكثر أهمية لمحاولة تطوير فهم أفضل لمعنى العلمانية. فصاحب هذا الكتاب الضخم والكثيف والثري والمعقّد أحيانًا أراد أن يتحرّى بشكل جدّي أوضاع عقائد الإيمان في العالم الغربي حيث استطاعت النزعة الإنسانية الحصرية أن تفرض نفسها كخيار مُتاح لعدد لا يُستهان به من البشر، يتخطى حدود النخب ليشمل عامة الناس([1]).
ينطلق تايلور من تمييز ثلاثة معانٍ مختلفة للعلمانية. يتعلق الأول والثاني، كما قلت أعلاه، باستبعاد الدين من الفضاءات العمومية وبتراجعه. ولقد استطاع تايلور أن يقول في ذلك أمورًا كثيرة على قدر كبير من الأهمية. ولكن الأهم من ذلك، يتمثّل في انتقاده لما يُسميه «قصص الطرح». وهي قصص تعقّب فيها المفكرون الدّين أو خصخصته من دون التفكير بجدّية في التحوّلات التي ينطوي عليها ذلك – ليس فقط في مجال الدين نفسه ولكن كذلك في كل مجال آخر. ولقد مثلت أجزاء لا بأس بها من كتاب عصر علماني مناقشات مطوّلة حول الطرق التي تغيّرت بموجبها الأفكار حول الشخصية والذاتية والعلاقات الاجتماعية والالتزامات الأخلاقية والرفاهية المادية والاهتمامات الاقتصادية نتيجة تغيّر منزلة الدين في علاقة بكل ذلك. ولأجل ذلك تبدو انتقادات تايلور لسرديات العلمنة الكلاسيكية مثيرة للاهتمام وقد اعتبرها مارسيل غوشاي وجيهة تمامًا([2]).
لكن الأجزاء الأكثر عمقًا وأصالة من الكتاب تتعلق بما يسميه «العلمانية بالمعنى الثالث». وفي ذلك يقول تايلور:
أعتقد أنه من المهم اليوم إعادة النظر في علمانية عصرنا انطلاقًا من معنى ثالث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالثاني، من دون أن يعني ذلك أنه لا علاقة له بالأول. ويُسلط هذا المعنى الضوء على أوضاع الإيمان. ويتمثّل التحوُّل إلى العلمانية بهذا المعنى، من بين أمور أخرى، في الانتقال من مجتمع حيث لا خلاف بشأن الإيمان بالله الذي لا يُمثّل إشكالًا، إلى مجتمع لا يرى في ذلك إلا خيارًا من بين خيارات أخرى، ولكنه غالبًا ليس الخيار الذي يمكن استساغته بسهولة([3]).
العلمانية ليست مجرّد تراجع في الإيمان الديني أو الممارسة الدينية، وإنما هي أيضًا تغيير في أوضاع الإيمان ذاتها. فلقد واكب ظهور العلمانية تغيّرات أخرى كثيرة ينبغي تثمينها، مثل فكرة أعمق عن الذات والفاعلية الذاتية ونظام اجتماعي أكثر مساواة. ورغم أن الإيمان قد يكون إشكاليًا بطرق جديدة، فقد يكون أيضًا ذا معنى بطرق جديدة([4]).
لكن كتاب عصر علماني ليس مجرّد نقد لسيسيولوجيا العلمنة وتاريخها بل إنه يثير انتباهنا إلى مختلف المسائل المتعلقة بالذات الإنسانية التي تتّصل بهما. فالكتاب يعرض علينا الكيفية التي تحوّلنا من خلالها من «الذات الما قبل حديثة» إلى «الذات الحديثة» حيث تُحيل الأولى إلى ذات مسامية يسهل اختراقها من قبل قوى سحرية، في حين تُحيل الثانية على ذات عازلة، منيعة، قادرة على الصمود أمام التأثيرات التي كانت تُغذّي التجربة الدينية والروحية للأولى([5]).
إن كتاب عصر علماني كما يقول عنه مارسيل غوشاي:
عظيم بثرائه وعمقه، كتاب ثقافة عالية، ينبغي أن يُتّخذ أمثولة للخبراء الذين يحكموننا فيما يجب أن يكون عليه إنتاج عقلي جدير بهذا الاسم بعيدًا عن مراجعات لجان القراءة. إنه كتاب خصب يتضمن كتبًا أخرى كثيرة في حالة الكمون من خلال المسالك التي يفتحها([6]).
تعمل مكوّنات الكتاب الرئيسة (وقد وردت في خمسة أجزاء: دور الإصلاح، ونقطة المنعطف، وأثر النوفا، وسرديات العلمنة، وأوضاع الإيمان، مبوبة في عشرين فصلًا مسبوقة بمقدمة ومشفوعة بخاتمة: قصص متعددة) على إيجاد إجابة مقنعة للتساؤل المحوري الذي ينطلق منه وما يفتأ يُذكّرنا به من حين لآخر على امتداد الكتاب: «ماذا نعني حين نقول إننا نعيش في عصر علماني ؟»([7])، «لِمَ كان من المستحيل عمليًا في مجتمعنا الغربي في القرن السادس عشر ألا يُؤمن الناس بالله، بينما أصبح ذلك متاحًا بسهولة لدى العديد منّا، بل لا مناص منه كما يعتقد في ذلك الكثيرون، في القرن الحادي والعشرين؟»([8]).
وكان معنى ذلك أن غرض الكتاب صار يدور في فلك هذه المعضلة حيث انبرى تايلور يتحرّى ويتفحّص المجتمعات الغربية بوصفها علمانية بالمعنى الثالث حيث صار فيها الإيمان «خيارًا» شخصيًا ومن ثم أصبح من حق أيّ مؤمن آخر، أو أي شخص غير مؤمن أن يشاركنا المواطنة في فضاء عمومي مشترك من دون أن ينتهي بنا ذلك إلى أيّ نزاع لاهوتي سواء بشأن خلاصنا الأخروي أو طريقته أو عدم ضرورته([9]).
وتكمن طرافة أطروحة تايلور في كتابه هذا في أنه:
يُبشّر بكوننا دخلنا عصرًا علمانيًا لن يكون الدين غير تجربة معيشة لنوع معين من الامتلاء، أو في الدخول في علاقة مع مكان امتلاء مخصوص تعدّه جماعة بشرية دون أخرى عنصرًا مكونًا لهويتها([10]).
وهكذا يمكننا القول إن انبلاج عصر علماني يعني تحوُّل أوروبا من عصر ديني (قبل حديث) يتميّز بطابعه العقدي واللاهوتي المغلق وحيث لا شيء ينازع الإيمان سيادته وحيث لم يكن الإلحاد موقفًا مطروحًا البتة إلى عصر علماني (حديث) تنوّعت فيه أشكال الإيمان حتى صار عدم الإيمان نفسه بديلًا من بين بدائل أخرى بما فيها الإلحاد نفسه، ومن ثم تعيّن علينا القبول بالآخر في اختلافه بل وبعدم إيمانه بما نؤمن به أيضًا وبذلك انتقلنا أولًا إلى نمط من مخالطية اجتماعية بين الغرباء ثم إلى مخالطية اجتماعية بين مواطنين. ولم تعد ماهية الدين هي التي تعنينا وإنما ما يعنيه الدين بالنسبة إلينا «نحن» الذين نعيش في عصر علماني .
وخلاصة القول، أيًا يكن الموقف من مضامين الكتاب، فإنه يدعونا بإلحاح إلى معاودة النظر في تجاربنا الروحية والأخلاقية والحياتية اليومية، الداخلية والخارجية، في علاقة بالمتعالي والمحايث، وبالمقدّس والدنيوي، وبالعالم الطبيعي والعالم الخارق للطبيعي عسى ألا تستغرقنا أيّ من تلك التجارب على حساب الأخرى.
نوفل الحاج لطيف
كانون الثاني/يناير 2019
توطئة
يجد هذا الكتاب نواته الأساسية في محاضرات جيفورد في إدنبره ربيع عام 1999، بعنوان «العيش في عصر علماني ؟». لقد مرَّ وقت منذ تلك المحاضرات، وقد اتَّسع نطاق الكتاب. في الواقع، تشمل محاضرات عام 1999 الأجزاء الثلاثة الأولى من هذا الكتاب، ويتناول الجزءان الرابع والخامس المسائل التي أردت مناقشتها آنذاك، لكن لم يسعفني الوقت والكفاءة الضروريين لمعالجتها بشكل صحيح. (آمل أن تكون السنوات الماضية قد ساعدتني في هذا الشأن).
لقد تطوَّر الكتاب منذ عام 1999، وتوسَّع نطاقه أيضًا. لكن العملية الأولى لم تواكب الثانية: يتطلب توسيع نطاق المسألة كتابًا أكبر بكثير من هذا الذي أُقدمه للقارئ. لقد قدَّمت رواية لقصة، ما نسميه عادة «العلمنة» في الغرب الحديث. ومن أجل ذلك، اجتهدت في توضيح معنى هذه العملية، التي كثيرًا ما يُستشهد بها، ولكن نادرًا ما تُحدَّد بشكل واضح. ومن أجل معالجتها بشكل صحيح، تعيّن عليّ أن أروي قصة أكثر كثافة ولا انفصام لها، ولكن لم يسعفني الوقت أو الكفاءة للقيام بذلك.
أطلب من القارئ الذي يقع بين يديه هذا الكتاب ألا يعتبره كحجة وقصة لا انفصام لها، بل كمجموعة من المقالات المتشابكة، التي تُلقي الضوء على بعضها البعض، وتُقدِّم سياقًا مناسبًا لبعضها البعض. وآمل أن ينشأ المعنى العام لهذه الأساطير من هذه المعالجة المبدئية، وسأقترح طرقًا أخرى لتطوير الحجة وتطبيقها وتنقيحها وتبادلها.
أود أن أشكر لجنة محاضرات جيفورد في إدنبرة لتوفير هذه الفرصة لإطلاق هذا المشروع. كما أنني ممتن للمجلس الكندي للفنون الذي خصني بمنحة إسحاق كيلام Isaac Killam للبحث خلال الفترة 1996-1998، مما سمح لي بالبدء في تأليف هذا الكتاب؛ وإلى مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية والإنسانية في كندا لمنحي جائزة الميدالية الذهبية لعام 2003. لقد استفدت كثيرًا من زياراتي لمعهد العلوم الإنسانية Wissenschaften vom Menschen في فيينا عامي 2000 و 2001. ولمعهد الدراسات المتقدمة في برلين Wissenschaftskolleg zu Berlin الذي خصَّني بمنحة باحث في 2005-2006 وهو ما مكنني من إنهاء المشروع في أفضل الظروف الممكنة، ووفَّر لي فرصة تبادل النقاشات مع جوزيه كازانوفا José Casanova وهانس جوا Hans Joas، اللذين كانا يهتمان بمشاريع موازية.
يجب أن أُعرب عن امتناني لأعضاء الشبكة القريبة من مركز دراسات الثقافات Centre for Transcultural Studies. وقد ظهرت بعض المفاهيم الأساسية التي استخدمتها في هذا الكتاب خلال عمليات التبادل في ما بيننا.
ساعدني براين سميث Bryan Smyth كثيرًا في إعداد الكتاب، فقد ترجم العديد من الاقتباسات أو تحرّاها بالإضافة إلى إعداد فهرس الأعلام والمصطلحات. وتعود الترجمات غير الدقيقة في الغالب إليه، وقد اجتهدت في تنقيحها في بعض الأحيان.
المقدمة
[ 1 ]
ماذا نعني حين نقول إننا نعيش في عصر علماني ؟ يكاد يتَّفق الجميع على أن ذلك يُشير إلى عصرنا نحن بمعنى ما: أعني بـ«نحن»، نحن الذين نعيش في الغرب، وبعبارة أخرى في شمال الغرب، أو بمعنى آخر، عالم شمال الأطلسي، على الرغم من أن العلمانية تمتد جزئيًا أيضًا وبطرق مختلفة، إلى أبعد من هذا العالم. ويبدو أن العلمانية تفرض نفسها فرضًا لا سبيل إلى مقاومته كلما هممنا بمقارنة هذه المجتمعات مع أي مجتمعات أخرى في تاريخ البشرية: أي مع كل المجتمعات الأخرى المعاصرة تقريبًا (على سبيل المثال، الدول الإسلامية والهند وأفريقيا)، من جهة، ومع بقية المجتمعات التي عرفها التاريخ البشري، سواء في المحيط الأطلسي أو في غيره، من جهة أخرى.
بيد أن هذه العلمانية تبدو مستغلقة على الفهم. ويمكن تحديد أهم ميزاتها ضمن اتجاهين رئيسين - أو ربما طائفتين من الاتجاهات. يتمحور الأول حول المؤسسات والممارسات المشتركة - الدولة يقينًا ولكن ليست الوحيدة. ويكمن الاختلاف، إذن، في أنه في حين أن التنظيم السياسي للمجتمعات ما قبل الحديثة كافة كان على علاقة بشكل إيماني معين أو بولاء لله أو بتمثل لحقيقة نهائية، لأن في ذلك ضمانة له وفيه يجد أساسه، لا أثر لهذه العلاقة في الدولة الغربية الحديثة. فالكنائس الآن منفصلة عن البنى السياسية (مع بعض الاستثناءات، في بريطانيا والدول الإسكندنافية، وإن كانت متواضعة وغير متشددة بحيث لا تُصلح لأن تكون استثناءات حقيقية). وصار حضور الدين أو غيابه مسألة خاصة جدًا. كما صار المجتمع السياسي شأنًا يهمّ المؤمنين (من جميع المشارب) وغير المؤمنين على حد سواء([11]).
ولننظر في الأمر من زاوية أخرى، ففي مجتمعاتنا «العلمانية»، يمكنك أن تنخرط بشكل كامل في الحياة السياسية من دون أن تلتقي الله البتة، أي من دون أن تشعر بأيّ أهمية لإله إبراهيم قد تكون حاسمة بحيث تفرض نفسها بكل قوة ولا لبس فيها. ولا تمثل بعض المناسبات التي نقضيها في ممارسة طقوس غير وظيفية أو صلوات تفتقد لأبسط معاني الخشوع اليوم فرصة للالتقاء به، خلافًا لما كان سائدًا في القرون السابقة في العالم المسيحي حيث لم يكن ممكنًا البتة التخلف عن تلك المناسبات.
ومن زاوية النظر هذه ليست الدولة فقط هي المعنية بهذا التحوُّل. ولو تعقبنا أثر حضور الله على مدى قرون من حضارتنا، لتبيّن لنا أنه كان حاضرًا بالمعنى المذكور أعلاه في مجموعة كاملة من الممارسات الاجتماعية وليس السياسية فقط، وفي كل مناحي المجتمع: على سبيل المثال، عندما كان نمط نظام الحكم المحلي أبرشيًا، وكانت الأبرشية لا تزال في المقام الأول جماعة عمادها الصلاة. أو عندما حافظت جمعيات الحرفيين والتجار، ذات النفوذ الكبير في القرون الوسطى (النقابات) على حياة طقسية أكثر من شكليّة. أو عندما كانت الأعياد الدينية على غرار موكب عيد القربان، الوسائل الوحيدة التي يستطيع من خلالها المجتمع في جميع مكوناته أن يكشف عن نفسه في تلك المجتمعات، لا يمكن الدخول في أي نوع من النشاط العمومي من دون «الالتقاء بالله» بالمعنى المذكور أعلاه. ولكن الوضع مختلف تمامًا اليوم.
وكلما توغَّلنا أكثر في تاريخ البشرية، اكتشفنا أن جملة التمييزات بين مناحي الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في مجتمعنا اليوم، لا معنى لها في المجتمعات القديمة. ففي تلك المجتمعات، كان الدين «في كل مكان»، ومتشابكًا([12]) مع كل شيء آخر، ولا يُشكِّل بأي حال من الحالات «مجالًا» منفصلًا.
يمكن أن تفهم العلمانية، إذن، هنا ضمن حدود الفضاءات العمومية من حيث هي فضاءات تزعم أنها خالية من أي حضور لله أو أي إحالة إلى حقيقة نهائية، أو بعبارة أخرى، إن القواعد والمبادئ التي نتبعها والمداولات التي ننخرط فيها في مختلف فضاءات النشاط الاقتصادي والسياسي والثقافي والتعليمي والمهني والترفيهي، لا تُحيلنا عمومًا إلى الله أو إلى أي معتقدات دينية، وأن الاعتبارات التي نعمل وفقها متضمنة في كل صيغة من صيغ «العقلانية» الخاصة بكل فضاء من فضاءات هذه الأنشطة-أعظم كسب في الاقتصاد، وأكبر فائدة لأكبر عدد في المجال السياسي، وهَلُمَّ جرًّا. وفي ذلك تناقض صارخ مع الفترات السابقة، حيث أقرّ الإيمان المسيحي أوامر تسلطية، في كثير من الأحيان عبر أفواه رجال الدين، وهي أوامر لا يمكن تجاهلها بسهولة في أي من هذه الميادين، مثل حظر الربا، أو الالتزام بإنفاذ الأرثوذكسية([13]).
ولكن أن ننظر إلى هذا الشأن من زاوية الأوامر أو من زاوية الطقوس أو الاحتفالات، فإن إخلاء الدين من الفضاءات الاجتماعية التي تتمتع بالاستقلالية، يجد صداه، بطبيعة الحال، لدى الغالبية العظمى من الناس الذين ما زالوا يعتقدون في الله، ويمارسون طقوسهم الدينية بهمَّة وعزم. وهنا تحضر في الذهن حالة بولندا الشيوعية. ومرة أخرى ليس المثال الأفضل لأن العلمانية العمومية فرضت هناك من قبل نظام ديكتاتوري لا يحظى بشعبية. بينما تبدو حالة الولايات المتحدة مذهلة في هذا الصدد، فهي من أولى المجتمعات التي فصلت الكنيسة عن الدولة، وكذلك في المجتمع الغربي حيث يشهد أَسمى مستويات الإيمان والممارسة الدينية، بحسب ما تشير إليه الإحصائيات.
تلك هي القضية التي غالبًا ما يرغب الناس في إثارتها عندما يتحدثون عن عصرنا على أنه عصر علماني ، من خلال تمييزه بحنين أو بارتياح، عن العصور السابقة حيث هيمن الإيمان وسادت التقوى. وبحسب هذا المعنى الثاني، تتوافق العلمانية مع تراجع الإيمان والممارسة الدينية حيث تخلى الناس عن الله وهجروا الكنيسة. وبهذا المعنى، أصبحت بلدان أوروبا الغربية علمانية بالأساس-بما في ذلك تلك التي احتفظت بالله في الفضاء العمومي وإن كمرجع غير وظيفي.
أعتقد أنه من المهم اليوم إعادة النظر في علمانية عصرنا انطلاقًا من معنى ثالث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالثاني، من دون أن يعني ذلك أنه لا علاقة له بالأول. ويسلط هذا المعنى الضوء على أوضاع الإيمان. ويتمثل التحوُّل إلى العلمانية بهذا المعنى، من بين أمور أخرى، في الانتقال من مجتمع حيث لا خلاف بشأن الإيمان بالله الذي لا يمثل إشكالًا، إلى مجتمع لا يرى في ذلك إلا خيارًا من بين خيارات أخرى، ولكنه غالبًا ليس الخيار الذي يمكن استساغته بسهولة. وفي هذا الاتجاه، في مقابل المعنى الثاني، على الأقل، تُعدّ الكثير من الأوساط في الولايات المتحدة علمانية، وأعتقد أن الولايات المتحدة برمتها علمانية، خلافًا لمعظم المجتمعات الإسلامية، أو الأوساط التي تعيش فيها غالبية من الهنود. ولا يهم إذا أظهرت إحدى الإحصاءات أن معدل ارتياد الكنيسة أو كنيس يهودي في الولايات المتحدة، أو بعض أنحائها، قريب من معدل ارتياد المسجد يوم الجمعة في باكستان والأردن مثلًا (فضلًا عن الصلاة اليومية). ومن شأن ذلك أن يكون دليلًا على أن هذه المجتمعات لا تختلف كثيرًا في ما بينها، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العلمانية في المعنى الثاني. ومع ذلك، من البديهي، فيما يبدو، أن هناك اختلافات كبيرة بين هذه المجتمعات في ما يتعلق بعقائد الإيمان، وهي اختلافات نابعة في جزء منها من حقيقة أن هذا الإيمان هو خيار، وبمعنى ما خيار محاصر في المجتمع المسيحي (أو «ما بعد المسيحي»)، خلافًا لما هو عليه الحال (أو ليس بعد) في المجتمعات الإسلامية.
إن قصدي من وراء ذلك هو تفحّص مجتمعنا العلماني على ضوء هذا المعنى الثالث، ويمكن اختصاره في التالي: إن التحوُّل الذي أُعنى بتحديده وتعقبه هنا هو ذاك الذي يأخذنا من مجتمع كان يستحيل فيه عمليًا عدم الإيمان بالله، إلى مجتمع يكون فيه الإيمان خيارًا من بين خيارات أخرى، حتى بالنسبة للمؤمنين الأكثر تشددًا. وقد يكون غير مقبول بالنسبة لي أن أتخلّى عن إيماني، ولكن هناك آخرين، بمن فيهم ربما أقرب الناس إليّ لا يؤمنون (على الأقل لا بالله ولا بأي كائن متعال)، ورغم ذلك لا أستطيع بكل أمانة أن أشجب نمط عيشهم كنمط منحرف ومتهور وجائر. فلم يعد الإيمان بالله بديهيًا. فقد صارت هناك بدائل أخرى. وهذا معناه أيضًا على الأرجح، في أوساط معينة على الأقل، أنه من الصعب أن يحافظ المرء على إيمانه. سيشعر البعض بأنهم مكرهون على التخلي عنه، وإن كانوا يذرفون الدمع حزنًا على فقده. وتلك تجربة مألوفة في مجتمعاتنا، على الأقل منذ منتصف القرن التاسع عشر. وسيكون هناك آخرون كثر لا يرون في الإيمان حتى مجرد خيار مشروع. والثابت أن عددهم في أيامنا بالملايين.
العلمانية بهذا المعنى تتعلق بمسألة سياق الفهم برمته الذي تتحقق فيه تجربتنا وسعينا في أبعادهما الأخلاقية والروحية والدينية. وأعني (سياق الفهم) هنا، في الآن ذاته المسائل التي ربما صيغت على نحو صريح من قبل الجميع تقريبًا، مثل كثرة الخيارات، وتلك التي تشكل الخلفية الضمنية لتجربتنا تلك ولسعينا ذاك بشكل غامض والتي تشكل بحسب عبارة هيدغر «ما قبل-الأنطولوجيا».
يكون عصر أو مجتمع علمانيًا أم لا تبعًا لأوضاع تجربة الروحي والسعي إليه. وقطعًا، يتوقف هذا البُعد على مدى تطابق هذا العصر أو هذا المجتمع مع العلمانية بالمعنى الثاني، الذي يطبع مستويات الإيمان والممارسة، ولكن ليست العلاقة المتبادلة بين المعنيين بسيطة، كما في حالة الولايات المتحدة الأميركية. أما بالنسبة للمعنى الأول، الذي يتعلق بالفضاء العمومي، فقد لا تكون له أيّ علاقة مع المعنيين الآخرين (كما في حالة الهند). ولكني مقتنع تمامًا بأن التحوُّل إلى العلمانية العمومية في الحالة الغربية هو الذي ساهم في نحت معالم عصر علماني بالمعنى الثالث.
[ 2 ]
إن تبيّن أوضاع التجربة في تفاصيلها مهمة صعبة للغاية. ويرجع ذلك في جزء منه لأن الناس يميلون إلى تركيز اهتمامهم على الإيمان في حد ذاته. ما يثير اهتمام الناس عادة وما يثير كربًا وصراعًا، هو المسألة الثانية: في ماذا يعتقد الناس وفي ماذا تتمثل ممارساتهم؟ كم عدد الذين يؤمنون بالله؟ إلى أين يتَّجه هذا الميل؟ ويتعلق الاهتمام بالعلمانية العمومية في كثير من الأحيان بمسألة في ماذا يعتقد الناس وفي ماذا تتمثل ممارساتهم، وعلى أيّ نحو يتم التعامل معهم تبعًا لذلك: هل يهمش نظامنا العلماني المسيحيين المؤمنين، كما يدّعي البعض في الولايات المتحدة الأميركية؟ أم أنه يشجب الجماعات غير المعترف بها حتى الآن؟ الأميركيون من أصل أفريقي أو من أصل إسباني؟ المثليون جنسيًا والسحاقيات أيضًا؟
لكن عادة ما تُطرح المسألة الرئيسة التي يُثيرها الدين في مجتمعاتنا، وفق مقتضيات الإيمان. وقد عرفت المسيحية الأولى نفسها دائمًا في علاقة ببيانات التصديق. وغالبًا ما اقترنت العلمانية بالمعنى الثاني بتراجع الإيمان المسيحي. وقد ساهم في هذا التراجع بشكل كبير ظهور أشكال إيمان أخرى، مثل الإيمان بالعلم وبالعقل، كما ساهم فيه أيضًا ما شهدته بعض العلوم من تطور في مجالات معينة: مثل نظرية التطوُّر، أو التفسيرات العصبية الفيزيولوجية لوظائف العقل.
ويكمن السبب وراء رغبتي في تحويل التركيز على أوضاع الإيمان وتجربة الروحي والسعي إليه في جزء منه، إلى أنني لم أكن مقتنعًا بهذا التفسير للعلمانية بالمعنى الثاني: العلم يُفنِّد الإيمان الديني ومن ثم يستبعده. ولست مقتنعًا بذلك على مستويين: أولًا، لا أرى أيّ حكمة في الحجج المُفترضة التي تربط مثلًا بين اكتشافات داروين والتفنيد المزعوم للدين. وثانيًا، لهذا السبب جزئيًا، لا أرى في ذلك تبريرًا كافيًا لارتداد الناس عن إيمانهم، حتى حين يُعربون هم أنفسهم عن ذلك وفق مصطلحات داروين كقولهم مثلًا: «فند داروين الكتاب المقدَّس»، كما زعم تلميذ هارو Harrow في تسعينيات القرن التاسع عشر([14]). وبطبيعة الحال يمكن لحجج سيئة أن تلعب دورًا حاسمًا في تفسيرات سيكولوجية وتاريخية لها تحظى بمصداقية تامة. ولكن حجج سيئة مثل هذه، إذ تهمل الكثير من الإمكانيات التي أثبتت جدواها في الأصولية والإلحاد على حد السواء، تدعو إلى التفكير في الأسباب التي حالت دون أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الاتجاهات الأخرى. أعتقد أن عمق هذه المسألة يجد مداه في هذا المستوى الذي أحاول استكشافه. وسأعود إلى ذلك عاجلًا.
وحتى أكون أكثر وضوحًا ولو قليلًا في هذا المستوى، أريد أن أتحدث عن الإيمان وعدم الإيمان، لا بوصفهما نظريتين متنافستين، أي كطريقتين يتمثل من خلالهما الناس الوجود والأخلاق سواء أكان مرجعهم في ذلك الله أم شيء ما في الطبيعة، أو أيًا كان، وإنما بوصفهما تجربتين مختلفتين معيشتين تشاركان في فهم حياتك بطريقة أو بأخرى بحسب نمط عيشك الذي ترتئيه لنفسك مؤمنًا أم غير مؤمن.
وكمؤشر تقريبي أول للاتجاه الذي أعتزم أن أتوخاه، يمكن أن نقول إن تلك هي الطرق البديلة لنعيش حياتنا الأخلاقية/الروحية في معناها الأشمل.
ونعتبر أن حياتنا بأسرها، و/أو الفضاء حيث نعيش حياتنا، يتشكلان أخلاقيًا/روحيًا. ويكمن الامتلاء أو الثراء في مكان ما، في نشاط ما، أو وضع ما، أي في ذلك المكان (النشاط أو الوضع)، تبدو الحياة أكثر امتلاءً، وأكثر ثراءً، وأكثر عمقًا، وأكثر إثارة للاهتمام، أكثر إعجابًا، وأكثر مما ينبغي لها أن تكون. ولعله مكان نستمد منه القوة: فغالبًا ما نشعر بشيء ما في أعماقنا يدفعنا ويلهمنا. وكأن الشعور بالامتلاء لا يعدو أن يكون سوى شيء نلمحه من بعيد. إن حدسنا بما ينبغي أن يكون الامتلاء متين، كلما كنا في وضع من السلام أو الكمال على سبيل المثال، أو قادرين على العمل على هذا المستوى من الإخلاص أو الكرم أو الهجر أو نسيان الذات. ولكن في بعض الأحيان قد نعيش لحظات من الامتلاء، من الفرح والكمال عندما نشعر بأننا أدركنا ذلك. ولننظُر في هذا المثال المُستمَدّ من السيرة الذاتية لبيدي غريفثس:
ذات مساء من الثلاثي الأخير بالمدرسة كنت أَتجوَّل لوحدي وأستمع لجوقة من الطيور تغني، غناء لا يحدث في تلك الفترة من السنة إلا عند الفجر أو عند غروب الشمس. أتذكر الآن صدمة المفاجأة التي أحدثها فيّ ما تناهى إلى سمعي من ذلك الغناء كما لو كنت أستمع لذلك لأول مرة. وكنت أتساءل عما إذا كانت العصافير تغني على هذا النحو على مدار السنة ولكني لم ألاحظ ذلك قط من قبل. وبينما أنا كذلك امتد بصري إلى أشجار الزعرور وقد أزهرت تمامًا، ومرة أخرى انتابني إحساس بأني لم أرَ هذا المشهد وأني لم أستمتع بعذوبته قبل ذلك اليوم قط. وفجأة انتهى بي المسير بين أشجار حديقة الفردوس حيث جوقة من الملائكة تغني في مشهد ما كان لمشهد غيره أن يثير فيّ ما أثاره فيّ من روعة. ثم بلغت ناحية حيث غروب الشمس يغمر الملاعب. وفجأة طارت قبَّرة من حولي حيث كنت واقفًا بجانب شجرة وانطلقت في الغناء وهي تعلو فوق رأسي، ثم استمرت تُغني حتى استكانت. وكلما غشى الغسق الأرض أكثر بدأ الصمت يعمّ أرجاء المكان. أتذكر شعور الخشوع الذي انتابني حيث شعرت بالرغبة في السجود على الأرض كما لو كنت في حضرة ملاك. وأنا لا أكاد أجرؤ على النظر إلى وجه السماء، فقد كانت تبدو لي كستار يحجب عني وجه الله([15]).
ينبع الشعور بالامتلاء، في هذه الحالة، من تجربة تقلبنا رأسًا على عقب وتثير انزعاجنا من خلال إحساسنا العادي بوجودنا في العالم، وبين أشيائه المألوفة وأنشطته ونقاطه المرجعية. وقد تنشأ عن ذلك، كما يقول بيتر بيرغر في وصفه لأعمال روبرت موزيل، عندما ««يُلغى» الواقع العادي ويشعّ شيء آخر مروّع»، حالة من الوعي عبَّر عنها موزيل باسم «حالة أخرى»([16]).
لكن قد يحدث أن نشعر بالامتلاء من دون أن نعيش تجربة معيّنة من هذا القبيل، سواء أكانت مرحة أم مروّعة. قد يحدث أن نتجاوز تمزقاتنا العميقة واضطراباتنا ومخاوفنا وأحزاننا التي تشدّنا إلى الوراء أو أن نتطابق معها، بحيث نشعر فجأة متّحدين، غير مكترثين، بأنه لا تعوزنا القدرة وأننا مفعمون بالحيوية. تتعاضد تطلعاتنا وطاقاتنا الحيوية بطريقة ما، بما يُعزز بعضها البعض فلا يُكبّلنا الخمول النفسي. تلك هي التجربة التي حاول شيلر أن يفهمها من خلال تصوّره لـ«اللعب»([17]).
تساعدنا هذه التجارب، وتجارب أخرى لا يمكن أن نحصيها هنا، على تحديد مكان الامتلاء([18])، الذي نتَّجه نحوه أخلاقيًا أو روحيًا. وتقودنا هذه التجارب لأنها تعطينا فكرة على ما هي عليه: وجود الله أو صوت الطبيعة أو القوَّة التي تتدفق عبر كل شيء، أو التطابق مع رغبة أو دافع في تشكيلها. غير أن هذه التجارب تبدو في كثير من الأحيان مزعجة وملغزة أيضًا. وقد ينتابنا إحساس غريب وملتبس وغامض بشأن مصدرها. ويؤثر فينا ذلك بشدة، ويجعلنا في حيرة وارتباك. نناضل من أجل أن نُعبِّر عمّا عشناه في تفاصيله. وإذا نجحنا في صياغة ذلك، وإن على نحو جزئي فقط، نشعر بالانعتاق، كما لو كانت سلطة التجربة قد تعززت، إذ تركزت وعُبِّر عنها في تفاصيلها وأُعتقت.
يمكن أن يساعد هذا في تحديد وجهة لحياتنا. ولكن لا يخلو الإحساس بالتوجيه من منحدر سلبي أيضًا. حيث نواجه قبل كل شيء مسافة، غيابًا، استبعادًا، عجزًا لا يمكن التغلب عليه على ما يبدو للوصول إلى هذا المكان، انعدام القدرة، ارتباك، أو أسوأ من ذلك، حالة غالبًا ما توصف في التقليد بالكآبة، والسأم (السأم، بودلير). وما هو فظيع في هذه الحالة الأخيرة هو أننا نفقد الإحساس بالوجهة التي يوجد فيها مكان الامتلاء، بل حتى مما يتكون الامتلاء، ونشعر أننا قد نسينا إلى أيّ شيء يشبه أو أكثر من ذلك لم نعد نؤمن به. ولكن بؤس الغياب، والفقدان، لا يزال حاضرًا، بل هو في بعض النواحي أكثر حدَّة([19]).
يعرض التقليد صورًا أخرى من الاستبعاد، حيث يُهيمن الشعور باللعنة، بالاستبعاد المستحق إلى الأبد من الامتلاء، أو صور الأسر، في أشكال بغيضة تُجسِّد النفي التام للامتلاء، على غرار أشكال الحيوانات الوحشية التي نراها في لوحات هيرونيموس بوش، على سبيل المثال.
ثم ثالثًا، هناك الحالة الوسطى المستقرة وهي الحالة التي نطمح إليها غالبًا وفيها نعثر على وسيلة للهروب من أشكال النفي والاستبعاد والفراغ، من دون أن نصل إلى الامتلاء. وغالبًا ما نبلغ هذه الوضعية الوسطية من خلال نظام الحياة الثابت والروتيني حيث ننجز مهامًا ذات معنى بالنسبة لنا. مهام من شأنها مثلًا أن تساهم في سعادتنا العادية، أو أن تزدهر بطرق مختلفة، أو أن تساهم في ما نتصوره على أنه خير. أو هي مهام في أفضل السيناريوهات تشمل كل هذه المستويات الثلاثة: على سبيل المثال نسعى جاهدين للعيش بسعادة مع الزوج والأبناء، بينما نمارس مهنة من أجل تحقيق الازدهار فنساهم بذلك بداهة في الرفاه الإنساني.
ولكن من الضروري لهذه الحالة الوسطى بداية أن يستحضر الروتين والنظام والتمثل المنتظم للمعنى في أنشطتنا اليومية، بطريقة أو بأخرى، الاستبعاد، أو السأم، أو الأسر بشكل وحشي. وثانيًا، أن نشعر باستمرار بالاتصال بمكان الامتلاء، وببطء التوجه نحوه على مر السنين. لا يمكن أن نصرف النظر عن هذا المكان، أو أن نيأس منه تمامًا، من دون تقويض توازن الحالة الوسطى([20]).
قد يبدو توصيفي لهذه البنية العامة المفترضة لحياتنا الأخلاقية/الروحية يتَّجه أكثر نحو قناعات المؤمن. ومن الواضح أن الجمل الأخيرة من الفقرة السابقة تتطابق تمامًا مع الحالة الذهنية للمؤمن في سياق الحالة الوسطى. فالمرء لا يفتأ ينزّل الإيمان ضمن سياق حالة أكثر كمالًا. غالبًا ما تُوصف بأنها حالة خلاص، وليس له أن ييأس منها، حالة يشعر على الأقل بأنه قريب منها، إن لم يكن بالفعل قد اتخذ بعض الخطوات الصغيرة في هذا الاتجاه.
ولكنْ، بدون شك، هناك العديد من غير المؤمنين مقتنعون بأن الحياة بالنسبة إليهم ليست شيئًا آخر غير ما وصفته بـ«الحالة الوسطى». وتلك هي الغاية. أن نعيش في رغد وامتلاء ذلك ما نطمح إليه-على سبيل المثال، السيناريو الثلاثي الذي وصفته أعلاه. ذلك أقصى ما تقدمه الحياة البشرية، ولكن من وجهة النظر هذه، (أ) لا شيء تافه، و(ب) إن علينا الاعتقاد بأن ما هو أكثر من ذلك، على سبيل المثال، بعد الموت، أو في حالة مستحيلة من القداسة، الهروب وتقويض كل إمكانية للسعي إلى هذا التميّز البشري.
لذلك وصف الامتلاء كـ»مكان» آخر من هذه الحالة الوسطى قد يكون مضللًا. ومع ذلك هناك مماثلة بنيوية هنا. يطمح غير المؤمن أن تكون الحياة بالنسبة إليه مدعاة للرضا تمامًا، حيث كل شيء فيها يُسعده. وحيث يتوافق إحساسه الكامل بالامتلاء مع كل ما فيها. بيد أن هذا الطموح لم يتحقق بعد. إما لأن حياته لم تبلغ جمامها فعلًا: فقد لا يكون زواجه سعيدًا فعلًا، ولكن عمله مزدهر، أو لأنه يقدّر أن هذه المهمة لها فائدتها لصالح البشرية. وإما لأنه يقدر على نحو معقول بأن يفعل ذلك استنادًا إلى قواعد معينة، ولكن خلافًا لما يُعلن، لا يمكن له إثبات إحساسه بالأمان وبالرضا والامتلاء في حياته. وبعبارة أخرى، هناك شيء يطمح إليه أبعد مما هو عليه. ولعله لم يبلغ بعد على نحو كامل مرتبة الحنين لشيء متعال. وبطريقة أو بأخرى، لا يزال أمامه الكثير. ذلك ما تُحيل عليه صورة المكان هذه، رغم أن هذا المكان ليس «آخر» بالمعنى الصريح حيث يفترض أنشطة مختلفة تمامًا، أو حالة في ما وراء هذه الحياة.
أما تحديد هذه الأبعاد المميزة للحياة الإنسانية الأخلاقية/الروحية باعتبارها مقومات الامتلاء، وأنماط الاستبعاد، ونماذج الحالة الوسطى، فمن شأنه أن يمكننا من فهم أفضل للإيمان وعدم الإيمان كأوضاع نعيشها، وليس مجرد نظريات أو مجموعات من المعتقدات نتبناها ونعتنقها.
ويتمثل التناقض الرئيس والصريح هنا في أنَّ تمثل مكان الامتلاء، يتطلب بالنسبة للمؤمنين، استحضار الله، أي شيء ما خارق لحياة الإنسان و/أو الطبيعة، وهو ما لا يستقيم مع غير المؤمنين. بل إنهم يتركون مثل هذا التمثل مفتوحًا، أو يفهمون الامتلاء كإمكانات بشرية مفهومة من زاوية نظر طبيعية. ولكن حتى الآن يبدو أن هذا التناقض لم يخرج بعد عن دائرة الإيمان. وما نحتاج إليه هو ترجمة هذا الاختلاف في صلب التجربة المعيشة.
ولما كانت تجربتنا تلك، بطبيعة الحال، على غاية من التنوّع يفوق الخيال، فقد يكون علينا تحديد بعض المواضيع المتواترة. وينشأ الإحساس بالامتلاء بالنسبة للمؤمنين، غالبًا أو عادة عن علاقة شخصية، ومن طرف آخر قادر على الحب والعطاء. ويفترض الاقتراب من هذا الامتلاء، من بين أمور أخرى، الإخلاص والصلاة (وكذلك الصدقات والعطايا). وهم يدركون أنهم أبعد ما يكونون عن هذه الحالة حيث يتحقّق الإخلاص والعطاء في أتمّ معانيهما، كما يدركون أنهم منغلقون على أنفسهم، ويرتبطون بأشياء وأهداف متدنية، غير قادرين على الانفتاح وعلى الأخذ والعطاء كما لو كانوا في مكان الامتلاء. لذلك هناك فكرة مفادها أن نتلقى هذه القدرة أو الامتلاء عبر علاقة. ولكن من يتلقاها (تتلقاها) لا تتعزز قدرته (قدرتها) فقط بمجرد التقوقع في حالته (حالتها) الخاصة، بل إن عليه (عليها) أن ينفتح (تنفتح) وأن يتغيّر (تتغيّر) وأن يتحرَّر من ذاته (تتحرَّر من ذاتها).
تلك صياغة مسيحية بأتمّ معنى الكلمة. من أجل أن نتبيّن حقيقة اختلافها مع عدم الإيمان الحديث، قد يكون من المفيد أن نوازي بينها وبين صياغة أخرى، «البوذية» على سبيل المثال: ففي هذه الحالة ليست العلاقة الشخصية علاقة محورية، إذ الاهتمام ينصب رأسًا على اتجاه التعالي على الذات، وفتحها على الخارج، وتَلقّي سلطة من خارج ذواتنا.
وبالنسبة لغير المؤمنين في العصر الحديث، فالمأزق يختلف تمامًا. فالقدرة على بلوغ الامتلاء تكمن فينا. ويمكن أن ننظر إلى هذا الأمر بطرق شتى، من بينها تلك التي تركز على طبيعتنا ككائنات عقلانية وأهمها التصوّر الكانطي. وكفاعلين عقلانيين نمتلك القدرة على وضع القوانين التي تنظم حياتنا. وهذه القدرة أسمى إلى حد كبير من قوة الطبيعة التي تتهيَّأ فينا في شكل رغبة، بحيث عندما نتأملها من دون تحريف، لا يسعنا إلا أن نشعر بجلالها. إن مكان الامتلاء هو المكان الذي نخضع فيه في نهاية المطاف لهذه القدرة بشكل مطلق، وأن نسلك في حياتنا بما تمليه علينا. إن إحساسنا بتلقي هذه القدرة، ينبع من إحساسنا العميق بهشاشتنا وبقابليتنا للتأثر ككائنات رغبة، حين ننظر إلى هذه القدرة كقوة تشريع حكمها نافذ فينا بإعجاب ورهبة. ولكن هذا لا يعني في النهاية أننا نتلقى هذه القدرة من الخارج، إنها كامنة فينا، وكلما أدركنا هذه القوة، كلما تبيّن لنا أنها كامنة فينا، وأن الخلقية ينبغي أن تكون مستقلة وغير خاضعة.
(ولاحقًا يمكن أن نضيف إلى هذا نظرية فيورباخ في الاغتراب: إننا نُؤلِّه الله بسبب إحساسنا المبكر بأننا وضعنا هذه القوة الرهيبة عن طريق الخطأ خارج ذواتنا، إننا بحاجة إلى إعادة ملاءمتها للبشر، ولكن كانط لم يتَّخذ هذه الخطوة).
بطبيعة الحال، هناك أيضًا الكثير من التصوُّرات الطبيعانية التي تؤمن بقدرة العقل، والتي تنأى عن الأبعاد الثنائية والدينية التي طبعت فكر كانط والتي تتجلى في إيمانه بالحرية الراديكالية للفاعل الأخلاقي وبالخلود وبالله – وهي قواعد العقل العملي الثلاث. وقد تكون هناك طبيعانية أكثر صرامة، والتي لا توفر هامشًا كبيرًا للمناورة للعقل الإنساني، مدفوعة من ناحية بالغريزة، ومن ناحية أخرى تسيّجها مقتضيات البقاء. وقد لا يكون في مقدورنا تفسير لماذا تتوفر لنا مثل هذه القدرة. قد تتكوَّن إلى حدّ كبير في استخدامات أداتية للعقل وذلك في تناقض مع كانط مرة أخرى. ولكن في ظل هذا النوع من الطبيعانية، غالبًا ما يكون هناك إعجاب بقدرة العقل الرصين والمتحرر، القادر على التفكير في العالم والحياة البشرية من دون وهم، والتصرف بنقاء من أجل ازدهار البشر. لا يزال هناك بعض الجلال يحيط بالعقل كقدرة حاسمة، قادرة على تحريرنا من الوهم والقوى الغريزية العمياء، فضلًا عن الأوهام الناشئة عن خوفنا وضيق أفقنا وجبننا. ويكمن أقرب شيء للامتلاء في قدرة العقل هذه الذي ينتمي إلينا بشكل كامل والذي لم يتطوَّر إلا بفضل مغامراتنا البطولية في كثير من الأحيان. (وعادة ما نستحضر هنا عمالقة العقل «العلمي» الحديث: كوبرنيكوس، داروين وفرويد).
في الحقيقة إن إحساسنا بأنفسنا ككائنات ضعيفة وشجاعة في الآن ذاته وقادرة على مواجهة كونٍ فاقد للمعنى وعدائي ولا يرحم، وأن نرفع التحدي المتمثل في استنباط قواعد حياتنا الخاصة، يمكن أن يكون ملهمًا، كما جاء في كتابات كامو على سبيل المثال([21]). وقد يمثل رفع هذا التحدي، انطلاقًا من إحساسنا بعظمتنا، بالنسبة إلينا مكان الامتلاء الذي نطمح إليه ولكن نادرًا ما ندركه، بالمعنى الذي نناقشه هنا.
وخلافًا لهذه الأساليب في التعبير عن تهليلنا بقدرة العقل المكتفي بذاته، هناك أنماط أخرى من عدم الإيمان، تشبه وجهات النظر الدينية، ترى أننا بحاجة إلى قدرة من أيّ مكان آخر غير هذا العقل المستقل لتحقيق الامتلاء. ولما كان العقل في حد ذاته يضيق عن مطالب الامتلاء ويتعامى عنها، سينتهي به المطاف إلى تدمير الإنسان والإيكولوجيا بدافع الغرور والغطرسة ما لم يعترف بحدوده. وغالبًا ما يكون هناك صدى لنقد ذي طابع ديني للعقل الحديث المتحرر وغير المؤمن. وفي ما عدا ذلك فإن مصادر هذه القدرة ليست متعالية. إنها موجودة في الطبيعة، أو في أعماق ذواتنا، أو في كليهما. ويمكننا أن نعترف هنا بنظريات التحايث التي انبثقت عن النقد الرومانسي للعقل المتحرر، وبصفة أخص بعض الأخلاقيات الإيكولوجية المعاصرة، وخاصة الإيكولوجيا العميقة. ينبغي على التفكير العقلاني أن ينفتح على شيء أعمق وأغنى. إنه شيء (على الأقل في جزء منه) ذاتي. أو هو مشاعرنا أو غرائزنا الأعمق. لذلك علينا رأب الصدع الذي أحدثه العقل المتحرر في أعماق ذواتنا لما جعل التفكير مناهضًا للإحساس أو للغريزة أو للحدس.
إننا إذن إزاء وجهات نظر، كما ذكرت أعلاه، تتشابه جزئيًا مع ردة الفعل الدينية على الأنوار غير المؤمنة، إذ تشدد على تلقي القدرة من خارج الذات ضد الاكتفاء الذاتي. ولكنها تظل وجهات نظر تقول بالتحايث، وكثيرًا ما تكون معادية، إن لم تكن أكثر من ذلك، للدين أكثر من وجهات النظر المتحررة.
وهناك فئة ثالثة من وجهات النظر، التي يصعب تصنيفها هنا، ولكن آمل أن أوضحها في وقت لاحق في هذه المناقشة. ووجهات النظر هذه مثلها مثل بعض الأنماط المعاصرة الما بعد حداثية، التي تنكر ادعاءات العقل المكتفي بذاته وتنتقدها وتسخر منها، لكن لا تعيّن أي مصدر خارجي لتلقي هذه القدرة. إنها عازمة على تقويض وإنكار أفكار الرومانسية كفكرة العزاء في الإحساس، أو في الوحدة المتعافية، كما انتقدت حلم الأنوار في التفكير النقي، ويبدو أنها في كثير من الأحيان أكثر حرصًا على التأكيد على قناعاتها الإلحادية. إنها تشدِّد على طبيعة الانفصال الذي لا يمكن إصلاحه، والافتقار إلى المركز، والغياب الدائم للامتلاء، بما هو في أحسن الحالات حلم ضروري، وهو أمر قد نضطر إلى افتراضه حتى نضفي معنى ولو محدودًا على عالمنا، لكنه دائمًا في مكان آخر، يتعذر العثور عليه أصلًا.
يبدو أن هذه الطائفة من وجهات النظر تقف تمامًا خارج البنى التي أتحدث عنها هنا. ومع ذلك أعتقد أنه يمكن للمرء أن يتبين أنها تجد أساسها في تلك البنى بطرق مختلفة. وعلى وجه الخصوص، فإنها تستمد قدرتها وتتعزز من الإحساس بشجاعتنا وعظمتنا في أن نكون قادرين على مواجهة العضال الذي يتعذر الشفاء منه وتحمله رغم ذلك. وآمل أن أعود إلى هذا لاحقًا.
لذلك حققنا بعض التقدُّم في الحديث عن الإيمان وعدم الإيمان بوصفهما نمطيّ عيش أو نمطين من تجربة الحياة الأخلاقية/الروحية، وذلك في الأبعاد الثلاثة التي تحدثت عنها آنفًا. ولقد نصصت على بعض التناقضات في البعد الأول، كيف نعيش تجربة الامتلاء. وما مصدر هذه القوة التي يمكن أن تقودنا نحو هذا الامتلاء، هل تنبع من «الداخل» أم «من الخارج»، وبأي معنى. وتتطابق الاختلافات التي تكشف عنها تجارب الاستبعاد، مع تلك التي تتعلق بالحالة الوسطى.
لنا أن نفصِّل القول في هذا التمييز بين الداخل والخارج، ولكن قبل ذلك، هناك جانب آخر مهم من تجربة الامتلاء كما «وضعت» في مكان ما ونحن بحاجة لاستكشافها. لقد تجاوزنا مجرد الإيمان، وصرنا أقرب إلى أن نعيش تجربة، لكن لا تزال هناك اختلافات مهمّة في الطريقة التي نعيش من خلالها تلك التجربة في تجلياتها.
ماذا يعني أن أقول إن الامتلاء يأتي من قدرة تتجاوزني، وأن عليّ تلقيها، وما إلى ذلك؟ من المرجح، اليوم، أن يعني شيئًا من هذا القبيل: تتَّخذ تجربتي الأخلاقية والروحية المتناقضة معنى ضمن وجهة نظر لاهوتية من هذا النوع. معنى هذا يبدو لي، في تجربتي الخاصة، في الصلاة، في لحظات الامتلاء، في تجارب التغلب على الاستبعاد، أني أرى في حياة الآخرين من حولي – حيوات روحية ممتلئة استثنائية، أو حيوات ذوات منغلقة على ذاتها إلى أقصى حد، حيوات شيطانية آثمة، وما إلى ذلك، ويبدو أن هذه هي الصورة كما تظهر لي. لكن لم أكن أبدًا، أو نادرًا ما أكون متيقنًا حقًا، ومتحررًا من كل شك، ومن أيّ اعتراض، ومن أيّ تجربة غير مواتية، بعض الحيوات التي تظهر الامتلاء ضمن شروط أخرى، وبعض الأنماط الأخرى من الامتلاء أحيانًا ما تشدَّني إليها، إلخ.
ذلك هو ما يميّز الوضع الحديث، ويمكن لكثير من غير المؤمنين أن يسردوا قصة مماثلة. نحن نعيش في وضع لا نستطيع فيه إلا أن ندرك أن هناك تأويلات متنوعة، ووجهات نظر يمكن للأشخاص الأذكياء الذين يتمتعون بصفاء الذهن وبإرادة خيرة، أن يختلفوا بشأنها. ولا شيء يمنعنا من التساؤل أحيانًا، ومن أن نُخضع إيماننا لمحك الشك وعدم اليقين.
ذلك هو مؤشر الشك، الذي قاد الناس للحديث هاهنا عن «نظريات». لأن النظريات هي في كثير من الأحيان فرضيات، تنشأ في مناخ من عدم اليقين في نهاية المطاف، في انتظار مزيد من الأدلة. آمل أني استطعت أن أُبيّن أنه لا يمكننا فهمها على أنها مجرد نظريات، وأن هناك طريقة يتم من خلالها التغلب على تجربتنا بأكملها إذا كنا نعيش وفق روحية أو أخرى. ولكن نحن ندرك اليوم أن للمرء أن يعيش الحياة الروحية بشكل مختلف. وأن هذه القوة، والامتلاء والاستبعاد، وما إلى ذلك، يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة.
لكن من الواضح أن هناك طريقة أخرى يمكن للمرء أن يعيش من خلالها هذه التجارب، ولقد عاشها العديد من الناس. ذلك هو وضع التجربة المباشرة للقوة، ولمكان الامتلاء والاستبعاد، وهو لا يعدو أن يكون سوى شرط من شروط أخرى ممكنة، لكن حيثما لم ينشأ أي تمييز من هذا القبيل بين التجربة وتأويلها. وبالعودة إلى هيرونيموس بوش على سبيل المثال، يمكننا أن نتصوَّر أن الخيالات والكوابيس ذات الصلة بالتملك، والأرواح الشريرة، والافتتان بأشكال حيوانية وحشية بالنسبة لكثير من الناس في هذا العصر لم تكن «نظريات» في تجربتهم المعيشة بأي شكل من الأشكال. كانت تلك أشياء مثيرة للخشية حقًا، بحيث يكاد يكون من المستحيل اعتبارها غير واقعية. قد تكون تعرضت لمثل هذه الأشياء وكذلك أقاربك أيضًا. وربما لا أحد من حولك استطاع أن يشكك في لا واقعيتها.
وبالمثل، كان شعب العهد الجديد في فلسطين، كلما رأوا شخصًا تملكته روحًا شريرة، وقد يكون هذا الشخص أحد الجيران أو الأحباء، تفاعلوا مباشرة مع معاناته الحقيقية مقتنعين بأن ذلك ضروري للاهتمام بتفسير حالة نفسية، يمكن تحديدها فقط نفسانيًا، من دون أن ينفي ذلك وجود أسباب أخرى قد تكون أدت إلى تلك الحالة.
يُمكن أن نأخذ مثالًا معاصرًا أيضًا، يتعلق بحالة سلستين Célestine من غرب أفريقيا التي أجرت معها بريجيت ماير([22]) لقاءً. لقد «غادرت سلستين أفنتيل مع والدتها، ورافقهما شخص غريب يرتدي ثوبًا شماليًا أبيض». ولما سئلت أمها عن ذلك، أنكرت رؤية الرجل. وأوعزت لها بأن الرجل قد يكون روح أكان سولوي Akan Sowlui، الذي يتعيَّن على سلستين أن تنذر نفسها لخدمته. ففي عالم سلستين، ربما تكون مماهاة هوية الرجل مع هذه الروح بمنزلة «إيمان»، أعقب التجربة ضمن سعيها لإيجاد تفسير لكل ذلك. لكن مرافقة هذا الرجل لها لا تعدو أن تكون إلا مجرد واقعة حدثت لها في عالمها.
لذلك يتعلق الأمر بحالة من التجربة المعيشة، حيث ما يمكن أن نسميه تأويلًا للأخلاقي/الروحي لا يعاش بما هو كذلك، ولكن كحقيقة مباشرة، مثل الحجارة والأنهار والجبال. وينطبق هذا أيضًا على مختلف الأشياء في جوانبها الإيجابية، مثل، البشر الذين أدركوا، في العصور الغابرة من ثقافتنا، أن الامتلاء يعني ببساطة القرب من الله. وكانت الخيارات التي واجهوها في الحياة هي: إما العيش بإخلاص تام، أو بأقل ما يمكن من الطيّبات، وتفصلهم عن الامتلاء مسافة ممتدة، وفي فرنسا القرن السابع عشر لم يكن هناك أيّ تمييز بين مصطلح «مخلص» أو «دنيوي» من دون أن يُستند في ذلك إلى تأويل مغاير لما يعنيه الامتلاء.
لعل أهم ما يميّز حضارتنا اليوم هو تراجع هذه الأشكال المباشرة من اليقين إلى حد كبير. ويبدو واضحًا أنها لم تعد تبدو (لنا) «ساذجة» تمامًا([23]) كما كانت في زمن هيرونيموس بوش. ولكن لا يزال هناك شيء يشبه ذلك في زماننا هذا وإن بشكل محدود. أنا أتحدث عن الطريقة التي تميل بها الحياة الأخلاقية/الروحية إلى الظهور في أوساط معينة. ورغم أن الجميع قد أصبح الآن على بيّنة من أن هناك أكثر من خيار واحد، قد يكون في الوسط الذي ننتمي إليه التأويل الأكثر معقولية هو ذاك الذي يتعلق إما بالإيمان أو بعدمه. أنت تعرف أن هناك خيارات أخرى، وإذا استهواك أحدها فآثرته دون البقية فإنك ستفكر وستناضل من أجل إيجاد الطريق التي توصلك إليه. وفي هذه الحالة ستنقطع عن جماعتك المؤمنة وتصبح مُلحدًا، أو العكس بالعكس. ولكن يظل دائمًا، ضمن بعض الوجوه، أحد الخيارات خيارًا مفترضًا.
وفي هذا الصدد، شهدت حضارتنا الغربية تحولًا هائلًا. لقد تحوَّلنا ليس فقط من حالة حيث كان معظم الناس يعيشون «بسذاجة» وفق نهج (جزء مسيحي، جزء متعلق بـ«أرواح» ذات أصل وثني) قوامه تأويل بسيط للحقيقة، إلى حالة تعوز الجميع القدرة على ذلك، إلا أنهم يعتقدون جميعًا أن خيارهم كواحد من بين خيارات أخرى عديدة. وقد تعوَّدنا جميعًا التقلب بين وجهتي نظر: «الالتزام» الذي يقودنا إلى أن نعيش أكثر ما يمكن الحقيقة التي تفرضها وجهة نظرنا تلك، و«فك الارتباط» حيث يمكننا أن نسلك وفق وجهة نظر معيّنة من بين وجهات نظر أخرى ممكنة يتعيّن علينا أن نتعايش معها.
لكننا انتقلنا أيضًا من وضع كان فيه الإيمان خيارًا مفترضًا، ليس فقط للسذج ولكن أيضًا لأولئك الذين شهدوا الإلحاد وتبيَّنوا أمره وخاضوا فيه، إلى حالة صار فيها عدد أولئك الذين يعتقدون في أن التأويلات غير الإيمانية وحدها المعقولة، في تزايد مستمر. ولا يمكن لهم أن يكونوا «مُلحدين» ساذجين، كما كان أسلافهم مؤمنين ساذجين شبه وثنيين، لكن يبدو أن هذا هو التأويل الأكثر معقولية، ومن الصعب أن نتخيَّل أن يتبنى الناس تأويلًا آخر. ومن هنا ينتهي بهم الأمر بسهولة إلى نظريات خاطئة على نحو صارخ لتفسير الإيمان الديني: الناس يجزعون من عدم اليقين، ومن المجهول. إنهم بليدو الذهن، ويخشون اقتراف الذنوب، وما إلى ذلك.
هذا لا يعني أن الجميع كذلك. فحضارتنا الحديثة تنطوي على كثرة من المجتمعات والمجتمعات الفرعية والأوساط، المختلفة في ما بينها إلى حد ما. ولكن صار افتراض عدم الإيمان هو المهيمن أكثر فأكثر من هذه الأوساط، والأكثر تناغمًا في الحياة الأكاديمية والفكرية، على سبيل المثال، حتى أصبح قادرًا على الامتداد بسهولة أكبر ليشمل أوساطًا أخرى.
وحتى نضع النقاش بين الإيمان وعدم الإيمان في عصرنا هذا وأيامنا هذه، في إطاره، علينا أن ننزله في سياق هذه التجربة المعيشة، وفي سياق التأويلات التي تُشكّل هذه التجربة. وهذا يعني أن ننظر إليها ليس فقط على أنها أكثر من مجرد «نظريات» مختلفة لتفسير التجارب نفسها، لكن أيضًا يعني هذا فهم الموقف التفاضلي من مختلف التأويلات، وعلى أي نحو يمكن أن نعيش تلك التجارب «على نحو ساذج» أو «بتروٍ». وبأي معنى يكون هذا الخيار أو ذاك خيارًا مفترضًا لكثير من الناس أو الأوساط.
بعبارة أخرى، إن الإيمان بالله تغيَّر في القرن الواحد والعشرين عمَّا كان عليه في القرن السادس عشر. أنا لا أُشير إلى حقيقة أن المسيحية الأرثوذكسية قد شهدت تحوُّلات مهمة (على سبيل المثال، «تراجع الجحيم»، وفهم جديد للكفارة). وحتى إذا تعلق الأمر بمبادئ العقيدة ذاتها فثمة اختلاف مُهم. يظهر ذلك حالما نأخذ في الاعتبار حقيقة أن جميع المعتقدات تتم في سياق أو إطار محدد ومعطى، عادة ما يكون ضمنيًا، وربما حتى الآن لم يُعترف به من قبل الفاعل، لأنه لم يتبلور أبدًا. ذلك ما سمَّاه الفلاسفة الذين تأثر بهم فتغنشتاين أو هيدغر أو بولاني بـ«الخلفية»([24]). وكما يشير فتغنشتاين([25])، فإن بحثي حول تشكُّل الصخر وما علق به من تشقق وتثليم بسبب عوامل التعرية، يُثبت أن العالم لم يبدأ قبل خمس دقائق، ولكن رغم ذلك لم يخطر ببالي أن أُبلور ذلك قبل أن يُقدم على ذلك فيلسوف مهووس بالإبستمولوجيا.
ولكني الآن ربما أدركت موطن الخلل، وانطلاقًا من هذه الاعتبارات ما عاد لي أن أكون ساذجًا في بحثي، ومن ثم ربما أصبح عليّ أن أُشكك في مصداقيته. وغالبًا ما يكون كسر طوق السذاجة هذا أولى خطوات الطريق نحو الفهم الكامل (وإن لم يكن الأمر كذلك في هذه الحالة). يمكن أن تعمل ضمن إطار تتَّجه فيه كل التحوّلات نحو واحد من الاتجاهات الرئيسة إما نحو الأسفل أو نحو الأعلى، ولكن عليك أن تتبيَّن كيف أن هذا الإطار يظل نسبيًا ومقيّدًا حتى يكون عملك حميدًا.
إن الاختلاف الذي تحدَّثت عنه أعلاه يتطابق مع واحد من الأُطر الخلفية الذي يفرض علينا أن نُؤمن بالله أو ألا نؤمن. ويُنظر إلى أُطر الأمس وأُطر اليوم على أنها إما «ساذجة» وإما «متروّية»، لأن وجهة النظر التي تقول بالتروّي تفتح سؤالًا كان قد أُغلق في وجهة النظر الساذجة من قبل الشكل غير المُعترف به للخلفية.
يظهر التحوُّل في الخلفية، أو بالأحرى القطع مع الخلفية السابقة، بشكل أكثر وضوحًا عندما نركِّز على بعض التمييزات التي نُقيمها اليوم، على سبيل المثال، بين المحايث والمتعالي، وبين الطبيعي والخارق للطبيعي. الجميع على بيّنة منها سواء أولئك الذين يؤيدون أو أولئك الذين ينكرون اللفظ الثاني من كل زوج. هذا الاستغناء عن مستوى مستقل وقائم بذاته، وهو «الطبيعة»، التي قد تكون أو لا تكون في تفاعل مع شيء آخر أو أبعد من ذلك، يُمثل جزءًا مهمًا من التنظير الحديث، والذي بدوره يتطابق مع البعد التأسيسي لتجربة الحداثة، كما آمل أن أبيّنه بمزيد من التفصيل أدناه.
هذا التحوُّل في الخلفية، في السياق كله الذي نعيش فيه تجربة الامتلاء ونسعى إليه، يتطابق، في تقديري، مع ما أُسمّيه انبعاث العصر العلماني بالمعنى الثالث للعلمانية. كيف انتقلنا من حالة كان فيها الناس في المسيحية يعيشون بسذاجة ضمن تأويل توحيدي، إلى تأويل آخر يقوم على اعتبارنا جميعًا نتأرجح بين موقفين، حيث يكون لكل شخص تأويله. وحيث أصبح، علاوة على ذلك، عدم الإيمان بالنسبة للكثيرين الخيار الرئيس المُفترض؟ ذلك هو التحوُّل الذي أريد أن أتحدث عنه، وربما أيضًا أن أتوقف عند خصوصياته (جزئيًا) في ما سيأتي من فصول هذا الكتاب.
وليس الأمر بالهيِّن، ولن يتسنى لنا طرح المسائل الوجيهة وتجنب السذاجة في مختلف تمظهراتها ما لم نعيّن حقيقة التحوُّل الذي حدث في مستوى التجربة المعيشة: إما أن يكون عدم الإيمان هو مجرد أفول لأي معنى من معاني الامتلاء، أو خيانة له (ذلك ما يُعيبه الموحّدون على الملحدين أحيانًا)، أو أن الإيمان هو مجرَّد مجموعة من النظريات التي تحاول أن تُضفي على تجاربنا جميعًا معنى، والتي يمكن تمثّل طبيعتها الحقيقية على نحو محايث (ذلك ما يُعيبه الملحدون على الموحدين أحيانًا).
في الواقع، علينا أن نفهم الاختلافات بين هذه الخيارات ليس فقط من حيث العقائد، ولكن أيضًا من حيث الاختلافات في التجربة والحساسية. وانطلاقًا من هذا المستوى الأخير، علينا أن نأخذ في الاعتبار اثنين من الاختلافات المهمة: أولًا، هناك تحوُّل جذري في خلفية الإيمان أو عدم الإيمان، تمثل في تراجع إطار «السذاجة» لحساب إطار «التروي». وثانيًا، علينا أن ندرك كيف يمكن للمؤمنين وغير المؤمنين تجربة عالمهم بشكل مختلف تمامًا. إن الشعور بأن الامتلاء يكمن في شيء ما يتجاوزنا يمكن أن يفرض نفسه علينا كواقعة في التجربة، كما هو الحال في تجربة بيدي غريفثس المذكورة أعلاه، أو في لحظة التحوُّل التي عاشها كلوديل في نوتردام في فيسبرز. ويمكن بعد ذلك بلورة هذه التجربة وعقلنتها، فقد تتولد عنها أشكال إيمانية معينة. قد تستغرق هذه العملية وقتًا، وقد تتغيَّر تلك الأشكال الإيمانية على مر السنين، ولكن التجربة تظل محفورة في الذاكرة كلحظة نموذجية. ذلك ما حدث لبيدي، الذي انتهى إلى قراءة توحيدية تمامًا لتلك اللحظة الحاسمة بعد سنوات قليلة فقط، ولقد شهدت حالة كلوديل «تأخرًا» مماثلاً([26]). وهكذا فإن حالة العلمانية بالمعنى الثالث يمكن وصفها من حيث إمكانية أو استحالة تجارب معيَّنة في عصرنا.
[ 3 ]
لقد واجهتُ أعلاه صعوبات في تحديد معنى «علماني»، أو «علمانية». قد يبدو الأمر بديهيًا للوهلة الأولى، ولكن بمجرد أن تعزم على التفكير في ذلك، تنشأ العديد من الصعوبات. حاولت استحضار بعضها من خلال التمييز بين ثلاثة معانٍ لتحديد هذا المصطلح. ولا يعني هذا بالضرورة استبعاد، بأي حال من الأحوال، جميع الصعوبات التي علقت به، ولكنه قد يكون كافيًا لإحراز بعض التقدم في مسعاي هذا.
ولكن كل أنماط العلمانية الثلاثة مرجعها «الدين»: بوصفه هذا الذي ينسحب من الفضاء العمومي (1)، أو كنوع من الإيمان والممارسة في تراجع أو يكاد (2)، وكنوع معيّن من الإيمان أو الالتزام الذي يجري فحص أوضاعه في هذا العصر (3). ولكن ما هو «الدين»؟ نعلم جيّدًا أن هذا السؤال يتحدَّى تعريف الدين وذلك لأن الظواهر التي يُحيل إليها الدين متنوعة جدًا في حياة الإنسان. عندما نحاول أن نُفكر في ما هو مشترك بين حياة المجتمعات القديمة حيث «الدين حاضر في كل مكان»، ومجموعة واضحة من المعتقدات والممارسات والمؤسسات التي يشملها الدين في مجتمعنا، نجد أنفسنا أمام مهمَّة حسَّاسة وربما مستحيلة.
ولكن إذا كنا حذرين (أو ربما تعوزنا الشجاعة)، ونزعم أننا نحاول أن نفهم مجموعة من الأشكال والتغييرات التي نشأت في حضارة بعينها، حضارة الغرب الحديث، أو تلك التي نشأت مع بدايات التجسيد، المسيحية-اللاتينية، فلسنا بحاجة إلى صياغة تعريف يشمل كل شيء «ديني» في جميع المجتمعات البشرية في جميع العصور حتى نحتفظ بسكينتنا. إن التغيير الذي يهمّ الناس في حضارتنا (شمال الأطلسي، أو «الغربية») وما زال يُثير الاهتمام إلى أيامنا هذه، في ما يتعلق بوضع الدين في الأبعاد الثلاثة للعلمانية التي حددتها، هو الذي بدأتُ بالفعل في استكشاف أحد وجوهه الرئيسة: لقد انتقلنا من عالم كان يُنظر فيه إلى موضع الامتلاء، من دون أن يثير ذلك إشكالًا، خارج الحياة البشرية أو «في ما وراءها»، إلى عصر تشقّه الصراعات يواجه فيها هذا التأويل تحديًا من قبل تأويلات أخرى تنزله (بطرق شتى) «داخل» حياة الإنسان. ذلك هو الأمر الذي لا يزال يُثير صراعات مهمّة حوله في الآونة الأخيرة (كما كافح الناس حتى الموت، في الأزمنة الماضية من أجل قراءات مختلفة للتأويل المسيحي).
وبعبارة أخرى، فإن قراءة «الدين» على أساس التمييز بين المتعالي والمحايث من شأنها أن تفيدنا في ما نحن بصدده. تلك هي الاستراتيجية الحذرة (أو التي تعوزها الشجاعة) التي أَرتئيها هنا. ولا يمكن القول إن الدين عمومًا يمكن تعريفه على أساس هذا التمييز. يمكن للمرء أن يزعم بأن هذا التمييز لم يسبقنا إليه أحد قبلنا (نحن الغربيين والمسيحيين اللاتينيين)، ولسنا ندري ما إذا كان في ذلك مجد لنا أو حماقة اقترفناها في حق أنفسنا (وسأناقش بعضًا من هذا لاحقًا). لا يمكن أن نكون قد أخذناه من أفلاطون، على سبيل المثال، لا لأننا لا نستطيع أن نُميِّز الأفكار عن الأشياء في التدفق الذي «ينسخها»، ولكن على وجه التحديد لأن هذه الحقائق المتغيّرة لا يمكن فهمها إلا من خلال الأفكار. والاختراع الكبير للغرب يتمثَّل في أن هناك نظامًا محايثًا في الطبيعة، يمكن فهم عمله بشكل منهجي وشرحه استنادًا إلى مفاهيمه الخاصة، مما يترك مسألة ما إذا كان لهذا النظام كله أهمية أعمق، وما إذا كان ينبغي لنا استنتاج أن وراءه خالقًا متعاليًا مسألة بلا جواب. ينطوي مفهوم «المحايث» على إنكار – أو على الأقل عزل وأشكلة – أي شكل من أشكال التداخل بين أشياء الطبيعة، من جهة، و«الخارق للطبيعة» من جهة أخرى، سواء تعلَّق الأمر بإله متعالٍ واحد، أو بآلهة متعددة أو بالأرواح، أو بقوى سحرية، أو أيًا كان([27]).
لذا فإن هذا التحوُّل الذي شهده تعريف الدين على أساس التمييز بين المحايث والمتعالي لا يعدو أن يكون سوى تحوُّل يخص ثقافتنا تحديدًا. قد يُنظر إلى هذا الموقف على أنه ضيِّق الأفق ومتمركز حول ذاته، لكن أودّ أن أقول إنها خطوة سديدة ولها ما يُبرّرها، لأننا نحاول أن نفهم التحوُّلات الثقافية التي أدَّت إلى اعتبار هذا التمييز تمييزًا أساسيًا.
لذا، بدلًا من السؤال عمّا إذا كنا نُدرك مصدر الامتلاء أو نعيشه داخل ذواتنا أو خارجها، كما فعلنا في المناقشة المذكورة أعلاه، يمكننا أن نسأل عمّا إذا كان الناس يعترفون بوجود شيء ما يتخطّى حياتهم أو يتعالى عنها. هذه هي الطريقة التي يتمّ من خلالها عادة طرح المسألة، وأريد اعتمادها في ما سيأتي. وسأُقدِّم وصفًا أوفى، إلى حد ما، لما أَعنيه بهذا التمييز على امتداد فصول عدة، عندما نأتي على دراسة النظريات الحديثة للعلمنة. وإنني أدرك تمامًا أن لفظ مثل «التعالي» زلق جدًا، لأن بعض هذه التمييزات نشأت وتحدَّدت في مسار الحداثة والعلمنة ذاته. ولكنني أعتقد أنه على ما عليه من غموض يمكن له في هذا السياق أن يُفيدنا في ما نحن بصدده.
ولكن على وجه التحديد، وللأسباب التي عرضتها أعلاه، أريد أن أُكمل التعريف السائد «للدين» على أساس الاعتقاد في المتعالي، مع التركيز أكثر على تمثّل سياقنا العملي. وفي ما يلي الطريقة التي من شأنها أن تُضفي معنى على ذلك.
لكل شخص، ولكل مجتمع، تصوُّر أو تصوُّرات بشأن الازدهار الإنساني: ما هي الحياة الكاملة؟ ما الذي يجعل حياة تستحق أن تُعاش؟ ما الذي يمكن أن يجعلنا نُعجب ببعض الأشخاص؟ ليس ثمة ما يمنعنا من طرح هذه الأسئلة أو غيرها مما له علاقة بها في حياتنا. وترمي جهودنا المبذولة للإجابة عنها إلى تحديد وجهة النظر أو وجهات النظر التي نحاول أن نعيش وفقها، أو التي نتأرجح بينها. وعلى مستوى آخر، يتم تدوين هذه الآراء، أحيانًا في النظريات الفلسفية، وأحيانًا في القواعد الأخلاقية، وأحيانًا في الممارسات الدينية وضروب الإخلاص المتصلة بها. وتشكل هذه الممارسات ومختلف الممارسات غير المُعدّة جيدًا التي يشترك فيها الناس من حولنا، مصادر يوفرها لنا مجتمعنا حتى نسلك وفقها في حياتنا.
ثمَّة طريقة أخرى يمكن من خلالها إثارة مسألة مثل المسألة التي أُثيرت أعلاه على أساس الداخل/الخارج، وتتمثّل في أن نتساءل عما إذا كانت الحياة الأسمى والأفضل تفترض أن نسعى أو نعترف، أو نسخّر أنفسنا من أجل خير خارج ذواتنا، بمعنى مستقل عن ازدهار الإنساني؟ وفي هذه الحالة، يمكن أن يشمل الازدهار الإنساني الأسمى والأكثر حقيقية وأصالة أو تطابقًا غاية (أيضًا) من بين مجموعة من الغايات القصوى غير الازدهار الإنساني. وأقول «غايات قصوى»، لأنه حتى النزعة الإنسانية مهما ادعت الاكتفاء بذاتها يجب أن تُعنى، من زاوية نظر أداتية، بحالات بعض الشؤون غير البشرية، مثل وضع البيئة الطبيعية. بيد أن الأمر يتعلق هنا بما إذا كانت هذه الأمور تنتمي إلى أهدافنا النهائية أم لا.
ومن الواضح أن الإجابة عن هذا السؤال في التقاليد الدينية اليهودية المسيحية، إيجابية. محبَّة الله وعبادته هي الغاية القصوى. وبطبيعة الحال، في هذا التقليد يُنظر إلى أن الله يُريد للبشر الازدهار، ولكن لا ينظر إلى الإخلاص إلى الله على أنه متوقف على ذلك. إن الأمر «يتعيّن عليهم القيام بكذا» لا يعادل «السماح للبشر بالازدهار»، رغم أننا نعلم أن الله يريد ازدهار البشر.
وهذا أمر مألوف جدًا بالنسبة إلينا. ولكن هناك طرقًا أخرى يمكننا من خلالها أن نأمل في أبعد من الازدهار الإنساني العادي. ومثال ذلك البوذية. ففي إحدى الطرق، يمكننا أن نتأوّل رسالة بوذا كرسالة في سبل تحصيل السعادة الحقيقية وتجنّب الألم وبلوغ النعيم([28]). ولكن من الواضح أن تمثل شروط النعيم على هذا النحو يفترض اتخاذ «موقف تصحيحي» مما نعتبره عادة ازدهار إنساني. وهي إعادة نظر قد تجد أساسها في تغيير جذري للهوية. ويفترض الفهم العادي للازدهار قيومية الذات، وما يمكن أن تغنمه من ذلك، أو ما يمكن أن تعانيه من ألم في حالة فشلها في ذلك. وتسعى عقيدة أناتا Anatta البوذية إلى مساعدتنا على تجاوز هذا الوهم. ويقتضي الطريق إلى السعادة القصوى Nirvana الزهد في جميع أشكال الازدهار الإنساني المعترف بها، أو على الأقل الإعراض عنها.
تشترك البوذية والمسيحية، رغم ما بين العقيدتين من تباين كبير، في أن المؤمن أو الشخص المخلّص مطالبان بالقطع ذاتيًا وبشكل تام مع الأهداف التي يفترضها ازدهارهما الخاص، إنهما مدعوان إلى الزهد في ازدهارهما، إلى حد إنكار الذات، أو إلى الزهد في إخلاصهما البشري في خدمة الله. وهو ما تعكسه الشخصيتان النموذجيتان لهاتين العقيدتين بشكل واضح. ففي حين يقود بوذا إلى التنوير، قَبِلَ المسيح الموت المهين إنفاذًا لإرادة والده.
ولكن لا يمكن أن نتَّبع فقط التلميح أعلاه، وإعادة صياغة الفهم «الحقيقي» للازدهار بوصفه زهدًا، على غرار ما ذهبت إليه الرواقية على سبيل المثال؟ وهو ما لم تذهب إليه المسيحية، ولا البوذية أيضًا فيما أظن. ففي الحالة المسيحية، يفترض الزهد نفسه تأكيد الازدهار في معناه العادي. لو لم يكن طول العمر خيرًا، لما كان لتضحية المسيح بنفسه معنى. وبهذا المعنى يختلف موت المسيح عن موت سقراط تمامًا، إذ كان هذا الأخير يعتبر موته انتقالًا من وضع إلى وضع أفضل. وهنا مكمن الهوَّة بين المسيحية والفلسفة اليونانية التي يعسر جسرها. إن الله يُريد أن يزدهر الناس بالمعنى العادي للازدهار، وجزء كبير مما ورد في الأناجيل يعرض كيف كان المسيح يجتهد في سبيل أن يجعل هذا الضرب من الازدهار ممكنًا حتى يتخطى الناس آلامهم. ولا تنفي الدعوة إلى الزهد قيمة الازدهار، بل هي دعوة إلى اعتبار أن الله هو أصل كل شيء، حتى لو كان على حساب الزهد في خير غير لا يمكن الاستعاضة عنه. وثمرة هذا الزهد الذي نقبل به هو أن يتحوَّل، من جهة، إلى مصدر ازدهار للآخرين، وأن يساهم، من جهة أخرى، في استعادة ازدهار أكمل يكون الله مصدره. إنه طريقة لتضميد الجراح و «إصلاح العالم» (اقترض العبارة العبرية تيكون أولام tikkun olam).
هذا يعني أن الازدهار والزهد لا يمكن لهما ببساطة أن ينصهرا في ما بينهما لتحقيق هدف واحد، إن جاز القول، إلقاء الطيبات التي نزهد فيها كما نُلقي الحصى التي لا طائل من ورائها من السفينة في رحلة الحياة، بطريقة رواقية. ولا يزال هناك توتر جوهري في المسيحية. الازدهار خير، ومع ذلك ليس السعي إليه غايتنا القصوى. ولكن حتى عندما نزهد فيه، إنما نؤكد قيمته من جديد، لأننا نتبع إرادة الله باعتبارها جسرًا يمتد إلى آخرين وفي نهاية المطاف إلى الجميع حتى يبلغوه.
هل تنطوي البوذية على مفارقة كهذه؟ لست متأكدًا، ولكن البوذية تتضمَّن كذلك فكرة أن الزاهد هو مصدر التعاطف بالنسبة لأولئك الذين يتألمون. هناك تشابه بين كارونا karuna (السعي إلى التخفيف من معاناة الآخرين) والمحبة agape. وعلى مدى قرون في الحضارة البوذية نشأ، بالتوازي مع المسيحية، تمييز بين مهمة الزهَّاد الراديكاليين، وأولئك الذين ينشدّون إلى أنماط عيش تُنشد الازدهار العادي، عسى أن يكون هم «الأعلون» في الحياة المستقبلية. (وبطبيعة الحال، فقد «فكَّك» الإصلاح البروتستانتي هذا التمييز جذريًا، وقد كانت لذلك التفكيك تبعات حاسمة في ما يتعلق بالقصة التي نحن بصدد سردها هنا، والتي نحن جميعًا على بيّنة منها بشكل أو بآخر رغم أن ارتباطاتها بالعلمانية الحديثة ما زالت لم تتبلور تمامًا بعد).
إن هذا التمييز بين الازدهار الإنساني وبين الغايات التي تتجاوزه من شأنه أن يؤكد أن ظهور العلمانية الحديثة بالمعنى الذي أعنيه اقترن بنشأة مجتمع صارت فيه لأول مرة في التاريخ نزعة إنسانية حصرية مكتفية بذاتها خيارًا متاحًا على نطاق واسع. وأعني بذلك نزعة إنسانية لا تقبل أي غايات قصوى تتجاوز الازدهار الإنساني، وترى أنه لا ولاء لأي شيء آخر يتجاوز هذا الازدهار. وهو أمر لم يشهده أي مجتمع في السابق.
وعلى الرغم من أن هذه النزعة الإنسانية نشأت عن تقاليد دينية قوامها تصوُّر للازدهار متميز ومتناقض ومشدود إلى غاية متعالية (ولهذا أمر له أهميته بالنسبة لقصتنا)، فإن هذا لا يعني أن جميع المجتمعات السابقة عرفت ثنائية في هذا المجال، على غرار البوذية والمسيحية. لقد عرفت بعض العقائد، مثل الطاوية Taoism، تصورًا أحاديًا للازدهار، مع توقير للأسمى. ولكن في هذه الحالة، فإن هذا التوقير، وإن كان ضروريًا للازدهار، لا يمكن أن يضطلع به بروح أداتية محضة، ومتى كان كذلك فإنه يكف عن أن يكون توقيرًا.
وبعبارة أخرى، فإن الفهم العام للوضع البشري المـتأزم قبل الحداثة يصنفنا في مرتبة من دون مرتبة الريادة. وإن الموجودات العليا، مثل الآلهة أو الأرواح، أو كل موجود أسمى، مثل المثل أو كوسموبوليس الآلهة والبشر، تفرض وتستحق العبادة والتوقير والإخلاص والحب. وفي بعض الحالات، اعتبر التوقير أو الإخلاص في حد ذاته جزءًا لا يتجزَّأ من الازدهار الإنساني، وبعدًا من أبعاد الخير الإنساني، كما في الطاوية على سبيل المثال وفي بعض الفلسفات القديمة كالأفلاطونية والرواقية. وفي حالات أخرى، لا معنى للإخلاص إلا إذا كان في ذلك فوز بمرضاة لله وليس لأن فيه صلاحنا ومصلحتنا. ولكن حتى هنا يظل التوقير المرتجى حقيقيًا. فهذه الموجودات تفرض الاحترام. وما من شك في أننا نتعامل معها كما نسخّر قوى الطبيعة مصدرًا للطاقة.
ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالنزعة الإنسانية، ولكن ليست المكتفية بذاتها أو النزعة الإنسانية الحصرية، تلك التي تتميز بها العلمانية الحديثة.
تبدو هذه الأطروحة، التي تقصر النزعة الإنسانية الحصرية على الحداثة دون سواها، راديكالية ومعممة إلى أقصى حد، وبالتالي مجانبة للصواب، لأنه بالفعل توجد استثناءات. ففي تقديري، تُعتبر الأبيقورية القديمة ذات نزعة إنسانية مكتفية بذاتها. إنها تعترف بوجود الآلهة، ولكن تنفي أن تكون لها صلة بالحياة البشرية. ولكن خطاف واحد لا يصنع الربيع. إنني أتحدّث عن عصر تصبح فيه النزعة الإنسانية المكتفية بذاتها خيارًا متاحًا على نطاق واسع، وهو ما لم يكن عليه الأمر أبدًا في العالم القديم، حيث لم تكن هناك سوى أقلية صغيرة من النخبة، قليل منها فقط تبنَّى تلك النزعة.
لا أدَّعي أن العلمانية الحديثة متشابكة بشكل ما مع النزعة الإنسانية الحصرية. فالعلمانية، كما أعرفها، هي الوضع الذي تنبثق عنه تجربتنا عن الامتلاء والسعي إليه، وهذا أمر نتقاسمه جميعًا، مؤمنون وغير مؤمنين على حد سواء. ولكنني أيضًا لا أعتزم الادعاء بأن النزعات الإنسانية الحصرية هي البدائل الوحيدة عن الدين. وقد شهد عصرنا مجموعة قوية من التيارات التي يمكن للمرء أن يدعوها غير الدينية المناهضة للنزعة الإنسانية، والتي تمتد جذورها تحت أسماء مختلفة اليوم، مثل «التفكك» و«ما بعد البنيوية»، إلى مؤلفات لها تأثيرها القوي من القرن التاسع عشر، وخاصة مؤلفات نيتشه. وفي الوقت نفسه، هناك محاولات لإعادة بلورة نزعة إنسانية غير حصرية على أساس غير ديني، كتلك التي تتجلى في صيغ مختلفة من الإيكولوجيا العميقة.
إن ما أريد التأكيد عليه بالأحرى هو أن العلمانية بالمعنى الثالث اقترنت بالنزعة الإنسانية الحصرية، ما أدى للمرة الأولى إلى توسيع نطاق الخيارات الممكنة، ومن ثم غسق حقبة الإيمان الديني «الساذج». وبهذا المعنى تسربت إلينا الإنسانية الحصرية عبر توسط الألوهية، ومن ثم صارت كلٌ من الألوهية والنزعة الإنسانية ممكنتين من خلال التطورات السابقة التي شهدتها المسيحية الأرثوذكسية. وحالما اعتلت هذه النزعة الإنسانية المشهد، تأزمت وضعية التعددية غير الساذجة إذ فتحت المجال أمام كثرة من الخيارات خارج نطاق الخيارات الأصلية. ولكن يظل ظهور النزعة الإنسانية الحصرية تحولًا حاسمًا ضمن هذا المسار.
من وجهة النظر هذه، يمكن لنا أن نختصر الاختلاف بين العصور السابقة والعصر العلماني في ما يلي: العصر العلماني هو عصر يصبح فيه غسق جميع الأهداف التي تخرج عن نطاق الازدهار الإنساني ممكنًا، بل أكثر من ذلك، إنه يقع في نطاق حياة ممكنة لعموم الناس. وهناك تكمن أهمية العلاقة بين العلمانية والنزعة الإنسانية المكتفية بذاتها([29]).
ويمكن تعريف «الدين» بحسب ما نحن في صدده بما تقتضيه معاني «التعالي»، ولكن التعالي يجب أن يفهم على أكثر من صعيد. ويمثل الإيمان في بعض الفعاليات والقوى التي تتعالى عن النظام المحايث في الواقع، ميزة حاسمة من ميزات «الدين»، كما بينت ذلك نظريات العلمانية التي ركّزت اهتمامها على علاقتنا بالإله المتعالي الذي فقد مركزيته في الحياة الاجتماعية (العلمانية بالمعنى الأول)، وعلى تراجع الإيمان بهذا الإله (العلمانية بالمعنى الثاني). ولكن من أجل فهم أفضل للظواهر التي نريد أن نوضحها، ينبغي أن ننظر في الأبعاد الثلاثة التي تشكلت ضمنها علاقة الدين بـ«الما وراء». ويكمن البعد الحاسم الأول، الذي يجعل تأثير الدين في حياتنا مبررًا، هو الذي عرضت له منذ حين: الشعور بأن هناك خيرًا أسمى من الازدهار الإنساني. ففي الحالة المسيحية، يمكن أن ننظر إلى هذا الأمر على أنه محبَّة، المحبَّة التي يمنّ بها الله علينا، والتي يمكن أن نشارك فيها عبر توسّط قدرته. وبعبارة أخرى، تُعطى لنا إمكانية التحوّل الذي تحملنا إلى ما وراء مجرد الكمال البشري. ولكن، بطبيعة الحال، لن يكون لهذا المفهوم للخير الأسمى الذي يمكن أن نبلغه أيّ معنى إلا في سياق الاعتقاد في قوة عليا، الله المتعالي في الإيمان الذي يظهر في معظم تعريفات الدين. ثم ثالثًا، فإن القصة المسيحية للتحوّل المحتمل عبر المحبة تتطلب أن نتدبر حياتنا كما لو كانت تتجاوز حدود نطاقها «الطبيعي» من الولادة إلى الموت، لتمتد إلى ما وراء «هذه الحياة».
ومن أجل فهم الصراع أو التنافس أو السجال بين الدين وعدم الإيمان في ثقافتنا، علينا أن نفهم الدين على أنه يجمع بين هذه الأبعاد الثلاثة للتعالي. وليس ذلك لأنه لا توجد خيارات أخرى في مجتمعنا، خيارات بين هذا المنظور الثلاثي الأبعاد للتعالي، وبين الإنكار التام للدين. بل على العكس من ذلك، توجد خيارات كثيرة. ولكن كما سأبيّن في العديد من فصول هذا الكتاب، أن هذا السجال المتعدد الأطراف يمكن اختزاله في هذين الموقفين المتطرفين: دين متعالٍ، من جهة، وإنكار صريح له، من جهة أخرى. ومن الشرعي تمامًا أن نعتقد أن هذا هو الوجه المؤسف للثقافة الحديثة، ولكن علينا أن نعترف، كما سأبيّن ذلك، أن تلك هي الحقيقة.
[ 4 ]
إذن فالعلمانية بالمعنى الثالث، وهو المعني الذي يعنيني هنا، في مقابل المعنى الأول (الفضاءات العمومية العلمانية)، والمعنى الثاني (تراجع الإيمان والطقوس)، تتمثل في أنماط جديدة من الإيمان، شكل جديد من التجربة يحفزنا إلى الإيمان وهي بدورها تجربة يحددها الإيمان، وذلك في سياق جديد حيث ينبغي أن تتعلق كل تساؤلاتنا ومباحثنا بالأخلاقي والروحي.
وتتمثل السمة الرئيسة لهذا السياق الجديد في أنه يضع حدًا للاعتراف الساذج بالمتعال، أو بالغايات أو الانتظارات التي تتجاوز الازدهار الإنساني. ولكن هذا يختلف تمامًا عن التحولات الدينية في الماضي، حيث كلما انهار أفق سذاجة استعيض عنه بآخر، أو أن ينصهر الاثنين معًا بشكل توافقي -كما هو الحال، على سبيل المثال، عندما تحوَّلت آسيا الصغرى من المسيحية إلى الإسلام في أعقاب الغزو التركي. لا مجال للسذاجة اليوم بالنسبة لأي شخص كان مؤمنًا أو غير مؤمن على حد سواء.
هذا هو السياق العالمي في مجتمع ينطوي على أوساط مختلفة، بحيث قد يكون الخيار المفترض مختلفًا عن غيره، ورغم أن منتسبي تلك الأوساط يدركون تمامًا الخيارات التي يُفضلها الآخرون، ولا يمكنهم رفضها كما لو كانت خيارات خاطئة وهجينة وغير مبررة.
يتمثل التحوُّل الحاسم الذي فرض علينا هذا الوضع الجديد في ظهور النزعة الإنسانية الحصرية كخيار متاح على نطاق واسع. كيف حدث كل هذا؟ أو بلغة أخرى، ما الذي حدث على وجه الدقة حتى تغيرت أوضاع الإيمان بهذا الشكل؟ وهذه ليست بالأسئلة التي يمكن الإجابة عنها بسهولة.
وأعتقد أيضًا أنها أسئلة ليست سهلة وإن تبدو الإجابة عنها، بالنسبة للعديد من الناس في يومنا على الأقل في خطوطها العامة، واضحة إلى حد ما. لقد اقترنت العلمانية في جميع صيغها الثلاث بالحداثة. وهذه العلاقة السببية لا مفر منها، وإن نظرية العلمانية الرئيسة هي المعنية ببيان ذلك. ولا يمكن للحضارة الحديثة إلا أن تؤدي إلى «موت الإله».
وأعتقد أن هذه النظرية غير مقنعة، ولكن حتى نتبيّن السبب الكامن وراء ذلك، لا بدّ لي من أن أبادر إلى عرض قصتي الخاصة التي سأسردها في الفصول التالية. وفي مرحلة لاحقة سأعود إلى مسألة معرفة أيّ نظريات العلمانية الأكثر إقناعًا.
ولكن، قبل ذلك، أود أن أسوق كلمة بشأن السجال الذي سأخوضه. وبالأحرى كلمتين في الحقيقة. أولًا، سأهتم، كما قلت أعلاه، بالغرب أو بعالم شمال الأطلسي، أو بعبارة أخرى، سأوجه اهتمامي إلى الحضارة التي تمتد جذورها الرئيسة إلى ما نطلق عليه عادة اسم «المسيحية اللاتينية». وبطبيعة الحال، فإن ظواهر العلمانية والعلمنة يمتد وجودها اليوم إلى ما وراء حدود هذا العالم. وليس لنا من بدّ إلا أن نُجري يومًا ما دراسة للظاهرة برمتها على نطاق عالمي. ولكن لا أعتقد أنه بإمكاننا أن نبدأ من تلك الحقبة. وذلك لأن العلمانية، مثل غيرها من سمات «الحداثة» – البُنيات السياسية، وأشكال الديمقراطية، واستخدامات وسائل الإعلام، وما إلى ذلك – في الواقع، تُعبِّر عن نفسها بشكل مختلف نوعًا ما، وتتطوَّر تحت ضغط مطالب وتطلعات تختلف باختلاف الحضارات. إننا نعيش شيئًا فشيئًا في عالم يشهد «حداثات متعددة»([30]). وتحتاج هذه التحوُّلات الحاسمة إلى دراسة تأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الحضارية المختلفة قبل أن نقع في تعميم عالمي متسرِّع. وبالفعل الأمر على غاية من الامتداد حيث نجد في عالم شمال الأطلسي العديد من الطرق الإقليمية والوطنية للانخراط في العلمنة ولا أستطيع أن أجزم بصحتها جميعًا. لكنني آمل، مع ذلك، أن نُسلِّط بعض الضوء على السمات العامة لمسار العلمنة([31]). وأجدني مضطرًا هنا لاتّباع المسار ذاته، الذي اتخذته في كتاب «منابع الذات»([32])، حيث تناولت فيه أيضًا مجموعة من القضايا ذات الاهتمام الإنساني الكوني، ولكني تعاملت معها ضمن حدود الإقليمية.
ثانيًا، سأُجادل، في الفصول التالية، ضد ما أُسمّيه «قصص الطرح». وبعبارة مُختصرة أعني بذلك سرديات الحداثة بشكل عام والعلمانية على وجه الخصوص والتي تفسر تلك الظواهر عبر التأكيد على أن البشر فقدوا أو انحرفوا عن أنفسهم أو حرَّروا أنفسهم من أفق سابقة أو أوهام أو قيود كبَّلت المعرفة. وما ينبثق من هذه العملية – الحداثة أو العلمانية – هو أن يُفهم وفق السمات الأساسية الكامنة في الطبيعة البشرية التي كانت حاضرة دائمًا، ولكن عطَّلها ما صار مستبعدًا الآن. ضد هذا النوع من القصص، سأظل أؤكد دائمًا على أن الحداثة الغربية، بما في ذلك علمانيتها، هي ثمرة للاختراعات الجديدة، والتصوّرات الجديدة للذات والممارسات ذات الصلة بها، ولا يمكن تفسيرها من حيث السمات الدائمة للحياة البشرية. ويحدوني الأمل في أن توضح المناقشة التفصيلية التالية هذه المسألة بوضوح أكثر، وسأعود إلى ذلك أيضًا بصورة أكثر انتظامًا حتى نهاية الفصل الخامس عشر.
الهوامش (عصر علماني):
[1] Calhoun, Craig (2008) Book review: A Secular Age: Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2007). European Journal of Sociologie, 49 (03). p. 455-461.
[2] شارل تايلور، الدين والعلمانية، مجموعة من المؤلفين، من ضمنهم تايلور نفسه، إشراف سيلفي توسيغ، ترجمة محمد صالح أحمد، دار نينوى، دمشق، سوريا، 2016، مارسيل غوشاي: «خيبة الأمل في زوال الأوهام»، ص 54.
[3] تايلور، تشارلز، عصر علماني ، ترجمة نوفل الحاج لطيف، المقدمة، ص 9.
[4] Ibid., Calhoun, Craig.
[5] شارل تايلور، الدين والعلمانية، مصدر موثق أعلاه. سيلفي توسيغ: «مقدمة لقراءة عصر علماني »، ص 20 وما بعدها.
[6] مارسيل غوشاي، مصدر موثق أعلاه، ص 54.
[7] عصر علماني ، مصدر موثق أعلاه، فاتحة الكتاب.
[8] المصدر نفسه، فاتحة الجزء الأول: «دور الإصلاح»، الفصل الأول: «حصون الإيمان».
[9] انظر، المسكيني، فتحي، الإيمان الحر أو ما بعد الملة، مباحث في فلسفة الدين، مؤمنون بلا حدود، الرباط، المعرب، 2018، ص 252.
[10] المصدر نفسه، ص 253.
[11] هذا، بطبيعة الحال، الرأي السائد إلى وقت قريب لما أسميه «علمانية بالمعنى الأول». ويقينًا سنواجه بعض التحديات في مستوى بعض النقاط التي يثيرها في أدق تفاصيله، كمفهوم الدين بوصفه شأنًا شخصيًا، انظر:
José Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago: University of Chicago Press, 1994).
وقد أوضح كازانوفا في أعماله الأخيرة بعض التعقيدات التي يثيرها ما أسميته هنا «العلمانية بالمعنى الأول». فهو يُميّز من جهة، العلمنة كخصخصة مزعومة للدين (وهو المعنى الذي يعترض عليه دائمًا)، عن العلمنة «كتمايز بين الفضاءات العلمانية (الدولة والاقتصاد والعلوم)، التي عادة ما تُفهم على أنها (تحرر) من المؤسسات والقواعد الدينية». ويعتبر ذلك بمنزلة «المكون الأساسي للنظريات الكلاسيكية للعلمنة، التي ترتبط بالمعنى الأصلي-الاشتقاقي-التاريخي للمصطلح. وهو يشير إلى نقل الأشخاص والأشياء والمعاني، وما إلى ذلك، من الاستخدام أو الملكية أو السيطرة في المجال الكنسي أو الديني إلى المجال المدني أو اللائكي». انظر كتابه المقبل الذي يُميّز فيه الصالح عن الخاطئ في نظريات العلمانية الرئيسة.
[12] حول عبارة «الدين في كل مكان»، انظر:
Danièle Hervieu-Léger, Le Pèlerin et le Convert (Paris: Flammarion, 1999), pp. 20-21.
[13] تيار مهم في نظرية العلمنة المعاصرة اقتفى أثر ماكس فيبر ويُركز على أهمية «التمايز» و«الاستقلالية» في الفضاءات المختلفة، تقوده عملية «عقلنة». انظر
Peter Berger, The Sacred Canopy (New York: Doubleday, 1969); and Olivier Tschannen, Les Théories de la sécularisation (Genève: Droz, 1992), chapter IV.
وسأقدّم نقدًا جزئيًا لوجهة النظر هذه لاحقًا.
[14] The schoolboy was George Macaulay Trevelyan. The saying is invoked by Owen Chadwick, The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), p. 164.
[15] Bede Griffiths, The Golden String (London: Fount, 1979), p. 9.
[16] Peter Berger, A Far Glory: The Quest for Faith in an Age of Credulity (New York: Free Press; Toronto: Maxwell Macmillan Canada; New York: Maxwell Macmillan International, 1992), pp. 128-129.
[17] Schiller, Letters on the Aesthetic Education of Man, ed. and trans. Elizabeth Wilkinson and L. A. Willoughby (Oxford: Clarendon Press, 1967), chapter 15.
[18] لقد فرض مصطلح «الامتلاء» نفسه عليّ حتى صار يدل على الوضع الذي نطمح إليه، وإني على وعي تام بأنه لا توجد كلمة يمكن أن تستوفيه حقه. وكل تسمية ممكنة تظل منقوصة ضمن بعض الوجوه. إن ما هو صارخ في «الامتلاء»، هو أنه وفقًا لمسار روحي معقول جدًا، حاضر بوضوح في البوذية، على سبيل المثال، حيث يكون أقصى ما نطمح إليه هو بلوغ حالة من الفراغ (سونياتا)، أو بتعبير لا يقل مفارقة، لا يتأتى الامتلاء الحقيقي إلا من خلال الفراغ. ولكن لأنه لا توجد عبارة تستوفي هذا الوضع حقه تمامًا فإني استخدم مصطلح الامتلاء مع كل هذه التحفظات.
[19] انظر المناقشة المثيرة للاهتمام (على ما يبدو) للتجربة الدينية ومختلف تمفصلاتها.
Hans Joas, Braucht der Mensch Religion? (Freiburg: Herder, 2004), especially pp. 12-31 and 50-62
[20] إذا ما أخذنا بعين الاعتبار من زاوية نظر فينومنولوجيا التجربة الأخلاقية/الروحية في علاقة بـ«الأوساط» الثلاثة: العالي والمنخفض والمتوسط، لتبيّن لنا بداهة أن أمورًا كثيرة أتلفت. من ذلك مثلًا وهذا واضح، أننا نشهد أيضًا قوة المطالب الأخلاقية/الروحية في مواضع أخرى، على سبيل المثال في أحكامنا بشأن أعمالنا أو أعمال الآخرين فنُعجب ببعضها ويؤلمنا ويغيظنا البعض الآخر. حياتنا العادية مشبعة بالبعد الأخلاقي الذي يحضر فيها بطرق مختلفة.
[21] La Peste, Le Mythe de Sisyphe.
[22] Birgit Meyer, Translating the Devil (Trenton: Africa World Press, 1999), p. 181.
[23] لقد اقتبست هذا المصطلح من تمييز شيلر الشهير بين الشعر «الساذج» والشعر «العاطفي»، بسبب أوجه التشابه الواضحة بين تناقضه وبين التناقض الذي أشير إليه هنا.. انظر
Schiller, «Über naïve und sentimentalische Dichtung», in Sämtliche Werke, Volume 5 (München: Carl Hanser Verlag, 1980), pp. 694-780.
[24] انظر
Hubert Dreyfus, Being in the World (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991); and John Searle, The Construction of Social Reality (New York: The Free Press, 1995).
[25] Ludwig Wittgenstein, On Certainty, ed. G. E. M. Anscombe and G. H. Von Wright, trans. Denis Paul and G. E. M. Anscombe (Oxford: Blackwell, 1969).
[26] Marie-Anne Lescourret, Claudel (Paris: Flammarion, 2003), chapter 3.
[27] بطبيعة الحال، تعود هذه الفكرة إلى العصور القديمة، في فلسفة الأبيقوريين، على سبيل المثال، وهنا لا بد من أن نستثني أرسطو، حيث لعب الله في نظريته دورًا حاسمًا، كمحور للجاذبية، في الكوسموس. ولكن لم يصبح النظام المحايث مجرد نظرية فقط بل خلفية لتفكيرنا برمته إلا في الغرب الحديث وبصفة خاصة مع العلم الما بعد غاليلي.
[28] انظر
The Dalai Lama, Ancient Wisdom, Modern World: Ethics for the New Millennium (London: Little, Brown, 1999).
[29] بمعنى ما، يبدو أني أتخذ هنا بطريقة ضمنية موقفًا ضمن سجال يقسّم منظري «العلمانية» ويتعلق بكيفية تعريف «الدين». ففي حين يتمحور تعريف الدين، بالنسبة للبعض، حول الوظيفة التي يمكن أن يؤديها بالنسبة إلى الناس أو المجتمع، كأن يكون عاملًا مساعدًا على «الاندماج»، فإنه بالنسبة للبعض الآخر، يجب أن يكون تعريف الدين موضوعيًا، ومعظمهم يحيلون إلى ارتباطه بكائنات خارقة للطبيعة أو إلى قوى معيارية. وفي ذلك اختلاف بيِّن لا يخلو من أهمية نظرية بين التوجهين. فمن وجهة النظر التي تعرف الدين وظيفيًا، يمكن القول بأن الدين لم يتراجع في العصر «العلماني»، لأن هذا المصطلح يمكن أن يشمل جميع أنواع الظواهر المعاصرة، بما في ذلك أيضًا حفلات الروك ومباريات كرة القدم، فضلًا عن الاحتفالات الدينية. بينما لا تنكر وجهة النظر التي تعرف الدين موضوعيًا تراجعه. انظر المناقشة المثيرة للاهتمام
Danièle Hervieu-Léger, La Religion pour Mémoire (Paris: Cerf, 1993), chapters 2 and 3.
أنا لا أقصد أن أقرر على نحو مجرد أن أحد هذين التعريفين أفضل من الآخر، وإنما فقط أريد أن أقول إن المسألة المثيرة للاهتمام بالنسبة لي تتعلق بالدين بالمعنى الجوهري. وقد انتهجت في سبيل تقييد هذه الظاهرة طريقة خاصة، مع مراعاة الإحالة إلى «الخارق للطبيعة»، لأن التمييز بين الطبيعي والخارق للطبيعة ليس كونيًا، وإنما نشأ حقًا فقط في صلب التقليد الغربي (مع استثناء الإسلام)، عبر التأكيد على الازدهار الإنساني.
[30] انظر
Daedalus volumes edited by Shmuel Eisenstadt, «Early Modernities», Summer 1998, Volume 127, Number 3; and «Multiple Modernities», Winter 2000, Volume 129, Number 1;
وأيضًا
Dilip Parameshwar Gaonkar, ed., Alternative Modernities (Durham: Duke University Press, 2001).
[31] أنا أدرك أيضًا الخطر المعاكس المتمثل في أننا قد نهمل الترابط بين مسارات العلمنة في مختلف الحضارات. وهو استنتاج انتقده بيتر فان دير فير Peter Van Der Veer، لإهمالي الطريقة التي تغذي فيها التصورات الاستعمارية للمجتمعات غير الأوروبية مفاهيمها للدين.
[32] Harvard University Press, 1989.