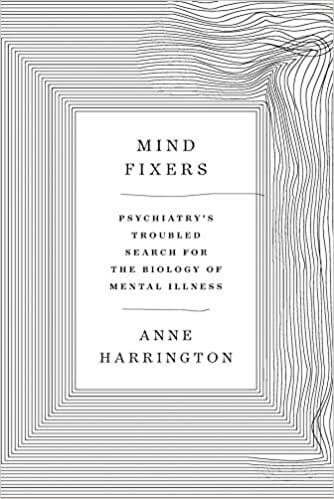
لطالما اعتقد الطب النفسي أنه على وشك فهم وشفاء المرض النفسي، لكن تاريخه الحقيقي قصة من التعذيب والإحتيال! .. هذا ما يكشفه كتاب حديث.
إذا ذهبت إلی طبيبك تشكو أعراضا ً نفسية، كتتابع الأفكارفي ذهنك بصورة دائمة، أو تعاني عجزاً في النوم أو إفراطاً فيه، أو تفكر كثيراً بإيذاء نفسك، أو تشعر بالحزن أو الغضب أو الإجهاد بصورة دائمة، أو تعاني فقراً في المشاعر أصلا، أو كانت لديك أوهام [delusion] أو تسمع أصواتا [هلاوس Hallucinations]، أو كان إيقاع مزاجك بين صعود زائف وهبوط ماحق؛ فإن زيارتك للطبيب تبدو حيئنذ كأي زيارة له. يتلقی أكثر الأطباء بشكل روتيني شكاویً من هذا النوع، يستمعون شكواك، يشخصّون، ثم ربما وصفوا لك دواءاً، تماما كما لو كان الأمر شكوی من أعراض مرض السكري أو الربو أو ارتفاع ضغط الدم أو أي مرض جسدي آخر.
[لكن] الفرق الكبير الذي يخفى على المرضی أنه بينما يمتلك الأطباء معرفة جيدة حول بيولوجيا أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ونحوها، كما أن لديهم إلماما ممتازاً بفهم آلية عمل الدواء الذي يصفونه (رغم أن بعضهم أكثر هوسا بالأدوية من غيره)، حتى وإن كان مرضك معقداً أو عصيا على العلاج، فإن بوسع الطبيب أن يُحيلك الى أخصائي يحظى بدراية متقدمة بطبيعة مرضك وعلاجه (رغم افتقارهم أحيانا إلى المهارات الإجتماعية لشرح الأمور لك). وحتی لو كنت تعاني سرطاناً عضالا، فإن لدى الأطباء أيضا فهما لمرضك، وهم إنما يعجزون عن علاجه فقط.
إلا أنه لا وجود لشيء من ذلك إذا قدمت إلى طبيب نفسي أو أخصائي نفسي، تشكو [مثلا] أعراض الاكتئاب أو القلق أو اضطراب ثنائي القطب (Bipolar)، إذ ليس لدى أي من هؤلاء الخبراء أدنى فهم لبيولوجيا عمل هذه الاضطرابات ولا أسبابها، فليس لأحد علم بذلك، كما أنه ليس بينهم إتفاق حول سبب علاج أصناف متعددة من الإدوية[1] لتلك الاضطرابات، ولا لماذا تفلح هذه الأدوية في علاج بعض الناس ولا تفلح مع آخرين؟ أو لماذا يتوقف مفعولها مع بعض المرضى بعد مدة من تناولها؟ أو لماذا يوقف بعض المرضى الأدوية بلا عناء، بينما يعاني آخرون أعراضا رهيبة جراء التوقف؟!. لا أحد يعرف.
تنطوي معظم الأمراض على خلل كامن يمكن التحقق منه إكلينيكيا، إذ تستطيع أن تجري فحصاً للدم أو البول، أو تقوم بعمل صورة أشعة للتحقق من كسر في العظم أو بحثاً عن أي علامة حيوية دالة على المرض.أما في اضطراب المزاج [مثلا]؛ فإن ما لدينا هو “الأعراض” وحسب، وليس من الواضح ما إذا كانت أعراض القلق وثنائية القطب والاكتئاب أعراضاً لعدة اضطرابات أم هي أعراض لاضطراب واحد، أم هي مجموع أطياف ومزيج من عدة اضطرابات، أو حتى إن كانت اضطرابات من الأساس.
يخشى بعض الناس إذا ما أخبر طبيبه بأعراض كهذه أن يقوم بإدخاله المشفى النفسي، لكن تأكد أن لا شيء يدعوك للقلق، فشوارعنا وسجوننا ملئى بالمشردين الذي يعانون اضطرابات نفسية، ولا سبيل إلى تمويل أنظمة الرعاية النفسية لتقوم بإدخالك أنت.
تحظى معظم الحقول العلمية الرئيسية بتاريخ تقدمي باعث على التفاؤل؛ رحلة من الجهالة الی النور. فقد بدأت مشوارها في زمان كنا نجهل فيه الانتقاء الطبيعي أو النسبية العامة أو نظرية الأمراض أو النظرية الجرثومية، فسارت تدريجيا إلی حاضر بهيج مستنير، يتحقق منها على الدوام العديد من أولئك العباقرة غريبي الأطوار والفائزون بجوائز نوبل.
شافيات العقل (Mind Fixers) للدكتورة آن هارينغتون؛ كتاب في تاريخ الطب النفسي الحديث، يدور حول البحث في الأساس البيولوجي للأمراض النفسية، على نحو غير معهود، إنها رحلة من ظلام إلى ظلام يتخللها كثير من الفجر الكاذب . لطالما اعتقد الطب النفسي أنه على وشك فهم وشفاء المرض النفسي، وفي كل مرة تجد إطاراً نظرياً جديداً، وفئات تشخيصية جديدة، وعلاجات معجزة جديدة، وسياسات صحية جديدة؛ فيتضح بعد مزيد من التحقق أن الأمر مريب، هذا إن لم يكن محض احتيال!. وعلى الدوام، يكسب الأطباء النفسيون -وحلفائهم ذوو الإحسان السخي من شركات الأدوية متعددة الجنسيات- مالاً وفيراً ومكانة ثقافية لسنوات أو عقود قبل أن يُكشف زيف ذلك.
هارينغتون أستاذة باحثة في تاريخ العلوم في جامعة هارفارد، وكتابها هذا كتاب تاريخ أكثر من كونه كتاب علم. فالعلم هاهنا علم زائف، والتاريخ قاتم بلا رحمة.
تبدأ المؤلفة من منتصف القرن التاسع عشر، حيث شهدت أوروبا وأمريكا صعوداً واسعاً غير مفهوم في [تفشي] الأمراض النفسية. (منذ 170 عاما على الأقل يرى كل جيل نفسه ضحية لأزمة نفسية، وكل جيل من من أرباب العلوم الاجتماعية يبتدع نظريات ملتبسة -لكن ذات طراز عصري- لتفسير ذلك كله).
في خمسينيات القرن التاسع عشر كان الأصلّ أن يُنظر للاضطراب النفسي كقصور أخلاقي، ناتجاً عن الإنحلال الجنسي والقمار وشرب الخمر والكفر ونحو ذلك. ومع فرط امتلاء المشافي النفسية بالمرضى، تساءل الاطباء النفسيون وأخصائيو الأعصاب عما إذا كان لتلك الحالات المرضية أساسٌ جسدي، وشرعوا في فحص دقيق لأدمغة النزلاء المتوفين بحثا عن الإجابة.
ثمة تاريخ حديث مُجمع عليه مفاده أن صناعات الطب النفسي تخبرنا بذاتها عن هذه المهنة، وأنها قصة تقدم باعثة على التفاؤل، وعلى النقيض مما يعرضه كتاب “شافيات العقل“، كان التحوّل إلى علم الأحياء في أواخر القرن التاسع عشر هو اللحظة الذي تحوّل فيها الطب النفسي إلى علم حقيقي، فقام علماء الأحياء وقتئذ بتشريح ودراسة الأدمغة وفقاً للنهج الصحيح، لكن بعد ذلك -وفقا للرواية التاريخية الشائعة- حدث انقلاب مفاجئ على هذا الصرح من قبل فرويد ومؤيديه، فأخرجوا الطب النفسي عن مساره! ، وهو ما امتد إلى سنوات متأخرة في القرن العشرين، واستولوا عليه بمفاهيم لا معنى لها كـ “حسد القضيب” و”عقدة أوديب” و”تفسير الأحلام”. ثم شهدت الثمانينيات تراجعاً للفرويدية، وعاد الطب النفسي العلمي من جديد، بحيث صار يًفهم المرض النفسي على أنه “خلل كيميائي”، أي مجرد خلل في النواقل العصبية، وهو ما يمكن علاجه بمضادات الاكتئاب ومضادات الذهان الجديدة، والتي لا تزال تصرف على نطاق واسع اليوم.
تتولى د. هارينغتون مهمة إرباك هذا التاريخ المفرط في الأناقة. وأول مسألة تتناولها في هذا التأريخ المتداول، هو أن النظريات والعلاجات الطب نفسية “العلمية!” في مرحلة ما قبل فرويد هي إلى التعذيب العشوائي أقرب منها إلى العلم أو الطب، فهذا ما كان عليه الطب النفسي؛ من المداواة بحمامات الثلج (ice bath)، وإحداث الغيبوبة بالأنسولين، والعلاج بالملاريا (هذا ما لم اسمع به من قبلُ قط، أن تتعمّد المشافي النفسية إصابة مرضاها بالملاريا على أمل أن تشفيهم الحمّى، ثمّ يتولى المشفى بصورة أساسية علاج الملاريا. وقد توفي نحو 15% من هؤلاء وبقي بعضهم مصاباً بالملاريا بلا شفاء. ولأجل هذا كان لدى المشافي مخزون من المايكروبات تستعين به).
كان الطب النفسي وقتها طب عمليات الفص الجبهي للدماغ، فأجريت آلاف العمليات الجراحية عبر مخرز ينفذ من تجويف العين ليُحدث إتلافاً كبيراً في الفص الجبهي للدماغ من أجل أن يُـشفى المريض. لقد كان طب العلاج بالصدمات الكهربائية بصورة عشوائية، دون حتى تخدير المريض أو أخذ موافقته (لا يزال العلاج بالصدمة الكهربائية يستخدم أحياناً، مع أخذ موافقة المريض وتخذيره، كعلاج فعال لحالات الاكتئاب العصي على الاستجابة الأدوية).
كان الطب النفسي وقتئذ طب التحسين الإنتقائي للنسل. فإذ قد بدا أن العديد من الأمراض النفسية موروثة، فالنتيجة المنطقية التي خلص إليها الأطباء النفسيون مطلع القرن العشرين هي معالجة الأمراض النفسي من خلال عملية التعقيم الإجباري[2] (Compulsory sterilization). “حسبنا ثلاثة أجيال من البُلهاء“؛ هذا ما قررته المحكمة الأمريكية العليا حين حسمت حكمها بالتعقيم الإجباري على فتاة بلغت ثمانية عشرة عاماً حبلت بعد تعرضها للإغتصاب، وقد أدخلت والدتها قبل ذلك مشفى فرجينيا للصرع والتخلف العقلي (كان تعبير “تخلف عقلي” feeblemindedness كلمة عامة تشمل فئات من لصوص المتاجر إلى ذوي الإعاقات النمائية من أطفال النساء الماجنات).
أكثر من 60,000 شخص في الولايات المتحدة أرغموا قسراً على التعقيم الإجباري على مدار القرن العشرين، فقد كان ينظر للأمر كسياسة تقدمية مستنيرة، حظيت بتأييد معظم العقلاء والأذكياء والمتعلمين؛ أليست تعني نهاية الفقر والاضطراب النفسي؟!. لقد وافقت أيضا الحكومة الإشتراكية في ألمانيا على هذا البرنامج وقامت بمحاكاته، فشرعت في عمليات التعقيم الإجباري للمرضى النفسيين، ثم وسعت نطاق الأمر إلى القتل الرحيم، ثم انتهت بتوسيعه إلى القتل الجماعي لأي شخص يُشتبه في إضراره بالسلامة العِـرقية للشعب.
لم يكن التحوّل من المنحى البيولوجي إلى الطب النفسي الفرويدي أمراً غير مفهوم، هذا ما تشير إليه هارينغتون. وبحلول منتصف القرن العشرين كانت الثقة بالطب النفسي (البيولوجي) قد تلاشت، لكن هذا لا يعني أن صعود الفرويديين كان أمرا حسنا؛ لقد كان فظيعا في معظمه، ولكن فظاعة على نحو مختلف.
لم يكن فرويد نفسه معنيّا كثيرا بالأمومة. لقد اتضح لديه أن النساء يسعين لإنجاب الأطفال بدافع الشعور بالدونية لافتقارهن الى القضيب ، إلا أن الهوس المعروف للمدرسة الفرويدية بالأمهات ظهر بصورة أساسية في مرحلة ما بعد الحرب. فقد لعب الأطباء النفسيون دورا حاسماً في التجنيد العسكري، فرفضوا نحو مليوني شاب لأسباب “نفسية عصبية”، لكنهم بعد الحرب وجدوا أكثر من مليوني جندي ممن انخرطوا في الخدمة يعانون مشكلات نفسية حادة (وهي ما نعرفه اليوم باضطراب كرب ما بعد الصدمة PTSD)، واستنتج الاطباء النفسيون أن ذلك ربما كان بسبب خطأ أمهاتهم. فلئن كان أفراط الأمهات في حماية ودلال أبنائهن أمراً سيئاً، وكانت الأمهات المُـهملات غير الودودات أسوأ حالاً، فإن الأسوا على الإطلاق أولئك المروعات المتسببات بالفصام (schizophrenogenic mothers)، وهن الأمهات اللواتي كـن ما بين حماية مفرطة وإهمال؛ فهؤلاء المسؤولات عن التفشي الواسع للفصام والمثلية الجنسية[3] التي اجتاحت امريكا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. لقد حذر الأطباء النفسيّون البارزون الأمهات بشدة من كونهن يشكلن خطراً جسيماً على الأمن القومي؛ إنهن يقوضّن قدرة أمريكا على الدفاع عن نفسها ضد الشيوعية.
كان “الفصام” تشخصياً غامضاً، ومع ذلك تم التشخيص به على نطاق واسع. فالطفل صعب الطباع كان ذا “فصام طفولي”، سيما أولئك الذين يتجبنون التواصل البصري أو واجهوا صعوبة في فهم الإشارات الانفعالية لمن حولهم. والنساء العازفات عن ممارسة الجنس مع أزواجهن أو أولئك اللاوتي لم يرغبن بالزواج أصلاً قد يكن أيضا فُصاميات، كما أن الفتيات اللاوتي يفتقرن للاخلاق والحشمة قد يكنّ أيضا فصاميات، وأيضا كونك غير وطني ربما يكون عرضا محتملاً.
لم يتم تصنيف “الاكتئاب” و”القلق” كاضطرابات مستقلة في عهد الفرويديين، وبدلاً من ذلك كانت أعراضاً للفصام تدل على أن الطاقة النفسية (psychic energy) للفرد قد تضرّرت، وأن من شبه المؤكّد أن ذلك بسبب أمهاتهم.
كان العلاج عموماً وقتئذ أن يُدخل الأفراد المصحات مدى حياتهم، مع تقديم دروس قاسية لعائلاتهم التي قادت تربيتهم الردئية أطفالهم إلى الجنون. كما كان المرضى يعالجون أحيانا بالتحليل النفسي الفرويدي: تأويل الأحلام، واختبار بقع رورشاخ، والتداعي الحر، والذكريات المكبوتة، ونحو ذلك. وبالتاكيد، فلم يُـعالج ذلك أحداً، وغالب الذي تم ادخالهم أقاموا في المصحات وعملوا هناك حتى ماتوا أو حتى إغلقت المصحة.
في يناير عام 1973 نشر عالم النفس ديفيد روزنهان مقالاً في مجلة (Science)، وهي واحد من أكثر المجلات الأكاديمية تأثيرا في العالم، بعنوان “أن تكون عاقلا في أماكن مجنونة” ( On Being Sane in Insane Places). حيث أجرى روزنهان تجربة بأن قدم ثمانية أشخاص (بمن فيهم هو) إلى اثني عشرة مشفى مختلفاً للأمراض النفسية في أنحاء الولايات المتحدة، واشتكو من الهلاوس السمعية، واختيرت الكلمات التي زعموا أنهم سمعوها بعناية، بحيث لم ترد في أيّ من الأدبيات المنشورة وقتئذ مربوطة بأعراض الذهان، فتم تشخيصهم جميعاً بالفصام أو الذهان الهوسي الاكتئابي، وادخلوا المصحات، وبمجرد دخولهم بدءوا بالتصرف على نحو طبيعي وتسجيل الملاحظات حول تلك البيئة بصورة علنية، إلى الحد الذي دفع زملائهم المرضى لاتهامهم أنهم أساتذة جامعيون أو صحافيون في زيارة تفقدية للمشفى، كما لم يشك أحد من الطاقم الطبي مطلقا أنهم ليسوا مرضى نفسيين. وفي النهاية تم تشخصيهم جميعا بــ فصام مع غياب الأعراض (schizophrenia in remission). ثم ختم روزنهان مقاله بقصة مشفى تعليمي بحثي مرموق بلغه نبأ دراسته تلك، فتحداه المشفى أن يرسل إليهم مرضى نفسيين زائفين، واثقين من قدرتهم على كشف المخادعين منهم. وبعد أكثر من عدة أسابيع أعلن المشفى انه تعرّف على واحد وأربعين شخصا من “العقلاء المتظاهرين بالجنون”. إلا أن روزنهان في الحقيقة لم يرسل أحداً في تلك الدراسة؛ لقد كانوا مرضى حقيقين، وهذا يعني واحداً وأربعين تشخيصاً سلبياً زائفاً.
ويوضح ناقد آخر للطب النفسي، وهو توماس ساس (Thomas Szasz) أن لا شيء من هذا يشبه الطب من قريب ولا بعيد. وما يبدو أن الأطباء النفسيين يفعلونه هو تحديد الأشخاص الذي يتصرّفون بنحو غير اعتيادي وغير مقبول اجتماعياً، ثم التأكيد أنهم “مرضى”، وبالتالي يلزمهم الحجز والعلاج، سواءٌ أراد المريض أن يتعالج أم لم يرد. يبدو أن الأطباء النفسيين [كانوا] ينتهكون الحقوق المدنية الأساسية لمرضاهم بشكل مذهل وعلى نطاق واسع؛ كان ذلك كله باسم العلم، لكن لم يكن أيا منه علمياً بحق.
أظهرت الدراسات المعنية بمدى دقة التشخيص الإكلينيكي في الطب النفسي الفرويدي أن الأطباء الذين يفحصون المريض نفسه يتوافقون فقط بنسبة 30% في كل مرة.
لقد فقدت مهنة الطب النفسي مصداقيتها إلى حد بعيد إثر سلسلة من الفضائح الصحفية التي كشفت عن الظروف المروعة للعديد من مشافي الصحة النفسية والإساءة الممنهجة للمرضى المحبوسين فيها.
في الوقت ذاته أثبتت العقاقير التي أنتجتها شركات الأدوية في الخمسينات والستينات أنها أكثر فعالية في علاج الأشخاص الذي يعانون الفصام واضطراب ثنائي القطب والاكتئاب؛ والتي بدت أقرب إلى اضطرابات متعددة، كلها ذات أساس وراثي وثيق للغاية، ولا صلة للأمر بالأمومة السامة أو الطاقة النفسية. لقد استهدفت الأدوية الجديدة النواقل العصبية (وهي موصلات كيميائية دقيقة بين خلايا الدماغ)، وتعمل تلك الأدوية من خلال تنظيم كمية ناقل عصبي معين في الدماغ، وهو ما يشير إلى تفسير بيولوجي في فهم المرض النفسي؛ من الواضح أن هذه الاضطرابات نشأت عن خلل في توازن النواقل الكيميائية، وهو ما ستعالجه الأدوية إذن.
قادت العقاقير الجديدة إلى فئات تشخيصية جديدة. فالاكتئاب الذي الذي كان ينظر إليه سابقاً كعرض لمرض نفسي آخر، لم يلبث أن أعيد وصفه كمرض نفسي مستقل في حد ذاته، وغدا على نحو مفاجئ مرضاً واسع الانتشار جداً كشيوع نزلات البرد!، ويمكن علاجه بفئة من العقاقير تعرف بــ SSRI (مثبطات اعادة امتصاص السيروتونين الإنتقائية)، وهو الاسم الذي يحكي قصة أنيقة وجيزة حول عدم التوازن الكيميائي وآلية الدواء في شفاء ذلك.
كان احتجاز مرضى الصحة النفسية على نطاق واسع كارثة صحية عامة، وكان باهض الثمن؛ إذا ما قورن بمضادات الذهان الجديدة ومثبتات المزاج التي كانت فعالة وآمنة إلى حد بعيد -أو هكذا أكدت الشركات المصنعة لكل أحد- فأقنع مسؤولو الصحة العامة أنفسهم أن إغلاق المشافي وإعادة المرضى النفسيين الى المجتمع هو الإفضل للجميع. لقد كان حلاً ناجعاً لأولئك الذين انتفعوا جيداً بالأدوية الجديدة، أو لأولئك الذين لهم عائلات يعودون إليها، أو لأولئك الذين يمكنهم التعامل مع مرضهم بأنفسهم. أما العديد من أولئك الذي لم يحظوا بأي من هذا فقد انتهى بهم الأمر في نظام السجون الذي سرعان ما أصبح النظام الفعلي الجديد للصحة النفسية.
لم يكن القرن الواحد والعشرين لطيفاً تجاه مصداقية الطب النفسي (المبني على أسس بيولوجية)، فقد دُحضت نظرية “اختلال التوازن الكيميائي” في التسعينيات. فإذا كان الاكتئاب اختلالا في توازن السيروتونين، فلماذا تعالج أدوية (SSRI) بعض الأشخاص دون غيرهم؟ وكيف يكون اضطراب ثنائي القطب (Bipolar) مفهوما في ظل نموذج الاختلال التوازن الكيميائي؟! . ليس هناك إجماع حول نموذج جديد يمكن أن يحلّ محل هذا النموذج، باستثناء اتفاق عام على أن معظم الأمراض النفسية محتمل أنها نتاج مجموعة معقدة للغاية من العامل الجيني والكيمياء الحيوية والبيئة، والتي تتفاعل فيما بينها في حلقة تغذية راجعة تعزّز بعضها بعضا.
من الواضح أن مُضادات الاكتئاب -وهي الدعامة الأساسية لنظرية “اختلال التوازن الكيميائي”- تعالج بعض المرضى بصورة فعالة، وهي حرفياً تنقذ حياتهم. لكن مضادات الاكتئاب حين تدرس على نطاق واسع، فإن فعاليتها (أي القدرة على تمييز أثرها عن أدوية البلاسيبو في تكرار التجارب العشوائية العمية[4]) لا تكاد تقدم دلالة إكلينيكيا. وتشير بعض الدراسات التحليلية (meta-studies)، والتي لم تستشهد بها مؤلفة الكتاب (د. هارينغتون) ولكن يمكن الوصول لها بيُسر بالبحث في الأدب الإكلينيكي، إلى أن أدوية (SSRI) نافعة في علاج بعض المصابين بالإكتئاب المعتدل أو الشديد. لكن هناك إفراطاً واسعاً في الوسط الطبي في وصف هذه الأدوية، وهذا ما يضعف فعاليتها المؤكدة حين تختبر في التجارب الإكلينيكية.
عام 2006، نشرت صحيفة نيويورك تايمز فضيحة شركة (Eli Lilly) واستراتيجيتها التسويقية للدواء الذي طورته، ويُـدعى زيبركسا (Zyprexa). فقد تم انتاج هذا الدواء لعلاج الفصام، لكن لا يمكنك أن تصبح ثرياً من خلال علاج مرضى الفصام، إذ لا يوجد ما يكفي من الفصاميين لذلك!، وقد كانت براءة اختراع هذه الشركة لدواء بروزاك (Prozac) على وشك الانتهاء، فعقدت مؤامرتها لتسويق الدواء الجديد بين الأطباء النفسيين وأطباء الرعاية الأولية على أنه علاج للاكتئاب والخرف والأرق وتقلب المزاج والتهيّج (irritability)، بينما أخفت في ذات الوقت تجاربها الإكلينيكية التي تشير إلى ارتباط الدواء بالسُـمنة وارتفاع سكر الدم ومرض السكري.
أعقب ذلك موجة من فضائح شركات الأدوية، التي ضبطت وهي تستعين بشركات التسويق لتلفيق مجموعات من المعنيين بدعم المرضى ( Patient advocacy group) لزيادة الوعي بمشكلات نفسية لم تكن موجودة أصلا قبل أن تبتكر الشركة أدويتها، ثم مارست ضغطاً على الأطباء النفسيين للبدء بالتشخيص بتلك المشكلات المختلقة. إن على كل صحفي كسول ساذج في نيوزيلاندا يُعين شركات الأدوية في هجومها على هيئة الإدارة الدوائية Pharmac[5] أن يقرأ آخر مائة صفحة من كتاب هارينغتون هذا، ليعرف ما سيحدث لنظامك الصحي إذا لم يكن لديك مشترون مركزيّون للأدوية، وكيف تضغط شركات الأدوية على الأطباء وموظفي الصحة بصورة مباشرة.
خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين (s2010)، فإن شركات الأدوية الكبرى -والتي لا تزال تترنح إثر تلك الفضائح والدعاوى القضائية الجماعية الواسعة- قد تراجعت عن الدخول في الأبحاث واسعة النطاق للصحة النفسية. وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات حيوية ولا تشخيصات موضوعية للأمراض النفسية. والربح الأكبر حيث يوجد مرض السرطان.
تقرر د. هارينغتون أن ما يجري اليوم بين مرضى الصحة النفسية والأطباء هو “لعبة”، يتقدم المريض فيشكوا لطبيبه ضيقاً نفسياً أو انفعالياً شديداً، فيبحث الطبيب في التشخيصات ضمن التصنيفات المتوفرة مما قد يكون له معنى، ثم يصف له دواءاً؛ هذا هو المتاح لديهم.
تكون الأدوية فاعلة أحيانا، وبالنظر إلى التأثير الوهمي للدواء (placebo effect) في علاجات الصحة النفسية، فإنه حتى لو لم يكن الدواء فعالاً حقيقة، فغالبا ما يشفي الناس على كل حال.
اقتباسان من جملة الاقتباسات التي ختم بها هذا الكتاب، يعودان لأعضاء رفيعي المستوى في كهنوت الطب النفسي، يوجزان الحالة الراهنة لهذا العلم. أما الإقتباس الأول فهو لتوماس إنسيل (Thomas Insel) المدير السابق للمعهد الوطني للصحة النفسية في الولايات المتحدة لثلاثة عشر عاما، كتب يقول:
“أمضيت ثلاثة عشر عاما في المعهد الوطني للصحة النفسي جادا في دعم بحوث علوم الاعصاب والوراثيات المتعلقة بالاضطرابات النفسية. وحين انظر في الماضي أدرك أنني بينما أفلحت في ايجاد كثير من الأوراق العلمية الجيدة التي نشرها علماء أكفاء بتكاليف مالية كبيرة أظنها بلغت 20 مليار دولار؛ فإني لا أظن أننا حركنا قيد إبرة في خفض الانتحار أو تقليل حالات الادخال إلى المشفى أو في تحسين تعافي ملايين من الناس الذين عانوا مرضاً نفسياً”.
وفي عام 2016 ، أكد الدكتور شيخار ساكسينا رئيس وحدة الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية أنه لو تم تشخيصه بالفصام لفضّل أن يعيش في أديس أبابا في أثيوبيا أو في كولمبو في سريلانكا، حيث يمكنه العيش كفرد منتج حتى لو كان غريب الأطور، بدلا من العيش في نيويورك أو لندن حيث سيكون الفرد في حالة “وصم” وسيُقصى إلى هامش المجتمع.
[1] مثل SSRIs, monoamine oxidase inhibitors, lithium, anticonvulsants.
[نقلت هذه الجملة من متن المؤلف إلى الحاشية، حتى لا تربك القارئ غير المتخصص].
[2] [يشير مصطلح التعقيم القسري أو الاجباري الى التدخلات التي تقوم بها الدولة بصورة إحبارية للحيلوية دون الانجاب لدى بعض الاشخاص أو الاجبار على اجهاض الحمل. وتتنوع الاعتبارات التي تدفع لذلك: كخفض مستويات الفقر في المجتمع (وبالتالي تحديد نمو السكاني)، أو لوجود اعاقة عقلية أو مشكلة صحية لدى أحد الوالدين تؤثر على المولود، أو من أجل الحفاظ على سلامة العرق، ونحو ذلك]
[3] كان ذلك ضمن اضطراب الشخصية السيسيوباثية sociopathic personality disorder وفقا للإصدار الأول من الدليل التشخيصي DSM، المنشور عام 1952، وهو الاضطراب الذي أعيد تصنيفه كشل من اشكال الإنحراف الجنسي، على نحو مماثل للبيدوفيليا، وذلك قبل أن يزال عام 1973 [نقل هذا النص من متن الكاتب للهامش].
[4] randomized double-blind trials
[5] تعنى هذه الوكالة الحكومية في نيوزيلندا بإصدار القرارات ذات الصلة بالصناعة الدوائية، ومن ذلك تحديد الأدوية التي يسمح بصرفها في المشافي والعيادات.


