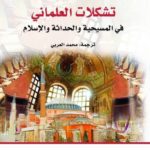
اقترحت في الفصل السابق أنه يحسن الاقتراب من العلماني على نحو غير مباشر. لذلك تفحصت بعض الطرق التي استخدمت بها فكرة الخرافة عبر العديد من القرون التي تشكلت فيها المعارف والسلوكيات والحساسيات التي نطلق عليها العلماني. في هذا الفصل، أقوم باستكشاف العلماني من خلال مفهوم الفاعلية، خاصة تلك الفاعلية المرتبطة بالألم. لماذا الفاعلية؟ ذلك لأن العلماني يقوم على تصورات معينة حول الفعل والعاطفة. ولماذا الألم؟ ذلك لسببين: الأول لأنه من جهة العاطفة، فإن الألم مرتبط بالذاتية الدينية وغالبًا ما يعتبر كنقيض للعقل؛ وثانيًا، لأنه من جهة المعاناة، يتم التفكير في الألم باعتباره حالة إنسانية ستمحوها الفاعلية العلمانية كليًّا[1]. وفي الجزء الأخير من الفصل الأول أناقش عددًا من أمثلة الفاعلية من التاريخ المسيحي والإسلامي وما قبل المسيحي التي يكون فيها الألم مركزيًّا. بيد أني أقوم بالأقل في هذا الصدد من لأجل تفهم التبريرات التي يقدمها بعض المتدينين حول وجود المعاناة، لا من أجل تفحص جوانب الحالة العلمانية. ولأن الألم هو عرض لجسد مبتلى، فهو في المقام الأول قيد على قدرة السد على التصرف بفاعلية في «العالم الحقيقي». كما أنه أيضًا العلامة الأكثر فورية على هذا العالم، على الحواس التي من خلالها يتحقق الشعور بماديته الداخلية والخارجية، وبالتالي يقدم الألم نوعًا من إثبات للعلماني. بيد أن النقطة الأكثر مفصلية بالنسبة للألم هو أنه يمكن الفكرة العلماينة القائلة بأن «صناعة التاريخ» و«التمكين الذاتي» يمكن أن تحل اللذة محل الألم بشكل تقدمي، أو على كل الأحوال من خلال البحث عما يسعد الإنسان.
تبدو لي الكتابات الأنثروبولوجية حول هذا الموضوع وقد اتسمت بالانتباه غير الكافي لحدود الجسد الإنساني باعتباره محلًا للفاعلية، وعلى وجه الخصوص بالحساسية غير الكافية للأنواع المختلفة التي يتفاعل بها الفاعل مع الألم والمعاناة. وعندما تستخدم كلمة «جسد»، فغالبًا ما تكون أكثر من مرادف للفرد الذي تعتبر فيه رغبته وقدرته غير إشكالية[2]. وليس الأمر كذلك بالنسبة لهؤلاء المتأثرين بفرويد بالطبع. وفي الحقيقة، وعلى الرغم من أن ادعاء فرويد حول إنتاجه نظرية شاملة حول الموضوع لها قدرة شاملة على التطبيق قد تم نقده على نحو صحيح من قبل الكثيرين، فإن انشغاله بعدم معرفتنا الكاملة وسيادتنا على أجسادنا وعقولنا يبقى ذا تأثير واسع. وهكذا، ففي دراستها الممتازة حول النظريات الحديثة المبكرة حول المشاعر، وصفت سوزان جيمس الخطوات التي يحدث بها التفكير في «الرغبة» كقوة مركزية تحكم كل الأفعال. فهي تلاحظ «مع معظم الإعادات في هذا النوع، فإن إنجازاتها تأتي مع بعض التكاليف.. فمن ناحية، يمهد الفهم متزايد العمومية للرغبة الطريق للأرثوذكسية الحديثة القائلة بأن الاعتقادات والرغبات هي مقدمات الفعل. ومن ناحية أخرى، فإن تفسيرات الأفعال القائمة على رؤية مفادها أن العواطف تحركنا فقط نحو الفعل، طالما هي أشكال من الرغبة أو مختلطة بالرغبة غالبًا ما تكون غفلًا بالمقارنة. وتفتقد الرغبات، التي يتم تناولها بعمومية، الالتواءات التي قد تجدها أكثر تفسيرية. فبمجرد أن نبدأ في توسيعها، فإننا ننجذب رجوعًا إلى منطقة العواطف المعقدة والمركبة أحيانًا»، وترى جيمس أن هذا التوتر بين «الرغبة» باعتبارها فعلًا وعاطفة قد تمت معالجته بفرادة في عصرنا من خلال فرويد ورفاقه[3]. إلا أنه ينبغي إضافة أنه على الرغم من أن الفرويدية تمتلك فهمًا مركبًا باستثنائية للآليات الداخيلة للعواطف (كوسائط بين العقل والجسد)، فإنها تحمل وعدًا إشكاليًّا بأن العواطف يمكن أن يتسيد عليها العقل في النهاية من خلال الملاحظة والتفسير المنظم، وعليه تمنح العقلانية التفوق في تكوين الذات العلمانية الحديثة.
نشر في العقد الأخير عدد متزايد من البحوث حول مركزية المشاعر في الحياة الثقافية، وإن هذا لأمر مرحب به ونحن بصدد فهم الفاعلية. بيد أن اهتمامي بالمعاناة كعاطفة مختلف نوعًا ما عن معظم هذه الأدبيات. إنني أتساءل في البداية عما إذا كان الألم ليس سببًا للفعل، بل هل يمكن أن يكون هو نفسه نوعًا من الفعل.
لا يوجد اتفاق بين الباحثين المعاصرين حول ماهية المشاعر[4]. فهناك من يصر على كونها دفقات تحدث كليًّا في جزء من الجسد يطلق عليه الدماغ، في ما يذهب آخرون إلى أنها تداخل بين الذوات وتقع في الفضاء الاجتماعي الذي يسكنه الأفراد. وفي بعض الأحيان تتم المساواة بين كل المشاعر والرغبة، وفي أحيان أخرى، تعتبر الرغبة شعورًا واحدًا من بين مشاعر أخرى. ومع هذا، فهناك العديد من النظريات خلا نظرية فرويد تؤكد على الطبيعة غير الواعية للمشاعر. كما أن كل إنسان، بغض النظر عما إذا كان يملك أو تملك نظرية عن المشاعر أو لا، يعرف أن بعض المشاعر (العواطف) يمكن لها وتقوم فعليًّا بالتشويش على النوايا أو إخفائها[5]. ويبقى أن النوايا الواعية تفترض كجزء أساسي في مفهوم الفاعلية عند أغلب الأعمال الأنثروبولوجية[6].
حتى في المجال النامي للأنثروبولوجيا الطبية التي أعطتنا فهمًا ثقافيًّا للصحة والمرض، فإن المعنى القياسي للفاعلية يعتبر مسلمًا به إلى حد بعيد. إن الجسد المريض غالبًا ما يمثل بدون اختلاف عن الجسد السليم، إذ إن مقاومة كل منهما للسلطة هو الشكل الذي تأخذه الفاعلية بالضبط[7].
وأجد أن مثل هذه الآراء مربكة لأنها تعزو الفاعلية الفردية إلى الجسد المريض بترجمة كل حالاته وحركاته مباشرة إلى «المعارضة». إذ إن الأنثروبولوجيين عندما يتحدثون عن تناول موضوع خبرة المرض، غالبًا لا يحيلون فقط إلى كلمات المريض بل أيضًا إلى سلوكه أو سلوكها كما لو كانت جزءًا من الخطاب. يبدو اعتبار ردود الأفعال الذاتية قابلة للقراءة بهذه الطريقة غير مرضٍ عندما نظل غير موقنين بالطريقة التي تفك بها شفرة «النص» السلوكي، عندما تعتبر «المعارضة» و«المقاومة» بدهيتين. حتى عند فرويد، فإن «المقاومة» تمثل مفهومًا معرفًا نظريًّا، ومفهومًا له مكانة خاصة في عملية التحليل. ودائمًا لا تقرأ معاناة الجسد المريض على أنها مقاومة لسلطات الآخرين الاجتماعية؛ فهي في بعض الأحيان عقاب للذات على رغبتها في ما لا ينغي اشتهاؤه.
لقد تعرض الاستخدام الأنثروبولوجي لمفهوم «المقاومة» للنقد على نحو صحيح لتقليهلا من شأن قوة وتنوع بنى السلطة[8]. إنني أقل قلقًا تجاه ما أطلق عليه «رومانسية المقاومة» من التصنيف الأكثر شمولية لــ «الفاعلية» التي تفترضها مسبقًا. وبالطبع، وبمفاهيم الفكر السليم، تحدث «المقاومة» في الحياة اليومية، وغالبًا ما تكون مهمة بالنسبة للعواقب عندما تحدث. غير أن اهتمامي يتمثل في أن افتنانًا بــ «المقاومة» يأتي من أفكار مؤيدة وأوسع. ينبع ميلنا للتعامل الرومانسي مع المقاومة من المسألة الميتافيزيقية التي تمثل فكرة «الفاعلية» ردًا عليها، وهي: مع التسليم بجوهرية الحرية أو السيادة الطبيعية للذات الإنسانية، ومع التسليم أيضًا برغباتها ومصالحها[9]، فما الذي على البشر فعله كي يحققوا حرياتهم ويمكنوا أنفسهم ويختاروا متعتهم؟ والافتراض هنا هو أن السلطة، وكذلك الألم، هي خارج الفاعل وقامعة له، أي أنها «تخضعه أو تخضعها»، ومع أن الفاعل «كذات فاعلة» لديه رغبة في معارضة السلطة ومسؤوليه في أن يصبح أكثر قوة، فبإمكانه أن يتغلب على إحباطه، أي المعاناة[10]. سأحاجج ضد هذا الافتراض. ولكن إلى الحد الذي اعتبرت فيه مهمة مواجهة السلطة أكثر من مهمة فردية، هي أيضًا تعرف مشروعًا تاريخيًّا هدفه هو الانتصار المتزايد للاستقلال الفرداني. تؤشر حقيقة أن «المقاومة» مصطلح تم استخدامه من قبل منظري الثقافة إلى الدلالة على أحوال متفرقة (السلوك غير الواعي للمرضى واحتجاجات الطلبة في المدارس وعموم حركات الإصلاح المدني والاستراتيجيات الدفاعية في اتحادات العمال والصراع المسلح ضد القوى المحتلة وما إلى ذلك) تؤشر على سبيل واحدة يصبح فيها نوع واحد من الدوافع العميقة وقد عزي إلى ذات فاعلة جوهرانية.
يجد منظّرو الثقافة أنفسهم يؤكدون وينفون وجود مثل هذا الجوهر في آن واحد. وهكذا يكتب محررو أحد المسارد في النظرية الاجتماعية المعاصرة في المقدمة: «من وجهة نظر نظرية، نحن بحاجة إلى ذات مبنية ثقافيًّا وتاريخيًّا في الوقت نفسه، ولكن من وجهة نظرية سياسية، نود لو كانت هذه الذات قادرة على الفعل بشيء من «الاستقلالية»، وأن تكون في غير توافق مع القواعد والأنماط الثقافية السائدة، أو في النماذج التي تخطها السلطة. بيد أن هذا الفاعل المستقل قد لا يعرف كفاعل من بئر خفية لــ «الإرادة» الداخلية أو من وعي قد أفلت من الضبط والتشكيل الثقافي. في الحقيقة، ليس مثل هذا الفاعل ممكنًا فقط بل «طبيعي»؛ وذلك لسبب بسيط وهو أنه لا «الثقافة» نفسها ولا نظم السلطة المتراكبة في المنطق والخبرات الثقافية يمكن أن تكون متّسقة كليًّا أو محتّمة كليًّا[11]. ولأنهم ذوو عقلية تقدمية (لنقل: «بنيويين»)، فإن هؤلاء المنظّرين الثقافيين يختلقون أي حديث عن «الغريزة». كما أنهم يريدون تقديم الصراع (المقاومة) والمعارضة كأمر طبيعي بالنسبة للسلوك الإنساني. بيد أن «الطبيعي» مفهوم يتسم على نحو معروف بالغموض، ويشتمل على معنى إحصائي وصفي يكون فيه التوزيع طبيعيًّا وعلى معنى علاجي يكون الطبيعي فيه صحيًا والنقيض له مرضيًا[12]. مذبذبين هذين المعنيين، يمكن للمحررين أن يؤكدوا أنه لا يوجد شيء في الفاعل «له أن ينفلت من الضبط والتشكيل الثقافي»، مع أنهم يؤكدون على أن «الثقافة» لا يمكن أن تكون «محتمة كليًّا».
بالطبع، كتب الأنثروبولوجيون على نحو شائق حول الجسد ومشاعره واشتباكه مع العالم من خلال الحواس. أما اهتمامي، فهو لأن الجسد الإنساني له حياة متبدلة وقادرة على الولوج لذاتها على نحو واسع، ولأن المشاعر تجعل امتلاك الأفعال مسألة توصيفات متضاربة، ولأن الجسد والعقل يضمحلان بتقدم العمر والأمراض المزمنة، علينا ألا نفترض أنه فعل فاعل مؤهل له نوايا واضحة. ولا ينبغي لنا أيضًا أن نفترض أن الفهم السليم للفاعلية يتطلب أن نضعها ضمن إطار التاريخ العلماني للتحرر من الهيمنة القهرية، وهو التاريخ الذي يمكن فيه فعل كل شيء وأن نستمتع باللذة بكل براءة دائمًا وهو إطار مثال أنه يمكننا أن نرى الحياة العادية مشوهة وغير مكتملة.
والمفارقة المقدرة هنا على نحو غير كافٍ تتمثل في أنه كي تتحرر الذات من السيطرة الخارجية يجب أن تكون خاضعة لسيطرة ذات محرِرة هي فعلًا وأبدًا حرة وواعية ومسيطرة على رغباتها. وتعرف سوزان وولف Suzan Wolf هذه المعضلة الميتافيزيقية وفشل الفلاسفة المحدثين في حلها. فتقدم لنا وولف، وهي في معرض محاولاتها الشغوف لتعريف حرية الذات باعتبارها قدرته على خلق نفسها، بديلًا بالاعتماد على الفهم السليم لفكرة أن نكون عاقلين: فتكتب وولف «إن الرغبة في أن نكون عاقلين ليست إذن رغبة في شكل آخر من السيطرة؛ بل هي الرغبة التي يربطها المرء بالعالم بطريقة محددة وربما نستطيع القول إنها رغبة ذات المرء في أن يكون مسيطرًا عليها من قبل العالم بطرق معينة لا بأخرى»[13]. وتفترض فكرة التعقل مسبقًا معرفة العالم عمليًّا وأن نكون معروفين عمليًّا من قبل العالم، وهو عالم من الاحتماليات المتراكمة لا اليقينيات المستمرة. كما أنه يسمح لنا بالتفكير في الفاعلية الأخلاقية من جانب اشتباك الناس الاعتيادي مع العالم الذين يعيشون فيه؛ بحيث يقع نوع واحد من التعلق الأخلاقي بالضبط عندما لا يكون الألم الذين يعرفون العالم من خلاله فجأة هدفًا للمعرفة العملية.
التفكير في الفاعلية
بافتراضنا أن الفاعلية لا يجب أن تحدد بمفاهيم المقاومة والتمكين الذاتي للفرد، أو بمفاهيم التاريخي الطوباوي، فكيف ينبغي فهمها؟ ربما على المرء أن يبدأ بالنظر في استخدامات المفهوم (أو المفاهميم التي تعتبر معادلة له) في سياقات تاريخية مختلفة. ومن شأن هذا ألا يؤشر فقط إلى أن الفاعلية ليست تصنيفًا طبيعيًّا، ولكن إلى أن الاستخدامات المتتابعة لهذا المفهوم (وقواعدها النحوية المختلفة) قد فتحت وأغلقت العديد من إمكانيات متنوعة للغاية للفعل والوجود. وليس العلماني، بتركيزه على التمكين وصناعة التاريخ، إلا واحدًا من هذه الإمكانيات. ومن غير الممكن لي أن أحاول تأريخ مفهوم الفاعلية هنا، غير أني سأبدأ بتناول تعليقات مختصرة حول الاستعمال المعاصر.
تعمل الفاعلية اليوم بالأساس كي تعرف فعلًا شخصيًّا مكتملًا ضمن شبكة غير محددة من السببية من خلال عزوه إلى مسؤولية فاعل ما أمام السلطة. بشكل نموذجي، يعني هذا إجبار شخص ما على أن يكون محاسبًا، وأن يجيب على القاضي في محكمة قانونية عن الأمور التي وقعت وتلك التي لم تقع. وبهذا المعنى، تقوم الفاعلية على فكرة اللوم والألم. ويصبح عالم من الوقائع الظاهرة إلى عالم من الجواهر بالعزو إلى مسؤولية شخص ما الأخلاقية/ القانونية على قاعدة تحديد الذنب أو البراءة (ومن ثم العقاب أو إطلاق السراح). كيف أصبح هذا النموذج من الفاعلية مثالًا نموذجيًّا؟ وبعد كل ذلك، يقوم البشر ويفكرون ويشعرون بكل أنواع الأشياء المتفرقة فما الذي يجمعهم معًا؟ وعلى الأقل وبالعودة إلى الماضي لجون لوك، فقد كان «الشخص» ينظر له باعتباره مفهومًا قضائيًّا يطلق على مزيج من الذات المفردة مع وعي مستمر في جسد واحد[14]. وقد كان تطور قانون الملكية في ظل الرأسمالية المبكرة مهمًا لهذا التصور. ولكن تساوت في الأهمية أن الطريقة الي تنسب الجوهر إلى الذات الإنسانية قد ساعدتها على أن تصبح موضع الضبط الاجتماعي.
ويميل المحدثون إلى التفكير في المسؤولية عن شيء ما باعتبارها مؤسسة على علاقة بين الفعل والقانون الذي يعرف العقوبة المرتبطة بالقيام به أو عدم القيام به. ويبدو أن ليس للنية علاقة بهذا الأمر (من حيث كونها سببًا ذاتيًّا)، كما هو الحال عندما يحدث أحد الأشخاص ضررًا في ملكية شخص آخر بسبب حادثة ما. ولا يحتاج الفاعلون بالضرورة إلى أن يتوافقوا مع الأجساد البيولوجية الفردية والوعي الذي يقال إنه يسري معهم. إن الشركات خاضعة للقانون ولها من القوة ما تمارس به مهام معينة. غير أن مشروعات الشركة مختلفة عن نوايا الأفراد الذين يعملون لديها ويتصرفون باسمها. ولأن «الشركات لا تموت»[15]، فمن الممكن وصفها كفاعلين دون أن تمتلك كيانًا ذاتيًّا.
وتحمل الفاعلية أيضًا معنى التمثيل. وبهذا المعنى، تعتبر أفعال الفاعل أفعال المبدأ الذي يمثله. لقد كان مفهوم التمثيل، وهو مفهوم محوري لمعنى الفاعلية، موضوع جدل طويل في النظرية السياسية الغربية. هل الممثلون المنخبون هم في النهاية مسؤولون أمام أنفسهم (أي فاعلون باسم حقهم)، أم مسؤولون أمام ناخبيهم (أي وكلائهم)؟ وأمانيّ من يجب تحقيقها في المجلس النيابي؟ لا يبدو أن ثمة إجابة حاسمة. إن فكرة التمثيل المؤسسة للفاعلية متجذرة في مفارقة مفادها أن من أو ما يتم تمثيله غائب وحاضر في الوقت نفسه (معاد تقديمه)[16]. ويعبر التمثيل المسرحي الذي يقوم فيه جسد الممثل بتقديم شخص ما غائب عن نفس المفارقة بطريقة أخرى.
حتى عندما تشير الفاعلية إلى ترك ما كان يجب فعله غير منجز، فإن مسؤولية الأفراد هنا تشير إلى فعل ما في مواجهة عاطفة ما. وهذا هو المنطق وراء المذهب القانوني القائل بأن «جرائم العاطفة» أقل ذنبًا من تلك الجرائم المخطط لها؛ إذ إن قدرة الفاعل فيها على التعقل (وبالتالي، وبالمفهوم الكانطي، القدرة على الحكم الأخلاقي) تتضاءل بسبب تدخل «قوة خارجي». بالضبط مثل أفعال الشخص غير العاقل، لا تعتبر جريمة العاطفة ناتجة عن النوايا الخاصة بالفاعل. أما الآن، بما أن المشاعر يتم التفكير فيها عمومًا وكأنها جزءٌ من التكوين الداخلي للذات، لذا، تعززت الفكرة القائلة بأن الفاعلية تعني امتلاك الفرد الذاتي لمن تؤشر سلطته دائمًا على تهديد محتمل.
وللفاعلية أيضًا سياق مسرحي. وفيها يحاول الممثل المسرحي المحترف أن ينحي ذاته جانبًا وأن يسكن العالم الجسدي للشخصية، أي إيماءاتها وعواطفها ورغباتها. إن فاعلية الممثل لا تتكون خلال حركات الدور الذي يقوم به ولكن في قدرته على سلب القدرة من ذات لأجل ذات أخرى[17]. إن فعل الممثل ليس ملكه وحده. ففي الوقت نفسه، هو ملك المؤلف الدرامي الذي كتب النص والمخرج الذي توسط بين النص والأداء. وينتمي أيضًا إلى تقليد التمثيل التي تعمل فيها الممثل. وفي أحد المعاني الهامة، يعتبر الممثل ذاتًا جزئية؛ أفعاله ليست ملكه كليًّا. ولا يعني أنه ليس مؤلف القصة أنه موضوع سالب.
لقد أوضح إدوارد برنز Edward Burns عند كتابته حول تقاليد التمثيل على نحو شائق أنه في ما كان الممثل المسرحي في العصر الإليزابيثي يسعى إلى أن يكون أداة للنص، وأن يدمج نفسه مباشرة معه عبر تقديم الشخصيات الدرامية بشكل واضح وبنهايات واضحة، فإن الممثل (الحديث) الستانيسلافيسكي على النقيض يبني نصه الخاص أي أن يكون «شخصيته» التي يحاول أن يمثلها من خلال النص. ويذهب برنز أن هناك توترًا بين ذات الممثل وتلك الذات المحورية التي يعرضها، وهو التوتر الذي يخلق الأثر على جمهور الواقعية (أوضاع الذات «الإنسانية» المتوفرة للإشغال التخيلي) وعلى جمهور العمق (المعاني «الإنسانية» الخفية التي يتم الكشف عنها بلا نهاية)[18]. وهناك طريقتان مختلفتان تبين من خلالهما قدرة الممثلين على التنصل أو تفريغ أنفسهم فاعليتهم في علاقتها ببعض تقاليد التمثيل المحددة. ومن بين هذين التقليدين، ليس الثاني «أصدق» أو «أكثر تطورًا» من الأول؛ لكن الحالة أنه في الثقافة الأدبية الخالقة للذوات، يتعامل الناس مع التقليد الثاني على نحو أكثر سهولة ويعتبرونه «أكثر طبيعية».
يدَّعي ناقد عصري لأساليب التمثيل الحديثة (الستراسبرغية وليست الستانيسلافسكية) على نحو شائق أن الانحياز الفردي الشديد في الأسلوب يؤدي إلى تبخيس الحبكة. ويقول: «إن مشاهدة مسرحية في هيئة مجموعة صور مفردة للشخصيات يعني أن الحبكة، الموضوعات، الصور، الأشكال البلاغية، الصيغ المترية، الموضوعات الشعرية، وجميع أشكال المحتوى الفكري، تصبح غير مهمة؛ … وتتحول إلى مجرد أمور ظاهرية. وكما أخبرني عشرات الممثلين والمخرجين على مدار العقود الثلاثة الماضية بصدق: «لا يمكنك تمثيل فكرة»، بل يمكنك فقط تمثيل أشخاص حقيقيين، أحياء، ومستقلين، وهكذا … وليس بُنى أدبية»[19]. أما الافتراض بأن الشخصيات الحقيقية والحية مستقلة عن الحبكات فله عواقب مثيرة للاهتمام. (سأعود إلى تلك النقطة في القسم الأخير)..
قد تُرفض فكرة أن الممثلين المحترفين يسلبون أنفسهم القدرة طوعًا وبشكل مؤقت في سياق العروض المؤطَّرة بينما في «الحياة الحقيقية» يمكننا تمثيل أنفسنا، وهكذا نفعل. ويمكن الرد على ذلك بأن العديد من أنشطة الحياة الاجتماعية، وإن لم تكن كلها، مؤطرة. ويتشابه اهتمام الممثل المحترف بإتقان دور ما على المسرح مع تعليم وتعلم المهارات البلاغية (الخطابة، الإيماء، الأسلوب، والسلوك)[20] من قبل فاعلين في مواضع أخرى، بحيث تكون أفعالهم غير ذاتية كليًا. تضم تلك المواضع، في المجتمع العلماني الحديث، المحاكم والساحات السياسية، حيث يتعين انكار الذات (سواء بصدق أو لا) في المشاهد المرتبطة بتمثيل العملاء أو «القانون»، الدوائر الانتخابية، أو جماعات التأثير وهي مواضع تقوم فيها قوانين الدولة بسلب قدرة المواطن الفاعل وتمكينه على حد سواء. (اقترح النقاد اللذين يستندون إلى الأفكار التحليلية النفسية، عرضًا، أن التمثيل في المجتمع الحديث يمكن أن يحقق الارتياح من الجهد المؤلم الناتج عن محاولات الفرد إلى الارتقاء للصورة المثالية للذات، تحديدًا من خلال سلبها للقدرة)[21]. وتتجلى الملكية الجزئية لتصرفات الفاعل وطبيعة إعادة تعريفها باستمرار، في كل المواقف المماثلة. وتتضح الأفعال، بعكس الحبكة الدرامية، وتصبح عرضة لإعادة التعريف بطرق عادة ما تكون غير متوقعة.
تنطوي الدراما الشعائرية، كآلام المسيح واستشهاد الحسين، على بُعد إضافي، حيث يصور المشاركون فيها الآلام الحتمية للشخصيات الواردة في السرديات المسيحية والإسلامية، ويميزوها، ويخضعون لها. ويسعون جزئيًا من خلال تعريض أنفسهم للعذاب (الإلحاق الذاتي للجروح في بعض الأحيان) إلى منح أنفسهم مركز الفاعل[22].
يعتبر التاريخ الديني حقلًا استطراديًا بحيث تم استهلاك فكرة الفاعلية بغزارة. لذا، ظهر بين الإنجيليين في إنكلترا في القرن الثامن عشر مزيج من الأفكار العلمانية حول الكمال الإنساني وأفكار مسيحية حول عذاب المسيح، واجتمع هذا المزيج في ذات إيجابية وسلبية في نفس الوقت. تقول فيليز ماك Phyllis Mack إن «لاهوت التكفير علَّم النساء والرجال أن يكونوا أطفالًا صغارًا، مستقرين بشكل سلبي في أحضان (أو جراح) المسيح، بينما دفعهم لاهوت الكمال الكوني إلى فهم أكثر حسمًا للاستقلال الشخصي أو السيادة الذاتية، وجعل هذا الفهم بدوره نظرتهم لأنفسهم بأنهم خاضعون إلى اﷲ أكثر صعوبة. ومن هنا، أصبح للوصول الميثودي (المناهجي) للتحكم في الذات كعادات التنظيم، الانضباط، والتبصُّر الذي ساعدهم على التحكم في العذاب قادرًا على تهديد صلب إيمانهم وثقتهم في قدرة التكفير على محو الخطايا وقهر الموت. قامت الفاعلية بزيادة الرغبة في تجاوز الذات، وجعلت بلوغ هذا التجاوز أكثر صعوبة. ولم تكن المشكلة، بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء، في العثور على سلطة للتحدث والتصرف، بل في تذكر أن تلك السلطة لم تنتمي إليهم»[23].تؤمن ماك بأنه مع عدم استقرار التوتر، أصبح الانتصار الجلي للنشاط الإصلاحي على السلبية ومن ثم نظرة أكثر علمانية ودنيوية حتميًا. ولكن هذا الانحراف العَرَضي لم يجعل احتمالية «الاستسلام للمسيح» متعذرة، كما تُظهر حياة العديد من المسيحيين.
إذًا، فإن «الفاعلية» مصطلح معقد ينبع إدراكه من الشبكات الدلالية والمؤسسية التي تحدد وتتيح طرقًا معينة للشعور بالأشخاص، الأشياء، والنفس. ومع ذلك، فإن «النية»، التي يتم صقلها بطرق متنوعة في شكل مصطلحات مثل «الخطة»، «الوعي»، «العمدية»، «التوجه»، أو «الرغبة» (لا تقوم الأضداد اللغوية لتلك المصطلحات بنفس الوظيفة النحوية: أي أن تكون بلا رغبة لا يشبه أن تكون بلا خطة أو أن تكون في حالة لا وعي)، عادة ما تصبح مركزية في إسناد الفاعلية. ويصبح «التمكين»، وهو مصطلح قانوني يرمز إلى كل من فعل إعطاء القدرة لشخص ما وإلى قدرة الشخص على القيام بالفعل، ميزة ميتافيزيقية تحدد الفاعلية الإنسانية العلمانية، أهدافها، وشروطها المسبقة. وبالرغم من أن الاستخدامات المختلفة للفاعلية لها تبعات مختلفة غير مترابطة، فإن النظرية الثقافية تميل إلى اختزالها في الفكرة الميتافيزيقية لفاعل واعٍ لديه القدرة والرغبة في اتباع طريق تاريخي واحد: وهو زيادة تمكين الذات وتقليل الألم.
التفكير في الألم
يتبنى الكثيرون (ومنهم علماء أنثروبولوجيا) وجهة نظر علمانية تدعو المرء إلى أن يقبل بوجود خيارين متنافيين فقط في التحليل النهائي: إما وجود فاعل (يمثل نفسه/نفسها ويؤكد عليها) أو ضحية (الغاية السلبية للصدفة أو القسوة).
عندما نقول إن شخصًا ما يعاني، فإننا نفترض عادة أنه (أنها) ليس فاعلًا، كما نعتقد أن المعاناة (الألم الجسدي أو العقلي، الإذلال، والحرمان) هي حالة سلبية بحيث يكون المرء مفعولًا به وليس فاعلًا. نقر بسهولة بأن الألم قد يكون سببًا للقيام بفعل ما (السعي لإنهاء العذاب، مثلًا)، ولكننا عادة لا نفكر فيه بأنه فعل في حد ذاته. الألم هو شيء ما يحدث للجسم أو يصيب العقل. أو هكذا نفكر، على أي حال. ومع ذلك، يمكن أن ندرك الألم بأنه ليس مجرد حالة سلبية (رغم أنه قد يكون كذلك) ولكن في أنه فاعلي بحد ذاته.
إن الألم الجسدي هو بالطبع موضوع خاص بالعاطفة، والفعل أيضًا. نجد في رواية «Monsieur Teste» لبول فاليري Paul Valery مثالًا مميزًا على محاولات الذات المريضة التحكم في ألمها الجسدي عقليًا. وينطوي ذلك على استخدام الاستعارات. وتعد أكثر تلك الاستعارات استخدامًا التصوير القاتم للألم على أنه كائن غريب ومُعادٍ داخل الجسم. يشير جان ستاروبينسكي Jean Starobinski إلى فكرة تطويع فاليري الموسيقي، حيث يكتب: «ينتج الألم عن مقاومة الوعي للنظام الداخلي للجسم»، ويمكننا أن ندرك هذا الألم ونحيط به إلى حد ما، بحيث يصبح شعور دون معاناة وربما ننجح بتلك الطريقة في معرفة شيئًا عن جسدنا الأعمق بشكل مباشر وهي معرفة مشابهة لتلك التي نجدها في الموسيقى. الألم هو شيء موسيقي جدًا، بحيث يمكن وصفه في إطار موسيقي إلى حد كبير. فهناك آلام عميقة وعالية النغمة، وبطيئة بنشاط، صاخبة، مطولة، متوقفة، أصوات تتابعيّة، ومتواليات صمت مفاجئ، وهكذا …». يلاحظ ستاروبينسكي أن المجاز الموسيقي المستخدم هنا يتصل بخطة للتحكم، لأن «كل استعارة توحي بتفسير، وكل تفسير ينطوي على مسافة بين قوة تفسيرية ومفعول به يتم تفسيره حتى وإن كان المفعول به هو حدث يقع داخل «جسدي». … بالنسبة لفاليري، «الألم ليس له معنى» وكذا طبيعته التأويلية للأبد»[24].
أقدم بإيجاز استنتاجًا مختلفًا قليلًا. فقد يكون استخدام الاستعارات الموسيقية (أو الموسيقى نفسها) لعلاج آلام الجسد بهدف إضفاء معنى للتجربة القاسية بل لتنظيم التجربة نفسها. عرفت شخصية تستخدم الأرقام للتنبؤ بتجربة الألم وتصنيفها. وبينما أعطت للآلام الحادة أرقامًا أعلى، كان هناك تنظيم آخر أقل وضوحًا؛ حيث أعطت الآلام الحادة ومتعذرة الحل فقط أعدادًا أولية. علاوة على ذلك، اختلف الترقيم وفقًا السياق الاجتماعي الذي مرت فيه بتجربة الألم: حيث زادت احتمالية الأعداد الأولية إذا كانت وحدها. لا يضفي هذا التنظيم «معنى» للألم بالضرورة؛ ولكنه يعتبر مجرد طريقة للتفاعل معه. لذا فإن الاستنتاج الذي أقترحه يتعارض مع موقف إلين سكاري Elaine Ccarry في دراستها المؤثرة «الجسد المتـألم»، حيث ترى أن «القسوة المطلقة للألم في حد ذاتها» تنعكس عالميًا في حقيقة أن «مقاومته للغة ليس مجرد نتيجة لصفاته العرضية لكنها ضرورية لماهيته»[25]. وبالرغم من أن كلًّّا من التنظيم الموسيقي والحسابي (يجب معرفة كلاهما) قد لا يشكل «اللغة» بالمعنى العادي، لكنهما يثيران إشكاليه حول فكرة أن الألم في حد ذاته حدث ذاتي مدمر للأفكار بالضرورة.
تؤكد سكاري أن الألم هو تجربة ذاتية بالضرورة، وتقترح أن تجربة «الألم الجسدي للمرء» تمثل نموذج اليقين، بينما يمثل السماع عن «الألم الجسدي لشخص آخر» نموذج الشك حيث لا يمكن أبدًا التأكد منه كليًا»[26]. أقترح أن هذا الفهم العلماني للألم غامض قد ينبع جزئيًا من تجربة الاختبار ات التي تجرى على الحيوانات كتلك التي ناقشتها في الفصل السابق، إذ إن ردود الأفعال الملاحظة للجسد الخاضع للتجربة تمثل «الألم». السؤال الذي يجدر التفكير فيه هنا هو عما إذا كان هذا الادعاء حقيقيًا أم لا، وإذا كان كذلك، لم يجب أن ينطبق على الألم فقط[27].
يعتمد تيقن المرء من ألم الآخر أو عدمه بالطبع على من يقوم بالتعبير عن هذا الألم، ولمن، وكيف يعبر عنه لفظيًا، على سبيل المثال، أو من خلال التألم، أو إشارات الوجه، أو بطريقة الكشف عن جسد متألم أو ضعيف ولأي غرض يتم السعي إلى الوصول لهذا اليقين. قد يكبت المرء أو يخفي تلك العلامات (وبالطبع يمكن اعتبار الصمت غير المعتاد ذا أهمية)، ولكن الفكرة هنا هي أن الألم ليس تجربة خاصة فحسب بل علاقة عامة كما أشار فتغنشتاين Wittgenstein منذ عهد بعيد[28]. إذا كان الشك في ألم الآخر غير قابل للفصل دائمًا، كما تدعي سكاري[29]، يصبح من الصعب فهم فكرة الإلحاق المتكرر للقسوة على ضحايا التعذيب إلا إذا تم اعتبار الإلحاق المتكرر للقسوة هوس إبستمولوجي. يبدو لي أن تصريح سكاري أن «الألم المُجسَّد {للضحية} لا يعتبر في نظر القائمين بالتعذيب ألمًا بل تجرى قراءته على أنه قوة» تصريح غريب، لأن هذا الإنكار لآلام الضحية يوحي بنوع من اليقين لدى القائم بالتعذيب، بالرغم من أن ادعاء سكاري الرئيسي هو أنه يجب على المرء أن يكون متشككًا دائمًا في ألم الآخر. (لماذا يتم اختيار الألم المُلحق كالوسيط المستخدم في وصف وقراءة القوة إذا كان تأثيره مثيرًا للشك بهذا الشكل؟).
بالطبع، قد يحدث الخطأ، وبالتالي الشك، وذلك ليس في سياق التعبير عن الألم فقط بل التعبير عن أي مشاعر. (كما قال كولينغوود Collingwood ذات مرة، لا يمكن أن أكون مخطئًا إذا شعرت بشيء ما رغم أنني من الممكن أن أكون مخطئًا، أو كاذبًا ببساطة، عندما أقول إنني أشعر به[30]). ولكن، مخاطبة ألم الآخر ليست مجرد مسألة حكم على التصريحات المرجعية، بل تدور حول كيفية إقامة وإجازة نوع محدد من العلاقة[31].
تعاني الشخصية الفاعلة نتيجة ألم شخص تحبه، كالأم التي تتعامل مع طفلها المصاب على سبيل المثال. تلك المعاناة هي حالة ناتجة عن علاقتها، تتضمن قدرتها على الاستجابة لألم صاحب المعاناة الأصلي بتعاطف. الشخصية التي تعاني بسبب ألم الآخر لا تقوم في البدء بتقييم الدليل المقدم إليها ثم تقرر ما إذا كانت، وكيف ستستجيب. تلك الشخصية تعيش علاقة، بحيث تصنع آلام الآخر المعبر عنها من خلال عبارات الألم، الصيحات، الإيماءات، الصمت غير الاعتيادي، (أي بلاغة ملحوظة، باختصار) فرقًا لديها، ويصبح السبب النشط لتعاطفها وتواصلها مع آلام الآخر. وهي حالة عملية تعكس ماهيتها، وماهية طفلها الذي يعاني. (ينطبق ذلك بالطبع أيضًا على أوقات البهجة التي يشاركونها). تقف الأم في تلك الحالة فقط كفاعل فردي بمسؤولية تجاه طفلها بغض النظر عن مشاعرها الفعلية.
لا يعني ذلك أن الألم الذاتي لا يمكن أبدًا نقله بشكل مقنع للآخرين، ولكن عندما يشعر المرء بالحاجة الملحة لتوصيل ألمه، ويفشل في هذا التواصل، إذًا فقد يعتقد، بمعاناة متزايدة، أن ألمه لا تمكن مشاركته.
تقول سوزان برسون Susan Brison في نقاشها حول ضحايا الاغتصاب والتعذيب إنه «من أجل بناء روايات ذاتية، لا نحتاج فقط إلى الكلمات التي تحكي قصتنا بل أيضًا مستمعين قادرين وراغبين في سماعنا وفهم الكلمات التي نوجهها إليهم. يسلط هذا الجانب من إعادة إحياء الذات في أعقاب الصدمة الضوء على اعتماد الذات على الآخرين، ويساعد على فهم سبب صعوبة تعافي الناجين عندما يكون الآخرون غير راغبين (غير قادرين) في الاستماع لما تحملونه[32]». تعتمد القدرة على العيش بعقل بعد تجربة صادمة من الألم دائمًا على استجابة الآخرين. قد يغامر المرء بالقول إن الألم ليس واقعًا غاشمًا يقوض الفكر ولا هو تفسير ناتج عن استرسال أيديولوجي أو علمي، لكن يمكن أن تكون علاقة نشطة وعملية تسكن الزمن. ولكن ينطبق ذلك بالطبع، وقد تتم معارضة ذلك ــ على «المعاناة النفسية» وليس الألم الجسدي فقط.
إلى أي مدى يعتبر التمييز بين الألم الجسدي والمعاناة النفسية (الاجتماعية) واضحًا؟ تنطوي كل مشاعر الألم الجسدي على تغيرات لا تحدث داخل الجسد فقط (عضلية، بيوكيميائية) ولكنها أيضًا ظاهرة خارجيًا (الصوت، السلوك، طريقة المشي)، ومفهومة ثقافيًا. تُعَقِد تلك الحقيقة وحدها التمييز المنظم بين الألم الجسدي والألم النفسي. تتصل مشاعر الكآبة أيضًا بالاضطرابات الكيميائية في الجسم، والاختلالات الكيميائية تلك سواء كانت مرتبطة بصدمة أو نمو خلايا خبيثة هي «جسدية» تمامًا كالأربطة الممزقة. وقد يحدد المصاب الألم الجسدي في أجزاء معينة من جسده/جسدها، وهذا هو ما يفرقه عن الألم النفسي. ولكن الحالات النفسية هي نفسها مرتبطة عن قرب بالظروف الاجتماعية ذات الأهمية في تجربة الألم الجسدي.
لطالما عُرف أن تحمل الألم الجسدي هو أمر متغير ثقافيًا (أعود إلى تلك النقطة في الفصل المقبل). وتشير أحدث أبحاث فسيولوجيا الألم إلى خلاصة أكثر تطرفًا: وهي أن الإصابة الجسدية في جزء معين من الجسم ليست ضرورية لتنشيط نظام ألم الجسم. الظاهرة الشهيرة لألم وهم الأطراف ليست شذوذًا غريبًا، كما يبدو الآن. يقول الباحثون إن الألم لا يتم اختباره في العقل فقط، لكنة ينتج عن العقل أيضًا[33]. والمخ هو موضع التفاعلات المعقدة بما في ذلك التفاعلات بين الذكريات، التصورات، ومشاعر الكآبة، والتي تنتج عنها تجربة الألم وسلوكه. إن التمييز المألوف بين الألم الجسدي كشيء يحدث عادة في جزء محدد من الجسم، والمعاناة النفسية كتجربة لا يمكن تحديد موقعها بدنيًا، ليس بهذا الوضوح، خاصة عندما نتذكر أنه في العديد من الثقافات يتم اختبار المشاعر الكئيبة بأنها موجودة في أجزاء معينة من الجسم (الكبد، البطن، القلب، وهكذا)[34]. وحتى في المجتمع الحديث، يدرك الناس أنهم قد يكونون «مرضى بالغضب» و«متوهجين بالخجل»، وأن تلك التجارب المزعجة متمركزة بدنيًا وراسخة اجتماعيًا.
إذا كان البحث يشير الآن إلى أن المخ هو مصدر وليس منتهى أحاسيس الألم، فيمكن أن يُنظر للشعور بالألم بأنه أفعال متمركزة في سياقات ثقافية وفسيولوجية عصبية. وفي سياق مهم، فإن «الثقافي» و«البدني» ليسا منفصلين، بالرغم من إمكانية تمييزهم من أجل أغراض تحليلية. ما تعتبره الذات مؤلمًا، وكيف تختبره، لا يتم بوساطة ثقافية وبدنية ببساطة، بل هم في حد ذاتهم أنماط من عيش علاقة. وتحول القدرة على عيش تلك العلاقات الألم مع الوقت من تجربة سلبية إلى نشطة، وبالتالي تحدد أحد طرق الحياة في هذا العالم بتعقل. ولا يعني ذلك، بالطبع، أن المرء لا يمكنه أو لا يجب عليه السعي لإصلاح العلاقات الاجتماعية التي يسكنها، فضلًا عن اعتبار الألم «شيئًا قيمًا» بشكل مثير للاهتمام. الفكرة التي أود بلوغها هنا هي أن المرء يمكنه أن يختبر ألمه بعقل أو بدونه (بالرغم من أن الأفكار الخاصة بالجنون تتغير) وأن النموذج التقدمي للفاعلية يصرف الانتباه عن محاولاتنا لفهم كيفية حدوث ذلك في تقاليد مختلفة، نتيجة الافتراض بأن الفاعل يسعى دومًا لتخطي الألم المدرك كمفعول به وحالة من السلبية. يُصَعِب التشديد العلماني بأن جسم الإنسان التكاملي مركز السيادة الأخلاقية من قبول فكرة الألم كعلاقة متخيلة بحيث تتوسط الحالات الداخلية كالذاكرة والأمل السلوك الاجتماعي.
لا أدّعي أن الألم الجسدي الذي يشعر به الشخص المصاب يمكن أن يختبره المُراقب بنفس الشكل. هناك دومًا مغالاة غير قابلة للإنتاج في الألم. وأجادل بأن هذا ليس كل ما ينطوي عليه الألم. المصابون هم أيضًا شخصيات (حيوانات) اجتماعية ومعاناتهم تتكون جزئيًا من كيفية سكن علاقاتهم مع الآخرين، أو كيف يتقيدون بها. ليس الألم دومًا عذابًا لا يحتمل أو حالة مزمنة. فهناك تنوعات في التجارب غير قابلة للقياس التي نجمعها معًا تحت شعار «الألم» أو «المعاناة» كأنها مثل الفاعلية، شيء مفرد، وتبرير مطلق للواقع الجسدي. ولكن الألم كعلاقة اجتماعية هو أكثر من مجرد تجربة، فهو جزء مما يخلق حالات الفعل والتجربة، كما سأحاول الآن أن أوضح من خلال بعض الأمثلة حول الألم من التاريخ الديني والإثنوغرافيا.
التفكير في الألم الفاعل في التاريخ الديني والإثنوغرافيا
يمكن لهؤلاء الواقع عليهم الألم المتعمد كعقاب أن يتقبلوا هذا الألم بحماس ويحولوه إلى شيء آخر غير ذلك المقصود. تعد السادية (التي أناقشها في الفصل المقبل) مثالًا واحدًا على ذلك، بالرغم من أنني سأجادل بأنه لا يجب تعريفها بأنها مجرد نسخة علمانية من الظاهرة التي نألفها من حقل الدين، وبالتالي تعريفها بأنها باثولوجيا كامنة في ممارسات دينية محددة. إن وجود كلمة «ألم» لا يجب أن يؤخذ على أنه دليل على أنها تشير إلى مفهوم واحد.
ساعدنا مؤرخو أواخر العصور القديمة على أن نألف حقيقة أن السيادة في الإمبراطورية الرومانية تحققت بدرجة كبيرة من خلال الإظهار الجماهيري لقوة الإمبراطور وكرمه. كان التعذيب المسرحي عقابًا على بعض الأشكال الإجرامية جزءًا أساسيًا من إظهار تلك القوة. وكان الشهداء المسيحيون الأوائل من أشهر هؤلاء الذين تعرضوا للتعذيب. تشير جوديث بيركينز Judith Perkins في كتابها «الذات المُعَذَبة» The Suffering Self إلى أن سير الشهداء المسيحية المبكرة «ترفض تفسير الأجساد المحطمة للشهداء على أنها هزيمة، لكنها تعكس تلك التفسيرات، وتشدد على أنها رموز الانتصار على قوة المجتمع»[35]. وقد سعى الشهداء إلى عيش المعاناة الجسدية بفاعلية بعيدًا، لا تجنبها، مثل آلام المسيح على الصليب، حيث اعتُبرت سلبية الشهيد فعلًا انتصاريًا. كان هذا الانفتاح على الألم تحديدًا جزءًا من بناء فاعليتهم كمسيحيين، وهو ما يجعل وصفه بأنه «رمز للانتصار على قوة المجتمع» (وهو دافع علماني) غير صائب، بل كان القدرة على التمكين من خلال تحمل ما اعتُقد أن المسيح عاناه على الصليب.
ولكنني لا أود أن أركز هنا على الأهمية الرمزية للاستشهاد، بل فاعليتها في خلق مساحات جديدة للفعل العلماني. بالنسبة لبيركينز، فإن البحث عن معاني الاستشهاد يقود إلى تفسيرات متعلقة بالوعي الزائف، وهذا هو ما أود أن أتجنبه.
اعتاد المجتمع المسيحي في أواخر العصور القديمة (بعكس العالم القديم) المرض والمعاناة الإنسانية بفاعلية. فقد أصر المسيحيون، في حالة عدم إمكانية علاج المرض، أنه يمكن تفسير الألم بأنه شيء قيم. واختلف ذلك عن تقليدين كانا متزامنين بشكل أو بآخر مع الاضطهادات المبكرة للمسيحية الواردة في سير الاستشهاد؛ وهما: الفلسفة الرواقية الأخلاقية (التي تؤكد على السيادة الذاتية، وتنكر العوامل الخارجية كالمعاناة)،والطِّبُّ الجالينوسِيّ (الذي اعتبر الألم حالة جسدية قابلة للحضوع لتدخل تقني مناسب).
تجادل بيركينز بأن الرواقية كانت ايديولوجية سائدة: «استطاع تأكيد ابكتيتوس على الأمور الداخلية، السيادة الذاتية، وتشكيل الذات، وأيضًا إنكاره أهمية الأمور الخارجية (كالمعاناة)، أن يصرف انتباه طلابه وآخرين مثلهم عن الاهتمام بالأحوال الاجتماعية والمادية. وقد دعمت تعاليمه الوضع الراهن، وبالتالي ترسيخ موقف النخب. تماشى إصرار الرواقية على عدم أهمية الفقر والمركز الاجتماعي مع خطة النخب أكثر من خطة هؤلاء الذين لا يتمتعون بأي امتيازات: وقد شددت الخطة المقابلة على أن ما يهم في الحقيقة هو كيفية التعامل مع كون المرء فقيرًا، سجينًا، أو غير محبوب سياسيًا. يتصل هذا المذهب وتأكيده على التحكم النابع من الذات الداخلية، بالكيان الاجتماعي، حيث يعمل على تحجيم الاضطرابات الاجتماعية والشخصية»[36]. ولكن، يبدو لي أن هذا اللجوء إلى فكرة الوعي الزائف لشرح الهيمنة السياسية ضعيف. في بادئ الأمر، كانت الرواقية مذهبًا أخلاقيًا يستهدف النخب وليس الجماهير. وهكذا، شجعت على التراجع عن فساد الحياة العامة والزهد في الأحوال الاجتماعية والمادية. إذًا يمكننا أن نسأل عما إذا كانت الرواقية أيديولوجي مناسبة للانخراط النشط في الحكم الإمبراطوري. تتغاضى بيركينز عن حقيقة أنه بالرغم من القبول المتشائم للمعاناة بأنها جزء لا يمكن استئصاله من الحياة والتوصية بالتكيف معه عوضًا عن السعي إلى تغيير تلك الحياة قد يكون مخطئًا، فهو ليس في حد ذاته إنكارًا بأن الحياة غير عادلة في النهاية. على العكس، فقد قدمت الرواقية تعويضات نفسية تحديدًا لأن العالم يُنظر إليه على أنه غير عادل ومليء بالمصائب.
يعدّ حديث بيركينز عن الطب القديم أكثر إثارة للاهتمام، وتقول إن المسيحيين الأوائل تبنوا فهم جَالِينُوس للجسد المريض في علاجهم المميز للألم. لذا، وفي تطور متناقض، فإن التقبل المسيحي للمعاناة قاد إلى اهتمام أكبر بالمرضى، الفقراء، وأعضاء المجتمع المزدرين، وبالتالي نوع جديد من الفعل العلماني الموجه إليهم. إذا كانت بيركينز محقة، فإننا لا نجد هنا معنى جديدًا للألم فقط، بل أيضًا هيئة جديدة للفعل. كان تعرض المسيحيين الذاتي للألم (على الأقل في سير الشهداء التي تشير إليها بيركينز) في حد ذاته شكلًا من أشكال الفاعلية، ليس من أجل نواياهم الفاعلة (أيًا كانت)، ولا بسبب الأهمية الرمزية للمعاناة («نص يجدر قراءته»)[37]، بل كان شكلًا من أشكال الفاعلية، لأن معاناتهم العامة أحدثت فرقًا في هذا التقليد الناشئ، ليس لذواتهم فقط (وأفعالهم الذاتية المحتملة) كتابعين للدين الجديد، بل أيضًا للعالم الذي يعيشون فيه: وتطلب ذلك التفاعل مع ألم المرء والآخرين بشكل مختلف.
يمكن تفسير التمييز بين البحث عن المعنى الدلالي للألم (كأيديولوجية) ووظيفته الفاعلة، بشكل أكبر، بالرجوع إلى إثنوغرافيا الألم أثناء الولادة بين نساء أميركا الشمالية المتدينات الذي نشرته عالمة الأنثروبولوجيا باميلا كلاسين Pamela Klassen. تخبرنا كلاسين أن العديد من النساء محل الدراسة اعتبرن الولادة بدون أدوية فعلًا تمكينيًا، لأنه كما تقول إحداهن «أمر لا يمكن للرجل فعله أبدًا». تعي كلاسين أن مزاعم القوة تلك يمكن أن يتم انتقادها لأنها تقدم فئة مختزلة من النساء، فليس كل النساء يلدن. وهي ترى، على الرغم من ذلك، أنه يمكن أن تساعد تلك المزاعم على هدم الصورة الجندرية للقوة الذكورية والضعف الأنثوي.
تقول كلاسين «ربما في أميركا في أواخر القرن العشرين حيث تم تعليم النساء بأن يكونوا ملاحظات ونقاد لأجسادهن من الخارج، كان يُنظر لألم الولادة على أنه يعيد النساء إلى أجسادهن. وفي هذا السياق المحدد، فإن قوة الثقافة المضادة للألم لها بُعد تمكيني وخَلاصي بالنسبة للبعض. بالتوافق مع كارولين والكر بينوم Caroline Walker Bynum، أؤكد بحذر على أن «ثقافتنا قد تحتاج أخيرًا إلى شيء من العصور الوسطى، والذي ينعكس بوضوح في استخدام الولادة والإرضاع كرموز للخلاص، فالتوالد والمعاناة قد يكونان مترادفين». وتسعى العديد من النساء اللاتي يلدن بالمنزل إلى تقبل هذا الاقتران»[38].
لكنني لا أود أن أشير إلى ألم الولادة بأنه تجربة ذات معنى، ولا صورة هادمة للتكبر الذكوري (للأسف لم تكن تلك الفكرة فعالة تاريخيًا). قد يُنظر للألم بشكل مباشر على أنه عامل تأسيسي في الولادة. ولا أقصد أنه يجب قبول الولادة على أنها أساس أخلاقي بالادعاء الأنثوي بالتمكين، فضلًا عن اعتبار قدرة المرأة على مواجهة الألم بشجاعة فضيلة. ولكن الحقيقة هي أن نساء محددات في أماكن محددة وأوقات محددة يختبرن الألم أثناء الولادة ما يخلق موقفًا جديدًا للأم نفسها وللآخرين. بالنسبة لهؤلاء القادرين على اختبار ذلك، فإن القوة التي يستلزمها إحضار حياة أخرى إلى هذا العالم وبالتالي علاقات أخرى في إطار الألم لا يعتبر أقل فاعلية فقط لأنه محدد ولا إرادي (لا أشير بالطبع إلى قرار الإنجاب لكن عملية الحمل والولادة).
تعتبر الأمومة ممكنة بالطبع في حالة منع أو تخفيف الألم الجسدي باستخدام المسكنات. فلا أود أن يُقال إنني أعتبر أن الولادة المؤلمة قيمة جوهريًا (بالرغم من أن النساء المؤمنات بدراسة كلاسين يفضلن الولادة في المنزل بين أفراد العائلة وبدون وجود أطباء). النقطة التي أقصدها هي أنه عندما يكون الألم جزءًا تأسيسيًا للولادة فهو ليس مجرد تجربة سلبية للمريض، كما يميل الطب الحيوي إلى وصفها، بل جانب من فعل اجتماعي مميز بحيث يقدم فيه الآخرون المساعدة. وأود أن أوضح أنه في الحالات التي تصفها كلاسين، الألم ليس حالة للجسد الفردي يمكن فصلها وأخيرًا القضاء عليها بتدخل كيميائي أو جراح، لكنه جزء من فعل ينتج عنه تكاثر وتعزيز العلاقات الإنسانية. ويعتمد الشعور بالألم إلى حد ما على كيفية التعبير عنه، وهو ما يعتمد بدوره على العلاقات الاجتماعية.
ليس المعنى الرمزي المرتبط بالأمومة (أو الألم) هو الذي يهمني هنا أكثر من الإدراك الذاتي للأفراد بأنهم أمهات. أعتقد أن ما يهم هو ما يجعل المرأة «أم» في إطار المناهج العملية المستخدمة في تقاليد مختلفة. إن فعل الولادة لا ينتج عنه شخص حي فقط بل يخلق علاقة حيوية مشبعة بإدراك الألم وهي العلاقة التي تربط الأم والطفل بحيوية معًا. تعتبر الأم فاعلًا نتيجة ما قامت به في موقف اجتماعي محدد بعد الحدث، كما كان وليس لنيتها الواعية. (الرغبة في أن تنجب طفلًا ليست خاصة بالأم فقط، فهناك أقارب آخرون مشاركون في ذلك).
إن ميلنا للتفكير في أن الولادة عملية سلبية لأنها لا إرادية ولا يمكن التحكم فيها هو أمر متجذر بعمق. تلاحظ سوزان بريسون أنه حتى سيمون دي بوفوار Simone de Beauvoir «ترى أن الولادة والإرضاع عمليات سلبية وبالتالي فهي عمليات مهينة بحيث تجعل المرأة غارقة في الاستقرار»[39]. يرفض هذا الفكر، بمنظوره الفائق والمتعمد، فكرة أن الولادة لها أي ارتباط بالفاعلية، أو الفعل. وتميل الإشارات إلى ألم الولادة للتأكيد على تلك السلبية.
أناقش مثالًا أخيرًا على دور الألم في تكوين الفعل هذه المرة من التقليد الإسلامي، ومنظورات تم وصفها بالارتباط بحركات التقوى في القاهرة المعاصرة، وذلك في دراستين إثنوغرافيتين لصبا محمود Saba Mahmood وتشارلز هيرشكايند Charles Hirschkind [40]. تهتم الدراستان بسنة تقوم على فكرة الروح، وهي على الأقل قديمة كأرسطو وتم استيعابها في اليهودية، والمسيحية، والإسلام. لا تتطلب منا هذه السنة الانتباه لفكرة التجسيد فقط (أن الفعل والتجربة الإنسانية موجودان في جسد مادي) بل أيضًا فكرة «نفخ الروح» أي أن جسد الإنسان الحي هو مجموع متكامل له قدرات تطورية على الفعل والتجربة خاصة به، أي قدرات الإدراك، التخيل، والعمل، المتوسطة ثقافيًا.
بالرغم من أن الجسد الحي هو موضع الإحساس (وهو سلبي من هذا المنطلق)، فإن قدرته على المعاناة والاستجابة بشكل عقلاني وعاطفي للمسببات الخارجية والداخلية، واستخدام ألمه بطرق مميزة في علاقات اجتماعية محددة، تجعله إيجابيًا. لذا فإن العديد من التقاليد تعزو لجسد الإنسان الحي القدرة على التشكيل (قوة تشكيل نفسه) سواء في الصحة أو المرض.
وتعتبر مادية الجسم الحي، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، وسيلة ضرورية لغرس ما تعرّفه تلك التقاليد بأنه سلوك فاضل وتثبيط ما يعتبرونه رذيلة. ويعدّ دور الخوف والأمل، الغبطة والألم، محوريًا في تلك الممارسات. وفقًا لوجهة النظر تلك حول الجسم الحي، كلما مارس المرء فضيلة أصبحت أسهل بالنسبة له. من ناحية أخرى، كلما استسلم المرء للرذيلة زادت صعوبة التصرف بشكل مستقيم. ويعدّ ذلك تحديدًا ما يدفع العديد من المسلمين لتفسير التصريح القرآني المتكرر بأن اﷲ يختم على قلوب الآثمين العنيدين. إن العقاب على الإثم المتكرر هو أن يصبح المرء: غير قادر على تمييز الخطاب الصائب من الخاطئ، الخطاب الإلهي من الإنساني، أي أن الشخص لا يمكنه عيش حيلة الفضيلة التي يتطلبها اﷲ منه/منها، ولا يمكن العودة بالزمن هنا.
تعتبر العمدية الواعية ذات أهمية هنا، حيث تسود قلة التجربة أو الرذيلة، لأنه يجب في تلك الحالات مواجهة القصور في المقاومة الذاتية للجسد وضعفه عمدًا من خلال ممارسات مسؤولة. ويجب ملاحظة أنني أتحدث هنا عن تشكيل الفضائل والإحساس. وتتطلب طقوس العبادات، والتي تعد ممارستها المنتظمة في الحقيقة ضرورية لغرس الفضائل والإحساس المطلوب للمسلم دائمًا، النطق الصامت للنية في إقامة الصلاة، وهكذا، في بداية أي الطقس. تعد النية إذًا جزءًا من الطقس، ونوعًا من الالتزام الواعي الذي يسكن أفعال العبادة، والتي يجب أن تكون مغروسة كجانب من إيمان المرء المستمر. الإيمان ليس وسيلة إبستمولوجية مفردة تضمن وجود اﷲ للمؤمن، ولكنه يترجم بشكل أفضل على أنه فضيلة الولاء إلى اﷲ، وطاعة لا جدال فيها، يتطلبها اﷲ من هؤلاء المؤمنين به، ونزعة يجب غرسها كغيرها، بحيث تربط المرء بالمؤمنين الآخرين من خلال الثقة والمسؤولية المشتركة.
تقدم كل من محمود وهيرشكايند أوصافًا لممارسات موجهة لغرس السلوك الإسلامي، بحيث يُنظر للمشاعر المؤلمة، الخوف والندم على سبيل المثال، بأنها مركزية في ممارسة التمييز الأخلاقي. بطرق أخرى، تكشف تقاريرها أن التقوى لا تعتبر مجرد حافز للفعل بل هي تكاملية مع الفعل نفسه. إن تحمل الألم، بعيدًا عن كون ضروريًا لتطوير التمييز الأخلاقي، يتم اعتباره وسيلة ضرورية لغرس فضيلة الصبر التي تعتبر أساسية في كل عمليات اكتساب الفضائل.
لا يتم الاحتفاء بالألم الجسدي والضرر الملحق بالجسم في التقاليد السنية المركزية للإسلام كما هو الحال على سبيل المثال عند شهداء المسيحية الأوائل ولا يقوم الألم بنفس الدور في إطاره الديني. ولكن تعتبر أشكال المعاناة بالرغم من ذلك جوهرية في نوع الفاعل الذي يطمح المسلم الورع أن يصبح عليه. الأهم في ذلك هو التجربة الكونية لتجربة الوفاة والموت. فعندما «يحين الوقت»، فإن المسلم الورع يُتطلب منه التسليم. يقوم الأحياء بمشاركة معاناتهم الناتجة عن فقدان أحبابهم من خلال ممارسات موصوفة في الدفن والعزاء (بالرغم من أن التنظيم الكامل لممارسات الدفن يجعل الوصول لخاتمة أصعب على النساء في حالة الحداد أكثر من الرجال). ويسعى المسلم الورع إلى غرس الفضيلة وإنكار الرذيلة من خلال وعيه الدائم بفنائه/ها في الدنيا، وذلك في محاولة لتحقيق حالة الاتزان التي يطلق عليها القرآن «النفس المطمئنة»).
تعتبر العقوبات، سواء كانت ناتجة عن قصور من داخل وظائف الجسم الحي أو مفروضة على الجسم كعقاب خارجي، جزءًا ضروريًا من تعلم كيفية التصرف بشكل لائق. تتم هذه العملية التأسيسية في السنة الإسلامية للتأديب المشترك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[41]. يتم التعبير عن اكتساب الفرد للفاعلية السليمة وممارستها بالمسؤولية، وهي ليست مجرد مسؤولية الفاعل بل مجتمع المسلمين بأكمله على نحو فردي وجمعي. إذا تم تعريف السلوك الديني في إطار المسؤولية، إذًا فإننا لدينا هنا حالة من السلوك التي تكتسب معناها ليس من اللاهوت التاريخي بل لاهوت كتابة السير، بحيث يسعى الفرد إلى اكتساب قدرات وأحاسيس مرتبطة بالسنة الدينية، وموجهة من قبل الإيمان بالآخرة بحيث سيقف/تقف الشخص وحيدًا يوم الحساب للمحاسبة على حياته/حياتها. في هذا الإطار، الجسد وقدراته ليس مملوكًا للفرد فقط، لكنه معرض للعديد من الالتزامات التي يفرضها الآخرون كمسلمين. لذا هناك توتر مستمر بين المسؤولية بوصفها فردية وميتافيزيقية من ناحية، وجمعية ويومية من ناحية اخرى أي، بين علم الأخرويات وعلم الاجتماع.
بالإشارة السريعة إلى جوانب التأديب الجسدي الإسلامي لا أود أن أكرر التحيز العلماني القديم بأن الدين يقوم أساسًا على الخوف من العقاب. اهتمامي ينصب على الإشارة إلى طريقة استخدام سنن محددة للألم من أجل خلق مساحة للفعل الأخلاقي الذي يوضح هذا العالم في التالي. لذا يتم استخدام الألم وتبريره من قبل قانون الدولة الحديثة (بما في ذلك قانون الحرب) لإقرار النظام وتحقيق الأمن. الأمراء المسلمون والمسيحيون استخدموا الألم لهذا الغرض أيضًا. ولكن بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت السنن المسيحية والمسلمة، باختلاف الطرق، أن المعاناة إعادة إنتاج للشر الدنيوي. بالنسبة لصاحب المعاناة، ليس كل الألم يتم تفاديه، ولكن بعض الألم يجب تحمله بفاعلية حتى يتم تجاوز الشر. وفقًا للسنن المسيحية والمسلمة، الشر هو جزء أساسي في طريقة تكوين العالم. وما دام هذا العالم مستمرًا، لا يمكن محو الشر بشكل دائم، بل التغلب عليه بشكل مؤقت[42].
لذا، فإن الألم لا يشكل فقط دليلًا لا يدحض على الأساس البدني للتجربة، لكنه أيضًا وسيلة لتشكيل الحالة الإبستمولوجية للجسم، بالإضافة إلى إمكاناتها الأخلاقية.
الفاعلية الأخلاقية والمسؤولية والعقاب
في الختام أود أن أناقش إذا كانت النية والمسؤولية والعقاب ضرورية معًا في فكرة الفاعلية التي أصبحنا نألفها في الأخلاقيات العلمانية. وأقوم بذلك من خلال مناقشة مثال «أوديب» الذي كان الألم بالنسبة له متداخلًا مع الفعل الأخلاقي وهو فعل لا يمكن وصفه في إطار «المسؤولية»، كما يُزعم.
تُصور مأساة أوديب قصة معاناة وضعف ليست طوعية ولا إلزامية. بيد أن أوديب فاعل، ويقوم بما فعله دون وعي بإحداث تغيير عميق في العالم. بمعرفة سر أفعاله الماضية تدريجيًا، يلحق أوديب جراحًا بشعة للجسد الذي ارتكب تلك الأفعال، والذات التي لا يمكن التعرف عليها ولا إنكارها. تضم أفعال أوديب الأخيرة من عدوله الشعبي عن السلطة الملكية كتعبير عن الألم وكنتيجة له. وتمثل تلك الأفعال وتستمد من مشاعره عذابه وليس نيته الواعية. تتشكل فاعلية أوديب بالتعريفات المتصارعة لورطته ونتيجة لإصراره على كشف حقيقة أصله. يقوم بسلب نفسه القدرة لأنه، كقاتل والده وزوج أمه (وهو انتهاك مزدوج، كلاهما مرتكب بدون معرفة)، سبب معاناة ذاته الخاصة، وهي المعاناة التي ستتوقف عندما ينفي نفسه عن طيبة، أي عندما يسلب نفسه القدرة.
يلاحظ مايكل ديلون[43]، الذي قادني تحليله المبهر حول سلب القدرة إلى كتابة هذا الجزء، أن أوديب يصبح بتحمل مسؤولية أفعاله في النهاية فاعلًا بإرادته. ويعد ذلك تفسيرًا مقترحًا، لكنني لست مقتنعًا بأن فكرة «المسؤولية» مناسبة هنا. إذا نظرنا إلى تلك الفكرة بأنها تحتوي عوامل الإسناد والمسؤولية على العقاب، فيبدو لي أن أوديب ليس مسؤولًا تجاه أي سلطة، وليس عليه الامتثال لأي محكمة (إنسانية أو إلهية) لأفعاله ولا حتى لما أطلق عليه الإفتاء المسيحي لاحقًا «محكمة الضمير الداخلية»، فهو مبدأ غريب جدًا على الإغريق[44].
ينكر أوديب في مسرحية «أوديب في كولونا» صراحة أن انتهاكاته كانت أفعاله الخاصة، ويقاطع الجوقة التي تشير إلى ما قام به، بالإصرار على أنه «ليس فعله». ولا ينكر أنه تسبب في موت رجل في مفترق طرق (وهو ما الذي عرفه دومًا) بل إنه قتل والده، وهو فعل مختلف، وما حاول تفاديه تحديدًا. بأي شكل كان أوديب مسؤولًا عن هذا الفعل؟ بالتبرؤ من الشيء الشنيع الذي حدث (قتل الأب) هو لا يقول إنه لم ينتو القتل، فهو يعترف بأنه صاحب فعل مسؤول (فاعل)، لكنه يدعي أيضًا أن الفعل اتضح أنه لم يكن خاصًا به، وأنه كان أداة غير متعمدة (وكيل) للآلهة، لذا فإن نيته تعتبر غير ذات صلة هنا. ولكن، عندما اكتشف حقيقه فعله، أدرك أن عليه التصرف ليس لأنه يعترف بالمسؤولية ويتحملها، بل لأنه لا يستطيع العيش بعد أن أدرك من هو، وما فعله لأبيه وأمه (في ضوء تلك المعرفة). بالرغم من أن أوديب لم يعرف «المعنى الأخلاقي» لفعله التجاوزي في وقت القيام به، إلا أنه يعاني منه. إن دواخله ليست محصنة ضد المعاناة بالرغم من أنها لم ترتكب شيئًا لتستحقه.
(هل يظل أوديب نفس الشخص في نهاية الدراما كما كان في بدايتها؟ فقد خاض في النهاية تجارب بشعة الصدمة النفسية عند اكتشاف الذات والصدمة الجسدية عند إعماء نفسه. إن الذات التي تتجلى الآن هي نفس الذات التي تتعمد تدمير قدرته على الرؤية. تحول أوديب من ملك قوي، محبوب، وحام، إلى منفي مشرد، أعمى، ومكروه. هل يسمح هذا التمزق بهوية شخصية مستمرة لأوديب، ووعي لوكي (فلسفة جون لوك) بالذات؟ وفي حالة غياب تلك الاستمرارية، هل يمكننا القول فعلًا إن أوديب يتحمل على الأقل مسؤولية ما فعله أو ما تم نسب مسؤوليته إليه؟)[45].
لا ألمح إلى أن ما فعله أوديب يحسن تفسيره بالربط بالسحر في مقابل الفاعلية الأخلاقية وأنه نظرًا لاعتقاده أنه بقتله لأبيه تسبب في وباء خطر دون عمد فقد سعى إذًا لإيقافه بعقاب ونفي نفسه. (هذا هو ما رآه فرويد في قصة أوديب تعديات ضد محظورات مشروطة في إطار سحري، وبالتالي ليس لها علاقة بالأخلاقية[46]). لكنني أنبه إلى أن الأفعال يمكن أن يكون لها أهمية أخلاقية دون أن تحتاج أن يتم تفسيرها بالضرورة في إطار «التبرير».
رأى علماء الأنثربولوجيا في الحقبة الفيكتورية أن «السحر»، كونه أساسًا تطويع فهم خاطئ للسببية الطبيعية، كان نوعًا من الزيف، وبالتالي لا يجب خلطه مع الأخلاقية «الدين»، ومن ناحية أخرى، عندما يتم تطهيره من عوامله السحرية، كان يعتبر الموقع الأصلي للأخلاقية، لأن الأخلاقية الدينية ترتبط بمسؤولية الفاعلين عن أفعالهم وتجاه اﷲ. تستبدل الأخلاقية العلمانية اﷲ بالوعي الفردي للرجال والنساء. لذا، فإن الاعتقاد البدائي بأن وفاة الإنسان تثير تلقائيًا مادة وبائية تسبب الضرر للبشر الأحياء هو فهم خاطئ للسببية الطبيعية وفكرة غير متوافقة مع فعل المسؤولية. ولأن الفعل الأخلاقي، بالنسبة لمنظري العصر الفيكتوري وأيضًا تابعيهم المعاصرين، يعني الفعل المميز «للفاعل الحر» والمسؤول أمام اﷲ والمجتمع أو الضمير (الثلاثة مطابقين بالنسبة لدوركايم). إن معارضة السحر/العلم لـ الدين/الأخلاقية تبدو معقولة حتى الآن للكثيرين. لكن علماء الأنثروبولوجيا في القرن العشرين عقَّدوا مفهوم «السحر، و«الدين» مؤخرًا. وهناك أيضًا أسباب معقولة للتشكيك في المعارضة الحادة بين حقل الطبيعة وذلك الخاص بالمجتمع. وقد قدم لنا المؤرخون، علماء الاجتماع، والفلاسفة فهم أعمق للطرق التي يعتمد حقل الطبيعة من خلالها على النشاط الإنساني ويكرره[47]. باختصار، إذا كان فهمنا «للفعل الأخلاقي» يتشكل بالتضاد مع بعض الأفكار عن «السحر و«الدين» إذا هل سيمكن أن يبقى دون تأثر عندما يتم إظهار الأخيرين على أنهما مهجورين؟
إذًا، قد لا تعتمد طبيعة الفعل الأخلاقي لأوديب على تتابع السببية الطبيعية بحيث تكوت «المسؤولية» ذات صلة. قد أقول إن أفعال أوديب عقب اكتشاف ما فعله (بداية من عقاب النفس) تنشأ من فضائل معتمدة على ما أطلق عليه مرسيل موس Marcel Mauss الخلقة أو «الهابيتوس» Habitus، وهي مقدرة متجسدة تفوق القدرة الجسدية بحيث تتضمن حساسيات وعواطف مصقولة، أي تزامن الحواس. لذا فإنني أعتقد أن الألم الذي ألحقه أوديب بنفسه لا يجب اعتباره نتاجًا لحكم على مسؤوليته، وربما لا يحسن التفكير فيه بأنه «عقاب» (فكرة وجود مواقف مسبقة لكونه فعلًا معقولًا ومدركًا)، لكن الألم في حد ذاته الأداء العاطفي لإدراك أخلاقي متجسد. يعاني أوديب، ليس لأنه مذنب، لكن لأنه صالح.
الفهم الحديث للمسؤولية يعني أن تكون عرضة للمحاسبة أمام سلطة ما، وأن تكون مستعدًا لتقديم مبررات وأعذار لأفعالك، وأن تعي أن المرء يستحق العقاب على فشله في القيام بواجباته أي واجب كان من الممكن القيام به، أو تعين القيام به، وهو بذلك حق الآخرين بأن يتم القيام بذلك الواجب. يشير ريتشارد مكون Richard McKeon إلى أن أول استخدام لكلمة «مسؤولية» في اللغتين الإنكليزية والفرنسية يعود لعام 1787، في سياق الثورتين الأميركية والفرنسية، ومنذ ذلك الحين بقي استخدامها الأساسي سياسيًا[48]. إذًا فإن فكرة «الحكومة المسؤولة»، أي مبدأ الحكومة الدستورية، وحكم القانون، وحق تقرير المصير، أصبحت نموذج السلوك السياسي المشبع بصفة أخلاقية محددة، وأيضًا للأخلاقية نفسها.
ليست الخلقة شيئًا قد يقبله المرء أو يرفضه في مقابل هذا النموذج السياسي للأخلاق، لكنها جزء من ماهية الفرد وما يتعين عليه فعله (أخلاقيات الحتمية العاطفية تتضمن التراجيديا). فقأ أوديب عينيه، ليس لأنه يستحق العقاب على فشله في تحمل المسؤولية من منظور ضميره أو ربه أو لأنه يعتقد ذلك إنما لأنه (كما يقول) لا يمكنه تحمل فكرة النظر إلى أبيه وأمه عندما ينضم إليهما بعد الموت، ولا أن يرى إنجاب أولاده بتلك الطريقة. يقوم أوديب بأفعاله نتيجة الشغف الذي يرتبط بــ «الخلقة» الخاصة به. إنني متحير إذًا من تمثيل ديلون Dillon لأوديب بأنه نموذج للمسؤولية الأخلاقية.
يرى بيرنارد ويليامز Bernard Williams أيضًا أن قصة أوديب تصور مفهوم المسؤولية الأخلاقية[49]. يعتبر ويليامز فكرة المسؤولية رئيسية في مفهوم الفاعلية، لذا فإنها تساوي الأخلاقية عمليًا مع القانون الجنائي، ولكن تفسيراته ليست واضحة دائمًا كما ينبغي. لذا، في صفحة رقم 55 يعرف «السبب، النية، الحالة، والاستجابة» بأنها العوامل الرئيسية لأي إدراك للمسؤولية، ولكن في صفحة 57 يعترف بأن القانون الحديث يُحَمل الناس المسؤولية، في بعض الحالات، لنتائج لم يقوموا حتى بالتسبب بها». إذا، يعتبر السبب عاملًا أساسيًا هنا بسبب غيابه. وهو يعتقد أن نسب المسؤولية دون سبب يرجع إلى امتياز «موازٍ» لذلك المتبع في طقس «كبش الفداء»، أي أن يصبح المرء «بديلًا لشخص ما مسؤول».
بالعادة، يقدم نمط الشرح بالمضاهاة «العلماني» (القانون) على أنه نسخة منزوع القداسة من «الديني» (الطقس). ومع ذلك، فإن الهيكل الداخلي للحالتين ليس واحدًا. ويحدد القانون الحديث مسؤولية الأشخاص الاعتباريين كأصحاب الأملاك قبل حدوث أي جنحة، بينما يتشكل كبش الفداء بالارتباط بتعديات محددة. تختلف مسؤولية الملاك عن الضرر اللاحق بالآخرين نتيجة ما يتم على ممتلكاتهم عن دور كبش الفداء في محو خطايا الآخرين. في بداية الأمر، مبدأ «الإهمال» الذي جعل صاحب الأملاك مسؤولًا قانونيًا، هو حديث تمامًا وإذًا فإن مفهوم الفاعلية الذي يقوم عليه هو حديث أيضًا[50]. علاوة على ذلك، يوضح فرانز ستاينر Franz Steiner، أن كبش الفداء لم يكن بديلًا لمذنب في نظر القانون (شخص فشل في تحمل المسؤولية بشكل كاف) ولا تعبير عن اعتقاد بدائي في المحرمات، بل الطرد الشعائري للشر من المجتمع المحدث[51]. يتم تحميل المالك المسؤولية أمام المجتمع الذي يكون عضوًا فيه، أما وظيفة كبش الفداء فهي أن يكون خارجه. ويعد ذلك تحديدًا الفكرة البروتستانتينية المتجذرة بأن «الدين الحقيقي» يتطلب الاعتقاد في «المسؤولية الفردية»، وأن الممارسات الشعائرية تشغل الحقل بحيث يزدهر السحر والخرافة أيضًا، ويقدمون بدورهم الفهم العلماني المبالغ في التبسيط عن «كبش الفداء» بأنه شخص يتم إلقاء اللوم عليه نتيجة آثام الآخرين.
يعتقد ويليامز، كعلماء أنثروبولوجيا القرن التاسع عشر، أن فكرة «المعتقدات السحرية» (مثل الوباء الناتج عن قتل الغير) لا يمكن أن يكون أساس «الفاعلية الأخلاقية»، لكنه يختلف عنها في التفكير في أن قصة أوديب لا تدور بالضرورة حول الخرافة البدائية بل عما يدركه الحداثيون بأنه أخلاقي. ويتفق معهم في افتراض أن تبرير هذا الادعاء يتطلب دليلًا على أن القصة تتضمن مفهومًا حديثًا حول المسؤولية، مكتشفًا عن طريق الخرافة. ويقول: «في مسرحية أوديب ملكًا، هذه الآلة البشعة، تنتقل إلى اكتشاف شيء واحد، أنه قام بالفعل». «هل نفهم الرعب الناتج عن هذا الاكتشاف فقط لأننا نشارك معتقدات سحرية بالتبعية عن ذنب القتل، أو أفكار مهجورة عن المسؤولية؟ بالطبع لا: إننا نفهمها لأننا نعرف أنه في قصة حياة المرء هناك سلطة تمارس وفقًا لما قام به المرء، وليس فقط بما قام به المرء عن قصد (ص69)». يقودنا ويليامز إلى أن نفهم أن أوديب فرد وإنسان مألوف، شخصية كانت حقيقية وعميقة، وحالته الأخلاقية مستقلة عن أي حبكة. في هذا الإطار، يبدو أنه لا يوجد اختلاف أساسي بالنسبة لويليامز بين كيفية إدراك الجمهور الأثيني في القرن الخامس لأوديب وكيف يتم حثنا على رؤيته. ولكن طريق التعبير تلك عن «وجود سلطة» يعتبر غامضًا. أي أنها تتيح للمرء التملص من سؤال متى، كيف، وبأي شكل تحديدًا، يتشكل الرعب الناتج عن اكتشاف أنه «قام بالفعل» من خلال إدراك المرء مسؤوليته.
في الحالة النموذجية لأوديب، لا يقوم الأمر ببساطة على أنه يسيء دون قصد للمحرمات الأخلاقية ويكتشف ذلك تباعًا. ولكن لأنه، منذ ولادته، مقدر للقيام بذلك.
ويشارك والدا أوديب، لايوس وجوكاستا، في هذا المصير بمحاولة التخلص منه. ومهما يحاول أوديب تفادي هذا المصير، فهو يتصرف دون قصد بالطريقة التي كُتبت له. تعتبر الحبكة جزءًا من ماهيته. (رأى فرويد، كما هو معروف، أن هذه الحبكة هي نتاج للرغبات غير الواعية[52]، لكننا يمكننا أيضًا اعتبار أن القصة مكونة من أفعال العديد من الفاعلين الذين يعملون معًا للخروج بنتيجة واحدة)[53]. هذا الحكي الاسترجاعي للنص المكتوب مسبقًا هو تحديدًا الذي يساعد على تحديد حالته الحالية كفاعل أخلاقي ليس لأنه يحرره من ماضيه بل لأنه يرجع فاعليته إلى الخلقة، والقدرة على التصرف بعقلانية، ولو مأساويًا، بالتوافق مع خبرته وموقفه. إن سلطة الماضي ليست بالضرورة دليل على المرض النفسي، وفقًا لتعاليم فرويد الحداثية.
قال بول فييرآبند Paul Feyerabend ذات مرة إن التراجيديا الإغريقية الكلاسيكية كانت «رصدًا واقعيًا للأحوال الاجتماعية بنقد تلك الأحوال واقتراح بديل لها»[54]. ولكن هذا التصريح لا يسمح بإمكانية التعايش مع التراجيديا (كالألم نفسه) بفاعلية كشكل ضروري للحياة، وهو شكل لا يمكن لأي قدر من الإصلاح الاجتماعي والعلاج الفردي أن يمحيه إلى الأبد. لا تفسر تراجيديا أوديب «كيف يمكن للأعراف أن تشل الفعل»، كما يقول فييرآبند وآخرون. ولكنها تظهر كيف يمكن للماضي سواء كان علمانيًا أو دينيًا أن يشكل الفاعلية. الاختيار المستحيل هو اختيار بين بدائل فظيعة كُتبت مسبقًا للشخص لكن يظل الاختيار والتصرف بناء على ذلك ممكنًا. ولا أقصد بذلك بالطبع أن إصلاح الترتيبات الاجتماعية المصورة في المسرحية غير ممكن (هو كذلك بالطبع، رغم أن فكرة الإصلاح لا توازي الأفكار العلمانية لصناعة التاريخ أو تمكين الذات). لكنني أعني ببساطة أن أوديب يقوم بالفعل، ويقوم بذلك في موقف لم يكن من «مسؤوليته»، وأنه تمكن من التصرف بابتكار (لتحرير مدينته) دون استهداف تمكين الذات. وأعني أن الإصلاح لا يمكنه محو الألم، ليس فقط لأن الألم جزء من تقلبات الحياة دائمًا، بل لأنه جوهري في السنن اليهودية والمسيحية والإسلامية الخاصة بالفريضة، وفي التقليد العلماني بربط المسؤولية الفردية التي تم تشكيلها من ذلك الأخير. تختلف طبيعة هذا الألم (العقاب، التوبة، والتهذيب) عن ذلك الذي تحمّله أوديب لأنه متجذر في فكرة المسؤولية، وهي فكرة أن الشخص عرضة للمحاسبة واللوم لنتاج محدد. ويشير ذلك إلى أن قبول الذنب والتكفير المؤلم يقود إلى نوع من الإحياء العادل[55]. وبالنسبة لأوديب، فإن تلك العودة غير مسموحة، وتراكم الأحداث لا يمكن عكسه. المستقبل لا يُصنع هنا، يل يتم مواجهته وتحمله.
تعقيب ختامي
أعتقد أنه من المهم الأخذ في الاعتبار كيف يتم تحديد واستخدام مفهوم الفاعلية، من الذي يقوم بذلك، ولماذا، وذلك للخروج بفهم أفضل عن طرق تشكيل وإعادة تشكيل «الديني» و«العلماني» باستمرار. التحولات في ضوء هذا المفهوم، وبالارتباط بأفكار المسؤولية والوعي، مهمة جدًا في المراجعات الخاصة بفهمنا للديني وبالتالي العلماني. وما يتطلبه ذلك ليس تحقيقًا مجردًا في التغيرات البسيطة للاستخدام اللغوي، بل رد على الأسئلة المتعلقة بكيفية معايشة الجسد للألم والعقاب، الشغف والمتعة، الأمل والخوف. ومن هذا المنطلق، أنتقل الآن بشكل عام إلى بعض المواقف العلمانية تجاه الألم.
هوامش:
[1] يلاحظ لورانس غروسبرج Lawrence Grossberg أن الفاعلية وهي القدرة على صنع التاريخ كما كان ليست جوهرية، ﻻ في ما يتعلق بالذاتية، وﻻ الموضوعات. وهي ليست مبدأ وجوديًا يمكن من خلاله التفريق بين البشر وغيرهم من الكائنات الحية. يتم تعريف الوساطة/الوكالة من خلال تعريفات المواقف الخاضعة إلى أماكن محددة (مواقع الاستثمار)، وفضاءات (مجالات النشاط)، على الأقاليم المشيدة اجتماعيًا. الفاعلية هي التمكين المفعل في مواقع محددة، وعبر ناقلات محددة» (Lawrence Grossberg, «Cultureal Studies and/in New Worlds», Critical Studies in Mass Communication, vol. 10, 1993, p. 15)، أتفق مع غروسبرج في وجوب الفصل بين الوساطة والذاتية على المستوي التحليلي، ولكني أختلف معه في وجوب تعريف الوساطة من خلال «صنع التاريخ»، و«التمكين الذاتي»، كما يوضح هذا الفصل.
[2] مجموعة أخرى ذات صلة، تستحق انتباهًا نقديًا أشمل، هي؛
Other Intentions: Cultural Contexts and the Attribution of Inner States, ed. Lawrence Rosen, Santa Fe, NM: School of American Research, 1995.
[3] Passion and Action: The Emotions In Seventeenth Century Philosophy, Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 292.
[4] هناك مناقشة مهمة لمجموعة متنوعة من النظرية في كتاب حديث لعالم الأعصاب جوزيف لودوكس،
Jiseph LeDoux, The Emotional Brain, New York: Simon & Schuster, 1996.
أنا ممتن لوليام كونولي William Connolly لتوجيهي إلى هذا الكتاب.
[5] يجادل كولينوود Collingwood بأن العاطفة ليست بالضرورة نقيض العقل، لأن العقل وبالتبعية كل الأفعال العقلانية في حد ذاته مشحون بالعاطفة. انظر:
- G. Collingwood, The Principles of Art, Oxford: Clarendon Press, 1938,
خاصة الفصل الخاص باللغة التي تسبق الكتاب الثالث (نظرية الفن).
[6] تشتكي شيري أورتنر Sherry Ortner من إنكار الخضوع المتعمد، ومن «الوكالة» في الكتابات المعاصرة للعلوم الاجتماعية (انظر:
- Ortner, Making Gender: The Politics and Erotics of Culture, BostonL Beacon Press, 1996, p. 8).
ولكني أجد أن الحديث عن الفاعلية شائع جدًا في الأنثربولوجيا، وأن «الخضوع المتعمد» يكاد يكون جزءًا منها. إن النمط الحميمي من الروايات المتناقلة عن الكتابة الإثنوغرافية يعكس انهماكًا في النوايا، نادرًا ما يتم التمعن فيه بشكل جيد.
[7] ويمكن توضيح ذلك من خلال عملية مسح مفيدة لعمل حديث عن الجسد بواسطة مارجريت لوك Margaret Lock، والتي تلاحظ أن «المقاومة الجسدية كان يتم تأويلها، حتى وقت قريب، بأنها هامشية، أو مرضية، أو على قدر كبير من الغرابة، أو حتى يتم تجاوزها دون ملاحظة أو تسجيل. التناول الإثنوغرافي الممنوع، والتحفيز بواسطة زيادة الاهتمام الوثيق، وللمرة الأولى، بالحياة اليومية للنساء والأطفال، والمهمشين، كل ذلك أدى إلى إعادة تشكيل النظرية. الجسد، المشبع بالمعنى الاجتماعي، هو الآن متموضع تاريخيًا، وفضلًا عن كونه دالًا على الانتماء والنظام (كما جاء في الأعمال الأنثربولوجية الأقدم)، فقد أصبح أيضًا منتدى نشطًا للتعبير عن المقاومة والخسارة، وهو ما تم عزوه بالتبعية إلى الوكالة الفردية. (Margaret Lock, «Cultivating the Body: Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge», Annual Review of Anthropology, 1993, vol. 22 p. 141. Italicd dupplirf; the syntactic hiatus in the final clause is in the original) الجسد المريض، كما الطبقة العاملة المضطهدة، ينظر إليه على أنه مقاوم، ولهذا السبب، ينظر إليه على أنه وكيل يحاول الدفاع عن مصالحه. نموذج نفسي وحيد من الاستقلال، وهنا مكمن كلتا الحالتين. ولكن المشكلة هي أنه لقراءة سلوك الجسم المريض بوصفه «تعبيرًا عن المقاومة»، فإننا نحتاج إلى معايير للترجمة تختلف عن تلك التي نتبعها عندما نتعرف على مقاومة الطبقة العاملة.
[8] انظر على سبيل المثال مقال ليلي أبو لغد «رومانسية المقاومة»، أميركان إثنولوجيست American Ethnologist، المجلد 17، العدد 1، 1990.
[9] مفهوم «المصلحة» (بما في ذلك «المصلحة الشخصية») والذي غالبًا ما يستحضره منظّرو الوكالة، هو مصطلح نفسي آخر، ذو تاريخ فريد، والذي يطرح نفسه للحداثيين بوصفه ذا طابع عالمي، طبيعي، وجوهري. (انظر؛ Albert Hirschman, The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism before Its Triumph, Princeton: Princeton University Press, 1977)، إن سلالات النسب المعقدة، التي اكتسبنا بموجبها مفرداتنا للحديث عن الوكالة والذاتية، والنظريات النفسية المتغيرة التي تجلبها، يجب أن تنبهنا إلى مخاطر تطبيقها دون تفكير متأن، وتأهيل إلى أي من المواقف الاجتماعية أو كلها.
[10] على الرغم من أنه كثيرًا ما يتم استدعاء فوكو من قبل منظّري المقاومة، إﻻ أن أسلوبه في استخدام هذا المفهوم مميز بشكل كبير. على سبيل المثال؛ «هناك في الواقع، شيء ما في الجسد الاجتماعي، في الطبقات، في المجموعات والأفراد أنفسهم، والذي يتجاوز، بمعنى ما، علاقات السلطة، شيء ما، ليس بأي حال من الأحوال، سهل الانقياد، أو أحد أشكال رد الفعل البدائي، وإنما هو حركة الطرد المركزي، والطاقة العكسية، والتفريغ. من المؤكد أنه ليس هناك ما يسمى «العوام»، في حين أن هناك، خاصية أو جانبًا محددًا من العامية (de la’ plebe). هناك عوام في الهيئات، في النفوس، في الأفراد، في البروليتاريا، في البرجوازية، ولكن في كل مكان في مجموعة متنوعة من تشكيلات وملحقات الطاقات غير القابلة للاختزال. هذا القدر من العوام ليس هو ما يقف، بشكل كبير، خارج علاقات السلطة، على أنه حدودهم، وجانبهم السفلي، أو ضربتهم المرتدة، والتي تستجيب لكل شكل متقدم من السلطة عن طريق حركة فك الارتباط. (Power/Knowledge, Brighton, UK: Harvester Press, 1980, p.138) هذا المفهوم من المقاومة بوصفه «الحد» من السلطة، فيه بعض التشابه من مفهوم كلوزويتزن Clausewitzian عن الاحتكاك. (انظر:
Carl von Clausewitz, On War 1832, New York: Penguin Books, 1982, pp. 65 – 164).
[11] Culture/Power/History, ed. Nicholas B. Dirks, Geoff Eley, and Sherry B. Ortner, Princeton: Princeton University Press, p. 18
[12] انظر: Ian Hacking, The Taming of Chance, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, especially chapter 19.
[13] Susan Wolf, «Sanity and the Metaphysics of Responsibility» in F. Schoeman, ed, Responsibility, Character, and the Emotions, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p. 55.
[14] الشخص كما يكتب لوك «هو مصطلح قضائي، يقوم بالاستيلاء على الأفعال واستحقاقاتها وما إلى ذلك، وينتمي فقط إلى الفاعلين الأذكياء، قادر على القانون والسعادة والبؤس. تمدد هذه الشخصية نفسها إلى ما هو أبعد من وجودها الحالي، إلى ما هو ماضٍ، من خلال الوعي فقط، إلى حيث تصبح معنية وخاضعة للمسؤولية، تمتلك وتنسب لنفسها أفعالها السابقة، استنادًا لنفس الأرضية ولنفس السبب التي تتعامل على أساسه في الوقت الحاضر.
(An Essay Concerning Human Understanding, Book Two, Essy XXVII, Section 26).
[15] «الشركات ﻻ تموت» ﻻحظ هنري ماين Henery Maine على الدستور القانوني أن «وفاة الأعضاء الأفراد ﻻ تؤثر على الكيان الجماعي للجسم الكلي، وﻻ تؤثر بأي شكل من الأشكال على الحوادث القانونية، وقدراتها أو مسؤولياتها».
.(Ancient Law 1861, Oxford (world Classics), 1931, p. 154)
[16] Hanna Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley: University of California Press, 1967.
[17] الممثل Alla Nazimva ينظر إلى هذا الأمر على النحو الآتي؛ «الممثل نفسه ينبغي أن يكون مخلوقًا من صلصال، معجون، قابلًا للقولبة في هيئة أخرى وشكل آخر. الممثل ﻻ يجب أن يرى نفسه في الشخصية. أقوم بدراسة المرأة، أنظر إليها تحت عدسة مكبرة وأقول لنفسي؛ «هل هي على صواب؟ هل هي منطقية؟ هل هي صادقة مع نفسها؟ هل أستطيع تمثيل هذه المرأة؟ هل يمكنني أن أحول نفسي إلى هذه المرأة؟ أنا ﻻ شيء، أنا ﻻ أحد. على أن أعيد تكوين نفسي داخل هذه المرأة، عليّ أن أجسد التحدث بصوتها، الضحك بضحكتها، التحرك بحركتها. ولكن إذا كنت تستطيع رؤية الشخص باعتباره كائنًا حيًا، تمت إزالته تمامًا من نفسك، يمكنك العمل بشكل موضوعي لتكييف نفسك على أداء هذا الدور».
(The Actor as an Instrument, in Toby Cole and Helen K. Chinoy, eds., Actors on Acting, New York: Crown, 1949, p. 512).
ما يبدأ باعتباره بيانًا بسيطًا بأن دور الممثلة هو أن تكون مجرد أداة، سرعان ما يتطور إلى المطالبة بأن الممثلة يجب عليها التنظيم والاستقرار لنفسها على شخصية يمكنها أن تقوم بأدائها.
[18] Edward Burns, Character: Acting and Being on the Pre Modern Stage, New York: St. Martin’s Press, 1990.
[19] Richard Hornby, The End of Acting, New York: Applause: Books, 1992, pp. 6 – 7.
يعد هذا الكتاب، من بين أشياء أخرى، رصدًا إرشاديًا لحدود النية الواعية في التمثيل الفعال.
[20] يذكرنا بيرن بأن «التمثيل والبلاغة لم يُنظر إليهما في بداية أوروبا الحديثة على أنهما كيانان مستقلان، ولذا فإن نظرية التمثيل لم تكن ضرورية، وكذلك الكتيبات المنهجية لتقنياتها، حيث إن الأولى موجودة بالفعل في نظرية البلاغة، بينما أن الثانية، من ناحية، يمكن اعتبارها جانبًا من مجموعة المهارات الاجتماعية والترفيهية التي لا يمكن تصنيفها، ومن ناحية أخرى، فهي تعتبر تطورًا من الداخل نابعًا من تقليد بلاغي مؤسَّس، وذلك في المؤثرات الخاصة برواد البلاغة مثل ألين Alleyn وبيرباج Burbage. قامت التقاليد الدرامية للجامعات، جماعات المحامين، ومدارس الكورال، باستكشاف التمثيل والبلاغة على أنهما أمر واحد. لذا، لا يجب أن نرتكب خطأ اعتبار البلاغة في معناها الدارج الحديث بأنها شيء مصطنع، غير حقيقي، وسخيف على نحو وثيق. إن الحديث عن التمثيل في إطار بلاغي يعني اعتباره أحد فروع دراسة الاتصال الإنساني، وتطور مهارات إثارة، إبهاج، إقناع وتعليم أشخاص آخرين وفقًا لتصور ثقافة الحقبة الكلاسيكية، العصور الوسطى، وعصر النهضة، (بيرنز، ص10). كان من الممكن أن يضيف بيرنز أن التقاليد البلاغية في العصور الوسطى والحديثة المبكرة لها جذور قوية في الوعظ المسيحي وأداء الطقوس المقدسة وأيضًا مسرحيات الآلام.
[21] «يمكنك في أي موقف آمن ومقبول اجتماعيًا (كحفل، عطلة، أو مسرحية) إسقاط الألم الناتج عن محاولات الارتقاء للصورة المثالية للذات بشكل مؤقت، وأيضًا أن تكون شخصًا مُزدرى أحمق، وغدًا، وجبانًا ولا تتعرض للإساءة أو التهكم، بل من الممكن أن تلقى الضحك والاستحسان … يمكن أن تبكي الشخصية، بينما يشعر الممثل بالنشوة (من المصطلح اليوناني ex histanai، والذي يعني وقوف المرء خارج مكانه، حرفيًا) لأنه تحرر من شخصيته الحبيسة والمقيدة اليومية المعتادة» (Hornby, pp. 17 -18).
[22] انظر مقال ديفيد بينو:
David Pinault, «Shia Lamentation Rituals and Reinterpretations of the Doctrine: of Intercession: Two Cases from Modern India», History of Religions, vol. 38, no. 3, 1999.
[23] Phyllis Mack, «Religious Dissenters in Enlightenment England», History Workshop journal, issue 49, 2000, pp. 16 – 17.
[24] Jean Starobinski, «Monsieur Teste Confronting Pain», in M. Feher, ed., Fragments for a History of the Human Body, Part Two, New York: Zone, 1989, p. 386.
[25] Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, Oxford: Oxford University Press, 198s, p. s.
[26] المرجع نفسه، ص 4.
[27] في مقدمة كتاب Pain as Human Experience: An Anthropological Perspective لمحرريه Mary Jo DelVecchio Good, Paul E. Brodwin، Byron J. Good, وArthur Kleinman (Berkeley: University of California Press, 1992) يكشف المحررون عن توتر غير محسوم بين فكرتين. فهم من ناحية، يعتبرون الألم تجربة سابقة على اللغة سيتم تمثيلها (لذا، فإن الألم يقاوم التعبير بالرموز)، ومن ناحية أخرى، هو تجربة سيتم تشكيلها في ومن خلال اللغة منذ البدء (لذا، فهو دائمًا «متأثر بالمعاني، والعلاقات، والمؤسسات»). هذه المفارقة قد تكون سبب افتراض وجود نوعين من الألم، نفسي (بتوسط من العقل) وجسدي (موضوعي، و«خام»)، بينما في الحقيقة يمكن أن يكونا جانبين لنفس الحدث، ذاتي وموضوعي.
[28] Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigation, Oxford: Blackwell, I953, especially p. 100.
[29] Scarry, pp. 2 – 8.
[30] يبيّن كولينجوود أن الشعور، بعكس التفكير، هو حالة عفوية من السلبية، بحيث لا تنطبق فكرة الفشل لأنها ليست متعمدة. وكالمعاناة، فإن المرء إما يشعر أو لا يشعر بشيء. علاوة على ذلك، المشاعر تعد خاصة بشكل أساسي بينما الفكر ليس كذلك. وبالرغم من أن عملية التفكير في شيء ما قد أو قد لا يكون خاصة بشكل كامل، وذلك اعتمادًا على كيفية قيام المرء بها، فإن ما نفكر فيه (فكرة محددة) هو دائمًا متاح للآخرين ظاهريًا وبشكل مباشر، ومن ثم يصبح عامًا. انظر R. G. Collingwood, The Principles of Art, Oxford: Oxford University Press, 1938, p. 158) وفقًا لكولينجوود، حالما يقوم المصاب بتعريف أي شعور، يتم ربطه بشكل راسخ بالفكر، كما أنه يستقر به، ويصبح بالطبع قابلًا للتعديل من قبله. وقد أزيد عليه أن الألم يمكن مشاركته لأن الفكر لا يشير ببساطة إلى شعور، لكنه يدفعه، يشكله، ويخلده في إطار علاقة اجتماعية.
[31] توضح فينا داس Veena Das تلك النقطة بشكل رائع في مقالتها عن معاناة النساء خلال تقسيم الهند عام 1947: بعد فتغنشتاين، استطاع أسلوب تصور أحجية الألم أن يحررنا من التفكير بأن التعبير عن الألم في هيئة تساؤلات عن اليقين أو الشك في ألمنا وألم الآخرين. بدأنا عوضًا عن ذلك في التفكير في الألم بأنه طلب للاعتراف والإدراك، حيث إن إنكار ألم الآخر لا يحدث بسبب إخفاقات الفكر بل إخفاقات الروح. في سجل التخيلي، ألم الآخر لا يسعى لإيجاد موطن في اللغة فقط بل في الجسد أيضًا.
«language and Body: Transactions in the Construction of Pain», in A. Kleinman, V. Das, and M. Lock, eds., Social Suffering, Berkeley: University of California Press, 1997, p. 88.
انظر أيضًا مقالها المهم: «Witgenstein and Anthropology», Annual Review of Anthropology, vol. 17, 1998.
[32] Susan Brison. «Outliving Oneself: Trauma, Memory, and Personal Identity», in D. Meyer. ed., Feminists Rethink the Self, Boulder, CO: Westview. 1997, pp. 21 – 22. (أنا ممتن لسوزان جيمس Susan James من أجل هذا المرجع).
[33] قام رونالد ميلزاك Ronald Melzack، صاحب نظرية بوابة التحكم في الألم (Ronald Melzack and Patrick Wall, The Challenge of Pain, New York: Penguin, 1982)، بمراجعة رؤيته الآن بشكل جذري (انظر: Pain: Past, Present and Future», Canadian Journal of Experimental Psychology, vol. 47, no. 4, 1993). ولأن الألم ينشأ من المخ باستقلالية عن الضرر اللاحق بالجسد، كما يقول ميلزاك، فإنه يمكن «الشعور» به في مواضع الجسد غير الموجودة. ويفسر ذلك ظاهرة رؤية وسماع الوهم. انظر: R. Melzack. «Phantom Limbs», Scientific American, April 1992.
[34] المرجع عن ثقافات العصور القديمة انظر:
- B. Onians, The Origins of European Thought About the Body, the Mind, the soul, the World, Time, and Fate, Cambridge Cambridge University Press, 1951، خاصة الفصل الخامس.
[35] Judith Perkins, The Suffering Self. Pain and Narrative in the Early Christian Era, New York: Routledge, 1995, p. 117.
[36] المرجع السابق، ص 84 ــ 85.
[37] المرجع السابق، ص 152.
[38] Pamela Klassen, «Sliding Around between Pain and Pleasure: Home Birth and Visionary Pain», Scottish journal of Religious Studies, vol. 19, no. 1, 1998, p. 66.
[39] موقف سوزان بريسون نفسها معارض لوجهة نظر دي بوفوار.
[40] Charles Hirschkind, «Technologies of Islamic Piety: Cassette Sermons and the Ethics of Listening. (Ph.D. diss., Johns Hopkins University. 1999); Saba Mahmood, «Women’s Piety and Embodied Discipline: The Islamic Resurgence in Contemporary Egypt» (Ph.D. diss., Stanford University, 1998).
[41] أعيدت طباعة كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية، فقيه القرن الثالث عشر، مرارًا في القاهرة منذ عام 1979، بمقدمه شرح طويلة للكاتب المصري محمد جميل غازي.
[42] أنا ممتن إلى جون ميلبانك John Milbank لمساعدتي في الوصول لفهم أوضح حول رؤى الآباء المسيحيين الأوائل عن المعاناة. انظر:
«The Force and Identity», «Can Morality Be Christian in his The Word Made Strange» Oxford: Blackwell, 1997.
[43] Michael Dillon, «Otherwise than Self Determination: The Mortal Freedom of Oedipus Asphaleos», in Hent de Vries and Samuel Weber, eds., Violence, Identity, and self Determination, Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.
[44] أؤكد أن هدفي ليس الجدل بأن الإغريق لم يكن لديهم مفهوم المسؤولية. لست أهلًا لعرض تلك النظرية أو الدفاع عنها. ترتبط أسئلتي الشكوكية فقط بحالة أوديب التي يقدمها ديلون وأيضًا بيرنارد ويليامز (انظر الآتي).
[45] انظر: «Feminism and Philosophy of Mind: The Question of Personal Identity», in M. Fricker and J. Hornsby, eds., The Cambridge Companion to Feminist Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 2000. لعرض قيم عن النقاش حول الاستمرارية النفسية، الهوية الشخصية، والجسد.
[46] «قيود المحرمات بعيدة عن الحظر الديني والأخلاقي. وهي ليست قائمة على أي أمر إلهي، لكن قد يقال إنها تفرض نفسها. هي تختلف عن الحظر الأخلاقي بحيث إنها لا تقع في نظام يصرح بشكل عام أنه يجب ملاحظة بعض التحجيمات ويقدم أسبابًا لتلك الضرورة. إنها حظر المحرمات ليس له أساس ولا أصل معروف. وبالرغم من أنها غامضة بالنسبة لنا فهي مسألة اعتيادية بالنسبة لهؤلاء الخاضعين لها Totem and Taboo, London: Routledge & Kegan Paul, 1960, p.18. (الإشارات الصريحة لأوديب في صفحات 68 ــ 80). وفقًا لفرويد، لا توجد أسباب للمحرمات فقط هنا بل أيضًا لا يوجد هدف من إعطاء أسباب لخرقها. تلك اللامنطقية هي التي تضع منظورات المحرمات خارج مجال الفاعلية الأخلاقية.
[47] انظر على سبيل المثال:
Ilya Prigogine, The End of Certainty: Time, Chaos, and the New laws of Nature, New York: The Free Press, 1997 .
[48] Richard Mckeon, The development and the significance of the concept of responsibility, in Freedom and History and other Essays, Chicago, University of Chicago Press, 1990.
[49] Bernard Williams, Shame and Necessity, Berkeley: University of California Press.
[50] William Holdsworth, A History of the English Law, London, 1922 – 1952, vol.8, p.449.
[51] Franz B. Steiner, Taboo, London: Cohen and West, 1958, Chapter 5.
[52] Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, London: Penguin Books, 1975, pp. 362 – 66.
[53] تنطبق تلك الحالة على البشر والآلهة. بعض أتباع المدرسة الكلاسيكية رأوا أن الآلهة الإغريق أشخاص، وآخرون رأوهم كقوى. يقول جون بريمر Jan Bremmer في دراسته للمعرفة الحديثة، إن بما أنه جرت شخصنة القوى فإن كلا التفسيرين هما أقرب مما قد يتصور للوهلة الأولى. انظر:
Jan Bremmer, Greek Religion, Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 22 – 23.
[54] Paul K. Feyerabend, Three Dialogues on Knowledge, Oxford: Blackwell, 1991, p. 97.
[55] يحاول ماير فورتز Meyer Fortes في كتاب:
Oedipus and job in West African Religion Cambridge: Cambridge University Press, 1959.
إظهار كيف تمتزج منظورات القدر والعدالة في الفكر التالنسي والممارسة الاجتماعية. وهو عمل مميز لا يستحق الإهمال الذي لاقاه، حتى وإن كانت نتائجه مختزلة في علم الاجتماع في النهاية.


