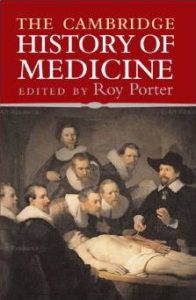
تمهيد
لم يعش الناس في الغرب لمدة أطول ولم يكونوا أكثر صحة ولم تكن الإنجازات الطبية بكل هذا التقدم الذي نراه اليوم، كما أنه أيضاً (وللمفارقة)، لم يواجه تطور الطب كل تلك الشكوك الشديدة والرفض كما يواجه هذه الأيام. لا يستطيع أي أحد أن ينكر أن الإنجازات الطبية خلال الخمسين عاماً الماضية – وتتويجاً لتاريخ طويل من الطب العلمي – استطاعت أن تنقذ أرواحاً أكثر مما تم إنقاذه في جميع العصور منذ فجر التاريخ. لعلنا غير مبالين بما نحن فيه من تقدم طبي هو في حقيقته مثير للاهتمام ويستحق إلقاء نظرة على بعض ابتكاراته الهائلة التي لم تكن متوفرة من قبل. هذه التطورات سيتم الحديث عنها في الفصول القادمة من الكتاب. وللتمهيد، سنقدم لكم ملخصاً قصيراً عن معظم التغيرات الجوهرية التي حدثت خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، كان دواء البنسلين لا يزال في مرحلة التجارب المعملية، وظل استخدامه محدوداً لعدة سنوات لاحقة. قبل ظهور هذا المضاد ”الرصاصة السحرية“ كانت بعض الالتهابات قاتلة في أكثر الأحيان، كالالتهاب الرئوي والتهاب سحايا الدماغ وبعض الالتهابات الأخرى. الدرن (السل) – الذي يلقب بالطاعون الأبيض على غرار الطاعون الأسود لأنه يسبب شحوباً في المرضى المصابين به- كان لفترة طويلة السبب المهم الوحيد لحالات الوفاة في الأمم الفقيرة. لكن هذا الوباء قد أُطلقت عليه رصاصة الرحمة حين تم توفير اللقاح المضاد له، بالإضافة إلى دواء الستريبتومايسن في الأربعينيّات، لتتلوه بعد ذلك وفي الخمسينيّات ”ثورة دوائية“ واسعة استطاعت خلالها الأدوية البيولوجية الجديدة هزيمة البكتيريا. كما أنتجت كذلك إبان تلك الفترة أدوية فعالة جداً (كدواء الكلوروبرومازين) المستخدم للأمراض النفسية وظهور أول لقاح ضد شلل الأطفال.
كما حدثت ثورات دوائية أخرى، وتحديداً أدوية الستيرويدز (المنشطات) كالكورتيزون، والتي سهلت الفهم المتزايد للجهاز المناعي. هذه الأدوية، ومن خلال فعاليتها في علاج معضلة رفض الجسم للأجسام المزروعة فيه، فإنها قد فتحت مجالات واسعة في جراحات التجميل وزراعة الأعضاء. جراحات القلب تطورت هي الأخرى. أحد الإنجازات المهمة كان أول تدخل جراحي في عام 1944م لمعالجة ”المواليد الزرق“ المولودين بمرض خلقي في القلب، لتقطع بذلك جراحات قلب الأطفال شوطاً كبيراً نحو المزيد من التقدم والذي استمر فيما بعد ليشمل عمليات القلب المفتوح للبالغين في الخمسينيّات، ثم عمليات تغيير شرايين القلب في عام 1967م.
بحلول ذلك الوقت، بدأ تطور الجراحة يشبه كثيراً السفر عبر الزمن، إذ بدأت تستحوذ على خيال الجماهير، وبدا أنها لا تعرف حدوداً لتقدمها. تبديل الأعضاء بدأ بالتطور هو الآخر، بداية مع زراعة الكليتين، لتحتل عمليات زراعة الأعضاء عناوين الصحف الرئيسية في العام 1967م حينما زرع كريستيان برنارد قلب امرأة داخل صدر لويس واشكنسكي والذي بقي حياً لثمانية عشر يوماً بعد العملية. وبحلول منتصف الثمانينيّات، كان هناك المئات من عمليات زراعة القلب التي تجرى كل سنة في الولايات المتحدة وحدها فقط، مع وجود نسبة نجاح كبيرة في المتلقين الذين يعيشون لخمس سنوات أو أكثر بعد الزراعة. خلال الخمسين عاماً الماضية، لم تتطور الجراحة فقط، بل تغيرت طبيعتها كلياً! ففي بدايات القرن العشرين، كان جوهرها يكمن في الاستئصال؛ حدد موقع الخلل وقم باستئصاله (غالباً ما تكون طريقة فعالة ولكنها وحشية). أما الآن فقد أصبحت فلسفتها أكثر تعقيداً، من خلال جراحات الإصلاح المستمر والتغيير (والتي لا تنتهي أحياناً).
بجانب القفزات المهنية الكبيرة في التدخل العلاجي، شارك العلم أيضاً في عملية المداواة. إذ خلقت الانجازات التكنولوجية ثورة كبيرة في القدرة الطبية التشخيصية، مثل المجهر الإلكتروني والمناظير وأجهزة التصوير المقطعي والتصوير المقطعي البوزيتروني والتصوير بالرنين المغناطيسي والليزر وأجهزة تتبع المواد داخل الجسم والتصوير بالموجات فوق الصوتية، ووجدت الجراحات المجهرية بعد ظهور الليزر في الاستخدام الطبي. كما أخذت بعض الأجهزة مكانها في الترسانة الطبية، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة القلب والرئة وأجهزة ضبط نبضات القلب. وفي تلك الأثناء، غيرت البحوث في العلوم الطبية الأساسية فهمنا لجسم الإنسان ومعركته مع الأمراض؛ خصوصاً في علم الجينات والوراثة وعلم الأحياء الجزيئي، التي تطورت سريعاً بعد اكتشاف تركيب الحمض النووي على يد واتسون وكريك وفك الشفرة الوراثية في العام 1953. كما أحرز تقدم كبير في الفحص الجيني والهندسة الوراثية. وفي الوقت نفسه، فتحت البحوث في كيمياء الدماغ آفاقاً جديدة في الطب، فالبحوث عن الاندورفينز (أحد الموصلات العصبية) قد كشفت اللثام عن أسرار الإحساس بالألم ومكنت العلماء من التحكم فيه، ونتج عن ذلك اكتشاف طرق التلاعب الصناعي بالناقلات العصبية مثل إل-دوبا مما وفر العلاج لمرض باركنسون والاضطرابات الأخرى في الجهاز العصبي المركزي. وطوال هذه الفترة، دخلت العلوم الإكلينيكية السريرية الحيز الخاص بها – وتعني هذه العلوم: تطبيق الطرق العلمية على التجربة الحقيقة للمرض – ويعود جزء كبير من الفضل للتجارب السريرية العشوائية, التي بدأت منذ منتصف الأربعينات.
لم يحدث كل هذا التقدم في العلم والتداوي في صحراء جرداء، بل نشأ بفضل وجود موهبة الطب الكبيرة التي تؤدي وظيفتها كأداة اجتماعية. في المملكة المتحدة، كان إنشاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في العام 1948م حدثاً مشهوداً. كما كرست الدول في مختلف أنحاء العالم، أكثر من أي وقت مضى، مواردها العامة والخاصة على الصحة، ففي الولايات المتحدة ومعظم دول الإتحاد الأوروبي فإن أكثر من عشرة بالمئة من الناتج القومي الإجمالي يذهب إلى الصحة. كما واصلت منظمة الصحة العالمية توسعها أيضاً، فبرامجها للوقاية من الأمراض والقضاء عليها، خصوصاً في البلدان الفقيرة، حصلت على نجاحات ملفتة للنظر، وبشكل خاص حين استطاعت القضاء التام على مرض الجدري عام 1977م في أنحاء العالم.
لتوضيح هذا التقدم باختصار، هناك حقيقتان تعطيان دليلاً قوياً (وإن بدا أنهما متناقضتين) على الأهمية المتزايدة للطب. الحقيقة الأولى هي تضاعف سكان العالم خلال الخمسين عاماً الماضية (من 2.5 مليار في عام 1950 إلى حوالي 6.25 مليار نسمة في العالم 2000)، ولم يكن لهذا أي سبب قد قامت به التدخلات أو الوقاية الصحية. والحقيقة الأخرى هي اختراع أدوية منع الحمل، والتي مهدت الطريق، ولو نظرياً على الأقل، لوسيلة سهلة وبسيطة للتحكم في عدد السكان. هذه التطورات حقائق مألوفة، لكن تشابهها لا ينقص من تأثيرها. إن التاريخ الإنساني مليء بالقفزات النوعية كاكتشاف الزراعة وتطور المدن والطباعة وأخيراً الثورة الصناعية، لكن ليس قبل النصف الثاني من القرن العشرين، حيث حدثت ثورة طبية لها آثار علاجية كبيرة. ويكفينا أن نأخذ كمعيار على المدى الواسع تلك القدرة الكبيرة للطب في هزيمة أمراض مهددة للحياة. والمقارنة, على حد سواء, بين الصحة وطول معدل الأعمار في العالم الغني, والكثافة السكانية في العالم الفقير.
إن الهدف الرئيسي لهذا الكتاب هو أن نضع مجموعة التغيرات في الطب ضمن سياقها التاريخي. حيث تتبعنا تطور الطب منذ عهد اليونان القديم، العهد الذي ولأول مرة وضع الطب وفقاً على أسس منطقية وعلمية، ثم درسنا التغيرات الطبية التي صحبت عصر النهضة والثورة العلمية التي قدمت الطب جنباً إلى جنب مع الانتصارات في الفيزياء والكيمياء. كما أخذنا بعين الاعتبار الإسهام البارز لطب القرن التاسع عشر من خلال إنجازاته في الصحة العامة، وعلم بيولوجيا الخلية، وعلم الجراثيم، وعلم الطفيليات، والتعقيم، واستخدام التخدير في العمليات الجراحية، وغيرها من العديد من الإسهامات الكبيرة في الطب والتي كانت في بدايات القرن العشرين مثل: اكتشاف الأشعة السينية، وعلم المناعة، والفهم الأوسع للهرمونات والفيتامينات، والعلاج الكيميائي، والتحليل النفسي.
كما سيأتي أيضاً في الفصول المقبلة، فإن هذا الكتاب يعرض فهمًا تاريخيًا شاملاً للطب لا يقتصر فقط على عرض كوكبة الانتصارات الطبية بل يتعدى ذلك إلى محاولة فهم الآثار الجانبية وغير المباشرة التي أدت إلى تطور الطب في الشكل الذي نراه الآن. لماذا اتخذت هذه التطورات هذا المنحى عوضاً عن ذاك؟ يدرس هذا الكتاب أيضاً العلاقات المتداخلة بين الجانبين النظري والتطبيقي من الطب، والعلوم، والشفاء، والطبيب والمريض ليحلل العلاقة بين التوجهات العامة والأشخاص المؤثرين. وأخيراً، يطمح الكتاب لإزاحة الستار عن التفكير خلف الأنظمة الفسيولوجية والعلاجية للماضي.
(تاريخ كامبريدج للطب) يحاول أن يذهب إلى ما هو أبعد من سرد قصة تطور الطب وتفاعله مع العلوم والمجتمع، فهو يهدف – من خلال التحليل التاريخي – إلى وضع الطب تحت المجهر ووضع الأسئلة حول القوى التي أسهمت في تطوره خلال قرون مضت حتى اليوم. من يتحكم بالطب؟ هل تم تشكيله وفقاً للمصادر المتاحة أو الحاجة أم بالمال والسوق؟ هل استطاع الطب أن يستجيب إلى تطلعات وحاجة المرضى؟ كيف كانت وظيفة السياسة في تمويل وإدارة الشفاء؟
يطرح هذا الكتاب العديد من الأسئلة حول الآثار السياسية والمجتمعية للطب. إذا ما أخذنا بالاعتبار أن الشفاء هو المهمة الأساس للطب، فهل كانت هناك – كما يزعم النقاد – أي أجندة خفية له؟ انضمام الأطباء والعلماء الألمان، مثلاً، للقوات النازية من خلال التجارب اللاأخلاقية والمميتة وإدارة غرف الإعدام بالغاز في معسكر “أوشفتيز” وأماكن أخرى. رغم أن هذا الشيء لا ينكر وجود العديد من الأطباء والممارسين الصحيين الأخلاقيين وخصوصاً ما بعد مأساة الحرب العالمية الثانية ودور الأطباء البارز في الحركات الإنسانية خلال الخمسين سنة الماضية بما فيها إقامة الحملات الداعية إلى نزع السلاح النووي ونبذ التعذيب.
إن إثارة الأسئلة حول أهداف الطب أمر ذو أهمية وذلك لسبب بسيط، فنحن إذا ما أردنا أن نعرف مستقبل الطب والاتجاهات التي سيأخذها، من الواجب أن نكوّن نظرة تاريخية دقيقة إلى من ساهم في صنع الصورة الحالية للطب. على الرغم من التقدم الهائل إلا أن هناك جو عام من القلق والشك يجتاح الطب. حيث اختفى ذلك التفاؤل الذي كان في ستينيّات القرن الماضي، وذهب شعور النشوة جراء اكتشاف البنسلين، وزراعة القلب، وأطفال الأنابيب. في الوقت الحالي هناك الكثير من المخاوف من القوى الغريبة للطب في ظل انتشار الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية. هل هذه التطورات في الطب ستجعله بعيداً عن متناول أيدي العديد من البشر؟
أما الآن، وبعد أن تغلب الطب على العديد من العقبات فإنه ما يزال أكثر عرضة للانتقاد. فعلى سبيل المثال، إن المضاد الحيوي المعروف بـ “الثاليدومايد” عُرف بآثاره الضارة على الإنسان مسبباً العديد من الأمراض التي هي ذات أساس طبي.
ففي بريطانيا، أضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ألعوبة بيد السياسيين، وتواجه الآن الانحلال والتفكك في إدارتها. في الولايات المتحدة، يهدد التأمين وفضائح الدعاوى القضائية المهنة الطبية. وفي الدول الغنية ما زال الفقراء والمحتاجين يتلقون خدمة صحية رديئة. أما الدول النامية ولغياب الإرادة العالمية في إنقاذ الموقف، فإن الملاريا والأمراض الموسمية لا زالت مستشرية. وتشهد دول ما عُرف بالاتحاد السوفيتي طفرة جديدة للديفتريا والدرن بعد أن أُعتقد أنه تم التغلب عليها. وليس أخيراً، انتشار وباء الإيدز الذي دمر أي اعتقاد ساذج حول تغلب الطب على المرض.
إن الطب في أزمة حقيقية، أولاً، كثمن للتطور والتوقعات اللامنطقية التي صنعتها أدوات الإعلام، وثانياً، بسبب أفعال الممارسين الصحيين. يبدو أن الطب قد فقد البوصلة أو بحاجة إلى إعادة تعيين أهدافه. ففي عام 1949م، وفي مقال في المجلة الطبية البريطانية سأل الطبيب الشهير لورد هوردير سؤالاً حيث قال: إلى أين أيها الطب؟ ولقرون عدة ولبساطة مهنة الطب، لم يكن هناك أية انتقادات كبيرة. كما يشير إدوارد شورتر في الفصل الرابع من هذا الكتاب إلى ما أسماه الأيام الخوالي السيئة والجيدة في الوقت نفسه؛ حيث كانت الحياة بسيطة والناس لم تكن تتوقع الكثير من الأطباء، فيرضون بذلك بالقليل، بلا شكوى من المرضى.
كان الطب مهنة بلا هيبة كبيرة ولم تكن له أية نفوذ، الأمر الذي بدأ بالتغير لاحقاً، ففي القرن العشرين بدأ الطب بالحصول على بعض السلطة وأصبح مكلفًا للغاية. وهذا الصعود جلب معه العديد من الانتقادات، وأصبح الطبيب يُنظر إليه كجزء من السلطة أو الحكومة.
الطب – كما يبدو – أضحى سجين نجاحه، فبعدما استطاع التغلب على العديد من الأمراض الفتاكة وأثبت قدرته على إيقاف المعاناة والألم، أصبحت أهدافه مشوشة وأقل وضوحاً من ذي قبل. ما هي أهداف الطب؟ متى يقف عن التطور؟ هل هدفه الأوحد هو المحافظة على حياة الناس أطول مدة ممكنة؟ أم أن هدفه جعل الناس يعيشون حياة صحية؟ أم أن الطب لا يعدو كونه مهنة خدمية همها تلبية رفاهية عملائها على غرار ما تفعله عمليات التجميل.
العديد من المشاكل يمكن تجاوزها في هذه الحالة بمساعدة العرف والنية الحسنة والأخلاق العامة. ولكن من يتحكم بالتوجهات التي قد يتخذها الطب في بقية أنحاء العالم؟ ففي الوقت الحالي – على الأقل في الدول الغنية – قد أتم الطب أغلب أهدافه التي رسمت من قِبل أبقراط ووليام هارفي. فمن يحدد مهامه الجديدة؟ وفي هذه الحالة، لا بد للتنبيه العام أن ينمو على طريقة “يمكن القيام به – إذن سيقام” والطب على الطليعة، حيث أن قادة الطب مهتمين أكثر بتطوير مهاراتهم التقنية، مما له علاقة شحيحة بالقيم أو حتى بالمريض. عندما يُرى المرضى على أنهم “مشاكل” وتنخفض قيمتهم إلى مجرد عينات أو فحوصات مخبرية لا نستغرب أن يلجأ بعض الناس إلى أساليب الطب الشمولي التي تعطيهم قيمة أعلى كبشر.
مايقلق حقاً ليس نزوح كثير من الناس إلى الطب البديل، بل أن الناس اعتادوا على الطب نفسه. من المضحك أنه كلما أصبح المجتمع الغربي أكثر صحةً كان بالوقت ذاته أكثر تعطشاً إلى الطب. إن المجتمع الحالي يذهب إلى اعتبار أعلى مستويات الخدمات الطبية في نفس صف الحق السياسي والواجب الخاص. في أمريكا بالذات، حيث سياسة السوق المفتوح ، ضغط كبير تصنعه وسائل الإعلام ومهنة الطب وبعض الأشخاص لتوسيع دائرة تشخيص الأمراض القابلة للعلاج. هناك رعب يزداد كل يوم بشأن الأمراض الجديدة. يجبر الناس خداعاً على أخذ تحاليل مخبرية أكثر وأكثر رغم أنها – أي التحاليل – ليس لديها دقه يعتمد عليها بشكل كبير. نعزوا جزيل الشكر لظاهرة “الزحف التشخيصي” (Diagnostic Creep) والتي أدت إلى اكتشاف العديد من الاضطرابات، أو كما يحب بعضهم أن يقول، باختراع العديد من الاضطرابات التي بالتالي تؤدي إلى الحاجة لعلاجات باهضة الثمن والكلفة. في الولايات المتحدة، الطبيب الذي يختار ألايعالج، يجعل من نفسه عرضةً للمحاكمة بتهمة سوء الممارسة الطبية. قلق وتدخلات في دوامة الصعود. الأطباء والمحامون وشركات الأدوية يقومون بعمل حسن حتى وإن كان المريض لا يتحسن. الطب يخرج عن مساره الطبيعي بشكل مستمر.
لكي نفهم جذور المشكلة، بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في غيرها، علينا فحص هذه العناصر على ضوء التغير التاريخي. المشكلة متوطنة في نظام تضخمت فيه المؤسسة الطبية في مواجهة قومٍ أكثر صحةً بسببه. حيث أن الطب تدخل حتى في أحداث الحياة الطبيعية كانقطاع الطمث لدى النساء في سن اليأس. تغيّرت المخاطر إلى أمراض. وبدأنا نعالج شكاوي طفيفة بعمليات باذخة. الاطباء والمستهلكين ،كلٌ بطريقته، صاروا ملهوفين بفكرة خيالية تجمع صنع القلق مع الكمال التقني: كل شخص عنده خطب ما، كل شخص يمكن أن يُشفى. النجاح الطبي قد يخلق لنا وحش فرانكشتاين، وهو ما أسماه أحد نقاد الطب الحديث إيفان إليتش(Ivan Illich)، “تطبيب الحياة”. عرض هذه المشاكل لا يعني أننا ضد الطب أو أنه انتقام فض لانتصارات الطب المتكررة، إنما ببساطة إدراك للقوة الطبية التي تنمو على نهجٍ ليس بدون مسؤولية ولكن مع تذويبٍ للأهداف. حتى وإن كان هذا أجمل عصور الطب إلا أنه أيضا قد يكون فجر معضلاته.
لقرون كان الطب واهناً وبالتالي لم يكن قادراً على صنع المشاكل. من الإغريق وحتى الحرب العالمية الأولى، كان عمل الطب بسيطاً: مكافحة الأمراض المميتة والإعاقات الظاهرة، التوليد وتخفيف الآلام. كان الطب يقوم بهذه المهام بنجاح ضئيل. اليوم ، مع اكتمال المهمة، مسيرة نجاحات الطب تهتز وتتوه. المهمة التي تواجه الطب في القرن الحادي والعشرين ستكون إعادة تعريف حدود الطب مع قدرته التي تتوسع باستمرار.
انتصارات الطب الحديث ومحنه لايمكن أن تفهم إلا بإطار تاريخي. هذا أن الفهم يجب أن يكون معتمدًا على قدر من العلم. في كثير من الأحيان تجد موضوع نهضة الطب مشروحاً بطرق ورسومات كاريكاتورية أبسط من اللازم في العديد من الكتب والمجلات. على سبيل المثال الطبيب الأمريكي الشهير لويس توماس (Lewis Thomas) كتب مرة: لم يكن تاريخ الطب مادة محببة في التعليم الطبي، أحد الأسباب الداعية لذلك; أن تاريخ الطب بائس بشكل لايصدق … نزيف وتطهير وحجامة. إعطاء سوائلٍ من كل نبات ومحاليل من كل معدن. استخدام كل أنواع الحمية بما في ذلك الصوم الكامل. كل هذه الأشياء كانت مبنية على أغرب الخيالات لسبب المرض، الذي بدوره يستنتج من فراغ. هكذا كان تراث الطب حتى ماقبل قرن بقليل من الآن.
يمكن لأحدنا فهم المشاعر التي تخفيها جملة البروفسور توماس. لكن نظرته للتاريخ سيئة للغاية: ستجد في هذا الكتاب أن كل جملة قالها غير صحيحة. إن جعلنا من تاريخ الطب صورة ساخرة زائفة، حتى وإن كان هذا تبسيطاً أكثر من اللازم، كيف لنا أن نفهم اتجاهات العمل الطبي اليوم؟ أحد أهم الأهداف لهذا الكتاب هو خلق فهم أن الطب كان ومازال يعيد صناعة نفسه، يدحض اعتقاداته القديمة، يبني على ماضيه، يصيغ آفاق أخرى ويعيد تعريف أهدافه. من أحد الجوانب، بالطبع كان الطب ومازال حول شيءٍ واحد: شفاء المريض. لكن ما أورثه ذلك إبداعياً وتنظيمياً وعلمياً وإنسانياً كان دائماً (كما سترى في هذا الكتاب) في طور التغيير.
يتحتم علينا بعض الإيضاح. فهذا الكتاب لايعرض تاريخ الطب في جميع أنحاء العالم. فبعض المواضيع، كالعناية الأولية والجراحة والطب النفسي، يعرض فيها بعض التفاصيل أكثر من غيرها كطب المناطق الحارة وطب الأسنان والقانون الطبي والعلاجات التكميلية. وهذا الكتاب في جوهره يعرض جذور الطب ونهضته والوضع الحالي لأشهر التخصصات في الطب الغربي، أو كما يسمى بالطب العلمي. ولم نتطرق إلا للقليل عن الأنظمة الطبية للمجتمعات القبلية ولم نضع فصولاً عن الطب الصيني أو الطب الإسلامي أو الطب الهندي (أيورفيدا) أو أي من الأنظمة الطبية التي ازدهرت في آسيا. وإهمالنا لهذه التقاليد الطبية ليس رأياً منا بعدم أهميتها.فهذه الفصول ضحينا بها للتركيز والترابط بين عناصر الكتاب. واخترنا بالمقابل فحص الجذور التاريخية للطب العلمي الغربي والذي، بشكل أو بآخر، يهيمن على العالم الآن. فالجواب على سؤال (لماذا هيمن هذا النظام الطبي الغربي على العالم؟) سيكون في هذا الكتاب.
نعيش اليوم في لحظات هامة للطب، ومليئة بالشكوك. فخلال القرنين الماضيين، وبالتحديد خلال العقود القريبة، لم يشهد الطب نهضةً قوية وناجحة مماثلة. ومع ذلك يزداد القلق الداخلي الشخصي والنقاش بين العامة بخصوص الطرق التي يسلكها الطب. فتلك المفارقة التي تتضمن (صحة أفضل وحياة أطول لكن قلقًا طبيًا أعظم) من الممكن أن تفهم، إن لم تحل، من خلال الآفاق التاريخية المعروضة في هذا الكتاب.
ترجمة: خالد البدراني، وليد المطيري، صالح القريان


