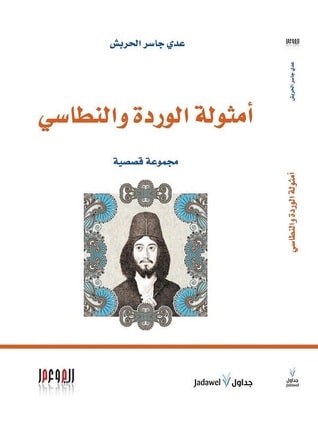
يمكنك شراء نسخة كندل من الكتاب عبر هذا الرابط
«وها هنا زعترٌ جبلي، إنه للذكرى؛ أرجوك يا حبيبي: تذكر!»
(ويليام شكسبير)
الوردة والنطاسي
(1)
في غُرّة شهرِ محرم عام اثنين وستين وستمائة للهجرة، صدرَ مرسومٌ سلطاني من جهةِ جبلِ المقطّم، وبختمِ السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري، يحذرُ من الاجتراء على تدنيس القبور، وانتهاك حرمة الأموات، ويتوعدُ بالجلدِ والحبسِ كلَّ من سوّلت له نفسه خلافَ ذلك. لجّ العامةُ بالحديث عن سببِ صدورِ هذا البيان، واستغربوا ما جاءَ في متنه، إلا أن المجرّب منهم علمَ أن للمرسوم علاقة بالشكوى المرفوعة من قبل أعيان التجار اليهود القاطنين أسفل باب النصر، والذين لم يعد بإمكانهم الصبر أكثر على الانتهاك الخفي والمتكرر للقرّافة الخاصة بموتاهم.
حرصَ رئيس الشَرطة أول الأمر أن يرسل كوكبة من رجالهِ يحرسون المقبرة، ورغم أنه كان معروفًا بين الناس ببغضه الشديد لليهود، إلا أنه لم يكن يملك أن يعصي مرسومًا ممهورًا بختم السلطان نفسه. ولكنه - وبعدَ انقضاءِ أسبوعٍ كامل دون أن يُنبشَ قبرٌ أو تُسرق جثة – لم يسعه إلا أن يرسل رجاله نحو مناطق أخرى أكثر شغبًا وأجدى بالمراقبة؛ كباب زويلة والحجارين، وبندرة الإسلام وسويقة علي. لهذا السبب، وبعدَ أن مرّ شهر على صدور المرسوم السلطاني، لم يجد القاسمُ كبيرَ حرجٍ في التسللِ مجددًا مع أستاذه أبي الحسن علاء الدين، مُستَتِرين بجُنحِ الليل، ليعاودا اقتحام القرّافة الخاصة بيهود القاهرة.
توقفَ القاسمُ أمامَ قبرٍ يُفترض أن يكون رطبَ الثرى، ونظر إلى أستاذه أبي الحسن وكأنهُ ينتظر منه نظرة تشجيع، وعندما أومأ الأخيرُ برأسه، هوت مجرفةُ القاسم لتنبشَ أرض القبر وتقلبَ تربته. التفتَ الأستاذ يمنة ويسرة ليتثبتَ من خلو المقبرة، وعندما عاد ببصره إلى القبر، رأى المجرفةَ ترتدُ سريعًا وقد اصطدمت بتابوت. أزال القاسمُ باقي التراب عن الصندوق الخشبي، وانحنى أبو الحسن إلى الأرض ليفتحَ عنقَ جرابٍ كان يخفيه في ثيابه، وبعد أن أخرجا الجثة الملفوفةَ في أكفانها البيضاء، تعاونا على حشرها في الجراب، وانطلقا بسرعة مغادرين المقبرة، بعد أن أغلقا التابوت وأهالا التراب فوقه.
رفعَ القاسمُ الجرابَ فوقَ ظهره، وانطلق يمشي متثاقلًا تحت ظلال الحيطان، وقد تقدمه أستاذه أبو الحسن يستشرف الطريق ويتأكد من خلوه من الشرطة. كانت دار أبي الحسن في قيسارية الملقية، ولم يكن يلزمهما إلا أن يقطعا دربًا قصيرًا كي يصلا بحمولتهما المشبوهة إليها. عالج أبو الحسن قفل بابه بالمفتاح ودخل مسرعًا، وتبعه القاسمُ دون أن ينتظر إذنًا أو إشارة، فلقد كان يعرفُ الدار جيدًا، وخصوصًا تلك الغرفة الشرقية الخاصة بأبحاث أستاذه ذات الطبيعة الشائكة.

ألقى القاسمُ الجثةَ على طاولةٍ خشبية تتوسط الغرفة، وسحب الجراب، وأزال الأكفان، فإذا بوجه اليهودي المتصلّب يستقبلهما، بعينين غائرتين، وفكٍ ملتحٍ مائل. أقفل أبو الحسن باب الغرفة، وسارع إلى إحدى الزوايا، ليخرج منها أدواته العديدة من مشارط ومبارد وكلاليب. اعتلى أبو الحسن الطاولة الخشبية، وشمّر عن ذراعيه، وأمسك بمشرطٍ مدبب النهاية، ليغرزه في صدر الجثة، وليحفر خطًا مستقيمًا، يمتدُ طوليًّا من الترقوةِ اليسرى للجثة حتى سرتِها، بامتداد عظمِ القصّ. ناول القاسمُ أستاذهُ مقضًّا ومطرقة، ليبدأ الثاني الحديث بينما يداه مشغولتان بتحطيم عظام الجثة:
«ابنُ سينا كان عظيمًا، ليس في ذلك شكّ. لكني آخذ عليه أنهُ تقبّلَ نظرية جالينوس بخصوص الثقوب الموجودة بين حجرتي القلب. باللهِ عليك، أخبرني: كيف يمكن لفتحاتٍ غير مرئية، متناهية الدقة، متناهية الصغر، أن تنقل كل الدم الجاري في عروقنا في زمان نبضةٍ واحدة؟ ولو افترضنا جدلًا وجودها، ما الذي يدفع الدمَ من اليمين إلى اليسار، بدل انتقاله من اليسار إلى اليمين؟ من يفحص عضلة الحجرة اليسرى للقلب، سيلاحظ تضخمها مقارنة باليمنى، وهذا يدل على أن القوى الموجودة داخلها أكثر من تلك الموجودة باليمنى كثيرًا. ألا يجدر بالدم إذن أن ينتقل من اليسار إلى اليمين، وهو ما يبطلُ نظرية جالينوس، ويجعل ثقوبه غير الموجودة عديمة جدوى!»
توقفَ أبو الحسن عن الحديث، وأشار إلى القاسم كي يُنشبَ الكلاليب بجلدِ الكوةِ المفتوحة في صدر الجثة. تصببتْ جبهته عرقًا حين استروح الرائحة العفنة المتصاعدة من أحشاء الجثة. تناول بيمناه المشرط مجددًا وشقّ بسرعةٍ تامور القلب، وكم كانت خيبتهُ هائلة وهو يرى انحلال عضلات القلب وامتلاءها بالقيحِ والصديد.
نزلَ أبو الحسن عن الطاولة وأرجع مشرطه وهو يتمتم بضيق:
«ألم تخبرني أن صاحب الجثة مات حديثًا؟».
«هكذا أخبرني سمعان اليهودي! كما أن تراب القبر حين عايناه كان رطبًا!».
«هذا لا يجدي يا قاسم. لا أملك وقتًا أضيّعه».
«الأمر ليسَ بهذه السهولة، وخصوصًا بعد صدور المرسوم السلطاني. لا أستطيع أن أطوف في أحياء اليهود سائلًا إياهم بوجه بارد إن كان أحد منهم مات حديثًا أو أن جنازة ستنطلق غدًا! سأثير الريبة لا محالة».
سادَ الصمتُ الغرفة لحظات، وبدت علاماتُ الندم فوق وجه الأستاذ بسبب الحدةِ التي أبداها تجاه تلميذه. تناول القاسم عنق الجراب، وعاون أستاذه في رمي كومة الجسد المبقورِ الأحشاءِ داخلَه.
«سأغري سمعان اليهودي بمزيدٍ من النقود. أنا متأكد أن الذهب سيجعله أشد حرصًا وأسرع مبادرة بإخبارنا عن الجثث الجديدة».
ربّتَ أبو الحسن على كتف تلميذه، وساعدهُ في وضع الجراب المربوط على ظهره، وبعد أن قاده إلى فناء الدار، أقفل الباب خلفه، ليستأمنه على دفن الجثة في الحديقة الخلفية للمنزل.
سارَ أبو الحسن إلى الجهة الغربية من المنزل، حيثُ غرفة نومِه، وعندما اقتربَ من بابها، سمع صوتَ فاطمة:
«أهذا أنت يا عليّ؟».
ابتسمَ أبو الحسن برقة، ودخل الغرفةَ بوجهٍ متهللٍ بشوش، وكأنه لم يأت للتوّ من المقبرة، ولم ينهشْ جثةَ ميتٍ بمشارطهِ وكلاليبه. قبّل أبو الحسن رأس زوجته الهزيلِ الشاحب، ومسحَ بأصابعه العرقَ المتفصّد من جبينها.
«هل كنتَ بصحبة القاسم؟».
أومأ أبو الحسن بالإيجاب.
«صرت تلازمهُ كثيرًا! احذر أن تخصّه بالحظوة، فتوغر بذلك صدور باقي التلاميذ».
«حُقّ للمبرّزِ أن يلقى من الاهتمام ما يماثل جهدَ طلبِه».
«هكذا أنت دائمًا، تريد الناسَ جميعًا أن يكونوا مثلك. كيف هو الجو بالخارج؟».
«ما زال باردًا».
«هل تنام معي الليلة؟».
«وكل ليلة».
انحنى أبو الحسن ليطبع قبلة ثانية فوق خد زوجته، ثم مشى وإياها إلى سريرِ نومهما. أبدل أبو الحسن ثيابه، وعندما رجع، وجد زوجته تغطّ في نومٍ عميقٍ هادر. كان صدرها يعلو ويهبط في صعوبةٍ مع كل نفسٍ تجترؤه. وضع أبو الحسن سبابته ووسطاه فوقَ معصمها، ثمّ اقترب بأذنه نحو صدرها محاولًا سماع دقات قلبها دون أن يوقظها. وبعد أن فرغ؛ أخذ يتأمل وجهها المُحببَ التعِب في حزنٍ وإشفاق.
استلقى أبو الحسن على ظهره، وأسلم عقله للأفكار التي تنتهبه عادةً في هذا الوقت المتأخرِ من الليل. تبًّا للحمى اللعينة! يصارعها ويطفئها أنّى كانت، ثم تأبى إلا أن تهاجمه في عقر داره، وتختار أعزّ الناس عليه، فتصيب قلبها بهذا الضعف الذي يجعله يهدرُ تحتَ راحة يده، وتسبب مشقّة نَفَسِها، وانتفاخَ بطنِها، وتورمَ أطرافِها. لو استطاع أن يحلّ لغز جالينوس، أن يثبتَ خطأ نظريته، أن يفهم تشريح القلب وطريقة نبضه وسببها، حينها، لربما استطاع أن ينقذ أعزّ الناس عليه، أن يشفيها من علتها، أن ينجب منها ذرية وعيالًا، أن يعيش معها ولها، ما أمكنهما أن يعيشا معًا.
عندما أغمض أبو الحسن عينيه رأى حلمًا غريبًا: لقد كان يمسكُ بين أصابعه وردةً حمراء قانية. كان كل ما حولَها ظلامًا. وضع الوردة الحمراء على الطاولة. تناولَ مشرطه الباردَ المدبب، وبدقةٍ متناهية، رسمَ شقًّا دقيقًا غائرًا، يجري عاموديًا من عنق الوردةِ حتى جذرِها. من هذا الجرحِ؛ أخذتْ قطرات من الدم القاني تتفصدُ تباعًا، وتنسكبُ لتتشربها مساماتُ الطاولة الخشبية.
(2)
هذه المرة؛ كانت تربةُ القبرِ رطبةً حقًا!
أخذت الريحُ المعوِلة تنفخ من الجهة البحرية، وتدفعُ بالخرقِ والقوارير في كلِ اتجاه، وكأنها مكنسة كونية. نظرَ أبو الحسنِ إلى البدرِ المتلألئ في السماء بقلقٍ، هذا النور الفضي سيحرمهما ثوب الظلام الذي اعتادا الاستتارَ تحته. أخرجَ أبو الحسنِ الجرابَ من ثيابه، بينما أخرجَ القاسمُ مسحاته، وما كاد يضربُ بها جوفَ الثرى، حتى سمعا صراخًا صادرًا من شمال المقبرة، ليُتبع سريعًا بأصواتِ أقدام وخطوات.
لم يحتج أبو الحسن ولا القاسم إلى التريثِ مكانهما كي يتأكدا من هوية الرجال الساعين نحوهما. إن أي تريثٍ كان كفيلًا بإيقاعهما في قبضة الدرك، هما اللذان يحفظان المرسوم السلطاني عن ظهر قلب، ويدركان أن من قُبض عليه بالجرم المشهود، ويداه معفرتان بالتراب، سيكون مصيرهُ الجلدَ أو الحبسَ، أو كليهما، دون ريث أو شفقة.
انطلق الرجلانِ هاربين غربًا باتجاهِ سويقة علي، وعندما وصلا ساحتها الخالية، سلكا طريقًا شماليةً تقودهما إلى القيسارية عبر زقاقٍ غير مأهول، إلا أنهما عند وصولهما آخرَ الزقاق، إذا بهما يقفان أمام حائطٍ عالٍ يسدُ طريقهما. نظرَ أبو الحسن بقلقٍ باتجاهِ فم الزقاق. استطاع أن يستخلص من الريح أصوات الأقدام وهي تقترب. أشار بعنقه إلى الحائط، ليقوم القاسم بعقد أصابعه شابكًا بينها، منتظرًا قدم أستاذه الحافية، وما إن قفز أستاذه، حتى دفع بهِ فوقَ الجدار. تشبّث أبو الحسن بأظفاره بالحائط، ثم استخدم عضلات ذراعيه الضعيفة كي يدفع بجذعه إلى الأعلى، وما إن امتطى الحائط بفخذيه، حتى تدلّى بجذعه إلى أسفل نحو تلميذه، الذي تعلّق بيد أستاذه وقفز بسرعة، ليمتطي هو الآخر جرفَ الجدار.
كانت أصواتُ الشرطة تزدادُ قربًا. كل ما عليهما فعله الآن، هو القفز من الحائط، حيثُ الجهة الشمالية، حينها سيفقد رجالُ الشرطة أثرهما، وسيسيران بضعة أمتارٍ إلى أن ينتهيا إلى موضع دارة أبي الحسن. أشارَ أبو الحسن إلى تلميذه كي يقفز، إلا أن الخوفَ بدا واضحًا في وجه القاسم، خصوصًا بعد أن لاحظ عمق الهوة الموجودة شمال الحائط. عندما لاحظ أبو الحسن ترددَ تلميذه، أغمض عينيه، ورمى بجسده من فوقِ الحائط، ليهوي على ذراعه اليمنى، كومة واحدة، فوقَ أرض الزقاق.
عضّ القاسم على شفتيه، وحاولَ أن يستردّ جأشه، خصوصًا بعد أن رأى أستاذه يقفُ سالمًا معافىً أسفل الحائط. أغمض عينيه، وملأ صدرهُ بالهواء وكأنه يهمُ بالقفز وسط البحر، وعندما قفز، هوى إلى الأسفل رأسًا على عقب، لتصطدم جمجمتهُ بأرض الزقاق، ولتندقَّ عنقُه.
وقفَ أبو الحسن مصعوقًا فوقَ جسد تلميذه، متأملًا الدمَ المنهرقَ من جمجمته. أيعقلُ أن مات؟ انحنى فوقه، وتحسسَ بأصابعه أخدعَه، ولكن هناك، حيثُ كان الدمُ يجري قبل دقائق، لم يجد سوى هدوء موحش أشبه بهدوء الليل. أيعقل أن يموتَ رجلٌ بهذه السرعة؟ ابتعدَ أبو الحسن بقدميه عن الجثة، وأخذ يسير كالسكران نحوَ داره، لكنه توقف فجأة، وقد اتسعتْ عيناه، وبعد ترددِ ثوانٍ، رجع على أعقابه نحو الجثة.
انحنى أبو الحسن على القاسم وأمسك بتلابيبه. رفعه بصعوبةٍ فوق ظهره. أخذ يسيرُ مترنحًا باتجاه منزلِه. لم يعد باستطاعته أن يسمع أصوات صرخات الشرطة ولا وقع أقدامهم. لا بدّ أنهم فقدوا أثرهما بعد أن انتهوا إلى الزقاق المسدود. حتى الريح الشمالية توقفت عن اللعبِ بالمِزقِ والقوارير. كان الشيء الوحيد الذي يدوي في أذنيه هو صوت نبضات قلبه. أحسّ بالاطمئنان عندما لمحَ جدران منزله في نهاية الزقاق. تمطى بظهره، وابتلع ريقَه، وأخذ يسرع في خطوِه، علّه يبلغ موضع الأمن قبل أن تدهمه الشرطة.
ولكنهُ، عندما وصل بابَ دارهِ، كاد أن يُسقِطَ حملهُ من الذعر! هناك، أسفلَ عتبةِ داره، وتحتَ ضوءِ القمر، كانت تنتصبُ وردةٌ حمراء، حمراء قانية! لم يسبق له أن رآها أسفلَ عتبة داره من قبل. لم يسبق له أن رآها سوى مرةً واحدة: في حلمه.
استعاذ أبو الحسن من الشيطان الرجيم، وسارع باللجوء إلى حرمةِ داره، حيثُ أقفلَ البابَ خلفَه. استدعى أبو الحسن ما تبقى لديه من قوة، وحمل الجثة إلى غرفة أبحاثه الشرقية، وألقاها بنصَبٍ على الطاولة. لقد كانت ظلال الموت تمتدُ ببطءٍ فوقَ وجهِ القاسم، وكأنها ظلالُ خسوف القمر.
عاد أبو الحسن إلى باب داره، وفتحه ليتفقد عتبة منزله، وعندما لم يرَ دمًا ولا خطوطًا يمكنُ أن تدُلَّ عليه، حمد الله، وهم بإقفاله، لولا أن تذكر الوردة الحمراء القانية. انحنى أبو الحسن نحو الوردةِ وقطفها بعناية من جذرِها ورفعها نحوَ أنفِه. كان شذاها يبعث الخدرَ في النفوس ويختلطُ بهواء هذه الليلة الباردة فيزيدها رهبة. فجأةً، سمعَ أبو الحسنِ صوتًا واهنًا ينبعثُ وراءَ ظهره:
«علي! أهذا أنت؟».
التفتَ أبو الحسن وراءه وقد تذكر زوجته المستلقيةَ عليلةً فوقَ الفراش. أسرع بإقفال باب الدار، وقد زايلهُ الخدر، وانطلقَ قاصدًا حجرةَ نومهما.
على طرفِ الفراش، كانت فاطمةُ تجلسُ، وقدماها بالكاد تلمسان الأرض. أحسّ أبو الحسن بفيضِ حبٍ وهو يرى قدمي زوجته الصغيرتين، ولم يملك إلا أن ينحني على إحداهما ليقبلها. تورّدت وجنتا فاطمة الشاحبتان بلونٍ غير مألوف. تمتمتْ بصوتٍ أجشّ:
«ما هذا في يدِك؟».
رفعَ أبو الحسن الوردةَ باتجاه زوجته، وتمتمَ هو الآخر بصوتٍ متحشرج:
«وردة! قطفتها لكِ».
التمعت عينا فاطمة وهي ترى هذه المخلوقة اللطيفة بين يدي زوجها الخشنتين، وهي التي لم يسبق لها أن شاهدت فيهما سوى المشارط والمبارد والكلاليب. انحنت بجسدها المتعب نحوَ الوردة، وأمسكت بها من عودها بكلتا يديها، وكأنها تخشى أن تتلفها، أو أن تسقطها على الأرض.
حدّق أبو الحسن في عيني زوجته اللامعتين، المكان الوحيد الذي لم تمتد يدُ المرضِ لتغيرَه، ثم نظرَ إلى خصلات شعرها المتدلية فوق كتفيها، وإلى يديها الصغيرتين، الممسكتين برقةٍ عنقَ الوردة، ثمّ أشار إليها كي تناوله الوردة، واعتدل على قدميه، ليضعها أخيرًا في صدغ زوجته، بين طياتِ شعرها المحبب.
«ها هنا أجمل!».
قالَ ذلك، ليستدير على أعقابه قاصدًا بابَ الغرفة.
«إلى أين تذهب؟».
«غرفة درسي».
«ألن تنام معي؟».
«ليسَ بعد. أمامي عملٌ كثير يلزمني الفراغ منه».
اتجهَ أبو الحسن إلى الغرفة الشرقية، حيثُ كانت جثة القاسم، ليقفلَ البابَ بإحكامٍ خلفَه. هذه المرة، لم يُلقِ ولو نظرة واحدة باتجاه وجه القاسم. اتجه إلى الزاوية التي يحتفظ فيها بأدواته، وبعثرها بسرعة على الطاولة، ثمّ شمّر عن ذراعيه، وهو يرى في مخيلته القلب الطازج، يتحللُ كل دقيقةٍ في صدرِ تلميذه.
أمسكَ مشرطه البارد بإحكام، وانحنى بظهره الموجوع نحو الجثة، وعندما لامس بمعدنهِ جلدَها الشاحب، سمعَ صوتَ طرقٍ عنيف ينبعث من باب الدار، ويملأ فضاءَ الحيّ والدارِ معًا.
ألقى أبو الحسنِ المشرطَ برعبٍ من يدِه. في الخارج؛ تتابعَ الطرق. لم يكن أبو الحسن يملك الوقتَ الكافي لإخفاء الجثة، ولا حتى التفكير في كيفية إخفائها. سارعَ إلى ركنٍ من أركان الغرفة، وتناولَ من هناك غلالة بيضاء، أسبلها فوق الجثة والطاولة والأدوات. عندما فرغ، غادر غرفة درسه، وأقفل بابها مرتين، ثم استجمعَ شجاعته، واتجه نحو باب الدار كي يجيب الطارق.
عندما فتحَ الباب، كانت وجوهُ ثلاثة من رجال الشرطة تطلُ من أعلى بملامحهم الخشنة. ظلّ أبو الحسن واجمًا مكانه، لا يريمُ حراكًا، وكلما همّ بالحديث، تمنعت عليه الكلمات. في الأخير تمتم بصوتٍ بالكادِ يُسمع:
«ماذا تريدون؟».
«آثار دماء تؤدي إلى دارك».
«دماء!».
«لن نشغلك طويلًا. سنتفقد غرفكَ بالداخل ثم ننصرف».
أفسح أبو الحسن الطريق لهم وهو يحسّ بإعياء يسري في ساقيه. لو أنهم وصلوا إلى الغرفة الشرقية، حيث الجثة ممدة على الطاولة، ستكون نهايته. يجبُ عليه أن يتمالك جأشه كي لا تخونه رعشة أو تدل عليه كلمة، وأن يسعى إلى تضليلهم وإبعادهم عن مكان الجثة ما أمكنه ذلك.
«ما هذه الغرفة؟».
«غرفة منامي وزوجي».
«هل يسكنُ في الدار أحدٌ غيركما؟».
«لا أحد».
قال ذلك، وهو يراقبُ بتوجسٍ خطواتهم الكسولة تبتعدُ ببطءٍ عن الغرفة المقفولة وعن الجثة. توقفوا عند الباب الرئيسي، وأخذ أحدهم يعتذر لأبي الحسن بسبب إزعاجهم إياه وسط الليل، لكن الرعبَ سرعان ما زلزل قلبه وكاد أن يتلفَه عندما دوّى من الجهة الغربية صوت مألوف، كان يمكن لهُ أن يتهللَ فرحًا لسماعه في أي وقتٍ، عدا هذا الوقت:
«ماذا يجري يا علي؟».
امتقع وجهُ أبو الحسن بصفرةٍ تكاد تشبهُ صفرةَ الموت.
«كنتُ أحسبُ أن زوجتكَ تنامُ في الجهة الأخرى من الدار!».
سقطَ أبو الحسن على ركبتيه، ومال برقبته إلى الأرض، وعندما فعل، لاحظ آثار دماء تملأ بلاط داره، وتتحلق حولَ الموضع الذي سقط عليه وكأنها دوائر بطليموس الفلكية.
(3)
هناكَ أساطيرُ كثيرةٌ تدور حولَ قلعة الجبل؛ المكان الذي أراد السلطان الناصر صلاح الدين أن يبنيه كي يكون حرزًا له وحصنًا حصينًا يقيه شرّ الفاطميين في الداخل، والصليبيين في الخارج. إحدى هذه الأساطير تزعم أنّ قراقوش كي يبني القلعة، أمرَ بهدمِ أهرام الجيزة كي يستخدم أحجارها، وأنه استعمل لبنائها خمسين ألفًا من أسرى الإفرنج والصليبيين. أسطورة أخرى تزعمُ أنّ صلاح الدين أمر بتعليق اللحم النيئ في شوارع القاهرة، ففسد ليلته، ولكنه عندما علقه في موضع الجبل، بقي أكثر من يوم وليلة، فكان سببًا لاختيار المكان. إذا كانت هذه الأسطورة صحيحة، فهي تؤكد نقاء هواء الجبل إذا ما قورن بهواء الفسطاط والقاهرة. هذا الافتراض لا يمكن أن ينطبق على جميع دهاليز وأبراج القلعة، وخصوصًا سراديبها التي كانت تُستخدم لحبس المساجين. في هذه القلعة: حُبس أبناء العاضد الفاطمي كي لا ينازعوا صلاح الدين ملكَه. في هذه القلعة: وثب غلمانُ شجرة الدرّ على الأمير عز الدين أيبك وهو يسترخي عاريًا في حمامه وقتلوه، ثم عُذب نفسُ الخدم جراء صنعتهم في الدهاليز السفلية حتى اعترفوا بجريمتهم النكراء ثم قتلوا. في نفس هذه القلعة، في دهاليزِها السفلية الفاسدةِ الهواء: حُبس الطبيب أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي الدمشقي المُلقب بابن النفيس، بعد أن عثر رجال الشرطةِ على جثة شابٍ عشريني، يستلقي بلا حراكٍ فوقَ الطاولة الخشبية.
في الليلة الأولى، أخذ أبو الحسن يقرع باب السجن بكل قوته حتى أدمى قبضتيه. أخذ يصرخ مؤكدًا أنه بريء من جرم القتل، وأن الجثة التي عثروا عليها كانت ميتة أصلًا، وأن زوجته العليلة بحاجة إلى تواجده، لكن لا آذانَ للحرس ولا للجدران. في الليلة الثانية، سقط أبو الحسن عليلًا بسبب هواء الحبس الفاسد، وأخذ يبكي وقد أحسّ بالضعف والعجز. في الليلة الثالثة، بدأ أبو الحسن يفكر بالاحتمالات المترتبة على فعلته: ماذا سيجري لفاطمة؟ هل أفاقت لتجد جثة القاسم ملقاة على طاولته؟ هل أزال رجال الدرك الجثة ودفنوها قبل أن تراها؟ ماذا قالوا لها؟ كيف فسروا اعتقاله وحبسه؟ من سيعتني بها الآن؟ وهل ستسامحه؟ لقد فعل كل ذلك لأجلها. كي يكتشف الحقيقة التي من شأنها أن تساعده في إيجاد شفاءٍ لها. الأحياء أولى بالبرِ من الأموات. الشاة الميتة لا يضرها السلخ، ولكن من سيفهمُ ذلك؟ من سيفهم؟
في فجر رابع يومٍ انصرم مذ حبسِه، تقدم السجّان من الباب الأصمّ وأعمل مفاتيحه في القفل. كان أبو الحسن ينزوي متكورًا في إحدى الزوايا وقد غيّرهُ الهزال والتعب. أشار إليه السجّان كي ينهض، وعندما تطلع أبو الحسن مستفهمًا، قالَ السجان:
«مولانا السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس يريد مقابلتك».
تحامل أبو الحسن على نفسِه وقد هفا بقلبهِ نحوَ هذا البصيصِ من الأمل، وأخذ يمشي متمهلًا وراء السجّان، ليقطعا دهاليزَ وأقبيةً مختلفة. كان نور الفجرِ الضعيف يتسلل من النوافذ المرتفعة للقلعة. وكانت النسمات العليلة تهبُ ما بين وقتٍ وآخر من أعلى لتبدل بهوائها النقي الهواءَ الفاسد المتجمع في رئتي أبي الحسن. عندما وصلا إلى مكان المجلس السلطاني، رأى أبو الحسن السلطانَ ركن الدين بيبرس متربعًا فوق عرشه. ها هنا الرجل الأسطورة، ذاك الذي هزم الصليبيين في المنصورة، والمغول في عين جالوت، والذي لم يكن قبل ذلك أكثر من مملوك ذليل، يُباع مع باقي الخدم والجواري في سوق النخاسة. كانت عيناه الواسعتان بلون البندق، وجبهته الخشنة تجللها السمرة، وقد ارتسمت على خده الأيسر ندبة غائرة عريضة.
«أنتَ النطاسي أبو الحسن؟».
«أنا هو يا مولاي».
«سمعتُ عنكَ كثيرًا من رئيس البيمارستان الناصري. يقولون أنك أبرع أطباء الديار المصرية والشامية».
«أرجو أن أكون كذلك».
«كنتُ أنوي أن أستعملك رئيسًا على البيمارستان، أن تكون طبيبي الخاص، ولكن النبأ الذي وصلني من قبل رئيس الشرطة أزعجني كثيرًا. أخبرني يا نطاسي، ولا تتجرأ بالكذب عليّ: هل قتلت الرجل الذي وُجد ميتًا في منزلك؟».
«لم أفعل يا مولاي. لقد كان أحد تلامذتي، كان أنجبهم، ولقد كنتُ أخرج وإياه بحثًا عن الجثث الصالحة للتشريح والدرس».
«أنتَ تعلم النهيَ المشددَ الذي أصدرتهُ بخصوص نبشِ القبور».
«أعلمهُ يا مولاي. ولكن للحقيقة جذبة، وللكشف لذة، ولقد دفعاني في لحظة طيش كي أعصي أمر مولاي المعظّم».
«حدثوني أنكَ رجلُ دينٍ يا نطاسي، فكيف أبحتَ لنفسك أن تعصيَ ربك، بعد أن عصيتَ سلطانك؟».
«الشاة الميتة لا يضرها السلخُ يا مولاي».
«للأموات حرمتهم».
«الأحياء أولى بالبرّ من الأموات».
قالها أبو الحسن، وهو يفكر للمرة الألف بفاطمة. فاطمة التي تستلقي وحيدةً فوق سريرها، حيث لا أهل ولا سند.
سكتَ أبو الحسن، بينما أخذ السلطان يحدق مندهشًا في وجهه، وقد أُخذ بإصراره وتمنعه رغم حرج موقفِه. قال السلطان بعد تفكر:
«تتحدثُ عن الأحياء وكأنهم جنسٌ مختلف عن الأموات يا نطاسي. حتى الأحياء مصيرهم الموت، ولو سألتهم هل يرضون أن يُفعل بهم ما فعلته بموتاهم، لربما أجابوا بالامتناع. الأمر على أية حالٍ غير قابل للنقاش. أخبرني بباقي أمرِك، ماذا حصلَ لتلميذك؟».
«هربتُ وإياه من رجال الشرطة بعدَ افتضاح أمرنا. أثناء الهروب، اضطررنا إلى القفز من فوق حائط، هبطتُ سالمًا، بينما سقط هو على رأسِه فاندقت عنقُه. كنتُ أنوي أن أتركه ميتًا وسط الدرب، ولكني رجعتُ إليه فحملته على ظهري، وسرتُ به إلى داري».
«لا تكمل. لا أريد أن أعرف ما حدث بعد ذلك. أنتَ إذن لم تقتله!».
«لم أفعل».
«عرضي لا يزال قائمًا يا نطاسي. أريدكَ طبيبي الخاص، ورئيسًا للبيمارستان الناصري، مقابل أن تعدني أن لا تعود إلى نبش القبور وانتهاك حرمةِ الجثث».
«أنا رهنُ أمرِ مولاي».
«أنتَ حرٌ إذن. يمكنك أن تمضي».
استدارَ أبو الحسن وقد امتلأ بالبهجة والامتنان. سارع إلى الباب كي يجري إلى القيسارية، حيثُ داره وأعزّ الناس إليه، ولكن صوت السلطان تداركهُ من خلفه.
«يا نطاسي».
«مولاي!».
«عندما قلتَ: الأحياءُ أولى بالبرِ من الأموات، كنتَ تقصدُ أحدَهم. أخبرني، هل لكَ قريب عليلٌ ترجو برأه؟».
«زوجتي يا مولاي».
قالَها أبو الحسن، وهو يغادرُ عتبة المجلس السلطاني، ليتبع دهليزًا مستقيمًا يؤدي إلى خارج القلعة. عندما خرج، استقبلته النسائم العليلة التي تهبُ من جبل المقطّم وملأت أنفاسه. استنشق أبو الحسن الهواء بشغفٍ وهو لا يكادُ يصدق أنهُ حرٌ طليق؛ يمضي حيثُ يريد، ويملأ بالهواءِ النقي رئتيه متى ما يريد. مثلُ هذا الهواء يبعثُ الحياة ثانيةً وسطَ أطرافِك.
في هذه اللحظة، سقطت الحقيقة على أبي الحسنِ فتلقفها مندهشًا. الهواء! سرُ الحياة، كالماء تمامًا. لم يهبنا الله الرئتين إلا لنستنشقه ونستخلصُ منهُ ذاك الإكسير. ولكن ماذا يحصل بعد أن نستخلصه؟ لا بدّ أن مضخة الجسم تدفعُ بهِ إلى باقي الأعضاء. جالينوس يفترض أن الهواء يمازج الدمَ في القلب، ولكن هذا زعم فاسد، إذ أنه يتجاهلُ وجود الرئتين. لا بدّ أن هناك دورة أخرى، تربط القلبَ بالرئتين، كما يرتبط القلب بباقي الأعضاء عبر الأبهر. لهذا السبب يتكون القلبُ من حجرتين؛ اليمنى تدفع بالدم الفاسد إلى الرئتين، واليسرى تدفعُ بالدم الممازجِ للهواء نحوَ باقي الأعضاء. هذه هي الحقيقة! شقان طوليان يجريان بتوازٍ على امتداد عظم القصّ، وعندها سيتبين الأوعية الخفية التي تصلُ حجرات القلب بالرئتين.
عدا أبو الحسن كالمجنونِ شمالًا نحو القاهرة حتى دخلها من قبلِ باب زويلة. كانت الأفكار تتدافعُ في عقله تدافعَ الهواء في الرئتين، تدافع الدمِ في حجراتِ القلب. لقد حلّ لغز جالينوس، لقد فاقَ ابن سينا، كل ما يلزمهُ الآن هو أن يطوّر الفكرة قليلًا، أن يستغلها، أن يستخدمها جراحيًّا، كي يجدَ علاجًا لفاطمة.
عندما وصلَ دارَه أسفل القيسارية، دفعَ البابَ، فإذا بهِ ينفتحُ مجلجلًا على مصراعيه:
«فاطمة».
صرخَ أبو الحسن.
«فاطمة، وأخيرًا رجعت».


