
الفقيه والسلطان
(1)
عندما قامت الدولتان العثمانية ثم الصفوية; كانت الأمة الإسلامية قد عاشت تجربة ثقافية وسياسية طولها زهاء السبعة قرون. ومن هنا فإن الجديد لدي الأسرتين الجديدتين في الثقافة والسياسة لم يكن كبيرا. إذ وقعتا – كما يثبت الدكتور وجيه كوثراني، ضمن مواريث التقاليد التي أرسلتها الدول السلطانية السابقة، من حيث القيام والتنظيم في نطاق العصبية ومجالها، كما أوضحه ابن خلدون، من حيث الآيين والرسوم في نطاق الرؤية المتوارثة لتقاليد المُلك الساساني القديم (حسب رؤية الوزير السلجوقي نظام الملك في كتابة المعروف: سياسات نامه). بيد أن الجديد لم يكن غائبا تماما. إذ إن العصبية السياسية للدولتين حملت “دعوة” (بالشروط الخلدونية ايضا) هي الطريقة البكتاشية عند العثمانيين, والطريقه الصفوية عند الصفويين. والجديد أيضًا علي المستوى الثقافي/الديني تجاه الدولتين في تنظيمها الداخلي, وفي الصراع بينهما إلى استخدام العلماء بشكل ما كان له الوضوح نفسه لدي السلاجقة أو الإيلخانيين أو المماليك. وهكذا وضعت الدولة العثمانية المذهب الحنفي السني في واجهتها الأيديولوجية; بينما وضع الصفويون المذهب الشيعي الإثني عشري في واجهتهم. وإذا كان ظهور الدولتين نتاج تطور طويل على المستوى السياسي, ومستوى صراع العصبيات; فإن علائق الفقهاء برجالات الدولتين كانت لها مواريثها أيضًا. فقد درس المؤلف إتجاه الفقهاء السنة (وعلى رأسهم الماوردي / ت 450 هـ) إلى الإعتراف “بسلطة الضرورة” أو الأمر الواقع; ومصير الفقهاء الشيعة منذ الإيلخانيين إلى تبادل التأييد والنصرة مع المسيطرين.
ويلاحظ المؤلف أن بدايات الدولتين شهدت استقلالية “نسبية” لفئات من العلماء آثروا الزهد والإعتزال أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ذلك اختفى في المجال العثماني مع تأسيس منصب “مشيخة الإسلام” الذي ضبط كل شئ ضمن مصالح الدولة; وتضاءل في المجال الصفوي مع إتجاه الدولة لتشديد قبضتها علي المجتمع بالداخل, وإستخدام الطاقات في الصراع مع العثمانيين.
والملاحظ أن الدولتين اتجهتا للإستغناء عن الخدمات الصوفية بعد استقرار السلطة لكل منها, والتعاون مع الفقهاء (أهل الحلال والحرام) والذين كانوا أوضح وأفعل في إعطاء إجراءات السلطة مشروعية في حالات معينة.
بيد أن علماء الصفويين والقاجاريين كانوا في وضع أفضل من الناحية الأيدويوليجية والفقهية من زملائهم الأحناف العثمانيين. فمع نظرية الغيبة للإمام المعصوم; لم يكن بوسع الفقيه الشيعي قبل ظهور رؤية “ولاية الفقيه” أن يهب الشريعة الكاملة لأي كيان سياسي. كل ما كان يستطيعه في حال إرادته الإقتراب من السلطان أن يسكت عنه أو يعطيه تأييدا غير مباشر. ومع اشتداد ضغوط السلطة, وتوالي الشاهات المستبدين; كان الفقية الشيعي بإيران والعراق يطور رؤية للفقيه المجتهد في حال الغيبة تجعله هو وليس السلطان المرجع في أمور الدين; حتي تبلورت الرؤية تماما في القرن التاسع عشر. هذا; وإن رأي بعض الباحثين أن الفقيه/المرجع كان يقاوم استبداد السلطة مع الجماهير دون أن يعني ذلك إرادة من جانبة للحلول محلها; حتي كان آية الله الخميني, والثورة الاسلامية في إيران. وهكذا فالملاحظ أن التطورات في إيران والامبراطورية العثمانية كانت تتجة لإلغاء التمايز بين الشريعة والسياسة; الشريعة التي يعمل في نطاقها الفقهاء, والسياسة التي يتولاها رجالات الدولة.

فالذي حدث أنً السلطان العثمانى (الذي اتخذ لنفسه لقب الخليفة أيضاً فى القرن الثامن عشر) كان يعتبر نفسه الدنيا والدين, ويرى من حقه إخضاع الجميع له. كما أن الشاه كان يعتبر نفسه نائب الإمام أو وكيله غير تارك للفقيه مجالاً يتحرك فيه بمنأىً عن نزعات السلطة وإدارتها. وكان من نتائج ذلك لدى العثمانيين فقدان العلماء لمصداقيتهم لدى الناس (واتجاه العامة إلى الاحناف والفتوة والصوفية بعد أن غادرتها الدولة تدريجياً); كما كان من نتائجه لدى الصفويين والقاجاريين إتجاه العلماء تدريجياً لتطوير رؤية ((ولاية الفقيه)) (=سلطنة الشريعة) في مقابل سلطنة الشاه كما سبق بيانه. وشكلت مصر ضمن الأقطار العثمانية استثناء لا بٌد من ذكره هنا; فقد تمتعت باستقلالية ((نسبية)) منذ مطالع القرن الثامن عشر: احتاج خلالها الولاة والمتغلبون من المماليك إلى العلماء والفقهاء والصوفية; فتجددت قيادة هؤلاء للناس, ومصداقيتهم لديهم حتى كان عصر محمد علي.
وعصف النصف الثانى من القرن التاسع عشر; مع إستشراء التدخل الأوروبى بكل المواريث. فاتجه علماء أحناف إلى ((فتح باب الاجتهاد)) الذي أقفله لقرون فقهاء السلطان; وانفتحوا على التجربة السياسية والثقافية الوافدة والمقتحمة: فإذا الدستور والقوانين التنظيمية هى الشورى التقليدية نفسها. وشارك فقهاء إثنا عشريون كبار فى النهضة الدستورية بإيران. ويذكر المؤلف من علماء السنة السيد محمد رشيد رضا; ومن فقهاء الشيعة الشيخ حسين نائيني: وكلاهما أيد التغيير والدستور.
* * *
دراسة الزميل الكبير وجيه كوثراني دراسة رائدة; تميزت بمنهج تاريخي صارم وازن بين التطورات السياسية، والتطورات الفقهية. ولا تستطيع مراجعة كالتى قدمتها هنا إلا أن تلم بالخطوط الكبرى لهذه الريادة. فقد كان عليه أن يقرأ الفصول الأولى من تاريخ الدولة السلطانية بمجالنا السياسي: كما كان عليه في الوقت نفسه أن يرافق تطورات الفقه الشيعي الإمامي بين مدرستي الأخباريين والأصوليين.
وإذا عرفنا أن التاريخ الفقهي المتأخر لسائر المذاهب الإسلامية لم يٌكتب بعد; أدركنا الصعوبات التى واجهت الدارس, والتى نجح فى تجاوزها, رغم ندرة المصادر, وقلة المراجع الضرورية لقراءة منعطفات الفقه, وجدليات علائقه بالسلطة والسلطان. والواقع أن الأمر شديد التعقيد إذا لا سبيل – حتى الآن – للبرهنة على تلازٌم ((ظاهر)) بين تطورات الفقه، وتطورات السلطة: على الرغم من حصول ذلك ظاهراً منظوراً إلى المسألة فى سياق حقب كبرى. فالماوردي لم يكن من فقهاء “الأمر الواقع” رغم إصرار كل الدارسين علي ذلك. إذ مع الماوردي نلاحظ تْبلور إتجاهين فى الفقه السياسى لدى فقهاء السنه. الإتجاه الذى يغلب مبدأ المشروعية التاريخية (كما هو عند الحليمى فى المنهاج في شعب الأيمان), والأخر الذي يغلب مبدأ المصلحة أو الوظيفة (كما هو الحال لدى الماوردي). إذ يرى الباقلاني (- 403 هـ) والحليمي (مطالع القرن الخامس أيضاً) أنْ دولة الخلافة بشكلها القديم هي الحقيقة بالنصرة لحصول الإجماع التاريخي عليها. بينها يرى الماوردي (-450هــ) , والجويني (- 478 هــ), إلى حدً ما, والغزالي (- 505 هــ) أن كفاية الدولة أي قدرتها على القيام بالمهام المستجدة فى نطاق المشروع التاريخي للأمة; هي التي تحدد مشروعيتها. لذا فإن الماوردي الذي يسمي فى الأحكام السلطانية الدولة السلطانية الأولى (البويهيين) إمارة الاستيلاء; يسميها فى تسهيل النظر; دولة القوة; وهي إشارة دقيقة إلى المهام الجديدة الملقاة على عاتقها. فقد ضعفت الخلافة التاريخية عن القيام بالمهمتين الأساسيتين الموكلتين إليها منذ البداية; منع الفتنة الداخلية ومواجهة أعداء الخارج. وبذلك صار النظام الاجتماعي/السياسي كله مهدداً بالسقوط; إن لم يجبر إصطناع أشكال جديدة فى المجتمع والسلطة للمقاومة. وهكذا كان! إذا اكتسح السلاجقة البيزنطيين, وبدأوا بمواجهة الصلبيين: ثم أكمل المهمة النوريون والصلاحيون والمماليك والعثمانيون. وكذا الأمر بإيران; فقد أنهى تغلب الصفويين مائتى عام من الفوضى والمذابح. ولذا فإن إعتراف الماوردي والجويني والغزالي وابن تيمية وابن جماعة بالدول السلطانية فى النطاق الرمزي للخلافة; لم يكن اعترافاً بالأمر الواقع; بل دعوة إلى تغييره: باتجاه السلطة القوية الضابطة; وليس للمجتمع; بل لأعدائه الخارجين. ولذا تتضاءل في كتبهم مسائل النظر والنظرية لصالح أبواب القتال وجهاد الأعداء. وعندما يكتب فقيه مغربي; لم تكن السلطنة العثمانية قد استولت على بلاده; كتاباً بعنوان; بشائر أهل الإيمان فى فتوحات آل عثمان; فإن ذلك من جانبه ليس اعترافاً بسلطان الضرورة أو الأمر الواقع: بل إحساس بأن نهضة إسلامية شابة هي على وشك الإستتباب بعد أن تولت هزائم المسلمين بالأندلس وسواحل شمال أفريقية, وسواحل الشام. ثم إن الدولة هى مشروع الإسلام الأول لإنجاز المهمتين السالفتي الذكر. فتعاون الفقيه مع السلطان ليس مرفوضاً بالمطلق: بل إن العكس في نظر الفقيه هو الصحيح. ومن هنا كان إنكار فقهاء على الغزالي إعتزاله الفكري والشعوري بحيث لم يذكر الصليبيين الهاجمين على عالم الإسلام بكلمة واحدة فى مؤلفاته. لقد اختار الفقهاء بعد تردد المبدأ الانتقائى القائل ((لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)): وإنما الطاعة في المعروف. دون أن يعني ما أقوله هنا أنه لم يكن هناك اتجاه للإعتزال الكامل للمجال السياسى لدى بعض الزهاد والمتصوفة. فليس كل معارض محقاً: وليس كل متعاون فقيهاً سلطانياً. وإذا كان التأويل التاريخي فى المجال السياسي مشكلاً; فقراءة الفقه من خلال التطور السياسي أكثر إشكالاً. وعلى سبيل المثال; فإن المدرسة الأخبارية فى الفقه الإمامي هي مدرسة الإعتزال أو المعارضة; بينها المتعاونون مع الإيلخانيين والصفويين والقاجاريين; هم أتباع مدرسة الأصول. ومع ذلك فإن نظرية ((ولاية الفقيه)) تطورت فى أوساط الأصوليين وليس الأخباريين. لذلك لا بدًٌ من قراءة نصوص إلى تحقيب للتطور الفقهى . فليس هناك تلازم ضرورى وحاكم بين الحدث السياسي, والاجتهاد الفقهي; هذا وإن لم يمكن دراسة الفقه إلا فى سياق تاريخي.
* * *
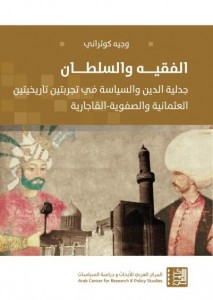
(2)
مقدمة د. وجيه كوثراني للطبعة الرابعة من كتابه: “الفقيه والسلطان – جدليّة الدين والسياسة في تجربتين تاريخيتين: العثمانية والصفوية – القاجارية”
عبّر كتاب الفقيه والسلطان، عندما صدر بطبعته الأولى في العام 1989 ثم بطبعته الثانية في العام التالي 1990 ولاحقاً بطبعته الثالثة في العام 2001، عن حيثية تاريخية تزامنت مع إشكالية البحث عن الخلفيات التاريخية “للولاية العامة للفقيه”، وهي النظرية التي دعا لها الإمام الخميني قبل الثورة الإسلامية ثم أدخلها بعد الثورة في صميم دستور الجمهورية الإيرانية كمبدأ تأسيسي ودائم للدولة.
لم يطرح الكتاب آنذاك هذه الإشكالية بصورة مباشرة، كما أنه لم يطرحها أيضاً من زاوية الفقه وأصوله أو علم الكلام الشيعي أو السنّي حول الإمامة. كان السؤال القائم (صراحةً أو ضمناً) يدور في أوساط المثقفين والسياسيين العرب وغير العرب، حول الاستفهام ان كانت هذه النظرية (ولاية الفقيه) شيعيةً محضاً أو هل هي خاصة بإيران وبالتجربة الإيرانية الشيعية فقط؟ هذا في وقت، كان لا يزال فيه الخطاب التاريخي العربي، كما الخطاب الثقافي – السياسي العربي عموماً مُشبعاً بالمفردات التي تتحدث عن “الخلافة العثمانية”، وعن “الخلفاء العثمانيين”، ولا سيما عندما يجري الكلام عن “إلغاء الخلافة” على يد أتاتورك، فنلاحظ في الخطاب، مرارة الإسلاميين وحسرتهم وحنينهم إلى هذه الخلافة، أو فرحة العلمانيين وراحتهم بالخلاص منها. هذا يعني أن الذاكرة العربية على وجوه صورها، كانت وما زالت، تكرر خطاباً تمويهياً وأسطورياً لتوصيف “سلطة” مُجسّدة بدولة في التاريخ الإسلامي تدعوها “خلافة”.
هذا يعني أيضاً أن النخب العربية المعاصرة، سواء كانت إسلاميةً أم قوميةً علمانية، ظلّت بعد “إلغاء الخلافة”، أي بعد العام 1924 وحتى اليوم، أسيرة تداعيات هذا الحدث، سواء عبر تذكّر “الخلافة” صورةً يجب إعادة إحيائها في الوعي والواقع والعمل (شأن العديد من الأحزاب والحركات الإسلامية) أو عبر تذكّرها صورةً بائسة لمؤسسة الاستبداد والتمييز الديني أو تعبيراً عن “ظلامية وتخلّف القرون الوسطى”.
أمّا بالنسبة لباحثٍ اشتغل على طبيعة السلطة والسلطان في التاريخ الإسلامي، وحاول أن يفهم آليات الحكم فيها ومراتب السلطات والولايات القائمة بين السلطان والمجتمع، فإن الحالتين المذكورتيْن عن صورة الخلافة، لا تعبّران معرفياً عن الواقع ولا عن معطيات التاريخ الفعلي، بل كانتا حالتيْن من حالات الذاكرة التاريخية “المستخدمة” في الحقل الايديولوجي – السياسي في الزمن الراهن. ومن هنا يمكن القول أن الخلافة، وقد أضحت “مؤسسة” مُفترضة في كل مراحل التاريخ الإسلامي، أو متخيلةً للمستقبل، اكتسبت وظيفتين: وظيفة “الهدف” الذي يُسعى إليه (حال بعض الأحزاب الإسلامية والمثقفين الإسلاميين) ووظيفة “الفزّاعة” التي يخشى منها وينفّر.
ما علاقة كل هذا بحيثية الدعوة الخمينية لإقامة “الولاية العامة للفقيه“؟ وهل كان الفكر الشيعي مهيئاً آنذاك لاقتحام الحقل السياسي الإسلامي، الذي احتكرته آنذاك جماعة الإخوان المسلمين وفروعها في الأقطار العربية والإسلامية، وشاركتها بذلك أحزاب إسلامية أقل شأناً؟ وهل شجّع ذلك نخباً شيعية على استخدام وظيفي لرأسمال رمزي شيعي مشابه لصورة الدعوة إلى الخلافة؟
نعرف أن حزب الدعوة في العراق تأسّس في الوسط الشيعي، بالتماثل مع جماعة الإخوان، وان كتابات حسن البنا وسيد قطب وشارحي أفكارهما شاعت شيوعاً كبيراً في الأوساط المتعلّمة السنيّة والشيعية (المتعلّمة في الحوزات الدينية كما في الجامعات)، ووصل الأمر في إيران أن قام السيد علي خامنئي بترجمة أعمال سيد قطب إلى الفارسية، لكن الدخول الشيعي حقل العمل السياسي على غرار “الاخوان المسلمين”، كان يحتاج إلى حل “المأزق” الناتج عن “معتقد الغيبة” للخروج من “تاريخية الانتظار” إلى تاريخية الفعل السياسي والمطالبة بحق “الولاية العامة”. ورأيي أن نظرية الخلافة عند أهل السنّة، والمطالبة الحزبية المعاصرة بإعادتها، قدّمتا لمن يبغي قيام دولة شيعية مثالاً للتقريب وللدفع باتجاه التماثل بين وظائف الخليفة ووظائف الولي الفقيه (أو نائب الإمام)، بل ان الاجتهاد القائل بإمكانية، بل وجوب قيام “نائب الإمام” بوظائف الإمام المعصوم، بل بوظائف النبي (ما عدا الوحي)، جاء يحسم أمر “الغيبة” ومفهوم “الانتظار” باتجاه تكريس أمر واقع بالثورة أو الانقلاب: إقامة “ولاية عامة” للفقيه الشيعي، هي في حقيقة أمرها “خلافة” بالمعنى السنّي. وبالتحديد، بالمعنى والحدود التي رسمها الماوردي “للولايات الدينية والأحكام السلطانية”، وبالمعنى الذي أعاد رسمه الإمام الخميني “لنائب الإمام” في “الحكومة الإسلامية”.
في ثمانينات القرن الماضي، وفي خضم الجدل الذي احتدم في الوسط السنّي العربي، بين مؤيّد لما حَصَلَ في إيران وبين معارض له، وفي سياق نشوب الحرب العراقية – الإيرانية، طالب الشيخ سعيد شعبان (في طرابلس) المعارضين من السنّة العرب تحدّي قيام “الولاية العامة” في إيران بالدعوة لإقامة الخلافة. يقول “إن أحسن حرب ضد إيران هي قيام خلافة إسلامية تنطلق من مدينة رسول الله وتدعو إلى بيعة عالمية للمسلمين (…) عندها سيصبح الخميني جزءاً من التركيبة ولا يستطيع أن يكون التركيبة كلها”. وفي تعليق للسيد محمد حسين فضل الله على احتدام الصراع حول مسألة الحكم، يرى السيد إمكانية حلٍ للخلافة حول مسألة الحكم بين الاتجاهات الإسلامية عن طريق الحوار (ملف مجلة الشراع حول الحركات الإسلامية).
ولكن نظرةً أخرى لتاريخنا، ومن خلال مصادره، ترينا من خلال معطى التاريخ ومعطى الواقع أن هذه المسألة (مسألة الإمامة أو الخلافة) هي التي أسالت دماء المسلمين أكثر من مسألة أخرى. يخلص الشهرستاني (ت 548 هـ) لتأكيد هذا الواقع في كتابه “الملل والنحل”، فيؤكد “ما استل سيف في الإسلام مثل ما استل على الإمامة”. وظنّي أن الأمر لا يزال على حاله. كتبت في العام 1995، تعليقاً على ما ورد في الخطابيْن المذكوريْن (شعبان/فضل الله) ما يلي: “… ما من دولة إسلامية قامت إلا ودخلت في صراع مع اختها الإسلامية لجملة من الأسباب الإقليمية والاستراتيجية والاقتصادية، بينما يقوم شعار التكفير المتبادل سلاحاً ايديولوجياً للتعبئة. ألم يكن هذا شأن الصراع الصفوي – العثماني المزمن في تاريخنا الحديث؟ واللافت للنظر أن أصحاب الخطاب الإسلامي الوحدوي اليوم لا يستطيعون أن يخرجوا من الأطر الاجتماعية – البشرية التي تفرض تركيباً ديموغرافياً مذهبياً متجانساً لتنظيماتهم وأحزابهم. ففي لبنان يبقى “حزب الله” حزباً شيعياً في قواعده الاجتماعية وقياداته، وتبقى “حركة التوحيد” أو “الجماعة الإسلامية” (على سبيل المثال) حركة سنيّةً في قواعدها الاجتماعية وقياداتها. والحوار يبقى دعوات مكررة على صفحات الجرائد بين الطرفين. وستبقى هذه الدعوات كذلك، لأن موضوعها – موضوع السلطة – ليس موضوع توحيد، وإنما هو موضوع خلاف، لا سيما إذا أصرّ المعنيون بالخطاب التعبوي على الانطلاق من نصوص فقهية محدّدة، ومن اعتبارات إيمانية ومعتقدية معينة في مسألة الخلافة أو الإمامة أو تطبيق الشريعة. ذلك أن التجربة التاريخية لعلاقة الفقه بالسياسة في الدولة السلطانية التي شهدتها معظم فترات الحكم الإسلامي، تدلنا على أنها لا تمد الخطاب الإسلامي المعاصر الذي يتوخى التعبئة من أجل الوحدة بما يلزم من عدة فكرية ومنهجية من أجل التوحيد. فالموقف الفقهي الذي يوجب طاعة السلطان المستولي ولو قام على بيعة قسرية (الغزالي، ابن تيمية، ابن جماعة…) وكما هو حال حكم الفقيه – الولي العام يمكن أن ينسحب، وانه لينسحب اليوم، إلى أطر الأمراء الصغار والمتفقهين والجماعات الصغيرة بحيث يكثر “الأمراء” و”الأدعياء” وتكثر معهم إمارات الطاعة و”الأحكام التكفيرية والتخوينية” دون طائل…”.
في عهد الانتداب الفرنسي في بلاد الشام، خاطب السيد محسن الأمين المسلمين (سنّة وشيعة) (وهو المرجع الكبير الذي لم يدع إلى خلافة أو ولاية): “بقينا نختلف على من هو خليفتنا حتى أضحى المندوب السامي الفرنسي خليفتنا”. والحقيقة أن تاريخ المسلمين الفعلي – وإذا استنينا طوبى الخلافة الراشدة عند أهل السنّة، وطوبى “الإمامة المعصومة” عند أهل التشيع، لم يشهد إلا “دولاً سلطانية” هنا أو هناك، استضاف بعض سلاطينها “خلفاء” يكاد لا يعرف التاريخ أسماءهم، أو اخترع بعضهم الآخر حججاً عبر استضافة فقهاء لكسب “شرعية دينية” من هذا الفقيه أو ذاك، أو ادعى لقباً من ذاكرة “خلافة” كادت تنساها تواريخ أخبار الخلفاء وسيرهم بعد أن تمكن “امراء الاستيلاء” من تشييد “سلطاناتهم” الكبرى أو الصغرى في مختلف أصقاع العالم الإسلامي.
ولهذا، فإن أتاتورك بإلغائه الخلافة في العام 1924، فإنما كان يلغي أمراً ملغياً ومقضياً منذ عهد البويهيين والسلاجقة. وعندما تأسست السلطنة العثمانية وتوسّعت وعظم شأنها، لم يكن السلاطين الكبار من المؤسسين و”الفاتحين” و”الغزاة” (وهذه بعض ألقابهم) بحاجةٍ إلى لقب خليفة وكما أمسى وضعهم في أواخر عهدهم، فتلقب بعضهم، وبسبب الضعف والوهن – بهذا اللقب فتمّ اختراع رواية تنازل آخر خليفة عباسي عن الخلافة للسلطان سليم في أواخر القرن الثامن عشر. وكان استخدام السلطان عبد الحميد الثاني أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ذروة استثمار هذا الرأسمال الرمزي في سياساته الداخلية والدولية، وصولاً إلى تعثّر هذا الاستخدام وفشله في دعوة الجهاد للدفاع عن “دولة الخلافة” في الحرب العالمية الأولى. لقد وضع أتاتورك حدّاً لهذا الاستخدام، من خلال إنجازيْن اثنيْن سبقا لوزان 1923 وسبقا إعلان إلغاء الخلافة وعلمانية الجمهورية التركية. الإنجازان هما:
– انتصار حركة التحرر الوطني التركي وإسقاط معاهدة تقسيم تركيا (Sèvres) التي حازت موافقة “السلطان – الخليفة” وهي مشابهة لاتفاقية سايكس – بيكو في بلاد الشام.
– إنجاز وثيقة التفريق بين السلطنة والخلافة في العام 1922، وشرعنتها في الجمعية الوطنية كوثيقة تأسيسية (وثيقة أنقرة)، حيث أعيد النظر في تاريخ الخلافة ليتبيّن فيها أن تاريخ الدولة الغالب في الإسلام هو تاريخ “الدولة السلطانية”، وليس “دولة الخلافة”.
ولم يكن شاهات إيران (الصفويون والقاجاريون)، بعيدين عن هذا الأسلوب في التعامل مع مسألة الإمامة ونيابة الإمام، كانوا “سلاطين” أيضاً يتماثلون ويتماهون مع سلاطين آل عثمان في أمور كثيرة، أهمها:
– في البنية العسكرية للقبيلة المقاتلة، وفي الإطار الصوفي للتنظيم الديني والطقسي للتشكيلات العسكرية والأهلية.
– في الخلفية النظرية الفارسية للإدارة والحكم لدى الطرفين (العثماني والصفوي).
– في نمط المأسسة للعلاقة بين السلطان والفقيه.
ولعلّ دراسة هاتين التجربتين التي بدأ بها مبحث “الفقيه والسلطان” لا زالت تستحق القراءة من جديد، وربما لا زال هذا الكتيّب يستحق طبعة رابعة بعد مضي ربع قرن على تأليفه، وبعد أن تحوّل الفقيه من موظّف لدى السلطان أو واعظ أو ناصح إلى فقيهٍ سلطان، فتقلّص بذلك وجود الفقيه المستقل ودوره، بل كاد ينعدم.
مراجعة رضوان السيد (مجلة الإجتهاد – 1989م)
■ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – 2015.


