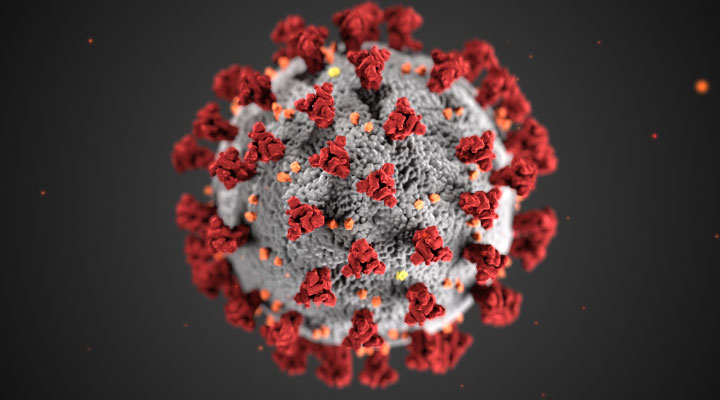تقديم
ليس من المبالغة في شيء القول اليوم بأنّ حدث ظهور فيروس-كورونا، كوفيد (covid 19) وانتشاره في أرجاء المعمورة، وتصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية (11/03/2020) باعتباره وباء عالميا أو جائحة عالمية. خلق صورة أخرى “للإنساني وللقيم الكونية”، صورة بقدر ما جهّزت لتجسيد فكرة التعايش والوعي الجماعي بالانتماء الطبيعي للأرض أو المصير المشترك للبشر، فإنّها مهدّت لزحزحة جملة من المسلّمات المريبة والصامتة، لأنّ الحدود لم تفتح من أجل التأكيد على الحقّ في العيش والحقّ في الرعاية الصحيّة وحسب، بل فُتحت أيضا أمام اللّقاء بين المعرفة والسلطة، وبين البحث والقوّة. وهنا يمكن أن نتساءل: كيف يمكن أن نفهم علاقة الفلسفة بالعلم اليوم في انخراطهما في تدبير جائحة الكورونا ؟
الكورونا والجسد:
لا شكّ أنّ فيروس الكورونا الذي سلك طريقه إلى الوجود العالمي تحت رعاية السوق العالمية عبر شبكات الانتشار التي لا حصر لها جعل الجسد يتخلّى عن عرشه، ولم تعد هويّته تحدّدها الرّموز الثقافيّة أو حتّى العلامات الاستهلاكية. لذلك كان من نتائج حدث انتشار هذا الفيروس المستجد في أرجاء المعمورة (la terre habitée) أن جعل الجسد نطاقا خاليا من الذّات بعد أن اخترقه الوباء على نحو عنيف ومباغت، كما قوّضّ إلى حدّ بعيد علاقته (الجسد) بالمكان، فإصابة واحدة يمكن أن تُحوّل فضاء ما إلى فضاء موبوء بما ذلك الأجسام التي يحويها وأشياء التي تشغله، بل حتّى رمزية ذلك المكان يمكن أن يطالها الوباء لأنّها لم تحافظ على عذريتها ونقاوتها من الفيروسات. هنا يختفي كلّ مفهوم للجسد الخاص وللمكان الخاص بعد أن جُرّدا من كلّ قيمة رمزية بما ذلك دور العبادة والأماكن المقدّسة. وإذا سمحنا لأنفسنا هنا باستعارة لغة دي سوسور لقلنا، إنّ العلاقة بين الجسم والفيروس، على الرّغم من اعتباطيتها، قد تحطّمت، ذلك أنّ الفيروس بات قادرا على أن يقيم بطريقة تكاد أن تكون خاصّة به تشكيلة من العلاقات العابرة للحدود مع الأجسام البيولوجية الأخرى ليصبح سيّدها، ويوقّع نهاية الحياة فيها.
إنّ الخطر الذي بات يهدّد الجسد اليوم لم يعد ناجما عن علاقتنا بعصر التكنولوجيا وماهية التقنية وحسب، كما أنّه لم يعد مرتبطا بعلاقتنا بالمجتمع الإستهلاكي واستشراء ثقافة الاستهلاك أو بجسد الإشهار باعتباره سلعة ضمن معاملات الإنتاج والاستهلاك وقانون العرض والطلب، بل أصبح مرتبط في صميمه بانتقال استراتيجي من مستوى معين من الكينونة (عالم الذات الحالمة بالسيادة على العالم، والمتيقّنة من سيادتها على نفسها: براديغم الذات الحديثة: ديكارت، كانط). إلى نموذج جديد يكرّس شكلا مُختزلا للذات (باعتبارها كائنا بيولوجيا-الجسم/الفيروس الخالي من أي مضمون روحي أو أي صيغة للتعنّي). وربّما كانت تلك طريقة أخرى للقول، إنّ الوباء بات جزء أصيلا من النقاش المعاصر حول أزمة براديغم الذات، وهو أصيل لأنّه نجح في إعادة تخريج ماهية “الآخر” الثقافي بوصفه شريكا في الإنسانية لا باعتباره غريبا أو دخيلا أو منبوذا[1] أو هو أحد نتائج براديغم الذات الغربية.
ولأوّل مرّة أيضا، لم يعد ممكنا الفصل بين مساحة الجسم الموبوء والأجسام السليمة، وبين المساحات المعقّمة والمساحات الموبوءة، وبين ما هو قريب منّا وما هو بعيد عنّا، بل وحتّى بين الموت الطبيعي والموت الموبوء، وبين النار والتراب في قدرتهما على قبر الفيروس ووضع حدّ لمخاطر انتقاله إلى الأجسام الحيّة. وفي ذلك ما يشير إلى أنّ ثنائية المعقّم/المعدي هي التي باتت تُعيّن الحدود الفاصلة/الواصلة للفعل التواصلي في تجربة الإنسان المعيشة. وهكذا أصبحت العدوى هي التي توجّه التفاعل وتقوده. بيد أنّ العدوى المشار إليها، ههنا، لا تشير إلى معرفة بما هو خطير، قدر إشارتها إلى معرفة بما يحتمل أن يكون خطرا. فمن ناحية يقال للناس: “احذروا من بعضكم البعض، لا تُقبِّلوا بعضكم البعض، ابقوا بعيدين”، ومن ناحية أخرى يقال لهم: “فكروا بالآخرين لأنه حتى لو تكونوا معرضين للخطر، فأنتم تشكلون خطرًا عليهم”. هاهنا يصبح التواصل مشكلا صحيًّا وبيولوجيّا بعد أن انحلّ برمّته في مكائد اللامرئي (عالم الفيروسات والأجسام المتناهية في الصغر) الذي كرّس بدوره رعبا كونيّا معمّمًا.
الكورونا والرّعب الكوني المعمّم
إنّ المثير في أفق هذا المشهد الجديد، هو أنّه وفي الوقت الذي برزت فيه فكرة الحجز الذاتي الصحّي وضرورة “ملازمة المنزل”، تمّ استغلال الخوف من الوباء لتحويله إلى خوف معمّم من الأجسام الأخرى، وبذلك تمّ استثمار الجسد من جديد في سياسة الحقيقة كما أظهرها ميشيل فوكو منذ “ميلاد العيادة” (1963) وإلى غاية “المراقبة والمعاقبة” (1975)، حيث لم يعد ممكنا زمن انتشار الفيروس الفصل بين الأجساد والأرقام، وبين الأجساد وأسرّة الإنعاش، وبين الأجساد وأجهزة التنفّس الاصطناعية والملابس العازلة والأقنعة الواقية. وفي ذلك ما يشير إلى أنّ سياسة الخوف تحوّلت اليوم إلى سلاح وبائي بعد أن اختزلت الدول الموبوءة الأجساد في مجرّد مساحات للعدوى. وعلى هذا النّحو من الاعتبار، فإنّ الرّعب بات ينتقل إلينا زمن الوباء لا عبر الأجسام الحاملة للفيروس، بل عبر لغة الوباء، أي عبر لغة الأرقام التي أصبحت شبيهة بلغة الأسهم في البورصات التي ليس لها أصول حقيقيّة، في لهجة تجمع بين الحتمية البيولوجية والتوبيخ الأخلاقي والسياسي.
هكذا مهّدت الجائحة العالمية إذن لاسترجاع الدول سيادتها على مرضاها ومحتجزيها بعد أن صيّرت الأفراد ذاتيات هشّة وكائنات معزولة في مجتمعات المخاطر والأوبئة، فضلا عن تشكيل مسار من التّحولات في العلاقات الدولية والإنسانية، ذلك أنّه لم تعد ثمّة أيّة إمكانية للفعل العقلاني ما دام كلّ ما يقع أو يحدث إنّما يحدث من أجل رسم ملامح صورة جديدة للنظام العالمي ما بعد الأزمة البيولوجية المعولمة، على ما ذهب إليه الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي[2] (Noam Chomsky) منذ أيام ومن قبله الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين[3] (Giorgio Agamben). وبذلك تكتمل الصورة في أبعادها الجغرافية والمعرفية والسلطوية. وفي ذلك ما يُشير أيضا إلى أنّ النسق المعولم للانتشار الوباء نشأ قهرا عن طريق بورنوغرافيا الرّعب التي لعبت فيها التكنولوجيا الحديثة دورا كبيرا بعد أن أصبح “العلم نفسه اصطناعا خالصا”[4] بعبارة لبودريار (Jean Baudrillard)، لاسيّما التكنولوجيا التي يسرت فاعليّة الإعلام الجماهيري، كما يسّرت دخول العلم والرعب إلى المؤسّسات التكنو-بيروقراطية وفق ما تمليه قواعد التنظيم الفعّال للمراقبة والتحكّم (السيبارنيطيقا) كما لو أنّ قيم المجتمع ينبغي أن تنبع آليا من “مؤسسات الخبرات التقنية”.
ضمن هذه الرؤية الدغمائية للعلم وللعقلانية التكنو-علمية التي ترى في الخبرة التقنية فضيلة كاملة، أصبحت “المعرفة العلمية الجديدة تُودع في بنوك المعطيات وتُستخدم وفق وسائل الأقوياء وقراراتهم”[5]. وعلى ذلك، فإنّ هذه العقلانية تتميّز عن كلّ العقلانيات الأخرى بأنّها في حقيقتها عقلانية سيبارنيطيقية (Rationalité cybernétique) عقلانية تدرّبت على مراقبة كلّ العقلانيات الأخرى والعلاقات القائمة بين الاختصاصات المختلفة. لا غرابة إذا أن يمّحي الفارق بين البحث والقوة. وبالنتيجة، لم يعد العلم في هذه الأنظمة محصّنا ضدّ الهجمات الفيروسية المتطرّفة التي تصبّ في مصلحة أقليّة احتكارية (أوليغارشية أو استبدادية) تمزج بين القوة والامتثال. فبعد استهلاك سردية الإرهاب –كما ذهب إلى ذلك جورجيو أغامبين- من أجل اتخاذ إجراءات فوق أو خارج القانون واستدامة حالات الطوارئ، ها نحن زمن الوباء أمام سردية أخرى هي سردية الفيروسات والأوبئة، والتي يمكن أن توسّع من مدى السيادة بشكل يتجاوز كلّ حدود.
خاتمة
الوباء إذن عنوان موت شيء ما، لكن حين ينتشر الموت قد يأتي على الإنسان نفسه. لذلك يحتاج الموت إلى ستار يؤمّن مروره السلمي حتّى يصير مقبولاً من الجميع كضرب من الحياة. وإذا كان ستاره وصلاً خادعاً بين معاني الحياة والموت، وبين منتجات الإنسان وعطايا الطبيعة. فإنّ الوعي بالموت بما هو موت قد لا يكون ممكناً إلاّ عبر استيعاب سردية الوباء في علاقتها بالعولمة كأحد تجليّات فكرة الحداثة، بل وانعكاساتها الّتي غيّرت مقومّات المشترك الإنساني والمصير المشترك للبشر، ليتماهى مع سيرورة العولمة في مراحلها المتتالية. والسؤال هو: أيّ معنى فلسفي للتعايش متى تمّ تأسيس ماهيته على ثقافة الخوف من العدوى؟
لائحة في المصادر:
- جان بودريار، المصطنع والاصطناع، ترجمة جوزيف عبد الله، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت، 2008.
- Edgar Morin, Science avec conscience, éd. Seuil, Paris, 1990.
- Slavoj Zizek, «Coronavirus: le virus de l’idéologie», in: BiblioObs. Publié le 06 février 2020. https://www.nouvelobs.com/idees/20200206.OBS24500/coronavirus-le-virus-de-l-ideologie-par-slavoj-zizek.html
- https://positionswebsite.org/giorgio-agamben-the-state-of-exception-provoked-by-an-unmotivated-emergency/
[1] مقال سلافوي جيجك ينتهي برفض التمييز الذي استشرى مؤخرا، خاصة ضد الصينيين بسبب الكورونا.
Slavoj Zizek, «Coronavirus: le virus de l’idéologie», in: BiblioObs. Publié le 06 février 2020. https://www.nouvelobs.com/idees/20200206.OBS24500/coronavirus-le-virus-de-l-ideologie-par-slavoj-zizek.html
[2] في إشارة إلى التحليل الذي قدمه عالم السياسة والفيلسوف نعوم تشومسكي لوباء الكورونا والذي نشرته مجلة le numérique de L’Insurgé المختصة في دراسة تاريخ الحروب والأوبئة.
[3] نص المقال في ترجمته الإنجليزية:
https://positionswebsite.org/giorgio-agamben-the-state-of-exception-provoked-by-an-unmotivated-emergency/
[4] جان بودريار، المصطنع والاصطناع، ترجمة جوزيف عبد الله، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت، 2008، ص 53.
[5] Edgar Morin, Science avec conscience, éd. Seuil, Paris, 1990, p. 116.