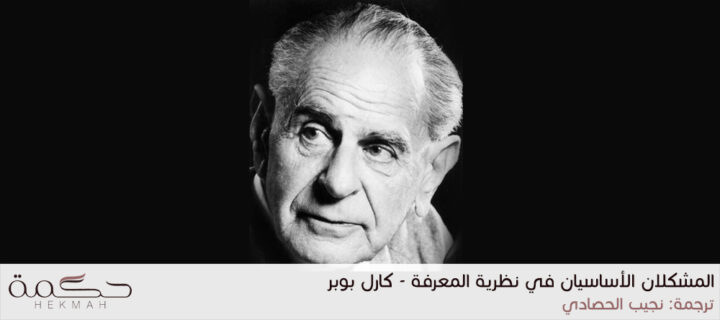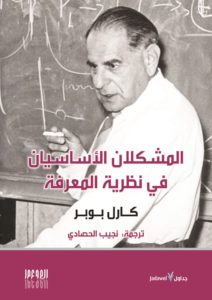
يمكنك شراء نسخة كندل من كتاب (المشكلان الأساسيان في نظرية المعرفة) عبر هذا الرابط
-
تقديم (المشكلان الأساسيان في نظرية المعرفة): الطبعة الأولى الألمانية، 1978
يمكن اعتبار هذا الكتاب، المشكلان الأساسيان في نظرية المعرفة، مجموعة من المخطوطات والأعمال التمهيدية التي قمت بها في الأعوام 1930-1933 للتحضير لكتابي الأول منطق الكشف العلمي، الذي صدرت أول طبعاته في خريف عام 1934. في العنوان إشارة إلى كتاب شوبنهور (Schopennhauer) المشكلان الأساسيان في علم الأخلاق (Die beiden Grundprobleme der Ethik) [1]. أما الأعمال التمهيدية الأسبق عهدًا، وبعض أعمال الأعوام 1930-1933، فقد ضاعت.
لم أكن قد خططت لنشر هذا العمل الأقدم. وكما قلت في الجزء 16 من سيرتي الذاتية[2]، كان هربت فايغل (Herbert Feigel) هو من شجعني عام 1929 أو 1930 على تأليف كتاب للنشر، ثم نسّق لي بعد ذلك مقابلة مع رودلف كارناب (Rudolf Carnap). اطلّع كارناب على مخطوط المشكلان الأساسيان في نظرية المعرفة في صيف 1932، ومن بعده اطلّع عليه أعضاء عدة في حلقة فيينا. وقد كتب كارناب عن الكتاب في مجلة تبصّر (Erkenntnis)[3]، كما كتب هنريتش غومبرز (Heinrich Gomperz) رسالتين مفصلتين عنه، واحدة لي والأخرى لأوكار سيبيك (Oskar Sieeck) من دار النشر. وهاهو جي.سي.ب. مور (J.C.B. Mohr)، يقوم بعد مرور أربعة وستين عامًا بنشر الكتاب.
وإلى جانب هربرت فايغل، فعل صديقي القديم روبرت لامر (Robert Lammer) الكثير من أجل الكتاب. لقد قام بنقد عرض كل جزء جديد، ونتيجة لذلك عرفت الكثير عن صعوبة تأليف كتاب بأسلوب واضح. وكان شوبنهور ورسل (Russell) ويظلان قدوتين يستعصي عليّ التأسي بهما.
عرض هذا الكتاب أكثر تفصيلًا وسعة من منطق الاكتشاف العلمي، الذي أجريت عليه حذوفات جمّة. وبطبيعة الحال، جرى تجاوزه جزئيًا على يد منطق الاكتشاف العلمي الذي جاء بطريقة ما بعده. غير أن صديقي ترولز إيغرز هانسن، الذي تعطّف بتحرير الكتاب، لفت انتباهي إلى حقيقة أن كثيرًا من الأفكار، التي لم أُعد اكتشافها ونشرها إلا بعد سنوات، كنت أرهصت بها في المشكلان الأساسيان في نظرية المعرفة.
وخلال بحثه عن مخطوطات ضائعة، عثر هانسون أيضًا على بعض الرسائل القديمة واقترح أن أستشهد هنا بفقرة، اقتبست من رسالة كتبتها في 30 حزيران/يونيو 1932، توجهت فيها إلى شاعر ومؤرخ ثقافة من البندقية يدعى إيغون فريديل (Egon Friedell). في هذه الرسالة وصفت كتاب المشكلان الأساسيان بأنه «وليد أزمة، … هي في المقام الأول أزمة علم الفيزياء. وهو يقر بقاء الأزمة؛ وإذا صح هذا، فإنها أزمة الوضع المعتاد لعلم عقلاني غاية في التطور».
أنا مدين كثيرًا لترولز إيغرز لعمله الذي استغرق سنوات في تحرير هذا الكتاب، ولإخلاصه في تأدية هذه المهمة. وكان جيرمي شيرمور (Jeremy Shearmur)، الذي كلفته مؤسسة نفيليد وجامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية باحثًا مساعدًا لي، معينًا كبيرًا لي وللمحرر. لقد قرأ مخطوطات المحرر الأولى وقام بتجميع الأدلة. قام آكسل بولر (Axel Buhler) وإروين تغتمير (Erwin Tegtmeir) بقراءة المخطوطات المطبوعة أيضًا. أما هانز آلبرت (Hans Albert) فقد شجع ودعم المشروع برمته. وأنا أدين لهم جميعًا بالعرفان.
بن، بكنغهامشاير
تشرين الثاني/نوفمبر 1978
-
مقدمة (المشكلان الأساسيان في نظرية المعرفة)، 1978
-
– 1 تعليق تاريخي موجز حول المعرفة العلمية كجهل سقراطي
في عمل أفلاطون اعتذار سقراط (Apology of Socrates) – الذي ربما يكون أجمل عمل فلسفي أعرفه – يتحدث سقراط عن مدى استغرابه من أن وسيطة الوحي في معبد دلفي أجابت بالنفي عن السؤال ما إذا كان هناك من هو أكثر حكمة من سقراط. ما الذي يعنيه الإله؟ سأل سقراط نفسه، وهو يعلم تمامًا العلم أنه لم يكن حكيمًا. بعد ذلك خلص إلى النتيجة التالية:
«إنني في واقع الأمر أكثر حكمة بقليل من الآخرين لأني أعرف أني لا أعرف شيئًا، في حين أن الآخرين لا يعرفون حتى هذا القدر؛ ذلك أنهم يعتقدون أنهم يعرفون بعض الأشياء».
يحوز تبصر سقراط بخصوص جهلنا، «أعرف أني (أكاد) لا أعرف شيئًا»، مغزى عظيمًا. في الغالب، لم يكن هذا التبصّر يُحمل محمل الجد؛ الراهن أنه اعتبر مفارقيًا؛ ولا ريب في أنه قُصد من صياغته في اعتذار أن يبدو مفاجئًا ومفارقيًا[4].
تخلى أفلاطون، تلميذ سقراط، عن أطروحة الجهل السقراطية كما تخلى عن مطلب التواضع الفكري. وقد أكد كلاهما أنه ينبغي على رجل الدولة أن يكون حكيمًا. غير أنهما كانا يعنيان من هذا شيئين مختلفين. فحسب سقراط، يلزم رجل الدولة أن يدرك جهله، في حين يلزمه حسب أفلاطون أن يكون مفكرًا راشدًا، بشكل كامل، فيلسوفًا خبيرًا.
وقد أُعيد تأكيد الأطروحة السقراطية المتعلقة بالجهل بشكل متكرر خلال تاريخ الإبستمولوجيا، على سبيل المثل أثناء الفترة الوسيطة في الأكاديمية (التي أسسها أفلاطون).
وهناك أساسًا ثلاث رؤى في نظرية المعرفة: (1) رؤية متفائلة: نحن قادرون على فهم العالم. (2) رؤية متشائمة: النوع البشري عاجز عن الحصول على أي معرفة، وهذه هي الرؤية التي يشار إليها هذه الأيام بالارتيابية (scepticism) (3). ورؤية ثالثة مفادها هو الارتيابية (spektomai = يفحص، يتأمل، يبحث) بالمعنى الأصلي في «الأكاديمية الوسيطة». وهذه أيضًا هي رؤية كزينوفانيس (Xenophanese) الفيلسوف قبل-السقراطي: ليس لدينا معيار للصدق، ولا أي معيار للمعرفة؛ غير أننا نستطيع البحث، وبالبحث قد يتسنى لنا في النهاية الظفر بشيء أفضل[5]. ووفقًا لهذا الشكل من الارتيابية، في وسع معرفتنا أن تحرز تقدمًا.
وكان لدى شكلي الارتيابية حجج أقوى في صالحهما إلى أن جاء نيوتن، الذي أفضى كتابه المبادئ[6] (Principia) إلى موقف جديد كليًا. ويمكن اعتباره تحققًا للبرنامج البحثي لدى الفلاسفة قبل-السقراطيين وأفلاطون، يتجاوز إلى حد كبير أكثر أحلام الأقدمين جرأة. لقد تم التدليل على تنبؤات نظريات نيوتن بدقة لا تصدق؛ وما بدا في البداية زيغًا عن تنبؤاته أدى إلى اكتشاف كوكب نبتون. وكانت هذه، بلا شك، معرفة، يقينية ((episteme، بالمعنى الذي أراده أفلاطون وأرسطو. إنها معرفة يقينية بالأكوان؛ معرفة من نوع لم يكد الفلاسفة قبل-السقراطيين وأفلاطون يحلمون به.
هُزم المرتابون، فيما بدا، على الرغم من أنهم لم يدركوا هزيمتهم مباشرة. وبعد اثنين وخمسين عامًا، كتب هيوم (Hume)، أحد أعظم المرتابين مقالة (Treatise)[7] على أمل استحداث نظرية للعلوم الاجتماعية تقارن بنظرية نيوتن في الجاذبية.
وكان كانط (Kant)، الذي تحول إلى الارتيابية بسبب هيوم، هو من أدرك بشكل واضح تمامًا الطابع الذي يكاد ينافي العقل والذي تتسم به المعرفة الجديدة. لقد أدهشه نجاح نظرية نيوتن فأثار بعد مائة سنة على صدور المبادئ، تحت تأثير هيوم، السؤال التالي:[8]
«كيف يكون علم بحت بالطبيعة ممكنًا؟»
وكان يفهم أساسًا من عبارة علم بحت بالطبيعة (أو «علم طبيعة بحت») قوانين الميكانيكا النيوتنية، وأيضًا النظرية الديناميكية-الذرية في المادة التي طورها كانط نفسه (فضلا عن بوسكوفك (Boscovic)[9].
ولا سبيل لفهم سؤال كانط إلا بمعنى أنه شعر، منطلقًا من ارتيابية هيوم، بأن وجود فيزياء نيوتنية مفارق. وقد أفضى به سؤاله إلى سؤال آخر، اعتبره أكثر أساسية:[10]
«كيف يمكن لرياضيات بحتة أن تكون ممكنة؟».
وقد كتب يقول:[11]
«بحسبان أن هذه العلوم [الرياضيات البحتة وعلم الطبيعة البحتة] موجودة بالفعل، من المناسب تمامًا أن نتساءل عن الكيفية التي تكون بها ممكنة؛ ذلك أن حقيقة إمكانها إنما تثبتها حقيقة وجودها».
وغالبًا ما كان يُعتقد أن كانط صاغ السؤال بأسلوب غير مباشر بشكل مثير. ولكن إذا تذكرنا أنه بدأ بارتيابية هيوم، فإن السؤال طبيعي ومباشر تمامًا: وجود ميكانيكا نيوتن مفارقي عند المرتاب؛ وهو يقود مباشرة إلى السؤال: كيف يكون هذا ممكنًا؟ كيف يمكن لمثل هذا العلم أن يوجد؟
إجابة كانط هي:[12]
«لا يستنبط الفهم قوانينه [أي قوانين العلم الطبيعي البحت] … من الطبيعة، بل يفرضها عليها».
بتعبير آخر، لم تكن نظرية نيوتن مستمدة إمبيريقيًا من الظواهر، بمساعدة حواسنا، بل هي غير إمبيريقية، خلق «بحت» من قبل الفهم؛ إنها شيء يفرضه فهمنا على الطبيعة.
أعتقد أن هذا صحيح وغاية في الأهمية؛ لكني، خلافًا لـ كانط، أفضل أن أقول: إن النظرية شيء يحاول فهمُنا فرضه على الطبيعة؛ غير أنه فرض لا تتسامح الطبيعة دائمًا معه؛ إنها فرضية خلقها فهمنا، ولكني أرى، خلافًا لكانط، أنها لا تنجح بالضرورة، فقد تتعرض الفرضية التي نحاول فرضها على الطبيعة للهزيمة على يديها.
تشير صياغاتي إلى حدث لم يقع إلا بعد سنوات عديدة من رحيل كانط؛ الثورة الأينشتاينية.
لنظرية أينشتاين في الجاذبية، التي بيّنت أن النظرية النيوتونية فرضية أو تخمينية، تاريخ سابق مديد، وكذا شأن أفكار أينشتاين النظرية في منزلة المعرفة العلمية. ومن بين أهم الأسماء في هذا التاريخ السابق برنارد ريمان (Bernhard Reimann)، وهرمان هلمهولتز (Hermann Hemholtz)، وإرنست ماخ (Ernst mach)، وأوغست فوبل (August Fopple)، وهنري بونكاريه (Henri Poincare).
وليس من قبيل المصادفة أن تنتمي هذه الأسماء إلى التاريخ السابق لنظرية أينشتاين في الجاذبية ونظريته الإبستمولوجية.
في عشرينيات القرن العشرين أدركت أول مرة أهمية الثورة الأينشتاينية للإبستمولوجيا. إذا تبيّن أن نظرية نيوتن، التي تعرضت لأصعب الامتحانات وتعززت بشكل أفضل مما كان لأي عالم أن يحلم به، غير يقينية ومجرد فرضية مؤقتة، لن يبقى أمل في توقع أن تتبوأ أي نظرية فيزيائية أخرى منزلة تتجاوز منزلة الفرضية.
آنذاك، لم يحظ هذا الإدراك بأي حال بقبول عام. صحيح أنه كان هناك الكثير من منظّري المعرفة الذين أكدوا الطابع الفرضي الذي يسم معرفتنا العلمية، لكن جميعهم تقريبًا افترضوا أن الفرضية قد تصبح عبر التعزيز أكثر احتمالًا بحيث تبلغ درجة من اليقين لا سبيل لتمييزها عن احتمال درجته 1. وما إن تبلغ الفرضية هذه الدرجة من اليقين، حتى تنتفي الحاجة إلى وصفها بالفرضية وتصبح جديرة بلقب نظرية التشريفي. إنها لا تُقبل ضمن المعرفة العلمية إلا إذا كانت يقينية، وكانت يقينيتها قابلة للتبرير. ذلك أن العلم معرفة، والمعرفة تستلزم اليقين والتبرير: القدرة على أن تكون مكرسة (أو مؤسسة) إمبيريقيًا أو عقلانيًا.
لم تطرأ أي تغيّرات مهمة على هذه الرؤية في المعرفة العلمية في الفترة الفاصلة بين عمل كانط نقد العقل الخالص (Critique of Pure Reason) وعمل كارناب البنية المنطقية للعالم (Der logisch Aufbau der Welt)[13]. وحتى المناوئان العظيمان في هذا التقويم للعلوم الاستقرائية؛ جون ستيوارت مل (John Stuart Mill) ووليام هيول (William Whewell)، يوافقان على هذا الموقف.
وقد أدركت الآن أنه إذا كانت هناك نظرية تحصل على أعلى درجة تعزيز يمكن تصورها، فلا بد أنها نظرية نيوتن. من جهة أخرى، كل التنبؤات العلمية الناجحة التي استنبطت بمساعدة نظرية نيوتن قابلة لأن تستنبط بمساعدة نظرية أينتشتاين. كل ما يوصف بأنه يشكل الأسس الإمبيريقية في صالح نيوتن إنما يتكلم وفق هذا في صالح أينشتاين. وهناك فضلًا عن هذا تنبؤات يمكن استنباطها باستخدام نظرية نيوتن تناقضت مع بعض تنبؤات أينشتاين. ولهذا فإن النظريتين متعارضتان: وكان في الوسع إجراء تجارب حاسمة (experimenta cruces) بينهما.
لم تنفذ معظم التجارب الحاسمة التي اقترحها أينشتاين في زمنه (باستثناء انثناء أشعة الضوء في المجال التثاقلي للشمس، وربما حركة الحضيض الشمسي لعطارد؛ غير أنه كان في الوسع تفسير كلتا الظاهرتين بسبل مغايرة لنظرية أينشتاين). أما اليوم فقد أجريت كل التجارب التي اقترحها أينشتاين، كما أجري عدد آخر من التجارب. ويبدو أن النتائج في صالح أينشتاين وضد نيوتن. على ذلك فإن القياسات صعبة في كل الحالات، والنتائج ليست جديرة تمامًا بالثقة. لا أرغب إذن في زعم أن النظرية النيوتنية قد تم دحضها (تكذيبها). غير أن الموقف المنطقي-الإبستمولوجي الذي كشفت عنه نظرية أينشتاين موقف ثوري. إنه يبين أنه حتى نسبة إلى النظرية ن1 الأكثر نجاحًا إمبيريقيًا (أي نسبة إلى نظرية يُزعم أنها يقينية ومبررة أو مكرسة – أو مدلل عليها – إمبيريقيًا)، يرجح أن تكون هناك نظرية منافسة ن2 تتناقض منطقيًا مع ن1 (ومن ثم يلزم أن تكون إحداهما على الأقل كاذبة)، تم تعزيزها من قبل كل التجارب السابقة التي عززت ن1. بتعبير آخر، على الرغم من أن ن1 ون2 متناقضتان بشكل متبادل، فإنهما قد تقودان إلى تنبئين لا سبيل للتمييز إمبيريقيًا بينهما ضمن نطاقات واسعة بشكل اعتباطي، وضمن أي واحد من هذه النطاقات، وكلاهما معزز بدرجة كبيرة.
ولأن النظريتين ن1 ون2 متناقضتان بشكل متبادل، تتضح استحالة أن تكون كل منهما «يقينية». ووفق هذا، يستحيل حتى على النظرية التي تعززت بالقدر الأعظم من الشمولية أن تكون يقينية: نظرياتنا خطّاءة وتظل خطّاءة، حتى حين تتعزز بشكل كبير[14].
آنذاك كنت أقرأ أعمال أينشتاين، مؤمِّلًا أن أعثر فيها على هذه النتيجة المترتبة على ثورته. وما وجدته بالفعل هو دراسته «الهندسة والخبرة» (Geometrie und Erfahrung) التي كتب فيها يقول:[15]
«بقدر ما تتحدث الإقرارات الرياضية عن الواقع، تكون غير يقينية، وبقدر ما تكون يقينية، لا تتحدث عن الواقع».
في البداية، عممت من الرياضيات على العلم بوجه عام:[16]
«بقدر ما تتحدث الإقرارات العلمية عن الواقع، تكون قابلة للتكذيب، وبقدر ما لا تكون قابلة للتكذيب، لا تتحدث عن الواقع».
(يتضح أن أينشتاين يشير بهذه العبارات اليقينية التي لا تتحدث عن الواقع إلى بونكاريه (Poincare) والمواضعتية (conventionalism)، أو فكرة أن قانون العطالة تعريف ضمني للحركة دون قوة، ويُعد من ثم تعريفًا لمفهوم القوة).
وهذه الفكرة المتعلقة بلا يقينية أو خطئية كل النظريات البشرية، حتى الأفضل تعزيزًا منها، هي ما اسميتها لاحقًا «الخطّائية» (falliblism). (في مبلغ علمي كان تشارلز ساندرز بيرس (Charles Sanders Pierce) أول من استخدم هذا المصطلح).
غير أن الخطّائية، بطبيعة الحال، لا تكاد تختلف عن الجهل السقراطي. باختصار، لدينا التالي:
-
سقراط: أعرف أني لا أعرف شيئًا. (ولا أحد يعرف أكثر من هذا).
-
كانط: نظرية نيوتن علم قابل للتبرير، ولذا فإنها تشكل معرفة يقينية. (ولهذا دُحض زعم سقراط بحقيقة وجود العلم). وهكذا يخلص إلى السؤال: كيف يمكن للعلم أن يكون ممكنًا؟
-
أينشتاين: المعرفة العلمية بالعالم غير يقينية. (ولهذا فإن المعرفة العلمية ليست معرفة بالمعنى التقليدي للكلمة؛ ولا حتى بمعنى اللغة السارية، ولا وفق الاستخدام الفلسفي، على الأقل حتى كتاب كارناب بنية[17]). وهكذا، على الرغم من إنجاز نيوتن العظيم، تظل خطّائية سقراط في النهاية صحيحة.
هنا بودي أن أعبّر عن أملي في أن يصبح التبصّر السقراطي المتواضع في جهلنا مرة أخرى منقبة فكرية سائدة. ولعل كل العلماء الطبيعيين العظماء يتفقون على هذا التبصّر: من غاليليو الذي يتحدث في كتابه محاورة (Dialogue) عن «تلك الكلمات الحكيمة والمتواضعة «لا أعرف»»[18]، مرورًا بكبلر ونيوتن[19] ثم أينشتاين ومن أتوا من بعده. كل العلماء الطبيعيين هؤلاء كانوا خصومًا للاعتقاد الدوغمائي في سلطة العلم: لقد كانوا خصومًا لما نسميه اليوم العلموية (scientism).
غير أن خصوم العلموية اليوم لم يفهموا هذا بعد. ولعلهم لم يفهموا أيضًا أن الخطّائية تقوض العلموية. إنهم ليسوا خصومًا للاعتقاد الدوغمائي في سلطة العلم بقدر ما هم خصوم غير ناقدين للعلم؛ إنهم أشياع دوغمائيون لأيديولوجيا مناوئة للعلم.
– 2بعض التعليقات النقدية حول نص هذا الكتاب، خصوصًا نظرية الصدق
(1) أثناء كتابتي المشكلان الأساسيان وأيضًا منطق الكشف العلمي، لم يكن عمل آلفرد تارسكي (Alfred Tarski)[20] العظيم في الصدق (truth) قد نشر بعد. ومثل كثيرين غيري، لم أكن أفهم بشكل واضح مفهوم الصدق.
ولفكرة الصدق أهمية أساسية لنظرية المعرفة، خصوصًا المعرفة العلمية. ذلك أن العلم بحث عن الحقيقة [[الصدق]]: ليس امتلاكها، بل السعي وراءها.
وتفترض هذه الصياغة، التي يمكن العثور عليها أيضًا في الفقرة قبل الأخيرة من منطق الكشف العلمي، التمييزات الحاسمة بين الصدق والتيقن (اليقين)، أو بين الصدق والتبرير، وبين الحقيقة الموضوعية والاعتقاد الذاتي. في المشكلان الأساسيان، أحافظ أحيانًا على التمييز بينهما بشكل كاف.
ليس عذرًا أن الاستخدام الساري للغة يغذي الخلط؛ وأنه يمكن قفوه إلى كزينوفانيس وحتى هوميروس (Homer)؛ وأن فكرة أن الصدق يتجلى فكرة سائدة[21]؛ وأنه حتى في أيامنا هذه، يظل بالمقدور العثور على هذا الخلط في كتب فلسفية كثيرة.
(2) في تقديري، هناك فحسب نظرية واحدة في الصدق جديرة بالتأمل الجاد: نظرية التطابق. حسب هذه النظرية يكون الإقرار صادقًا إذا كان يتفق، أو يتطابق مع الوقائع أو الواقع. غير أن هذه النظرية تثير مباشرة مشكلًا: يبدو كما لو أنه سوف يكون من الصعب جدًا شرح ما يعنيه «الاتفاق» أو «التطابق» بين إقرار ما وواقعة ما. غير أن آلفرد تارسكي تمكّن من حل هذا المشكل بشكل كامل، وقد قام بهذا بأسلوب بسيط بشكل مفاجئ ومُرض بشكل بدهي.
عادة ما نستخدم لغتنا في الحديث عن وقائع: واقعة أن هناك قطة تنام هنا مثلًا. إذا أردنا أن نشرح التطابق بين الإقرارات والوقائع، نحتاج إلى لغة نستطيع أن نتحدث فيها عن إقرارات – أي كينونات لغوية بعينها – وعن وقائع. ومنذ صدور أعمال تارسكي، أصبحت اللغة التي نستطيع التحدث فيها عن كينونات لغوية تسمى «لغة ماورائية» (metalanguage). أما اللغة التي نتحدث عنها، ونتحدث عن كينوناتها، فتسمى «لغة شيئية» (object language). اللغة الماورائية التي نستطيع أن نتحدث فيها ليس فقط عن لغة شيئية بل نستطيع أن نتحدث فيها أيضًا عن وقائع (كما هو حال اللغة الطبيعية)، هي ما يسميها تارسكي بـ«اللغة الدلالية» (semantic language). كي يتسنى لنا شرح التطابق بين الإقرارات والوقائع، يتضح أننا نحتاج إلى لغة دلالية ماورائية.
إذا استخدمنا اللغة الإنكليزية [[العربية]] كلغة دلالية ماورائية، نستطيع أن نتحدث مثلًا عن إقرار باللغة الألمانية (لغة شيئية)، مثل «Ein katze shlaft hier». آنذاك يكون في وسعنا أن نقول في لغتنا الدلالية الماورائية:
الإقرار بالألمانية (لغة شيئية)، «Ein katze shlaft hier»، يطابق الواقعة إذا، وفقط إذا، كانت هناك قطة تنام هنا.
وعلى هذا النحو، إذا كانت لدينا لغة ماورائية لا نستطيع أن نتحدث فيها عن إقرارات فحسب بل نستطيع أيضًا أن نصف فيها وقائع من قبيل أن هناك قطة تنام هنا، تكاد تصبح حقيقة قدرتنا على الحديث عن تطابق بين الإقرارات والوقائع، والكيفية التي نستطيع بها القيام بذلك، حقيقة عادية لا تثير خلافًا.
وفي حين أنه لا ريب في أن حاجتنا إلى مثل هذه اللغة الماورائية، أو حاجتنا إلى استخدام لغتنا كلغة ماورائية، كي نتحدث عن التطابق بين إقرار وواقعة، ليست أمرًا تافهًا، فإنها سهلة تمامًا على الفهم.
بهذا الشرح للتطابق بين إقرار (لغة شيئية) وواقعة توصف في اللغة الدلالية الماورئية، يُردُّ على الاعتراض الأساسي على نظرية التطابق في الصدق، ونستطيع أن نقول بعبارات عامة إن الإقرار يكون صادقًا إذا كان يتطابق، أو يتفق، مع الوقائع.
(3) سوف أذكر هنا بإيجاز أمرين آخرين
(أ) حين أقول،
«الإقرار في اللغة الشيئية، Ein katze shlaft hier، يطابق الواقع»،
فإن هذا الإقرار [[باللغة العربية]] حول إقرار باللغة الألمانية ينتمي إلى اللغة الماورائية [[العربية]]. وقد أثبت تارسكي أنه يلزم لتجنب المفارقات أن تميَّز اللغة الماورائية بدقة عن اللغة الشيئية. المحمولان «يطابق الوقائع» و«صادق» ينتميان إلى اللغة الماورائية، ويرتبطان بإقرارات لغة شيئة بعينها. فضلًا عن ذلك، حين نتحدث عن محمولي اللغة الورائية هذين، فإننا نتحدث في لغة ماوراء-ماورائية (meta-metalanguage). ونتيجة لذلك، ثمة هرمية من اللغات الماورائية. وما دمنا نتذكر هذا، ونعي حقيقة أن محاميل اللغة الماورائية خطوة في هذه الهرمية أعلى من تعبيرات اللغة الشيئية (الإقرارات مثلًا) التي تنتمي إليها، فإنه لا يهم ما إذا كنا نستخدم اللغة الطبيعية نفسها (أو بالأحرى أجزاء مختلفة من اللغة الطبيعية نفسها)، [[العربية مثلًا]]، كلغة ماورائية وكلغة شيئية.
(ب) لا تنتمي كلمة «صادق» إلى اللغة الماورائية في كل استخدامتها:
المحمول «… صادق» ينتمي دائمًا إلى اللغة الماورائية، في حين قد يستعاض عن الفراغ «..». باسم (أو معيِّن) إقرار في اللغة الشيئية. غير أن التعبير «يصدق أن ..». ليس تعبيرًا في اللغة الماورائية، بل عبارة في اللغة الشيئية نفسها التي تنتمي إليها العبارة المستعاض بها عن «..»..
فعلى سبيل المثل، الإقرار «يصدق أن هناك قطة تنام هنا» ينتمي إلى اللغة نفسها التي ينتمي إليها «هناك قطة تنام هنا».
لا واحد من هذين الإقرارين يتسم بطابع ماوراء-لغوي: فكلاهما يتحدث عن قطة، ولا واحد منهما يتحدث عن أي تعبيرات لغوية. ومن وجهة نظر منطقية، يتخذ كل منهما القيمة الصدقية نفسها: فإما أن كليهما صادق (إذا كانت هناك قطة تنام هنا) أو أن كليهما كاذب (إذا لم تكن هناك قطة تنام هنا). من وجهة نظر منطقية، الإقراران متكافئان وينتميان إلى اللغة نفسها. في المقابل، فإن الإقرار: «الإقرار >هناك قطة تنام هنا< صادق»، أو بتعبير أكثر اختصارًا، «>هناك قطة تنام هنا< صادقة»، ينتمي إلى اللغة الماورائية للغة الشيئية التي ينتمي إليها الإقرار «هناك قطة تنام هنا».
في الأمثلة التي اعتبرنا لتونا، يبدو في البداية أن المحمول «… صادق» لا يقوم بأي وظيفة مهمة، شأنه في ذلك شأن العبارة «يصدق أن ..».. غير أننا نستطيع وضع قواعد ماوراء-لغوية مهمة، من قبيل:
«لا إقرار كاذبًا يمكن اشتقاقه منطقيًا من فئة (أو نسق) تتألف من إقرارات صادقة جميعها».
يتضح هنا أن الحد ماوراء-اللغوي «صادق» قد يقوم بدور مهم. وسوف يصبح هذا الأمر أكثر وضوحًا حين نترجم هذه القاعدة وفق نظرية التطابق.
«لا إقرار يخالف الوقائع يمكن اشتقاقه منطقيًا من نظريات (أنساق من الإقرارات) تطابق الوقائع».
وهذا يفسر جزئيًا لماذا نبحث في العلم عن الحقيقة، أي عن نظريات صادقة.
(4) يمكن بسط نظرية التطابق في الصدق على النحو التالي:
إذا كان إقرار ما باللغة الإنكليزية إقرارًا صادقًا، يستبين أن مكافئاته بالألمانية، والفرنسية، واليونانية، إلخ.، سوف تكون صادقة هي الأخرى: الإقرار يكون صادقًا أو كاذبًا رفقة فئته من الترجمات المتكافئة. ولهذا يلزم اعتبار الصدق أو الكذب لا بوصفه خاصية لإقرار مفرد، بل كخاصية لمعناه؛ ويمكن اعتبار معنى الإقرار فئة ترجماته المتكافئة، أو ما تشترك فيه كل الترجمات المتكافئة. وهكذا فإن الإقرار يكون صادقًا إذا كان معناه صادقًا؛ أي إذا كان الإقرار وكل مكافئاته تطابق الوقائع.
وعلى نحو مشابه، يمكن وصف اعتقاد أو فكرة بأنه صادق إذا كان الإقرار الذي يصوغ هذا الاعتقاد أو الفكرة صادقًا.
ومن البيّن أن كل حالات البسط هذه لنظرية تارسكي في التطابق لا تحدث تغييرًا مهما. إنها تشترك جميعها في فكرة أن الصدق أو الكذب هو في الأساس خاصية تختص بها إقرارات وصفية تم التعبير عنها لغويًا.
وفي تقديري أن الفكرة السائدة – التي تبنّاها أيضًا برترند رسل[22] – أن التطابق يكمن في التشابه بين صورنا الذهنية أو مفاهيمنا وبين الوقائع – كما لو أن التطابق يكمن في التشابه بين الصورة الفوتوغرافية وموضوعها – خاطئة بشكل أساسي. غير أنها صحيحة بقدر ما تتضمن نظرية التطابق بوصفها كذلك. ما يتم إغفاله هو أنه حتى الشخص الأعمى والأصم-الأبكم يستطيع استيعاب فكرة الصدق إذا تعلّم، كما فعلت هيلين كيلر (Helen Keller)، اتقان اللغة. أما الكائن البشري الذي لم يتعلم استخدام اللغة فلن يكون في وسعه استيعاب هذه الفكرة.
(5) إذا قبلنا نظرية التطابق – مبدأ أن صدق الإقرار إنما يكمن في تطابقه مع الوقائع – يصبح من البيّن أنه يلزمنا تمييز الصدق عن التيقن أو اليقين، أو عن القابلية للتبرير أو البت أو الإثبات.
قد نكون أكثر أو أقل تيقنًا أو ثقة من أن إقرار ما صادق، أو أنه كاذب. وهذا يثبت بوضوح الفرق بين التيقن أو اليقين من جهة، والصدق من جهة أخرى.
قابلية الإقرار للإثبات أو التبرير تستلزم صدقه؛ لكن العكس ليس صحيحًا: قد يطابق إقرار الوقائع (أي يمكن أن يصدق) دون أن يكون قابلًا للإثبات أو للتبرير بأي طريقة أخرى.
(6) من المهم بوجه خاص للتقويم الناقد لصياغات رديئة بعينها في المشكلان الرئيسان أن نميز بشكل قاطع بين مسألة ما إذا كان الإقرار قابلًا للبت – أو يمكن لنا إثبات أنه صادق أو كاذب – ومسألة صدقه. لم أكن آنذاك أدرك هذا التمييز بشكل واضح بما يكفي. لقد كنت أتحدث بين الحين والآخر عن «نمط الصحة»، قاصدًا القابلية للبت (القابلية للتحقق والقابلية للتكذيب)؛ أي إمكان إثبات أن إقرارًا ما صادق أو ربما كاذب. ومن البيّن أنني لم أميز دائمًا بين الصدق أو الكذب القابل للبت من جهة، والقيمة الصدقية (أي صادق وكاذب)[23] من جهة أخرى: أحيانًا أستخدم «صادق» بمعنى «صادق بشكل قابل للبت».
(7) النظريات الكلية فرضية وتخمينية بشكل أساسي، لأنها ليست صادقة بشكل قابل للبت. غير أن هذا لا يعني أن صدقها مستحيل. كل ما في الأمر هو أننا لا نستطيع التيقن من صدقها. ولكن إذا لم تميَّز «صادق» على نحو كاف عن «صادق بشكل قابل للبت» أو «صادق يقينًا»، قد يخلص المرء بسهولة إلى وصف الفرضيات «بالتخييلات» (بالمعنى الذي يريده فينغر (Vaihnger)). وهذا خطأ آخر أرتكبه أحيانًا في المشكلان الأساسيان؛ وهو خطأ جسيم[24].
وعلى الرغم من هذه الأخطاء، التي نجدها أيضًا لدى مؤلفين آخرين (وحتى بعد سنوات عدة)، ثمة فقرات أخرى في الكتاب تخلو من هذه الاختلالات؛ وفي مبلغ علمي، لم تعد مثل هذه الأخطاء ترد في منطق الكشف العلمي.
(8) سوف أناقش الآن ما أسميه معيار التأريف (criterion of demarcation)، معيار الطابع الإمبيريقي-العلمي للنظريات (أنساق الإقرارات).
كما هو معروف، اقترحتُ القابلية للدحض الإمبيريقية («القابلية للتكذيب» («falsifiability»)) معيارًا للتأريف. قد تُدحض النظرية إمبيريقيًا أو يتم تكذيبها إذا كانت هناك إقرارات ملاحظية («إقرارات أساسية»، «إقرارات اختبارية») يدحض صدقها النظرية؛ أي يثبت كذبها. أو بدلًا من ارتهان القابلية للتكذيب لوجود مثل هذه الإقرارات، لنا أيضًا أن نشترط وجود أحداث ممكنة قابلة للملاحظة؛ أي أحداث تستبعد النظرية المعنية أو «تحظر» وقوعها. أحيانًا أسمي مثل هذه الأحداث الممكنة «مكذِّبات ممكنة».
كي نضرب مثلًا متطرفًا؛ حدوث عكس في اتجاه الحركة (البادية) للشمس لمدة تبلغ (مثلًا) ست ساعات مكذِّب ممكن لكل النظريات الفلكية تقريبًا، من أنكسماندر وبطليموس وحتى نيوتن وأينشتاين. ولهذا فإن هذه النظريات قابلة للتكذيب؛ إنها نظريات علمية إمبيريقية (لديها «محتوى إمبيريقيًا»).
(9) تعرّض معياري للتأريف مرارًا لسوء الفهم وبسبل عجيبة. مثل ذلك أن مصطلح «القابلية للتكذيب» شُرح على أنه يعني «عرضة للتزييف أو الفساد» بدلًا من أن يعني «القابلية للدحض» – وبيّن أن هذا تم على يد شخص بحث عنها بضمير في معجم دودن[25] (Duden) أو معجم آخر.
وبدلًا من ذلك، تعرضت الغاية من التأريف لسوء فهم تام عبر افتراض أنني رغبت في تحديد خصائص النظريات المقبولة في الوقت الراهن في العلوم الإمبيريقية؛ في حين أني قصدت فصل كل القضايا التي يمكن اعتبارها بشكل صحيح نظريات إمبيريقية-علمية، بما فيها نظريات عفا عنها الزمن أو تم دحضها – أي كل النظريات الإمبيريقية الصادقة والكاذبة – عن النظريات العلمية الزائفة، وأيضًا عن المنطق، والرياضيات البحتة، والميتافيزيقا، والإبستمولوجيا والفلسفة بوجه عام. وثمة افتراض آخر مؤداه أني اقترحت وجوب اعتبار كل الإقرارات المستبعدة وفق معيار التأريف «خالية من المعنى»، أو «غير معقولة»، أو «غير مقبولة».
تقريبًا كل الطلاب المهتمين (وأكثر من أستاذ واحد) استجابوا لمعياري في التأريف في البداية بالتساؤل: «ولكن هل معيار التأريف هو نفسه قابل للدحض إمبيريقيا؟» وبطبيعة الحال هو ليس كذلك، فهو في النهاية ليس فرضية إمبيريقية-علمية بل مبدأ فلسفي: مبدأ في ما بعد-العلم. فضلًا عن ذلك، فإنه ليس دوغما بل اقتراح حصل في كل النقاشات الجادة على تعزيز قوي.
وفق هذا فإن معيار التأريف ليس إمبيريقيًا. لم يتم الوصول إليه عبر ملاحظة ما يقوم به أو لا يقوم به العلماء، سواء بدراسة علماء بقيد الحياة أو دراسة تاريخ العلم. غير أنه معين لنا في تاريخ العلم؛ فهو يحدد لنا ما ينبغي علينا تضمينه وما ينبغي علينا استبعاده في تاريخ العلم الإمبيريقي.
إذا أصبح «مكذِّب ممكن» ما متحققًا بالفعل، أي صدق إقرار ملاحظي، «أساسي»، يتضارب مع نظرية ما؛ أي إذا وقع بالفعل حدث تحظر النظرية وقوعه، فقد تم تكذيب النظرية؛ وأصبحت نظرية كاذبة مفنّدة. ويتضح أن مثل هذه النظرية الكاذبة والمكذَّبة قابلة للتكذيب، وتتسم من ثم بطابع إمبيريقي-علمي، على الرغم من أنها تُستبعد، بمقتضى دحضها، لكونها نظرية كاذبة (ولكن ليس لكونها نظرية غير علمية) من فرضيات العلم المقبول.
وعلى هذا النحو، لو توقفت الشمس (فيما يظهر لنا) عن حركتها أو توقفت الأرض فجأة عن الدوران دون أن تقع كارثة، لدُحض علم الفلك والفيزياء النيوتونية والأينشتاينية. وكذا الشأن لو أن هذا الحدث وقع بعد فناء الجنس البشري، ولم يكن هناك من يشهد وقوعه: «الحدث القابل للملاحظة» حدث يمكن من حيث المبدأ ملاحظته إذا كان هناك ملاحظ مناسب في الوقت المناسب[26].
للنظريات التي تكون على شاكلة النظريات الأينشتاينية والنيوتونية في الجاذبية عدد لامتناه من المكذِّبات الممكنة. ثمة عدد كبير من حركات الكواكب والأقمار الممكنة محظورة تمامًا من قبل مثل هذه النظريات.
بعض الحركات تبدو أول وهلة مستبعد («محظورة»)، لكنها محظورة فحسب في ظروف بعينها؛ بافتراض، على سبيل المثل، أننا نعرف جميع الكواكب وأننا أخذناها في الحسبان.
وكما نعرف، أدى انحراف في الفلك المحسوب لكوكب يورانيوس إلى اكتشاف نبتون. الحدث الذي ظهر في البداية كما لو أنه مكذِّب لنظرية نيوتن أضحى يشكل انتصارًا مقنعًا لها.
وكنت قد أشرت إلى هذا الأمر مرارًا. غير أن بعضًا من طلابي السابقين أساء فهمه. لقد اعتقدوا أن أي تكذيب مزعوم للنظرية النيتونية قابل لأن يصبح انتصارًا عبر افتراض وجود كتلة مجهولة (وربما غير مرئية).
لكن هذا مجرد خطأ فيزيائي (أو رياضي). أولًا، قد تكون هناك حركات قابلة من حيث المبدأ للملاحظة لكنه لا سبيل لتفسيرها عبر أي فرضية مساعدة من هذا القبيل (عكس مفاجئ في وجهة الحركات مثلًا). ثانيًا، نستطيع باستخدام مجساتنا الفضائية أن نعرف ما إذا كان الكوكب غير المرئي، أو الكتلة الثقيلة غير المرئية، التي استنبطنا وجودها، موجودة بالفعل في الموقع المحسوب.
وهكذا، وكما سبق أن ذكرنا، ثمة عدد لامتناه من الحركات الكوكبية التي تستبعدها نظرية نيوتن. غير أنه ليس هناك سلوك بشري ممكن تستبعده نظريات التحليل النفسي (فرويد (Freud) ، وإدلر (Adler)، وينغ (Yung)).
لدينا هنا تقابل حاسم أنكره كثيرون، تمامًا كما هو متوقع.
(10) تحدثت حتى الآن عن حوادث فعلية مكذِّبة (أي حوادث فعلية تقوم بالتكذيب) أو عن إقرارات مكذِّبة صادقة.
مسألة إذا كان في وسعنا التأكد من وقوع مثل هذا الحدث المكذِّب بالفعل، ومن صدق الإقرار المكذِّب المناظر، مسألة مختلفة تمامًا.
هذه المسألة لا تمت بصلة لمعيار التأريف بوصفه كذلك. إن معيار التأريف لا يتعلق إلا بحوادث وإقرارات أساسية ممكنة من حيث المبدأ. ويتضح تمامًا أنه توجد هنا لاتماثلية (asymmetry) بين القابلية للتحقق والقابلية للتكذيب. ثمة نظريات كلية بعينها قابلة من حيث المبدأ للتكذيب، أو الدحض، بسبب حدث قابل للملاحظة (أو إقرار أساسي وصفي مناظر)؛ غير أنه يستحيل تبريرها أو التحقق منها عبر مثل هذا الحدث أو الإقرار.
وهذه اللاتماثلية حقيقة منطقية أساسية لا تتأثر بأي مشكلات تتعلق بالظفر بيقين إمبيريقي يتم بواسطة ملاحظاتنا.
(11) وهذه المشاكل قائمة بالفعل، وقد أكدت هذه الحقيقة في منطق الكشف العلمي[27]. لكنها لا تتعلق إطلاقًا بالقابلية للتكذيب كمعيار للتأريف.
إنها تتعلق فحسب بمسألة ما إذا كنا قمنا بالفعل بتكذيب نظرية عبر الملاحظات. مسألة ما إذا كان التكذيب حدث بالفعل قد تكون مهمة وصعبة؛ ولكن يلزم فصلها بشكل قاطع عن مسألة القابلية الممكنة من حيث المبدأ للتكذيب (أي مسألة معيار التأريف).
وينزع مصطلح «النزعة التكذيبية» (falsificationism) الذي تجادل بعض نقادي بحرية كثيرًا حوله، إلى المزج بين المسألتين. ولكن لعل عرضي لم يكن دائمًا واضحًا بما يكفي.
(12) في المشكلان الرئيسان تحدثت تحديدًا عن أشياء من قبيل «القابلية النهائية للتكذيب»[28]. وكما سبق أن اقترحت، هناك بالفعل قابلية نهائية للتكذيب، ولكن، وكما أكدت في منطق الكشف العلمي[29]، من المؤكد تقريبًا أنه لا وجود لتكذيب يقيني (أو حاسم) عبر الملاحظات. هذا على وجه الضبط هو الموضع الذي يرد فيه الجهل السقراطي، والخطّائية (Fallibilism)، وعدم يقينية المعرفة العلمية. يمكن دائمًا، أو دائمًا تقريبًا على الأقل في كل الحالات المهمة، أن نكون مخطئين.
وبطبيعة الحال يلزم أن نسلّم بوجود حالات، تافهة، يكاد يستحيل فيها أن نكون مخطئين[30]. لا ريب في وجود عدد هائل من هذه الحالات، لكنها ليست ذات أهمية. ويمكن بوجه عام تحصين النظريات العلمية ضد التكذيب. (هانز آلبرت (Hans Albert) هو أول من استخدم مصطلح «التحصين»[31]، وقد تحدثت في منطق الكشف العلمي بأسلوب غير مناسب بعض الشيء عن «حيلة نصير المواضعتية»[32]). غير أن أهم سبل تحصين كل النظريات العلمية، أو معظمها على الأقل، لا يؤثر فيما أصفه بالقابلية للتكذيب؛ أي القابلية للتكذيب بالمعنى المقصود من معيار التأريف: وجود «مكذِّبات ممكنة».
(13) وفيما يتعلق بمصطلح «النزعة التكذيبية» (الذي أميل إلى تجنبه)، بودي أن ألحظ أنني لم أقل إطلاقًا إن التكذيب مهم، أو أنه أكثر أهمية من التحقق. القابلية للدحض مهمة (وأكثر أهمية من القابلية من التحقق، تحديدًا لأن القابلية للتحقق لا تقبل التطبيق على النظريات العلمية)؛ ذلك أن الأمر المهم بوجه خاص هو الموقف النقدي: المنهج النقدي.
يتميز الموقف النقدي بحقيقة أننا لا نحاول التحقق من نظرياتنا بل نحاول دحضها. التحقق رخيص، إذ يسهل العثور عليه بالبحث عنه. التحقق المهم الوحيد محاولة جادة للتكذيب لم تنجز غايتها، بحيث أدت إلى تحقق بدلًا من أن تؤدي إلى تكذيب.
وبطبيعة الحال، يمكن دائمًا أن ينتج تكذيب عن الاختبار التالي للنظرية نفسها.
وكما يتضح، فإن الموقف النقدي هو موقف البحث عن خطأ. وهذا لا ينطبق فحسب على اختبار نظرياتنا الإمبيريقية، بل ينطبق أيضًا، بوجه أعم، على نقد النظريات الفلسفية. ومن الطبيعي أنه لا ينبغي على المرء أن يسرف في الاهتمام بالأخطاء التي يسهل إصلاحها، بل عليه إذا أمكن له أن يصلحها قبل الشروع في ممارسة النقد الجاد.
وكان سبق لنصير النزعة الاستقرائية فرنسيس بيكون (Francis Bacon) أن أدرك أهمية الموقف النقدي، والبحث عن تكذيبات، عوضًا عن البحث الناجح دائمًا تقريبًا عن تحققات؛ ما لم يدركه هو أن التحققات لا تحوز أهمية، ما لم تكن دحوضًا فاشلة.
(14) أتحدث مرارًا في المشكلان الرئيسان عن مبدأ الاستقراء، أي المبدأ الذي يجعل، إذا كان صادقًا، الاستدلال الاستقرائي صحيحًا. المثل الذي استشهدت به على مبدأ الاستقراء[33] (على الرغم من أنه قد لا يكون مهمًا لحجتي) ليس مناسبًا بوصفه مبدأ للاستقراء. ثمة شكوك تساورني بخصوص إمكان صياغة مبدأ للاستقراء يبدو مرضيًا، ابتداء على أقل تقدير. قد يكون التالي صياغة لمبدأ استقراء ممكن:
«بنية العالم هي بحيث إن القاعدة الممكنة (الافتراضية) المدعومة بما لا يقل عن 1000 حالة تحقق مفردة («عينية» بالمعنى الذي يريده بيكون)، قاعدة صحيحة بشكل كلي».
يمكن استخدام مثل هذا المبدأ كمقدمة كبرى لاستدلال استقرائي من 1000 مقدمة تصف حالات فردية على نتيجة تصوغ قانونًا كليًا.
وبطبيعة الحال، أي مبدأ من هذا القبيل سوف يكون كاذبًا. بصرف النظر عن قدر تضخيمنا لعدد الحالات، سوف يكون دائمًا كاذبًا يمكن أن نرى بندول الساعة في الجانب الأيسر أي عدد من المرات؛ لكنه ليس دائمًا في الجانب الأيسر. وقد أدى هذا إلى حض بيكون على البحث عن حالات سلبية بغية التحصن من تعميميات مبتسرة.
ولكن حتى هذا لا يكفي. إن سلسلة من الحالات الإيجابية، مهما طالت، مرفقة بغياب حالات سلبية، لا تكفي لتأكيد تواتر ذي طابع قانوني (law-like regularity). ثمة عدد لا يحصى من الأمثل على هذا – أمثلة على قوانين استقرائية بدا لفترة طويلة أنها صحيحة (سوف أشير إليها بالتعبير «إقرارات لاوجودية»[34])، تدعهما سلسلة من الحالات الإيجابية ذات حجم اعتباطي وبغياب موضوعي للحالات السلبية، لكنها دُحضت في النهاية بحالة سلبية جديدة تمامًا. أمثلة: «لا وجود لسحب طولها 1000 متر وعرضها أقل من 30 مترًا» – «لا وجود لطيور أو آلات طيران تزن أكثر من طنين». إننا نرى مباشرة أنه مع كل اختراع جديد وما ينتج عنه، يتم دحض عدد هائل من الاستقراءات الممكنة التي بدت صحيحة حتى ذلك الوقت، ولآلاف السنين وربما أكثر. كي تكون جديرة بالتأمل الجاد، يلزم نظرية الاستقراء أن تستبعد مثل هذه الاستقراءات. لا أعرف نظرية من هذا القبيل، ولا نظرية يمكن أن تلهمنا بالقيام بشيء من هذا القبيل.
لا يقود مطلب استدلال استقرائي صحيح إلى صياغة مبدأ في الاستقراء ويفضي من ثم إلى متراجعة لامتناهية فحسب؛ بل يبدو أنه ليس بالإمكان صياغة مبدأ في الاستقراء يتسم بقدر متواضع من الوجاهة.
(15) ما ممكن ضعف النزعة الاستقرائية (Inductivism) الأساسي؟ إنه لا يتعين في هدفها؛ ذلك أن النزعة الاستقرائية والنزعة الاستنباطية (Deductivism) تتفقان على حقيقة أن هدف العلم إنما يتعيّن في اكتشاف تواترات ذات طابع قانوني، نستطيع بمساعدتها تفسير حوادث طبيعية وفهمها. إن الخلل الحاسم في النزعة الاستقرائية إنما يكمن في نظريتها الرائجة والخاطئة بشكل أساسي في الذهن البشري، نظرية الصفحة البيضاء، التي وصفتُها بنظرية «الدلو في الذهن». حسب هذه النظرية، الذهن البشري خامل أساسًا. الحواس تؤمّن «البيانات» («الحسية»)، ومعرفتنا، في جوهرها، تعبير خامل عن هذه «المعطيات».
في المقابل، تقر نظريتي أنه لا شيء «معطى» لنا؛ أن حواسنا تكييفات نشطة أصلًا، وأنها نتيجة لتغيرات، أي أنها نذور فرضيات؛ والفرضيات محاولات نشطة للتكيف.
نحن كائنات نشطة، خلاقة، مبدعة، حتى لو كانت اختراعاتنا محكومة بالاختيار الطبيعي. وهكذا يُستعاض عن خطاطة المثير-الاستجابة بخطاطة تغير-اختيار (تغير = فعل جديد). حياة الحيوانات العليا، خصوصًا البشر، ليست روتينًا. تحديدًا، اكتساب المعرفة، واكتساب العلم، ليسا كذلك.
ومفهوم اكتساب المعرفة غير المعتاد هذا لن يحظى بسهولة بالقبول. ذلك أن الخبرة اليومية تعلّمنا فيما يبدو أن إغلاق عيوننا هو كل ما نحتاجه للتقليل بشكل حاد من معرفتنا بالعالم الخارجي؛ وأننا لن نحتاج إلا لفتحها كي نستقبل ثانية وبشكل مباشر وخامل تعليمات العالم الخارجي. غير أن هذا الوصف مضلل. إدراكنا الحسي نشط، فهو تشكيل نشط لفرضيات، حتى إن لم نكن واعين بذلك.
وإلى أن يحظى هذا المفهوم الجديد في اكتساب المعرفة (بل في الحياة البشرية) بالقبول، من المرجح أن يظل معظم الفلاسفة يراهنون على الاستقراء.
(16) وكنقطة أخيرة في هذه المقدمة، بودي أن ألحظ بأني اتفقت مع الناشر على طباعة مجموعة أجزاء بعينها[35] ببنط صغير لأني أرغب في التنصل بوجه خاص من هذه الأجزاء. أولًا، هذه أجزاء ليست مهمة، فهي، جزئيًا على الأقل، ذات طبيعة اصطلاحية؛ وثانيًا، لأن المصطلحات (المؤسسة جزئيًا على عمل كارناب الأصيل إلى حد كبير AbriB der Logistik [36] قد عفا عنها الزمن). ومن بين المصطلحات التي أصبحت الآن نادرة الاستخدام (أو يندر استعمالها بالمعنى الذي استعمله كارناب) مصطلح «منطقاني» («logistic»)، حيث أصبحنا نتحد الآن عن «المنطق الرمزي» أو «المنطق الرياضي». يستخدم كارناب أيضًا عبارة «استلزام عام» (أحيانًا في الإشارة إلى قانون طبيعي). ومن الأشياء الأخرى التي عفا عنها الزمن تحليل فكرة الاستنباط المنطقية المركزية. لا يلزمنا التمييز بين الاستلزام (المادي فضلًا عن الصوري) والقابلية للاشتقاق أو الاستنباط فحسب، بل أيضًا بين الاستنباط المنطقي والإثبات المنطقي. غير أن هذا لم يصبح واضحًا، على الأقل بالنسبة لي، إلا بعد كتاب كارناب (AbriB der Logistik).
بن، بكنغهامشاير/تشرين الثاني/نوفمبر 1978
هوامش (المشكلان الأساسيان في نظرية المعرفة):
[1] Arthur Schopenhauer, Die Grundprobleme de Ethikm behandelt in zwei akademischen Preisschiften: 1. Uber die Freiheit des menschlichen Willens …, II. Uber das Fundament der Moral … (1841; 2nd ed, 1860).
[2] Karl Popper, «Intellectual Autobiography», Philosophy of Karl Popper !. (edited by Paul Arthur Schilpp, 1974); Unended Quest: An Intellectual Autobiography (1976); Ausgangspunkte: Mein intellektuelle Entwicklung (German translation by Friedrich Griese and the author, 1979).
[3] Rudolf Carnap:,«Uber Protokollsatze», Erkenntnis 3 (1932), pp. 223 ff.
[4] يمكن اعتبار «أعرف أني لا أعرف شيئًا» تنويعة في مفارقة الكاذب («ما أقوله كاذب»). المثير أن كلمة «أكاد» تتجنب صوريًا مظهر المفارقة. ولهذا فإنه لا شك في أن «الارتيابية» (بهذا المعنى على الأقل) ليست «هراء بيّنًا»، كما يقول فتغنشتاين (Tractatus Logico–Philosophicus, 1918/1922, proposition 6.51). كذلك فإن الصياغة الكلاسيكية للارتيابية، «ليس هناك معيار كلي للصدق»، أبعد ما تكون عن الخلو من الدلالة [[الهراء]]: الحال أن الارتيابية بهذا المعنى نظرية صادقة. غير أنه لا ينبغي أن يستنتج المرء من هذا أنه لا سبيل إلى تحقيق تقدم في العلم.
[5] ليست أطروحة سقراط المتعلقة بالجهل أقدم صور الارتيابية. ثمة أطروحة أقدم عهدًا بكثير نجدها عند كزينوفانيس؛ انظر:
Hermann Diels and Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker (below cited as D-K).
ارتيابية كزينوفانيس مهمة بوجه خاص، فهي تقبل صراحة التقدم في معرفتنا (D-K B 18). انظر:
Book 1: Section 11, text to notes 28a and 28b, and my book Logik der Forschung (3rd ed, 1969, and subsequent editions), Preface to the 3rd ed., esp. p. XXVI.
[6] Isaac Newton, Philosopiae Naturalis Principia Mathemateca (1687).
[7] David Hume, A Treatise of Human Nature (1739/40).
[8] Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (2nd ed., 1787), Introduction, p. 20 [English translation by N. Kemp Smith (1929), 1965: Critique of Pure Reason, p. 56 Tr].
[9] See Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft (1786). (English translation by N. Kemp Smith (1929), 1965: Critique of Pure Reason, p. 56 Tr].
[10] Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (2nd ed., 1787), Introduction, p. 20 [English translation by N. Kemp Smith (1929), 1965: Critique of Pure Reason, p. 56 Tr].
طرح كانط السؤال المتعلق بإمكان علم طبيعي بحت بسبب نظرية أفلاطون ولم يتناول السؤال المتعلق بإمكان الرياضيات إلا في فترة لاحقة.
[11] Immanuel Kant, loc. Cit.
في هامش (pp. 20 ff.) English translator, loc. cit] يتعلق بالفقرة المقتبسة، يقول كانط: قد تظل الشكوك تساور كثيرين بخصوص علم طبيعي بحت [أي بخصوص واقعيته]. غير أنه لا يلزم المرء سوى اعتبار القضايا المتنوعة التي يمكن العثور عليها في بداية علم الفيزياء (الإمبيريقي [ومن ثم ليس «بحتًا»]) الذي يوصف بشكل مناسب بأنه كذلك، في ما يتعلق مثلًا … بالعطالة [قانون نيوتن الأول]، ولتساوي الفعل ورد الفعل [قانون نيوتن الثالث]، إلخ.، كي يقتنع أنه يشكل علم فيزياء بحت أو عقلاني ..». [التعليقات المحشورة بين أقواس معكفة تعزى إلى مؤلف الكتاب وليس كانط، Tr.] ق.
[12] Immanuel Kant, Prolegomena (1783), # 36, p. 113. English translation by Paul Carus, extensively revised by James W. Ellington (1977), p. 62. Tr.].
[13] Rudolf Carnap, Der logisch Aufbau der Welt (1928);
انظر على سبيل المثل ص. V، حيث يشترط كارناب «مطلب التبرير ومطلب الإثبات الملزم لكل أطروحة».
(The passage quoted in the 2nd ed., 1961, and in the 3rd ed., 1966, on p. XIX).
[14] أثناء كتابة المشكلان الأساسيان في نظرية المعرفة، ولسنين كثيرة بعدها، لم أتجاوز بشكل مهم التبصرات البدهية الآتية: (1) نظرية نيوتن معززة بشكل كبير. (2) نظرية أينشتاين معززة على الأقل بالقدر نفسه. (3) نظريتا نيوتن وأينشتاين متفقتان إلى حد كبير؛ على ذلك، فإنهما متناقضتان منطقيًا مع بعضهما البعض لأنهما، كما في حالة أفلاك الكواكب الغريبة إلى حد كبير مثلًا، تفضيان إلى تنبؤات متعارضة. (4) ولهذا يستحيل على التعزيز أن يكون احتمالًا (بمعنى أن يكون حسابًا للاحتمالات).
لسوء الحظ أني أغفلت إلى عهد قريب التفكر بشكل مفصل قي الحكم (4) الغاية في الوجاهة بداهة، كما تغاضيت عن إثباته عبر الأحكام (1)، و(2) و(3). غير أن الإثبات بسيط. لو كان التعزيز احتمالًا، لكان تعزيز «إما نيوتن أو أينشتاين» مساويًا لمجموع التعزيزين، لأن كلاهما يستبعد الآخر منطقيًا. ولكن لأن كليهما معزز بدرجة كبيرة، يلزم أن يكون لكل منهما احتمال أكبر من نصف (لأن النصف يعني أنه ليس هناك تعزيز). وعلى هذا النحو يلزم أن مجموعهما أكبر من واحد، وهذا مستحيل. ووفق هذا يستحيل أن يكون التعزيز احتمالًا.
ويمكن تعميم هذه الأفكار: إنها تقود إلى إثبات أنه حتى احتمال القوانين الكلية التي حصلت على أكبر قدر من التعزيز يساوي صفرا. وقد أثبت بيتر هافاز (Peter Havas)
(«Four-Dimensional Formulations of Newtonian Mechanics and their Relation to the Special and the General Theory of Relativity», Reviews of Modern Physics 36 (1964), pp. 938 ff).
أنه يمكن ترجمة نظرية نيوتن إلى صيغة شبيهة إلى حد كبير بصيغة نظرية أينشتاين، بحيث يساوي الثابت k في حالة أينشتاين c (سرعة الضوء) ويساوي في حالة نيوتن ψ. ولكن سوف يكون هناك في هذه الحالة عدد أكبر من النظريات المتنافية التي تكون فيها c ≥ k ≥ ∝ وتكون قابلة للعد، وجميعها معززة على الأقل بقدر تعزيز نظرية نيوتن. (نتجنب الاحتمالات القبلية الموزعة بشكل اعتباطي).
وفي كل الحالات، يمكن للمرء أن يختار من هذه الفئة من النظريات فئات قابلة للعد؛ على سبيل المثل نظريات تكون فيها k = c; k = 2c; …, k = cn; k = ψ. ولأن أي نظريتين مختلفتين في هذه السلسلة اللامتناهية متناقضتان منطقيًا مع بعضهما البعض، فإنه يستحيل أن يكون مجموع احتماليهما أكبر من واحد. وعن هذا يلزم أن لنظرية نيوتن المعززة إلى حد كبير حيث k = ψ احتمال يتناقص. (ولذا يستحيل أن يكون التعزيز احتمالًا بالمعنى المراد في حساب الاحتمالات). وسوف يكون من المثير سماع ما كان لمنظّري الاستقراء – كالبيزيين (Bayesians) مثلًا، الذين يماهون بين درجة التعزيز (أو «درجة الاعتقاد العقلاني») ودرجة الاحتمال – شيء يقولونه بخصوص هذا الدحض البسيط لنظريتهم.
[15] Albert Einstein, Geometrie und Erfhrung (1921), pp. 3 f.
[16] Karl Popper, «Ein Kriterium des empirischen Charakters theoretischer Systeme (Vorlaufige Mitteilung)’, Erkenntnis 3 (1933), p. 427:
«بقدر ما يتحدث الإقرار العلمي عن الواقع، يكون قابلًا للتكذيب، وبقدر ما لا يكون قابلًا للتكذيب، لا يتحدث عن الواقع».
وكان هذا «البلاغ التمهيدي» قد نشر ثانية في منطق الكشف العلمي (الطبعة الثانية؛ والطبعات اللاحقة)
[The Logic of Scientific Discovery (1959); 2nd ed., 1968; and subsequent editions). Tr.], New Appendix* (see text to note 4). Cf. also below, Appendix: Section V, text to note 4.
[17] Rudolf Carnap, loc. cit. (See above, note 10).
[18] Galilio Galilei, Dialogo … Doue ne congressi di Quattro giornate si discorre sopra due massimi sistemi de mondo Tolemaico, e Copernicano (1932), Giornata quatra, p. 439; dialog uber die beiden hauptsachlichsten Welstsysteme: Das Ptolemaische und das Kopernikanische (German translation by Emil Strauss, 1981), Vierter Tag, p. 465. [English translation by Stillman Drake (1953), 2nd ed., 1967: Dialogue Concerning the Two Chief Systems, p. 445. Tr].
[19] يمكن العثور في المصدر التالي على الاقتباس الشهير الآتي الذي يعزى إلى نيوتن: «لا أعرف كيف أبدو للعالم، لكني أعتبر نفسي مجرد طفل يلهو على شاطئ البحر، أسلي نفسي بين الحين والآخر بالعثور على حصاة أشد نعومة أو أكثر جمالًا مما نعتاد، فيما يستلقي بحر الحقيقة العظيم مجهولًا أمامي»:
Volume II, Chapter 27 of Sir David Brewster’s Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries of Sir Isaac Newton (1855), p. 407.
[20] Alfred Tarski, «Der Wahreitsbegriff in den Sparchen der deduktiven Diszplinen [Summary]», Anzeiger der Wissenschaften in Wien: Mathematisch-naturwissenschaftliche Klass 69 (1032), pp. 23 ff:, «Projecie prawdyw jezkach nauk dedukcjnych:, Travaux de la societe de sciences et des letters de Varsovie, Classe III: Sciences mathematiques et physiques 34 (1933); «Der Wahreitsbegriff in den formalisierten Sparrchen», Sudia Philosophiica 1 (1935), pp. 262 ff:, «The Concept of Truth in Formalized Languages» (English translation by Joseph Henry Woodger), in: A Tarski, Logic, Semantics, Mathematics (1956), pp. 152 ff.
[21] For Xenophanes (D-K B 34), see my translation: («Certain Truth») in Book I: Section 11, text to note 28b; also in Logik der Forschng (3rd ed., 1969; and subsequent editions), Preface to the Third Edition.
عند هوميروس الصدق في الغالب عكس الكذب؛ ولهذا فإنه ما يُعتقد أنه صادق. بخصوص النظرية المهمة تاريخيًا أن الصدق يتجلى، انظر مقدمة عملي تخمينات وتفنيدات (Conjectures and Refutations) (1963).
[22] Bertrand Russell, Human Knowledge: Its Scope and Limits (1948), p. 170.
[23] انظر خصوصًا الكتاب الأول: الجزء 6، والنص الخاص بالهامش *1، والعبارة «قابل للبت بشكل نهائي» التي ترد هناك، وأيضًا المصطلح «قيمة صدقية» في الفقرة الموالية.
[24] See Book I: Section 34, text to note *4 and *5 as well the text to these notes.
[25] Cf. Duden: Das groBe der deutschen Sprache II. (ed. Gunther Drosdowski, 1976). P. 794. [See also A Dictionary of the English Language, Vol. I (ed. Samuel Johnson, 1755/1967): «FALSIFIABLE: liable to be counterfeited or corrupted». Tr.].
[26] See Karl Popper, Logic der Forschung (1934; 2nd ed., 1966); and subsequent editions) [The Logic of Scientific Discovery, 1959 (2nd ed., 1968); and subsequent editions). Tr.], Section 28, penultimate paragraph.
[27] See Karl Popper, op.cit., Sections 29 and 30. Cf. also Book I: Section 11 near the end; and Appendix: Sections VIII (C, D) and IX.
[28] See e.g. Book I: Section 37, text to note *2.
[29] See note 8.
[30] مَثل رسل هو: «لا يوجد الآن وحيد قرن [مكتمل النمو] في الغرفة».
Cf. Ronald W. Clark, The Life of Bertrand Russell (1975), pp. 170, 680; Bertrand Russell, «Ludwig Wittgenstein», Mind, NS., 60 (1951), p. 297.
[31] See Hans Albert, Traktat uber Kritische Vernunft (1968; 4the., ed., 1980) [English translation by Mary Varney Rorty, 1985: Treaties on Critical Reason. Tr.].
[32] See Karl Popper, Logic der Forschung (1934; 2nd ed., 1966); and subsequent editions), Section 20. [The Logic of Scientific Discovery, 1959 (2nd ed., 1968); and subsequent editions), Section 20, Tr.].
[33] See Book I: Section 5, note *3 and text to note.
[34] بخصوص القوانين التي تتخذ صيغة «إقرارات-لاوجودية»، انظر:
Karl Popper, Logic der Forschung (1934; 2nd ed., 1966); and subsequent editions), Section 15 [The Logic of Scientific Discovery, 1959 (2nd ed., 1968); and subsequent editions). Section 15 Tr.]; and Karl Popper, «The Poverty of Historicism II»., N.S., 11 (1944), pp. 121 f. (The Poverty of Historicism, 1st ed., 1957; and subsequent editions, pp. 61 ff).
[35] Book I: Sections 27 to 29 (inclusive) and 31.
[36] Rudolf Carnap, AbriB der Logistik (1929).