
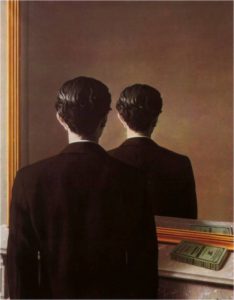 المشهورين والمؤثرين في القرن العشرين، ولا سيما جوتلوب فريجه “أبو الفلسفة التحليلية“، غير أن التركيز على هذه الفكرة، أو ربطها بأي أهمية حقيقية، سيكون من شأنه أن يضع للمرء معايير منخفضة للغاية. هايدغر كان معاديا للسامية وكان عنصريا. لا يوجد أي مبرر لمحاولة إعادة تأهيله وتقديمه بأنه “أقل عنصرية” من بعض أقرانه ومعاصريه. ولذلك يجب أن يُشجَب صراحة، دون تلطيف أو تردد.
المشهورين والمؤثرين في القرن العشرين، ولا سيما جوتلوب فريجه “أبو الفلسفة التحليلية“، غير أن التركيز على هذه الفكرة، أو ربطها بأي أهمية حقيقية، سيكون من شأنه أن يضع للمرء معايير منخفضة للغاية. هايدغر كان معاديا للسامية وكان عنصريا. لا يوجد أي مبرر لمحاولة إعادة تأهيله وتقديمه بأنه “أقل عنصرية” من بعض أقرانه ومعاصريه. ولذلك يجب أن يُشجَب صراحة، دون تلطيف أو تردد.Copyright © 2024 | مجلة حكمة: من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفي