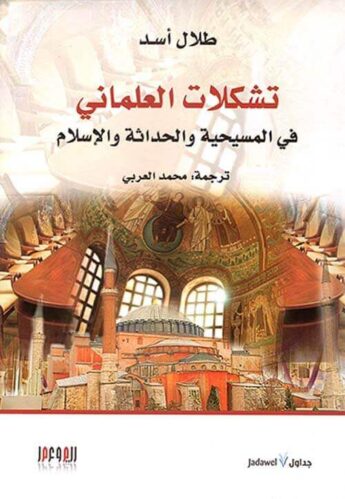
ما الذي قد تبدو عليه أنثروبولوجيا العلمانية؟
كتب علماء الاجتماع والمنظرون السياسيون والمؤرخون بغزارة عن العلمانية؛ فهي جزء من نقاش عام محتدم في مناطق كثيرة في العالم، خاصة في الشرق الأوسط. هل «العلمانية» عبء استعماري؛ رؤية عالمية شاملة تعطي الأسبقية للمادي على الروحي، أم هي ثقافة الاغتراب واللذة الجامحة الحديثة؟ أم أنها ضرورية للإنسانوية العالمية، ومبدأ عقلاني يدعو إلى كبت أو على الأقل إلى تقييد العاطفة الدينية حتى يمكن التحكم في مصدر خطير للتعصب والخرافة ويمكن تأمين الوحدة السياسية والسلام والتقدم؟[1] من الواضح أن التساؤل حول الكيفية التي ترتبط بها العلمانية كمذهب سياسي بـ العلماني كمبحث وجودي ومعرفي على المحك هنا.
على النقيض من بروز مثل هذه النقاشات، نادرًا ما أبدى الأنثروبولوجيون اهتمامًا بفكرة العلماني، على الرغم من أن دراسة الدين كانت في صلب اهتمامات الحقل منذ القرن التاسع عشر. وتظهر مجموعة من مقررات الدراسة في عدد من الكليات والجامعات حول أنثروبولوجيا الدين المعدة مؤخرًا من أجل الجمعية الأنثروبولوجية الأميركية[2] اتكالًا كبيرًا على موضوعات من مثل الأسطورة والسحر والعرافة واستخدام المهلوسات والطقوس كعلاج نفسي والملكية والتابوهات. توحي هذه الموضوعات المألوفة معًا بأن «الدين»، والذي موضوعه المقدس، يقع في نطاق اللاعقلاني. أما العلماني، حيث تقع السياسة والعلم الحديثان، فلا يظهر في هذه التوليفة. كما أنه لم يعالج في أي من النصوص التقديمية المعروفة جيدًا[3]. على أنه من شائع المعرفة أن الدين و العلماني مرتبطان بشدة، سواء في فكرنا أو في الطريقة التي ظهرا بها تاريخيًّا. فينبغي لأي علم يسعى إلى فهم الدين أن يفهم أيضًا آخره. وتحتاج الأنثروبوبوجيا، وهي العلم الذي سعى إلى فهم غرابة العالم غير الأوروبي إلى أن تدرك كليًّا ما دلالة أن تكون في آن واحد حديثةً وعلمانية.
لقد أخذ عدد من الأنثروبولوجيين في تناول العلمانية بنية نزع الغموض عن المؤسسات السياسية المعاصرة. وأينما رأى المنظرون السابقون العقل الدنيوي مرتبطًا بالتسامح، فإن هؤلاء الكاشفين يجدون الخرافة والعنف. ومن ثم، يشتكي مايكل توسيج Michael Taussig من أن المفهوم الفيبري المتعلق باحتكار الدولة الرشيد الشرعي للعنف يفشل في معالجة «الخصائص الثقافية الغامضة والأسطورية والملغزة والخفية في جوهرها والمفزعة بوضوح للعنف وقوته إلى الحد الذي يكون فيه العنف إلى درجة كبيرة غاية في حد ذاته، وهي إشارة، كما صاغها بنيامين، على وجود الآلهة». وفي رأي توسيج، «فإن التفسير المؤسسي للعقل من خلال العنف لا يقلص من دعاوى العقل فقط دافعًا إياه نحو الأيديولوجيا والأقنعة وتأثير السلطة، ولكن أيضًا .. اجتماع العقل والعنف معًا في الدولة يخلق مطلقية لفظة الدولة ليس فقط وحدتها الظاهرة وخيالات الإرادة والعقل الموحي بها إذا، ولكن الكيفية ذات الهالة وشبه المقدسة لهذا الإيحاء.. والذي يقف الآن ليمثل أساس كوننا مواطنين في العالم»[4]. وبمجرد أن يكشف عنها قناعها، أو هكذا يقترح، سوف تظهر الدولة الحديثة نفسها كأبعد من أن تكون علمانية. بالنسبة لهؤلاء النقاد، فإن النقطة الجوهرية في هذه القضية هي إذا ما كان اعتقادنا في الشخصية العلمانية للدولة أو المجتمع مبرر أم لا. أما وسم العلماني نفسه فيبقى بلا فحص.
أما الأنثروبولوجيون الذين يعرفون الشخصية المقدسة للدولة الحديثة غالبًا ما يلجأون إلى المفهوم العقلاني للخرافة كي يشحذوا هجومهم. إنهم يتعاملون مع الخرافة باعتبارها «خطابًا مقدسًا» ويتفقون مع أنثروبولوجيي القرن التاسع عشر الذين نظروا للخرافات كتعبيرات عن الاعتقادات حول العالم الخارق للطبيعة وحول الأزمنة والكينونات والأماكن المقدسة، وبالتالي هي الاعتقادات المضادة للعقل. بشكل عام، استخدمت كلمة «خرافة» كمرادف للا عقلاني أو غير العقلاني، وللارتباط بالتقليد في العالم الحديث، وللتوهم السياسي والأيديولوجيا الخطيرة. تقف الخرافة في طريقة التفكير هذه كنقيض لـ العلماني، حتى بالنسبة لهؤلاء الذين يستدعونه بإيجابية.
سأشير إلى الخرافة كثيرًا في ما هو آت، غير أني لست في معرض التنظير لها؛ فهناك العديد من الكتب المتاحة في هذا الخصوص[5]. أما ما أريد فعله هنا فهو تعقب العواقب العملية لاستخداماتها في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من أجل تفحص الطرق التي تكوّن بها العلماني. ولأن كلمة «خرافة» التي ورثها المحدثون من العالم القديم تغذي عددًا من المضادات المألوفة الاعتقاد والمعرفة، العقل والخيال، التاريخ والتخيل، الرمز والاستعارة، الطبيعي والروحاني، المقدس والمدنس، وهي ثنائيات تتخلل الخطاب العلماني الحديث، خاصة في نمطه الجدالي. ومع اهتمامي بتبديل شبكة المفاهيم التي تشكل العلماني، سأناقش العديد من هذه الثنائيات.
لقد دخل مصطلحا «العلمانية» و«العلماني» اللغة الإنكليزية على يد المفكرين الأحرار في منتصف القرن التاسع عشر كي يتجنبوا تهمة أن يكونوا «ملحدين» أو «كفارًا»، وهي مصطلحات تحمل معاني اللاأخلاقية في مجتمع ما زال مسيحيًّا في معظمه[6]. كانت هذه النعوت ذات أهمية ليس لأن المفكرين الأحرار كانوا منشغلين بسلامتهم الشخصية، لكنهم سعوا إلى توجيه السياسة الجماهيرية للإصلاح الاجتماعي في مجتمع متسارع التصنيع[7]. فأصبحت عادة اللامبالاة وعدم الإيمان أو العدوانية الراسخة تجاه السلطات والطقوس المسيحية الآن متشابكة مع مشروعات إعادة التأسيس الاجتماعي من خلال وسائل التشريع. لقد أُجري التفاوض على إعادة التوكيد النقدية بين قانون الدولة والأخلاق الشخصية[8]. وافترض هذا التحول فكرة جديدة عن المجتمع باعتباره مجموع السكان من الأفراد الذين يتمتعون ليس فقط بحقوق وحصانات ذاتية ولديهم صلاحيات أخلاقية، ولكن أيضًا يملكون القدرة على انتخاب ممثليهم السياسيين هذا التحول وقع فجأة في فرنسا الثورية (باستثناء النساء والخدم) وتدريجيًّا في أنكلترا القرن التاسع عشر. لقد كان اتساع حق الاقتراع الشامل بدوره مرتبطًا كما يشير فوكو بأساليب جديدة من الحكم قائمة على أنماط جديدة من الطبقية والحسابات، وأكال جديدة من التبعية. إن هذه المبادئ علمانية بمعنى أنها تتعامل فقط مع النزعة الدنيوية، وهو ترتيب يختلف كثيرًا عن التصور القروسطي عن الجسد الاجتماعي للأرواح المسيحية التي يمنح كل منها كرامة متساوية أي اعضاء مرة واحدة لمدينة الرب والمجتمع الإنساني المصنوع ربانيًّا. لقد سهلت هذه النقلة الخطابية في القرن التاسع عشر من التفكير في «الطبيعة الإنسانية» الثابتة إلى النظر إلى البشر من خلال «الحالة العادية» المكونة، الفكرة العلمانية عن التقدم الأخلاقي المعرف والموجه بواسطة القدرة الإنسانية المستقلة. باختصار، يبدو أن العلمانية كمذهب سياسي وحُكمي له جذر في المجتمع الليبرالي للقرن التاسع عشر أسهل في فهمه من العلماني نفسه. ومع هذا فالاثنان مترابطان.
ليس التالي تاريخًا اجتماعيًّا للعلمنة، وليس حتى تاريخًا لها كفكرة. إنها استكشاف للافتراضات الإبستمولوجية لـ العلماني التي قد تساعدنا على أن نكون أكثر وضوحًا حول ما تشتمله أنثروبولوجيا العلمانية. إني أجادل بأن العلماني ليس استمرارًا للديني الذي سبقه ضمنًا (أي أنها ليست المرحلة الأخيرة من الأصل المقدس) وليست مجرد انفصال بسيط عنه (أي أنها ليست العكس، أي جوهر يستبعد المقدس). إنني أتعامل مع العلماني باعتباره مفهومًا يجمع معًا مجموعة من السلوكيات والمعارف والحساسيات في الحياة الحديثة. ولتقدير هذا، ليس من الكافي إظهار أن ما يبدو ضروريًّا عرضيًّا، أي أنه في جوانب معينة، يتداخل «العلماني» بوضوح مع «الديني». بل إنها مسألة إيضاح الطريقة التي تترابط بها العوارض بالتغيرات نحو المفاهيم، أي كيف تجلي التغيرات في المفاهيم التغيرات في السلوكيات[9]. وبالتالي، فإن غرضي في هذا الفصل الأولي ليس تقديم إطار السردية التاريخية بل القيام بسلسلة من التحقيقات حول ما أصبحنا نطلق عليه العلماني. لذا، وعلى الرغم من أني أتتبع بعض الصلات على حساب بعضها الآخر، يجب ألا يؤخذ هذا ليعني أن هناك خطًا واحدًا لتتبع تشكل «العلماني». في رأيي، ليس العلماني مفردًا في أصله أو ثابتًا في هويته التاريخية، على الرغم من أنه يعمل من خلال سلسلة من المعارضات المعينة.
أبني مادتي كلها تقريبًا من تاريخ الغرب الأوروبي، لأن ذاك التاريخ كانت له تأثيرات عميقة على الطرق التي رأيت من خلالها العلمانية وطبقت في بقية العالم المتمدن. وأحاول أن أفهم العلماني، والطريقة التي تكون بها وأضحى حقيقيًّا واتصل بالظروف التاريخية المعينة وانفصل عنها.
أما التحليلات التي أقدمها هنا فقد قصد بها نقيض التاريخ الانتصاري لـ العلماني. أتبنى، كما تبنى آخرون، الرؤية القائلة بأن «الديني» و«العلماني» ليسا صفات ثابتة جوهريًّا. إلا أني لا أدعى أنه إذا أزلنا المظاهر، فسوف نرى أن ما يبدو بوضوح كمؤسسات علماني هي في حقيقتها دينية. بل أفترض على العكس من هذا أنه لا يوجد شيء ديني في جوهره، ولا يوجد أي جوهر شامل يعرف «اللغة المقدسة» أو «التجربة المقدسة». ولكني أفترض أيضًا أنه كانت هناك انقطاعات بين الحياة العلمانية والمسيحية أعيد فيها ترتيب الكلمات والممارسات وأن أجروميات خطابية جديدة قد حلت محل السابقة. وأقترح أن التضمينات الأوسع لهذه التحولات في حاجة إلى الاستكشاف. وبالتالي، أتناول مقتطفات من تاريخ خطاب ما، والذي غالبًا ما يتم التأكيد عليه كجزء جوهري من الدين، أو على الأقل له علاقة وثيقة به، كي أوضح مدى اعتماد المقدس و العلماني على بعضهما البعض. وأسهب قليلًا في الكيفية التي أسهمت فيها الخرافة الدينية في تشكيل المعرفة التاريخية الحديثة والحساسية الشاعرية الحديثة (مستعرضًا الطريقة التي جرى تبنيها من خلال بعض العرب المعاصرين)، بيد أني أجادل بأن هذا لا يجعل التاريخ والشعر بالضرورة «دينيًّا».
إن هذه أيضًا حالة بعض تصريحات المفكرين الليبراليين الأخيرة الذين تعتبر الليبرالية بالنسبة لهم نوعًا من الخرافة الخلاصية. إنني أشير إلى العنف اللصيق بها مع احتراز بأن الخرافة العلمانية في الليبرالية يجب ألا تختلط بالخرافة الخلاصية في المسيحية، على الرغم من بعض التماثلات بينهما. ومن نافلة القول إن غرضي ليس انتقاد هذه الخرافة أو التصديق عليها. وبشكل أكثر عمومية، فلست مهتمًا بالهجوم على الليبرالية سواء كانت نظامًا سياسيًّا أم مذهبًا أخلاقيًّا. وهنا، كما في حالات أخرى أتعامل معها، أريد ببساطة أن أخرج من فكرة أن العلماني هو قناع للدين، وأن الممارسات السياسية العلمانية غالبًا ما تحاكي الممارسات الدينية. ومن ثم أنتهي بإطار مختصر بتصورين عن «العلماني» أراهما متاحين للأنثروبولوجيا اليوم، وأقوم بهذا من خلال مناقشة نصوص لبول دي مان وفالتر بنيامين بالترتيب.
قراءة للأصول: الخرافة والحقيقة والسلطة
تكتسب اللغات الأوروبية الغربية الكلمة خرافة Myth من اللغة اليونانية؛ وقد كانت الحكايات حول الآلهة اليونانية موضوعات نموذجية للتأمل النقدي عندما أصبحت الميثولوجيا علمًا في بداية العصر الحديث. لذا فإن من الضروري عرض تاريخ موجز للكلمة والمفهوم.
في كتابه التنظير للخرافة Theorizing Myth يفتتح بروس لينكولن الحديث بمقدمة رائعة عن تاريخ المصطلحين اليونانيين Mythos وLogos. ومن ثم نعلم بأن كتاب الحيسيدية الأعمال والأيام يربط الحديث عن الخرافة Mythos بالحقيقة Alethea، والحديث عن الكلمة Logos بالأكاذيب والخداع. الـ Mythos حديث قوي؛ فمن المعتاد أن يغلب حديث الأبطال. ويشير لينكولن إلى أنه في هوميروس تعود الكلمة Logos إلى الحديث المقصود به عادة استرضاء شخص ما ويستهدف المحاربين أثناء القتال.
أما في سياق التجمعات السياسية فإن للــ Mythoi نوعين؛ «مستقيم» و«ملتوٍ». وتعمل الـ Mythoi في سياق القانون بالقدر الذي يعمل فيه Logoi في سياق الحرب. أما Mythos عند هوميروس، فهي «فعل خطابي يشير إلى السلطة ويمارس لمدة وغالبًا في العلن بانتباه كامل لكل التفاصيل»[10]. إنها لا تعني الحكاية الرمزية التي ينبغي كشفها أو في هذا الإطار حكاية زائفة. في الأوديسا، يمتدح أوديسيوس الشعر مؤكدًا أنه حقيقي، وأنه يؤثر على مشاعر السامعين وأنه قادر على التوفيق بين الاختلافات، وينتهي إلى روايته الشعرية معلنًا أنه «قص خرافة Mythos»[11].
في البدء، عمد الشعراء إلى منح القوة إلى خطابهم عبر تسميته Mythos أي وحي من الآلهة (وهو ما يطلق عليه المحدثون، بلهجة جديدة، العالم الما ورائي)؛ ولاحقًا، لقّن السفسطائيون أن كل الكلام قد ولد مع البشر (الذين عاشوا في هذا العالم). ويكتب جان برمير Jan Bremmer أن «فيما تفصل الرؤية المسيحية بقوة الرب عن العالم.. فإن آلهة اليونان لم يكونوا متجاوزين بل منخرطون مباشرة في العمليات الطبيعية والاجتماعية.. وبسبب هذه الروابط كتلك الموجودة بين دنيا الإنسان والإله، وصفت دراسة مؤخرًا الرؤية اليونانية للعالم بأنها «مترابطة» على العكس من رؤيتنا الكونية «الانفصالية»»[12]. غير أن هناك ما هو أكثر من حضور أو تجاوز القداسة في علاقتها بالعالم الطبيعي. إن فكرة «الطبيعة» نفسها متغيرة داخليًّا[13]. ولأن تمثيل الإله المسيحي باعتباره موجودًا في معزل بعيد في العالم «الماورائي» يؤشر على بناء الفضاء العلماني، والذي أخذ في الظهور في بداية العصر الحديث. ويأذن هذا الفضاء بــ «الطبيعة» ليعاد تصورها مادة قابلة للاستغلال ومحدودة ومتجانسة وخاضعة لقوانين الحركة. وأي شيء يتجاوز هذا الفضاء هو بالتالي «ماورائي»، وهذا المكان بالنسبة لكثيرين هو امتداد تخيلي للعالم الحقيقي ومسكون بالأحداث غير العقلانية والمخلوقات المتصورة[14]. لقد كان لهذا التحول أثر عميق على معنى «الخرافة».
ولم تكن خرافات Mythoi الشعراء، كما قال السفسطائيون، وحدها هي المؤثرة عاطفيًّا، إنها أيضًا أكاذيب بقدر ما يتحدثون عن الآلهة على الرغم من أن مثل هذه الأكاذيب قد يكون لها أثر محسن أخلاقيًّا على المستمعين. وقد التقط هذا الخط وشهد منعطفًا جديدًا من خلال أفلاطون الذي جادل بأن الفلاسفة، لا الشعراء، هم المسؤولون بالأساس عن التهذيب الأخلاقي. وفي معرض هجومه على الشعر، غيّر أفلاطون معنى الخرافة؛ فهي الآن تأتي لتدلل على كذبة مفيدة اجتماعيًّا[15].
لقد اتخذ مؤسسو الميثولوجيا التنويريون مثل فونتنيل Fontenelle رؤية معتقدات العالم القديم عن آلهته، ومثل عدد من الرجال المثقفين في زمانه، اعتبر دراسة الخرافة كمناسبة للتأمل في الخطأ الإنساني. فقال «على الرغم من أننا بدون تمييز أكثر تنورًا من أصحاب العقول البدائية التي ابتكرت FABLES في الإيمان الصالح.. فإننا ببساطة نعيد نفس الكرة العقلية التي جعلت من هذه الخرافات في غاية الجاذبية بالنسبة لهم. لقد أهلكوا أنفسهم لاعتقادهم أنها صحيحة، بيد أننا نهلك أنفسنا في غاية الساعة مع عدم اعتقادنا بصحتها. ولا يوجد خير من هذا مثالًا على أن العقل والخيال بينهما القليل من الصلة، وأن الأشياء التي تخلص العقل من وهمها لم تفقد أيًّا من جاذبيتها للخيال»[16]. لقد كان فونتنيل مطبعًا كبيرًا لــ «الظواهر الخارقة للطبيعة» في عهده عندما برزت «الطبيعة» كمجال مميز للخبرة والدراسة[17].
بيد أنه في عصر، لم تكن كل الخرافات أبدًا وحدها موضوعات «للإيمان» و«التحقيق العقلي». فباعتبارها عناصر للثقافة العليا في بدايات أوروبا الحديثة، كانت الخرافات جزءاً أصيلًا من حساسيتها المميزة: قدرتها المصقولة على الشعور المرهف، خاصة على التعاطف واستعدادها للتحرك بكل ما هو مثير للشفة في الفن والأدب. لقد صور أو ألمح الشعر والرسم والمسرح والتماثيل العامة والزينات الخاصة في منازل الأثرياء إلى خصائص ومساعي آلهة وإلهات ووحوش وأبطال اليونان. وقد كانت معرفة هذه القصص والرموز جزءًا أساسيًّا في تعليم الطبقة العليا. وسمحت الخرافات للكتاب والفنانين بتمثيل المشاعر والحوادث المعاصرة في ما نطلق عليه نحن الحديثين نمطًا خياليًّا. لقد سهلت المعالجات المثالية البعيدة للحب الجسدي والمدح المبالغ فيه للملك يسيرًا على السواء من خلال الأسلوب الخلاب. وقد يسّر هذا بدوره شكلًا من السخرية الساعية إلى أن تزيل الأقنعة أو أن تشيع الفهم. وأصبح من المقدور الهجوم على السلطة الكنسية دون مخاطرة الاتهام بالتجديف. وبشكل عام، كشف الهجوم الأدبي على الظواهر والرموز الخرافية عن تفضيل لحياة السعادة الحسية كنقيض للمثال البطولي، والذي أصبح ينظر إليه كأقل وأقل عقلانية في المجتمع البرجوازي. ولكن، وكما يذكرنا جان ستاروبينسكي Jean Starobinski، كانت الخرافة أكثر من مجرد لغة تزينية أو لغة ساخرة لصناعة مسافة من البطولي كمثال اجتماعي. ففي التراجيديات والأوبرات الكبرى في القرنين السابع والثامن عشر، قدمت الخرافات المادة التي من خلالها كان من الممكن استكشاف سيكولوجيا وعواطف الإنسان[18].
لذلك، فإن السؤال حول ما إذا كان الناس قد اعتقدوا أو لم يعتقدوا بهذه السرديات القديمة، سواء (كما ذهب فونتنيل) باللجوء إلى أكاذيب الخيال التي جعلت جذابة لا يشتبك إلى حد بعيد مع المساحة التي سكنها الخطاب الخرافي في الثقافة. لم تكن الخرافة مجرد تمثيل أو (سوء) تمثيل للحقيقي. لقد كانت مادة لتشكيل الممكنات وحدود الفعل. وبشكل عام، فهي تظهر وقد فعلت هذا من خلال تغذية الرغبة في إظهار الواقعي وهي رغبة أصبحت صعبة الإرضاء بتزايد، في ما تكاثرت الفرص التجريبية للحداثة.
ولاحظ عدد من المعلقين المحدثين أن مقولات كتلك التي لفونتنيل أضرت على تحول في التعارض الأقدم ما بين المقدس والمدنس إلى تعارض جديد بين الخيال والعقل، وهي المبادئ التي افتتحت التنوير العلماني[19]. ويرى هؤلاء أن هذا التغير ينبغي أن يرى كاستبدال للهيمنة العلمانية بالهيمنة الدينية. بيد أنني أظن أن ما لدينا هنا هو أمر أكثر تعقيدًا.
والنقطة الأولى الجديرة بالملاحظة هنا هي أن العقل الثنائي الأجدد قد تمتع بعمل كبير لتعريف وتقييم وتنظيم الخيال الإنساني الذي تعزى إليه الأسطورة. وقد عبر مارسيل ديتين Marcel Detienne عن هذا على هذا النحو: «تتعدد الإجراءات الإقصائية في خطاب علم الخرافات وتحملها لغة فضائحية تشير إلى كل رموز الآخرية. فالميثولوجيا هي دائمًا في جانب الأعراق البدائية والأدنى وشعوب الطبيعة ولغة الأصول والطفولة والتوحش والجنون دائمًا في جانب الآخر، كرمز مستبعد»[20]. غير أن المقدس لم يتمتع بهذه الوظيفة في الماضي؛ إذ لم يكن هناك بعد مجال في الحياة الاجتماعية ينظم فيه «المقدس». بدلًا من هذا، كانت هناك أماكن وموضوعات وأزمنة عديدة، لكل منها خصائصها وكل منها يتطلب سلوكًا وكلمات ملائمة لها. وتحتاج هذه النقطة إلى إيضاح، لذلك سأناقش الآن ثنائية المقدس/ المدنس قبل العودة إلى موضوع الخرافة.
استطراد حول «المقدس» و«المدنس»
في لاتينية الجمهورية الرومانية، كانت تشير الكلمة Sacer إلى أي شيء يمتلكه أي إله، تم «الاستيلاء عليه من منطقة الـ Profanum بفعل الدولة وتم تمريره إلى منطقة الـ Sacrum»[21]. ومع هذا كان هناك استثناء مثير: كان يستخدم مصطلح homo sacer للتعبير عن الشخص الذي يصبح، نتيجة لعنة (sacer esto)، خارجًا عن القانون وعرضة للقتل على يد أي شخص وبإفلات من العقاب. وبالتالي، وفيما كرست قداسة الملكية لرب جعل منها غير قابلة للانتهاك، فإن قداسة الإنسان المستباح Homo sacer جعلت منه خاضعًا للعنف بشدة. لقد شرح هذا الاستخدام المتناقض من قبل علماء الدراسات الكلاسيكية (بمساعدة معترف بها من قبل زملائهم الأنثروبولوجيين) من خلال «المحرم Taboo»، وهو مفهوم يفترض فيه البدائية يخلط ما بين أفكار المقدس وغير النظيف، وهي أفكار جاء الدين «الروحاني» لاحقًا ليميّز ويستخدمها على نحو أكثر منطقية[22]. ولفكرة أن «المحرم» هو الأصل الأولي لــ «المقدس» تاريخ طويل في الأنثروبولوجيا، والتي لم يستعر منها الكلاسيكيون وحدهم هذه الفكرة لفهم الدين القديم، ولكن أيضًا اللاهوت المسيحي كي يعيد بناء الدين «الحقيقي». وقد فحص الجانب الأنثروبولوجي من هذا التاريخ نقديًّا في دراسة لـفرانتس شتاينر Franz Stiener يوضح فيها أن فكرة «المحرم» قد بنيت على أسس إنثروغرافية ولغوية شديدة التزعزع[23].
طبقًا لقاموس أكسفورد للغة الإنكليزية Oxford English Dictionary، فإن كلمة sacred في الاستخدام الإنكليزي القديم تشير عمومًا إلى الأشياء والأشخاص والحوادث المفردة التي توجد منعزلة ومؤهلة بالتبجيل. بيد أننا لو تفكرنا في الأمثلة الموجودة في القاموس البيت الشعري «الفاكهة المقدسة، مقدس التقشف»، والكلمات المحفورة «مقدسة ذكرى صامويل باتلر» وشكل الخطاب «جلالتكم المقدسة»، والعبارة «الحفل المقدس» فمن المستحيل فعليًّا أن نعرف فعل الفصل أو التبجيل بكونهما نفس الفعل في كل الأحوال. ولا تقف ذات الأشياء أو المناسبات أو الأشخاص الذين يقال عنهم مقدسين في نفس العلاقة معهم. لقد كان الفكر اللاهوتي والأنثروبولوجي في القرن التاسع عشر هو الذي جعل من مجموعة من الاستخدامات الاجتماعية المتداخلة والمتجذرة في أشكال متبدلة وغير متجانسة، جعل منها جوهرًا مفردًا وثابتًا، وادعى أنها موضوع الخبرة الإنسانية الشاملة المسماة بــ «الديني»[24]. لا تجد المعارضة المفترضة بين «المقدس والمدنس» مكانًا لها في الكتابة ما قبل الحديثة. ففي لاهوت القرون الوسطى، كان التناقض الشائع ما بين «الإلهي» و«الشيطاني» (وكل منهما قوة متجاوزة)، أو ما بين «الروحاني» و«الزائل» (وكل منهما مؤسسات دنيوية) وليس ما بين المقدس الخارق للطبيعة والمدنس الطبيعي.
على سبيل المثال في فرنسا، لم تكن الكلمة sacre جزءًا من لغة الحياة المسيحية العادية في العصور الوسطى وفي باكر العصور الحديثة[25]. وكانت لها استخدامات مكتسبة، حيث كان من الممكن أن يشار بها إلى أشياء محددة (الأتباع) والمؤسسات (مدرسة الكرادلة) والأشخاص (جسد الملك)، بيد أنه لم تكن هناك خبرة فريدة يتم افتراضها في ما يتعلق بالأشياء التي تشير إليها، كما أن هذه الأشياء لم تكن تعزل بطريقة موحدة. أما الكلمة والمفهوم اللذان تعلقا بالدين الشعبي خلال كل تلك الحقبة، أي تعلق بالممارسات والحساسيات فقد كانت saintete، وهي ميزة رحمانية لأشخاص محددين وبقاياهم، تلك المتصلة بقرب بالأشخاص العاديين وعالمهم العادي. وقد أصبحت الكلمة sacre بارزة في زمن الثورة واكتسبت صدى مروعًا لدى السلطة العلمانية. وهكذا تتحدث مقدمة إعلان حقوق الإنسان والمواطن (1789) عن «الحقوق الطبيعية وغير القابلة للمصادرة والمقدسة»، ووصف الحق في الملكية في المادة 17 باعتباره مقدسًا. وقد كان شعار «الحب المقدس للوطن» تعبيرًا شائعًا في القرن التاسع عشر[26]. لقد أشر إلى الخبرة الفردية من خلال هذه الاستخدامات، وأصبحت السلوكيات المتوقعة من الشخص الذي يدعي امتلاكها مختلفة كليًّا عن أي شيء دلل عليه بالكلمة sacred في القرون الوسطى. وقد أصبحت الآن جزءًا من الخطاب وثيق الصلة بوظائف وتطلعات الدولة الحديثة العلمانية، والتي تعبر فيها عملية علمنة المواطنين الأفراد ومجموعة الشعب عن شكل من السلطة المطبعنة[27].
وقد وصف فرانسوا ايسمبريه Francois Isambert بتفصيل الكيفية التي وصلت بها المدرسة الدوركهايمية، القائمة على مفهوم روبرتسون سميث عن «المحرم» كشكل نموذجي من الدين البدائي، إلى المفهوم البحثي «المقدس» كجوهر شامل[28]. جاء المقدس كي يشير إلى كل شيء من المصلحة الاجتماعية الأحوال والتقاليد والمشاعر الجماعية، والتي يوضحها المجتمع كتمثيلات، وقد قيل أيضًا إنه المصدر التطوري للفئات الإدراكية[29]. وأصبح المقدس، الذي شكله الأنثروبولوجيون ثم استولى عليه اللاهوتيون، ميزة شاملة مخفية في الأشياء وحدًّا موضوعيًّا للفعل الدنيوي. لقد كان المقدس في آن واحد قوة متجاوزة فرضت نفسها على الذات ومساحة، لا ينبغي لها أن تنتهك، أي تصبح مدنسة، بسبب تهديد العواقب الوخيمة. باختصار، جاء «المقدس» ليتشكل كشيء غامض وخرافي[30] ومركز الانضباط الأخلاقي والإداري.
لقد كان صعود علم الأديان المقارن هو السياق الذي طورت فيه الأنثروبولوجيا المفهوم المتجاوز للمقدس. ويمكننا إيجاد نسخة مثيرة من هذا في أعمال ر. ر. مارت R. R. Marett [31]، والذي ذهب إلى أن الطقوس يجب أن ينظر إليها كمن يمتلك وظيفة تنظيم المشاعر، خاصة في المواقف الحرجة في الحياة، وهي الفكرة التي مكنته من تقديم تعريف أنثروبولوجي شائع للقرابين: فيقول «لأغراض أنثروبولوجية، دعونا نعرف القرابين كأي شعيرة يكون هدفها المحدد التعظيم أو التقديس. وبشكل أكثر وضوحًا، يعني هذا أية شعيرة تغطي وظيفة طبيعة بسلطة ذاتية خارقة للطبيعة»[32].
إن فكرة القربان كعادة مصممة كي تغطي على أزمات دورة الحياة («التزاوج» و«الموت» وما إلى ذلك) بــ «سلطة خارقة» لكونها بالضرورة «علاجًا نفسيًا دينيًا»، كما قالها مارت، مقدمة باعتبارها تملك تطبيقًا عامًا مقارنًا. لكنها تقف في تباين واضح على سبيل المثال مع المفهوم المسيحي القروسطي عن القربان. ومن ثم يعتبر اللاهوتي في القرن العشرين هيو أوف سانت فيكتور Hugh of St. Victor، وهو يرد على السؤال «ما القربان؟»، أن «القربان هو علامة على شيء مقدس»، لكنه يذهب قدمًا ليشير إلى أنه لن يحمل إشارات على الأشياء المقدسة، بسبب التماثيل والصور وكلمات النص المقدس المتنوعة، من دون أن تكون قرابين. لذلك يقدم سانت فيكتور تعريفًا أكثر كفاية وهو أن «القربان عنصر مادي أو جسدي (الأصوات والإيماءات والأردية والأدوات) التي توضع قبل الحواس بالخارج، ممثلة في التطابق ومدللة بالعادة ومحتواة بالتكريس على شيء من البركة الروحية والخفية». على سبيل المثال، فإن ماء التعميد يمثل غسل الخطايا من الروح بالتماثل مع غسل الدنس من الجسد ويدلل على أهمية كبيرة للمؤمن لأن المسيح هو من بدأ هذه الممارسة ويبث، بفضل كلمات وأفعال القس المعتمد الذي يمارس التعميد، البركة الروحانية. وليست الوظائف الثلاث هذه واضحة بذاتها، بل يجب أن يتم تعريفها وشرحها من قبل هؤلاء الذين في موقع السلطة. (وقد تعلم المسيحيون في القرون الوسطى معاني الرموز الواضحة المستخدمة في الطقس من خلال الشروحات المعتمدة)، وبالتالي، وبالنسبة لهيو، فإن القربان هو شبكة معقدة من المدللِين والمدللات والتي تعمل مثل الأيقونة، تذكاريًا. والأيقونة هي شيء في ذاته وعلامة في أذهان الممارسين صحيحي الانضباط؛ وهي تشير بالوراء إلى بعض الذكريات وإلى الأمام إلى التوقعات باعتبارهم مسيحيين[33]. وليس هناك معنى للقول، مع الإشارة إلى السردية التي يقدمها هيو، أن هناك في القرابين وظائف «طبيعية» تتمتع بسلطة «خارقة» (أي تمتع متجاوز)، فما زالت القرابين أقل من أن تكون علاجًا نفسيًا لعلاج البشر خلال أزماتهم الحياتية (أي خرافة مفيدة). ويؤكد هيو أن هناك ظروفًا جعلت من القرابين ألا يكون معترفًا بها على ما هي عليه، «ولهذا السبب تحتقر عيون الكفار التي لا ترى إلا الأشياء المرئية تبجيل قرابين الخلاص؛ لأن النظر في هذا وحده متوافق مع الأجناس الخفية التي لا يعترفون بها والفضيلة الداخلية وثمرة الطاعة»[34]. إن سلطة القرابين هي في نفسها تضمين للذات المسيحية مع ما تراه العين كتجسيد للنعمة الإلهية[35]. والنعمة نفسها ينظر إليها كحالة معينة من اللاوعي في إطار علاقة، وليس كمكافأة على الاجتهاد الطقوسي.
ما الذي سهّل جعل «المقدس» جوهريًا باعتباره قوة خارجية متجاوزة؟ إجابتي المبدأية على هذا هي أن التنظيرات حول المقدس كانت قد اتصلت مع التواصلات الأوروبية مع العالم غير الأوروبي في الوقت والمساحة المتنورة التي شهدت بناء «الدين» و«الطبيعة» باعتبارها تصنيفات عالمية. فمنذ العصور الحديثة المبكرة في أوروبا عبر ما عرف لاحقًا بالتنوير العلماني وخلال القرن التاسع عشر الطويل في أورويا وممتلكاتها، كانت الأشياء والكلمات والممارسات التي يمثلها ويميزها «أقوام الطبيعة Nature Folk» رآها الأوربيون كـ «فتييش Fetish» و«تابوو Taboo»[36]، وما كان قد اعتبر في القرن السادس والسابع عشر باعتباره «وثنية» و«عبادة للشيطان»[37] و«إخلاصًا لآلهة زائفة» أصبح المفهوم العلماني لــ «الخرافة» (أي البقاء بلا معنى)[38]، في إطار الفكر التطوري في القرنين الثامن والتاسع عشر. لكنها ظلت موضوعات وعلاقات أعطيت عن خطأ حالة الحقيقة، ومنحت عن جور سلطة فاضلة. وكان عليها أن تؤسس كصفات للوهم والطغيان قبل أن يتم تحرير الناس منها كما عرف فرويد عندما استخدم كلمتي «فيتيش وتابو» كي يعرف أعراض الكبت الأولى في العلاج النفسي للأفراد المحدثين.
ومن ثم يمكن أن يقال إن «التدنيس» هو نوع من الانعتاق القسري من الخطأ والطغيان. والعقل يتطلب أن تنفى الأشياء الخاطئة وتمحى أو أن يتم تحريمها أو إعادة موضعتها باعتبارها موضوعات يمكن أن ترى وأن تمسع أو تلمس من قبل الحواس المهذبة على نحو سليم. ومن خلال كشف القناع عن السلطة المدعاة (أي بتدنيسها)، فإن العقل الكوني يظهر مكانته باعتباره سلطة شرعية. ومن خلال التمكين لأشياء جديدة، تتأكد هذه الوضعية على نحو أبعد. لذا، فإن «حق الملكية المقدس» جرى تعميمه بعد أن جرى تحرير إقطاعات الكنيسة والأراضي المشاع. وتم التأسيس لــ «حرة الضمير» باعتبارها حقًا عامًا في معارضة مع السلطة الكنسية والقواعد التي مكنها الإفتاء في قضايا الضمير. ومع اللحظة الأولى للتحول نحو العلمانية، أصبحت هذه المبادئ ترانسندنتالية/ تجاوزية ووضعت في نطاق حركتها ضوابط قانونية وأخلاقية لحماية نفسها (حيث أصبح العنف ضرورة) باعتبارها مبادئ شاملة[39]. وعلى الرغم من أن التدنيس يبدو وكأنه تحويل للنظر من التجاوزية إلى الدنيوية، فإن ما يقوم به هو أنه يعيد ترتيب الحدود ما بين المتوهم والحقيقي.
ويرى ريتشارد كومستوك، من خلال تطوير رؤية دوركايمية (نسبة إلى إميل دوركايم) أن «المقدس باعتباره نوعًا من التصرف، ليس مجرد عدد من المظاهر المباشرة، بل هو نوع من القواعد ــ التصورات والتحريمات والممنوعات التي تحدد شكل السلوك وما إذا كان يحسب كمثال في نوعية ما في وضوع السؤال»[40]. إن هذا مفيد، بيد أن على المرء أن يمتثل للحقيقة الثلاثية وهي أن (1) كل السلوكيات التي تحكمها القواعد تحمل عقوبات اجتماعية، بيد أن (2) قسوة هذه العقوبات تختلف تباعًا للخطر الذي يمثله انتهاك هذه القواعد بالنسبة لتنظيم المجتمع، وأن (3) تقديرات هذه المخاطر لا تبقى تاريخيًا بلا تغير. إن الانتباه إلى هذه الحقائق يجب أن يحول انتباهنا من التركيز على تعريف «المقدس» كموضوع للخبرة إلى السؤال حول الكيفية التي يتشكل بها المشهد غير المتجانس من السلطة (الأخلاقية والسياسية والاقتصادية)، وما أهمية الانضباط (الفردي والجماعي). ولا يعني هذا أن «المقدس» ينبغي اعتباره كقناع للسلطة، بل إن ما ينبغي لنا النظر فيه هو ما الذي يجعل مجموعة معينة من الممارسات ممكنة ومرغوبة وإجبارية نظريًا، بما في ذلك ممارسات الحياة اليومية التي تنضبط بها الخبرة الذاتية[41]. ومن الممكن لهذا الاقتراب الذي أقدمه أن يمنحنا فهمًا أفضل للكيفية التي يمكن بها للمقدس (وبالتالي المدنس) أن يصبح موضوعًا ليس للفكر الديني فقط بل أيضًا للممارسة العلمانية أيضًا.
الأسطورة والنصوص المقدسة
أشرت سابقًا إلى جزء من وظائف الأسطورة باعتبارها خطابًا علمانيًا في فن وسلوكيات التنوير. أما ما تقوم به الأسطورة باعتبارها خطابًا مقدسًا في الدين والشعر خلال القرنين التاسع عشر والعشري أمر أكثر تعقيدًا. ومن الحتمي، في ما يلي أن أنتقي وأن أبسط.
لوحظ أن النقد الألماني الأعلى قد حرر الكتاب المقدس من «خطاب الوحي الإلهي» وسمح له بالاندماج في «نظام الدلالات الإنسانية»[42]، ومع ذلك، علينا أن نلاحظ أن هذا التحرير يدل على تغير واسع النطاق في معنى «الوحي» ــ أي التحول من إعادة توجيه الحياة نحو الغايات النهائية إلى سيكولوجيا القدرات الإبداعية التي يتسم «مصدرها» بالغموض، وبالتالي أصبح نوعًا من التفكر (الاعتقاد/المعرفة)[43]. وعلى هذا النحو، كانت الكلمات الموحاة موضوعًا لتبجيل شخص ما، ووسيلته/ها للتعبد في أزمنة وأماكن محددة. وانخرط الجسد الذي تربى عبر الوقت على الاستماع والترتيل والتحرك والثبات والصمت مع خصائص الكلمات، بأصواتها وإحساسها وشكلها. وقد اعتمدت ممارسة التعبد على نقش الأصوات والأشكال والإحساس في جهازه الحسي. وعندما سمع المتعبد الرب وهو يتحدث، كانت هناك رابطة حسية بين الداخل والخارج، اندماج بين الدال والمدلول. وقامت القراءة الصحيحة للنصوص التي مكنتها من سماع القداسة وهي تتحدث على تهذيب الحواس (خاصة السمع والكلام والنظر).
على النقيض من هذا، أحال النقد الكتابي الأعلى مادية الأصوات والعلامات إلى شعر روحاني يتولد تأثيره داخل الذات في ما يكون المؤمن منفصلًا عن حواسه. وكان تغير سابق قد ساعد على هذا التحول. وكما جادل جون مونتاغ John Montag فإن فكرة «الوحي» التي تشير إلى مقاولة تصدر عن كائن خارق للطبيعة وتتطلب قبولًا ذهنيًا من جانب المؤمن، إنما تعود إلى الحقبة الحديثة المبكرة. ويكتب مونتاغ، أنه بالنسبة للاهوتيين في العصور الوسطى «كان الوحي له علاقة بالأساس برؤية المرء للأشياء في ضوء غايته النهائية، وهو ليس باقة تكميلية من المعلومات حول «الحقائق» التي كانت جنونية، كما كانت، من جانب الإدراك العقلي أو الملاحظة المادية»[44]. وطبقًا لتوما الإيكوني، فإن الهدية النبوية للوحي هي عاطفة يخضع لها وليست قدرات يتم استخدامها، ومن بين الكلمات التي استخدمها للدلالة على الوحي كلمة inspiratio[45]. وقد ربطت تراتبية أفلاطونية جديدة للتوسطات القداسة بكل المخلوقات بما يسمح لوسيط اللغة أن يسهل الاتحاد بين المقدس والإنساني.
مع حركة الإصلاح (والإصلاح المضاد)، أصبحت القداسة متاحة كتابيًا دون وساطة، وأشار الوحي على الفور إلى وجوده ونواياه. وهكذا اكتسبت اللغة مكانة «الاستثنائية»؛ واعتبرت قادرة على «تمثيل» و«عكس»، وبالتالي أيضًا «حجب» الحقيقي. ويشير مايكل دي سيرتو Michel de Certeau إلى أن «التجربة، بمعناها الحديث، نشأت مع «نزع الصبغة الوجودية» عن اللغة deontologizing، ويرتبط بذلك أيضًا ظهور علم اللغة». ويرى بيكون Bacon وآخرون كثر أن التجربة تأتي في مقابل اللغة، باعتبارها ما يضمنها ويثبت وجودها. هذا الفصل بين اللغة المرجعية (التي تُظهر و/أو تنظم) والتجربة المرجعية (التي تتخطى و/أو تضمن) يبني هيكل العلم الحديث، بما في ذلك «العلم الروحاني»[46]. أينما كان الإيمان حينًا فضيلة، فقد اكتسب الآن حِسًا إبستمولوجيًا، وأصبح وسيلة للتعرف على للأشياء الخارقة للطبيعية، بالتوازي مع المعرفة بالطبيعة (العالم الحقيقي) عن طريق المنطق والملاحظة. هذا الاختلاف حول حقيقة «الوحي» يحتاج إلى تحقيق أبعد من ذلك، ولكن يمكن القول إن الإدراك الشاعري الحديث للوحي هو تكييف ذاتاني للتحولات المشار إليها هنا.
ولا أقصد، بالطبع، أن أضع تعميمًا تاريخيًا بسيطًا. فمن ناحية، فكرة الحوار الداخلي مع اﷲ لها جذور عميقة في التقليد الروحي المسيحي (وفي التقاليد غير المسيحية أيضًا)، ومن ناحية أخرى، كان الدمج بين الصوت الفيزيائي والحسي جزءًا من التجربة الإنجيلية الحديثة منذ القرن التاسع عشر على أقل تقدير[47]. ولكن، اهتمامي هنا ينصب على الجينيالوجيا. ولا أدعي أن الثقافة البروتستانتية فقط هي التي اهتمت بالحالات الروحية الداخلية وكأن الحياة المسيحية في القرون الوسطى، بتقاليدها الثرية في التجارب الروحية، لم يكن لها اهتمام بها. ولكنني مهتم في المقام الأول بسؤال تصوري: ماذا كانت الآثار الإبستمولوجية للطرق المختلفة التي اندمج فيها المسيحيون والمفكرون الأحرار على تنوعهم مع الكتابات المقدسة من خلال حواسهم؟ (إحباط، كبت، وتهميش واحدة أو أكثر من تلك الحواس يعتبر بالطبع أيضًا طريقة للاندماج مع طبيعتها المادية). كيف تحولت الكتابات المقدسة؛ الوسيط الذي اختبرت القداسة من خلاله، إلى أن يُنظر إليها على أنها معلومات عن أو من الخارق للطبيعة؟ وبشكل آخر، بأي كيف أصبحت المعارضة المحددة حديثًا بين الإشارة «المادية» فحسب والمعنى «الروحي» بحق، محورية لإعادة تشكيل «الوحي»؟
يقدم روبرتسون سميث Robertson Smith؛ عالم اللاهوت والأنثروبولوجيا، ونصير النقد الأعلى، مثالًا للتحول في اتجاه وصفة الوحي في مقاله حول العهد القديم كشعر، والذي يميز فيه الشعر كقوة عن الشعر كفن. ويتيح له ذلك وصف كل الشعر الأصيل، سواء العلماني أو الديني، بأنه «روحاني». فعندما يتحرك الشعر «من قلب إلى قلب»[48] يصبح تعبيرًا عن قوة متجاوزة يطلق عليها نقاد الأدب العلمانيون الآن المصطلح اللاهوتي «الإبيفانيا».
وبينما قاد الشك حول اعتبار مصدر الوحي تواصلًا إلى مساءلة فكرة أن النصوص المقدسة معطاة إلهيًا، أصبح الاهتمام بأصالتها التاريخية وأن لها جذورًا حقيقية، لحوحًا بشكل متزايد. إذا لم يوحِ اﷲ بالإنجيل مباشرة، فإن المعتقد المسيحي يحتاج على الأقل أن تكون روايات التي يتضمنها الكتاب عن المسيح عيسى موثوقة، لأنه حينها فقط ستضمن حياة وموت المسيح في العالم، وتشهد على حقيقة التجسد[49].
كُتب الكثير عن الطرق التي ساعد بها المؤرخون البروتستانتيون في تشكيل تصورًا للتاريخ بأنه موضوع جمعي واحد. يلاحظ جون ستروب John Stroup أنه «إذا كان التصور الجديد للتاريخ والمؤرخ قد علمن الدين الموحى به.. فقد عمد أيضًا إلى تقديس أحداث وثنية والمؤرخ العالمي .. ومع نهاية عصر التنوير تشابك التاريخ المقدس والوثني بشدة لدرجة صعوبة الفصل بينهما[50]. وفي نفس الموضوع، يكتب ستاروبينسكي Starobinski عن «أسطرة» mythicization التاريخ الحديث كنوع من التقدم: «ليس من الكافي الإشارة، كما فعل الكثيرون، إلى وجود عملية العلمنة في فلسفة التنوير، ومن خلالها طالب الإنسان بصلاحيات للعقل انتمت قبلًا للشعارات الإلهية. وكان هناك ميل مقابل أيضًا: الأسطورة، التي تم استبعادها مسبقًا واعتبارها عبثية، مُنحت الآن معنى كاملًا وعميقًا، واكتسبت صفة الحقيقة المكتشفة»[51].
ولكنني أعود من الموضوعات القديمة للاهوت التاريخي وعلمنة التاريخ للتركيز على مشروع أصالة التاريخ. وفي هذه الصلة يجدر الإشارة إلى أنه لم يكن حقل مُشكل بالفعل في التاريخ العلماني الذي وهب صفة القدسية. على العكس، الشك والقلق المسيحي[52] والفجوات في الحياة المسيحية هو الذي دفع العلماء التوراتيين لتطوير تقنيات نصية أصبحت منذ ذلك الحين جزءًا من تأسيس التأريخ العلماني[53]. هيربيرت باترفيلد Herbert Butterfield، في دراسته لتاريخ التأريخ الحديث، يضع الأمر كالآتي: «كان موضوع حقيقة التاريخ بالغ الأهمية، والنقاشات حوله كانت محتدمة جدًا، ما أدى إلى تطوير المناهج النقدية في البحث الكنسي قبل أن يفكر أي أحد في تحويلها لمجال التاريخ الحديث»[54]. ولكن هذه الخطوة، بالمعنى الدقيق، لا يجب اعتبارها تحولًا. فلقد تطور النقد العلماني، بالصدفة نتيجة القلق حول عدم استمرارية الممارسة المسيحية التقليدية، وساعد ذلك في حد ذاته على إنشاء حقل التاريخ العلماني المكتوب. وكانت النتيجة فصلًا واضحًا بين التاريخ «العلمي» (بما في ذلك التاريخ الكنسي)[55] الذي اعتمد على أسلوب التساؤل الشكوكي في السعي وراء الأصالة، ومؤلفات «تخيلية» (أو الدين والفنون بشكل عام) التي اعتمدت على استبعاد سؤال الصلاحية المفترضة. هذا الفصل المتنامي هو الذي رسَّخ «التاريخ العلماني» التاريخ كسجل لما «حدث بالفعل» في العالم وفي نفس الوقت، شكَّل الفهم الحديث لــ «الأسطورة» «الخطاب المقدس»، و«الرمزية». أصبح التاريخ العلماني كذاكرة نصية، بالطبع، جزءًا لا يتجزأ من الحياة الحديثة في الدولة القومية. وبالرغم من أنه كأي فترة يتم تذكرها، عرضة لإعادة تشكيل، وإعادة توظيف وإعادة استدعاء مستمر، فإن الوقتية الخطية للتاريخ العلماني أصبحت المقياس ذا الامتياز في كل الأوقات. إن إعادة قراءة الكتابات المقدسة من خلال شبكة الأساطير لم تفصل المقدس عن العلماني فقط، بل ساعدت أيضًا على إنشاء العلماني كاختصاص إبستمولوجي حيث يوجد التاريخ كتاريخ وكأنثروبولوجيا.
في إعادة القراءة الأسطورية للكتاب المقدس، ما زال يمكن تقديم معاناة المسيح، موته، والتجسد، على أنها أمور تأسيسية. ولكن في إطار إعادة التأسيس هذه، سعت العقيدة المسيحية إلى إعادة النظر في مسألة الوحي. من الممكن ألا يكون اﷲ قد أملى الكتاب حرفيًا لأنبياء العهد القديم ورسل الجديد، ولكن المسيحي المؤمن سعى للوصول إلى فهم بحيث لا يزال يمكن القول بأنهم «موحى إليهم»، أي أن الروح القدس نفث فيهم حرفيًا. بادر هيردر إلى تقديم إجابة على التساؤل بأن عزا مَلَكة التعبير عن قوة الروح إلى أنبياء العهد القديم، لكن كان تلميذه إيكورن Eichhorn هو الذي طبَّق هذا الفكر منهجيًا. وكان إيكورن أيضًا من قدّم حلًّا جديدًا لادعاءات المشكّكين والمؤمنين العنيدة الادعاء، من ناحية، أن الأنبياء كانوا دجالين، ومن ناحية أخرى، أنهم كانوا متحدثين باسم الإله. اقترح إيكورن بشكل جذاب أن الأنبياء كانوا فنانين موحى إليهم. ولكن يبدو أنه تم إغفال أن الرسل تمت «مناداتهم»، بينما لم يحدث ذلك في حالة الفنانين. قد يناجي الفنانون خلق اﷲ ولكن لا يمكنهم سماع صوته، فإن ذلك ليس في إمكانهم كشعراء بأي شكل من الأشكال.
وبما أنه لم يعد يُنظر إلى الوحي على أنه اتصال إلهي مباشر، فقد عرفه الشعراء الرومانسيون بأسلوب يقبله المشككون والمؤمنون سواء. تلاحظ إلين شافر Elaine Shaffer أن كولريدج Coleridge استخدم النوم، أحلام اليقظة، والأفيون (الذي أخذه للتقليل من الألم) لوقف الإدراك الطبيعي والوصول إلى حالة يمكن وصفها بالنشوة المستنيرة[56]. وفي هذا الإطار، كما هو الحال في حالات أخرى، كان هناك أكثر من محاولة بسيطة لطمأنة الرأي المشكك: جرت إضافة تحول جديد زاد في تعقيد فكرة موضوع الوعي الذاتي الوحدودي عن طريق إتاحة أنواع مختلفة جذريًا من التجارب إلى حالات مجزأة[57].
وفقًا لنظرية كولريدج عن التخيل، فقد افترضت الرؤية الشعرية مسبقًا تحولًا للإدراك الطبيعي، بغض النظر عن كيفية بلوغه[58]. لم يعد «التخيل» مضادًا للمنطق كما كان بالنسبة للتنوير العلماني، كما اكتسب الآن بعض وظائف المنطق، ووقف في مقابل «الوهم»[59]. ورأى كولريدج، الذي تعمق في قراءة النقد التوراتي الألماني، أن الأنبياء لم يكونوا رجالًا سعوا للتنبؤ بالمستقبل، بل شعراء مبدعون عبروا عن رؤيا لماضي جماعاتهم كتجديد للحاضر ووعد للمستقبل. و«التجديد»، كما أشار هنري هوبرت Henri Hubert الدوركايمي في وقت لاحق جدًا، هو تكرار، ومشاركة في الزمن الأسطوري»[60].
لم يتم الاعتراف بأن الأنبياء والرسل ليسوا «فوق البشر» فقط، بل أيضًا نُسب إليهم الوعي بعدم كفايتهم الشخصية كقنوات للوحي. في التصور الرومانسي للشاعر، أتاح التوتر بين الوحي الأصيل والضعف الإنساني ظهور لحظات من الوهم الذاتي ولذا اعتبر دليلًا على المبالغة والقصور. وفي هذا الإطار، لم يكن الأنبياء والرسل مختلفين. ما يهم لم يكن أصالة الحقائق حول الماضي، بل قوة الفكرة الروحية التي سعوا لنقلها كبشر موهوبين[61].
أنتقل الآن من تاريخ اللاهوت المسيحي إلى تاريخ الإثنوغرافيا الوصفية باختصار، حيث نجد مفاهيم متغيرة للوحي في تشابك مع الفسيولوجيا التجريبية الناشئة ومبادئ العبقرية الفنية.
الشامانية: الوحي والإدراك
ساهمت الإثنوغرافيا الوصفية حول الشامان في القرن الثامن عشر في إعادة تشكيل فكرة الوحي بمصطلحات «علمانية». لم ينطو ذلك على تحول كل المسببات من خارج عالم الأجسام المادية بالكامل إلى هذا العالم، بل أيضًا التحول إلى «داخل» كان لا بد من إعادة تعريفة تدريجيًا. ساهم هذا التحول أيضًا في الفصل بين الحالات العقلية والسلوكيات الصحية وغير الصحية، وأدى ذلك في فكر عقلاني التنوير إلى الاعتقاد بأن الفضيلة تبنى على العلوم الطبية وليس العكس، كما رأت المسيحية الأقدم.
منذ بداية الالتقاء بين الأوروبيين والبدائيين، اتجهت كل من العقيدة المسيحية والشكوكية العقلانية إلى وصف الشامان[62] بأنهم عبدة الشيطان، سحرة، دجالين ومشعوذين، وأن جلسات استحضار الأرواح الشامانية، بكل تفاصيلها من قرع للطبول وإيماءات ملتوية وصيحات غريبة، ما هي إلا مجرد محاولات غريبة للخداع. تم صرف ادعاءات الشامان بالقدسية والتكهن بثبات، وتصنيفهم مع القساوسة والعرافين القدماء الذين تظاهروا بالتواصل مع اﷲ والأرواح. ولكن إزالة الغموض التنويرية تلك لم تمنع الفضول، في بعض التقارير على الأقل، تجاه القدرات العلاجية الشامانية. لذا تم إعطاء اهتمام أكبر للأسلوب المسرحي لجلسات استحضار الأرواح، والتي اعتبرت أحيانًا عروضًا استثنائية؛ حيث ساعدت الموسيقى والنغمات على إبهاج الحضور وتهدئة المصابين. وكان هناك أيضًا اهتمام بالمواد الطبيعية التي استخدمها الشامان للعلاج أو تخفيف الآلام أو المرض[63]. ولكن، هذا الاهتمام جاء من ثقافة تزايد فيها الاعتقاد أن منشأ الألم داخلي تمامًا ومتصل بالعالم الآلي، ولذا يتأثر فقط بالأفعال المتصلة بعناصر هذا العالم. وقد قدم الشامان مثالًا مدهشًا للقوى الغامضة التي بدا أنها تراوغ عالم الطبيعة. وكأهل لما هو خارق للعادة كان لا بد من تفسير ظاهرتهم، أو صرفها.
كان إدراك الألم في أوروبا القرن الثامن عشر يمر بتغيرات مهمة تم تصنيفها بأثر رجعي على أنها «علمنة»[64]. روزالين راي Roselyne Rey، في تأريخها الطبي للألم، تصف تحولًا مهمًا في مشاورات الأطباء المنتمين للمدرسة الحيوية. وقد فسر الأطباء أسطورة العقاب على الخطيئة الأصلية بأنها أسطورة العقاب على التجاوزات بحق قانون الطبيعة (على سبيل المثال، اتباع نظام غذائي خاطئ أو عدم ممارسة الرياضة)[65]. كان هذا تفسيرًا مجازيًا بسيطًا بحيث تم تجسيد الطبيعة ووهبها وساطة مملوكة في الأصل لله[66]. ولكن كان هناك تحول آخر مثير للاهتمام تُعرّفه راي، ولم يكن مجرد مسألة تعويض مجازي بل تغير في قواعد المفهوم.
مستشهدة بالهجوم الذي شنه الفلاسفة على التبرير المسيحي للألم (بأنه احتفال بالألم بدأ مع أسطورة آلام المسيح)، تقول راي إن خطاب الخطيئة والعقاب جرت تنحيته جانبًا لصالح آخر[67]. في الخطاب الأحدث، بدأ تشييء الألم، وتم وضعه في إطار فلسفة آلية، ووضعه داخل المعرفة المتراكمة للجسم الحي، والتي تم اكتسابها من خلال تشريح الحيوانات الحية: «حتى بالنسبة لشخص مؤمن أو ورع بحق مثل هالر Haller»، تقول راي عن أحد أوائل المختبرين الكبار، «تمكن من مقاربة التساؤل عن الألم بدون إبداء هواجس دينية؛ ومن الحقيقي أن ذلك كان أسهل على شخص تضمن عمله الاختبار على الحيوانات، عوضًا عن كونه طبيبًا (أي شخص صقل في نفسه فن المداواة والإراحة). باختبارات هالر Haller وبداية المنهج التجريبي، أصبح مفهوم الإدراك والوظائف الخاصة بالأعصاب والعضلات مبنيًا بشكل أكبر على أسس علمية[68]. أي أنه تم تفسير «النشاط» و«الهمود» بمصطلحات تجريبية، بحيث ترتبط «المشاعر» بالأولى وتنتفي عن الثانية.
في هذا المثال، علمنة الألم لا تشير فقط إلى تخلي عن اللغة الفائقة (الهواجس الدينية)، بل تحول إلى انهماك جديد من المحاولة الشخصية للعلاج والمواساة (أي، إقامة علاقة اجتماعية) إلى محاولة نائية لبحث وظائف وأحاسيس الجسم الحي. ويتم إلحاق الألم بالحيوانات بطريقة منهجية بهدف فهم أسسه الفسيولوجية[69]. فمن ناحية، لدينا الألم الذي يأتي في الحوار بين المريض والطبيب، ومن ناحية أخرى الألم هو التفسير الناتج عن الملاحظة التجريبية في سياق يتم فيه، كما أشار دي سيرتو De Certeau، نزع الوجود عن اللغة. إن هذا النموذج الأخير هو الذي يقود التشكيك التنويري للتعرف على ادعاءات الشامان العلاجية (نتيجة الاضطراب من العروض المذهلة و«الوحي» بأرواح «غير مرئية»)، كما يساعد على إنشاء الاختصاص العلماني المعرفة الفسيولوجية من خلال تقارير مكتوبة حول النتائج التجريبية[70]. لا يوصف هذا التباين بصورة صحيحة في إطار «التخلص من الوهم»، بينما ما على المحك هو أنماط مختلفة من الإدراك حول الألم، وطرق مختلفة لتشييئه. لذا فإن السؤال الذي شغل هالر Haller في تجاربه على الحيوانات هو عما إذا كان الألم ينتج عن المثيرات نفسها أو يتأثر بجزء الجسم الذي يتعرض له: «من أجل حل هذه المشكلة، قام هالر بمضاعفة وتنويع أنواع الكاشف والطرق المستخدمة لتحفيز جزء معين من الجسم، باستخدام نهج «الإقصاء»: لذا قام بتطبيق مثيرات حرارية، ميكانيكية (التمزيق، القطع) وكيميائية (زيت الزاج، ملح النترات) على كل جزء على التوالي. تم استخدام الكهرباء، الكلفانية تحديدًا، عند اكتشافها، كوسيلة لقياس مدى حساسية أعضاء الجسم وصلاحيتها وحيويتها المتبقية بعد الموت. فُحص الجسم كلة تمامًا من الرأس للقدمين: «الأغشية، الأنسجة الحيوية، الأوتار، السفاق، العظام، الغضاريف، العضلات، الغدد، الأعصاب، وهكذا». وتحول مبدأ التجربة الذي اعتبر منذ البداية وضع الشيء تحت الاختبار إلى استخدامه لفحص حالة داخلية من خلال التلاعب الخارجي (التجربة)[71].
ولكن، ادعاءات الدجالين (الذين رُبط الشامان بهم غالبًا) لم تُصرف دائمًا. اعتبر جيروم غاوب Jerome Gaub، عضو الجمعية الملكية وأستاذ الطب، بلاغتهم وسرعة تصديقها قيمة في العلاج: «هذا الإيمان هو ما يطمح إليه الأطباء بشدة، وذلك لأنهم إذا عرفوا كيفية تحقيقه بأنفسهم مع المرضى، سيصبح المرضى أكثر طاعة وتزيد القدرة على نفث حياة جديدة فيهم بالكلام فقط، علاوة على ذلك، سيجدون أن قوة علاجاتهم قد زادت وتصبح النتائح أكثر يقينًا». أثارت العروض المبالغ فيها للمشعوذين الذين بشروا بالعلاج التعجب، وقاد التعجب إلى الأمل. «أحيانًا كانت تجرى إثارة أجزاء الجسم بحيث يتم تحرير أسسها الحيوية من التخدير، ويعود تناغم الجهاز العصبي، وتتسارع حركة الأعضاء، وهنا تهاجم الطبيعة وتهزم بقوتها مرضًا طال علاجه دون جدوى. ليهنئ هؤلاء المحظوظون أنفسهم، الذين تعافوا سريعًا بطريقة تلك الفنون الفارغة لا بنظام المداواة المتفق عليه، أقول، على استعادة صحتهم بغض النظر عن السبب!»[72]. يرى جاوب أن «المداواة هي عملية اجتماعية بحيث تتم إجازة إلهام المداوي لا بالمصدر الغامض بل بقدرته العلاجية».
نشأ الاهتمام بالمواد المسببة للهلوسة التي استخدمها الشامان لاحقًا[73]. ولكن في القرن الثامن عشر أُخذ منحى آخر من شخصية الشاماني بجدية أكبر، وهي الشاماني كشاعر، قاص للأسطورة، وفنان أدائي. تلخص غلوريا فلاهيرتي Gloria Flaherty تقارير يوهان خورخي Johann Georgi، الذي وصف شامانية آسيا الوسطى وربطها بنشأة فنون الكلام. وهو يقول: «مثل جميع وسطاء الوحي في العصور القديمة، تحدث رجال ونساء الشامان المعاصرون بلغة منمقة وغير واضحة حتى ينطبق ما يقولونه على كل الحالات، أيًا كانت النتيجة. أضاف أنه كان من الضروري أن يفعلوا ذلك حتى يعرف المؤمنون بهم وحدهم الذين عرفوا الطلاسم فقط لا الأبجديات كيفية التواصل معهم بمشاركة الصور والأحاسيس. كانت الابتهالات أحد الأشكال المفضلة لأن إيقاعها ونغماتها تؤثر في الجسم مباشرة، من دون مناشدة لملكة المنطق الأعلى شأنًا.. وحدد خورخي جهازهم العصبي الخاص كسبب في التأثر: «الأفراد الذين يتمتعون بتلك الهيئة والحساسية يكونون مفعمين بالأحلام، التخيلات، الخرافات، والقصص الخيالية، وهم كذلك بالفعل»[74]. الشامان، كما صرح هيردر بوضوح، بعيدًا عن كونهم مجرد مشعوذين، كانوا شعراء شفاهيين، موسيقيين مقدسين، وعارضين مداويين، والذين من خلال جميع الحيل التي استخدموها أتاحوا لجمهورهم الشعور في دواخلهم بقوة أعظم من أنفسهم[75].
إذا نُظر إلى بلاغة وسلوك الشامان على أنه فن، فيمكن أن يُنظر لبعض الفنانين على أنهم شامان. وإذا كانت النشوة علامة على الوحي التكهني، فقد كانت دلالة على العبقرية الفنية. تكتب فلاهيرتي Flaherty عن النظرية التطورية للعبقرية في أوروبا القرن الثامن عشر التي بنيت على أساطير أورفيوس الكلاسيكية والأوصاف الإثنوغرافية للشامان، وهي نظرية ركزت في النهاية على ظاهرة موتزارت العالمية المذهلة[76]. وتقول فلاهيرتي إن ربط جمهور موتزارت عادة بأورفيوس كان جزءًا من «أسطرة» الفنان العظيم، وقدراته العلاجية و«التهذيبية» التي اكتسبها بالوحي. لذا، تشير فلاهيرتي من بين معاصرين آخرين إلى الطبيب سايمون تيسو Simon Tissot، الذي وصف «العبقرية» التي أظهرها تأليف موتزارت للموسيقى: «كان يُقاد لا إراديًا أحيانًا إلى الهاربسيكورد (الشكل الأول من البيانو)، أي بقوة مفاجئة»، كتب تسيو، «واستوحى منها نغمات معبرة عن الفكرة التي استحوذت عليه للتو. قد يقول المرء في لحظات كتلك إنه كان أداة وقعت تحت سيطرة الموسيقى، والتخيل بأنه مجموعة من الأوتار المرتبة بتناغم بطريقة فنية بحيث لا يمكن لمس إحدها دون تحريك البقية؛ وهو يعزف كل الصور، بينما ينظم الشاعر شعرها ويرسمها الرسام[77]. تم استخلاص فكرة الوحي تلك من الأداء المذهل للفنان، والتي وُصفت بأنها نتيجة لاستحواذ قوة خارجية عليه.
يقول يوهان سولتزر Johann Sultzer؛ مُنظر في الفنون الجميلة، بمصطلحات أكثر عمومية: «يدعي كل الفنانون العباقرة أنهم يختبرون من حين لآخر حالة من الحدة النفسية المذهلة التي تجعل العمل أسهل على غير العادة، بحيث تظهر الصور من دون مجهود وتتدفق أفضل الأفكار بغزارة وكأنها هدية من قوة أعلى. هذا بدون شك ما يطلق عليه الوحي. إذا اختبر الفنان هذه الحالة، تظهر له أداته في ضوء غير اعتيادي، وتبتكر عبقريته، كأنما تقودها قوة إلهية، من دون مجهود، وتشكل اختراعاته في أكثر صورة مناسبة من دون عناء، وتأتي أفضل الأفكار والصور بتدفق إلى الشاعر الموحى إليه من دون دعوة، ويحكم الخطيب بأعظم فطنة، وأعظم حدة، بحيث تظهر الكلمات الأقوى والأكثر تعبيرًا بوضوح على لسانه[78]. يجادل فلاهرتي بأن تلك التصريحات تذكرنا بقوة بالشامانية وفي حالة الشامان لا يتم وصفها بشكوكية بل روعة. فهم يطوعون فكرة الوعي مجازًا كتحكم للأداة من خارج الشخص، أو كهدية من قوة أعظم. ولكن تظل تلك استعارات تغطي قصورًا في تفسير تلك الظاهرة الدنيوية بمصطلحات طبيعية.
ولكن عندما وضع الطبيب ملكيور ويكارد Melchior Weickard تفسيره في ضوء السيكولوجيا الإنسانية بشكل كامل، حدث تغير كبير في اللغة: «العبقري، إنسان يتمتع بقوى تخيلية ممجدة، يبدو أن لديه أليافًا دماغية أسرع في الانفعال عن باقي البشر»، يتوقع ويكارد، «أن تلك الألياف تتحرك بشكل أسرع وأسهل، بحيث تظهر صورًا حيوية ومتكررة»[79].
بغض النظر عن مدى ملاءمة تلك التفسيرات من منظور القرن اللاحق، ألمح خطاب علماني للوحي الآن كليًا إلى قدرات «الجسم الطبيعي» ومظاهرها الاجتماعية. العبقري، مثل الشامان، كان حينًا أداة، مؤديًا، ومنتجًا للخرافة. وبالنسبة لإيمانويل كانت Immanuel Kant، العبقري كان ببساطة شخصًا يستطيع أن يمارس ملكاته المعرفية بصورة طبيعية وببراعة من دون أن يحتاج إلى أن يعلمه أحد: «نقول إن من يملك تلك القوى بدرجة أعلى لديه عقل، ومن يملك مقاييس أقل من تلك الملكات يطلق عليه ساذج، لأنه يسمح لنفسه بأن يقوده أشخاص آخرون. ولكننا نطلق لفظ عبقري على من يستفيد من الأصالة وينتج من نفسه ما يجب بالعادة تعلمه بإرشاد من آخرين»[80]. العبقري كان نتاجًا للطبيعة، وما أنتجه كان طبيعيًا، ولو منفردًا. ولهذا السبب أمكن تقديره من قبل جمهور مثقف في ممارسته الأحكام الذوقية.
الخرافة، الشعر، والإدراك العلماني
بداية من بلايك وكولردج وصاعدًا، اختبر الشعراء الذين اعتُبروا «عباقرة» في التقليد الرومانتيكي، المنهج الأسطوري من خلال شعرهم الديني[81]. والأسطورة بالنسبة للفكر الرومانتيكي المبكر هي الطريقة الأصلية لفهم الحقيقة الروحية. وبينما أصبح الأنبياء التوراتيون والرسل بالإضافة إلى الشامان في «العالم البدائي» يُنظر إليهم على أنهم مؤديون، لاستخدامهم الأسلوب الروحي والوظيفة الشعرية، إذًا فإن العباقرة الجدد يمكنهم النظر في دواخلهم والتعبير عن حقائق روحية بتطبيق نفس المنهج. ولذا لم تكن فضيلة الإيمان ضرورية، وكل ما تطلبه الأمر هو أن يكون المرء صادقًا في نيته، وأن يعبر عن أعمق المشاعر الداخلية بصدق في شكل خطاب خارجي. قد يساعد ذلك على تفسير انتشار ما أطلق عليه ستيفان كوليني Stephan Collini «بلاغة الصدق»[82]، بين مشككي العصر الفيكتوري. ولم يُنظر إلى فكرة الصدق مع الذات بأنها واجب أخلاقي فحسب، لكنها افترضت أيضًا وجود ذات علمانية كان لا بد من إظهار سيادتها من خلال أفعال صادقة. ونشأت علمانية الذات من حقيقية كونها شرطًا مسبقًا يفترض وجوده للخوض في التجربة الفائقة (الشعرية والدينية) وليس نتاجًا عنها.
رأى الشعراء أمثال براونينغ Browning، الذين عانوا من أجل الحفاظ على قناعاتهم الدينية في عصر تتزايد فيه الشكوك، في الأنماط الروحية وسيلة لإحداث تناغم بين نتائج علم النفس والتاريخ، أي التناغم بين الواقع الداخلي والخارجي. يلاحظ روبرت لانغبوم Robert Langbaum أن براونينج كان أول من أوجز «ما أصبح النظرية الشعرية السائدة في القرن العشرين أن تأثير الشعر يحدث من خلال الربط بين العوامل المختلفة في عقل القارئ، وأن عملية الربط تلك تقود إلى إدراك نمط ثابت، من خلال ما تم تقديمه تباعًا. وكان يطلق على الإدراك عادة في القرن العشرين «الإبيفانيا»[83] أي الظهور المفاجئ للروحي في شكل الفعلي».
ظل المنهج الأسطوري مهمًا حتى بين أدباء القرن العشرين الذين لم يعترفوا بأي إيمان ديني، مثل جيمس جويس James Joyce. ويكتب تي إس إليوت T.S. Eliot، في عرضه المدحي لرواية عوليس: «في استخدام الأسطورة، والتلاعب بالتشابه مستمر بين المعاصر والقديم، يتيع جويس منهجًا يجب أن يتبعه آخرون من بعده… (المنهج الأسطوري) هو ببساطة وسيلة للتحكم، الترتيب، وإعطاء هيئة وأهمية لمشهد العبث والفوضى الهائلة التاريخ المعاصر. وقد أشار كل من ييتس Yeats… وعلم النفس… والأنثروبولوجيا، و«الغصن الذهبي» The Golden Bough، إلى المنهج الأسطوري، حيث قدموا جميعًا ما كان مستحيلًا قبل بضع سنوات. وعوضًا عن المنهج السردي، يمكننا الآن استعمال المنهج الأسطوري. وأنا أؤمن بشدة أنه خطوة في اتجاه جعل هذا العالم الحديث ممكنًا من أجل الفن، … النظام والشكل»[84].
استخدم تي إس إليوت T.S. Eliot ما أطلق عليه «المنهج الأسطوري» في شعره. ولكن، لا يجب أن يرتبك هذا الاستخدام للأسطورة مع إشارة ستاروبينسكي Starobinski إلى «أسطرة» التاريخ الحديث الذي أشرت إليه في وقت سابق. لا يوجد توق إلى وفرة مفقودة في هذا الأدب. هنا، تجري استعادة الأسطورة بوضوح كتأسيس خيالي للقيم العلمانية التي يبدو في النهاية أنها من دون أساس[85]. وبالتالي فإن الأسطورة هنا توصل إلى إدراك مختلف تمامًا عن ذلك الذي نجده في استخدام كولريدج Coleridge ورومانسيين آخرين للأسطورة. (مما يثير السخرية، أن الشخصية الخيالية للأسطورة التي قادت الكتاب التنويريين مثل ديدرو Diderot إلى وضع «الأسطورة» جنبًا إلى جنب مع «التقليد» هو تحديدًا ما يقود كُّتاب بداية القرن العشرين إلى ربط الاختلاق الأسطوري بـ «الحداثة»[86]).
جرت الإشارة بشكل متكرر إلى أهمية الأسطورة كتقنية أدبية لفرض وحدة جمالية على الطبيعة المفككة والعابرة للتجربة الفردية التي يختبرها الشاعر في الحياة الحديثة[87]. في تحول فضولي، استرجع الشعراء العرب الجدد، متأثرين بقوة بالشعر الأوروبي الحداثوي، ميثولوجيا شرق أوسطية قديمة، من أجل التعبير عما هو حديث بأصالة، ومشيرين بتلك الطريقة إلى رغبتهم في الهروب مما اعتبروه تقاليد خانقة في العالم الإسلامي المعاصر. أبرز هؤلاء الشعراء هو «أدونيس»؛ الاسم الأدبي الفينيقي لأشهر أعضاء مجموعة «شعر»[88]، والذي قدم نفسه بأنه ملحد وحداثوي. باستخدام أدوات مشابهة ومألوفة في الشعر الرمزي والسريالي الغربي، يلمح أدونيس إلى شخصيات أسطورية في جهد واعٍ لإرباك الإدراك الجمالي والأخلاقي الإسلامي، والهجوم على ما تم اعتباره تقليدًا مقدسًا، لصالح الجديد، أي الغربي[89]. (بالصدفة، كان يجب ترجمة تلك الأساطير إلى العربية من كتابات العلماء الأوروبيين الجدد الذين نسخوها وأعادوا سردها). ولكن تقنية أدونيس في هذا الإطار تصويرية وليست بنيوية؛ حيث هدفت بالأساس إلى خلخلة المشاعر المستقرة، لا إضفاء سمة النظام والهيئة في حال غيابها. هذا الاستخدام للأسطورة في الشعر العربي الحديث هو جزء من الرد على الفشل الملاحظ للمجتمعات المسلمة في العلمنة، وهو ممزوج بإدراك أن «الغرب» هو هدف يجب محاكاته.
وفقًا لأدونيس، تظهر الأسطورة حينما يتقابل المنطق الإنساني مع الأسئلة المربكة حول الوجود، وظهور محاولات للإجابة عليها بطريقة لا يمكن إلا أن تكون لا منطقية، مما ينتج مزيجًا من الشعر، والتاريخ، والروعة. يعتبر أدونيس حرية التفكير بتلك الطريقة، والتسليم علانية بأن الأسطورة نتاج ضروري للعقل العلماني، متكاملة مع الحداثة. لذا، فهو يخاطب الأسئلة الوجودية والتاريخية في شعره بأسلوب أسطوري. وتحديدًا، يعبر أدونيس عن رغبته في تخليص العرب الذين وقعوا في قبضة «اللغة المقدسة» لمدة ألف عام، من خلال أساطير الانعزال، البعث، والخلاص[90]. ومع ذلك، في الخطاب الإسلامي الكلاسيكي، اللغة العربية للقرآن لا يطلق عليها أبدًا «لغة مقدسة» كما هو الحال في الخطاب العلماني الحديث، إذ يفترض الأخير مسبقًا فكرة مجردة يطلق عليها «اللغة» يمكن أن تتحد مع خاصية مشروطة يطلق عليها «القدسية».
عادة، يستخدم أدونيس مصطلح الأسطورة لكل من الاحتفال بالإبداع الإنساني وكشف القناع عن نفوذ النصوص المقدسة. ينصب اهتمامه على المنطق، واستعادة قداسته الضرورية للإنسانية. بتقليد خطاب أوروبي (فيورباخي) سابق، يصرح أدونيس بأن «منطق الإلحاد هنا يعني استرجاع الإنسانية لطبيعتها الحقيقية، والإيمان بها عن طريق ميزة إنسانيتها… بالنسبة للإلحاد، المقدس هنا هو الإنسان نفسه، لكونه صاحب منطق، ولا يوجد ما هو أعظم من هذا الإنسان. يستبدل الإلحاد الوحي بالمنطق، واﷲ بالإنسانية»[91]. ولكن الإلحاد الذي يؤله الإنسان، هو، مما يثير السخرية، قريب إلى عقيدة التجسيد. فكرة وجود «منطق إلحادي» واحد وواضح هي في حد ذاتها نتاج لثنائي حديث اعتقاد أو عدم اعتقاد في كائن خارق للطبيعة.
ويجادل أنه بالرغم من أن الشكل الأصولي للفكر الإسلامي السائد اليوم هو في حد ذاته أسطوري، فإن شكل الأسطورة هذه اكتسب لدى المؤمنين طابع القانون الوصية ولا يبدو لهم كأسطورة. بالنسبة لأدونيس، الأسطورة جمعية، وفوضوية، بينما القانون الديني توحيدي وشمولي. في الإشارة للحقيقة غير الواعية للخطاب الديني المعاصر، الأسطورة لديها وظيفة مختلفة تمامًا عن تلك التي يحددها الشعراء الأوروبيون الحداثيون عندما يستخدمونها لتأسيس التجربة العلمانية[92].
الليبرالية الديمقراطية والأسطورة
أبدأ هذا الفصل بنظرة الأنثروبولوجيين الراديكاليين الذين انتقدوا الدولة الليبرالية الحديثة لتظاهرها بأنها علمانية وعقلانية بينما هي في الحقيقة غارقة بشدة في الأسطورة والعنف. أنتقل بعدئذ إلى إشكالية العلماني كفئة بعد البحث في تحولاته. وأصل الآن إلى مُنَظّرة سياسية ليبرالية معاصرة تجادل بأن الدولة العلمانية، الليبرالية، تعتمد في فضائلها العامة (المساواة، التسامح، الحرية) بشدة على الأسطورة السياسية أي، تعتمد على سرديات الأصل التي تؤسس لقيمها السياسية وإطارًا متماسكًا لأخلاقياتها العامة والخاصة. ويعيدنا ذلك إلى العلمانية كعقيدة سياسية، وارتباطاتها بالــ «مقدس» والـ «مدنس».
ترى مارغريت كانوفان Margaret Canovan أنه إذا تخلت الليبرالية عن أوهامها بأنها حزب المنطق، فستكون في وضع أفضل للدفاع عن قيمها السياسية في وجه نقادها المحافظين والراديكاليين[93]. وتذكرنا بأن المبادئ الرئيسية لليبرالية تقوم على افتراضات تساؤلية حول طبيعة البشرية وطبيعة المجتمع: «كل البشر يُخلَقون متساوين»، «الكل يمتلك حقوق إنسان»، وهكذا. ولكن، ليس هناك ملاحظ عادل للحالة الإنسانية سيجد تلك المقترحات الوصفية بدون إشكالية، تقول كانوفان. فالرجال والنساء ليسوا متساوين في الحقيقة، كما أنهم لا يمارسون حقوق الإنسان في العالم كما نعرفه.
تشير كانوفان إلى أنه في القرن الثامن عشر، الأفكار التي شكلت في النهاية صميم التفكير الليبرالي ارتبطت بتصور مميز للطبيعة بأنها واقع عميق. في القرن اللاحق، استدعى الليبراليون الطبيعة على أنها حقل أكثر حقيقية من العالم الاجتماعي، وهو فهم أعطاهم سببًا للتفاؤل بالتغير السياسي. لم تشر مصطلحات الحقوق الطبيعية ببساطة إلى ما يجب أن يحصل عليه الرجال (ولاحقًا النساء أيضًا) بل إلى ما يملكونه بالفعل في واقع الطبيعة الإنسانية التي تقع دون العالم المشوه كما يبدو الآن. ولكن، بالنسبة لمعارضي الليبرالية المحافظين فإن عدم المساواة والظلم في العالم يعكس مباشرة طبيعة البشر الميؤوس منها.
لماذا وظَّف الليبراليون الأوائل مصطلح الطبيعة بهذا الشكل؟ ببساطة لأنه من وجهة نظرهم، فكرة «الطبيعة» استخدمت لشرح وتبرير الأشياء. فقد كان الإصرار على أن عدم المساواة والقيود الاجتماعية الواضحة كانت «غير طبيعية» في الواقع بهدف استدعاء عالم بديل، عالم أسطوري و«طبيعي»، حيث تسوده الحرية والمساواة. ولكن مع الوقت، افتراضاتهم عن طبيعة «الإنسان» عرَّضَت الليبراليين إلى نقد غير مريح. وبَرُز هذا الضعف باكتمال مع نهاية القرن التاسع عشر، وصعود الواقعية الاجتماعية، والبروز المتزامن لرؤية جديدة عن الطبيعة بأنها عنيفة ويقودها الصراع. وما ساعد في النهاية على إحياء الفكرة الليبرالية للحقوق الطبيعية في مقابل الرؤية التي تفترض قسوة الطبيعة لم يكن تنظيرًا أكثر فاعلية، بل تجربة أوروبا بأهوالها الخاصة التي تجسدت في النازية والستالينية في النصف الأول من القرن العشرين. لذا، سهلت الأسطورة الليبرالية المشروع الكلي لحقوق الإنسان الذي يعد جزءًا كبيرًا من عالمنا المعاصر، ويصاحب ذلك أخلاقية قيل خطأً إنها غير مناسبة للعلمانية كنظام للحوكمة السياسية.
تقر كانوفان بوجود ليبراليين مشككين ممن يعترفون بضعف المؤسسات الليبرالية ويؤكدون أهمية المواطنة العلمانية والحاجة لالتزام واعٍ بالترتيبات السياسية العلمانية، حيث يتم فصل الدين عن الدولة. وتبدو الأسطورة أقل أهمية بالنسبة لهم. ولكن لا يوجد شك، تؤكد كانوفان، بأنه في بداية ما نعرفه الآن بأنه «ليبرالية» كانت أسطورة الطبيعة ملهمة، بحيث أتاحت التأثير في تحولات كبيرة. ومع ذلك فإن الخطاب السياسي الليبرالي يتعرض الآن للهجوم مجددًا. وترى كانوفان أن المبادئ الليبرالية كعالمية حقوق الإنسان من الصعب الدفاع عنها في وجه الطبيعة الموضوعة في إطار اجتماعي. فعندما يتم تفسير الطبيعة في إطار الفلسفة الوضعية وبمعايير إحصائية، فإن معايير السلوك والمشاعر المختلفة ستكون «طبيعية» على حد سواء. ما ينتج نسبية معاقة على حد علمنا.
تجادل كانوفان بأن الدفاع عن المبادئ الليبرالية في العالم الحديث لا يمكن أن يتم بفاعلية بجعل النقاشات المجردة أكثر تزمتًا، كما جاء في محاولات رولز Rawls. وقد دفع ذلك، ولو في سجل آخر، إلى ارتياب ستيوارت هامبشير Stuart Hampshire من استخدامات «المنطق» و«المنطقي» في عرض رولس للليبرالية السياسية. يسأل هامبشير: لماذا يجب أن يكون الإجماع المتداخل بين الأشخاص «المنطقيين» على القيم الليبرالية الأساسية إما مطلوبًا أو متوقعًا؟ «الإجابة تكمن في تاريخ أسطورة المنطق في حد ذاتها. أفلاطون، في حديثه عن العدالة في «الجمهورية»، تخلص من الفكرة العبقرية والمسلية بأن الروح مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، مثلما تقسم الدولة المدنية إلى ثلاثة مستويات اجتماعية، وفي روح الإنسان العادل، الجزء الأعلى، وهو المنطق، يضمن التناغم والاستقرار، وفي المدينة العادلة، المستوى الأعلى، أي الفلاسفة المدربين على الرياضيات، سيفرضون النظام في مجتمع منظم جيدًا. في الخطاب العادي والتقليدي، كان من البديهي افتراض أن مشاعر ورغبات الناس تنتج عن النفس الدنيا، العدوانية والمتمردة، كما أنه يجب أن تُترك تلك المشاعر والرغبات في موضعها المناسب، بعيدًا عن تمالك النفس[94]. يقول هامبشاير إن الشغف والصراع، لا المنطق والنظام، أساسيان في صورة الطبيعة الإنسانية التي سمحت ببقاء الليبرالية منذ البداية. لذا، بينما يريد هامبشير استبعاد أسطورة المنطق في النظرية الليبرالية المعاصرة، تستدعي كانوفان منطق الأسطورة.
تؤمن كانوفان بأن الدفاع عن الليبرالية يتم فقط بإدراك واستلهام أسطورتها العظيمة بصورة واضحة. «الليبرالية لم تكن أبدًا تفسيرًا للعالم، تقول كانوفان، بل مشروع وجب إدراكه. قد يتم الحديث عن «الطبيعة» في الليبرالية المبكرة، «الإنسانية» في عصرنا، وكأنهما موجودتان بالفعل، ولكن الغاية من الحديث عنهما هي أنهما ما زالتا في طور التكوين. هذا الجوهر لأسطورة الليبرالية، بنائها الخيالي، يؤكد على حقوق الإنسان تحديدًا لأنها غير مندمجة في بناء الكون. الحقيقة المخيفة التي كشفتها الأسطورة الليبرالية هي، إذن، أن المبادئ الليبرالية تتعارض مع صلب الطبيعة الإنسانية والاجتماعية. مسألة الليبرالية لا تكمن في إزالة بعض العراقيل العرضية وتمكين الإنسانية من كشف جوهرها الطبيعي، بل هي أقرب إلى بناء حديقة في غابة زاحفة باستمرار … ولكن عامل الحقيقة في الصورة الكئيبة للمجتمع والسياسة التي رسمها نقاد الليبرالية تحديدًا هو الذي يجعل مشروع إدراك المبادئ الليبرالية أكثر إلحاحًا. العالم مكان مظلم، يحتاج الخلاص بواسطة ضوء الأسطورة»[95]. مشروع الخلاص الليبرالي في عالم الظلم والمعاناة الذي تدعونا كانوفان للاعتراف به في إطار أسطوري يتيح مرة أخرى تأكيد صفة الإنسانية المقدسة، وإعادة تمكين المشروعات الليبرالية. ويسمح باستعادة سياسات اليقين، واسترداد السياسية للغة التكهن عوضًا عن النسبوية الأخلاقية. لذا، مثلما كان يوصف غالبًا بأنه استبعاد سياسي للنساء، يمكن الآن إعادة توصيف الموضوعات الاستعمارية في التاريخ الليبرالي بأنها امتداد تدريجي لمشروع التحرير الكوني الليبرالي غير المكتمل.
الصورة التي توظفها كانوفان لتقديم الليبرالية والدفاع عنها مدهشة: «عمل حديقة في غابة زاحفة باستمرار» و«أن العالم مكان مظلم، يحتاج الخلاص بواسطة ضوء الأسطورة». تلك الصورة ليست مجرد دعوة لتبني مقاربة أسطورية: لكنها بالفعل جزء من الأسطورة. وهي تركز على (تشرح وتبرر) العنف الواقع في قلب عقيدة سياسية تنصلت من العنف من حيث المبدأ. لا يعني ذلك، بالتبعية، أن هذا العنف في جوهره «غامض، محير، ملتوٍ، مخيف، أسطوري»، و«علامة على وجود الآلهة» كما يقترح توسينغ Taussing. العنف الليبرالي الذي أشير إليه (في مقابل عنف الأنظمة غير الليبرالية) شَفّانِي. وهو عنف ناتج عن تعميم المنطق نفسه. ومن أجل خلق مساحة مستنيرة، يجب على الليبرالي «أن يهاجم باستمرار ظلام العالم الخارجي الذي يهدد بغمر هذه المساحة»[96]، ولا يجب غزو هذا العالم الخارجي فقط، ولكن في الحديقة نفسها هناك دائمًا أعشاب ضارة يجب تدميرها وأغصان جامحة يجب قطعها.
يصل عالِم السياسة الليبرالي والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط ليونارد بايندر Leonard Binder، مثل كانوفان، إلى نفس النتيجة حول ضرورة العنف، ولكن من خلال مجموعة صريحة من المقترحات حول احتمالات الخطاب العقلاني وحدوده، وليس من خلال استدعاء الأسطورة كما يبدو:
الحكومة الليبرالية هي نتاج عملية مستمرة ذات خطاب عقلاني.
الخطاب العقلاني ممكن، حتى بين هؤلاء الذين لا يشاركون نفس الثقافة أو الوعي.
الخطاب العقلاني يمكن أن يُنتج تفاهمًا مشتركًا وإجماعًا ثقافيًا، بالإضافة إلى الاتفاق على التفاصيل.
الإجماع يسمح بترتيبات سياسية ثابتة، وهو الأساس المنطقي لاختيار الاستراتيجيات السياسية المحكمة.
الاختيار الاستراتيجي العقلاني هو أساس تحسين الحالة الإنسانية من خلال الأفعال الجمعية.
الليبرالية السياسية، بهذا المعنى، غير قابلة للانقسام. وإما ستسود في جميع أنحاء العالم، أو سيلزم الدفاع عنها من خلال فعل غير منطقي[97]. ولكنني أقترح أن ما تطلق عليه كانوفان الأسطورة الليبرالية هو جزء من الهيكل العميق لحجة بايندر المجردة. تقوم الليبرالية السياسية على إجماع ثقافي وتهدف إلى التقدم الإنساني. هي نتاج الخطاب العقلاني وشرطه المسبق أيضًا. يجب أن تسود العالم غير المحرر، إن لم يكن بالمنطق، فبالقوة من أجل أن تبقى حية.
في الحقيقة، الديمقراطية الليبرالية تعبر هنا عن الأسطورتين العلمانيتين اللتين على خلاف، كما هو معروف: الأسطورة التنويرية للسياسة كخطاب للمنطق العام والتي تمكن علاقتها بمعرفة النخب من توجيه تعليم البشرية، والأسطورة الثورية للتصويت العالمي، وهي سياسة الأعداد الكبيرة بحيث يتم السعي إلى تمثيل «الإرادة الجمعية» بقياس الرأي ووهم انتخاب المواطنين الفردي. النظرية العلمانية عن الدولة تقوم على تلك الأسس المتناقضة: من ناحية، الإدراك الليبرالي النخبوي يسعى إلى احتواء الشغف الديني، ومن ناحية أخرى، الأرقام الديمقراطية تتيح هيمنة الأغلبية على الأقلية حتى وإن كان كلاهما مشكل دينيًا.
فكرة أن العالم يحتاج أن يتحرر هي أكثر من مجرد فكرة. منذ القرن الثامن عشر، نشَّطَت الفكرة مجموعة متنوعة من المشروعات الفكرية والاجتماعية في إطار العالم المسيحي وما عداه، في الإمبراطوريات الأوروبية العالمية. اختلفت المشروعات عمليًا من دولة لأخرى، واشتركت فقط في التطلع إلى الحداثة الليبرالية. ولكنني أرى أن تشابه تلك المشروعات مع فكرة الخلاص المسيحية لا يجب أن تقودنا إلى الاعتقاد بأنها مجرد إعادة بيان للأسطورة المقدسة، كمشروعات علمانية في الظاهر فقط ولكنها دينية في الحقيقة. بالرغم من أن أسطورة العهد الجديد قد تكون ساعدت في تشكيل تلك المشروعات العلمانية فهذا لا يعني أن تلك الأخيرة مسيحية بالضرورة. تتبنى المشروعات سياسة مميزة (ديمقراطية، ضدّ سيطرة القساوسة)، وتفترض مسبقًا نوعًا مختلفًا من الأخلاقية (قائمة على قداسة الضمير والحق الفردي)، وهي تعتبر المعاناة ذاتية وعرضية تمامًا (أي ضرر جسماني يمكن علاجه طبيًا، أو عقاب إصلاحي على جريمة، أو مجرد العمل غير المنتهي للتمكين الكوني).
في سياسة التحرير العلمانية لا يوجد مجال لفكرة المُخلّص الذي ينقذ المذنبين من خلال خضوعه أو معاناته. كما لا يوجد مجال للاهوت الشر بحيث يتم تعريف أنواع مختلفة من المعاناة. («الشر» هو ببساطة شكل مبالغ فيه لما هو سيئ وصادم). ولكن هناك ميلًا لإلحاق الألم بهؤلاء الذين سيستلزم إنقاذهم من خلال أنسنتهم. ولا يعني ذلك أن أداة العنف مختلفة فحسب، بل إن الأسطورة العلمانية تستخدم عامل العنف لربط مشروع تفاؤلي للتمكين الكوني مع تفسير تشاؤمي للحافز الإنساني، بحيث يتشكّل الهمود والفساد بوضوح. إذا كان العالم مكان مظلم يحتاج للخلاص، فإن المُخلّص الإنساني، كساكن لهذا العالم، يجب أن يخلص نفسه أولًا. وفكرة أن المشروع الدنيوي للخلاص يتطلب تخليص النفس أولًا تعني أن الغابة في النهاية تكمن داخل روح زارع الحديقة. لذا فإن هيكل تلك الأسطورة العلمانية يختلف عن تلك التي توضح قصة الخلاص من خلال تضحية المسيح، وهو اختلاف قد يخفيه استخدام مصطلح «مقدس» لكل منهما. يبين الهيكلان أنواعًا مختلفة من الذاتية، وكل منهما يحرك أنواعًا مختلفة من النشاط الاجتماعي، ويستدعي أنماطًا زمنية مختلفة.
ومع ذلك، فإن التاريخ التبشيري للمسيحية يمكن من دمج الاثنين لطوي الوعد الروحي («المسيح مات لإنقاذنا كلنا») في المشروع السياسي («العالم يجب أن يتغير من أجل المسيح»)، ما جعل المفهوم الحديث للخلاص ممكنًا.
نوع من النهاية: قراءة في نصين حديثين عن العلماني
إذًا، في النهاية، كيف نصل إلى الفهم الأنثروبولوجي لـ العلماني. من الصعب تقديم إجابة قصيرة. ولكنني أختتم بتقريرين متناقضين يربطان تعريفات العلماني بالأسطورة، الإشارة، والمجاز؛ وهما: مقال بول دي مان Paul De Man «بلاغة الزمانية»[98] وكتاب فالتر بنيامين Walter Benjamin «أصل الدراما التراجيدية الألمانية»[99]. بالنظر إليهما معًا يتضح أنه حتى الرؤى العلمانية لـ العلماني ليست متشابهة.
يهتم مقال دي مان الشهير أساسًا بالحركة الرومانسية وكيف كُتب عنها في التاريخ الحديث. يقول دي مان إن الصورة الرومانسية تم فهمها على أنها علاقة بين الذات والطبيعة (فاعل ومفعول به)، ولكن هذا غير صحيح. في البداية، أعاد الرومانسيون اكتشاف تقليد مجازي قديم من العصور الوسطى، ولكن إعادة الاكتشاف تلك حدثت في عالم بدأ الاعتقاد الديني فيه بالتدهور في مواجهة اكتشافات المعرفة الحديثة. وقد كان كما قال فيبر Weber عالمًا يتحرر من الوهم على نحو متزايد. في عالم العصور الوسطى، المجاز كان ببساطة واحدًا من مجموعة من تشبيهات تم تثبيت معانيها من قبل تعاليم الكنيسة في التفسيرات التوراتية، وبالتالي أتاحت لها ممارسة سلطتها. ولأن المجالات الكنسية لم تعد مسلمًا بها، حيث أصبح الاعتقاد في المقدس أمرًا غير محسوم، يخبرنا دي مان أن الرومانسيين المبكرين أعادوا اكتشاف المجاز في إطار إشكالية مختلفة. بالإشارة إلى الخلافة التقليدية للدال على المدلول، كان للمجاز مصير زمني محتوم حتى النهاية، بحيث لا يمكن أبدًا للذات وغير الذات أن يتزامنا. التصوير الرومانسي المبكر شكَّل إذًا مساحة ليتوصل المتردد إلى تفاهم مع العلماني وعالم لا توجد فيه أعماق خفية، ولا استمرارية طبيعية بين مشاعر الفاعل والمفعولين بتلك المشاعر، ولا إنجاز للوقت. وأصبح إدراك أن الحقيقي غير مقدس، وغير مسحور، ممكنًا. ومع ذلك، كما يقول دي مان، هذا الصفاء المؤلم الذي وصل إليه الرومانسيون الأوائل في البداية حول العالم الحقيقي (في مقابل الضمير المرتبك للمؤمنين) لم يستمر. وبسرعة كبيرة تم تأسيس تصور رمزي (أو أسطوري) للغة في كل مكان في الأدب والرسم الأوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين، ما أتاح استرجاع المعاني الثرية بلا نهاية. مرة أخرى، يلاحظ دي مان، بدء التخيل الرمزي (أو التفسير الأسطوري) في حجب واقع هذا العالم.
في دراسته للدراما الباروكية الألمانية، المعروفة بالتراجيديا Trauerspiel، يصف فالتر بنيامين مسارًا مختلفًا، حيث يوجه القارئ إلى العالم العلماني الذي لم يُكتشف فحسب (من خلال معرفة واضحة بالحقيقي) بل تم جمعه دون ثبات وتطبيقه بطريقة متناقضة. بالرغم من أن دي مان يُظهر لمحة من عدم الثبات في حياة العلمانية في كتاباته، لكنه يحافظ على عهده لـ العلماني بأنه «الحقيقي»، بعكس بنيامين.
لذا، عندما يُفرِّق بنيامين بين الفاعل والمفعول به فهو لا يبدأ بالتناقض بين الذات والطبيعة (كما يفعل دي مان)، لكنه يهتم بالمعارضة بين الأشخاص. إنه هذا الغموض في النوايا وليس المفعولين هو الذي يولد الارتياب، الرغبة، والخداع في ممارسة السلطة، ما يجعل اللجوء إلى الصدق ببساطة أمرًا مستحيلًا. الباروكية بالنسبة لبنيامين هي عالم اجتماعي حيث يكون المجاز، لا الرمز، أساسيًا. مسرحيات القرنين السادس والسابع عشر التي يحللها بنيامين وهي ألمانية بالأساس، وأيضًا إنكليزية وإسبانية، تعكس إدراكًا لتاريخ لم تعد الأسطورة المسيحية عن الخلاص جزءًا منه. ويعدّ ذلك أحد جوانب علمانيتهم. ويظهر جانب آخر أقل وضوحًا في السمة الرمزية لموت سقراط. يرى بنيامين أن أسطورة انتحار سقراط الذي فرضته محاكمته يمثل علمنة للتراجيديا الكلاسيكية، وبالتالي الأسطورة، لأنه يضع الموت المسبب والمثالي محل الموت الفدائي لبطل أسطوري. وبالرغم من أن الدراما الباروكية لا تمثل الانتصار الكامل للمنطق المستنير على نحو تام، كما يرى بنيامين، إلا إنها تدلل على استحالة التراجيديا الكلاسيكية والأسطورة في العالم الحديث. وهي تطمح إلى تعليم المتفرج، وتتمحور حركتها عادة حول شخص الملكي، والذي كان يومًا طاغية وشهيدًا، وشخصية تُظهر مشاعرها المفرطة السعي وراء السيادة، وموضوعها ليس المصير التراجيدي (بحيث لا يمكن تعلم شيء منه) ولكن الحداد والكآبة الناتجين عن ممارسة المنطق الاجتماعي والقوة الاجتماعية.
نتيجة لعدم الاستقرار الاجتماعي والعنف السياسي في بدايات الأزمنة الحديثة، هناك توتر دائم في الدراما الباروكية بين فكرة التجديد والخوف من الكارثة. ويعدّ التشديد على الدنيوية نتيجة لهذا التوتر. إن الانفصال الشكوكي عن كل المعتقدات المثيرة للجدل كان مؤديًا للحفاظ على الذات. في تصريح بارز، يلاحظ بنيامين أنه حتى «الرجل المتدين في حقبة الباروكية يتشبث بالعالم بشدة للشعور بأنه مُنقاد في طوفان معه»[100]. لذا، يوضح بنيامين أن بروز العالم العلماني في الحداثة المبكرة لم يكن افتراض انتصار «المنطق السليم»، أو باستدعاء معايير يقبلها قراؤه العلمانيون لأنها تحدد ما يستحق الإيمان به. وهو يُظهر تجسيد الحكام السذج في سعيهم المستميت للتحكم في العالم الجامح بأنها عروض مجازية.
لماذا يعدّ المجاز الأسلوب المناسب لفهم العالم؟ لأن، المجاز الباروكي، كما يقول بنيامين، بعكس الرمز الرومانسي (أبدي، موحد، وروحي)، له زمنية سلسة، فهو مجزأ دائمًا، ومادي. ويعبر المجاز جيدًا عن كل ما لا يمكن التحكم فيه، أو تحديده، بل وأيضًا العالم المادي للبلاط الأميري الباروكي بما فيه من مكائد، خيانة، وقتل. باختصار، هذا العالم «علماني» ليس لأنه تم استبدال المعرفة الدينية بالمعرفة العلمية (أي، لأن «الحقيقي» أصبح واضحًا أخيرًا)، لكن لأنه، على العكس، يجب أن يعاش في شك، بدون مراسٍ ثابتة حتى لدى المؤمنين، أي عالم يعكس فيه الحقيقي والتخيلي بعضهما بعضًا. وفي هذا العالم، من الواضح أن سياسات الحتمية تعتبر مستحيلة.
فكرة أن دي مان ينسب الطريقة العلمانية إلى رومانسيين المبكرين، بينما يضعها بنيامين في حقبة الباروكية السالفة، هي غير ذات صلة بأهدافي. ما تجدر الإشارة إليه هو أنه من خلال تقريره عن المجاز الباروكي يقدم بنيامين فهمًا مختلفًا «لـ العلماني» عن ذلك الذي يقدمه دي مان في نقاشه حول الرمزية الرومانسية. لا يعتبر بنيامين المجاز مجرد علاقة تقليدية بين الصورة ومعناها بل «طريقة للتعبير». استشهادًا بمصادر من عصر النهضة، يجادل بنيامين بأن الشعارات والطلاسم لا تبين الأشياء فحسب، ولكنها تعطي توجيهات. (اللغة ليست استخلاصًا يقف بمعزل عن «الحقيقي»: لكنها تجسد وتتوسط حياة الناس، إيماءاتهم، والأشياء في العالم). وما يمكن أن تقدمه الشعارات كتعاليم هو أكثر موثوقية من التفضيلات الشخصية البحتة. التشابك في تبادل الآراء هذا، والذي قد يقسمه الكثيرون الآن إلى المقدس والمدنس، يظل بالنسبة لبنيامين سمة أساسية للمجاز. نجد هنا جانبين على الأقل. أولًا، لدينا قدرة الإشارة على الدلالة: ففي النصية المجازية، «كل الأشياء المستخدمة للدلالة مستقاة من حقيقة إشارتها لشيء آخر، وهي قدرة تجعلهم غير قابلين للقياس بأشياء مدنسة، وترتقي بهم إلى منزلة أعلى، وتستطيع بدون شك أن تطهرهم». فيقول بنيامين إن تحقق الأشياء ليس شفافًا بالنسبة للفاعل، ويجب قراءتها دائمًا (بصورة مؤقتة). أما التصوير (أو الدال) وما يصوره (المدلول) فهما مترابطان. كل منهما غير مكتمل، وكلاهما حقيقي بالتساوي.
وثانيًا: الترابط بين عوامل الديني و العلماني في الكتابات المجازية يشير إلى «صراع بين نوايا اللاهوتي والفني»، وهو تركيب لا يشبه السلام الذي تبنته حركة (هدنة الرب) treuga Dei للفصل بين الآراء المتصارعة[101]. بعبارات أخرى، هذا الصراع بين القطبين هو الذي خلق المساحة للمجاز، كما يقول بنيامين، وبذلك أتاح هذا الشكل المحدد للإدراك الذي يطلق عليه «الباروكية».
في رأي كل من دي مان وبنيامين، العلماني يتعارض بوضوح مع الأسطوري. ويعني ذلك استبعاد الرمزية بالنسبة لـ «دي مان»، وتضمين المجاز بالنسبة لبنيامين. بالنسبة لي، يبدو أنه للمقاربتين تبعات مختلفة على البحث وأيضًا السياسة. إحداهما تنادي بكشف القناع عن وهم جمعي نتيجة الرؤية من خلال عالم مسحور[102]، والأخرى تنادي بسبر أغوار التمثيلية المعقدة بين التصورات وما تصوره، وبين الأفعال والتخصصات التي تهدف إلى تعريفها وتثبيتها، وبين ألاعيب اللغة وأشكال الحياة. ولأن بنيامين يحاول أن يثبت وجود التوتر الدائم بين الحكم الأخلاقي والتحقق الصريح، وبين يقين التنوير وشكوك الرغبة، فهو يساعد المرء على مخاطبة الروابط الغامضة بين العلماني والسياسة الحديثة.
الهوامش:
[1] عرضت وجهتا النظر هاتان مؤخرًا في مناظرة بين عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة، عن هذا الموضوع نشرت في «العلمانية تحت المجهر»، دمشق، دار الفكر المعاصر، 2000. أخذت منها موضوع «العلمانية والقانون في مصر تحت الحكم البريطاني» في الفصل السابع.
[2] Andrew Buckser, comp, Course syllabi in the Anthropology of Religion, Anthropology of Religion Section, American Anthropological Association, December 1998.
[3] خذ على سبيل المثال،
Brian Morris’s Anthropological Studies of Religion, Cambridge: Cambridge Universiry Press, 1987, and Roy Rappaport’s Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
فلم يرد أي منهما أي ذكر لمصطلح «علماني»، أو «علمانية»، أو «علمنة»، ولكن بالطبع وردت في كل منهما إشارة واضحة لمصطلح «المقدس». ويشير بنسون سيلر Benson Saler في دراسة استقصائية له بعنوان (Conceptualizing Religion, Leiden: E.J. Brill, 1993)، فقط وبشكل عرضي إلى «النزعة الإنسانية العلمانية كديانة»، والتي تكون أيضًا، بالنسبة لـ العلماني، دينية. إن الاهتمام الأنثربولوجي الحالي بالعلمانية ينعكس بشكل جزئي في عدد من المقوﻻت الموجزة عن الموضوع في قسم خاص من «الأنثربولوجيا الاجتماعية»، المجلد التاسع، العدد 3، 2001.
[4] M. Taussig, The Bervous System, New York: Routledge, 1992, p. 116, italics in original.
[5] على سبيل المثال:
Ivan Strenski, Four Theories of Myth in Twentieth Century History: Cassirer, Eliade, Levi Strauss and Malinowski, Iowa City: University of Iowa Press, 1987, Robert Segal, Theorizing About Myth, Amherst: University of Massachusetts Press, 1999, and Bruce Lincoln, Theorizing Myth, Chicago: University of Chicago Press, 2000.
[6] مصطلح «العلمانية» صكه جورج جيكوب هولييوك George Jacob Holyoake في عام 1851. «كان القصد من العلمانية هو التفريق بين موقف هولييوك المناهض للتوحيد (الإيمان)، وبين تصريحات برادلو Bradlaugh الإلحادية، وعلى الرغم من أن برادلو، وتشارلز واتس، وجي دبليو فووت، وغيرهم من الملحدين، تم تعريفهم من خلال الحركة العلمانية، إﻻ أن هولييوك كان دائم السعي من أجل أﻻ تكون أهداف العلمانية الاجتماعية والسياسية والأخلاقية، بالضرورة، مدخلًا إلى الاعتقاد الإلحادي، على أمل أن أصحاب الحقول المتحررة من المؤمنين قد يشاركون في الترويج لمثل هذه الأهداف، من دون المساس بمعتقدهم، وهو السلوك الذي أصر هولييوك على التمسك به، على الرغم من النجاح الضئيل الذي حققه»
Eric S. Waterhouse, «Secularism», Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. 11, ed. James Hastings, p. 348.
[7] Owen Chadwick, The Secularization of The European Mind in the 19th Century, Cambridge: Cambridge University Press 1975.
[8] كانت هذه اللحظة جزءًا مهمًا من تاريخ أطول من ذلك بكثير. انظر تأثير الانسحاب التدريجي للولاية القانونية على ما عرف، بعد ذلك بأثر رجعي، بنطاق الأخلاق الخاصة، منذ العصور الوسطى، وحتى القرن التاسع عشر، في كتاب جيمس فيتزجيمس ستيفن، «تاريخ القانون الجنائي لإنكلترا»، لندن: ماكملان، 1883، المجلد الثاني، الفصل 25، «الجرائم ضد الدين».
[9] إن مفهوم «النحو» هنا مستمد بالطبع من فكرة فيتغنشتاين Wittgenstein عن التحقيق النحوي. هذا المفهوم ينتشر في كل كتاباته اللاحقة، ولكن انظر بشكل خاص «تحقيقات فلسفية»، القسم 90.
[10] Richard Martin, The Language of Heroes Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989, p. 12, cited in Bruce Lincoln, Theorizing Myth, Chicago: University of Chicago Press, 1000.
[11] يلاحظ مارسيل ديتين Marcel Detienne أن هيرودوت أطلق على قصصه لفظ logoi (منطقية)، أو لفظ hiroi (بطولية)، ولم يطلق عليها أبدًا لفظ «الأساطير». «الخطابات المقدسة الشهيرة، التي يفسرها استخدامنا لها كأساطير، ومما يزيد من سهولة هذا التفسير أن مثل هذه التقاليد ارتبطت على اﻷغلب بإشارات وأفعال شعائرية، هذه الخطابات لم يطلق عليها «أساطير» من قبل»
Marcel Detienne, «Rethinking Mythology» in Between Belief and Transgression, ed. M. Izard and P. Smith. Chicago: Universiry of Chicago Press, 1982, p. 49.
[12] Jan Bremmer, Greek Religion (published for the Classical Association, Oxford University Press, 1994), p. 5.
[13] للاطلاع على تقرير مبكر عن مثل هذه التحولات انظر دراسة R. G. Collingwood، «فكرة الطبيعة»، أوكسفورد: كلارندون، 1945، والتي يتعارض فيها علم الكونيات اليونياني مع وجهات النظر اللاحقة عن الطبيعة.
[14] يتتبع عاموس فنكنشتاين Amos Funkenstein في مؤلفه «اللاهوت والخيال العلمي: من العصور الوسطى إلى القرن السابع عشر، (برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 1986) النظرة العلمية العالمية الحديثة، بمثلها العليا المتمثلة في العلامات المتفق عليها، والطبيعة المتجانسة، وكذلك الميل إلى الميكنة والإخضاع للرياضيات، الذي ظهر في القرن السابع عشر. يستعرض فنكنشتاين، وبشكل خاص في الفصل الثاني المعنون «كلية الوجود الإلهي، جسد الإله، والمثل الأربعة للعلم»، كيف أن اللاهوتية تحتاج إلى رؤية أنطولوجية، وإبستمولوجية جديدة للإله.
[15] Lincoln, p. 42.
[16] أتي على ذكر ذلك في،
Jean Starobinski, Blessings in Disguise; or, The Morality of Evil, Cambridge. MA: Harvard University Press. p. 186.
[17] كتاب فونتنيل Fontenelle الفاضح للأكاذيب (Histoire des oracles 1686)، الذي نشرت نسخته الإنكليزية سريعًا، تحت عنوان (The History of Oracles, and the Cheats of Pagan Priests)، لندن، 1688
[18] Starobinski, p. 182.
[19] من بينهم Starobinski.
[20] Detienne, pp. 46 ــ 47، التشديد في الأصل.
[21] W. W. Fowler, «The Original Meaning of the Word Sacer» in Roman Essays and Interpretations, Oxford: Clarendon Press, 1920, p. 15.
[22] «إذا كان هذا هو المعنى الصحيح لكلمة «Sacer» في «sacer esto»، فأعتقد أنه يمكننا أن نتتبع أثرها إلى المرحلة الأقدم حيث كانت تعني ببساطة «المحرم»، بدون إشارة إلى الإله، وقد رأينا أنه قد جرى استخدامها على هذا النحو في واحد أو أكثر من القوانين القديمة» (Fowler, p. 21)، بيد أن التفسير التطوري المعروض هنا هو تفسير ملتبس وغير ضروري في الوقت ذاته. ويجادل جيورجيو أغامبن Giorgio Agamben في هذا الأمر على نحو مثير للاهتمام، بأن الإنسان المستباح، محل لعنة sacer esto، يجب أن يفهم في إطار منطق السيادة، والتي يعتبرها القوي المطلقة على الحياة والموت.
Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford, CA: Stanford University Press, 1998.
[23] في الحقيقة، يزعم شتاينر أن مشكلة المحرم هي اختراع فيكتوري، تسببت به تطورات اجتماعية وأيديولوجية في المجتمع الفيكتوري نفسه. انظر:
Franz Steiner, Taboo, London: Cohen & West, 1956.
[24] المقولة الكلاسيكية هي لدوركهايم Durkheim، «إن كل المعتقدات الدينية المعروفة، سواء كانت بسيطة أو معقدة، تقدم خصيصة واحدة مشتركة» يكتب دوركهايم «فهي تفترض بشكل مسبق، تصنيفًا لكل الأشياء التي يفكر فيها الإنسان، سواء كانت حقيقة أو خيالية، يقسمها إلى قسمين، أو مجموعتين متضادتين، يتم التمييز بينهما بشكل عام باستخدام مصطلحين مستقلين، واللذين يمكن ترجمتهما ترجمة وافية باستخدام الكلمتين مدنس ومقدس (profane, sacred) إن تقسيم الكلمة إلى نطاقين، يحتوي أحدهما على كل ما هو مقدس، ويحتوي الأخر على كل ما هو مدنس، هو السمة المميزة للفكر الديني؛ المعتقدات، الأساطير، العقائد والخرافات، هي إما صور، أو منظومة من الصور التي تعبّر عن طبيعة الأشياء المقدسة، والمناقب والقوى التي تعزى إليها، أو علاقاتها ببعضها البعض، وعلاقتها بالأشياء المدنسة. ولكن لا يجب أن يفهم المرء أن المقصود بالأشياء المقدسة هو ببساطة تلك الكيانات الشخصية التي يطلق عليها الآلهة أو الأرواح؛ فالصخرة، والشجرة، والربيع، والحصاة، وقطعة من الخشب، والمنزل، وفي كلمة واحدة، أي شيء يمكن أن يكون مقدسًا. الشعيرة قد تكون لها هذه الخصيصة، في الحقيقة، الشعيرة ليس لها وجود، وﻻ تمتلكها إلى درجة ما. هناك كلمات، وتعبيرات، وصيغ، ﻻ يمكن أن تنطق بها سوى أفواه الأشخاص المقدسين، وهناك إيماءات، وحركات ﻻ يمكن للجميع أن يؤدوها» (Elementary Forms of the Religious Life, 1915, p. 37)، اعترض النقاد بأن دوركهايم كان مخطئًا عندما زعم أن المدنس والمقدس هما نطاقان حصريان بالتبادل، ﻷن الأشياء المدنسة قد تصبح مقدسة، والعكس. (انظر؛ William Paden, «Befor ‹The Secular› Became Theological: Rereading the Durkheimian Legacy» Method and theory in the Study of Religion, vol. 3, no.1, 1991، والذي يدفع عن دوركهايم هذه التهمة) وقد احتج النقاد مؤخرًا، بأنه في الحياة العادية يتطابق المقدس والمدنس «يختلطا ببعض»، ولكن حتى مثل هؤلاء النقاد يتقبلون عالمية المقدس، والتي يستعرضونها كنوع خاص من السلطة. وما يعترضون عليه هو فكرة الفصل المتزمت بينها وبين مادية الحياة اليومية» (انظر؛
Colleen McDannell, Material Christianity, New Heaven, CT: Yale University press, 1995, Chapter 1).
[25] انظر:
Michel Despland, «The Sacred: The French Evidence», Method and Theory in the Study of Religion, vol. 3, no. 1, 1991, p. 43.
[26] op. cit.
[27] انظر:
the excellent history of universal suffrage in France: Pierre Rosanvallon, Le Sacre du citoyen, Paris: Gallimard, 1992.
[28] F. lsambert, Le sens du sacre, Paris: Les Editions de Minuit, 1982.
[29] ولكن هذه الشمولية الأصلية التي يشير إليها إيزامبرت Isambert، هي تحديدًا ما جعلها عديمة الجدوى في تعريف خصوصية الدين:
«on voit ainsi que cette expression du domaine sacre etait bien faite pour fonder l’idee d’une evolution des divers secteurs de la pensee a partir de la religion. Mais, pour la meme, la notion devenait impropre a la determiation de la sepcificite du domaine religieux» (Ibid, p. 221).
[30] «C’est ainsi que ie sacn! en arrive a etre constitue en objet mythique» (op. cit., p. 256)
[31] Marett is famous for the claim that «savage religion is something not so much thought out as danced out» R. R. Marett, The Threshold of Religion, 2nd ed., Oxford: Clarendon Press, 1914, p. xxxi. He was also the authority for Fowler’s venture into evolutionary anthropology.
(انظر أعلاه: p. 30, no. 22)
[32] R. R. Marett, Sacraments of Simple Folk, Oxford: Clarendon Press, 1933, p. 4.
[33] أناقش تقرير Hugh of St. Victor’s عن هذه الطقوس الدينية في بعض التفاصيل
in Genealogies of Religion, Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 58 – 153.
[34] Hugh of St. Victor, On the Sacraments f the Christian Faith, ed. R. J. Defarrari, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1951, p. 156.
[35] وفقًا لجون ملبانك John Milbank، هناك تحول عميق حدث في الطريقة التي يفهم بها «السر المقدس»، في وقت متأخر من العصور الوسطى، ما جعل منه الغطاء الخارجي للسلطة الروحية، تحول في الدلالات اللفظية كانت له عواقب بعيدة المدى على التقوى الحديثة (الاتصال الشخصي) انظر أيضًا؛
Michel de Certeau, The Mystic Fable, Chicago: University of Chicago Press, 1992, especially chapter 3.
[36] William Pien.. «The problem of the fetish, I», Res, no. 9, 1985, Steiner, op. cit.
[37] Margaret T. Hodgen, Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Philadelphia: Pennsylvania University Press, 1964.
[38] انظر:
Nicole Belmont, «Superstition and Popular Religion in Western Societies» in Between Belief and Transgression, ed. M. Izard and P. Smith, Chicago: Chicago University Press, 1982.
[39] Thus Durkheim on secular morality: «Ainsi le domaine de la morale est comme entoure d’une barriere mysterieuse qui en tient a l’ecart les profanateurs, tout comme le domaine religieux est sustrait aux atteintes du profane. C’est un domaine sacre «Cited in Isambert, p. 234.
[40] «A Behavioral Approach to the Sacred: Category Formation in Religious Studies» The Journal of the American Academy of Religion, vol. XLIX, no. 4, 1981, p. 632.
[41] إنه على قدر من الأهمية أن محاولات تقديم مفهوم موحد عن «المقدس» في اللغات غير الأوروبية قوبلت بأزمات كاشفة على مستوى الترجمة. وهكذا، وبالرغم من أن الكلمة العربية «قداسة» تقابلها بالإنكليزية كلمة «Sacredness»، فإنها ستبقى الحالة التي ﻻ تصلح لكل السياقات التي يستخدم فيها المصطلح بالإنكليزية في الوقت الحالي. إن ترجمة كلمة «المقدس» تستدعي العديد من الكلمات (محرم، mutahhar، مختص، بلا عقاب، وما إلى ذلك)، كل منها يتصل بنوع مختلف من السلوك. (انظر أدناه، مناقشتي عن لجوء الوعي الذاتي إلى الأسطورة في الشعر العربي الحديث).
[42] E. S. Shaffer, «Kubla Khan» and The Fall of Jerusalem: The Mythological School in Biblical Criticism and Secular Literature, 1770 ـ1880, Cambridge: Cambridge University Press, 1975, p. 10.
[43] في منتصف القرن العشرين حاول تي إس إليوت تقديم صياغة تتضمن كلًّّا من المعاني الدينية والعلمانية للمفهوم. «إذا كان لكلمة «وحي» من معنى، فلا بد أنها تعني أن المتحدث أو الكاتب يتلفظ بأشياء ﻻ يفهمها كلية، أو التي قد يسيء تفسيرها في حالة انقطاع الوحي عنه. هذا بكل تأكيد هو الوحي الحقيقي أو الشعري… (الشاعر) ﻻ يحتاج أن يعرف ما الذي سيعنيه شعره للآخرين، والنبي ﻻ يحتاج أن يفهم المعنى وراء حديثه النبوي»
(Virgil and the Christian World) 1951, in On Poetry and Poets, New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1957, p. 137.
[44] John Montag. «Revelation: The False Legacy of Suarez», in Radical Orthodoxy, ed. J. Milbank, C. Pickstock, and G. Ward, New York: Routledge, 1999, p. 43.
[45] Montag. p. 46.
[46] Michel de Certeau, The Mystic Fable; Volume One: The Sixteenth and Seventeenth Centuries, Chicago: Chicago University Press, 1992, p. 123.
[47] ولكن بالنسبة لمعارضي الحركة الإنجيلية (سواء كانوا مسيحيين، ربوبيين أو ملحدين)، كانت هناك حاجة ملحة لتعريف المؤثرات الحسية الخادعة. «المعارضون ليبراليو التفكير، مثل تشونسي Chauncy، رأوا أن الفورية الصوتية للتقوى الإنجيلية لم تتناغم مع معتقدات الآباء البيوريتان والإخلاص البروتستانتي الأصيل، لكنها مستوحاة من الكويكرز والأنبياء الفرنسيين. وأوضح تشونسي بثقة أن «روحانية المسيحيين لا تنطوي على همسات سرية أو أصوات مسموعة». وبينما افتقد الإنجيليون راسخو الإيمان هذا الوضوح العام، كانت لديهم شكوك مماثلة. وبالحذر المستمر من مخاطر التعصب وادعاءات الوحي الفوري، كان من الممكن أن يكون لدى العديد من الكهنة الإنجيليين الاستعداد للاتفاق مع الكاهن الأنجليكي، بنيامين بيلي Benjamin Bayly، والذي وصف في عام 1708، غاضبًا من بعض التابعين الملهمين ‘هذا النوع من الوحي عن طريق النداءات والأصوات’ بأنه الأقل شأنًا والأكثر التباسًا». ‘يبدو لي أن رجال العلم والتقوى لا ينبغي أن يؤسسوا معتقداتهم على أمور فارغة كالأصوات الجوفاء والضوضاء الخافتة، القادمة من خلف جدار، أو التي لا يمكن لأحد تحديد مصدرها’. «وبينما أرد بيلي حماية الإقناعية المتفردة للصوت المقدس الذي خاطب الأنبياء التوراتيين، بذل كل ما في وسعه لنزع الشرعية عن تلك المناقشات المتزعزعة والوهمية بين معاصريه». (Leigh Eric Schmidt, Hearing Things: Religion, Illusion, and the American Enlightenment, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000, p.71) يصف شميدت Schmidt كيف ارتبط السعي وراء المعرفة العملية حول الصوت والسماع في عصر التنوير بالكشف عن الدجل الديني الذي تضمن بناء حيل سمعية مبتكرة أنتج بها كهنة العصور القديمة (كما يدّعي النقاد العلمانيون) تأثيرات «خارقة للطبيعة».
[48] بمقارنته بين روبرت لوث Robert Lowth، أحد أوائل من اعتبروا العهد القديم شعرًا، ويوهان جوتفرايد هيردر Johann Herder، يكتب روبرتسون سميث Robertson Smith: «بينما يبحر لوث في فن الشعر العبري، يهتم عالم اللاهوت الفايماري بروحه بشكل معبر». وفي ظل تصريح الأول بذلك فقط عن طريق مدح اختيار الشعر للتلاميذ .. يسعى تعريف قرائه، من خلال الشكل الجمالي، على الروح العميقة للعهد القديم… اقترح لوث دراسة اتجاهات الشعر المقدس، من دون الرجوع إلى مصدرها الغامض. بينما تكمن نقطة قوة هيردر في إظهاره لطريقة تدفق شعر إسرائيل النبيل مع قوة طبيعية مطلقة تنبع من أعماق روح لمستها عاطفة ملهمة بالوحي الإلهي. وجد لوث في الكتاب المقدس مجموعات محددة من المواد الشعرية، ويقول: أرغب في تقدير البهاء والفضائل الأخرى في هذا الكتاب، أي قوته في التأثير على العقول، وهي قوة متوافقة مع امتثاله للقواعد الحقيقية للفن الشعري. «لا»، يقول هيردر، «إن القوة الحقيقية للشعر تكمن في كونه ينفذ من القلب إلى القلب. والنقد الحقيقي لا يقع في تصنيف التأثيرات الشعرية وفقًا لمبادئ البلاغة، بل الكشف عن القوى الحقيقية التي حركت روح الشاعر، فالاستمتاع بالشعر يأتي من مشاركة العاطفة التي حركت الشاعر. (William Robertson Smith, «Poetry of the Old Testament» in Lectures and Essays, London: Adam and Charles Black, 1912, p.405). ويقول روبرتسون سميث إن كل الشعراء المبكرين وحَّدوا المشاعر الداخلية مع الطبيعة الخارجية، وبين اليونانيين القدماء والساميين الوثنيين، ينعكس هذا الاتحاد في كل ديانة بشكل مختلف. وبالنسبة للأخيرة «دائمًا ما نجد دينًا قائمًا على العاطفة الشغوفة لا عبادة القوى الخارجية وظواهر الطبيعة في جمالها الحسي، ولكن نتيجة تلك القوى الداخلية، لأنها غير مرئية، تصبح الأشياء الخارجية مجرد رمز» (المرجع نفسه، ص 425). الفكر التطوري هنا يكمن في أن العبادة السامية للقوى الداخلية (الروحية) في مقابل الأشكال الخارجية (المادية) أتاحت لهم تلقي الوحي الإلهي (تواصل من قبل الإله)، بالرغم من أن تحول العبرانيين من الدين الرسمي إلى الروحي كان يتعثر باستمرار بسبب سقطات وثنية.
[49] «بفرض أن السؤال هو عما إذا كان الدين المسيحي موحى إلهيًا»، كما يشير يوهان ديفيد مايكيلز Johann David Michaelis عالم لاهوت القرن الثامن عشر، «فإن أصالة الكتابات المقدسة أو عدمها، تصبح أكثر أهمية مما قد يتصور المرء للوهلة الأولى… بافتراض أن اﷲ لم يوحِ أيًا من كتب العهد الجديد، ولكنه ترك الحرية ببساطة لمتى ومرقص ولوقا ويوحنا وبولس لكتابة ما يعرفونه، طالما كانت كتاباتهم قديمة، أصيلة، وموثوقة، فإن الدين المسيحي سيظل الحقيقي». انظر:
Peter Bietenholz, Historia and Fabula: Myths and Legends in Historical Thought from Antiquity to the Modern Age. Leiden: Brill, 1994. pp. 315 – 16.
[50] J. Stroup, «Protestant Church Historians in the German Enlightenment». in H. E. Bodeker et al., eds., Aufklarung und Geschichte, Gottingen: Vandenhoeck & Rupercht, 1986, p. 171.
[51] Starobinski. p. 191.
[52] كانت هناك أحوال أخرى أيضًا. «هذا الصعود للدولة المركزية أوحى إلى ظهور مجموعة مثقفة لم تتحدد آفاقها بأفكار مجتمع خصوصي»، يقول ستروب Stroup. بالتوافق مع هذا الظهور، جاء أصل الورع والتنوير المسيحي ليضع تشديدًا عظيمًا على التساهل العام والتقوى الخاصة: وأصبحت للكنيسة المؤسسية ودوجماها أهمية ثانوية. ما يهم كان الوصول لمسيحية تتخطى الفصائل القائمة: أي مسيحية محصنة ضد مؤامرات الدولة الكهنوتية. هذا الهجوم المتصل على الشرعنة الإلهية، التأسيس الرسولي، والامتياز العدلي للكنسية المؤسسية القائمة ودوجماها وكهنوتها، أعطى جاذبية للتاريخ. وقد تم بذل الجهد لإعادة تشكيل المسيحية وإزالة الجوانب الحادة التي تؤرق الدولة المركزية وحلفاءها الاجتماعيين». (المرجع السابق، ص 170). ومع ذلك، ليست الدوافع المزعومة للاهوتيين هي التي تهمني بقدر التقنيات التي استحدثوها مثل «النقد المصدري» الذي ساعد على إنتاج مجال التاريخ العلماني الحديث.
[53] هناك بالطبع لحظات سابقة في إنشاء التاريخ الحديث يمكن تحديدها بأثر رجعي. لذا، تم اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه خلال حركة الإصلاح المضاد من قبل اللاهوتي الدومينيكاني ملكيور كانو Melchior Cano عندما سعى للدفاع عن السلطات التقليدية المعرضة للهجوم. انظر:
Julian Franklin, Jean Bodin and the Sixteenth Century Revolution in the Methodology of Law and History, New York: Columbia, 1963, «Chapter VII. Melchior Cano: The Foundations of Historical Belief).
ولكن اهتمامي هنا ينصب على تطورات القرنين الثامن والتاسع عشر عندما فصلت فكرة التاريخ «العلماني» نفسها نهائيًا عن «الديني».
[54] Herbert Butterfield, Man on His Past: The Study of the History of Historical Scholarship, Cambridge: Cambridge University Press, 1955. pp. 15 – 16.
[55] تداعي التاريخ الكنسي في التاريخ العام للبشرية كان خطوة حيوية لإنشاء الدين المقارن (انظر:
Stroup p. 191).
[56] هناك نقاش مثير للاهتمام حول «الوحي بالتخدير» في كتابات ويليام جيمس
(The Varieties of Religious Experience, Fontana Books, 1960 «1902», Lectures XVI and XCII).
لا يدري جيمس مصادر التجارب الروحية التي ذكرها العديد ممن خضعوا لتخدير كلي لأجل عملية جراحية. ولكن بالتعليق على نشوات القديسة تيريزا، يكتب: «بالنسبة للعقل الطبي، تلك النشوات لا تمثل إلا حالات شبه نومية مقترحة ومقلدة، على أسس التدهور والهيستيريا العقلية. وبدون شك، تلك الحالات المرضية وجدت في العديد من الحالات، وربما كلها، ولكنها في الحقيقة لا تخبرنا بأي شيء عن قيمة المعرفة لدى الوعي الذي تستدعيه. ومن أجل إصدار حكم روحي على تلك الحالات، يجب ألا نكتفي بالحديث الطبي السطحي، بل الاستدلال على فوائده للحياة» (p.398). تقوم فلسفة جيمس الدينية على فكرة أن حفظ الوعي المسيطر حتى يتم تقييم الأفعال المنسوبة لفاعل وحدودي إجمالًا على أسس براجماتية. جيمس، في افتراضه للفاعل الوحدودي، هو أقرب إلى فرويد بمفهومه حول الوعي الذي يسيء قراءة لغة اللاوعي المكبوت، والذي ينبغي الكشف عنه من خلال ممارسة التحليل من فكرة النفس المنحرفة عن المركز، والتي لا يمكن استرداد تجاربها المتعاقبة. وصحيح أن فرويد عقد صورته المبكرة عن الهو والأنا كثيرًا لتشغل اختصاص اللاوعي والوعي بالترتيب، حتى أصبح يُنظر للأنا في حد ذاته بأنه فاقد الوعي جزئيًا. ولكن تبقى القضية هنا أن عمل التحليل العلاجي يتعذر إذا تم اعتبار الذات منحرفة أفقيًا عن المركز.
[57] بدأت سيكولوجيا الإثارة في القرن الثامن عشر لكونديلاك وهارتلي Condillac and Hartley بعمل ذلك.
[58] E. S. Shaffer, p. 90.
[59] Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria (1817).
[60] انظر:
Francois Isambert, «At the Frontier of Folklore and Sociology: Hubert, Hertz and Czarnowski, Founders of a Sociology of Religion», in The Sociological Domain: The Durkheimians and the Founding of French Sociology, ed, P. Besnard, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
[61] كما كتب الهيغلي ديفيد ستراوس David Strauss في مقدمة تأريخه «حياة يسوع» (1815): «الأرثوذكس والواقعيون سواء ينطلقون من الافتراض الخاطئ الذي اتبعناه دائمًا في الشهادات الإنجيلية، حتى تلك التي نشهدها بأعيننا، في الحقيقة. ولذا فهم يسائلون أنفسهم عما كان من الممكن أن تكون الواقعة الحقيقية والطبيعية والتي يعترف بها هنا بطرق استثنائية. علينا أن ندرك أن الرواة يشهدون أحيانًا، لا بحقائق ظاهرية، بل أفكار، وعادة ما تكون الأكثر جمالًا وعملية، وتفسيرات حتى شهود العيان أحالوها بدون وعي فوق الحقائق، وتخيلات متعلقة بهم، وتأملات حولهم، تأملات كانت طبيعية في حينها وطبيعية للمستوى الثقافي للمؤلف. وما نواجهه هنا ليس كذبًا، لكنه تحريف للحقيقة. إنه فهم تافه، ساذج، وفي نفس الوقت، عادة ما يكون الأكثر عمقًا للحقيقة في مجال الإحساس الديني والبصيرة الشعرية. وينتج عن ذلك سرد أسطوري، خرافي في طبيعته، وتفسيري عادة للحقيقة الروحية بنسق أكثر مثالية مما يمكن أن يحققه أي تعبير متشدد ومبتذل».
(W Neil, «The Criticism and Theological Use of the Bible, I700 – I950», in The Cambridge History of the Bible, vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 2.76).
[62] كتب مايكل توسيغ Michael Taussig دراسة تاريخية إثنوغرافية مثيرة للاهتمام، في موضوع: Shamanism, Colonialism and the Wild Man, Chicago: Chicago University Press, 1987.، وكان كتاب توسيغ أحد مصادر إلهام كتاب كارولاين همفري Caroline Humphrey, Shamans and Elders: Experience, Knowledge and Power Among the Daur Mongols, Oxford: Clarendon Press, 1996.
[63] Gloria Flaherty, Shamanism and the Eighteenth Century, Princeton, Princeton University Press, 1992.
[64] يصف التاريخ الانتصاري لعلمنة الألم هذه العملية بأنها تحول من التسليم للمعاناة والقسوة المبررة بالمعتقدات الدينية والمتغاضى عنها قبل العصر الحديث، إلى تراكم المعرفة العلمية وتعاظم التوجهات الإنسانية التي قادت إلى اكتشاف واستخدام التخدير في القرن التاسع عشر. انظر:
«Donald Caton, M.D., «The Secularization of Pain, Anaesthesiology», vol. 62, no. 4. 1985».
[65] «أصبح ألمهم علمانيًا تمامًا، وتم اعتبار الألم والمرض بأنهما عقاب الطبيعة لإهمال الإنسان لنظامه الغذائي، بينما كان يُنظر للمرض العقلي على أنه علامة على الصراع بين كل فرد وقيود النظام الاجتماعي؛ وقد دعا هذا التفسير إلى إعادة تنظيم جذري للمجتمع في حالة اعتراض مبادئه (العفة تحديدًا) للطبيعة. ويفسر ذلك سبب رؤية طبيب عصر التنوير بأنه كي يكون الفرد رجل فضيلة جيدًا عليه أن يكون طبيبًا جيدًا، وبذلك تم عكس العلاقة التقليدية بين الطب والفضيلة».
(Roselyne Rey, The History of Pain, Cambridge, Mass.: Harvard University Press,1993. p. 107).
[66] انظر:
Basil Willey’s The 18th Century Background: Studies on the idea of Nature In the Thought of the Period, London: Chatto & Windus, 1940.
[67] ترى راي أن «التغير الأساسي، حدث في موضع آخر… يقع هذا التغير تحديدًا في فكرة أن التساؤل المسألي حول الألم تم وضعه بالنسبة للطبيب أو الفسيولوجي خارج إطار مشكلة الخطيئة، الشر، والعقاب» (Rey, p.90). بمعنى أن مسألة الألم تصبح الآن «شر إنساني» وهو مبدأ علماني يفتقر إلى التفسير اللاهوتي.
[68] المرجع السابق، ص 91 .
[69] تلاحظ راي أنه في أعمال هالر «يصبح ألم الحيوان أداة للبحث الفسيولوجي الذي أتاح له تقرير أن الأعصاب والأجزاء المعصبة هي الحساسة، بينما ألياف العضلات هي سريعة الاستجابة فقط» (المرجع نفسه، ص 110).
[70] المرجع نفسه، ص 109. في مقالة عرض حول تأريخ روي بورتر Roy Porter للطب، يشير توماس لاكوير Thomas Laqueur بأسف إلى طباق العنف والألم الذي يلحق بالحيوانات والبشر من أجل التجربة، الذي صاحب القصة الانتصارية للطب الحديث.
(T. Laqueur, «Even Immortality», London Review of Books, July 29, 1999).
[71] للرجوع إلى المبادئ الجديدة للتجربة في طب القرن السابع عشر الطبيعي انظر:
Peter Dear, Discipline and Experience: The Mathematical way in the Scientific Revolution, Chicago: University of Chicago Press, 1995.
[72] انظر: Flaherty, p. 99.
[73] في دراستها للشامانية والإلهام الشعري، تشير نورا تشادويك Nora Chadwick إلى إثنوغرافي الحياة السيبيرية بالقرن التاسع عشر: «وفقًا لنيموجوسكي Niemojowski، فإن الأطفال الذين يتم تكريسهم للشامان يعلمهم رجال مسنون، شامان بدون شك، ليعرفوا ليس المظاهر الخارجية والاحتفالات فقط، بل أيضًا الوظائف الطبية للنباتات والأعشاب، والطرق المختلفة للتنبؤ بالطقس من خلال سلوك وهجرة الحيوانات (Poetry and Prophecy, Cambridge: Cambridge University Press, 1952, p. 53).
[74] Flaherty, pp. 74 – 75.
[75] Ibid, chapter 6.
[76] المرجع السابق، ص 150.
[77] انظر: المرجع السابق، ص 159.
[78] انظر: المرجع السابق، ص 151 ــ 152.
[79] انظر: المرجع السابق، ص 153.
[80] I. Kant, Anthropology from a Pragmatic Point of View, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1978, p. 22.
[81] ملحمة كولريدج Coleridge غير المكتملة Kubla Khan كانت معلمًا رئيسيًا كما أظهرت إلين شافر Elaine Shaffer في تطور الشعر الديني الحديث. ولكن بلايك Blake (الذي كان مصدرًا لإلهام كولريدج، بالصدفة) يعتبر مهمًا جدًا هنا، بالرغم من أن شافر لم تناقش عمله.
[82] Public Moralists: Political Thought and Intellectual Life in Britain, 1850 – 1930, Oxford: Clarendon, 1991, p. 276.
[83] Robert Langbaum, The Modern Spirit: Essays on the Continuity of Nineteenth and Twentieth Century Literature, Oxford: Oxford University Press, 1970, p. 87.
[84] انظر: المرجع السابق، ص 82.
[85] انظر أيضًا Joseph Frank. «Spatial Form in Modern Literature», in The idea of Spatial Form, Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1991.
[86] بدأت مقالات الإنسيكلوبيدي Encyclopedie بـذكر «التقليد» بمعناه اللاهوتي، ثم «التقليد» بالمعنى الديني (المسيحي واليهودي)، وصولًا إلى «التقليد الميثولوجي» وانتهاء إلى «التقليد» بعناه الفقهي (عملية نقل، التنازل عن شيء).
[87] انظر: Michael Bell and Peter Poellner, eds., Myth and the Making of Modernity: The Problem of Grounding in Early Twentieth Century Literature, Amsterdam/ Atlanta, GA: Rodopi, 1998.
[88] جاءت التسمية بناء على دورية تحمل نفس الاسم، جرى تأسيسها في بيروت عام 1956.
[89] انظر الحوار المطول الذي أجراه صقر أبو فخر: «حوار مع أدونيس: الطفولة، الشعر، والمنفى»، خاصة الجزء التاسع، المنشور في صحيفة القدس العربي، 14 يوليو/تموز 2000، ص 13، ويتطرق إلى التنوير، العلمانية، الدين، والتقليد، ودور الأسطورة في كل منها. في إحدى النقاط، بالإشارة إلى عمل حرره أدونيس مكون من ثلاثة مجلدات حول أساطير ما قبل الإسلام، يسأله المُحاور عن سبب غياب الأساطير والملاحم في الإسلام. يجيب أدونيس أن الإسلام رفض النصوص السابقة كتعبير عن الوثنية أو الخرافة والسحر، بالرغم من أنه تبنى العديد من الأساطير المرتبطة باليهودية مثل قصص حول عصا موسى السحرية، وانشقاق البحر الأحمر، وهكذا وهي في حد ذاتها إعادة كتابة لأساطير سابقة في المنطقة.
[90] ظهرت الأسطورة (اليونانية والتوراتية) أيضًا في أعمال من يطلق عليهم الشعراء الرومانسيين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، مثل أبو شادي، ناجي، أبو شبكة، وآخرين. بتقليد الأساليب الشعرية الغربية، ترك لهم انغماسهم مجالًا قليلًا للتأمل في مشكلة الخلاص الثقافي (انظر:
- M. Badawi, «Convention and Revolt in Modern Arabic Poetry». in Modern Arabic Literature and the west, London: Ithaca Press, 1985).
أما بالنسبة للشعراء «الجدد» فكان هذا الانشغال الأخير تحديدًا هو الذي أعطى لاهتمامهم بالأسطورة قوة الدافع. لذا، في منشوره الشهير «بيان الحداثة» عام 1992، يقارن أدونيس بنفس حاسدة بين العربي والآخر الغربي، ويجد في الأخير كل ما هو ذو قيمة. «ليست الحداثة فقط هي ما تغيب عن الحياة العربية»، يخلص أدونيس، «ولكن الشعر نفسه يغيب أيضًا»
(Muhammad Lutfi al Yusufi, «al Qasida al muasira» in Fandi Salih, ed., al Mu’aththarat al ajnabiyya fi al shi’r al ‘arabi almu’asir, Beirut, 1995, p. 57).
[91] Adonis (Ali Ahmad Sa’id), al Thabit wa l mutahawwal, Beirut: Dar al Awda, 4th ed., vol. I, 1983, p. 89.
[92] في سنوات أخيرة، أنتج علماء الإسلام الغربيون بعض التحليلات الجديرة بالملاحظة عن الأسطورة في الإسلام. لذا، يدعي ياروسلاف ستاتكفيش jaroslav stetkevych أن القرآن هو تمثيل كسري لأسطورة عربية قومية تؤسس لسلطة محمد ككاهن ملك نمطي. أجد محاولته لتقديم الافتراضات الفيكتورية عن القداسة والقومية في تقليد ثقافي مختلف تمامًا بأنها مبتكرة لكن غير مقنعة (J. Stetkevych. Muhammad and the Golden Bough, Bloomington: Indiana University Press, 1996). هناك مقاربات مختلفة تمامًا حول الأسطورة في القرآن، وهي في رأيي أكثر إثمارًا من قبل أنجيليكا نيويرث Angelika Neuwirth. بعكس ستاتكفيش وأدونيس، لا تهتم نيويرث بالأساس بسرديات أسطورية لكن بالبنى الزمنية للبلاغة القرآنية. وهي تصف تفصيليًا كيف يقوم أسلوبه باستدعاء وإعادة تمثيل ما تطلق عليه الزمن الأسطوري. وهي تؤكد على أهمية القرآن كتلاوة وليس مجرد نص أي، كونه لا يقرأ ببساطه لمحتواه الإعلامي لكنه يُقرأ ويُسمع باندماج تمام مع الإلهي؛
(A. Neuwirth, «Qur’anic Literary Structure: Revisited: Sartt al Rahman between Mythic Account and Decodation of Myth», in Story telling in the Framework of Non fictional Arabic Literature, ed. S. Leder, Wiesbaden: Harassowitz. 1998).
[93] Margaret Canavan, «On Being Economical with the Truth: Some Liberal Reflections», Political Studies. vol. 38, 1990. p. 9.
[94] S. Hampshire, «Liberalism: The New Twist». The New York Review of Books, vol. 40, August 12, 1993, pp. 45 – 46.
[95] Canovan, p. 16.
[96] يمكن إيجاد مجاز البستنة أيضًا في الخطاب الاستعماري للقرن التاسع عشر. لذا، اللورد كرومر، الحاكم البريطاني الفعلي لمصر منذ عام 1883 إلى 1907، في عرضه للإصلاحات التي تمت تحت قيادته، يقول، بثقة ملكية: «كما تجذرت بذور الحضارة الغربية الحقيقية بعمق ذات مرة، هذا هو الحال الآن في مصر، في النهاية، لن تتمكن القوى الرجعية، مهما كانت خبيثة، من كبح الإنبات والنمو المطلق. البذور التي زرعها الحكام المصريون السابقون للاحتلال البريطاني لم تنبت إلا أعشابًا ضارة. وما تم زرعه الآن هي بذور حضارة حقيقية. وسوف ينبتوا ثمارهم في موسمهم بالتأكيد. العداوة، الجهل، التحيز الديني، وكل القوى التي تجتمع حول النظام الاجتماعي الباطل والفاسد، قد تفعل كل ما في وسعها، لكنها لن تنجح. لقد وجهنا ضربة لقوى الرجعية في مصر بحيث لن تتمكن من التعافي أبدًا، وبحيث إذا وفت إنكلترا بواجباتها أمام نفسها، والمصريون، والعالم المتحضر، لن تتاح لهم أي فرصة للتعافي» (Modern Egypt, vol. II, London: Macmillan, 1908, pp. 558 – 559) هذا الاستخدام المجازي لعمل الحديقة في ذروة الاستعمارية يفتقر بوضوح إلى الكآبة في أسطورة البستنة ما بعد الاستعمارية لكانوفان.
[97] Leonard Binder, Islamic Liberalism, Chicago: University of Chicago Press, 1988, p. 1.
[98] In P. de Man, Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric if Contemporary Criticism, Minneapolis: University of Minnesota Press,1983.
[99] W. Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, London: Verso, 1977.
[100] المرجع السابق، ص 66.
[101] المرجع السابق ذكره، ص 77 ــ 162.
[102] لا أود أن يُفترض أنني أقول إن آراء دي مان عن الكشف بسيطة. على العكس. يكتب دي مان في «النقد والأزمة»: «بنفس الطريقة التي تنتج بها الكلمات الشعرية في لحظات من السكينة وغياب المشاعر الحقيقية، ثم تنتقل إلى اختراع مشاعر تخيلية لخلق وهم الذكرى، فإن الأعمال الخيالية تخترع مواد تخيلية لخلق وهم الواقع للآخرين. ولكن الخيال ليس الأسطورة، لأنه يدرك ماهيته ويقدم نفسه على أنه خيال. وهو لا يمثل إزالة للغموض، فقد أزيل الغموض عنه منذ البداية. عندما يعتقد النقاد الجدد أنهم يزيلون الغموض عن الأدب، ففي الحقيقة أن الأدب هو الذي ينزع الوهم عنهم، ولكن لأن هذا يحدث بالضرورة في شكل أزمة، فهم غير مبصرين لما يحدث في دواخلهم». (de Man, p.18). يقول دي مان إن الأدب يهتم بالتسمية، ولكن ما تتم تسميته لا يعد «الغياب كما يفترض النقاد الذين يهدفون إلى إظهار وظائفه الأيديولوجية ولكن العدم». ولكن يبدو لي أن هناك رغبة في تصريح دي مان باستحضار أثر المقدس في عالم «تحرر من الوهم».


